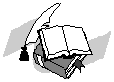محاضرة في
أهمّيّة اللّغة
وتدريسها
وأهدافها
ودورها
في بث
العلوم
والمعارف
وتسهيل
الإتصالات
***
فريد
الدين آيدن
Feriduddin AYDIN
أسطنبول
– 1996م.
***
بسم
الله الرحمن
الرحيم
الحمدُ
للهِ ربِّ
العالمين
والصّلاةً
والسّلامُ على
سيِّدنا
محمّدٍ وعلى
آلِهِ
وصحبِهِ
أجمعين.
أمّا
بعد، أيها
الإخوة!
العلم
بأوجز معناه،
هو انتفاء
الجهل. فالعلم
نور، والجهل
ظلمة، بل
ظُلُماتٌ في
ظُلُماتٍ.
تعلمون
بالتّحقيق،
أن أوّلَ ما
أنزل الله على
رسوله صلى
الله عليه
وسلّم – وهو
بغار حراء-،
قوله تعالى: »إقرأ
بِاسْمِ
رَبِّكَ
الَّذى
خَلَقَ ،
خلَقَ
الإِنْسَانَ
مِنْ عَلَقٍ، اقرأ
وَرَبُّكَ
الأكْرَمُ
الّذيِ
عَلَّمَ بِالْقَلَمِ
عَلَّمَ
الإنْساَنَ
ماَلَمْ يَعْلَمْ«
صدق الله
ربُنا العظيم.
وهذا من أكبر
الدّلائل
وأجلِّها على
أن الإسلام
دين العلم
والمعرفة.
يقول
الله تبارك
وتعالى في فضل
العلم والعالم:
قُلْ هَلْ
يَسْتَويِ
الَّذِينَ
يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ
لا
يَعْلَمُون،َ
إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ
أُولُوا
الأَلْبَابِ
[الزمر: 9] نلمس
في هذه الآية
الكريمة
نموزجاً
رائعاً من نمازج
البيان
القرآنيِّ إذ
تُذَكّرُنا
هذه الكلماتُ
المقدّسةُ
بفضل العلم
والعالم في
الوقت ذاته.
ويقول سبحانه
وتعالى: »يَرْفَعُ
اللهُ
الّذيِنَ
آمَنواُ
مِنْكُمْ
وَالّذيِنَ
أوُتواُ
الْعِلْمَ
دَرَجاَتٍ «
[المجادلة: 11]
نشاهد في هذه
الآية
الكريمة تصريحاً
بأنّ
العلماءَ لهم
درجاتٌ عند
ربِّهم ومكانةٌ
خصّهم الله
بها. ويقول
ربُّنا في
آيةٍ أخرى: »شَهِدَ
اللهُ أنّه
لاَ إلَهَ
إلاَّ هُوَ
وَالْمَلاَئِكَةُ
وَأُلوُ
الْعِلْمِ
قاَئِماً
بِالْقِسْطِ«
[آل عمران: 18] إن
الله تعالى
يعتدّ هكذا
بشهادة أهل
العلم في
وحدانيته؛
فيقرن
شهادتهم
بشهادته
تعالى وشهادة
الملائكة. وفي
هذا من رفع
قدر أهل العلم
ما فيه.
لذا،
عليكم بالسهر
والمواظبة في
طلب العلم،
وإياكم أن ترو
الكفاية فيما
قد جمعتم. إنّ
المخلص الجادَّ
في طلب العلم
والمعرفة لا
يألو جهداً في
ازدياده، ولا
يقنع بالرصيد
الذي يتمتّع به.
أيها
الشباب!
عليكم
بالعمل
الصّالحِ.
وأفضل
الأعمال الصّالحةِ
بعد أداءِ ما
فرض اللهُ على
عباده هو
السّعيُ في
طلب المعرفةِ
وازدياد
العلم.
فالطالبُ
الجادُّ
المخلصُ لا يألو
جهداً في سبيل
مطلوبهِ حتّى
يظفرَ به. لقد
كان السّلفُ
الصّالحُ ومن
كان على نهجهم
من أئمّةِ
الخلفِ،
كانوا لا
يُبْطِئونَ
عن متابعةِ
السّيرِ في
الحصول على
أدنى مسألةِ
من مسائل
العلمِ.
فجمعوا ما
جمعوا من كنوز
المعارفِ حتى
أذاقهم الله
سعادةَ الفوز
في هذه الحياة
الدّنيا،
فحبّبهم إلى
جمهورِ أهل
العلمِ،
وخلّدَ
ذكرَهم إلى
يوم القيامةِ.
ولهذا،
أنصحكم أولاً
بتقوى اللهِ
تعالى ثمَّ
بمتابعةِ
دروسكم
ملتزمين
جانبَ
العزيمةِ فيها.
عسى الله أن
يبلِّغكم
وإيّانا
منازل
الصّالحين.
أيها
الشباب!
لا
ينبغي أن
تقتصر جهود
التلميذ على دراسة
نوعٍ معيّنٍ
من العلوم، بل
يجب عليه أن يُلِمَّ
بأصنافٍ
مختلفةٍ منها.
نعم
يجب عليه أن
يركّز جلَّ
اهتمامه على
نوعٍ من
العلوم يألف
مع طبعه وتصبو
إليه نفسُه،ُ
ولكن مع هذا
يحب عليه في
الوقت ذاته أن
يدرس شطراً من
كلّ فصيلةٍ من
بقية العلوم
حتى يحظى
نصيباً منها
ويتميّز
بثقافةٍ عاليةٍ
تكون عونًا له
في علاقاته مع
الناس، ويكون
هو بذلك واسع
الإطلاع،
لأنّ الإنسان
إنّما ينضج
بكثرة علمه
وتجاربه
ومهاراته،
فيكون بذلك
مقبولاً عند
الناس
ومرموقاً
بينهم.
واعلموا
أنّ الناس
يحتاجون إلى
من يفوقهم. وإنما
يفوق
الإنسانُ
أمثالَه بأحد
الميّزتين؛
إمّا
بالمقدرة
المالية، أو
إمّا
بالمقدرة العلمية.
أما المال
فمهدّد
بالزوال
بغتةً. فكم من
ثَريِّ أصبح
فقيراً بعد أن
كان أغنى الناس؛
ولكنّ العلم
الراسخ قلّما
يُخسِرُ
صاحبَهُ.
اخوتي،
لقد
منّ الله
علينا أن وهب
لنا فرصة
اللّقاءِ على
مائدة العلمِ
ولو في أوقاتٍ
متباعدةٍ، فلا
ينبغي أن
نستحقرَ هذه
النعمة
لقلّتِها. فكم
من قليلٍ
يُجْدي
بثمراتٍ لا
حصر لها. يجب
علينا أن
نعترفَ بهذه
النّعمة الكريمةِ
"وَأَمّا
بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ
فَحَدِّثْ"
كما يجب علينا
أن نَمْثُلَ
بين يدي
ربِّنا
بالحمد
الجميلِ
والثّناءِ الجزيل
على ما خصّنا
بإحسانه
وإكرامهِ
فجعلنا ممّن
يستمعون
القولَ
فيتّبعونَ
أحسَنَهُ. ذلك
بفضله تعالى
نجتمع في هذه
البقعةِ
المباركةِ،
ندرس ونذاكر
ونتباحث عن
الحقيقة
لنتعلّم في
كلِّ تجربةٍ
شيئًا جديدًا
ولنـزداد
معرفةً
وحكمةً. مع
هذا لا بدّ أن
نكون
مستعدّين
لاستقبال ما
قد يصيبنا من
البلاءِ.
اخوتي،
أعزّكم
اللهُ تعالى،
ورزقكم
وإيّانا
العلم النّافع
والعمل
الصّالحَ، أنّه
لا ينبغي أن
تتناسوا ما
يعاني طالبُ
العلمِ في
بلادِنا
اليومَ من وَصَبٍ
وَنَصَبٍ
ومشقّةٍ
وحرمانٍ. لقد
ضاق الأرضُ
على طالبِ
العلمِ بما
رحُبتْ
خاصّةً في هذه
الأيّام الّتي
أوشك أن لا
يجد مَنْ
يُجيبُ عن
سؤالهِ، أو
نجدَ نحن
مجلسًا يتّصف
بمجلس العلم
على حقيقتِهِ.
هذا على
الرّغم من
كثرة المدارس
والجامعاتِ.
لأنّ كلّ هذه
الأبنية
الّتي يُطلَقُ
على بعضِها
اسمَ
المدرسةِ،
وعلى بعضها
اسمَ
الجامعةِ
والكلّيّةِ؛
في الواقع
ليستْ إلاّ
مسرحيّاتٌ
يتلاعب
السّماسرةُ
فيها بالعلمِ؛
وقد ضاعت
المعارفُ،
وحارَ
العالِمُ، وخيّمَ
الجهلُ على
المجتمعِ
بظلامِهِ
ومخاطرِهِ.
ولهذا أصبح
العلمُ
غريبًا،
فاشتبه على
النّاسِ مفهوم
العلمِ؛ منهم
من يُسمّيه
الثقافة، ومنهم
من يسمّيه
الفنَّ،
ومنهم من
يُسمّيه الصّناعةَ،
ويربطونه
بمفهوم
الحضارةِ
والتّكنولوجيا.
بينما العلم
بمفهومه
العامِّ هو
انتفاء الجهل
بالواقع
الضّروريِّ.
ذلك أنّ الإنسانَ
يحتاجُ إلى
معرفة سلسلةٍ
من الحقائقِ:
يحتاج بالدّرجة
الأولى أن
يتعرّف على
نفسِهِ،
وبالتّالي
على بيئتِهِ،
ثمّ يحتاج إلى
معرفِ أسرارِ
الكونِ
والْحَيَاةِ.
وإنّما يهتدي
بعد ذلك إلى
ما يترتّبُ
عليه من
مسئولية
الإيمان
والعمل
الصّالح.
إذن
الواقع
الضّروريُّ
هو الإيمانُ
بالله وبما
جاء من عنده
جملةً
وتفصيلاً. ولا
ينتبه
الطالبُ إلى
هذا الواقع في
غمار الأحداث
الّتي
تُضِلُّهُ
إلاّ بهداية
الله، وللحكمةِ
صلةٌ
بالهداية كما
يشير إلى ذلك
قوله تعالى:
"وَمِنْ
يُؤْتَى
الْحِكْمَةَ
فَقَدْ
أُوتِيَ
خَيْرًا
كَثيِرًا."
و"الحكمةُ ضالّةُ
المؤُمِنِ،
أينَ وجدها
أخذها."
أمّا
الحكمةُ: فهي
التّعبيرُ عن
الحقيقة بألفاظٍ
جميلةٍ ذاتٍ
معانٍ جليلةٍ.
أي هي البلاغةُ
بعينِها،
فهذا هو
مقصودُنا
ومطلوبُنا الّذي
يجب علينا أن
نبذل في
سبيلهِ
قُصارى جهودِنا،
وأن نفتديّ
لهذا الغرضِ
بكلّ ما
نملِكُهُ من
وقتٍ ومالٍ.
فهذا هو الّذي
جعلَنا نهتمّ
بعلوم قواعد
العربيةِ من
صرفٍ ونحوٍ
واشتقاقٍ
وإعرابٍ وإعلالٍ،
ثمّ بعلوم
البلاغة من
بيانٍ ومعانٍ
وبديع وما
إليها...
إخوتي،
المعرفةُ
مفهومُ
عملاقٌ ذو
أبعادٍ
متراميةٍ
تشتمل على
كلِّ ما
يستطيعُ
العقلُ
البشريُّ أن
يستوعبَه.
كلُّ شيءٍ
يعرفُهُ
الإنسانُ، أو
يريد أن
يتعرّفَ إليهِ،
يدخل في شمول
هذا المفهوم.
فما دام العقلُ
محدودًا لا
يستطيع أن
يستوعب أكثر
ممّا خُلِقَ
له، إذن يجب
على كلّ طالب
المعرفةِ أن يحدِّدَ
هدفَهُ في طلب
العلم.
نحن
كأبناء العلم
وخدّامِهِ
وسدنتِهِ منذ
أيّام الطّفولةِ،
وقد بلغ
أصغرُنا
الثلاثين من
العمر أو كاد؛
لا ينبغي أن
نُسرِفَ
وقتَنا بعد
هذا السّنِّ
فنشتغلَ
بالتّفاصيل،
بل يجب علينا
أن نتعلّم
أشياءَ
جديدةً لم
نتمكّن من
معرفتِها فيما
سبق.
أنتم
في الحقيقةِ
لستم طلبة
المدارس
الثانويةِ،
بل يفوق
مستواكم على
المستوى الجامعيِّ
بفضل جهودِكم
الخاصّةِ
ورَحَلاَتِكُمْ
إلى البلاد
العربية،
ومعاناتكم
مشاقَّ
الغُربةِ إذ
تذوقون مرارة
الحياةِ،
ولكن بفضلِ
تجارُبكم
التي
اكتسبتموها
يومئذٍ وما
زلتم
تزدادونها
حتّى الآن.
إذن أنتم لا
تحتاجون
أصلاً إلى حفظ
القواعد، ولا
إلى تكرار ما قد
درستم من
المقرّرات
التّعليميّةِ
أيّام
تطوافِكم على
العلماءِ
والأساتذةِ
والمرشدين. بل
تحتاجون
اليوم
بخَاصّةٍ إلى
الأسلوب
الأمثل في
الأداءِ
والحوار.
إنّ
حفظ فواعد اللّغة
العربيّة
وقوانينِ
الأدبِ
والبلاغةِ
كانت له
أيّامٌ مضتْ
من غير رجعةٍ.
فإن كنتم قد
زرعتم البذورَ
في تلك
الأيّامِ،
فلا بدّ وقد
حصدتمْ ثمارَها؛
وبالتّالي
فلا حاجة لكم
إلى حفظ هذه القواعدِ
واحصاءِها
وتكرارِها من
جديد. وإنّما
تنحصِرُ
مهمّتُكم
اليومَ في
تطبيق تلك القوانين
وإجراءِها
على كلامِكم
وأسلوبِكم في
الإنشاءِ
والحوارِ
والخطاب باللّغة
العربيّة. وهذا
سيساعدُكم في
الهيمنةِ على
النّفوسِ (لا لاستغلالها
والتّحكّمِ
فيها، بل
لإصلاحها وتهذيبها
ولقضاءِ
حاجتكم من
النّاسِ في
الوقتِ ذاته).
إنّ
مَثَلَكم
كمَثَلِ
سائقٍ ماهرٍ
في مهنتِهِ،
ولكن غيرِ
واثقٍ من
نفسِهِ. وهل
وجدتم مثلاً،
سائقَ مركبةٍ
آليّةٍ (بعد
أن تمرّسَ على
القيادةِ،
وحصل على
الرّخصةِ
الرّسميّةِ
لها)؛ هل يجوز
أن يعودَ هذا
السّائقُ فيتردّدَ
في معرفتِهِ
للقيادةِ،
ويختبِرَ كفائَتَهُ
فيها؟! هذا
أمرٌ في منتهى
الغرابةِ.
إذًا
يبدو أن
المشكلة التي
تعانونَها في
مسألة
المعرفةِ،
يبدو أنّها لا
تكادُ تنكشف
لكم أسرارُها
حتى هذه
اللّحظةِ.
وهذا من أخطر
المواقف. نعم
ما أشدَّ
خطرًا على
الإنسانِ أن
يلتبسَ عليه
مقاصِدُهُ،
وتعيا
مذاهبُهُ.
إنتم
في هذا الوقت،
وعلى هذه
الدّرجةِ
البالغةِ من
المعرفةِ
بقواعد اللّغة
العربيّة
وقوانين
البلاغةِ،
لستم في حاجةٍ
إلى تكرارِ ما
قد أحصيتم
فيما سلف. بل
أنتم بحاجةٍ
ماسّةٍ إلى تهذيب
أسلوبكم في
الأداءِ
نطقًا
وإنشاءً. لأنّكم
اليوم في غالب
أوقاتكم
تحتكّونَ
ببني جلدتكم وَتُكَلِّمُونَهُمْ
بلغتهم (اللّغة
التركية)، وهي
ربما تطغى
يومًا على
رصيدكم من اللّغة
الغربية
فتخسرونَ
قسطًا بالغًا
منها!
إذًا
يحب عليكم بعد
هذا الرّصيد
الّذي تتمتّعون
به، أن تُرَكِّزُوا
جهودَكم على
الإكثارِ من
الكتابةِ
والنّطقِ، بل
على صياغةِ
مراميكم
بأسلوبٍ
سليمٍ فصيحٍ
بليغٍ سلسٍ
ووجيزٍ،
بحيثُ يفهمكم
قارؤٌكم
وسامعُكم،
فيُعْجِبُهُ
كلامُكم. وهذا
لا يتحقّق طبعًا
إلاّ أن يكون
الخطيبُ أو
المنشئُ
عارفًا
بدقائق
البلاغةٍ وماهرًا
في صياغةِ
الكلامِ،
واثقًا من
كمالِ معرفتِهِ
بها، لأنّ من
خسر الثّقةَ
بعلمهِ، خسر
ثقةَ من
يخاطبُهُ في
الوقت نفسِهِ.
ولهذا سوف
نعود أحيانًا
إلى مفهمو
الفصاحةِ
والبلاغةِ،
ولن تنقطع
صلتُنا
بقواعد اللّغة
ووقوانين الأدبِ
لنستحسّه
بالقدر الّذي
نحتاج إليه ولنطبّقها
على كلامِنا،
وليس
لنُحصِيَ
مفرداتِها من
جديد.
إخوتي
وأعزّائي!
يجب
على الإنسانِ
قبلَ جميعِ
واجباتهِ، أن
يشعُرَ
بحقيقةِ
السّببِ
الّذي
يُوَجِّهُهُ ويدفعُهُ
إلى عملهِ.
فلا تنسوُنَّ
بهذه المناسبةِ
ما يجعلُ الإنسانَ
يرتبكُ عند
تنازُعِ
الأسبابِ أو
يّغْفُلُ،
فتلتبِسُ
عليه الأمور،
وتتفرّقُ به السُّبُل؛
فلا يكادُ
يميّزُ
الهدفَ
الأصليَّ
الّذي يسعى من
وراءِهِ عن
الأهداف
الثانوية
الّتي
يتمسّكُ بها
ليتدرّج إلى
ما يقصُدُهُ
ويبذُلُ
جهودَهُ من
أجلِهِ.
أنّه
ليؤلِمُني أن
أرى طلبةَ اللّغة
العربيّة من
أبناءِ
بلادِنا وهم
في هذه
الحالةِ من
الغفلةِ، وقد
التبس عليهم
الهدفُ
الأصلِيُّ في دراستِهم.
فلا يكادون
يميّزونَهُ
عن الأهداف
الجانبية
التي لا تعدو
عن درجات
سُلَّمٍ نُصِبَ
لَهم ليرقوا
به حتّى يصلوا
إلى الهدف الأصلِيِّ
المقصودِ والغرضِ
الحقيقيِّ
المنشود.
هذه
في الحقيقةِ
مشكلةُ
قديمةٌ يعاني
منها أبناءُ
المسلمين من
الأتراك منذ
حقبةٍ من الزّمنِ
وليس أمرًا
حديثًا. وإنّي
لأستغرِبُ أشدَّ
الاستغرابِ
موقِفَ
أساتذةِ اللّغة
الغربيةِ من
المهمّةِ
الّتي
كُلِّفوا
بأدائِها،
على قلّتهم في
تركيا، ويُؤْسِفُنيِ
عدمُ
اهتمامِهم
بالغرضِ النّهائيِّ
من تدريسِ هذه
اللّغة؛ فلم
أسمع يومًا من
الأيّامِ أنّ
أحدَهم أشارَ
على تلامذتهِ أنّه
إنّما
يدرِّسُهم
هذه اللّغة
ليستخدموها
في
الاتّصالاتِ
والحوارِ،
وليعبّروا
بها عن كلِّ
ما يقصدونهُ
من حلوٍ ومرٍّ،
وليشرحوا بها ما
تتطلّبُهُ
الحياةُ
والعلاقاتُ
والمناسباتُ
من سرورٍ
وألمٍ، وما
تستوجِبُهُ
المسؤوليّةُ
من إرشادٍ،
وإعلامٍ،
وتنبيهٍ،
وتبشيرٍ،
وإصلاحٍ،
وتنوير. ذلك
لأنّهم
بالذّات عاجزون
عن استخدام اللّغة
العربيّة في
هذه
الأغراضِ،
فكيف بهم أن
ينصحوا
تلامذتَهم
بذلك
فيفتضِحَ أمرُهم!
لذلك ما زلنا
نراهم
منهمكين في
تحفيظ القواعدِ
وتدريس
الآدابِ
والمبادئِ.
كلُّ همومِهم
يستقطِبُ على
التّحفيظِ لِمَحْضِ
التّحفيظِ!
وحسبُهم أن
يروا
التِّلميذَ أنّه
لايلحنُ في
القراءةِ؛
يرفعُ
الفاعِلَ،
وينصِبُ
المفعولَ،
ويجرُّ
المضافَ إليه
ليس إلاِّ!!..
فما
الفائدةُ
إذنْ من كلِّ
هذه الجهودِ
وما كلّفهم من
سهرٍ ووقتٍ
ومالٍ طوالَ
سنين في خدمةِ
التّدريسِ،
إذا وجدوا
يومًا هؤلاءِ
الطّلبةَ
عاجزين عن
النّطقِ وهم يُتَمْتِمُونَ
في حديثهم
خاصّةً مع
المتفتّحين
من أبناءِ هذه
اللّغة، وذلك
بعد أن أفنى
كلٌّ منهم
ثلثَ عُمُرِهِ
في إحصاءِ
القواعِدِ
وحفظِها،
فتخرّجوا من
كلّيةِ اللّغة
العربيّة
وحملوا
الشّهادّةَ
الجامعيّةَ
وهم لا يستطيعون
الإفصاحَ
بالعربية ولا
يبلُغُ مستوى
أحدِهم
معشارَ ما
يتمتّع به
أدنى
المستشرقين من
المعرفةِ
بِلُغَةِ
الضّادِ!
هذه
المشكلةُ
مازالت
قائمةً. لأن ثمَّةَ
قُوىً
تؤَجِّجها،
وتعملُ على
بقائِها،
وتصلُّبِها؛
حتّى
لايتمكّن
أبناءُ
الإسلامِ في
تركيا من
الاتصالِ
بأبناءِ
أمّتِهم في
البلادِ
العربيةِ.
ولعلّ
أساتذةُ اللّغة
العربيّة في
تركيا لم
يصْحوا من
نومتِهم
بعدُ، ولم ينتبهوا
إلى هذا
الخطرِ وإلى
ما يعاني منه
المتخرِّجونَ
من تلامذتهم
اليومَ من
العجزِ والبطالةِ.
بل نضطرُّ أن
نتّهمَ
بعضَهم بأنّهم
يتواطئون مع
المتـزمّتين
الّذين
يقدِّسون
الأسلوبَ
العثمانيَّ
العقيمَ.
فإنّهم يعتمدون
في تعليم اللّغة
العربيّة على
إلقاءِ
الدّروسِ باللّغة
التّركيةِ،
ويصرّونَ على
هذا الأسلوب،
وذلك من أكبر
العقباتِ
واخطرِها
أمام الطّالبِ.
لقد
بذلتُ جهودًا
بالغةً منذ
ثلاثين عامًا
في تنبيه
المشاعرِ إلى
هذه العقبةِ،
فقمتُ بإلقاءِ
محاضراتٍ
عديدةٍ في
إسطنبولَ
حولَ الأسلوبِ
الأمثلِ
لتعليم اللّغة
الأجنبيةِ
(ومنها
العربيةُ
بالنّسبة
للأتراك)؛ وهو
الطّريقُ
المباشِرُ.
وذلك أنْ
يكُفَّ
الأستاذُ عن
استخدامِ
التّرجمةِ،
وأن يتجنّبَ
الخطابَ
بلغةِ
التّلميذِ.
سوفَ
نركّزُ على ما
يرتبط بهذه
المشكلةِ من أسبابٍ
وحلولٍ في
دروسنا
المقبلةِ إن
شاء الله
تعالى.
أيّها
الإخوة!
لاشكَّ
من أنَّ اللّغة
هي أداة
الاتّصالِ والتّفاهُمِ
بين أبناءِ
البشرِ، وهي
آيةٌ من آياتِ
اللهِ العظمى.
يقول الله
تعالى: »وَمِنْ
آَيَاتِهِ
خَلْقُ
السّماوَاتِ
وَالأَرْضِ
وَاخْتِلاَفُ
اَلْسِنَتِكُمْ
وَاَلْوَانِكُمْ
إِنَّ فيِ
ذَلِكَ
لآيَاتٍ لِلْعَالَميِنَ«[1] لأنّ
الإنسانَ هو
المخلوق
الوحيد الذي
ينطقُ ويعبِّرُ
عمَّا في
ضميرِهِ من
أحاسيسَ غريةٍ،
وتصوّراتٍ
خطيرةٍ،
وأحلامٍ
عجيبةٍ، وخلاجاتٍ،
وحُبٍّ،
وكراهيّةٍ،
وفرحٍ،
وحُزنٍ،
وَالْتِذَاذٍ،
واستقذارٍ
وما إلى ذلك...
إنّ
البشريةَ
مجتمعٌ عظيمٌ
مكوَّنٌ من
أُمَمٍ
وشعوبٍ
وطوائفَ
مختلِفةٍ.
يقول الله
تعالى: »
يَا أَيَُهَا
النَّاسُ
إنَّا
خَلَقْنَاكُمْ
مِنْ ذَكَرٍ
وَأُنْثىَ،
وَجَعَلْنَاكُم
شُعوُبًا
وَقَبَائِلَ
لِتَعَارَفوُا...«[2]
إذن
يجب على
أبناءِ
البشرِ أن
يتعارفوا
فيما بينهم،
ليتعاونوا
على البرِّ
والتّقوى. وقد
أرشد الله عبادَه
إلى ذلك في
قولِهِ تعالى:
»وَتَعَاوَنوُا
عَلىَ
الْبِرِّ وَ
التَّقْوىَ،
وَلاَ تَعَاوَنوَا
عَلىَ
الإِثمِ
وَالْعُدْوَان،
وَاتَّقوُا
اللهَ، إِنَّ
اللهَ
شَديِدُ
الْعِقَابِ.«[3] وقال
تعالى: »وَلِكُلٍّ
وُجْهَةٌ
هُوَ
مُوَلِّيهَا،
فَاسْتَبِقوُ
الْخَيْرَاتِ،
أَيْنَ مَا
تَكوُنوُا
يَأْتِ
بِكُمُ اللهُ
جَميِعًا،
إِنَّ اللهَ
عَلىَ كُلِّ
شَيءٍ قَديِرٌ.«[4]
إنّ
من أسرارِ
حِكَمِهِ
تعالى، أنْ
خلقَ النَّاسَ
على اختلافٍ
كبيرٍ في
ألوانِهم،
ولُغاتِهم،
وثقافاتِهم،
وأذواقِهم،
ونزعاتِهم،
واتّجاهاتِهم،
وأعرافِهم،
وتقاليدهم؛ فلا
يُعقَلُ أن
يتمكّن
الإنسانُ من
تذليل هذه
العقباتِ
ليتّصلَ ببني
جنسِهِ من
الأجانبِ،
إلاّ أنْ يتبادل
معهم الحديثَ
بِلُغَتِهِم،
والحديث
والحوار هو
الطّريق
الأصحُّ الأمثلُ
والوحيد
الّذي يؤدّي
إلى
التّفاهُمِ
فاتّعاوُنِ.
فما أشدَّ
حاجةُ
الإنسانِ
خاصّةً في هذا
العصرِ إلى
هذه الأداةِ
السّحريةِ الّتي
تربط بين القلوب.
ولهذا كلُّ
مَنْ يُتْقِن
لغةً من
اللّغات
الأجنبيّةِ
ينالُ ثناءً
من بني
جِلدَتِهِ دائمًا.
ويُوَقَّرُ
في مجتمَعِهِ.
إلاّ إذا كان
في مجتمَعٍ
جاهلٍ. فيا
لَغُربَةَ ذي
علمٍ يسكن بين
قومٍ جاهلٍ،
ويا
لثُكلتاه!!!
إنّ
معرفةَ
الإنسانِ
بدقائقِ
لغتهِ المحلّيّةِ
–لاشكَّ-
تُمَكِّنُهُ
من استخدامِ
أفضلِ أساليبِ
الحوارِ مع
أبناءِ
شعبِهِ. وقد
تُحسِّسُهُ
في الوقتِ
ذاتِهِ على
أهمّيّةِ
إتقان اللّغات
الأجنبيّةِ.
لأنّ الإنسان
المتفتّحَ لا
يجهلُ ما سوف
يجني من ثمرات
الحوارِ
وتأسيس العلاقةِ
مع الأجانبِ،
خاصّةً مع
النّاسِ من
أهل البلادِ
الرّاقيةِ من
أصحابِ
الثّروةِ والعلمِ
والمناصبِ.
فعلى
الطّالبِ
إذًا، أن
يختار من بين
اللّغات
الأجنبيةِ ما
يخدُمُ
مصلحتَهَ
بأقصى قدرٍ ممكنٍ
حسبَ
مقاصِدِهِ
وأهدافِهِ.
إنّ
طالبَ العلمِ
من أبناءِ
الوطن
التّركيِّ لا
يستغني عن
وسائل
تربطُهُ
بالعالَم المتحضِّرِ.
ولا شكَّ من
أنّ اللّغاتِ
الأجنبيةَ هي
من هذه
الوسائلِ، بل هي
من أهمِّها
وألزمِها.
وقبل أن نشيرَ
إلى ما يحتاج
إليه
الشّابُّ في
هذا البلد من
اللّغات، يجب
أنْ نركّز
أوّلاً على
أهمّيّة اللّغة
التّركيةِ
لمن وُلِدَ
ونشَأَ في هذا
الوطن. فإنّه
لن يحظىَ صلةً
قويّةً
بأبناءِ
شعبِهِ، ولن
ينالَ ثقَتَهم
إلاَّ بالقدر
الّذي
يشاركُهم في
حياتِهم
وتقلُّباتِهم،
مهما خالفهم
رأيًا
وعقيدةً.
فاذكروا
قولَه تعالى. »وَمَا
أرْسَلْنَا
مِنْ رَسوُلٍ
إلاَّ بِلِسَانِ
قَوْمِه،ِ
فَيُضِلُّ
اللهُ مَنْ
يَشَاءُ
وَيَهْدِي
مَنْ يَشَاءُ،
وَهُوَ
الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ.«[5] ذلك أنّ
الإنسانَ في
كلِّ بلدٍ قد
يتميّزُ برأيِهِ
وعقائِدِهِ
ونزعاتِهِ
الخاصّةِ وتطلُّعاتِهِ
من بقيةِ
النّاس؛ وقد
يشاركُ فيها
بعضَهم دون
بعضِهم
الآخرِ،
ولكنّه
مضطرٌّ إلى
مشاركة
الجميعِ في اللّغة
والثّقافةِ على أقلِّ
تقديرِ؛
ليتمكّن بذلك
من الدّفاعِ
عن رأيِهِ
وعقيدتِهِ
وشخصيتِهِ
وعرضِهِ
ومالِهِ إذا
وجد مَنْ
يعاديه
ويقتحم
حرمتَهُ
وينالُ من
كرامتِهِ.
لأنّ اللّغة
أداةُ
التّفاهُمِ
وهي من
القِيَمِ
المشتَرَكَةِ
الّتي يتكوّن
المجتمعُ على
أساسِها؛ كالدّينِ
والعقيدةِ
والأعرافِ
والتّقاليدِ.
نعود
إلى صدد
الموضوعِ
فنقولُ: إنّ اللّغة
التّركيةّ
لها قيمتُها
بالنّسبةِ
لأبناءِ هذا
الوطن. خاصّةً
فإنّ طلبةَ
العلمِ من
أبناءِ
المسلمين في
هذا البلد،
يجب عليهم أن
يكترثوا بها
أكثر من غيرهم
من أنصار
القوميةِ والعصبيةِ،
فينبغي
للطّالبِ
المسلمِ أن
يحظى من
المهارةِ في
النّطقِ بهذه اللّغة
على مستوى
الأدباءِ
المتفوِّقيِن
والمشهورين
من رجالاتِ
عصرِنا. لأنّه
لن يتمكّن من
الدّفاعِ عن
الإسلامِ
وقِيَمِهِ في
هذه المرحلةِ
الحسّاسةِ
التي اشتدّتْ
فيها صولةُ
الكفرِ
وَاسْتَقْوَتْ
عبرَها جحافل
الشّركِ، لِتَنْقَضَّ
على الدّينِ
الحنيفِ
انقضاضَ
الوحشِ على
فريستِهِ.
نعم، لن
يتمكّن
المسلِمُ من
الاستعدادِ والمواجهةِ
في هذه
الظّروفِ
إلاّ بهذا
السّلاح
القويِّ
والسّلميِّ.
ولهذا
أنصحكم بكلِّ
تأكيد، أن
تُتْقِنواُ اللّغة
التّركيةَ
حقَّ
الإتقانِ،
وأن تتبحّروا
في فنونِها
وآدابِها، وأن
تكتسبوا
المهارةَ في
استخدامِ
أفضلِ أساليبِ
الأداءِ بها
نطقًا
وكتابةً، حتى
تهتزّ
النّفوسُ بين
أيديكم إذا
نطقتم،
وترتجف القلوبُ
وتدمع
العيونُ
وتقشعِرَّ
الجلودُ إذا
خطبتم؛
لأنّكم جنود
الحقِّ،
ورُسُلُ السّلامِ،
وورثةُ
الأنبياءِ؛
تأمرون
بالمعروفِ
وتنهون عن المنكر،
وتبشّرون
وتُنذِرون
على سنّةِ رسول
الله صلّى
الله عليه
وسلّم . هكذا
سيروا على
بركة الله!
أيّها
الإحوة!
إنّ اللّغة
التّركية في
الحقيقةِ
ليست من
اللّغات الرّائجةِ
والشّائعةِ
في العالَمِ،
لأسبابِ ليس
هذا مقام
الاسترسال
فيها. ولكن
مهما كانت، فإنّها
لغةُ هذا
الشّعبِ. وهي اللّغة
المنتشَرَةُ،
بصفتها اللّغة
الرّسمية.
غلبت على بقية
اللّغات
الطّائفيةِ،
وتحسّنتْ في
هذه السّنين
الأخيرةِ بعد
أن كانت
عُرْضَةً
للإهمال على
مدى قرونٍ.
فقد اكتسبت
نموًّا
وخصوبةً منذ
السّبعينات،
من القرن
المنصرم
خاصّةً بعد أن
استقتْ من
لغات الغربِ
مئاتٍٍ من
المفاهيم
والمصطلحات
العلمية
والفنيةِ.
يجب
علينا نحن
أبناءِ
الإسلامِ في
هذا البلدِ،
يجب أن
نتعاملَ مع
هذه اللّغة
تعامُلَ
الجنديِّ مع
سلاحِهِ.
إنّما بهذا نتميّزُ
من أتباع
الجماعاتِ
والأحزاب
والفئات
المتباينةِ
في تركيا. أنّهم
على اختلافٍ
كبيرٍ معنا في
تعامُلِهم مع اللّغة.
فإنّ كثيرًا
منهم خاصّةً
أصحابَ
النّزعةِ العصبيةِ،
يُقدِّسون اللّغة
التّركيةَ
على أنّها
صلةٌ تربطُهم
بتاريخهم
وأمجادِهم
وبطولاتِ
آبائِهمِ
الأوّلين.
أمّا
نحن أبناءُ
الإسلامِ، - مع
احترامنا
للقيم الّتي
يعترف بها الّدينّ
الحنيفُ، ومع
بالغ
محبَّتِنا
لهذه اللّغة-
فإنّنا لا
نُقدِّسُ
إلاّ شعائرَ
الله. »ذَلِكَ
وَمَنْ
يُعَظِّمْ
شَعَائِرَ
اللهِ فَإِنَّهَا
مِنْ تَقْوَى
الْقُلُوبِ.«[6]؛ كما لا
نتهاون باللّغة
في الوقت
ذاتِهِ؛
لأنّها من
أهمِّ
سلاحِنا. ذلك
أنّ من تهاون
بالسّلاحِ، وأهملّ
الاستعدادَ
لمواجهةِ
العدوِّ فقد تهاون
بسنّةِ
اللهِ، ومن
تهاون بسنّةِ
اللهِ ضُرِبت
عليه
الذِّلَّةُ
والمسكنةُ
وسُلِّطَ
عليه مَنْ لا
يستطيع له
دِفاعًا.
أمّا
اللّغاتُ
الأجنبيةُ
فإنّها
تتسابَقُ في
كلِّ عصرٍ،
ينالُ عددُ
قليلٌ منها
اهتمامَ
غالِبِ
النَاسِ في
العالمِ،
فيطغى على
بقية
اللّغاتِ،
فتـتردّى،
وقد يبلُغُ
ببعضِها
الإهمالُ
والانحطاطُ
حتّى يفقِدُ
من حيويّتِهِ
ويتقادم مع الزّمان
فلا يكاد
يستخدمه
أحدٌ،
فيضمحلُّ، كلغات
الأمم
البائدةِ.
فقد
شاع في عصرِنا
هذا عددٌ من
لغات شعوبِ
الغربِ، بسبب
النّهوضِ
والازدهار
الّذي
تشهدُهُ
بلادُهم. وهذه
من سنّةِ الحياةِ،
فكلّما ارتقت
أمةٌ وغلبت
على بقيةِ الأممِ
في المجالاتِ
العلميةِ
والحضاريةِ،
وأرهبتها
بقوّتِها
العسكريَةِ
وأساليبها
الحربيّةِ
والاستْراتيجِيّة،
راجتْ كلُّ ما
يختصُّ بها من
لغةٍ وفنونٍ
وآدابٍ وعاداتٍ؛
وأصبح العالَمُ
بأسرِهِ
تبعًا لها.
اللّغة
الإنجليزيةُ
تأتي على رأس
هذه اللّغاتِ.
ولذا أنصحُكم
الاهتمامَ
بهذه اللّغة
أيضًا. لأنّكم
لن تُلْفِتوا
عقولَ
النَّاسِ إليكم
في هذا البلدِ
ولن يعبأ بكم
أحدٌ منهم، إلاّ
إذا تمتّعتم
بشيءٍ يغبطكم
به بعضُ النّاس،
ويحسدكم عليه
بعضُهم
الآخرُ. فاللّغة
الإنجليزيةُ
قد أصبحتْ
مرغوبةً
ليستْ لأنّها
لغةُ العلم
والحضارةِ،
بل لأنّها
لغةُ شعوبٍ
قويةٍ يخافُ
العالَمُ من
بطشِها
وبأسِها. لذا
فإنّ أكثر
النّاسِ في
البلاد
المتأخِّرةِ
إنّما
يتعلّمون اللّغة
الإنجليزيةَ
انبهارًا
بعالَمِ
الغربِ فيستعظمونه
استعظام
الضعيفِ
للقويِّ،
والتّابع للمتبوعِ.
فإذا تعلّمتم
هذه اللّغة
سوفَ ينالُكم
من توقير
هؤلاءِ
الضعفاءِ نصيبٌ
قد تستغلّونه
في إرشادِهم
وإنقاذِهم من
هذا الضّعفِ
والهوانِ،
كما
تستخدمونه في
نشر رسالةِ
الإسلامِ بين
أبناءِ الكفرِ
والشّركِ. »وَمَنْ
أَحْسَنُ
قَوْلاً
مِمَّنْ
دَعَا إِلىَ
اللهِ وَعَمِلَ
صَالِحًا
وَقَالَ
إِنّنيِ مِنَ
الْمُسْلِمِينَ.«
أمّا
اللّغة
العربيّة، فإنّها من
أهم اللغات
الإنسانية،
حملت إلينا
عبر العصور من
ثمار علوم
العباقرة
وابتكارات
العلماء
وأخبار
القرون
والأمم التي
خلت؛
تزداد
اللّغة
العربيّة
قيمةً وأهمية
عندما
نقارنها ببقيّة
اللّغات
العريقة،
فنجد لها من
ميّزاتٍ
نادرةٍ منها،
شاء اللهُ أن
يُنْزِلَ بها
القرآنَ على قلب
محمّد صلّى
الله عليه
وسلّم،
فوسعتْ كلامَ
اللهِ لفظًا
ومعنىً.
ومنها،
استطاعت أن
تبقى على
أصالتها
سليمةً نقيةً
ذات فصاحةٍ
وبيانٍ بحفظٍ
من الله وبفضل
روّاد اللّغة
وعلماء
النحو؛ كأبي
بِشر عمرو بن
عثمان بن قنبر
الملقَّب بسيبويه
(ت. 180 هـ.)؛ وأبي
يوسف يعقوب بن
إسحاق المعروف
بابن
السّكّيت (ت. 244
هـ.)؛ وأبي
عثمان
المازني النحويّ
البصريّ (ت. 247
هـ.)؛ وأبي
العباس محمّد
بن يزيد
المُبَرَّد
(ت. 285 هـ.)؛ وأبي
إسحاق إبراهيم
بن السري بن
سهل الزّجّاج
(ت. 311 هـ.)؛ وأبي
القاسم عبد
الرحمن بن
إسحاق الزّجّاجيّ
(ت. 337 هـ.)؛ وأبي
بكر محمّد بن
عمر بن عبد
العزيز بن
إبراهيم بن
عيسى بن مزاحم
المعروف بابن
القوطيّة (ت. 367
هـ.)؛ وأبي بكر
محمّد بن
الحسن
الزبيديّ (ت. 379
هـ.)؛ وأبي
الفتح عثمان
بن جنّي (ت. هـز
392)؛ وأبي بكر
عبد القاهر بن
عبد الرحمن بن
محمّد
الجرجانيّ (ت. 471
هـ.)؛ وأبي عبد
الله محمّد بن
أحمد بن هشام
النحويّ (ت. 570
هـ.)؛ وأبي
القاسم جار
الله محمود بن
عمر الزمخشريّ
(ت. 538 هـ.)؛ وهو
تركي الأصل
ومع ذلك أنّه
من أعلام اللّغة
العربيّة ومن
كبار أئمّتها
وأساطينها.
وغيرهم
كثيرون من
العرب والعجم؛
والمسلمين
وغير
المسلمين.
لهذه
الأسباب،
استطاعت اللّغة
العربيّة أن
تَصْمُدَ
أمام عواصف
الدّهر، لم
تتزعزع
أركانُها إلى
يومنا هذا على
الرّغم من
المؤامرات
التي
حَاكَتْهَا
أعداءُ الإسلام
للقضاء عليها.
فهي ما زالت
قويّةً
فصيحةً
منـتشرةً في
ساحاتٍ
شاسعةٍ ومرغوبةً
بين المسلمين.
ومن
أهمّ ميّزات
هذه اللّغة؛ أنّها
محسودةٌ
ومكروهةٌ بين
أعداء
الإسلام
والمسلمين؛
وعلى رأسهم
المارقون
داخل الوطن
الإسلامي؛ وبعضُ
المستشرقين
الذين أثاروا
الدعوة إلى اللّهجة
العاميّة؛
ولكن نحمد
الله أنّهم لم
يجدوا حتى
الآن آذانًا
صاغيةً لهذه
الدعوة
الماكرة
الحبيثة! مع
هذا يجب علينا
أن نعلم بالتّأكيد
أنّ كلاً من
هذين
الفريقين
إنّما يُوَجِّهُ
قواها لضرب اللّغة
العربيّة
والقضاء عليها
تمهيدًا
للحربِ مع
كتاب الله
(القرآن الكريم)،
وإلحاق
الضّرر بالإسلام
وتشتيت شمل
المسلمين
أخيرًا في عُقْرِ
دارهم.
ولهذا
يجب على
المسلمين
جميعًا الاهتمام
بهذه اللّغة
الشريفة
وبأعلى درجةٍ
من الإتقان
مهما اختلفت
لغاتُهم
الأصليّةُ
وتباينتْ
قوميّاتُهم وألوانُهم
وأوطانُهم؛
ذلك من آيات
الله سبحانه،
كما أنّ اللّغة
العربيّة آية
من آياته
العظمى. فقد
قال تعالى
{إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا
عَرَبِيًّا
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلُونَ. يوسف/2}؛
وقال تعال {وَكَذَلِكَ
أَنْزَلْنَاهُ
حُكْمًا
عَرَبِيًّا
وَلَئِنِ
اتَّبَعْتَ
أَهْوَاءَهُمْ
بَعْدَ مَا
جَاءَكَ مِنَ
الْعِلْمِ مَا
لَكَ مِنَ
اللهِ مِنْ
وَلِيٍّ
وَلاَ وَاقٍ. رعد/37}؛وقال
تعالى {وَكَذَلِكَ
أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا
عَرَبِيًّا،
وَصَرَّفْنَا
فِيهِ مِنَ
اْلوَعِيدِ
لَعَلَّهُمْ
يَتَّقوُنَ
أَوْ يُحْدِثُ
لَهُمْ
ذِكْرًا. طه/113} وقال تعالى
{نَزَلَ
بِهِ
الرُّوحُ
اْلأَمِينُ عَلَى
قَلْبِكَ
لِتَكُونَ
مِنَ
اْلمُنْذِرِينَ،
بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍ
مَبِينٍ.شعراء/195} وقال
تعالى{قُرْآنًا
عَرَبِيًّا
غَيْرَ ذِي
عِوَجٍ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ. زمر/38}. فقد
وردت آياتٌ
أخري في كتاب
الله من أمثالها؛
وفي جميعها
إشاراتٌ إلى
شرف هذه اللّغة
بجانب ما فيها
من دروسٍ
وعِبَرٍ جاءتْ
من خلالها.
أمّا
أصول تعليم اللّغة
العربيّة
وتعَلُّمِها
فهي منصوصة في
كتب الاختصاص؛
وقد اختصرنا
لكم من عصارة
معلوماتنا نُبذةً
ضمن البيانات
التّمْهيديِّة
والدّيباجات
الّتي
نستهلُّ بها
في بدايةِ
كلِّ حلقةِ من
دروسنا، عسى
أن تنفعكم،
وأسأل الله
تعالى أن تكون
هذه الدروسُ
نافعةً
مُثْمِرةً
ومجديةً؛ كما
أرجو أن
تُتْقِنوا
هذه اللّغة في
أمدٍ غير بعيد
لتصبحوا من
أولئك الذين
أنعم الله
عليهم
فعرَّفَهم
على كثير من
حقائق كتابه
العزيز
وهداهم إلى
صراطه المستقيم.
وذلك هو الهدف
المنشود والغاية
التي نحن في
طلبها جميعًا.
وبهذه
المناسبة يجب
علينا نحن
القلّة القليلة
من أبناء
الإسلامِ
المبعثرين
بين صفوف الشّعب
التّركيِّ،
يجب علينا أن
لا نغفل عن
الظروف الّتي
طالما ابتلى
بها طالبُ اللّغة
العربيّة في
هذا البلد منذ
قرنٍ تقريبًا.
نعم يجب علينا
أن نكون على
بيّنةٍ وانتباهٍ
تامٍّ إلى ما
يجري حولنا؛
وعلى احتياطٍ
شديدٍ أمام
الخطر
المحدِقِ
بنا، معتبرين
بما ذاقه
الجيلُ الذي
قبلنا من
العذابِ؛ أن
لا ننسى أنّهم
لم يذهبوا
ضحية
النّكالِ
الّذي حلّ بهم
ما بين 1926-1945م.،
إلاّ لأنّهم كانوا
يريدون أن
يتعلّموا لغة
القرأن فحسب.
كان هذا
ذنبُهم،
الوحيد الّذي
أدّى بهم إلى
الهلاك. إذن
يجب علينا أن
لا نتجاهل هذه
الحقيقةَ؛
لأنّ الّذين
أبادوا طلبة اللّغة
العربيّة في
هذا البلد
بالأمس، قد
استخلفوا من
لا يعرف
الرّحمة
بالبقية
الباقية من
هذه الطائفة المؤمنةِ
اليومَ.
إنّ
الحزن على
السّابقين
منّا لا يُغني
عنّا شيئًا،
ولن يردّ ما
قد فات؛
وإنّما لنا
فيهم عبرةٌ،
بأن نعود إلى
أنفسِنا،
فنتحرّى
الأسبابَ،
وندرُس
النّتائجَ،
ونطرحَ
أسئِلةً فنتباحث
عن سُبُلِ
المعالجةِ
لهذه
المشكلةِ على
ضوءِ ما يأتي
من إجابات عليها.
فنقول مثلاً:
1. هل
نحن اليوم في
أمانٍ من شرِ
مَن يعادون
هذه اللّغة
على أرضنا؟
2. ما
ذنبُنا،
ولماذا
نُعَدُّ من
المجرمين بمجرّدِ
رغبتِها إلى
هذه اللّغة؟
3. لماذا
أصبحت اللّغة
العربيّة
مكروهةً في
نظر
الطّائفةِ
الحاكمةِ في
هذا البلدِ
منذ حقبةٍ
تزيد على قرنٍ؟
4. لماذا
لا يكادُ
يُبْديِ
الماهرُون
بهذه اللّغة
جُرْأَتُهُم
على تدريسها
وقليلٌ مّاهم.
على الرّغم من
رفع الحصارِ
عنها في
الماضي القريبِ؟
5. لماذا
يتجاهل
العالم
العربيُّ هذه
الأزمةَ التي
تتجاوز عن
حدَّ مشكلةٍ
محليةٍ،
فتُنْبئُ في
الوقتِ ذاته
عن الإهانةِ بكرامتهم،
وإن كان ذلك
بطريقٍ غيرِ
مباشر؟
كانت
هذه أسئلةً
هامّةً حول
الخطوط
العريضةِ
للمشكلةِ. يجب
القيام
بالإجابةِ
على كلٍّ منها
بالتّفصيل
وبأسلوبٍ
موضوعيٍّ،
حتّى يتمكّن
طالب اللّغة
العربيّة في
هذا البلدِ من
تقرير مصيره
بإرادتِهِ
الحرّةِ،
ويكون
الأطرافُ المعنيةُ
في الوقتِ
ذاته على علمٍ
تامٍّ بهذه الحقيقةِ
ليجدوا
السّبيلَ إلى
مناقشةِ الأمرِ
إذا تيسّرَ
طرحه يومًا
مّا على
الصّعيد العلميِّ
والسّياسيِّ.
لأنّ هذا
الأمرَ يتعلّقُ
بحقوقِ
الإنسانِ
وحرّيته.
إخوتي
أعزّكم الله
تعالى
ووفّقكم لما
يحبّه ويرضاه،
إنّكم
لقد
رُزِقْتُمْ
سعادةً
حُرِمَ منها
ملايين النّاسِ،
تتمثّل هذه
السّعادةُ في
حظِّكم من لغة
الضّادِ. وإن
لم يكن ذلك في
درجة الإتقانِ
لها من كلِّ
جانبٍ. لأنّكم
مازلتم من
فريق القرّاءِ
فحسب. أمّا
الّذي تنحصر
معرفتُهُ في
حدود
القراءةِ
فحسب، فإنّه
لايُعَدُّ من
المتقنين
إطلاقًا،
حتّى يُصبِحَ
كاتبًا وناطقًا
بها، وينافسَ
أربابَ هذا
العلمِ في
كلِّ المجالات
الثّلاثِ (في
القراءةِ،
والكتابةِ،
والنطقِ) على
مستوى
الكمالِ
والمهارةِ
فيها.
والبرهان على
ذلك هو
السّرعةُ مع
قلّةِ الخطأِ
والّلحنِ.
إنّي
في الحقيقة لا
أكتمُ ما قد تكبّدْتُمْ
من آلام
الغُربةِ وما
أنقضَ ظهرَكم
من وحشة
البيئةِ
وقلّة الدرهم
في أيامِ دراستكم
وأنتم يومئذٍ
تذوقون مرارة
الحياةِ ولا
تجدون من
يؤانسكم
لحظةً. وإنّي
لأعلم ما للغريب
من البؤس،
والثكلِ
والحزن
والخوف كما يقول
الشافعيُّ
رضي الله عنه.
إنّ
الغريبَ لَهُ
مخافةُ
سارِقٍ
* وخضوعُ
مديونٍ وذِلّةُ
مَوْثَقِ
فإذا
تذكّرَ
أهـلَهُ
وبِلادَهُ * ففؤادُهُ
كجناحِ طيرٍ
خـافقِ.
كذلك
لا ينبغي أن
أتجاهل ما قد
بذلتم من
جَهدٍ وسعيٍ
في حفظِ
قواعدِ هذه اللّغة.
ولكن يحب
علينا مع هذا
أن نعترفَ
بحقائقَ إن كتمناها
خُنّا أنفُسَنا
أو خدعناها،
وأصبحنا في
الوقت ذاته عونًا
لمن يكتمون
الحقائق من
أهل
الاستغلال تعميةً
لمن ينتبه إلى
جهلهم، من
أولئك الّذين
يزعمون أنّهم
يُتقنون اللّغة
العربيّة،
وهم في
الحقيقة
يجهلون
التعبيرَ بها
نُطقًا
وكتابةً. أنّهم
لا يكذبون على
أنفسِهم
فحسب، بل يتواطؤون
على خيانةٍ
رهيبةٍ؛
يكتمون
عجزَهم عن التعبير
بأدنى شيءٍ
مما يجولُ في
صدورِهم باللّغة
العربيّة،
كما يكتمون
عجزَ آلافٍ من
أمثالِهم في
هذا البلد، في
الحين الّذي
يحتلُّ كلٌّ
منهم منصِبَ
أستاذٍ
للّغةِ
العربية في
عديد من
كلّياتِ
العلوم
الإسلاميةِ،
ويباهون بتلك
الشّهاداتِ
الّتي
يحملونّها
والعناوين الأكاديمية
التي
يتمتّعون بها.
أيها
الإخوة!
إنّكم
لا بد وقد
لمستم نفعًا
كبيرًا من هذه
الحلقاتِ
الدّراسيةِ
لما فيها من
أسلوبٍ
واقعيٍّ
وعلميٍّ
متينٍ، كما
انتبهتم إلى مسائلَ
هامّةٍ في
تعليم اللّغة،
وتأكّدتم بعد
ذلك أنّ اللّغة
لا تنحصر في
القراءة
فحسب، وإنّما
هي آلةٌ يجبُ
استخدامُها
في التّعبير
الشّفويِّ
والكتابيِّ
على السّواءِ.
ثمّ علمتم
أيضًا وتأكّدتم
بعد ذلك أنّ
أسلوب تدريس اللّغة
العربيّة في
هذا البلد
قديم،ٌ
تقليديٌّ،
وعرٌ وسقيمٌ من
وجوه عديدةٍ.
تدلّ على هذه
الحقيقةِ
براهينُ
كثيرةٌ.
منها:
أنّ الّذين
يُدَرِّسون اللّغة
العربيّة في
تركيا هم
بالذات
عاجزون عن
استخدامِ هذه اللّغة
في التعبير
الشفويِّ
والكتابيِّ
على السّواء.
ومنها:
أنّ جميعهم
عناصرُ
تركيةٌ لم
يدرسوها ولم
يتخرّجوا على
يد أبناءِ هذه
اللّغة،
بينما الأسس
العلمية
نافيةٌ
للنجاحِ في
دراسةِ أي
لغةٍ إلا أن تكون
بواسطة من قد
تعلّمها من
أمه وأبيه وهو
طفلٌ ثمّ
درسها
وطوّرها
بطرقٍ علميةٍ
معروفةٍ.
ومنها
أنّ هؤلاءِ
الرّجال، هم
متعصّبون في اتّخاذ
الطريقة
القديمة
التّقليديةِ
للتّدريس
بسبب نزعتهم
القوميةِ
واعتزازهم
بالأمجادِ
والتاريخ
البائد.
يكفينا أن
نذكِّرَهم بقوله
تعالى:
"وَكَمْ
أَهْلَكْنَا
مِنْ قَبْلِهِمْ
مِنَ
الْقُروُنِ أنّهم
إِلَيْهِمْ
لاَ
يَرْجِعوُنَ"
إخوتي
الأعزّاء!
يقول الشّاعر:
رأيتُ
العقلَ
عقلين
*
فمطبوعٌ ومسموعٌ
إذا
لم يك مطبوعٌ *
فلا ينفـع مسموعٌ
كما
لا ينفع
الشّمسُ * وضوْءُ
العين ممنوعٌ
لا
شكّ أنّ
النّاسَ
يختلفون في إدراك
الحقِّ
والحقيقةِ،
وهذا ما ساقهم
إلى حربٍ
وجدالٍ
وصراعٍ فيما
بينهم من لدن
آدمَ إلى يوم
القيامةِ ...
تقولُ
كلمتَكَ
بوضوحٍ،
وبيدِكَ
الحجّةُ، وأنت
على بصيرةٍ من
أمرِكَ، وما
تريدُ إلاَّ
الإصلاحَ،
وإذا بأناسٍ
يهاجمونكَ،
ويرمونك
بالتّطرُّفِ
والخروجِ على
المألوفِ؛
بينما هم
المتطرِّفونَ
في الحقيقةِ.
ألِفتْ
آذانُهم
وأسماعُهم
الباطِلَ
لشيوعِهِ وقد
اعتادوهُ؛
ويقاطعونَكَ
على أنّكَ
أتيتَ بشيٍْ
لم يعهدوهُ،
فيرمونكَ
بالخيانةِ،
أو بالزندقةِ
واستحقارِ
سنّةِ
الآباءِ، وإن
كانوا هم على
ضلال.
فكُلُّ
شيءٍ جديدٍ،
سيّءٌ،
وحرامٌ، وممنوعٌ،
وخلافٌ
للعادةِ،
واقتحامٌ
لحرمة النّظامِ
المتّبَعِ
والعقائدِ
والأعرافِ.
هذا
بالنّسبةِ
لكلِّ قومٍ
غيرِ ذي رشدٍ،
أعمَتْهُ
التّبعيّةُ؛
خاصّةً المجتمعات
الّتي تعبد
التّاريخَ
والأمجادَ،
وتُشْرِكُ
ملوكَها
وحُكَّامَها
وأُمراءَها
وأغنياءَها
مع اللهِ،
وتتّخذُ من
الموتى
والقبورِ
والأضرحةِ
والطاغوت
آلهةً من دون
الله.
لقد
ابتلى جميع
الأنبياءِ
والمرسلين،
وجمهور
العلماءِ
والمصلحين
بمثلِ هذه
المجتمعاتِ
المتطرِّفةِ،
فذاقوا على
أيديهم من
ألوان
العذابِ
والنّكال. وَهذا
بِعَيْنِهِ ما
لقيتُ على مدى
أربعين عامًا
وأنا أنشد المتشيّخين،
أنّهم على غير
هدىً في
تدريسِ كتاب
الله ولغتِهِ.
ذلك لمّا أقرّ
الله عيني
فرزقني
مجالسةَ أبناءِ
هذه اللّغة
على أرضهم
بالذّات،
ووجدتُ نفسي
في لحظةٍ من اللّحظاتِ
عاجزةً عن
التّعبيرِ
بلغتِهم في
بدايةِ أمري –
على الرغم من
أنّي عربي
الأصلِ-، وأنا
في حيرةٍ
واستغرابٍ
أمامَ هذه
الصّدمةِ،
كيف أفنيتُ
عشرينَ عامًا
في دراسةِ اللّغة
العربيّة،
وتخرّجتُ على
يدِ أشهر
العلماءِ
المتبحِّرين
في لغةِ
الضّادِ!
اعترتْني
حالةٌ من العيِّ
كأنِّي
أُلْجِمتُ؛
فلم أرَ لهذه
المشكلةِ حلاًّ
حتّى انقشع
الغبارُ عن
وجه الأمرِ،
فعرفتُ بعد
ذلك
بالتّأكيد
أنّ هناك
أمورٌ دقيقةٌ لم
تتبيّنْ لي أو
لم أفطنها عبر
مدّةٍ أرْبتْ
على عشرين عامًا
درستُ خلالها اللّغة
العربيّة. ولم
أذكر عبر هذه
المدّةِ
كلِّها أنّ
أيَّ لغةٍ
يسعى في
سبيلِها
طالبٌ
ليعبِّرَ بها
عن مقاصدِهِ
يومًا من
الأيّامِ
إلاَّ
ويتحتّم عليه
أن يتلقّاها
ممّن يُتْقِنُهَا
نطقًا
وكتابةً. ولم
أذكر من ذي
قبل أن الّذين
درستُ على
أيديهم عشرين
عامُا (بِاستثناءِ
العرب منهم) كانوا
أعجامًا،
غالبهم من
عناصر كرديةٍ
لم يتّفق
لأحدهم أن كَتَبَ
باللّغة
العربيّة
حتّى صفحةً
واحدةً من
الورقِ فصبَّ
عليها من أدنى
أحاسيسه، أو
تكلّم باللّغة
العربيّة
ساعةً من
الزّمنِ،
فعبَّرَ
خِلاَلَهَا
عن شيءٍ مما
يجول في
خلدِهِ!!! أمّا
الّذِينَ
درستُ على
أيديهم من
الأساتذة ذوي
الأُصولِ
العربيةِ
فكانوا أيضا
يُلقُون
الدروسَ في
أغلب
محاضراتهم
باللغة الكرديةِ.
إذن،
فأين لأولئك
العلماءِ (!)
الّذين درسنا
على أيديهم
وأحصينا
وحفظنا تحت
إشرافهم كلَّ
ما أحصاه
سيبويه،
وابنُ جنّي
والزمخشريُّ
وغيرُهم من
أئمّةِ اللّغة،
أين لهم أن يكتبوا
باللّغة
العربيّة
حتّى كلماتٍ
معدودةً
يشرحون بها عن
أدنى شيءٍ
يجولُ في
صدورِهم!! أين
أحدُ منهم
نُشِرَتْ له
مقالةٌ أو
كتابٌ، أو
ألقى
محاضرةً، أو
حتّى شرح
لتلامذتِهِ
دروسَهم باللّغة
العربيّة مع أنّهم
يدرِّسونَ
قواعِدها من
صرفٍ ونحوٍ
وبلاغةِ وما
إليها... فهل
سمعتم بمثل
هذه
المهزلةِ؟!!
هذه
الحقائقُ
لمّا أفاقتني
من تلك
النّومةِ الّتي
أخذتني مدّةَ
عشرين عامًا،
بعد أن رجعتُ
إلى تركيا من
البلاد
العربية عام
1986م. بدأتُ أزور
المدارس
القرآنيةَ
وأتباحث عن
حقيقةِ هذه
المشكلةِ
بطريق الحوار
مع
المدرِّسين بهذه
المدارسِ ومع
شيوخ
الصّوفية
الّذين
يستغلّون هذه المدارسَ
في توسيعِ
محيطهم،
عثرتُ على
حقائقَ أخرى
أدهشتني
وزادتني
حيرةً
واستغرابًا. فأثْبَتُّ
أنّ هذه
المدارس
المنتشرة
بأنحاءِ تركيا،
يتخرّج منها
جمهورٌ من
الطّلبةِ وهم
يحفظون
القرآن عن
ظهرِ قلبٍ،
يبلغ عددهم
سنويًّا
بمعدّل
ثلاثةِ آلافِ
طالبٍ
وطالبةٍ. غير أنّه
لا يُتقن أحدٌ
منهم اللّغة
العربيّة،
كما لا يفهم
أحدهم شيئًا
من معاني آيات
القرآن؛
بينما نزلت
هذه الآياتُ
الكريمةُ
للحكمة الّتي
أراد الله بها
أن يزكّيَ
عبادَهُ، ويهذِّبَهم،
ويطهِّرَ
قلوبَهم
ويهديهم إلى صراطه
المستقيم.
زرتُ
أكثر من
ثلاثين
مدرسةً
قرآنيّةً في
مختلف مناطق
تركيا خلال
أربعة أعوامٍ
بدايةً من عام
1986م. وقد كانت
هذه المدارسُ
تمارس نشاطها
علنيًّا
بينما أعداد
كبيرةٌ منها
غير مصرّحٍ لها
بالتّدريسِ.
وجّهتُ
أسئلةً
عديدةً إلى
مسؤلى هذه
المدارسِ
أثناء تلك الزّيارات،
فتلقّيتُ
ردودًا
غريبةً منهم،
أخجلُ من ذكرِ
بعضها في مثلِ
هذا المقام.
وأرى أنّ
بعضها قد
يدعوا إلى
التّأمّلِ
والعبرةِ.
ولعلّ
من هذه
الرّدودِ ما
يثيرُ
الاستغرابَ ويجعل
الإنسان
يتعجّبُ! ذلك
أنّي لمّا
سألتُ أحدَهم:
لماذا لا
تدعونَ مَنْ
يُعلّمُ
هؤلاء الشّبابَ
اللّغة
العربيّة؟
قال بالحرف
الواحد: "وما
نصنع باللّغة
العربيّة!
لأنّها ليستْ
لغتًنا".
فقلتُ له: ألا
تريدون أن
تفهموا
القرآن، وإذا
تعلّمتم
لغتَهُ زالت
المشكلةُ؟
قال "من أراد
أن يفهم
القرآن، يكفيه
أن يتناول
نسخةً من
ترجمته، وهي
متوفّرةٌ"
ثمّ ناولني نسخةً
من ترجمة
القرآن
الكريم باللّغة
التركية كانت
عنده فوق
المكتبةِ،
وأضاف قائلاً
بلهجةٍ
مستهزئةٍ " ها
أنت تزعم أنّك
تُتقِنُ اللّغة
العربيّة،
فما الفرقُ
بيني وبينك في
فهم القرآن
وأنا لا
أُتقِنُها!
أنت تفهمه من
النّصِّ
العربيِّ،
وأنا أفهمُهُ
عن طريق
التّرجمةِ،
ولا أظنُّ
أنّكَ أعلم
بالقرآنِ من
مترجمِ هذه
النّسخةِ،
كَمَا لاَ
أَظُنَّكَ
إلاَّ
رَجُلاً
يُرِيدُ أَنْ
يُفْسِدَ فِي
الأَرْضِ؟!
سألتُ
مدرّسًا
يُشرِفُ على
تحفيظ القرآن
في مدرسةٍ
قرآنيةٍ
ضخمةٍ،
سألتُهُ عن
مدى فهمِهِ
لمعاني
القرآن
الكريمِ. لأنّه
كان يجهل اللّغة
العربيّة
تماماً.
أجاب
في تعجّبٍ أنّه
غير مستعدٍّ
للرّدِّ على
هذا
السّؤالِ،
لأنّه لم
يتوقّع أن
يُوَجَّهَ
إليهِ مثل هذا
السّؤال
يومًا من
الأيّامِ.
قلتُ
له، تعني أنّ
فهمَ معاني
القرآن لا
يتوقّفُ على
المعرفةِ باللّغة
العربيّة؟
أجاب على سؤالي
هذا في غضبٍ:
ما
أراكَ إلاَّ
تريد الفساد!
وهل سمعتَ
رجلاً من
أولياء الله
تكلّم بلسان
العرب؟ ألم
تسمع أنّ
أولياء اللهِ
إنّما يحجّون
بأرواحهم وليس
بأجسامهم،
حتّى لا يراهم
العرب،ُ
ولألاّ يتلقّوا
معهم
جسمانيًّا،
كراهيّةً
لهم!!"
سألتُ
عددًا من
طلبةِ المدارس
القرآنيةِ
عما إذا
يتلقّونَ
دروسًا في اللّغة
العربيّة؟
قال بعضهم في
تساؤلٍ
وتعجُّبٍ: "هل
القرآن عربيٌّ؟!".
وسأل بعضُهمُ
الآخرُ
"لماذا نزلت القرآنُ
باللّغة
العربيّة،
ولم تنـزل باللّغة
التّركيةِ؟"
وقال أحدُهم
"لماذا
العربُ يعادون
الأتراك؟" ثم
قال يافعُ منهم
" لماذا
العربُ
يأكلون
بأيديهم ولا
يستعملون
الملاعقَ
والشوكاتِ؟"
وهكذا طالت
المحادثةُ
إلى أن فسد
الأسلوبُ
ورأيت هؤلاءِ
الشباب لا
يكاد أحدهم
يعبأ بما
يتفوّه.
فعلمتُ أنّ
القرآن عندهم
لا صلةَ له باللّغة
العربيّة!!!
ولكن ما زلتُ
أبحثُ عن
السّببِ أو
الأسباب الحقيقيةِ
التي أسفرت
هذه
النّتائجُ
الخطيرةُ
عنها، وكيف
الطريقُ إلى
حلِّ هذه
المشكلةِ.
اتّفق
لي بعد هذه
الزيارات وما
جمعتُ خلالَها
من معلوماتٍ
غريبةٍ
وهامّةٍ؛ أن
أقومَ بإلقاءِ
محاضرةٍ
يحضرها
جمهورٌ من
قطاعِ الشّعبِ،
ممن يتولّونَ
شؤون المدارس
القرآنيةِ، ويعملون
على نشرِ
تحفيظ
القرآنِ في
تركيا؛ وجلُّهم
من الطُّرُقِ
الصّوفيةِ؛
ولا ترتبط مدارِسُهم
بالدّولةِ،
بل كانت
كلُّها
مستقلّةً غير
مصرّحٍ لها
بالنّشاط،
ولكنّ
الحكومات
السابقةَ
أرخت لها
العنان إلى أن
كسحها الحكومات
الأخيرةُ.
أبديتُ
استعدادًا
قويًا لهذه
المحاضرةِ،
لأنّها كانت
مواجهةً
جريئةً
باعتبار أنّها
كانت أوّل
مبادرةٍ
يُخطَرُ بها
شيوخ الأتراك
على أهمية اللّغة
العربيّة
بالنّسبةِ
للمسلمين في
تركبا.
فجمعتُ
المعلومات
اللاّزمةَ
وأنا يومئذٍ أستاذ
مادّةِ اللّغة
العربيّة
بكلّية أبي
بكر الصّديق
الشعبيةِ
للعلوم الإسلاميةِ.
في إسطنبول،
ثمّ قمتُ
بترتيب البرنامج
وتوجيه
الدّعوةِ إلى
عددٍ من رجال
الدّين وشيوخ
الصّوفيةِ
ومسئولي
المدارس
القرآنيةِ،
ذلك
بالتّنسيق مع
الصّديق
الكريم الفاضل
الدّكتور
عارف آيتكين
وهو أوّل مّنْ
انتبهَ إلى
هذه المشكلةِ
وأيقن
بضرورةِ
تشجيع طلبةِ
المدارس
الدّينيةِ
على إتقان اللّغة
العربيّة
واستخدامها
في التعبير.
فبدأت
المحاضرةُ في
أوائل شهر
أكتوبر من عام
1988م. حضرها
لفيفٌ من
الشّيوخِ
والملالي
والطّلبةِ،
وعلى رأسهم
شيخ طائفةِ من
النّقشبندييّن/
محمود أُسطىَ
عثمان أوغلو.
إنّ
المدعوّين في
الحقيقةِ لم
يكونوا على
علمٍ تامٍّ
بموضوع
المحاضرةِ، لأنّي
توقّعتُ منهم
أن يرفضوا
الإجابةَ
والحضورَ إذا
ما علموا أنّي
سوف أُركّز
على أهميةِ اللّغة
العربيّة
خاصّةً في
التّعبير؛
ولأنّي كنتُ
متأكّدًا من
حسّاسيتهم.
ذلك من الغريب
جدًّا أنّ
الّذين
يهتمّون باللّغة
العربيّة في
تركيا
يحتاطون
بكلِّ شدّةٍ
أن يتعدّى
اهتمامُهم
حفظَ القواعد
إلى استخدام اللّغة
العربيّة في
التّعبير.
أمّا إتقان اللّغة
العربيّة
كوسيلة
للتّعبير،
فهو مرفوضٌ
عندهم بتاتًا.
لذا
ما من أحدٍ
ينتبه إلى هذه
المشكلةِ
الغريبةِ،
فيتساءل عن
الموقف
السّلبيِّ
لشيوخ الأتراك
من اللّغة
العربيّة
الاَّ ويُهان
بكرامتِهِ
(إذا أكّد لهم
على أنّ للّغة
العربية
لابدّ من
تدريسها
بالطريق المباشر
حتى يتمكّن
الطالبُ من
استخدامها في التّعبير
متى أتقنها)
قد
يكون موقفهم
هذا ناشئًا من
خوفهم من
المتقنين
لهذه اللّغة.
إذ لو علِم
النّاسُ أنّهم
يجهلون لغةَ
القرآنِ، وهم
يُفسِّرونهُ
ويشرحونه (!)
ضعُفتْ ثقةُ
المجتمعِ بهم.
ولهذا تراهم
يحتاطون
بعنايةِ
بالغةٍ أن لا
يلتقوا بشخصيةٍ
من
مُثَقَّفِي
العربِ
وعلماءِهِم
حذرًا من
ألاَّ يراهم
النّاسُ في
صمتٍ مستمرٍّ
والعربيُّ
يتكلّمُ؛
ولألاّ
يتساءلوهم عن
سبب العجز
الذي يعانونه
في تبال
الحديثِ مع
العرب في عموم
الأحوالِ. لا
شك أن ذلك
سيؤدّى إلى زوال
قدرهم وَالْحَطِّ
مِنْ
كَرَامَتِهِم
وهيبتهم في
نظر الناس
وبالتالي
يخسرونَ
شهرتهم!
في
الحقيقة يدلّ
هذا الواقع
على أنّهم
يعانون من
داءٍ
نفسانيٍّ
عضالٍ. نجد
لهذا الدّاءِ
شرحًا وافيًا
في مصادر علم
النّفسِ. لأنّ
هؤلاءِ
المتشيّخين،
إنّما
يحاولون لِيُبْطِنُوا
ما يكوي
صدورَهم من
آلام العجزِ
والجهلِ الّذَيْنِ
إذا بدتْ
أماراتُها
للنّاسِ خسروا
مكانَتَهم
المرموقةَ.
فقد أدّى ذلك
إلى رسوخِ
عُقْدَةٍ
نفسيّةٍ
خطيرةٍ في
أعماقِهم.
يتعارضُ في
غياهب نفوسهم
نزعتان
شديدتا التّناقضِ،
يثيرُهما
سببٌ واحدٌ؛
وهو الهروبُ الرّخيصُ؛
ولكنّهم
يتحاشون هذه
العاقبةَ.
أمّا
النّزعتان:
فالأولى
منهما – لا شكّ –
هي انتهاز
الفرصةِ
للهروبِ
مخافةَ أنْ
تكون الغلبةُ
للشّخصِ
العالِمِ حين
يجمعُ بينهم القدرُ
على كراهيةٍ
منهم وهو
يتكلّم
بطلاقةٍ
وفصاحةٍ
وبلاغةٍ وهم
في سباتٍ
عميقٍ كأنّ
أفواهَهم
محشُوَّةٌ
بالقطنِ.
والنّزعةُ
الثّانيةُ هي
الثبوتُ
والمقاومةُ
الباطنيةُ مع
الصمت امتناعًا
من الهروبِ
مخافةَ أن لا
يتّهمهم النّاسُ
بالجبن
والجهلِ
والعجزِ. لذا
تراهم في ضيقٍ
شديدٍ،
وارتباك بين
هواجس
متناقضةِ،
تتبدّى في
وجوههم
علاماتُ
الحرجِ
والاختناقِ
كلّما
اصطدموا
بوجودِ رجلٍ
عالمٍ
بالعربيةِ، ولا
يزيدهم ذلك
إلاّ حقدًا
وضغينةً على
العلماءِ.
إنّي
في الحقيقةِ
لم أكن على
علمٍ تامٍّ
بهذا الواقعِ،
وكنتُ أظنُ
أنَّ تركيا لا
تخلو من رجالٍ
قادرين على
استخدامِ
الأسلوبِ
العلميِّ في
الخطابِ
والتّعبير
الكتابيِّ باللّغة
العربيّة.
ولكنيِّ
اصطدمتُ
بعكسِ ذلك
تمامًا بعد
هذه المبادرةِ
والاجتماعِ
برهطٍ من شيوخ
الأتراك في
هذه
المحاضرةِ.
فلمّا
حضر
الجمهورُ،
وفيهم عدد من
الشيوخِ، بدأ
المنسّقُ
يمهّدُ
السّبيلَ
بالمقدِّمات
المُلْفِتَةِ
ليُهَيِّئَ
الجوَّ حتّى
يدعوَني
أخيرًا إلى منصّةِ
الخطابِ. فدعا
شابًّا من
تلامذتي
ليستفتح
المحاضرةَ
بنشيدٍ
عنوانُهُ
(مسلمون)؛
وهذه
كلماتُهُ:
مسلمون
مسلمون
مسلمون
* حيث كان
العدلُ
والحقُّ نكون
نرتضي
الموتَ ونأبى
أن نهون
* في
سبيل الله ما
أحلى المـنون
نحن
بالأيمان
أحيـينا
القلوب *
نحن بالإسلامِ
حرّرنا
الشعوب
نحن
بالقرآن
قوّمنا
العـيوب *
وانطلقنا في
شمالٍ وجـنوب
ننشر
النّورَ
ونمحو كلَّ
هـن * مسلمون
مسلمون
مسلمون
يا
أخي في الهند
أو في
المغربِ * أنا
منكَ أنت منّي
أنت بـي
لا
تسل عن عنصري
أو نسبي *
أنّه
الإسـلام
أمـّي وأبـي
اخـوةٌ
نـحنُ به
مـؤتلفون * مسلمون
مسلمون
مسلمون
وما
أنْ قَرَعَتْ
هذه الكلماتُ
سمعَهم بَدَتْ
في وجوه الّذين
يفهمون
العربية منهم
المنكرُ،
وكانوا عددًا
قليلاً
يكادون يسطون
بالشابِّ
الّذي يتلو
عليهم
النّشيدَ.
ثم
صعدتُ المنبر
فألقيتُ
نظرةً سريعةً
إلى الحاضرين،
وإذا بأبصارٍ
شاخصةٍ
مليئةٍ بالغضبِ
والتّهديد
والاحتقارِ
قد استقطبتْ
عليَّ،
ولكنّهم لم
يتوقّعوا
آنئذٍ أن
يفاجئهم
رجلٌٌ من أهلِ
بلادِهم يقوم
خطيبًا فيهم باللّغة
العربيّة. لأنّهم
لم يعتادوا
ذلك، بل وحتّى
خطباء
الجمعةِ
يوجزون كلمة
الثناءِ عند
الافتتاح ما
أمكنهم،
لأنّها
بالعربيّة،
وسرعان ما
يشرعون
الخطاب باللّغة
التركيّةِ.
فعلِمتُ
بحكم الطّبعِ
أنّي إذا
طلبتُ منهم أن
يهتمّوا
بالطّريقة
المباشرةِ في
تدريس اللّغة
العربيّة (وهي
أن لا يستخدمَ
المدرّسُ اللّغة
التّركيّةَ
في إلقاءِ
الدّروسِ،
بأن لا يتحدّث
مع تلامذته
إلاّ باللّغة
العربيّة)،
علمت أنّي لو
نصحتُهم في
هذه المهمّةِ
كأنّي قمتُ
بعمليةٍ
انتحاريةٍ.
وفعلاَ لم
يلبث حتّى
حدثَ ما
توقَعتُهُ،
فانفجرت
القاعةُ، وَعَلتِ
الأصواتُ
وعمَّ الفوضى.
ذلك أنّهم
عدّوا هذه
المبادرةَ
نوعًا من
الاستخفافِ
بشأنهم،
والاستهانةِ
بعلمهم. ولم
أقصد ذلك
إطلاقًا. لأنه
مهما كان،
فإنّهم يقضون
كلَّ حياتهم
في إحصاءِ
قواعد
الصّرفِ
والنّحوِ،
بحيث يُصبح
كلٌّ منهم
مكتبةً
متنقّلةً في
قواعد اللّغة
العربيّة.
والغريب أنّهم
مع ذلك يعانون
منتهى العجزِ
في التّعبير
عن أدنى شيءٍ
باللّغة
العربيّة.
وكان
لهذه
الضّجّةِ
سببٌ هامٌّ
آخرُ. وهو أنّ الأتراك
ينافسون
العربَ
قديمًا
وحديثًا في الانتماءِ
الإسلاميِّ،
وتأبى
نفوسُهُمْ أن
تكونَ
فهمُهُمْ
للإسلامِ
كفهمِ العربِ
له. لذلك قد
شرعوا
لأنفسهم
أساليبَ
خاصّةً في
التّعامُلِ
مع الإسلام.
ومن جملةِ هذه
الأساليب،
اهتمامُهم في
المدارس
القرآنيةِ بحفظ
قواعد
الصّرفِ
والنّحوِ
فحسب، دون
اتّخاذ اللّغة
العربيّة
كأداةٍ
للتّعبير. ذلك
أنّهم إذا
اتّخذوها
أداةً
للتّعبيرِ،
معناه التّهاون
بما تتصف به
هذه اللّغة من
القداسةِ
والكرامةِ؛
وهذا يؤدّي
إلى
استحالتها من
لغةِ الوحيِ
إلى لغةِ
الشارعِ،
فتستوي مع
بقية اللّغات.
فلا ينبغي ذلك
في نظرهم.
لأنّ اللّغة
العربيّة
مقدّسةٌ في
ضمير
القاعدةِ
الشعبيةِ
للمجتمع
التّركيِّ،
ومكروهةٌ في
نظر الطّغمةِ
الحاكمةِ،
وهذا ما قد
أسفر عن
نتائجَ
غريبةٍ أصبحت
موضوعَ
الصّراعِ بين
القاعدة
الشّعبيةِ والقلّةِ
الحاكمةِ من
جانبٍ، وبين
الأتراكِ والعربِ
من جانبٍ آخر.
وربما
من هذه
النّتائج
الغريبةِ أنّ
الرّجلَ
التّركيَّ
إنّما يكره
الإنسانَ
العربيَّ،
لأنّه أنزل
هذه اللّغة
المقدّسةَ
منـزلةَ لغةِ
الشّارعِ،
حتّى انتُهكت
حرمتُها!!
على
الرغم من
السلبيات
التي عرضت لي
أثناء هذه
المحاضرة،
فقد كنتُ أنا
الفائز في
النّهايةِ.
لأني استطعتُ
أن أطرح مشكلة
تدريس اللّغة
العربيّة في
تركيا لأوّل
مرّةٍ.
فألهمتُ بذلك
جمهورًا من
النّاسِ أنّ اللّغة
العربيّة هي
في حدِّ ذاتِها
أداةٌ
للتّعبيرِ،
وهي لغةُ
أمّةٍ تُربي
على خمسمائةِ
مليون من
البشرِ،
بإزاءِ ما لها
من ميّزاتٍ
أخرى،
باعتبار أنّها
لغة القرآنِ،
ولغة
المسلمين على
اختلافِ لغاتهم
المحلّيةِ؛
وأنّها لغة
العلم
والحضارةِ ،
كما تتميّز
بأصالتِها
وقواعدها
وآدابِها
الرّصينةِ
بين اللغات
الحيّةِ.
أثبتُّ
في الوقتِ
ذاته حقيقةً
هامّةً أخرى بهذه
المحاولةِ
الجريئةِ.
فأيقظتُ
كثيرًا من الغافلين
بأن الله
سبحانُ هو
الكفيلُ
بإمدادِ هذه اللّغة
كلّما
تعرّضتْ
لخطرٍ. لأن
الله كفيلٌ
بحفظ كتابه
الكريمِ إلى
يوم القيامةِ
وهي لغةُ كتابهِ
ووحيهِ. فما دام
القرآن
محفوظًا
بعناية الله
تبارك وتعالى،
فلغةُ
كتابِهِ كذلك
محفوظةٌ
معهُ، لأنّها
جزءٌ لا
يتجزّأُ منه.
يبرهن على هذه
الحقيقةِ فشل
المستشرقين
الّذين
يقومون
بالدعوةِ إلى
اللّهجةِ
العامّيةِ في
البلاد
العربيةِ بين
الفينةِ
والأخرى. فقد
أحبط الله
أعمالَهم،
وأيّد هذه اللّغةَ
حتّى في
تركيا، في هذا
البلد الذي
أصبحتِ اللّغةُ
العربيّةُ
تَعْتَبِرُهَا
فئاتٌ من
الناسِ لغةَ
الشعوذةِ
والتمائمِ
والطَّلَّسْمِ،
لِيْسَ ذَلِكَ
اسْتخْفَافًا
منهم بهذه
الأشياءِ ولا
بِاللّغة
الْعَرَبِيَّةِ،
بل لاعتبارهم
إيَّاها
أمورًا
مقدّسةً لاَ
يليق أن يتمّ
التعامل بها
إلاّ عن طريق
اللّغة
الْعَرَبِيَّةِ
المقدّسة!!!
كذلك
من ثمرات هذه
المحاضرةِ،
أنّنا انتبهنا
في الوقتِ
ذاته إلى
حماقة
الحكومات
العربيةِ أنّها
كيف تحتقر
القدرةَ
الكامنةَ
للإسلامِ في
تركيا،
وتتجاهلُ
الثروةَ
الثقافيةَ
المستمدّةَ
من اللّغة
العربيّة في
هذا البلد!
لقد تجاهل
العربُ جميعَ
ما يعودُ إلى
الإسلامِ في
تركيا. لقد
أخطأ العربُ
عندما حمّلوا
الشعبَ
التركيَّ
مسؤوليةَ
يهودِ
سالونيك
وذنوبَهم،
وعدّوا هذا
المجتمعَ بأسرهِ
من المارقين،
واعتبروه
بأجمعِهِ من أعضاءِ
حزب الاتّحاد
والترقي. اغترّ
العربُ على
سعةِ عالمهم،
وكثرةِ عددهم
بحكّامهم
الذين هم رموز
الرّجعيةِ
والأساطيرِ
والخرافاتِ،
فأدرجوا
المجتمعَ
التّركيَّ عن
بكرةِ أبيه في
القائمةِ
السّوداءِ،
ولم يميّزوا
في ذلك بين
الطُّغمةِ
الحاكمةِ (يهودِ
سالونيك)،
وبين القلّةِ
المؤمنةِ
المستضعفةِ
من أبناءِ هذا
البلد. مع ذلك
لم يتورّع
العربُ عن
اتّخاذ
الموقف
الإزدواجيِّ
من أبناءِ هذا
البلدِ. يبرهن
على هذه
الحقيقةِ
استجابةُ الحكومات
العربيةِ
لدعوةِ
الحكومةِ
التركيةِ في
منعِ الطلبةِ
الأتراك من
الدّراسةِ في
بلادِهم. ومن
غرائبِ العقل
العربي
المتخلّفِ، أنّهم
لم يفطنوا إلى
ما يتمتع به
الطّالبُ
المسلم التّركيُّ
من الإيمانِ
والعزيمةِ
والإخلاصِ ،
وأنّه إذا
أرادَ أن
يتعلّمَ اللّغة
العربيّة
لحقّق أملَهُ
ولو في
الصّحاري
والغابات. وكم
من طالبٍ
تركيٍّ مسلمٍ
يحاول اليومَ
ليتعلّمَ اللّغة
العربيّة وهو
مضطَّهَدٌ
يطارده الشّرطةُ،
كما يعاني ضغط
القبوريين من
جانبٍ آخر؛
وكم من شابٍّ
يحاولُ
ليتعلّمَ هذه اللّغة
حتّى في
السّجنِ.
كلُّ
ذلك يدلُّ على
استغناءِ
طالب اللّغة
العربيّة في
تركيا عن
العربِ.
خاصّةً فإنّ
الاضطّهادَ الذي
يقاسيه
الطالبُ في
هذه الأيّام
على أرضنا،
سوف
يُجبِرُهُ
على أخذِ
احتياطاتٍ
كفيلةٍ
بحرّيتِهِ
حتّى يتمكّن
من تحقيق هذا
الهدفِ
المقدَّسِ
والبريءِ.
لأنّه أصبح
منتبهًا إلى
الأخطارِ
الّتي أحدقتْ
به خاصّةً في
هذه الأيّامِ
الأخيرةِ.
لا
شكّ يترتّب
على كلّ من
يُتقِنُ اللّغة
العربيّة
نطقًا
وكتابةً في
هذا البلدِ،
يترتّبُ عليه
ان يُشمّرَ عن
ساقِ الجدِّ
فيشتركَ في هذا
الجهادِ
العظيمِ،
ويساهمَ في
تدريس النّاشئةِ،
نذكّرُهم
بقولِهِ
تعالى
"وَقُلِ اعْمَلوُا
فَسَيَرىَ
اللهُ
عَمَلَكُمْ
وَرَسوُلُ
وَالْمؤُمِنوُنَ،
وَسَتُرَدّوُنَ
إِلىَ عَالِمِ
الغيْبِ
والشّهادِةِ
فينبّئكم بما
كنتم تعملون."
نعم
نحن لا ننسى أنّهم
أيضًا يعيشون
في هذا
البلدِ،
ويقاسونَ
الشّدائدَ
وهم
مضطَّهدونَ.
ولكنّ القدرَ
الإلهيَّ قد
حمّلَهم
مسؤوليّةً لا
مهربَ منها. أنّهم
ربما لم
يكونوا
واقفين على
سرِّ هذه
المسؤوليِةِ
يوم هبّتْ بهم
رياحُ
القَدَرِ إلى
بلادٍ بعيدةٍ
ليتعلّموا
هناك اللّغة
العربيّة.
فرجعوا بكنوز
المعارفِ
بفضلِ هذه اللّغة.
أصبح النّاسُ
يوقِّرُهم،
فالتفّتْ
حولَهم جموعٌ
من الرّعاعِ،
فاشتغلوا
بإرشادهم في عمياءَ،
ولم يفطنوا أن
هؤلاءِ لن
يتركوا أصنامَهم،
ولن يعودوا
مؤمنين حق
الإيمان، إلى
أن فشل أولئك
الشّباب في إرشادِهم،
وانتهت
مساعيهم في
هذه المحاولة
البائسةِ
بخساراتٍ
فادحةٍ،
أفنتْ عشرات
السّنين من
أحلى
أيّامِهم.
لأنّ
"القطاعَ
المتديّنةَ"
بتعبير
الصّحفييّنَ
يتكوّنُ من
فئاتٍ جهلةٍ،
وجماعاتٍ
ملتفّةٍ حولَ
شيوخ الصّوفيةِ،
أكثرُهم أهل
البِدَعِ
والخرافاتِ، وفيهم
زنادقةٌ
وأصحابُ
أهواءٍ
تختلفُ
نظرُهُمْ إلى
الإسلامِ عن
نظرِ أهل
الإيمان
الخالِصِ
والعلمِ والوعيِ.
ولهذا
من الجديرِ
بالأسفِ أنْ
ينشغلَ الرّجُلُ
العالِمُ
بهذه الفئات
الغريبةِ،
فتذهبَ
أعمالُهُ
هباءً
منثورًا. ولكن
اليومَ تتوجّهُ
مسؤوليةٌ
عظيمةٌ إلى
كلِّ من
يُتقِنُ اللّغة
الغربيةَ أن
يُعَلِّمَها
الشّبابَ ولو
شخصًا واحدًا
في هذا البلدِ
دونَ أن يأملَ
مساعدةَ
العربِ
لأنّهم
اليومَ
مشغولونَ
بآلامِهم وقد
صبَّ اللهُ
عليهم صوتَ
عذابٍ، إنّ
ربّكَ
لبالمرصاد!.
إنّ
من يسمع هذه
المعلومات،
لابد أنّه
يتساءل عن
أسبابِ هذا
العداء
السّافر على اللّغة
العربيّة منذ
عصرٍ كاملٍ
على أرضِ
تركيا. إنّ
هذه المشكلةَ
لم يطرق لها
أحدٌ من رجال
البحثِ في
أبعاده
الواسعةِ،
كما لا نجدُ
شيئًا يستحقّ
الذّكر من
الكلامِ حول
أسبابِها.
لأنّ دراسةَ
هذه القضيةِ
ليس أمرًا
سهلاً كما
يبدو. ذلك
يقتضي أوّلاً
وقبل كلِّ
شيءٍ أن
تتوفّر في
الباحث صفة
الحيادِ
والعلمِ
والجُرءةِ والصّدقِ.
ولكن أين ذلك
الباحث الّذي
يرى في نفسِهِ
الاستعدادَ
والجرَْةَ
ليقرَّ بأنّ
الأتراك لم
يكونوا قد
تعرّفوا حتّى
على أداةٍ اسمه
القلم، ولا
كان فيهم أحدٌ
يُتقِنُ
الكتابةَ والقراءةَ
في العصر
الّذي بلغ
الأدبُ العربيُّ
فيه أوجَ
ازدهاره. ألا
وهو العصر
الجاهليُّ.
أين كان
الأتراك
يومئذٍ؟ هل في
وسعِ أحدٍ من
أهلِ العلم
والبحثِ أن
يأتي بحجّةٍ
فيُبرهنَ بها
على أنّ
الأتراك قد
كتبوا شيئًا
بلغتهم، حتّى
في بدابةِ
أيّامهم
الّتي
اعتنقوا فيها
الإسلامَ،
بغضِّ
النّظرِ عن
سالفِ أيّامهم،
إن كان لهم
تاريخٌ
مدوَّنٌ كما
يزعمون ؟!
إنّ
الحربَ الّتي
شُنَّتْ على اللّغة
العربيّة على
مدى عصرٍ
كاملٍ في
الوطن
التُّركيِّ،
لابدّ أن
نتحرّى
أسبابَها من
وراءِ هذا
الواقع الهامِّ؛
هذا الواقع
الّذي
يقودُنا إلى أنّ
الأتراك لا
أبجديّةَ لهم
أصلاً،
وأنّهم إنّما
استطاعوا أن
يدوِّنوا
لأوّل مرةِ
بلغتهم بعد
الألفِ
الأوّلِ من
الميلادِ؛
ولكنّهم
استعملوا
الأبجديةَ
العربيةَ
أكثر من ألفِ
عامٍ. ولا
يزال
القاموسُ
التُّركيُّ
المعاصرُ
محشوًّا
بألفاظٍ عربيّةٍ.
فإنّ الكلمات
الّتي لا يزال
القاموسُ
التّركيُّ
يضمُها حتّى
اليومِ، لا
تقلُّ عن
خمسةِ آلافِ
كلمةٍ. أمّا
العربُ،
فإنّهم
يكتبون
ويقرؤون منذ
أيّام الجاهليةِ.
إنّ من
يُمعِنُ
النّظرَ في
تاريخ الأدبِ
العربيِّ يجد
أيّامًا
مُشرِقةً
لهذا الأدبِ
قبل الإسلامِ
وبعده. فلا
نكاد نجد حتّى
اسمًا واحدًا
لأديبٍ أو
شاعرٍ أو
مؤلِّفٍ أو
خطيبٍ نبغ في
الأدبِ
التّركيِّ
عبر العصور
الّتي عاش
فيها امرؤ
القيسِ،
والنّابغة
الذبيانيّ،
وزهير بن أبي
سلمى،
والأعشى،
وعنترة بن شدّاد،
وطرفة بن
العبد، وعمرو
بن كلثوم،
والحارث بن
الحلزة،
ولبيد بن
ربيعة، وحاتم
الطّاءيّ،
وأمية بن أبي
صلت.
نعم
لا يكاد باحثٌ
أو عالمٌ
بالتّاريخ
يقف على أدنى
دليلٍ يبرهن
عمّا إذا كانت
للأتراك علاقةٌ
بالعلمِ
والمعرفةِ في
عصر هؤلاءِ
المشهورين في
تاريخ الأدبِ
العربيّ؛ بل
وحتّى بعد
اعتناقهم
للإسلامِ
ومُضِيِّ
حُقبةٍ على هذا
الحدثِ؛ وهي
لا تقلُّ عن
ثلاثمائةٍ
وخمسين
عامًا، إذا
اعتبرنا القرنَ
الهجريَّ
الأوّلَ
بدايةَ
اعتناقهم
للإسلامِ.
لأنّ أوّلَ
مَنْ دوّنَ
منهم كتابًا باللّغة
التّركية هو
يوسف الحاجب.
ألّفَ كتابًا
بعنوان
(كوتادجو
بيليج) عام 1069 من
الميلاد. أي
بعد مُضيِّ
ثلاثمائةٍ
وخمسين عامًا
على إسلام
الطليعة
الأولى منهم.
ثمّ برز رجلٌ
آخرُ منهم
اسمه محمود
الكشغاري؛
ألّف كتابًا
عام 1072 من الميلاد،
ألمَّ فيه باللّغة
التّركية
معتمِدًا على اللّغة
العربيّة. وهو
الكتاب
المسمّى
(ديوانُ لغة
التُّرك). إلاّ
أنّه من
الغريب جدًّا
أنّنا لا نجد
في المجتمع
التُّركيِّ
اليومَ أحدًا
يفهم شيئًا من
مضمون هذين الكتابين
إلاّ عددًا
قليلاً من أهل
الاختصاصِ. بل
وملايينُ
الأتراك
المعاصرون لا
علمَ لهم
بهذين العملين
ولا بمن
ألّفهما.
فحسبنا
هذا القدر
اليسير من
جملة الحقائق
أن نتعرّف بها
على مدى
القاعدة
التّاريخية
لثقافة الشعب
التّركيِّ
وحظِّهِ من
العلم
والمعرفةِ.
ربما
تتساءلون في
أنفسكم عن مدى
علاقتنا باللّغة
التّركية
ونحن بصدد اللّغة
العربيّة.
نعم، لماذا
نتحدّث عن
تاريخ اللّغة
التّركية،
ونتعجّب من
أنّ الأتراك
أمّةٌ لا أبجديّةَ
لها، وأنّهم
متأخِّرون في
مجال التّدوين
والتّأليفِ؟
لماذا نتباحث
عن هذه
الأشياء في
الحين الّذي نتبنَّى
تعليل مشاكل اللّغة
العربيّة؟
إنّما
ذكرْنا آنفًا
حدثين هامّين
في تاريخ الأمّة
التّركيّةِ
استدلالاً
بهما على إثباتِ
ظاهرةٍ في
طبيعةِ هذا
الشغب، وما
نشأ منها من
سلبيّاتٍ عبر
حياتِهم منذ
اعتناقهم
للدّين الإسلاميِّ
حتّى اليوم.
وعلى رأسِ هذه
السّلبيّاتِ
كراهيتهم
للرّجل
الأجنبيِّ
وإن كان مسلمًا.
تلك الظاهرة
هي الروح
العسكرية
الراسخة فيهم
كأنّهم جبلوا
عليها حتى جعلَتْهم
يستخفّون
بكلِّ مَنْ
ليس من بني
جلدتهم، وما
ليس من
صُنعهم.
ومن
هذه
السلبيات،
موقفهم
المتهاون من
مفهوم العلم
والمعرفة.
فإنّ هذا
الموقفَ هو الّذي
ثبّطهم عن
النشاطِ في
المجال
العلميِّ
والتّقْنيِّ
عبر تاريخهم
حتّى أصبحوا
اليوم يحرصون
على
الانتماءِ
إلى الغربِ،
والغربُ
يستخفُّ بهم.
يبدو
وبكلّ وضوحٍ
أنّ الأتراك،
لمّا اصطدموا
بالفشلِ في
السباق مع
الأمم المتحضّرةِ،
ظنّوا أنّ ذلك
من نتائجِ
انتمائهم إلى
الإسلامِ.
فلمّا لم
يجدوا الحلَّ
في الهروبِ من
ساحتِهِ
تمامًا،
أصبحوا
مذبذبين بين
ذلك، لا إلى
هؤلاءِ، ولا
إلى هؤلاءِ.
فإنّ كراهيّتهم
للعربِ
وللّغةِ
العربيةِ ليس
إلاّ نتيجةً
لهذا
التذبذُبِ
والتّرنُّح.
لأنّهم قد
أحسّوا
أخيرًا على
فراغٍ كبيرٍ
في ثقافتهم، وقد
علموا
بالتّأكيد،
أنّ المشاكل
التي تتعرّضُ
لها لغتُهم،
إنّما هي من
نتائج تأثير اللّغة
العربيّة
فيها؛ وهم
يحاولون
تصفيتَها من
الكلمات العربيةِ
منذ عشرات
السّنين. لأنّ
الكلمات العربية
الموجودة في
القاموس
التّركيِّ قد
أضفتْ على هذا
اللّغة صبغةً
لا يكاد
الإنسان
التركيُّ
يطمئنُّ بأنّ
لغتَه خالصةٌ
تتميّز
بمقوّمات
لغةٍ قوميةٍ
يمكن
الاستدلالُ
بها على
استقلال
الثقافة
التركيةِ.
في
الحقيقة لا
يجوز القول
بأنّ الشعب
التركيَّ
بأجمعه يكره
العربَ واللّغةَ
العربيّةَ.
ولكنّ هذه
الكراهيّة
تُبديها
الحكوماتُ
التركيّةُ
والمؤيّدون
لها فحسب. يجب
التأكيد على
هذا الواقع
خاصّةً في كلّ
مناسبةِ حتى
لا يتخذ المغرضون
في البلاد
العربيّة هذه
المشكلة
ذريعة لفتنة
قد يريدون
إثارتها بين
صفوف
المسلمين من
الطرفين! لأن
المسلمين من
الشعب
التركيّ
والعربيِّ لا
مشكلة بينهما.
ولكنّ أبناءَ
العصبيّة من
الطرفين هم الّذين
يقومون دائما
بإثارة
المشاكلِ،
ليوقعوا
المسلمين
بعضهم في
بعضٍ.
أمّا
نحن أبناء
الإسلام في
الوطن
التركيِّ فلن
تُرهبنا هذه
السّلبيات،
ولن يدخلَ
بيننا وبين
لغةِ القرآن
حاجزٌ.
فسنبذلُ
جهودنا دائمًا
لنـزداد
حظًّا من
المعرفةِ
بهذه اللّغة
الشّريفةِ
وأسرارها. فقد
تشرّبتها
قلوبُنا،
وارتاحت بها
نفوسُنا؛
نعترف وبكلِّ
فخرٍ، ونُعلِنُ
بكلِّ
اعتزازٍ، أنّ اللّغة
العربيّة هي
التي
أسمعتْنا
رنين
المعجزات
القرآنية، وقرّبتْ
هديَهُ إلى
عقولنا، فهي
المفتاح الوحيد
لأبواب
فيوضاته
الربّانيةِ.
ولقد
قارنّا هذه اللّغة
مع كثيرٍ من
اللغات،
فوجدنا بونًا
كبيرًا بينهما.
وتأكّدنا من
أنّ أيَّ لغةٍ
من اللغات الإنسانيّةِ
مهما كانت غنيّةً
وقويّةً، لن
تستوعب كلام
الله إلاّ اللّغة
العربيّة »لِسَانُ
الّذيِ
يُلْحِدوُنَهُ
أَعْجَمِيٌّ،
وَهَذَا
لِسَانٌ
عَرَبِيٌّ
مُبيِنٌ«
هذا
ولا ينبغي أن
نستهين بتلك
العقليةِ
المتخلِّفةِ
التي هي في
الحقيقةِ
عقبةٌ كبيرةٌ
أمامَ شبابِ
بلادِنا
الّذينَ
يريدون أن
يتعلّموا
لغةَ
القرآنِ، وهم
أصلاً
مخلصونَ في نيّاتِهم،
ولكنّهم
سرعان ما
يقعون في شبكة
الصّوفيةِ
وعبدةِ
الأمجادِ
والتّاريخ.
أيها
الشباب
الأفاضل!
إنّ
الله قد
أنقذكم من هذا
الخطرِ
وأراكم الآية
الكبرى،
فسخّرني في
خدمتكم،
فألقيتُ الضّوءَ
على سبيلِكم،
وها أراكم
اليومَ قد
حُبِّبَتْ
إليكم
الطّريقةُ
المباشِرةُ،
والأسلوبُ
العلميُّ
المتينُ، وقد
اقتنعتم بأنّ
هذا هو
السبيلُ
الوحيد الّذي
يكفلُ
للطالبِ النّجاحَ
في تدريس اللّغة
الأجنبيةِ.
وربما
يشمئزُّ بعضُ
اخوتِنا من وصف
اللّغة
العربيّة
بإطلاق اسم
الأجنبية
عليها –
باعتبار أنّها
لغة القرآن،
وأنّها لغة
المسلمين
فيما بينهم
مهما اختلفت
لغاتهم
المحليةُ
وأوطانهم- ؛ فإنّي
لأعبّرُ بهذه
المناسبةِ عن
بالغ سروري بمثل
هذا الموقف
الأصيل
والانتماء
الجميل، كما
أشكر أصحابَ
هذا الشعورِ
الطّيّبِ
والموقف
النبيل،
لعلَّ
اعتذاري يقع
منهم موقع القبول
إذا اضطررتُ
أن اجعل اللّغة
العربيّة في
عداد اللّغات
الأجنبية
بالّنسبة لمن
يجهلها فحسب من
أبناء
المسلمين. عسى
الله سبحانه
وتعالى أن
يحقّقَ
آمالَهم
فيسهّلَ
لأبناء أمتنا
سبيل الإتقان
لهذه اللّغة
الشريفةِ
ويرشدنا بذلك
جميعًا إلى
هدي محمدٍ
صلّى الله
عليه وسلّم.
أمّا
أنتم يا
إخوتي!
فإيّاكم
أن تتراجعوا
في هذه
المعركة المباركةِ
فتولّوا
الأدبارَ وتنسحبوا...
بل واصلوا
جهادكم،
وقاوموا
أسلوبَ أبناءِ
الجهلِ
والتعصّبِِ،
واضربوه بوجه
الحائطِ،
وكثّفوا
جهودَكم
بتمرينات
الترجمةِ من اللّغة
التّركيةِ
إلى اللّغة
العربيّة
وليس بالعكس،
إلاّ ما
اضطررتم. فإنّ
التراجمةَ من اللّغة
الأجنبيةِ
إلى اللّغة
المحليةِ
(لغير أهل
الاختصاصِ) تُمِيتُ
المعرفةَ
بالأوُلى،
وتُعِيقُ
استخدامَها
في التعبير.
ولهذا
عليكم
بملازمة
التّرجمةِ من اللّغة
التّركيةِ
إلى اللّغة
العربيّة،
والحضورِ مع
من يتقنها،
والاستفادةِ
من أهلِها؛
فإنّكم على
الخطِّ
المستقيمِ.
سيروُا على
بركة الله!
إخوتي
الأعزّاء!
لقد
كان يتوافد
عددٌ كبيرٌ من
شبابِنا إلى
البلاد
العربيةِ منذ
سنين، بُغيةَ
أن يتلقّوْا
هذه اللّغة من
مصدرِها
الحقيقيِّ،
ومن أفواه
الّذين يُتقنونَها
حقَّ
الإتقانِ.
ولكنّ
الحكومةَ التّركيةَ
السابقةَ
أنذرت
البلادَ
العربيةَ بأن
لا توافقَ على
طلبِهم، وأن
لا
تُمَكِّنَهُمْ
من الإقامةِ
على أرضها. فحصلَتْ
ما حصلَتْ بعد
ذلك ودارتْ
الدّائرةُ على
كلِّ من درس
في البلاد
العربيّةِ
منذ عشرات
السّنين؛
حتّى
أُلْغيَتْ
شهاداتُهُمْ،
وأصبحوا
يُعَدُّونَ
من الجهلةِ، كما
لا يكاد
يعتدُّ بهم
أحدٌ في هذه
الآونة الأخيرةِ.
أسفرت
عن هذه
السّياسة
الماكرةِ
نتائجُ
خطيرةٌ، أهمّها
عزل العدد
الكبير من
أبناءِ تركيا
عن ساحات
العملِ؛
ليظهر بذلك
للبسطاءِ
والمغفَّلين
من النّاسِ أنّهم
غيرُ أهل
الكفاءةِ،
وأنّهم عالةٌ
على المجتمعِ.
لأنّ غالبَهم
بعد أن
اُقيلواُ عن
أعمالِهم
بالإضافةِ
إلى الّذين لم
يحصلوا أصلاً
على أيِّ
عملٍ،
أجبرتْهم الظروفُ
على البطالةِ
أو على قبولِ
الصّدقةِ من
الناسِ. وهذا
ما كانت
الحكومةُ
تريدُهُ؛ فحقّقتْ
بذلك أكبرَ
هدفٍ من
أهدافِها.
لأنّها استطاعت
أن تنالَ من
كرامةِ
الإسلامِ
بطريقٍ غيرِ
مباشرٍ، وأن
تكفَّ بذلك من
استنكارِ أهل الإيمان
في هذا البلد.
زد على ذلك
أنّ الحكومةَ
أرهبتْ عيونَ
البقيّةِ من
الشبابِ
الّذين كانوا
على استعداد
للدِّراسةِ
في البلادِ
العربيّةِ.
فما كاد أحدٌ
منهم
يُظْهِرُ
الجُرْأةَ بعد
ذلك
ويُقْدِمُ
على هذا
الخطرِ الّذي
يهدِّدُهُم
بالبطالةِ
والجوعِ.
إنّ
الّذين يخافون
من الجوعِ
سينسحبون لا
غرابةَ من هذه
الصّفوفِ،
بحكم طبيعتهم
الواهيةِ
ومعذرتهم
الرخيصةِ.
ولكنّ الّذين
يؤمنون
بالعلاقة القويةِ
الموجودةِ
بين هذه اللّغة
وبين رسالةِ
السّماءِ،
ويستعدّون
ليومٍ يهزم
الله فيه
الأحزابَ،
سوف يصبرون على
مرارةِ
الحياةِ
وسيقاومون
كلَّ أشكالِ
الاضطهادِ
والغدرِ
والظُّلمِ
والقمع حتّى
يتحقّقَ نصرُ
الله
للصّابرين »وَمَا
النَّصْرُ
إِلاَّ مِنْ
عِنْدِ اللهِ،
إنّ اللهَ
عَزيِزٌ
حَكيِمٌ«.
وبهذه
المناسبةِ
أنصحكم أيّها
الشّباب! أن تثبتوا
في معركة
العلم
والبحثِ
والتّبليغِ والإرشادِ
والإيمانِ والأخلاق...
واعلموا أنّ
العلمَ أكبر
سلاحٍ، وخيرُ
سلاحٍ، وأشدّ
تأثيرًا من
القنابل الذّريّةِ.
سلاحٌ يَهَبُ
الهدايةَ
والحياةَ
والسّعادةَ
لأبناءِ البشرِ.
أمّا بقيّةُ
الأسلحةِ
فإنّها
قامعةٌ
مبيدةُ
ومدمّرةٌ.
العلمُ سلاحُ
الأنبياءِ
المصطفين
الأخيار.
جهِّزُوا
أنفسَكم بهذا
السلاحِ
المقدّسِ
وانشروا
رايتَهُ ليس
لمصلحةٍ ولا
لسُمعةٍ، ولا
تغفلوا في الوقتِ
ذاته عن علاقة
اللّغة
العربيّة
بالقرآنِ
والعلم
والهدايةِ...
أنشروا رايةَ
العلمِ لنشر
دين اللهِ
ولتكون كلمةُ
اللهِ هي العليا
والله عزيزٌ
حكيمٌ.
أيها
الشباب!
عليكم
بكسب
المهارةِ في
البلاغةِ
والفصاحةِ والبيان.
لقد بلغ
الإهمالُ في
هذا الجانب من
علوم العربية
في بلادِنا
حتّى
أنّنا لا نكاد
نجد ولو شخصًا
واحدًا –ممّن
يدّعي أنّه
درس العربيةَ-
لا نجده
قادرًا على
النّطقِ بأدنى
شيءٍ من
أسلوبِ أهل
العلمِ. وهذا
يعدُّ من العارِ
لشعبٍ له صلةٌ
بكتاب اللهِ
العزيز الذي هو
بحر الفصاحةِ
وينبوع
البلاغة
والبيان
إنّ
البلاغةَ في
الحقيقة هي
موهبةٌ
يتميّز الإنسانُ
بها طبعًا،
فتزدادُ
وتتطوّرُ
بالكسبِ. وقد
يحظى منها
جامد الطّبعِ
بكثرةِ الممارسةِ
والإكثارِ من
قراءةِ
كُتُبِ
الأدباءِ
ودواوين
الشّعراءِ؛
لأنّه من
أسباب إصلاح
المنطقِ،
خاصّةً
الإكثارُ من
تلاوة القرآن
الكريم يزيد
من بلاغةِ
الإنسانِ. فقد
ورد في قاموس
المنجد للأب
لويس معلوف
اليسوعي في
ترجمة الشيخ
إبراهيم
اليازيجي أنّه
حفظ القرآنَ
(مع أنّه كان
مسيحيًّا).
ومن الغريب
جدًّا أن
يهتمّ رجلٌ
مسيحيٌّ
بتلاوة
القرآن،
فضلاً عن أن
يُكلِّفَ
نفسَهُ عناءَ
حفظِهِ في
الحين الّذي لا
يؤمن به أنّه
وحيٌ من عند
اللهِ. فلم
يكن الشّيخ
إبراهيم اليازيجي
ليجمع همَّهُ
ويفتدِيَ
بأحلى أيّامِهِ
في حفظ القرآن
الكريم إلاّ
لأنّه علِمَ وتأكّدَ
من أنّ تلاوة
القرآنِ وحفظَهُ
سوف
يُزوّدُهُ
بأغلى ثروات
العلم والمعرفةِ
والبلاغة.
لأنّ حفظ
القرآن ليس من
الأمور
السهلةِ. بل
لا يصبر على
حفظه حتّى
المسلمون
إلاّ قلّةً
منهم. ولكنَ
القرآنَ، في
أدِلَّتِهِ
وحُجَجِهِ
والاقتباسِ
منه مددُ
أيّما مددٍ
لمن يستنجدُ
به.
كان
طلبة العلم قبل
النّهضة
الأدبيةِ
الحديثةِ
يرتادون الحلقات
العلمية التي
تعقد في ردهات
المساجد يومئذٍ،
على غرار هذه
الحلقات التي
نقيمها اليوم،
ثم يقف بعضُهم
مواهبه على
التخصّص
بمكنونات اللّغة
العربيّة
وآدابها،
ويتعمق فيها
حتى تداني له
أسرارها،
فيصبح اماماً
ومرجعاً
بمفرداتها.
تختلف
الكفاءةُ في
البلاغةِ
والفصاحةِ من
شخصٍ إلى آخر،
كما تختلف في
الشّخصِ
نفسِهِ من نطقِهِ
إلى كتابتِهِ.
قد يكون
الإنسانُ
بليغًا في
نطقِهِ
وكتابتِهِ،
وهذا قليلٌ؛
وقد يكون
بليغاً في
صياغتِهِ
الكتابيةِ،
ولكن ركيكًا
في نطقِهِ
وأسلوبِهِ،
وهذا كثيرٌ.
لأنّ الكاتبَ
يجد الفرصةَ
فيتأمّلُ
ويدقّقُ فيتمكّن
من اختيار
الكلمات
المناسبةِ،
ثمّ يصوغُ
كلامَهُ
بأناةٍ
وتمهّلٍ
وتجرُّدٍ.
أمّا الخطيبُ
فإنّه لا يملك
الفرصةَ إذا
كان مرتجلاً،
أي دون إعدادٍ
سابقٍ. وإنما
يملِكُ الخطيبُ
المقوالُ
المِصْقَعُ
موهبةَ
النّطقِ غريزيًّا.
تنبع الحكمةُ
من صدرهِ
تلقائيّاً،
ينطق بأروع
الكلمات
فينسِجُها
على أبدع
منوالٍ. ذلك حظٌ
فطريٌّ لا
ينالُهُ
غيرُهُ
بالحسد أو
بالاغتباطِ
أو بالتّمنّي.
فالجمالُ
الفطريُّ مقسومٌ،
ويختلفُ حظُّ
النّاسِ منه.
أمّا البلاغةُ
في اللّسان
فإنّها من
أعظم المزايا
شأنًا، ويتفاوت
النّاسُ فيها
كما يتفاوتون
في المال والجاه
والعلم، "وَ
فَوْقَ كُلَِ
ذيِ عِلْمٍ
عَليِمٌ".
إخوتي وأعزّائي، حفظكم اللهُ تعالى وزادكم علمًا ومتّعكم بسعادة الدّارين آمين.أحمد الله الّذي أقرّ عيني بالصّلة المباركة التي تربط بيني وبينكم: صلةِ الأستاذِ بتلاميذه. تلك من أجَلِّ الرّوابِطِ وأقدسِها. إذ يتعارف كثيرٌ من النّاسِ لمجرّد المصالح الفرديةِ، فينتهي غالبُها بانتهاءِ ما يرجو كلٌّ من الطّرفينِ أن يتحصّلَهُ باستغلالِ صاحِبِهِ. ولكن هذه الّتي تربط بيني وبينكم إنّما هي امتداد علاقة الرّسولِ صَلّى الله عليه وسلّم بأصحابه الذين وصفهم الله تعالى بأنّهم ْأَشدّاءُ عَلىَ الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهَمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغوُنَ فَضْلاً مِنَ اللهِ وَرِضْوَانًا سِيمَاهُمْ في وُجوُهِهِمْ مِن أَثَرِ السُّجوُدِ«.
إخوتي إنّ الله قسم الأرزاق بين عبادِهِ بحكمتِهِ التي لا تُدْرِكُهُ العقولُ. فقد أصابَنا منها ما لا يمكن أن ينالَهُ ملايينُ النّاسِ ولو أنفقوا بالقناطير المقنطرة من الذّهب والفضّةِ. ألا وهي نعمة العلمِ والمعرفة والحكمةِ. »وَمَنْ يُؤْتَ الْحِكْمَةَ فَقَدْ أوُتِيَ خَيْرًا كَثيِرًا« وإنّي لأحمده سبحانه على ما زادني فوق ذلك أن رزقني مصاحبَةَ رهطٍ من أهل العلم (ذالكم أنتم)، تشاركونني فيما آتاني ربّي من كنوز المعارِفِ وعلّمني ما لم يُدْرِكهُ عقلي من ذي قبلٍ، وفضّلني بذلك على كثيرٍ ممّن خلق تفضيلاً.
تلامذتي الأفاضل، قبل أن أختتم كلامي أوصيكم أيضًا بتقوى اللهِ تعالى وطاعتِهِ في السِّرِ والعلانيّةِ، ثمّ أنصحُكُمْ أن تستغلّوُا أيَّ فرصةٍ لتصيبوا كلّ يومٍ قسطًا من المعرفةِ، تزدادون به اطّلاعًا، يومًا بعد يومٍ، وترتقون بذلك مدارج الكمال حتى أراكُمْ إن شاء الله تعالى يومًا تتسابقون فيه مصاقعَ البلغاءِ ونوابغ العلماءِ، فتستفيد منكم الأمّةُ، ويكون لكم اليد الطّولى في جمعِ شملِها، وتوحيدِ صفوفِها وإصلاحِ ما قد أصابها من فساد. نسأل الله التوفيق وهو على ما يشاء قدير، وبالإجابة جدير. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فريد الدين آيدنFeriduddin AYDIN
e-mail: ferid@maktoob.com