مُقَدِّمَةُ
النَّاشِرِ
بسم
الله الرحمن
الرحيم
إنّ
هذا الكتاب يضمّ
بين دفّتيه
دراسةً
هامّةً في
معرض فرقةٍ من
الفِرَقِ
الصوفيّة. لقد
بذل المؤلّف
جهدًا بالغًا
في سبيل هذه
المهمّة،
فانطلق
بعزيمة
الباحث
المدقّق المنظّم
في أعماله. لا
غرو إنّه من فُرْسَانِ
هذا الميدان.
فَنَذَرَ من
وراء هدفه
أغلى أيّامه
منذ عنفوان
شبابه وهو
يتباحث من غير
مَلَلٍ،
ويطارد
المصادر،
ويجمع
الوثائق،
ويطالع وينسّق
ويسجّل ويسهر
عليها، حتّى
أثمر سعيه المتواصل
عن هذا السِّفْرِ
الجليل. كلّ
ذلك ليكشف العَتَمَةَ
عن أهمِّ سببٍ
من تلك
الأسباب الّتي
أحاطتْ
بالمسلمين
منذ قرونٍ فَعَرْقَلَتْهُمْ،
وحالتْ دون تَقَدُّمِهِمْ،
وشَوَّهَتِ
الْكَثِيرَ
من جمال
الإسلام.
تُقَدِّمُ
هذه الدِّرَاسَةُ
ما تُقَدِّمُ
من معلوماتٍ
تفصيليّةٍ مُنَظَّمَةٍ
وَمُوَثَّقَةٍ
مع ذكر
مصادرها
والإشارةِ
إلى أرقامِ
الصفحاتِ
لكلّ نصٍّ
منقولٍ منها،
وأحيانًا مع تَرْجَمَتِهَا.
وذلك تسهيلاً
للباحثين
ورجالِ العلمِ
في مهامّهم
عند مراجعتها.
ليس
الهدف من
تقديم هذه
الدراسةِ إلى
جماهير المسلمين
إلاّ إِعلامَهم
عن حدثٍ هامٍّ
من واقع
تاريخهم،
غفلوا أو تغافلوا
عن حقيقتها؛
ليستبصروا
نتائجَهُ من خلال
بحثٍ علميٍّ
رصين،
ووثائِقَ
مضبوطةٍ؛ وليتمكّنوا
بذلك من
مقارنة
الإسلام
الّذي نفهمه
من الكتاب
والسنّة، مع
الإسلام
الّذي اخْتَلَقَتْهُ
الْعَقْلِيَّاتُ
الْمُتَطَرِّفَةُ
عَبْرَ عصور
الظّلام. عسى
أنْ يستوحيَ
منه العبرةَ كلُّ
مَنْ يطّلع
عليها من أهل
الإيمان والإخلاص؛
وأنْ يتحمّلَ
المسئوليّةَ
لإحياء أمّة
الإسلام
ثانيةً بعد أنْ
اختفتْ بمقتلِ
آخرِ الخلفاءِ
الراشدين.
ونتضرّع
إليه تعالى أنْ
يبارك في
خطوات كلّ
مؤمن مخلص
يسعى إلى
تحقيق هذه
الغاية العظمى
بدءًا بِالْفَهْمِ
الصحيح مع
العلم التامّ؛
بأنّ من أراد
عملاً يتقرّب
به إلى الله
تعالى مما لم
يُشَرِّعْهُ
الله
ورسولُهُ فهو
مردودٌ
ووبالٌ على
صاحبه. هذا وتُقَدِّمُ
مؤسّستنا
شكرَهُ
وتقديرَهُ لمؤلّفِ
هذا الكتابِ
فضيلةِ الشيخ
فريد الدين بن
صلاح بن عبد
الله بن محمّد
الهاشمي
المعروف
بلقبه الخاص: Feriduddin AYDIN في
تركيا؛ وبالله
التوفيق.
الْعِبَر
للطباعة
والنشر
مُقَدِّمَةُ
الْمُؤَلِّف
P
الحمد
لله ربّ
العالمين والصلاة
والسلام على
سيّدنا محمّد
وعلى آله
وصحبه أجمعين.
إنّ
كثيرًا من
المسلمين - وحتّى
العلماءَ
والباحثين -،
تَنَكَّرتْ
لَهُمْ
الطريقةُ النقشبنديّة
عَبْرَ
الْقُرُونِ
فَلَم تتعدَّ
مَعْرِفَتُهُم
المعلوماتِ المحدودةَ،
والملاحظاتِ
البسيطةَ،
حَولَ هَذِهِ
النِّحْلَةِ،
غالبها لا
تتّصف بالعلميّة
والواقعيّة،
بالرغم من
انتشار هذه
الطريقة بين
عشرات
الملايين من
الناس في
الشرق الأوسط.
لم
أستغرب هذه
الحقيقةَ منذ
عَلِمْتُهَا.
لأنّي ولدتُ
ونشأتُ في أسرةٍ
ذات شهرةٍ
واسعة
النطاقِ،
تتمتّع بالزعامة
لقطاعٍ كبيرٍ
من هذه
الطائفة
الصوفيّة.
وبالتالي
كنتُ على علمٍ
بأنّ جانبًا
خاصًّا من
التفسير
الروحانيِّ
لعقائدها، لا
يقف عليه أحدٌ
بسهولةٍ؛
إلاّ عددًا من
شيوخها
المتمتّعين
بصفاتٍ
مخصوصةٍ،
ومُلزَمين
بعهودٍ
باطنيّةٍ
مستورةٍ،
أخذها عليهم
أسْلاَفُهُمُ
الّذين
قلّدوهم أزِمَّةَ
هذه الطائفة،
وهم قليلون
جدًّا.
فلمّا
وجدتُ
تفاوتًا
كبيرًا
واختلافًا
كثيرًا بين
معتقداتِ
شيوخِ هذهِ
الفرقةِ،
وتأكّدتُ من
أنّ
المشهورين
منهم
يتواطئون علي
إخفاء شطرٍ مِمّا
في صدورهم...وَكِتْمَانِهِ
عن بقيّة
الشيوخ،
فضلاً عن
جماعة
المريدين من
الطّبقة
العامّيّةِ،
بدأتُ أشكُّ
في أمرهم؛ وخاصّةً
عندما ثَبَتَ
لي بالتّحقيق،
وَرَأَيْتُهُمْ
يطعنون في كلّ
مَنْ يحارب
عقيدةَ الشّركِ،
ويعادونه،
ويقفون منه
موقفَ المؤمنِ
من الكافر، أو
ربما بالعكس،
زادني الشّكُّ
فيهم وتضاعف
مع الزّمان
حتّى دفعني
الأمرُ أنْ
انطلقتُ
باحثًا
حقيقةَ ما
توارى خلف
الصورة
الظاهرة لهذه
الفرقة من
أمورٍ خطيرةٍ
لا يمكن الإطّلاع
عليها لأجْنَبِيٍّ
بطرائِقَ عادية،
والنّاسُ
كُلُّهُم
أَجَانِبُ
بِالنِّسْبَةِ
إِلَيْهِمْ. تؤكّد
عَلَى هَذِهِ
الْحَقِيقَةِ
وَثَائِقُهُم
وَطُقُوسُهُم...
ولهذا،
أرى المناسبةَ
للإشارة إلى
أنّ مشاهير
الباحثين في
الطريقة النقشبنديّة
وهم بالتحديد:
الأستاذ
الدكتور حميد
آلغار، والأستاذ
الدكتور بطرس
أبو مَنَّهْ،
والأستاذ
الدكتور شريف
ماردين، والشيخ
عبد الرحمن
الدمشقيّه؛
لم يقفوا على
كثير من جوانب
هذه الطريقة،
بالقدر الّذي
تمكّنتُ أنَا بعون
الله من
الإحاطة بها.
فدرستُ
تاريخَها، وعقائدَها،
واتّجاهاتِها،
وتطوّراتِها
بعمق ومن خلال
وثائقها
والاتّصال
بصناديدها
المعاصرين
بحكمةٍ وجرأةٍ
وصبرٍ إلى ما
شاء الله أنْ
فرغتُ من هذه
الدراسة بعد
ثلاثة وعشرين
عامًا.
فَمِنْ
واقع
إِيمَانِيَ
الراسخِ
بِأَنَّ اللهَ
سَبْحَانَهُ
وَحْدَهُ لاَ
شَرِيكَ لَهُ
مُتَفَرّدٌ
بِالْكَمَالِ
وَمُنَـزّهٌ
عَنْ سِمَاتِ
النقص والزوال،
وَمِنْ
وَاقِعِ
تَخَصُّصِي
فِي آدَابِ
الطَّرِيقَةِ
النقشبنديّة
لِمَا آلَتْ
إِلَيَّ
الْخِلاَفَةُ
الْعُظْمَى
فَتْرَةً
مِنَ
الزّمَنِ
عَلَى الطَّائِفَةِ
الْحَزِينِيّةِ
الخالديّة
مِنْهَا،
بَعْدَ
اتمامِ
السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
تحت
رَقَابَةِ
مَنْ
أَقَامَنِي
فِي هَذَا
الْمنصب
وَإقْرَارِهِ
بذلك،
وَلَمَّا تَبَرَّأْتُ
مِنْ هَذِهِ الْفِرْقَةِ
وَأَبَاطِيلِهَا،
رَايتُ من
الواجب
الحتميّ أنْ
أقولَ كلمةً
عسى الله
تعالى أنْ
يُنقِذَ بِهَا
مَنْ وَقَعَ
في أوحالِ
الشِّرْكِ
والضَّلاَلِ،
بالانخراطِ
فِي سلكِ هذه
الطريقةِ؛
وَمَا عَلَى
الرسول إلاَّ
البلاغ، وَ
منْ أبَى
فَعَلَيْهِ الوزرُ
والْوَبَال.
وبهذه
المناسبةِ،
مِن الجدير
بالإشارة إلى أنَّ
مُحْتَوَى
هذا الكتابِ
لا ينحصر في
حدودِ
التعريفِ
بالطريقة النقشبنديّة
فَحسب، بل
يتعدَّى
أحيانًا إلى
تفصيلاتٍ دقيقةٍ
جانبيّةٍ لها
علاقةٌ عضويّة
بالساحةِ
الّتي تركتْ
هذه الطريقةُ
فيها أنواعًا
من تأثيراتِها
فتغيّرتْ بها
عقليّةُ
المجتمعِ
وعَقِيدَتُهُ
وَنَظْرَتُهُ
إلى الإسلامِ
والمسلمين.
فإذن لهذا العمل
دورٌ كبيرٌ في
دعم دراساتٍ
وبحوثٍ قد يقوم
بها رجالُ
العلمِ في
المستقبل،
وبخاصّةٍ منها
ما سوف يتناول
الساحةَ التركيّة
من
وَاجِهَاتٍ
إجتماعيّةٍ
وتاريخيّةٍ
وسياسيّةٍ
بِعكوسها
ومستجدّاتِهَا
المختلفة،
علمًا بأنَّ
الواقعَ
البادِيءَ
الّذي يَلْمِسُهُ
الدّارسُ
والباحثُ على
هذه الساحةِ
في الْوَهْلَةِ
الأولى، ليس
هو هذا التّيّارَ
الصّوفِييَّ
مباشرةً؛
لأنّ
الطريقةَ النقشبنديّة
بِطُقُوسِهَا
وتَعَالِيمِهَا
وهيئتِهَا النّظَامِيَّةِ
ليستْ هِيَ
الّتي في الصّورةِ.
بل كلّ هذه
النّواحي
خفيّةٌ،
مستورةٌ،
ومحصورةٌ في
نطاقِ التَّكَايَا
والبيوتاتِ
والخلايا.
وإنّما الميّزات
الملموسة من
واقع حياةِ
الشعبِ التركيّ،
هي الملامح
الّتي
انعكستْ ولا
تزال تنعكس عن
تعاليم هذه
الطريقةِ
وتوجيهاتها.
فقد
رتّبْتُ
الكتابَ على
خمسةِ فصولٍ.
بدأتُ بنقل ما
تيسّر من
تاريخ هذه
الفرقة والتّطوّرات
الّتي حدثتْ
في تعاليمها
من مرحلةٍ إلى
أخرى، وذلك في
الفصل
الأوّل؛
وشرحتُ
عقائدَها وَطُقُوسَهَا،
وَمَا اسْتُحْدِثَتْ
لَهَا عَبْرَ
الْقُرُونِ من
آدابٍ
وأركانٍ ومناسكَ،
وذلك في الفصل
الثاني؛
وذكرتُ مَا وُضِعَتْ
لَهَا من
مفاهيمَ
ومصطلحاتٍ
هامّةٍ، في
الفصل
الثالث؛
ونقلتُ
تراجمَ
رجالِها في
الفصل
الرابع؛ وَأَثْبَتُّ
عُكُوسَهَا
على الحياة الاجتماعيّة
وما تمخّض
عنها من تأثيراتٍ
مختلفة على عقليّة
المجتمع
وثقافته
وسلوكه ضمن
الفصل
الخامس؛ وَضَمَمْتُ
إلَى الكتابِ
أَخِيرًا
نصَّ تَقْرِيرٍ
تَلَقّيْتُهُ
مِنْ جامعةِ
أمّ القُرى
الْكائِنَةِ
بِمَكَّةِ
المكرّمة، يُقَدِّمُ
نتائِجَ
هامّةً
أثْبَتَهَا
العلماءُ بعد
مراجعةٍ
دقيقةٍ لهذا
العمل. ثم
أتبعتُها
بفهارس
غنيّةٍ:
الأوّل منها،
لأسماء الأعلام؛
والثاني للمصطلحات
والمفاهيم
والتعبيرات
الخاصّة المبعثرة
في ثنايا
الكتاب، مع
ذكر أرقام الصفحات
الّتي وردَتْ
فيها كلاًّ
على حدة؛
والثالث،
لأسماء
الأماكن من الْمُدُنِ
والمناطق؛
والرابع،
للمراجع
الّتي
اطّلعتُ
عليها، سواء
نقلتُ منها أو
لَم أَنْقُلْ.
كلّ منها مُعَدٌّ
بِتَرْتِيبٍ
مُعْجَمِيٍّ.
وما ألوتُ
جهدًا ولا
ادّخرتُ وُسْعًا
في ركوب كلّ صَعْبٍٍ
وَذَلُولٍ
للحصول على
أدنى وثيقةٍ
تمتُّ بهذه
الفرقة،
فوقفتُ على
كثير منها؛
خاصّةً وأنَّ
معرفتي
باللّغتين الفارسيّة
والتركيّة أغْنَتْنِي
عن الحاجة إلى
غيري في دراسة
وثائقهم
الّتي غالبها
مُدَوَّنَةٌ
بِتِلْكُمَا
اللّغتين.
لأنّ الأكثريّة
العظمى
للنقشبنديّين
هم من عَنَاصِرَ
غيرِ عربيّةٍ.
احتسبتُ
لله تعالى فِي
احتمالَ
الْعبءِ
الثقيل لهذه
الدراسةِ
الهامّة راجيًا
عفوَه. ولم
يكن قصدي من
هذا الإقدامِ
إلاّ إظهارَ ما
قد بَقِيَ
خافيًا على
غالب
المسلمين من
أمورٍ خطيرةٍ
اُسْتُحْدِثَتْ
باسم الدِّينِ
ونُسبتْ إلى
الإسلام. فَأَرَدْتُ
عرضَها على
علماء هذه
الأمّة ليروا
فيها رأيَهم،
وليتمكّنوا
بذلك من تصحيحِ
الفاسدِ ممّا
اعْتَقَدَهُ
جُمْهُورٌ
مِنْ هَذِهِ
الْفِرْقَةِ،
وظنّوه من
عقائد الإسلام.
وقد
أجريتُ هذه
الدراسةَ
بأسلوب نقديٍّ
وتحليليٍّ. وهذا
لا يعني أنّي
ضربتُ عن
الموضوعيّة
صفحًا. يبرهن
على ذلك ما
نالَتْ من
القبولِ
والإعجابِ
لَدىَ
نُخْبَةٍ من
العلماءِ،
خَاصّةً منهم
الفاضل
الأسْتَاذ محمّد
نافع المصطفى
- عضو الهيئة
التدريسيّة
بجامعة الشارقة
-، الَّذي
قامَ
بِمُرَاجَعَتِهَا.
فجاءت
مُنقّحةً
خَالِيَةً من
العيوبِ
والأخْطَاءِ
اللُّغويَّةِ
بفضله. كذلك الأستاذ
الشيخ لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه، رئيس
قسم العقيدة الإسلاميّة
بجامعة أمّ
القُرَى، فلهما
الشُّكْرُ الْجَزِيلُ،
وجزاهما الله
تعالى خيرًا. فانتهتْ
تلك المسيرةُ
الطويلةُ
والجهودُ المبذولةُ
هكذا بتوفيق
الله تعالى
وأثمرَتْ بهذا
السِّفْرِ
الّذي بين يدي
القارئِ. عسى
أنْ يجدَ فيه
الباحثون
ورجالُ العلم
ضالّتَهم، كما
أرجو الله
تعالى أنْ
يجعل منه
بصيصَ نورٍ
يستضئُ به كلّ
مَنْ واجه
عَقَبةً
تصدّه عن سبيل
الله وهو لا
يقصد إلاّ
الهداية
والحق.
والله
يهدي من يشاء
إلى صراط
مستقيم.
فريد
الدين
آيدن
Feriduddin AYDIN
إسطنبول./يونيو/1997م.
الفصل
الأوّل
* النقشبنديّة؛
ظهورُها،
وتطوّرُها،
ومناطقُ
انتشارِها.
* أهم
الأسباب
الّتي عملتْ على
ظهور الطريقة النقشبنديّة.
-----------------------------
* السبب
الأول................................................................................................................................
* السبب
الثاني.................................................................................................................................
*
السبب الثالث..............................................................................................................................
* السبب
الرابع...............................................................................................................................
*
السبب الخامس............................................................................................................................
* السبب
السادس...........................................................................................................................
* التغيُّرات
الّتي طرأت
على هذه
الطريقة التركيّة...................................................................
* المناطق
الّتي انتشرت
فيها الطريقة النقشبنديّة
ودواعي انتشارها
....................................

الفصل
الأول
* النقشبنديّة؛
ظهورُها،
وتطوّرُها،
ومناطقُ
انتشارِها.
النقشبنديّة
طريقةٌ صوفيّةُ
تُنسب إلى رجل
اسمه محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ المولود
عام 717 من الهجرة،
والمتوفى سنة 791هـ.
وسيأتي ذكره
بالتفصيل في
الفصل الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
أما
لفظ »نقشبند«
فهو مصطلحٌ
فارسيٌّ مركّبٌ
من كلمتين:
إحداهما
عربيةٌ؛ وهي »نقش«
والثانية
فارسيةٌ، وهي »بند«
(بفتح الباءِ
وسكون النّون
والدال).
وكان
يُطْلَقُ اسم »نقشبند« على الرسّام
والنقّاش
الّذي يعمل
الوشي
والنمنمة على
الأقمشة في
اللّهجة التركيّة
القديمة.
والمناسبةُ
في أخذ هذه
الكلمة
وإطلاقها على
هذه النحلة واضحةٌ.
ذلك، يزعمون
أنّهم يسعون
إلى نقش محبة
الله في
قلوبهم
بالذكر المتواصل
والسلوك
المأثور من سادتهم،
ولربما هذا
اللّقب لم يكن
قد أُطلق على محمّد
البُخَاريّ
في حياته، ولا
طريقتُهُ
كانت مشهورةً
بهذا الاسم.
ذلك من ميّزات
الطرُقِ
الصوفيّة أنّها
غير مستقرة.
فتتغّير
أسماؤها من
بُرْهَةٍ إلى
أخرى. وتتبدّل
آدابها
وأركانها على
حسب ما يرى كُبَرَاؤُهَا،
وهي شبيهة
بالسيل
الجارف الّذي
يحمل الغَثّ
والسمين
عَبْرَ
مسيله، كما
سيأتي تفصيل
هذه الطبيعة
للطّرق
الصوفيّة
عامّةً وللنقشبنديّة
خاصّة في بابه
إنْ شاء الله
تعالى.
***
* أهمُّ
الأسبابِ
الّتي لها أثر
على
ظهورالطريقة النقشبنديّة
لا
شكّ في أنّ
مفهمومَ التّصوّف
لم يكن شيئًا
مذكورًا في
عهد الرسول
r،
ولا في عهد
الصحابة رضي
الله عنهم.
فلم نجد في ما
ورد عن النبيّ u،
أنّه نطق
بكلمة التصوف
ولا صحابته.
أمّا بقيّة
مصطلحاتِ الطّرَائِقِ
الصوفيّة وَآدَابُهَا
وَأرْكَانُهَا
وَمَقُولاَتُهَا
الفلسفيّة
مثل الرَّابِطَةِ
والختم الْخُوَاجَگَانِيَّةِ[1]،
واللّطائف
الروحانية،
وتعداد ألفاظ
الورد بالحصى
أو بالمسبحة
وبكميات
معينة، وحبس النفَسِ
أثناء الذكر،
والمبادئ
الأحد عشر، وفكرة
وحدة الوجود
ووحدة الشهود
وما إليها، فإن
رسول الله r
يستحيل أنْ
يكون قد أشار
إلى شيء منها.
وفي هذا برهان
قاطع على
براءة
الإسلام من
التصوّف، كما
يدلّ على أنّ
الصلة
المزعومة بين
التصوّف
والإسلام لا تقوم
على أساس من
الصحة.
أما
الّذين ربطوا التصوّف[2] بأهل
الصُّفَّةِ فلا
حجّة لهم في
إثبات ما
ادّعوه
بتاتًا. فمنهم
من تعمّد ذلك
عن حظِّ نفسٍ،
وَاتِّبَاعِ
هَوًى، ومنهم
من اغترّ
بغيره عن جهل
فاخطأ، ولم
تكن دعواهم في
ذلك إلا أنْ
يجعلوا
للتّصوّف
أساسًا من
الزهد
والتقوى. وهما
روح الإسلام ومخه،
إلا أنّه
شتّان بين التصوّف
والزهد
والتقوى، وما بينهما
بُعْد السماء عن
الأرض.
لقد
طال الجدل بين
العلماء
قديمًا
وحديثًا، وبذل
الباحثون
جهدًا بالغًا
في مسألة
اشتقاق كلمة التصوّف
ومصدر هذه
الحياة
الروحانية
ممّا يُغْني
ذلك عن إضافة
كلام آخر إلى
ما قد كتبوه
وصنّفوه في
هذا الباب،
إلاّ ما سوف
يقتضي ذكره
بالقدر
اللاّزم في مواطنه.
فَيكفي
التركيز في
هذا الفصل على
أهمّ الأسباب الّتي
قد مَهَّدَتْ
السبيلَ
لوجود ظروفٍ
مُلائمةٍ
أولدَتْ
الطريقةَ النقشبنديّة،
وذلك على سبيل
الإيجاز.
* السبب
الأوّل منها،
يرجع إلى حدث
عظيم شاهده آباء
الأتراك الأوّلون
قبل أربعمائة
وخمسين عامًا
من تأسيس هذه
الطريقة على
أيدي أحفادهم.
ألا وهو اعتناقهم
التقليديُّ
للدّين
الإسلاميّ وتصرّفهم
فيه.
إذن
ينبغي أولاً
أنْ نرجعَ إلى
هذا الْحَدَثِ
فَنَتَنَاوَلَهُ
بنظرِ الباحثِ
المدقّقِ
حتّى تتبَلور
لنا نتائجُهُ
الّتي أسفرتْ
عن اختلاقِ مُعْتَقَدَاتٍ
خطيرةٍ وظهورِ
نزعاتٍ
غريبةٍ على
الإسلام. ولكن
تبنّاها رجالٌ،
وتشرّبتْها
عقولٌ،
واعتنقَتْها
جماعاتٌ
وطوائفُ،
واحتسب في
الدفاع عنها
آلافٌ مؤلّفةٌ
من الناس
عَبْرَ
الأجيال من
هذا الشعب.
لقد
ورد في
المصادر
الّتي صنّفها
علماءُ
الأتراك بالذّات؛
أنّ الإسلام
انتشر بين
صفوف الّذين
اعتنقوه من
آبائهم
الأوّلين
بغير الوجه
الّذي انتشر بين
غيرهم من
الشعوب
والأمم.
فاختلف فَهْمُهُمْ
لهذا الدّين
بعكس ما أدركه
العربُ
وعلِموه
وتذوّقوه
وتعاطوه
عقيدةً
وسلوكًا. وهذا
أمر جدير
بالبحث
الدقيق في
جوانبه الّتي
لم يتوقّف
عليها كثيرٌ
من علماءِ
التاريخِ وخُبَرَاءِ
علمِ
الاجتماع. لقد
كان اعتناقُ
الأتراك
للإسلام
أمرًا غريبًا
من مُنْطَلَقِ
العاطفة،
وليس عن رويّةٍ.
يبرهن على ذلك
إقبالهم على
الدِّينِ
الجديد عن
طيبة نفسٍ،
دون أنْ
يتحسّسوا
معالِمَهُ.
ذلك أنّ
اختلافَ
لغتهم،
وسذاجةَ
طباعهم،
وبساطةَ
عقولهم لم
تسمح لهم
يومئذٍ
ليتأكّدوا من
أحكام هذا
الدِّينِ
وضوابطهِ
التي يحدّدُ
موقفَ العبدِ أمامَ
ربّه على
أساسِ
مَبْدَأِ
التوقيفية. ولكنّهم
لمسوا
الإسلامَ
وكأنّه نسيمٌ
يهبّ من رياض
الجنّةِ على
نفسهم
لتطمئنّ بها
اطمئنانَ
المسافر في
لحظات
نزولِهِ
العابِرِ، فاستقبلوه
كمصدرٍ
للتسلية
والعزاء
والدُّعَاءِ
والابتهال
والاتصال
بأرواح
الآباء. فما
لَبِثَ هذا
الدِّينُ
حتىّ امتزج
بعقائدهم
القديمة،
فتحوّل إلى طرائق
صوفيةٍ
وطقوسٍ
روحانيةٍ
وتَمَائِمَ وألْغَازٍ
وشعوذةٍ
وحلقاتِ ذكرٍ
موروثةٍ من مجوس
الهندِ،
وخرافات
وأساطير ما
أنزل الله بها
من سلطان.
فنشأت الطريقة النقشبنديّة
كنتيجةٍ
تمخّضت عن هذه
التطوّرات، حتّى
فَصَلَتْهُمْ
عن الإسلام
وأبعدَتْهُمْ
عن حقيقة
الإيمان
بالله
وتوحيده.
ولهذا حار المُصْلِحُونَ
ورجالُ
الإرشادِ في مكافحة
الفساد
والبدع الّتي
انتشرت بين
الأتراك والطوائف
التابعة لهم
من الأكراد
والظاظا والشراكسة
والبوشناق والأقلية
العربيّة في
العصر الحاضر،
من جرّاء
الطريقة النقشبنديّة.
لأنّ الإصلاح
يتوقّف على معرفةِ
أسبابِ
الفسادِ
وجذوره وطرق
انتشاره
وضروب كفاحه...
وإنّما بهذا
النّوع من
المعرفة
يتمكّن
الْمُصلِحُ من
كشفِهِ
وتعرِيَتِه
وقَمْعِهِ.
فما دام
المعروفون
بِسِمَةِ
العلم
والقائمون
بمهمّة
الدعوة
والإرشاد؛
مادام هؤلاءِ
أنفسهم يجهلون
مسيرةَ فساد
شعبهم
العقديّ
خلالَ
الأزمنة
التاريخية،
إذن فلا يُعقل
أنْ تكون لهم
قدرة على
تصحيح ما قد
فسد من عقائد
بني قومهم ولو
بذلوا قصارى
جهودهم
بمجرّد
النكير على
البدع
والأباطيل.
نعم،
لقد غفل كثيرٌ
من رجالِ
العلمِ عن
كيفيةِ
اسلامِ الأتراك،
ومدى
ادراكِهِمْ
لِحقيقةِ هذا
الدِّينِ في
أوّل أمرهم
معه، وعلى أيّ
دينٍ كانوا
قبل ذلك، وهل
عَلِقَتْ بهم
معتقداتٌ من
دياناتهم
السابقة
وأبقتْ أثرًا
في طوائفهم
التي دخلت تحت
حكمهم
وسلطانهم وما
إلى ذلك من
أمور...
لقد
ثبت بالدلائل
القاطعة أنّ الغالبيّة
العظمى من
الأوّلين
الّذين
أسلموا من هؤلاء
القوم لم
يدخلوا
سَاحَتَهُ عن
روّيةٍ، ولم يتلمّسوه
بتدبُّرٍ،
ولم يتلقَّوا
تعاليمه
بتعقّلٍ
وإمعانٍ.
وإنّما
أقبلوا عليه
إقبالَ
القطيع
الظمآن على
الماء العذب الفرات
وقد أضناه
العطش، فما
كاد يرتوي من
زلاله حتّى
صدّه الراعي
فسقاه ملحًا
أجاجًا؛ وهذا
يعني أنّ قبائل
الأتراك على
كثرة عددها
أقبلت على
الإسلام في
أوّل أمرها،
فجاء إسلامهم
تقليدًا أعمى لمن
كان يرأسهم
ويتـزعّمهم.
فما زال كثيرٌ
منهم يتقلّب
بين ما ورثه
من معتقداتٍ
شامانيةٍ
ونزعاتٍ
برهميةٍ
وتقاليدَ
مانويةٍ
ومزدكيةٍ. ذلك
لأنّ الأتراك
يمتازون بشدة
الانقياد إلى
ملوكهم
وزعمائهم في كلّ
دهر، سواء
أكانوا على
الحق أم على
الباطل. فلم
تتغيّر هذه
الخصلةُ فيهم
إلى يومنا
هذا. مما يدلّ
على ذلك
تمسّكهم
بزعيمهم
الّذي شارك في
القضاء علي
الدولة العثمانيّة
ذاتِ الطّابع
الإسلاميّ.
فأراد أنْ
يخلع
رِبْقَةَ
الإسلام من
أعناقهم، فلم
يزدهم ذلك إلا
محبّةً فيه
على الرغم من
اعتزازهم
بالإسلام؛ مع
علمهم بأنّه
ينحدر من
سلالة خزريّة
تشرّبت
العقيدةَ اليهوديّة
منذ قرون.
ولكن ما دام أنّه
تركيّ الأصل
فباتتْ صِلَتُهُمْ
بِهِ قَوِيَّةً
حتّى اتّخذوه
إلهًا كما قد
اتّخذوا
شيوخَهم آلهة
من دون الله.
نعم
إنّ الأتراك
استقبلوا
الإسلام في أوّل
أمرهم طيّيةً
به نفوسهم؛
فلمّا أسلم
ملكهم صتُوك
بُوغْراخان
(ت. 348 هـ.)[3] ملك
الدولة
القَرَاخَانِيَّةِ
التركيّة،
وتَسَمىَّ
بعبد الكريم.
دخلوا معه في
دين الله
أفواجًا،
وأسلموا عن
بكرة أبيهم.
هذا،
وقد أسلمتْ
جماعاتٌ
غفيرةٌ من
مختلف
الأجناس
البشريّة
عَبْرَ
التاريخ،
إلاّ أنّه لم
تَسْبِقْهُمْ
أمّة بتمامها
في الدخول إلى
حظيرة
الإسلام، ولم تظفر
بهذا الفضل
والشرف
العظيم غير
الأتراك الّذين
اعتنقوا
الإسلام في
أوّل أمرهم،
لابدّ
وقد أثار
الإسلامُ
يومئذٍ هَيَجَانًا
في نفوسهم،
ودبّتْ في
جميع مجالات
حياتهم حركةٌ
انسحبوا معها
إلى منعطفات
خرجوا بذلك عن
الخطّ
الإسلاميِّ
المستقيم دون
أنْ يشعروا
بخطورة
الأمر؛ لأنّهم
كانوا يومئذ
في بداية
الطريق،
ينظرون إلى هذا
الدِّينِ
الجديد
كعادتهم في
النظر إلى دينهم
القديم بفروق
بسيطة. ثم إنّ
ذلك التدفُّقَ
الْعَارِمَ والاندفاعَ
الْكُلِّيَّ إلى
هدي الإسلام،
لم يترك لهم
فرصةً في
الوهلة
الأولى
ليتدبّروا
حقيقة الدِّينِ
الحنيف إلاّ
قلة منهم.
فيبدو أنّهم
قد اعتنقوا
الإسلام على
همجيةٍ
وسطحيةٍ من العقليّة
المتخلّفة
والجهل
المتفشّي بين
جمهورهم وهذا
أفضى إلى التشبّث
بما كانوا
عليه في
سابقهم من
رواسب الشرك
ومخلّفات الوثنيّة
وتقاليد
الكفرة من
آبائهم
الأولين.
لمّا
نُقارن بين
السابقين
الأوَّلين من
الأتراك
ومشركي قريش
في موقفهم من
الدعوة الإسلاميّة
الأولى نجد
بُعدًا كبيرًا
بين الفريقين
في ذلك. فإنّ
الأتراك
أقبلوا على الإسلام
كالسيل
العارم منذ
أوّل تبشير
تلقّوه من
دعاةٍ لا شهرة
لهم في سجلّ
التاريخ.
بينما الكتب
حافلة بما
ابتلى به رسول
الله r من
المحنة
والأذى على يد
قومه الّذين
وقفوا في وجه
الإسلام وقوف
العدوّ
اللّدود.
واستعملوا العنف
والشدة ضد
أصحابه،
وأذاقوهم
ألوانا من التعذيب
والنكال. ولكنّ
أكثرهم في
نهاية المطاف
أسلموا لله
وأقاموا حدوده
واتخذوا دينه
نظامًا
لحياتهم؛
وضربوا من
البسالة
والبطولة
والفداء في
سبيله أمثالاً
لم يدانيهم
فيها قوم لا
قبلهم ولا
بعدهم.
ولهذا،
تشرّبت
العربُ الإسلامَ
عن حقيقته ولم
يتغيّر
تفسيرهم للدِّينِ
حتّى يومنا
هذا، على
الرغم من
ضلالة حُكَّامِهِمْ
وَسَفَهِ
زعمائهم فيما
اقتبسوه من
الأمم
الكافرة لشعوبهم
من سياسات
ضالّةٍ
وأنظمةٍ
فاسدةٍ.
أما
الأتراك،
فيبدو أنهم في
غمرة تلك الضّجّة
الّتي ثارتْ
في صفوف مُجْتَمَعِهِمْ
على أثر
الدعوة
الموجّهة
إليهم لم
يفطَنوا إلى
حقيقة ما يهتف
به الإسلام من
التوحيد الخالص
لله ربّ
العالمين.
فظنّوا أنّه دِينٌ
كسائر
الأديان،
وإنْ كان يمتاز
ببعض تعاليمه
الخاصّة
الّتي
أعجبتهم
واتفقتْ مع
طبيعتهم.
كالطهارة
وصلاة
الجماعة. لأنّ
الأتراك أشدّ
الناس
اهتمامًا
بالنظافة
وأفضلهم
نظامًا في
الحياة الاجتماعيّة،
فتأثّروا بضوابط
الإسلام
وقوانينه
وتشريعاته،
قبل أنْ
يتأثّروا
بعقائده
ووُجْدانياته.
ولهذا، لم يهتمّوا
بمسائل
التوحيد في
الخطوة
الأولى من
إسلامهم،
وإنما
الْتَهَوْا
بما شرعه
الإسلام من صلاة
الجمعة
والجماعة
والطهارة
وطاعة أولي
الأمر، وآداب
المعاشرة وما
أشبه ذلك من
أمور
العبادة، وما
يختصّ بتنظيم
الحياة الاجتماعيّة
والعلاقات
البشرية.
وبهذا،
يتبين لنا أنّه
لمّا غفل
المسلمون
الأوّلون من
الأتراك عن حقيقة
توحيد الله
تبارك وتعالى
(وهو لُبُّ
الإسلام
ومفتاح
الخلاص
ووسيلة
النجاة
والسعادة في
الدارين).
وبذلوا
اهتمامهم
فيما يظهر من
الدِّين
ويتّفق مع
طبيعتهم، وَجَدُوا
صلةً بين هذه
الأمور وبين
ما كانوا عليه
في سابق أمرهم؛
لأنّهم كانوا
على دينٍ اسمه
»الشَّامَانِيَّةُ«
فكانوا
يعتقدون في
رهبانهم
أنّهم ينفعون
ويضرّون من
دون الله،
ويشفعون لهم
عند الأرواح الإلهيّة
المهيمنة
ويتصرّفون
عنها في
الكون. وكذلك
كانوا
يتأمّلون
ويتفكّرون في
حكمة الله على
أساليب
الديانة البوذيّة
والبرهميّة.
فما
كان منهم إلاّ
أنْ استحدثوا
طرائقَ صوفيةً
ورتّبوا لها
آدابًا
وأورادًا
وأذكارًا
مزَّجوا فيها
بين أمور
أخذوها من
الإسلام. مثل
كلمة التوحيد،
واسم
الجلالة، والتحميد،
والتسبيح،
والتكبير... وأخرى
ورثوها من
دياناتهم
السابقة من
الشامانيّة
والبوذيّة
والزرادشتيّة
والمزدكيّة
والمانويّة[4] وورثوا
منها رواسبَ وثنيّة
مثل:» هوُشْ
دَرْدَمْ،
ونَظَرْبَرْقَدَمْ،
وسَفَرْدَرْوَطَنْ...
إلخ« فخلطوا
هذا بذاك بعد
أنْ
أتْخَمُوهَا بتفسيراتهم
الشاذةِ الغريبة،
ورتّبوها
ودَوَّنوها
في أسفارٍ وأقاموها
على هيئةٍ من
الآداب
والدعاء
والتعبُّدِ؛
كالرَّابِطَةِ،
وَالْخَتْمِ الْخُوَاجَگَانِيَّةِ،
والتوجُّه،
والسلوك
والرهبنة...
فكانت من أهم
نتائجها
الطريقة
التقشبندية.
*
السبب الثاني في
ظهور هذه
الطريقة: هو
الخلفيّات
التاريخية والاجتماعيّة
السائدة في
الفترة
والمنطقة اللّتين
نشأت فيهما
هذه الحركة
الصوفيّة.
لا
شكّ في أنّ
الأحداث
متسلسلة من
الماضي إلى الحاضر
فالمستقبل.
فلابدّ إذن أنْ
يكون لِماَ
وقع في سالف
العصور آثارٌ
وعواقبُ انعكستْ
على ما تلاها.
أو لابدّ أنْ
يكون لكلّ
حدثٍ أصلٌ
وسبب؛ بل
أسباب يرجع
إليها. وهذه
سُنّة الحياة.
فما
دامت الطريقة النقشبنديّة
هي حدثٌ من
الأحداث
الهامّة،
وواقعٌ أشغلَ
العقولَ
والضمائرَ
منذ حقبة تقرب
من سبعة
قرونٍ، إذن لابدّ
من أنْ
نتناولها،
فنعود بها إلي
أيّام نشوئها
من خلال
الحلقات
المتسلسلة
الّتي تربط
حاضرَها
بماضيها، وأن
نتباحث في الوقت
ذاته بظروف
المنطقة
الّتي عاش
فيها الأتراك
قبل دخولهم في
الإسلام
وبعده.
إنّ
المنطقة
الّتي كان
يسكنها آباء
الأتراك الأولون
(وهم
الهَيَاطِلَةُ)
تبدأ من تخوم
الهند شرقًا،
وتنتهي عند
ضِفاف
بحيرة
آرَالْ على
امتداد
الساحة
الواقعة بين
النهرين الشهيرين
سَيْحون
وجَيْحون.
تضمّ هذه
المنطقةُ عددًا
من المدن
العريقة، مثل
بُخَارَى
وسمرقند
وطاشكند
وفرغانة،
وأجزاءً من
بلاد خُوَارِزمْ.
أما
تاريخ
المنطقة،
فيشوبه غموض
حتّى ميلاد عيسى
u،
لأنّ أيّامَ
الأتراك قبل
الإسلام قد
خلتْ من الحركات
العلميّة والثقافيّة
والحضارية. وبذا
كانت المصادر
شحيحةً بين
أيدي الباحثين
ولم تمدّهم
بما كان عليه
الأتراك في
تلك القرون
الخالية. ولم
يؤرّخ لهم قوم
بالقدر الّذي
كتب عنهم
علماء العرب
المسلمين
كأحمد بن يحيى
بن جابر بن
داود
البلاذري[5] وأبي
جعفر محمّد بن
جرير الطبري[6]وابن
الأثير عزّ
الدين أبي
الحسن على بن
أبي الكرم
الشيباني[7] وأبي
الفداء
اسماعيل بن
عمر القرشي
المعروف بابن
كثير[8] وغيرهم.
ولعلّ
العالِمَ
الروسيَّ
فريديريك وِلْهَلْمْ
رَادْلُوفْ[9] قد
أولى الحياةَ الدينيّة
عند الأتراك
في جاهليتهم
بحديث واسع
أكثر من أيّ
باحث آخر.
فقد
ثبت من خلال
ما عثر عليه
الباحثون وما
شرحه علماءُ
التاريخ أنّ
الأتراك قد
اعتنقوا دينًا
بعد دين
عَبْرَ
تاريخهم.
وكلّما وجدوا
مساغًا
ليبدّلوا
دينهم نزحوا
من ساحته - وهم
يحملون جُلَّ
آثاره -
وركنوا إلى
دين آخر
فخلطوا
بينهما، فتقلّبوا
هكذا في أمواج
الديانات
والمعتقَدات
بصرف النظر
عما بينها من
التناقض
والتضارب
حتّى وجدوا
أنفسهم في
رحاب الإسلام
بدءًا من
النصف الثاني
للقرن الأوّل
من الهجرة النبوية.
فلم يكن
تعاملهم مع
الإسلام
مختلفا عن
تعاملهم مع دياناتهم
السابقة.
فحملوا جمًّا
من معتقَداتهم
الوثنيّة،
وتقاليدهم
الموروثة من
عهد الجاهليّة
الأولى، كما
سوف نشرحه إنْ
شاء الله
تعالى عَبْرَ
الفصول
التالية.
لقد
كان الأتراك
يقدّسون
موتاهم في
القرون الأولى
من جاهليتهم،
ويعبدونهم.
نشأ هذا
الاعتقاد وهم
على دينٍ اسمه
الشامانية،
خاصّة فإنّهم
كانوا
يقدّسون
الشامانَ.
والشامانُ
عندهم
كالعزيز أو
القِدِّيسِ
عند النصارى
فكانوا
يعتقدون أنّ
الشامان يعلم
الغيب ويتصرف
في أحوال
الجوّ؛ فَيُنَـزِّلُ
الْغيثَ،
ويُرْسِلُ
الرياحَ متى
شاء، ويمنع
الآفات، أو
يسلّط
المصائبَ
والأهوالَ
على من يشاء.
ومن
جملة ما كانوا
يعتقدونه
أيضًا في
شامانيهم:
أنّهم
يتّصلون بإله
السماء فَيَتَلَقَّوْنَ
منه الوحيَ.
أمّا من أراد
أنْ يكون لـه
حظٌّ من هذه
المكانة
بينهم، نزحَ
إلى خلوةٍ
ومارسَ
الرياضة على
الطريقة الصوفيّة
فأصبحَ
شامانَ بعد
مدة، يحذر
الناسُ من
لعنته
وينظرون إليه
نظرة الإجلال
والتوقير. فلمّا
ارتدّ هؤلاء القومُ
عن الشامانية
إلى البوذيّة،
ازدادوا تمسُّكًا
واعتقادًا برهبانهم
في الدين
الجديد، ذلك
أنّهم
تمكّنوا عن
طريق الترجمة
من الإطّلاع
على مناقب
رهبان البوذيّة
وما قيل فيهم
من كرامات
ومعجزات
وآثار. فتجمّع
في عقولهم
رُكامٌ هائلٌ من
الأساطير التي
تمكّنت من
ديانتهم، واستيقنتها
أنفسهم، حتّى
إذا أسلموا
وجدوا ضالّتهم
المنشودة
فيما سمعوا من
معجزات الرسول
r،
فاتّخذوا
منها
مُنطلقًا
ليصبغوا ما في
قلوبهم من رواسب
الشرك بصبغة
الإسلام. فلم
يلبثوا أنْ
اعتقدوا في
بعض الصالحين
كما كانوا
يعتقدون في
شامانيهم
ورهبانهم
سابقًا من
بركات وكرامات
وخوارق؛
فأقاموا على
أضرحتهم
بُنيانًا لم
يعهده
المسلمون قبل
إسلام
الأتراك.
ثم
حرّفوا مفهومَ
لفظةِ الوليِّ
في القرآن
بتفسير لم يرد
عن السلف
الصالح. إذ
أنّ الوليَّ
ليس هو الّذي
يتصرّف في قدر
الله، وينوب
عنه في إدارة
الكون، ويعلم
الغيب، وينـزّل
الغيث، ويمنع
الآفات، أو
يسلّط العذاب
على من يشاء
كما يزعمون.
وإنّما
أولياء الله،
هم الّذين قال
تعالى فيهم:
{أَلاَ إنَّ
أَوْلِياَءَ
اللهِ لا
خَوْفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ
* الّذينَ
آمَنُوا
وَكاَنُوا
يَتّقُونَ. }[10]
ولكنّهم
حرّفوا
المعنى
بتأويلاتهم
وتفسيراتهم
الّتي بنوها
على
معتقَداتهم
الموروثة من
العهد الوثنيِّ.
وهكذا نشأت
معظم الطرق
الصوفيّة على
يد الأتراك
كنتيجةٍ
للأسباب
الّتي ما زلنا
نواصل شرحها.
ومن أهمّها،
تلك الخلفيات
التاريخية الّتي
تراكمت في
عقلية هؤلاء
القوم،
وانحدرتْ
عَبْرَ
أطواره حتّى
طغتْ على
المفاهيم
القرآنية
بتفسيراتٍ
باطنيةٍ
متطرّفةٍ،
فشوّهت محيّاها،
وأذهبت
الكثيرَ من
جمالها
وطلاقتها و واقعيتها.
*
السبب الثالث في
ظهور الطريقة النقشبنديّة:
هو بُعْدُ
المسافة بين
مراكز الحكم
والعلم وبين
المنطقة
الّتي نشأت
وانتشرت فيها
الطريقة.
لمّا
انتـزع
الإسلامُ
جذورَ الشرك
وأزاحه عن
مهبط الوحي
والإلهام،
وبدأتْ
أنوارُ
التوحيد
تُشرق من
الحرمين على
أطراف
الجزيرة العربيّة،
فنبعتْ
مناهلُ
الحكمة وتدفّقتْ
من صدور أئمة
السلف
وانصبّتْ على
صفحات الكتب
بمداد
العلماء من
التابعين؛
فلم يلبث أنْ
سادت دولة
العلم في بلاد
اليمن
والعراق والشام
ومصر في مدّة
أقلّ من خمسين
سنة بعد
الهجرة
النبويّة. وفي
أثر ذلك أصبحت
كلّ منطقةٍ من
هذه البلاد
مركزًا
للعلوم
والفنون الإسلاميّة.
ولقد
كان المسلمون
الأوائل
أشدّاء على
الكفّار والمشركين
ومن كان على
نهجهم من
المستحدثين في
الدين
والمتلاعبين
بنصوصه من
خلال تأويلات
ماكرة. ولا
يُستَبْعَدُ
أنْ يكون أهل
الحلّ والعقد
منهم قد
أحبطوا أيّة
بدعة قد ظهرت
في أيّامهم
بسرعة وعنف.
فهكذا كانوا حتّى
في العهد
الأمويّ،
وكذلك في
المرحلة الأُولى
من العهد
العباسيّ. إذ
يبرهن على ذلك
موقف الخليفة
المقتدر من
حسين بن منصور
الحلاّج لمّا
علم أنّه
زنديق يتربّص
بالإسلام
ليعبث به
ثأرًا لدين آبائه
المجوس
الّذين قضى
عليهم
المسلمون، فأمر
به فقُتِلَ.[11]
وما
أنْ اتّسعت
أرض الإسلام،
ودانتْ به
فئاتٌ غيرُ
ذاتِ رُشْدٍ
وذوقٍ سليمٍ
من أهالي
المناطق
النائية عن
مراكز الحكم
والعلم
والحضارة الإسلاميّة
وخاصةً بعد
فتح خراسان
وبلاد ماوراء
النهر؛ سرعان
ما بدأ الانحراف
عن الخطِّ
الإسلاميِّ
المستقيمِ،
وصار يَدُبُّ
هذا الانحرافُ
وينتشر بين
الناس كلّما
وجدوا هرطقةً
تُذَكّرُهم
بماضيهم نزعتْ
إليها نُفُوسُهُمْ
ظنًا منهم أنّها
من صميم
الإسلام.
وربما لم تكن
الدّولةُ
يومئذ تتمتَّع
بالقدرة
والهيمنة
الكافية لكبح
جماح
المبتدعين
والمستحدثين
بسبب بُعْدِ
المسافة بين
مراكز الحكم
وبين تلك
المناطق المترامية
القاصية؛
أوربما لم يكن
لأصحاب
السلطةِ
اهتمامٌ بسلامةِ
الدينِ،
وقصرِ
تعاليمِهِ
على الكتابِ الكريمِ،
والسنّةِ
المُطهَّرَةِ
كما فهمها
سلفنا
الصالحُ
رضوان الله
عنهم.
فهذه
أيضًا من
الدواعي
الّتي أسفرت
عن انتشار
حياةٍ
روحانيّةٍ
غريبةٍ عن
الإسلام تحت
ستار الزهد
والاستغناء
عن الدنيا،
وممارسة الرياضة
والتقشّف
ولبس المسوح.
ثم تطوّرت
الأوضاعُ
حتّى ظهر عددٌ
كبيرٌ من الطَّرَائِقِ
الصوفيّة في
القرون
التالية،
وانتشر بعضها على
ساحات واسعة
فأقبل عليها
جمهور من
الناس وطاشتْ
حكمةُ
العلماءِ في
وجهها، إمّا
مخافةً أو عجزًا
أو جهلاً؛ إلى
أنْ قَوِيَتْ
صولةُ هذه
المنظمات
الصوفيّة
وتضاعفتْ قُوَّتُهَا.
وغلبت على
العاقل
والغافل
محبّتُها
بالرغم من
نبوغ شخصيّات
من أهل العلم
والفضل في تلك
المناطق من
أمثال: الإمام
الهرويِّ،
إسماعيل بن
إبراهيم بن محمّد
بن عبد الرحمن
القرَّاب [12]، وعليّ
بن محمّد بن
الحسين
البزدويِّ[13]، وشمس
الأئمّة محمّد
بن أحمد بن
أبي بكر
السرخسيِّ[14]، وأبي
حفص عمر بن محمّد
النسفيّ[15]،
والإمام
الرازي فخر
الدين محمّد
بن عمر بن
الحسين
الّتيميّ
البكريّ[16]،
والعلاّمة
مسعود بن عمر
بن عبد الله
التفتازانيّ[17] وغيرهم.
فيبدو
هكذا بوضوح،
سببٌ ثالثٌ من
أسباب ظهور
الطريقة النقشبنديّة
في بلاد »مَاوَرَاءِ
النَّهْرِ«،
ولكنّها كانت
محصورة في تلك
المناطق طوال
سنوات عديدة؛
إلى أنْ
اعتنقها
الأتراك
العثمانيّون
ومَنْ كان تحت
حكمهم من
الأكراد
والقلّةِ من
حثالة العرب
الّذين
يقطنون في
المنطقة الكرديّة.
وذلك بعد
الحملة الّتي
قام بها خالد
البغداديّ[18] لنشر
هذه الطريقة
في لباس جديد
وباستيحاءٍ من
الديانات
الهنديّة،
وبمساعدةٍ
ودعمٍ من
السلطة
العليا للدولة
العثمانيّة
كما سنشرحه في
نهاية الفصل
الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
* السبب
الرابع في انتشارِ
النـزعاتِ التصوفيةِ
عامّةً
وظهورِ
الطريقة النقشبنديّة
خاصّة في بلاد
الأتراك هو
جهلُهُمْ
بلغة القرآن
كما هي الحالة
نفسها
بالنسبة
للأكراد وغيرهم
من سائر
العناصر
العجمية.
أسلم
الأتراك وهم
لا يفهمون
شيئًا من القرآن
لاختلاف
اللّغة. ويبدو
أنّهم تلقّوا
الضرورات من
الدين عن طريق
الترجمة في
الخطوة
الأولى من
إسلامهم. أمّا
الترجمة وإنْ
كان لها أثرٌ
ودَوْرٌ في
تبليغ
الرسالات، إلاّ
أنّها قد لا
تفي بالحاجة
خاصّة لتفصيل
الأمور
الدقيقة لأنّ
فَهْمَ
المعاني
المقصودة في
مثل هذه
الأحوال
يزداد أهمّيّةً
ويتوقّف على كَفَاءَةِ
المترجم وصحّة
الترجمة. فإذا
كان المترجم
قاصرًا، أو
غيرَ ذي مهارةٍ
وحُنكةٍ في
مهمّته جاءت
الترجمة
مشوبةً
بأخطاء، ومعيوبةً
بغموض؛
فتعقّد الأمر
على المخاطب. هذا،
ولا ندري هل
كانت الترجمة
يومئذ وافية لأداء
مهمّة
التبليغ
والقيام
بأعمال
التعليم أم لا،
خاصّةً فانّ
تعليم مسائل
التوحيد
للإنسان
الّذي عاش في
ظلمات الشرك
طوال عمره،
وفوق ذلك يجهل
لغة الرسول r؛
فانّ تعليمه
من أشدّ
الأمور صعوبة
وتعقيدًا.
وإلى
جانب هذا،
فانّ الأتراك
يختلفون عن
كافة
المجتمعات
بموقفهم
السلبيّ من
اللغات الأجنبيّة؛
فتجاوز الأمر
إلى لغتهم؛
حتّى أصبحت هي
نَفْسُهَا
بعد إهمالهم
إيّاها
وتلاعبهم بها
عُرْضَةً
لنكبات الدّهر.
ولا يزالون
يعانون شتات
شملها إلى
اليوم. وربما
يرجع سببُ هذا
الموقف إلى
الروح
العسكريَّةِ
الراسخةِ
فيهم من قديم
الزمان. فإنّ
الأتراك يعتـزّون
دائمًا
بأنّهم قومٌ
مقاتلون،
وبأنّهم لم
يخضعوا لسيادة
قوم آخرين عبر
تاريخهم. فإنّ
تفاخرَهم
بأمجادِهم
وتشاغلَهم
بذكريات أيّامِ
عزّهم بصورةٍ
دائمةٍ قد
جعلهم
يحتقرون بقيّة
الشعوب وما
يميّزها عنهم
من صفات القوميّة
كاللّغة
والدين وبعض
التقاليد.
وإنما
هذا الموقف هو
الّذي جعلهم
لا يهتمّون باللّغة
العربيّة من
قديم الزمان؛
أو
بِالأَحْرَى
لاَ
يَلَقَّوْنَهَا
بالأسلوب
المتّبَعِ
عِنْدَ
الْعَرَبِ.
وإنّما قْتَصَرُوا
على حفظ قواعد
الصرف
والنحو، فاتّخذوا
العربيّة لغةَ
القراءةِ
لنصوص الدِّينِ
فحسب، دون
الكتابة
والحوار.
ويجري
تسميتها بـ »لُغَةِ
الْقُرْآنِ«
على لسان المعتـزّين
منهم
بالإسلام
تناسيًا
لصلتها
الخاصّةِ بالشعب
العربي. فقد
أسفر عن هذا
الشعور نتيجةٌ
غريبةٌ وهي
أنّ أكثر
المقرِّين
منهم بالانتماء
الإسلاميِّ
يقدّسون
اللّغة العربيّة
فلا يرون من
السهل
مزاولَتَها،
أو من الأمور
الجائزة لغير
رجال الدِّينِ!
لهذا،
قام بعض
الجهلة منهم
المنتحلين
سِمَةَ
العلم، فتصدّوا
للعبث بمسائل
الدِّينِ
واختلقوا
أنواعًا من
البِدَعِ.
فانتشرت
بسهولةٍ،
لجهل المجتمع
بلغة القرآن.
لأنّه لم
ينتبه كثير من
الناس، إلى أنّ
هذه الأمور
المستحدثة لا
تمتُّ بصلةٍ
إلى الإسلام،
أو أنها
مستورثة من
الشامانية
والبرهمية
والمزدكية
والمانوية
وغيرها من
أديانهم
السابقة
فزادت هذه
الخزعبلاتُ
انتشارًا،
وازداد الناسُ
إقبالاً
عليها إلى أنْ
استغلّها بعضُ
الصوفيّة.
فوجدوا فيها
ضالتهم،
ورتبوا على أساسها
طَرَائِقَ ومَذَاهِبَ
شتَّى مثل: البكتاشيّة،
والبنجريّة،
والبيرميّة،
والحروفيّة،
والخفيفيّة،
والخلوتيّة،
والجراحيّة،
و
اﻟْﮕُﻠْـشَنِيَّة،
والروشنيّة،
ممّا هي
جميعًا من صنع
الأتراك كما
يبدو من
أسمائِها التركيّة،
إلى جانب ما
أسّستها
أعجام الفرس
فجاءتْ من جملتها
الطريقة النقشبنديّة.
*
السبب الخامس في
ظهور الطرُقِ
الصوفيّة،
ومنها النقشبنديّة:
هي الفتن
الّتي حدثتْ
في عصر
الصحابة
وأثّرتْ على
النفوس حتّى
نشأتْ من
جرّائها بعد
القرون
فِرَقٌ
وأحزابٌ باطنيّةٌ
ومذاهبُ
غاليةٌ
عديدةٌ كلّ
حزبٍ بما
لديهم فرحون.
الفتنة
الأولى
والكبرى في
تاريخ
المسلمين لاشكَّ
هي مقتل
الخليفة
الراشد عثمان
بن عفّان رضي
الله عنه. ثم
تليها الحروب
الّتي جرت بين
عليّ بن أبي
طالب رضي الله
عنه وبين
ومعاوية بن أبي
سفيان؛ ثم
اغتيال عليّ
بن أبي طالب
رابع الخلفاء
الراشدين
رضوان الله
عليهم أجمعين.
دخل
الشقاق
بدواعي هذه
الفتن صفوفَ
المسلمين وهم
من الطبقة
الأولى من أمّة
الإسلام. بيد
أنّهم لم
يختلفوا
يومئذ إلا في
المسائل السياسيّة
والاجتهاديّة
بالاستناد
إلى الكتاب
والسـنّة،
تجمعهم العقيدة
الحنيفة إذ
ذاك، مهما تفرّقت
كلمتهم؛
فانقسموا إلى
فِرَقٍ ثلاثٍ:
الشيعة،
والخوارج،
والزهّاد
الّذين
تورّعوا
وصبروا،
واستأنسوا
بِرَوْحِ
الله وعكفوا
على العبادة
هرباً ممّا
وقع فيه غيرهم
من الطمع
والافتتان
بحطام هذه
الدنيا وملذّاتها
ومناصبها؛
كما يُقِرّ
ويعترف بهذه
الحقيقة أحد
أعلام
الصوفيّة في
عصرنا السيد
محمود أبو
الفيض
المنوفي إذ
يقول: »وأمّا
سبب شيوع
التصوف في الإسلاميّة،
فهو أنّه لمّا
حصل الخلاف
على الخلافة
والنـزاع بين
عليٍّ
ومعاويةَ، ثم
الخلاف بين
بني أُمَيَّةَ
وبين
العباسيّين؛
قد صارت
الخلافة
ملكًا عضوضًا
وسلطانًا
يتنافس عليه
أهل النفوس
الضعيفة
المحبّة
للدّنيا
ومتاعها
الزائل،
ترفّعَ البقيّة
المخلصة
الباقية من
الصحابة
والتابعين عن
إيثار ما يفنى
على ما يبقى،
ورجعوا إلى
أنفسهم
عاكفين على
مدارسة
الكتاب
الكريم.«[19]
وإذا
كان لموقف كلّ
قرفةٍ من هذه
الفرق الثلاثِ
شأنٌ انطلقت
منه فئاتٌ
غاليةٌ ممّن
جاء بعدها فإنَّ
صوفيةَ كلّ
عصرٍ قد
تشبّهوا
بالزاهدين
السابقين من
أمثال: أبي
عبد الله
سفيان بن سعيد
بن مسروق
الثوريّ
الكوفيّ[20]؛ وعبد
الله ابن
المبارك
المروزيّ وهو
تركيّ الأصل[21]؛
والفضيل ابن
عياض بن مسعود
التميميّ
اليربوعيّ[22]؛وأبي
محفوظ معروف
بن فيروز
الكرخيّ[23]؛ وأبي
نصر بشر بن
الحارث بن عليّ
بن عبد الرحمن
المروزيّ
الحافيّ[24]؛ وأبي
الحسن سَرِيّ
ابن المغلِّس
السقَطيّ[25]؛ وأبي محمّد
سهل بن عبد
الله بن يونس
بن عيسى
التسْتَرِيّ[26]؛ِّ ومن
كان على نهجهم
من الورع
والتقوى رحمة الله
عليهم أجمعين.
أنتحل
صوفية العراق
مذهبَ هؤلاء
الصالحين بعدهم
في القرن
الثاني من
الهجرة.
وصوفيةُ
العراقِ جلُّهم
من أصولٍ
مجوسيّةٍ من
العنصر
الفارسيِّ،
لا صلةَ لهم
في حقيقة
الأمر
بالزاهدين
المذكورين
سابقًا، وإنّما
انتحلوا
أسلوبهم في
الإعراض عن
الدنيا
بظاهرهم وهم
يتَبَنَّونَ
أغراضًا
خطيرةً في
باطنهم.
دفعتهم
النـزعة
الشعوبيّة
إلى هدم الدِّينِ
الحنيف بدسّ
سموم الشرك في
العقيدة الإسلاميّة،
ولكن بأسلوبٍ
أكثر خبثًا
ومكرًا
ودهاءً وهو
الأسلوب
الصوفيّ بخلاف
ما كان عليه الزنادقة
من الشعراء
والأدباء ذوي
الأصول الفارسيّة
بإيقاع
الفتنة بين
المسلمين
وتشكيكهم، عن
طريق تصوراتٍ
فلسفيةٍ
ظاهرة
المعالم. كعبد
الله ابن
المقفّع[27]؛ وأبي
عبيدة معمّر
بن المثنّى[28]؛وأبّان
بن عبد الحميد
بن لاحق بن
عفير الرقّاشي[29]؛ وأبي
نوّاس الحسن
بن هناء بن
عبد الأوّل بن
صباح[30]؛ وأبي
العَتَاهِيَة
إسماعيل بن
قاسم بن سويد
بن كيسان[31]. كان
هولاء
الشعوبيون
مجاهرين
بأفكارهم وتصوّراتهم
بخلاف
الصوفيّة.
أمَّا
الصوفيّةُ،
فإنَّ
السرِّيَّةَ
الّتي كانت
أعمالُهم
تتوارى
بقناعِها،
تجعلُهم في
أمانٍ من أيِّ
شكٍّ قد يثورُ
حولَهم؛ بل
غالب الناس
كانوا
يعظّمونهم
ويعدّونهم من
أصحاب
الفضائل
والكرامات
لما يرون من إعراضهم
عن زينة الحياة
الدنيا وطيّباتها.
لأنَّ
كراهيةَ
نِعَمِ اللهِ
كانت هي القسطاس
الّذي
يُقَيِّمُ
الناسُ به
مستوى الفضيلة
والسموّ
الروحيِّ
والأخلاقيّ
يومئذ.ِ.
هكذا
استطاع صوفيّةُ
العراق منذ
بداية ظهورهم
أنْ ينجحوا في
تشويه الوجه
المشرق
للإسلام بهذا الأسلوب
الدسّاس، على
حين غفلة من
المسلمين الّذين
هجمت عليهم
الفتنُ يومئذ من كلّ
حدب وصوب وهم في
وسطٍ من
الفوضى من
أمرهم. فاستمرّت
حِيَاكَةُ
الدَّجَلِ وَالْكَذِبِ
على لسان
السابقين من
أهل الزُّهْدِ
وهم برآء من
الصوفيّة
وضلالاتهم،
حتّى أسلم
الأتراك.
فما
لَبِثَ أنْ بَرَزَتْ
جماعةٌ حَشْوِيَّةٌ
بينهم من أهل
خُرَاسَانَ وبلاد
»مَاوَرَاءِ
النَّهْرِ«.
فزادوا على
هذه الأكاذيب
والدَّجَلِيَّاتِ
ما تمجّه
الأسماعُ. ثم
تطوّر منها فنٌّ
من فنون
التحريف
والتبديل
والتضليل،
وهو ما يسمى
بمناقب
الأولياء.
وأخطر
مَا وَضَعَهُ
الصُّوفِيَّةُ
من الأمور
الهدَّامَةِ
للدِّينِ
الحنيف: بدعةُ
»السِّلْسِلَةِ«
الّتي
اختلقها
بعضهم في عصور
الظلام،
وربما ليجعل
منها صلةً يدَّعي
بها الانتسابَ
والانتماءَ
إلى الصحابة
والتابعين
ليستغلَّ بها
ضمائر الناس
وليتدرَّجَ
بمساعدتهم
إلى تحقيق ما
هو من ورائه.
فسيأتي شَرْحُهَا
إنْ شاء الله
تعالى. وهي
أيضًا مِنْ صُنْعِ
زَنَادِقَةِ
الْعَجَمِ.
اغترَّ بهم
الصُّوفِيَّةُ
والمشعوذون من
قدماء
الأتراك لِجَهْلِهِمْ.
*
السبب السادس في
ظهور الطريقة النقشبنديّة:
هي الدَّواعِي
النفسيَّةُ
المتخفِّيَةُ
للأتراك من
وراء الصراع
التاريخيِّ
الّذي طالما
يجري بينهم
وبين العرب
على احتكار
الإسلام
واستغلاله في
كسب المصالح السياسيّة.
إنّ
من أهمّ
ميّزات
الأتراك،
أنّهم لا يُذْعِنُونَ
لسيادة مَنْ
ليس من قومهم.
ولا ينقادون
إلى رئاسة
أجنبيٍّ. وكأنّهم
قد جُبِلوُا
على
الأنِفَةِ
والحميَّةِ وَحُبِّ
الرياسة
والسياسة. قد
يختلفون فيما
بينهم أشدَّ
الاختلاف.
ولكن سرعان ما
يلتفُّون حول
الرجل القويِّ
من بينهم،
وينهضون بأمره
في وجه العدوّ
نهوض الرجل
الواحد. والغريب،
أنّ
المُقِرَّ
منهم بالانتماءِ
الإسلاميِّ،
ينتصر للكافر والفاسق
من بني جلدته
في وجه المؤمن
التقيِّ من
غير قومه أو
من غير حزبه.
يبرهن على هذه
الحقيقةِ ما
أخذتْهُ
الحكوماتُ التركيّة
من
الأُهْبَةِ
في سياستها
ضدَّ
المُعتـزّين
بالإسلام في
الداخل
والخارج وباستمرار.
ومن آخر عكوسِ
هذه
السياسةِ،
قيامُها
بمساعدة
المنشقّين من
العناضر ذات
الأصول التركيّة
في أفغانستان
ضدّ حكومةِ
(طالبان)[32]
الإسلاميّة
عام 2001م. إنّ
الحكومةَ التركيّة
لم تقم بدعم
الأتراك
الأُزبك في
أفغانستان لِمُجَرَّدِ
ماكانت حكومةُ
(طالبان)
تمارس
التعسُّفَ
والتطرُّفَ
في سياستها،
بل كان ردَّ
فعلٍ من مُنطَلَقِ
العصبيّة التركيّة
انتصارًا
للأتراك
الأفاغنةِ
ضدَّ خصومهم البشتون.
هذه
الخصلة
جعلتهم
ينافسون
العرب في
السياسة
والسيادة،
ويصارعونهم
على السلطة في
الوهلة الأولى
من إسلامهم.
غير أنّ
الأتراك قد وجدوا
أنفسهم
دائمًا أمام
عَقَبَتَين
في وجه العرب.
العقبة
الأولى: هي
اللّغة العربيّة.
لأنّ العربيّة
غلبت على جميع
لغات الشعوب
الّتي
اعْتَنَقَتِ الإسلامَ
بحكم كونها
لغة القرآن
والعلم
والحضارة. فلم
يستقم اعوجاج
اللّغة التركيّة
تحت هذه
الغلبة على
امتداد تاريخ
الأتراك المسلمين
وخاصّةً لمّا
زادت اللّغةُ الفارسيّة
مِنْ
حَيْفِهَا على
اللّغة التركيّة
وزَاحَمَتِ
فِيهَا
آثَارَ العربيّة،
فَقَدَتِ التركيّة
أَهَمِّيَّتَهَا
حتّى اختنقتْ
وتفرقتْ إلى
لهجاتٍ، بل
إلى لغات
مختلفة. ويشهد
اليوم على هذه
الحقيقة
استخدامُ
الترجمة في
الحوار بين
رؤساء بعض
الدول التركيّة
في الملتقيات
والاجتماعات
الدولية. مثل
تركيا
وكازاخستان.
كما لا تتّفق
أبجديّات هذه
الدول بخلاف
العرب. فإنّهم
بالرغم من
شتات شملهم
والشقاق
الّذي بينهم
على الصعيد
السياسيِّ
والدوليِّ،
ما زالوا
يتكلّمون
بلغةٍ
واحدةٍ،
ويستخدمون
أبجديّةً
واحدةً.
وإذ
نعود إلى
موضوع النقشبنديّة،
فإنّ هذه
الطريقة
أسّسها
الأتراك قبل
سبعة قرون قي
مدينة
بُخَارَى،
وهي عاصمة
وطنهم القديم.
ولا شكّ أنّهم
أسّسوها
لتكون نسخةً
أخرى
للإسلام، ليتميّزوا
بها عن العرب
والفرس في
عبادة الله.
فاتّخذوا أبا
بكر الصديق
رضي الله عنه
رمزًا لطريقتهم،
كي يُلمحوا
بذلك أنّهم
على نقيضٍ
للفرس الشيعة،
كما اتّخذوا
اللّغة الفارسيّة
كَلُغَةِ
العبادة في هذ
الدِّينِ المُخْتَلَقِ
لِفَقْرِ
لُغَتِهِمْ
وعدمِ
اتِّصَافِهَا
بالكفاءَةِ
اللاَّزِمَةِ
لاسْتِقْبَالِ
مَا جَاءَ به
القرآنُ مِنْ
مَفَاهِيمَ
عَالَمِيَّةٍ.
ووضعوا لهذا
الدِّينِ
آداباً ومبادئَ
تختلف تمامًا
عن أركان
العبادة
والدعاء في الإسلام،
بُغْيَةَ أنْ
يستقلّوا
بوُجْهَة
نظرهم إلى
الإسلام بخلاف
ما يفهمه
العرب.
أما
العقبة
الثانية:
الّتي
يعانيها
الأتراك هو
مفهوم الديِّنِ.
ومع أنَّ
الإسلامَ دِينٌ
عَالَمِيٌّ
لا يجوز أنْ
يستغلَّهُ
شخصٌ أو قومٌ
لِيُتَاجِرُوا
به أو لِيُطَبِّعُوهُ
في أشكالٍ
خاصَّةٍ، كما
لم يفكِّرْ بِهِ
الْعَرَبُ، - ولم
يتمكّنوا من
ذلك لو أرادوا
أنْ يحصروه في
نطاق قوميّتهم
- إلاَّ أنّهم
كانوا ولا
يزالون أكثرَ
فَهْمًا
لمعاني
القرآن، ولا غَرْوَ
أنّه نزل
بلغتهم. أمّا
الأتراك
وتُبَّاعُهُمْ
من أقليّاتٍ
عجميةٍ
فإنّهم لا
يفهمونه إلا
عن طريق الترجمة
الكتابيّة أو
بالاستماع
إلى علمائهم. ولا
شكّ أن لِهَاتَيْنِ
العقبتين تأثيرًا
عظيمًا على
أحاسيسهم،
وإن لم يجهر
به عامَّتُهُمْ.
ولا يُستَبْعَدُ
أنْ يكون في
باطنهم ما قد
يُثِيرُهُمْ
بدافع هذين
الأمرين حتّى
يتخلّصوا من
تأثير العرب
بلغةٍ قويّةٍ
ودِينٍ مُسْتَقَلٍّ
دونما
ارتدادٍ عن
الإسلام،
ولكنْ مختلفٍ
عن إسلام
العرب!
لقد
قام البرهانُ
على هذه
الحقيقةِ بصورةٍ
لاَ مجالَ
للشَّكِّ
فيها، وذلك
باعتراف رَجُلٍ
يُعظّمه
ملايينُ
النّاسِ في
تركيا اسمه
فتح الله
جولان، أدلى
في مقالٍ له
نُشِرَ في
صحيفة »الزَّمَانِ« التركيّة،
جَاءَ فِيهِ
بالحرفِ
الواحد:
عَرَفَتِ الدُّنْيَا
(أَيْ
الْبَشَرِيَّةُ):
»إسْلاَمَ
الْعَرَبِ
والْعَجَمِ،
فَلَم
يَقَعَا
مَوْقِعَ
الإِعْجَابِ
مِنْهَا،
وَلَكِنَّهَا
سَتَتَعَرَّفُ
عَلَى
إسْلاَمِ
الأَتْرَاكِ
وَسَوْفَ
يُعْجِبُهَا«.[33]
لا
شكّ أيضًا أنّ
الأتراك (
ونعني بهم
بقايا
العثمانيّين
من أصحاب
السيادة في
تركيا اليوم)
قد عملوا الكثيرَ
لتحرير لغتهم
من قيود العربيّة
والفارسيّة،
ولكن لم
يتمكّنوا من
ذلك. كما لم
يتمكّنوا من
توفير أسباب
الاستقرار
لها. فانّ
ظهورَ الطُّرُقِ
الصوفيّة هي
في الواقع من
نتائج هذه المُنْطَلَقَاتِ
العصبيّة
والعرقيّة، وانعكاسٌ
لأغراضٍ قوميّةٍ
وعنصريّةٍ.
خاصّة
الطريقة النقشبنديّة،
فإنّ في ثنايا
آدابها
ومعاملة
أتباعها
وانتمائهم أماراتٍ
ومَعَالِمَ
تُنْبئُ عن
حقيقةِ
منْطَلَقَاتِ
هذه الطائفة
وأغراضِهَا العصبيّة
القوميّة في
صورٍ غيرِ
خافيةٍ على
أهل البصيرة.
ولربما هي من
أقدم
أسبابها؛ وفي
ذلك شواهدُ
عديدةٌ،
حسبنا
الاستدلال بواحد
منها:
نقل
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ[34]
بطريق
الرواية عمن
تُنسب إليه
الطريقة النقشبنديّة
وهو محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ[35]. نَقل أنّه
قال: »نمتُ
ليلةً فرأيتُ
الحكيمَ آتا
قدّس سره.
وكان من أكابر
مشائخ التُّرْكِ
وهو يوصي بي
درويشًا.
فلمّا
انتبهتُ
بَقِيَتْ
صورةُ الدرويشِ
في مخيِّلَتي.
وكانت لي جدةٌ
صالحةٌ
فقصصتُ عليها
هذه الرؤيا،
فقالتْ: سيكون
لك يا ولدي من
مشائخ التُّرْكِ
نصيبٌ«[36]
إنّ
هذه الكلمات،
تُعَبِّرُ عن
حقيقةِ ما قد
تبنَّتْ هذه
الطريقةُ التركيّة
عَبْرَ
تاريخها
بصورةٍ
ملخّصةٍ، وقد
تحقّق ذلك.
وهو أن
المجتمعَ
التركيَّ قد
حدّدَ وجهةَ
نظرهِ في
الإسلام منذ
القديم
بتفسيره
الباطني المتمثّلِ
في تعاليم هذا
المذهب
الصوفيّ على
وجه الخصوص
وبموقفه
العصبيِّ
(إلاَّ مَنْ
عَصَمَهُ
اللهُ منهم،
وقليل مّا هم!).
***
* التَّغَيُّرَاتُ
الَّتِي طَرَأَتْ
عَلَى هَذِهِ
الطَّرِيقَةِ
إنّه
يُستَبْعَدُ
أنْ تكون
الطريقة النقشبنديّة
قد اشتهرت
بهذا الاسم في
حياة محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ
الّذي تُنْسَبُ
إليه الطريقةُ.
لأنّ الطرقَ
الصوفيّةَ
إنما تُدعى
بأسماء مؤسِّسيها
بعد موتهم
عادةً. وهذا
يُعتَبَرُ من
جملة الإشارات
الّتي تُنبئ
عن تغيُّراتٍ
عديدةٍ طرأت
على الطريقة النقشبنديّة،
وتدلّ في
الوقت ذاته
على أنّ
الطرقَ
الصوفيّةَ
عامّةً والنقشبنديّة
خاصّةً، لا
تقوم آدابُها
وأركانُها
وطقوسُها على
نصوصٍ من
الكتاب
والسنّة. بل وَإنْ
كانت لها أصولٌ
ومبادئُ، فإنّها
في الحقيقة
ليست إلا مِنْ
صُنْعِ الرُّوحَانِيِّينَ
الّذين
استطاعوا أنْ
يَفْرِضُوهَا
على أتباعهم
بحكم شهرتهم.
ثم اقتنع بها
المريدون
والمفتتنون
مِمَّنْ حولهم
فاتّخذوها
مناسكَ لهم،
وعملوا بها
حتّى ظنّ معشرٌ
مِنْ رَعَاعِ
الناس أنّها
فرائضُ أو سننٌ
من صميم الدِّينِ.
ثم
لم يلبث أنْ
تولّى رئاسةَ
الطريقة
رِجَالٌ روحانيّون
آخرون، زادوا
على ما
اختلقهُ
السابقونَ من الآداب
والشروط.
فزادوا عليها
تارة، وحذفوا منها
تارة إذا
زيّنتْ لهم
أنفسهم ذلك. وهكذا
جرت عادتهم من
القديم إلى
اليوم. فكان
لهذه الآداب
أثرٌ كبيرٌ
فِي نفوسِ
الْهَمَجِ
الْمُلْتَفِّينَ
حَولَ شيوخ النقشبنديّة
بما اثارتْ في
عواطفهم من
الشَّوْقِ
إلى هذه
الطّرِيقةِ،
وَدَفَعَتْهُمْ
إلى بثِّ
الدِّعَايَةِ
لَهَا،
وَجَزْبِ
مزيدٍ من
النّاسِ
إليها. فكلّما
استفاد
الرّوحانيّونَ
من حصيلةِ ما
ابتدعوه،
ازدادوا بذلك
حُنْكَةً
وتحقّقوا من
أنّهم كلّما
أشغلوا العقولَ
بتكثيف
الطقوس
والإكْثَارِ
مِنَ الآدابِ
ازدادوا
هيبةً
ومحبّةً
وَشُهْرَةً
وذَهَبَتْ صِيتُهُمْ.
إلاَّ أَنَّ
مُحَاوَلَةَ
تَطْوِيرِ
الطَّرِيقَةِ
هَكذا
غَيَّرَتْ
مجراها من
فترةٍ إلى
أخرى،
وكَسَتْهَا
لباسًا جديدًا
حَتّى وصلتْ
بها إلى ما هي
عليها اليوم.
وجدير
بالإشارة أنّه
لا يتأتّى ذلك
إلا لمن يمتاز
بالمهارة
واللّباقة في
إقناع النفوس
ويملك زمام
الآلاف فيتمكّن
من إلقاء
هيبته
ومحبّته في
قلوبهم، بحيث
لا يجدون
مساغًا ليتساءلوا
عن حقيقة هذه
المستحدثات
والبدع؛ وهل
لها أساس من
الدين أم لا؟
إذ أنّ لِبعض
شيوخ الطريقة
فنونًا من
الحيل يسحرون
بها حتّى عقول
العلماء، فضلاً
عن الجهلاء؛
كما قد نجحوا
في الاستيلاء
على الشريف
الجرجانيِّ[37] بالرغم
من باعه
الطويل في
العلوم، وَكذلك
ابن عابدين
(فقيه بلاد
الشامِ)، إلاّ
أنّ هذه الصفة
لا تشمل جميع
شيوخ الصوفيّة.
بل إنّ بعضًا
آخر منهم لم
يعرفوا
الخدعة في
حياتهم ولم
يتصوّروها
لحظة - ليس ذلك
لِمَا فيهم من
السمو الروحيِّ
والأخلاقِ
العاليةِ،
والسلوك
الرفيع، بل
لاستغراقهم
فيما يسمّونه »العشقَ
الإلهيَّ«
وربما هي حالة
من الجنون.
لذلك مَنْ
رآهم من
الجهلة، أو مِنْ
ذوي العاطفة،
أعجب بهم،
واغترَّ بما هم
فيه من الغياب
والتقشُّف،
والعزلة عن
الناسِ،
والشعوذة،
وإهمال أمور
الدنيا. فظنّ
المعجِبون
بهم أنّهم
أولياء الله
وخاصّته،
ووصفوهم
بالعِفّة
والقناعة
وعزّة النفس،
فبالغوا في
توقيرهم
وتعظيمهم،
حتّى أسندوا
إليهم ما لم
يكن فيهم من
الفضائل
والبركة
والكرامة. كلّ
ذلك من جهل
الناس بمفهوم
الزُّهْدِ وَالتَّقْوَى.
أمّا في
الحقيقة فليس
لهما صلة
بالعزلة من الناس،
وإهمال أمور
الدنيا،
وحالاتِ
الجنون الّتي
يصفها العامة
بالاستغراق
والعشق الإلهيِّ.
خاصّة فان
أكثر شيوخ
الطريقة النقشبنديّة
يتّصفون
بالطبيعة
الجامدة،
والصمت الطويل،
والمسكنة
والطأطأة. تلك
عادتهم تسري
فيهم عبر
الأجيال
خلفًا عن سلف.
لأنّ من أراد
منهم أنْ
يختار لـه
خليفةً من بين
خاصّته آثر
منهم المتميّز
بالصفات
المذكورة.
أمّا من كان
على نقيض تلك
الصفات فلا
حظّ لـه من
هذه الفرصة
غالبًا. وهذا
ما قد أفضى
إلى اغترار
كثير من جهلة
الناس
بالمظاهر التقليديّة
للشيوخ النقشبنديّة.
فهابوهم حتّى
الْتَبَسَتْ
عليهم تلك
الصورة
الجامدة
بالوقار
والسكينة. كماَ الْتَبَسَ
عليهم الحق
بالباطل
لاستسلامهم لهذا
التأثير،
واقتناعهم بكلّ
ما قَرَعَ سَمْعَهُمْ
من هفوات
الشيوخ وخُزَعْبَلاَتِهِمْ.
وهذا ما زاد
في جرأة الرُّوحَانِيِّينَ
حتّى تصرّفوا
في أمور
طريقتهم
بالذات، كما تصرّفوا
في تعاليم
الإسلام
بالتأويل
والتحريف.
ومما
يؤكّد أنّ
الطريقة النقشبنديّة
تعرّضت للعبث
( وكل ما فيها
لون من ألوان
العبث -،
فزيدت فيها
شعارات
ومقولات
وتفسيرات
وتعدّدت فيها
هرطقات وبدع
ومستحدثات مع
الزمان)؛ أنها
تسمّت من
بُرهةٍ إلى أخرى
بأسماءٍ
مختلفةٍ كما
يشهد على ذلك
رجلٌ من أكابر
المتأخّرين
لهذه الطريقة
وهو محمّد بن
عبد الله
الخانيّ[38] مؤلّف
كتاب »البهجة
السنيّة في
آداب الطريقة النقشبنديّة«.
يُقِرُّ
المؤلِّفُ
بهذه الحقيقة
مستدلاًّ
بعبارة نقلها
من كتابِ »الحديقة
النديّة في
آداب الطريقة النقشبنديّة«
لمؤلّفه محمّد
بن سليمان بن
مراد بن عبد
الرحمن
العبيديِّ
البغداديِّ[39] جاء في
مستهلّ هذا
المقطع: » اعلم أنّ
ألقاب
السلسلة
تختلف
باختلاف
القرون...إلخ«[40] فبلغ ما
ذكره
المؤلفان من
هذه الألقاب
الّتي اختلفت
عَبْرَ
القرون إلى
ثمانيةِ
أسماءٍ
متباينةٍ وهي:
الصِّدِّيقِيَّةُ،
وَالطَّيْفُورِيَّةُ،
وَالْخُوَاجَگَانِيَّةُ،
وَالنقشبنديّة،
وَالأَحْرَارِيَّةُ،
وَالمجدّديّة،
وَالْمَظْهَرِيَّةِ،
وَالخالديّة.
ومن
اختلاق بعض
الشيوخ في هذه
الطريقة: أنهم
استحدثوا
جملةً من
المفاهيم
والمعتقَدات
الّتي جعلت من
هذه الطريقة
دينًا
مستقلاً عن
الإسلام، وهي الرابطة،
وَالْخَتْمُ الْخُوَاجَگَانِيَّةُ،
وبدعةُ الذِّكرِ
(مَعَ حَبْسِ
النَّفَسِ)،
وعدّ الأوراد
بالحصى
وبإعدادٍ معينةٍ،
وملاحظة
الصورة
الفتوغرافية
لشيخ الطريقة،
والاتصال
بموتى
الروحانيّين
ما يسمّونه »الأوسِية«[41] وبعضٌ
من آداب
المريد مع
شيخه عندهم[42].وتصوّراتٌ
فلسفيةٌ
استورثوها من
الأديان السالفة،
فقرّروها
شيئًا فشيئًا
عَبْرَ القرون؛
كفكرة »وحدة
الوجود«
و»وحدة
الشهود«
والحلول
والاتحاد
والفناء
والبقاء؛
وغيره كثير ومفصّلٌ
في كتبهم كما
سيأتي شرح هذه
الأمورِ وتحليلها
في الفصول
الآتية إنْ
شاء الله.
وكلّ
ذلك، وضعوه لتمكين
هيبة الشيخ في
نفوس الناس من
المريدين
وغيرهم،
لتذلّ لـه
رقابهم،
وتخشع لعظمته قلوبهم؛
على أنّه ينوب
عن الله في
أرضه،
ويتصرّف في
ملكه وخلقه،
حتّى أصبح
كثير من الجهلة
العوامّ لا
يكادون
يصدّقون أنّ
الشيخ أيضًا
يبول ويتغوّط
ويمارس الجنس
كأحد من
الناس.
***
*
المناطق
الّتي انتشرت
فيها الطريقة النقشبنديّة
ودواعي
انتشارها.
إنّ
هذه الطريقة
لم تحظَ باهتمامَ
الناس من أيّ
شعبٍ في أرض
الإسلام
بالقدر الّذي
نالتْ من الإقبال
بين الأتراك.
ولا عجب أنهم
مختلقوها
ومؤيّدوها
منذ البداية إلى
اليوم.
فانتشرت في
المناطق
الّتي قام
فيها حُكْمُهُمْ،
واستحكم فيها
سُلْطَانُهُمْ
بعد انهيار
الدولة العبّاسية
وظهور
السلاجقة
الأتراك على
مسرح التاريخ.
يقول
الشيخ قسيم
الكُفْرَويّ
في رسالة أعدّها
باللّغة التركيّة
تحت عنوان »النقشبنديّة
ظهورها
وانتشارها«[43]
وكان الشيخ
قسيم هذا، من
أعلام الْمُثَقَّفِينَ
ومن أشهر
مشائخ هذه
الطائفة في
تركيا. يقول في
افتتاحية
كتابه: »إنّ
القدماء من
شيوخ النقشبنديّة
كانوا من
أهالي
تركستان وما وراء
النهر. ولذلك
تسرّبت
عاداتُ هذه
المنطقة
وتقاليدُها
إلى الطريقة النقشبنديّة«.
فإذا
أنعمنا
النظرَ في هذا
المقال وجدنا
فيه ثلاثَ نِقَاطٍ
هامّةٍ
وجديرةٍ
بالدراسة
والتحليل.
النقطة
الأولى: كون
الطليعة من
رجال هذه النحلة
قد ظهروا في
منطقة
تركستان وهو
الموطن الأصليّ
للأتراك.
والنقطة
الثانية: أنّ
الطريقة قد
امتصّتِ
الكثيرَ من
مخلَّفات
الأديان
والعادات والتقاليد
المتّبَعَةِ
في هذه
المناطق
عَبْرَ القرون.
والنقطة
الثالثة: أنّ
الطريقة قد
انتشرت في
الوهلة
الأولى على
ساحةِ المنطقةِ
نفسِها بحكم
ظهور مؤسِّسِهَا
في تلك
النواحي.
إذًا،
نستطيع أنْ
نقول إنّ
الطريقة النقشبنديّة
قد بدأت في
توسّعها من
الموطن
الأصليِّ
للأتراك منذ
أيّام ظهورها.
ثم انتشرت في كلّ
ساحة قام عليها
حكمهم بدايةً
من بلاد ما وراء
النهر، وخُرَاسَان،
فمرورًا بالمناطق
الهنديّة. ثم
بعد تقدُّمِ
السلاجقة إلى الأناضول
لأوّلِ مرّةٍ يَمَّمَتْ
الطريقةُ
وجهَهَا إلى
هذه الأرض
الّتي إستقرّ
الأتراكُ
فيها وأقاموا
عليها
الدولةَ العثمانيّة
بعد أنْ زالتْ
دولةُ بني
سلجوق.
جاء
في بعض
المصادر
للباحثين
الأتراك أنّ
الشيخ عبد
الله الإلهي
هو الّذي قام
لإوّل مرةٍ
بنشر الطريقة النقشبنديّة
في المملكة العثمانيّة
ما بين 1481-1512م. وقام
بمحاولة
التأليف بين
الطريقة النقشبنديّة
والطريقة
الملاميَّة
وعاش في عهد
السلطان
بايزيد
الثاني بن
السلطان محمّد
الفاتح، ثمّ
تابعه حَيْدَرْ
بَابَا في نشر
هذه الطريقة
أيّامَ
السلطان
سليمان
القانوني. مع
هذا يقول
الدكتور رشاد
أوﻧﮕﻮران، »لقد كان من
المعروف - إلى
الآونة
الأخيرة -: أنّ الطريقة
النقشبنديّة
دخلت منطقةَ
آناضول لأوّل
مرةٍ على يد
مُلاّ إلهي،[44] كما كان
من المعروف
أيضًا؛ أنّ
أوّل تكيةٍ للنقشبنديّين
في هذه الساحة
هي الّتي
بُنيتْ في
سِيماوْ من
ضواحي مدينة
الكُدَاهِيّة؛
إلاّ أنّ حسين
حسام الدين
أفندي
المعروف
بعبدي ذاده قد
سجّلَ في
تاريخه أنّ
أوّل تكيةٍ
للنقشبنديّين
في البلاد العثمانيّة
هي الّتي
بُنيتْ في
مدينة آماسيا
عام 1404-1405م.
باسم تكيّة
محمود شلبي؛
واحتلّ منصبَ
المشيخة
لأوّل مرةٍ في
هذه التكية
الخواجه ركن
الدين محمود البُخَاريّ
الّذي كان من
خلفاء شاه
نقشبند«[45]
على
الرغم من دقّة
أسلوب الباحث
رشاد أوﻧﮕﻮران،
فقد وردت
كلماتٌ لـه
يدّعي فيها ما
يؤدّي إلى
الشكِّ من
حقيقة كلّ ما
جاء على لسانه
حول الطريقة النقشبنديّة.
وهذه كلماته:
»إنَّ
الطريقة النقشبنديّة
الّتي أسّسها
الشيخ بهاء
الدين
نقشبند، لها
سلاسلُ، تتصل
عن طريقها
بأبي بكرٍ
وعليٍّ«[46]
يستند
الدكتور رشاد
في هذا
الإدّعاء
الجريء إلى
أربعةِ
مراجعَ من كتب
المتأخّرين؛
وهي في حدِّ
ذاتِها
خاليةٌ من
القيمة العلميّة
في مثل هذا
الإسناد.
وبالنسبة
لمزعمة »سلسلة
السادات«،
فسنشرحها في بداية
الفصل الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
ورد
في »موسوعة
إسطنبول«[47] - مادةِ النقشبنديّة
- أنّ هذه
الطريقةَ
بدأتْ تدبُّ
في صفوف
المجتمع
العثمانيّ
منذ أواخر عهد
السلطان محمّد
الفاتح.
واستقى
كَاتِبُ هذهِ
المادَّةِ
أكرم إيشن، من
كتابٍ اسمه:Otman Baba Velâyetnâmesi.
وأفاد
فيه أنّه كانت
للنقشبنديّين
في تلك
المرحلة تكيَّةٌ
بمدينة آقْ سَرَايْ
(وهي في أواسط
آناضول على
مقربةٍ من
مدينة قونية)؛
ولكنه يعترف
في الوقت ذاته
بعدم أيّ
معلومات
تُذَكِّرُ النَّشَاطَاتِ
الأولى
للطائفة النقشبنديّة
على الساحة العثمانيّة.
كذلك
ورد في نفس
الموسوعة أنّ
السلطان
محمّدًا
الفاتح »إنّما
اهتمَّ
بالنقشبنديّين
الّذين كانوا يومئذ
خارجَ
مملكتِهِ،
وتولّى
حِمَايَتَهُمْ،
وقام بدعوة
بعض مشاهيرهم
من أمثال نور
الدين عبد
الرحمن
الجامي وعبيد
الله الأحرار،
ليتمكّن بذلك
من الوقوف
أمام تهديدات
الشيعة الإيرانيين...« وَرَدْعًا
لانتشار
عقائدهم بين
السُّنِّيِّينَ
الأتراك. كما
يبدو موقفه
السلبيُّ
المحتقِرُ من
الشيعة من
تسميته ولدَه »با يزيد«،
ذلك لِيُغِيظَهُمْ
وَيَجْرَحَ
مشاعرهم!
نفهم
من عبارات
الكاتب أكرم
إيشن في هذه
الموسوعة أنّ
الطريقة النقشبنديّة
لم تتجاوز حدود
العاصمة العثمانيّة
(اسطنبول) في
مراحلها
الأولى وحتّى
ظهور الخالديّين.
ومهما كانتْ،
فإنّ أوّلَ
شيءٍ من آثار
هذا التّيّار
الصوفيّ
بمدينة
إسطنبول تعود
إلى جهود عبد
الله الإلهي
وخلفائه
الخمسة وهم: أحمد
البُخَاريّ،
وَعابد شلبي،
وَلطف الله الأسكوبي،
وَبدر الدين
بابا، وَمصلح
الدين الطويل...
لقد
استطاع مصلح
الدين الطويل
أنْ يُحَبِّبَ
هذه الطريقةَ
إلى السلطان
أبي يزيد بن
السلطان محمّد
الفاتح الّذي
عُرِفَ فيما
بعد بلقب »الصوفيّ
أبي يزيد الْوَلِيّ«؛
وبذل عابد
شلبي جهودَهُ
في سبيل
التأليف بين الطريقتَين
النقشبنديّة
وَالْمَوْلَوِيَّةِ.
إلاّ أنّ
ترسيخَ دعائم
الطريقة النقشبنديّة
الأحرارية
بمدينة
إسطنبول في
تلك المرحلة إنما
تحقّق بجهود
أحمد
البُخَاريّ
الّذي يُعْتَبَرُ
من أبرز خلفاء
عبد الله
الإلهي. وهو أصلاً
زميله ورفيقه
الّذي سافر
معه إلى سمرقند
وانخرط في سلك
هذه الفرقة
معه؛ ولكن
يبدو أنّ عبيد
الله الأحرار
قد أخضعه
لأوامر عبد
الله الإلهيِّ
عندما
كلّفهما بنشر
طريقته في
إسطنبول. فلما
عزم عبد الله الإلهيّ
على السفر إلى
المناطق الغربيّة
من المملكة العثمانيّة
لنشر الطريقة
استخلفه في
إسطنبول.
دخلت
الطريقة النقشبنديّة
في لباس جديد
وتحت اسم »المجدّديّة«
إلى إسطنبول
بدلالة رجل
مشلول
الساقين اسمه مراد
بن علي بن
داود الأُزْبًكِيِّ؛
كان من خلفاء
معصوم
الفاروقيّ.
على الرغم من الشلل
الّذي كان قد
أصابه منذ
طفولته قام
برحلاتٍ
طويلةٍ وطاف
أهمّ العواصم
من البلاد الإسلاميّة
مات في إسطنبول
عام 1720 من
الميلاد.
***
أمّا
دواعي انتشار
هذه الطريقة؛
فهي أمور
مثيرة للاستغراب
جدًّا؛ فمن
أهمّها، أنّ
هذه النحلة
تتميّز من
سائر
الفِرَقِ
الصوفيّة
بآدابها
وأركانها
وطقوسها
الّتي قَلّ من
يملك نفسَه من
موالاتِها
بعد ممارسته
لهذه الآداب.
لأنّها تبعث في
قلب المبتدئ
شوقًا لاحدّ
لـه، خاصّة
إذا كان قليل
الثقافة،
عاطفيًّا،
ضعيف المنطق،
متخلّف العقليّة،
أو يعاني مشكلةً؛
كما إذا كان
مهجورًا، أو
من مُدْمِني
الكحول
والمخدِّرات،
أو أصابته
نكبة؛ سرعان
ما ينجذب إلى
هذه الطريقة
ويجد في
رحابها ما يسلّيه
ويخفف من كربه
وآلامه.
فينخرط في
سلكهم. ومنهم
من تأخذه الحيرة
والإعجاب،
فينبهر بما
يشهد من توقير
المريدين
وإجلالهم
لشيخ الطائفة
وتفانيهم في
سبيله
واستعدادهم
الأكيد
لتحقيق
أوامره بأدنى
إشارةٍ منه،
فيتابع
أنفاسه عندما
يقابل شيخ
الجماعة وهو
يُقْبِلُ في
هيئته الخاصّة
ومظهره »النُّورَانيِّ
السَّاحِرِ،
كأنّه يهبط من
السماء
بأجنحةٍ من
النّور
الأخضر
يتلألأ في
موكب من
الملائكة،
فيتجلّى في
صورة لطيفة شَعْشَعَانِيَّةٍ
مُقَدَّسَةٍ
لكلّ واحدٍ من
جمهور أولئك
الحافّين من
حولِهِ« المفتتنين
به من فقراء
العلم
والمعرفة
الحيارى،
لذا،
لم ينضم إلى هذه
الطائفة أحد
من أصحاب
الشخصية
الهزيلة والرأي
الضعيف، إلا ورضي
بالخضوع
والعبودية
والتذلّل
والفناء لشيوخها.
فلا يكاد ذهنهُ
يخلو من
تصوّرهم ولا
قلبهُ من
محبّتهم، ولا
لسانهُ من
ذكرهم،
فينبهر
لعظمتهم
الموهومة
عقلُهُ حتّى
يراهم في درجة
الأنبياء
والمرسلين
ويُقسِمُ
بِهامَتِهِمْ،
ويقشعرّ جلده
عند ذكر
أسمائهم مع
يقينه الكامل
بهم أنّهم
ينوبون عن
الله في أرضه
ويتصرّفون في
ملكه وخلقه.
تعالى ربّنا
عما يصفه
الفاسقون.
ومن
أسباب
انتشارها،
جهلُ عامّة
الأتراك ومن
يليهم من
الأكراد،
وحثالةِ
العرب الّذين
يقطنون في
المنطقة
الجنوبيّة من
تركيا. جهلُهم
بلغة القرآن،
وجهلُهم بحقيقة
التوحيد
ومخاطر الشرك.
ومن
أسباب
انتشارها، العصبيّة
القوميّة
الّتي تتمثّل
في احتقار كلّ
ما يمتُّ إلى
العرب بِصِلَةٍ
مِنْ عَادَةٍ أو
مظهرٍ أو اتجاهٍ؛
كنتيجةٍ للدِّعَايَاتِ
الكثيرة الهدّامة
الّتي قام ولا
يزال يقوم بها
يهود سالونيك منذ
مائة وخمسين
عامًا، مما
شجّع كثيرًا
من رجال
السياسة
والمثقّفين
على إثارة
تتريك الدين
الإسلامي بين
الفينة
والأخرى،
وتضليل الناس
بأنّ الإسلام
الّذي تدين به
الأكثريةُ
السنِّيَّةُ
إنما هو دينٌ
عربيٌّ بحتٌ،
لا يفهمه ولا
يطمئن إليه
أبناء الشعب
التركيّ[48].
إنّ
هذه
المؤامرات
الخطيرة في
الحقيقة وإن
لم تكن
للنقشبنديّين
بها علاقة
مباشرة، ولكن
الّذين
يبذلون
جهودهم في
حِيَاكَتِهاَ،
يستغلّون هذه
الطائفة دائمًا
في اكتساب
القوة
والهيمنة
لتوجيه الشعب
وترويضه على
سبل المروق،
وسلخه عن
الإسلام
تمامًا.
ولا
يخفى أنّ
عددًا كبيرًا
من الشخصيّات السياسيّة
ورؤساء
الأحزاب،
يستعرضون
مكرهم في
مواسم الانتخابات
لاستمالة
مشائخ
الطريقة النقشبنديّة
كي ينالوا
مساعدتهم
وتأييدهم في
اغتصاب الحكم
واحتلال
المناصب؛
وليتمكّنوا
بذلك من توجيه
الشعب وترويضه
واستخدامه
ضدّ الإسلام
والمسلمين.
لأنّهم لا
يجدون لتحقيق
أهدافهم ما
يحتاجون إليه
من مالٍ
ورجالٍ إلا
عند شيوخ
الطريقة النقشبنديّة.
ولهذا يعملون
على إشاعةِ
صِيتِ مَنْ
يمكن التعاون
معه من هؤلاء
الشيوخ. ولا يتكلّف
الجانبان من
ثمن هذا
التعاون، سوى
ما ينفقه السياسيون
في سبيل الدِّعَايَةِ
للشيخ،
فيتواطأ معهم
عدد من رجال
العمل الأثرياء،
يُذيعون
شهرته في
المجالس
والمحافل بوسائل
مختلفة.
ويستخدمون في
هذه الحملة
بُلَغَائَهُمْ
من رجال
الخطابة
والكتابة. فما
يلبث حتّى
تزدحم
القوافل في
الطرق
المؤدية إلى تكيَّتِهِ
وتلتفّ الساق
بالساق في
سباق التبرك
بتقبيل »اليد
المباركة
الناعمة
الّتي لا عظم
فيها« - على حدّ
زعمهم -.
فبحكم
الطبع، لا
يزور أحد من
العوامّ
شيخًا في تلك
الزحمة الّتي
يرى فيها
آلافًا
يتلهّف كلّ
واحد منهم
ليمسّ يده
بشفتيه إلا
عَلِقَتْ به
نفسه، ونزعتْ
إليه عواطفه،
وامتلأ
بمحبته قلبه،
فكاد أنْ يسجد
لـه لولا
مخافةَ مقتٍ
يُصيبه.
يرجع
السبب في ذلك
إلى ما ذكرنا
آنفا من المظاهر
الخلاّبة
الجذّابة
الّتي يتراءى
الشيخ فيها
للنّاس من اللّباس
والحشم
والجماهير
الملتفّة
حوله بالإضافة
إلى ما يفعله
من طأطأة
الرأس وقلّة
الكلام، والزهد
المتصنّع
وكثرة
العبادة
والآداب
الّتي يفرضها
على المريد.
فقد
انتبه سلاطين
الأتراك،
ورجالات
السياسة منهم
خاصّة في
المرحلة
الأخيرة من الحكم
العثمانيّ
أنّ الطريقة النقشبنديّة
تتّصف بسحر
وجاذبيّة في
جلب قلوب
الناس
وتسخيرهم.
ولهذا قد
اهتمّ خلفاء
بني عثمان بمشائخ
هذه الطائفة
بداية من
السلطان
محمود الثاني.
وقد تابعهم في
هذه السياسة
رجال السلطة اليهوديّة
أيضا في العهد
الجمهوريّ.
فأدىّ هذا
الاهتمام إلى
انتشار
الطريقة على
ساحات شاسعة
من البلاد.
وإذا
مرّتْ بهذه
الطريقة
فترات زادت في
بعضها نشاطًا
وانتشارًا
وفي بعضها
انحطاطًا
وتقلّصًا فقد
بسطت سلطانها
اليوم على أرض
تركيا وهي
تستغلُّ جهلَ
الناس وحرصَ
رجال
السياسة، كما
تهدّد العقيدة
الحقّة،
والقلةَ
المؤمنةَ من
أبناء هذه
الديار.
***
الفصل
الثاني
* آدابُ
الطريقةِ النقشبنديّة،
ومَصَادِرُهَا،
وميّزاتُها.
-------------------------
*
البيعةُ
وآدابُ
المشيخةِ،
وآدابُ
المريدِ مع
شيخهِ عند
النقشبنديّين،
والغايةُ
منها.........
* آدابُ
الذِّكْرِ
عندهم.................................................................................................................
*
الذّكرُ
بلسان القلب...................................................................................................................
* الرابطة...........................................................................................................................................
* شروطُ
الرابطة
وصورة أدائها..................................................................................................
* أوّلُ
مَنْ أحدث الرابطة.............................................................................................................
* الغايةُ
من الرابطة.........................................................................................................................
* عقوبةُ
المخلّ بآداب الرابطة......................................................................................................
* أسلوبُهم
وطريقةُ
استدلالهم في
إثبات الرابطة،
ومقالاتهم في
الدّفاع
عنها، وما قيل
في
ردّها...............................................................................................................................................
* مِنْ
أهمّ ما كُتب
في مسألة الرابطة..........................................................................................
* مِنْ
آدابهم: الذّكرُ
على أساسِ
اللّطائفِ
الخمس.................................................................
* الحلقةُ
السِّرِّيَّةُ
الّتي
تُسمّىَ عندهم »خَتْمِ
خُوَاجكَانْ« .......................................................
* المصطلحاتُ
الفارسيّة في
الطريقةِ النقشبنديّة
وأسرارُها....................................................

* مبادئُ
الطريقة النقشبنديّة
بالفارسيّة،
وهي أحد عشر
مبدءًا
1.
هُوشْ
دَرْدَمْ.....................................................................................................................
2.
نَظَرْ بَرْ
قَدَمْ.....................................................................................................................
3.
سَفَرْ
دَرْوَطَنْ...................................................................................................................
4.
خْلَوْت دَرْ
أَنْجُمَنْ.........................................................................................................
5.
يَادْ كَرْدْ...........................................................................................................................
6.
بَازْ كَشْتْ......................................................................................................................
7.
نِكَاهْ
دَاشْتْ....................................................................................................................
8.
يَادْ دَاْشْت........................................................................................................................
9.
وُقُوفِ
زَمَانِي..................................................................................................................
10.
وُقُوفِ
عَدَدِي............................................................................................................
11.
وُقُوفِ
قَلْبِي........................................................................................................
......

الفصل
الثاني
* آدابُ
الطريقةِ النقشبنديّة،
ومَصَادِرُهَا،
وميّزاتُها.
طَرَأَتْ
عَلَى هذه
الطريقةِ
تَغَيُّرَاتٌ
وَاستمرّتْ
فيها
الاستحالةُ
خلال القرون السبعة
الماضية،
فَزِيدَ فيها
وحُذِفَ منها
ما لم يعرفه الأوّلون
من أمورٍ
سمُّوها
آدابًا
وأركانًا على
حساب الإسلام.
وقد ألْغَوْا
بعضَ ما أقرَّهُ
أسْلاَفُهُمْ.
وهذا من طبيعة
التصوف الّذي
انبثقتْ منه
سائرُ
المنظّماتِ الباطنيّةِ،
والمذاهبِ
الغاليةِ،
والجماعاتِ
الإباحيةِ
والتنظيماتِ الإرهابيّة،
وفرختْ زنادقةً
أرادوا هدم
الإسلام
وإثارة الفتن
بين صفوف
المسلمين.
اتّخذتْ
الطريقةُ النقشبنديّة
اللّغةَ الفارسيّة
كأداةٍ
للدّعاء
والعبادة؛
ولا غرابة في
ذلك. إذ أنّ قدماء
الأتراك
كانوا يسكنون
بلاد ما وراء النهر
وهي مجاورة
للمنطقة
الإيرانية
الّتي تحول
بينها وبين
بلاد العرب،
فتأثّروا
بثقافة الفرس
وحضارتهم
تأثُّرًا
بالغًا
لأسباب عدّة:
منها،
أنّ الْفُرْسَ
كانوا قد
أسلموا
قبلهم؛ ومنها
أنّ الشعبَ
الفارسيَّ
يمتاز بحضارة
عريقة، بينما
الأتراك لم
تكن لهم ثقافةٌ
ولا حضارةٌ تُوَحِّدُ
صفوفهم،
وتجمع
كلمتهم، وهم
قوم لا أبجدية
له, بل كانوا قبائل
متفرقةً
بدوِيَّةً
تنتقل من مكان
إلى مكان آخر تبعًا
للظروف
المناخيّة،
يعيشون تحت
خيامٍ من
لِبادٍ،
ويتتبّعون المراعي
لأنعامهم.
كانت قبائل
الأتراك في
القرون
الوسطى متمايزةً
جدًّا، لا
تجمعهم لغةٌ
واحدةٌ ولا
دينٌ واحدٌ،
ولذلك كانوا
أسوأ حالاً من
عرب الجاهليّة
في النـزاع
والقتالِ.
ولقد كانت
الحروبُ
سجالاً بينهم
حتّى بعد
إسلامهم. فلمّا
اعتنقوا
الإسلامَ تأثّروا
فورًا بالثقافة
الفارسيّة
وحضارتها
بحكم الجوار
بعد أنْ جمع
الإسلام بين
صفوفهم وجعل
منهم مجتمعا
قويًّا. غلبت
بذلك اللّغةُ الفارسيّة
على لغتهم
الأصليّة
حتّى صارت هي
اللّغةَ
الرسميةَ
للدّولة
السلجوقية التركيّة[49]
فقد
ورد في كتب
رجال النقشبنديّة
ما يبرهن على
إقرارهم هذه
اللّغة. منها
ما جاء في كتاب
»البهجة
السنيّة« لمؤلفه محمّد
بن عبد الله
الخانيّ. إذ
يقول في أوَّلِ
مقاطعه : »وأكثر
كلام أهل
الطريقة
معرّبٌ من
اللّغة الفارسيّة«.[50] بينما
لغة الإسلام
هي العربيّة
بقرينة كونها
لغة القرآن
قال الله
تعالى: { نَزَلَ
بِهِ الرُّوحُ
اْلأَمِينُ*
عَلَى
قَلْبِكَ
لِتَكُونَ مِنَ
اْلمُنْذِرِينَ*
بِلِسَانٍ
عَرَبِيٍّ مُبِينٍ.}[51]
وقال تعالى:
{لِسَانُ الّذِي
يُلْحِدُونَ
إِلَيْهِ
أَعْجَمِيٌّ
وَهَذَا
لِسَانٌ
عَرَبِيٌّ مُبِيٌن.}[52]
وقال تعالى:
{كَذَلِكَ
أَنْزَلْنَاهُ
قُرْآنًا
عَرَبِيًّا،
وَصَرَّفْنَا
فِيهِ مِنَ اْلوَعِيدِ
لَعَلَّهُمْ
يَتَّقوُنَ
أَوْ يُحْدِثُ
لَهُمْ
ذِكْرًا.}[53]
هذا،
وفى كتاب الله
آيات أخرى
تبرهن على أنّ
لغة الإسلام
هي العربيّة. كما
يجب على أهل
العلم وضع مصطلحاتهم
باللغة العربيّة
في كلّ مجالات
الحياة
المختلفة،
وخاصّةً ما
يمتّ لمسائل
الدين بوشيجة.
وهي لغة
الرسول r في الوقت
ذاته. {وَمَنْ
يُشَاقِقِ
الرسوُلَ
مِنْ بَعْدِ
مَا تَبَيّنَ
له اْلهُدَى
وَيَتَّبِعْ
غَيْرَ
سَبِيلِ
اْلمُؤْمِنِينَ
نُوَلِّهِ
مَا تَوَلَّى
وَنُصْلِهِ
جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ
مَصِيرًا.}[54]
ومع
هذا، فان
قدماء النقشبنديّة
قد اصطلحوا
لمناسكهم
أسماء غريبة
كما سنشرحها
فريبًا إنْ
شاء الله
تعالى؛ تلك
الأسماء
الّتي وضعوها
على غير سبيل
المؤمنين
اختلاقًا من
تلقاء أنفسهم
ونزعةً
وحنانًا
واشتياقًا
إلى ما كان
عليه أسلافهم
قبل الإسلام؛
وربما
تقليدًا لمن
كانوا يجاورونهم
من رهبان
البرهمية،
إعجابًا
بخشوعهم في ذكر
الله. لأن
رهبان
البرهمية
يضربون
مثالاً عجيبًا
من الخشوع
أثناء الذِّكْرِ
كما أنّهم
أزهد الناس في
الدنيا
وأقلّهم طمعًا
وأطولهم
صبرًا على
الجوع
والرياضات
الشاقّة المنصوصة
في الديانة
البرهمية.
***
إنّ
للّطريقة النقشبنديّة
آدابًا غريبة
وأركانًا
عجيبة يختلط
فيها الحق
بالباطل،
ويلتبس فيها
المعاني على
الغافل
والجاهل، بل على
العالم
والعاقل، ولا
يُدرِكُ
مقاصدَهَا
ولا مصادرَهَا
إلا من وفّقه
الله للهداية
والإيمان
الصادق ورزقه
المعرفة بِكُنْهِ
المستنقعات
الّتي استقى
منها أئمّة
هذه الطريقة.
أمّا
هذه الآداب،
فإنها تنحصر
في ثلاثة أبواب
رئيسة: آداب
المشيخة،
وآداب المريد
مع شيخه،
وآداب الذِّكْرِ.
إلاّ أنّهم
يشترطون
البيعة قبل كلّ
شيء. وهي
الركن الأعظم
عندهم.
***
* البيعةُ،
وآدابُ
المشيخةِ، وآدابُ
المريد مع
شيخه عند النقشبنديّة،
والغايةُ
منها.
البيعة
أو المبايعة.
معناها:
المعاقدة
والمعاهدة.
فيرونها
شرطًا لا مناص
منه لمن يريد
الدخول في
الطريقة.
وبذلك يكون
المريد قد
أعطى ميثاقّا
غليظًا للشّيخ
الّذي اتّخذه
مرشدًا لنفسه فيلتـزم
القيام بعده بكلّ
ما يأمره به
شَيْخُهُ أنْ
يفعل، وإن كان
حرامًا.[55]
ومن
الغريب إنّه
لا يقتصر هذا
الشرط على
مريد الطريقة
فحسب. بل يجب
على كلّ أحدٍ
أنْ يبايع
شيخًا،
ويستسلم له
تمامًا. »لأنّ
العبد، بينه
وبين ربه حجاب
يمنعه من الاستفاضة« (حسب
اعتقادهم.) يقول
محمّد أمين
الكرديّ
الأربليّ في
هذه المسألة: »فالشيخ
العارف
الواصل وسيلةُ
المريد إلى
الله، وبابُهُ
الّذي يدخل
منه على الله.
فمن لا شيخ له
يرشده فمرشده
الشيطان [56]«
ومعنى
هذا؛ أنّ كلّ
من لم ينخرط
في سلكهم ولم
يستسلم لشيخ
من مشائخهم
فهو تابع
للشّيطان. أي إنّه
ضالّ ومضلّ،
كما يعدّون
خروج المريد
من عهد الشيخ
خروجًا من
الإسلام.
فهذا
رأيهم في جميع
المسلمين وإن
كذّبوا ذلك ودافعوا
بأنّ غرضهم هو
أنّ الإنسان
لا محالة يحتاج
إلى من يعلّمه
الضروريات من
الدين والدنيا
حتّى يتبيّن
له الحقُّ من
الباطل
وليميّز بين
الحلال
والحرام
فيعمل
المعروف
ويجتنب المنكر.
فانّ دفاعهم
بمثل هذا
الأسلوب لا
يطابق ما
يقصدونه من
مفهوم البيعة.
وأمّا المرشد عندهم
في الحقيقة
ليس هو
الأستاذ
الّذي يعلّمُ
الفقهَ
والعقيدةَ
والفنونَ
ويهذّبُ الأخلاقَ.
بل إنّما هو
-على حد قولهم- »العارف
بالله
والواصل إلى
الله.« وما أكثر
وصفهم
لشيوخهم بهذه
الكلمات. مع أنّه
لم يرد في
الكتاب ولا في
سنّة رسوله r
ما يفيد أنّ
العبد مأمور ومكلَّفٌ
بمعرفة الله،
أو يمكنه أو
يجوزُ أنْ
يعرف الله حق
معرفته، أو
يصل إليه
وصولاً في منتهى
الغاية. بل
قال الله
تعالى:
{وَقُلِ الْحَمْدُ
للهِ
سَيُرِيكُمْ
آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا}[57] إذًا
فان معرفة
الإنسان
تنحصر في حدود
رؤيته لآيات
الله دون أنْ
تتجاوز إلى
ذات الله
سبحانه. كما
أنّ وصول الإنسان
إليه محال.
تعالى ربّنا
عن ذلك علوًّا
كبيرًا.
وإنّمَا
الإنسان
مأمور ومكلّفٌ
بعبادة الله
تعالى كما قال
سبحانه:
{وَمَا
خَلَقْتُ
الْجِنَّ
وَاْلإِنْسَ
إِلاّ
لِيَعْبُدُونِ}[58]
مع
هذا البيان
الواضح
بشهادة آيات
الله، فان عامَّةَ
الصوفيّة بما
فيهم
النقشبنديّون،
يعتقدون »المعرفة
بالله« أمرًا
جائزًا
للإنسان،
وأنه بإمكان
العبد أنْ
يتعرّف إلى
ذات اللهِ؛
فيشترطون لذلك
أمورًا
يمارسه
المريد بعد أنْ
يبايع شيخًا
ويأخذ منه
الميثاق
الّذي سموه »البيعة«.
أمّا
مسألة
البيعة،
فإنّها من
أهمّ مسائل الفقه
الإسلاميّ
تتعلّق بنصب
إمامٍ
للمسلمين، متّصفٍ
بالإسلام
والعقل
والذكورة
والبلوغ والشجاعة
والكفاءة
وسلامة
الأعضاء؛
يقوم بمصالحهم
وتنظيم
أمورهم،
وبإقامة
العدل وتنفيذ
الأحكام
بإنصاف
المظلومين،
والدفاع عن
أرض الإسلام
وعِرض
المسلمين
بميثاق
يتعهدون على
أساسه أنْ يُطيعوه
في حكمه
ويناصروه في
دفاعه
تطبيقًا لما
جاء في كلامه
تعالى { يَا
أَيُّهَا
الّذينَ آمَنُوا
أَطِيعُوا
اللهَ
وَأَطَيعُوا
الرسُولَ
وَأُولِي
الأَمْرِ
مِنْكُمْ
فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ
فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوُه
إِلَى اللهِ
وِالرَّسُولِ
إِنْ
كُنْتُمْ
تُؤْمِنُونَ
بِاللهِ وَاليَوْمِ
الآخِرِ
ذَلِكَ
خَيْرٌ
وَأَحْسَنُ
تَأْوِيلاً.}[59]
أما النقشبنديّة
فقد تأوّلوا
هذا المفهوم
بما يتعارض
والنصوص القرآنية.
فقد جعلوا
منها ميثاقًا
يتعاقد على أساسه
مريد الطريقة
مع شيخ
الطائفة على
أنْ يقوم بكلّ
ما يأمره ولو
كان حرامًا.
وَيأتي
على رأسِ مَنْ
عبثوا بمفهوم
البيعةِ رجلٌ
هندِيٌّ اسمه
أحمد بن عبد
الرحيم بن وجيه
الدّين. فقد
بالغتْ
الصوفيةُ في
تفخيم هذا الروحاني
الهندِيِّ
حتىّ لقّبوه
بشاه وليّ
الله الدّهلويّ.
يقول في ثنايا
كتابٍ له،
سمّاهُ: القول
الجميل في
بيان سواءِ
السّبيلِ:
»فالحقّ
أنّ البيعة
أقسام: منها
بيعة
الخلفاءِ،
ومنها بيعة
التمسُّكِ
بحبل التقوى،
ومنها بيعة
الهجرةِ
والجهاد،
ومنها بيعة
التوثّق في
الجهاد. وكانت
بيعة
الإسلامِ
مَتْرُوكَةً
في زمن الخلفاءِ.
أمّا في زمن
الرَّاشدين
منهم، فلأَنَّ
دخولَ النّاس
في الإسلامِ
في أَيَّامهم
كان غالبًا
بالقهرِ
والسيفِ، لا
بالتأليفِ وإظهار
البرهانِ ولا
طوعًا ولا
رَغبةً. وأمَّا
في غيرهم،
فلأَنَّهُمْ
كانوا في
الأكثرِ ظَلَمَةً
فَسَقَةً لا
يهتمّونَ
بِإقامة
السّننِ. وكذلكَ
بيعة التَّمَسُّكِ
بحبل التقوى
كانت
مَتْرُوكَةً.
أمَّا في زمن
الخلفاء
الرّاشدين،
فلكثرة الصحابة
الّذينَ
استناروا
بصحبة
النبيِّ r
وَتَأَدَّبوا
فيِ حضرته،
فَكَانوا لاَ
يَحْتَاجونَ
إلى بيعةِ
الخُلفَاءِ... « [60]
يتّخذ
الدَّهلويُّ
سبيلَ
الدّخولِ فيِ
مسألةِ البيعةِ
سربًا ومكرًا
من خلال هذه
الصيغة الْمُلْتَوِيَةِ
المارجة،
ويُرَاوغُ
بهذه العفعفةِ
ليختلقَ
صِلةً بينَ ما
صدر من الرسول
r من الأمر
بالمعروفِ
والنّهيِ عن
المنكرِ وبين
ما يأمر بِهِ
شيوخ النقشبنديّة
من تعاليم البوذيّة
والبرهميةِ؛
ثمَّ يتناسى
أنّ الرسولَ
الكريمَ r،
إنما كانَ
أصحابُهُ
يُبَايِعُونهُ
ليتولّىَ
أمورَهُم،
وخاصَّةً
لِيُجَنِّدَهُمْ
بِصِفَتِهِ
رئيسًا
يَمتَازُ
بِشَخصيتِه السياسيّة
والعسكريةِ
والروحيةِ.
وأين هذه
الصفات للشيوخ
النقشبنديّة؟
فهل يُتصور
لعاقل أن يقارن
بين هذه
الشخصية
العالميةِ
العظيمةِ وَبين
أيِّ شيخٍ من
شيوخ النقشبنديّة
الخاملينَ
المعزولين
البعيدين عن كلّ
مجالات
الحياةِ
ونشاطاتِها.
وهل
لِهَؤُلاَءِ
المساكين
سُلْطَةٌ
سياسيةٌ،
وقوةٌ يستخدمونها
في تنفيذ
الأحكام، وإنصاف
المظلومين
حتىّ يجوز
مبايعتهم؟ وهل
استطاع أحد
منهم حتى
اليوم أن يمنع
الكفار والمنافقين
من الظلم
والقهر
والقتل
والإبادة ضد
المسلمين؟!!!
تُرَى مَنْ
يكونُ هؤلاِ
الشيوخ،
ومَنْ
يَعْتَدُّ
بهم حتى
يبايعهم
الناسُ
فيولّوهم
أمورَهم؟!
فإنّ
الدّهلويَّ
يتعمّد فيما
سبق من كلماته
ليدسَّ في
مفهوم البيعة
ما لا يمتُّ
به صلةً
أبدًا، وأبعد
من ذلكَ فإنه
يكتم حقيقةً
عظيمةً أجمع
عليها علماءُ
التاريخ: وهي انعقاد
مبايعةِ
جمهورِ
الصحابةِ
للخلفاء
الراشدين. نعم
لم يتولَّ
أحدُهُمْ
أمرَ
المسلمين إلاَّ
بعد مبايعة
جمهور
الصحابةِ له
(وإن تأخرتْ عنها
جماعة منهم
لأسبابٍ). إذًا
فقد جاء
الدّهلويُّ
بكذبٍ ظاهرٍ
بشهادة
البراهين
التاريخيةِ
حين قالَ: »فلكثرة
الصحابة
الّذين
استناروا
بصحبة النبيِّ
r وتأدّبوا
في حضرته،
فكانوا لا
يحتاجونَ إلى بيعة
الخلفاءِ. «[61]
***
لقد
أفرد محمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ
بابًا في
كتابه »تنوير
القلوب« يشتمل
على اثنين
وعشرين شرطًا
يجب أن تتوفّر
فيمن يتصدّر
لأخذ العهد
على المريدين
وقبولهم في الطريقة
النقشبنديّة.
ومن هذه
الشروط ما
ينسجم مع روح
الإسلام ويقع
موقع القبول
عند المسلمين.
كقوله في
الشرط الأول »أن يكون عالمًا
بما يحتاج
إليه
المريدون من
الفقه
والعقائد
بقدر ما يزيل
الشبه الّتي
تعرض للمريد في
البداية
ليستغنى به عن
سؤال غيره [62]«
ولعلّ
كثيرًا من
الناس
يقتنعون بمثل
هذا المقال
الّذي لا تخلو
عبارات شيوخ
هذه الطريقة
منها؛ يقينًا
بأنّ غايتهم
لا تتجاوز إجماع
أهل العلم
والبصيرة في
حاجة الإنسان
إلى مَنْ
يُعلِّمُهُ
ويَدَرِّبُهُ
ويُهَذِّبُهُ
بالطرق المتعارف
عليها. إلا
أنّك إذا
تابعتَ
كلماتِهم واستقصيتَ
ما ينطوي عليه
بعضُ المقاطع
من عِبَارَاتِهِمْ،
ظهرت لك حقيقة
ما يقصدون من
وراء ذلك مما
قد سنّها لهم
بعض كُبَرَائِهِمْ
الّذين وقعت
عظمتهم في
قلوب العامّة
حتّى أذعنت
لهم، بحيث لم
يشكّ أحد في
صدقهم
وأمانتهم
وورعهم وعلوِّ
مكانتهم عند
الله رجما
بالغيب؛ فاتّبعهم
الخلفُ من
شيوخ هذه
الطريقة
تقليدًا صرفًا.
وأقوى دليل على
هذا الواقع
الخطير قول
المؤلّف وهو
يشرح الشرط الرابع
عشر من آداب
المشيخة -
وهذا نصه: »يجب
عليه أن يمنع
المريدين عن
التكلُّم مع
غير إخوانهم
إلا لضرورةٍ« [63]
والغرض
من قوله »غير
إخوانهم« هم
الّذين ليسوا
من أتباعه؛
سواء أكانوا
من المنتسبين
إلى غيره من
مشائخ الطرق
الصوفيّة أم
كانوا ممن لم
يدخلوا في سلك
الطريقة أصلا.
ومن
أين لشيخ
الطريقة أن
يفرض سلطانه
على جماعةٍ من
الناسِ فيسْتَبِدَّ
بِهَا،
فيتحكّمَ في إرادة
أفرادِها ويُحَرِّمَهُمْ
من الحديث مع
غيرهم؟ من أين
له هذا
التحكّم أو
الوصاية؟ وما
حجّته في ذلك
من الكتاب
والسنّة؟
وأين هذا
الكلام من
قوله تعالى:
{إِنّمَا الْمُؤْمِنُونَ
إِخْوَةٌ
فَأَصْلِحُوا
بَيْنَ
أَخَوَيْكُمْ
وَاتّقُوا
الله
لَعَلّكْمْ
تُرْحَمُونَ}[64]
فهل من مقتضى
الإصلاح أن
يمنع شيخ
الطريقة أتباعه
من التكلم مع
مَنْ ليس من
جماعته من
المسلمين، أم إنّه
من دواعي
الشقاق
وتفريق ذات
بين
المسلمين؟ ألم
يقل رسول الله
r: »مَثَلُ
الْمُؤْمِنِينَ
فِي
تَوَادِّهِمْ
وَتَرَاحُمِهِمْ
وَتَعَاطُفِهِمْ
مَثَلُ
الْجَسَدِ
إِذَا
اشْتَكَى
مِنْهُ
عُضْوٌ
تَدَاعَى له
سَائِرُ
الْجَسَدِ
بِالسهَرِ
وَالْحُمَّى« [65] فهل
يمكن ذلك إذا
منع شيخ
الطريقة
أتباعه من مجالسة
الناس
ومعاشرتهم،
بل وحتّى من
التكلُّمِ
معهم؟ إذًا
فما السبيل
لقيام الناس
بالتعاون فيما
بينهم
امتثالاً
لقوله تعالى:
{وَتَعَاوَنُوا
عَلَى
الْبِرِّ
وَالتقْوَى
وَلاَ تَعَاوَنُوا
عَلَى
اْلإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ}[66]
إذا منع كلّ
شيخ جماعته من
التكلُّمِ مع
غير إخوانهم؟
يظهر
من كلّ هذا: أنّ
شيوخ الطريقة النقشبنديّة
قد ألغوا
المؤاخاة
الّتي عقدها
الله بين
المؤمنين
فضربوها بعرض الحائط
بإقرار محمّد
أمين الكرديّ
عليهم: بأنّه
يجب على شيخ
الطريقة أنْ
يمنع
المريدين من
التكلُّمِ مع
غير إخوانهم.
وهذا يعني،
أنّ جماعة كلّ
شيخٍ إخوةٌ
فيما بينهم؛
أمّا من
سواهم، فانهم
أجانب.
يتابع
الكرديّ
مقالته في سرد
شروط المشيخة،
فيقول في
الشرط الرابع
عشر: »أن
يجعلَ له خلوة
ينفرد بها
وحده، ولا
يمكّنَ أحدًا
من مريديه أن
يدخلها إلاّ
مَنْ كان خصّيصًا
عنده« [67] يقول
في الشرط
السادس عشر: »أن لا يمكّنَ
مريدًا من أن
يطّلع على
حركة من
حركاته أصلا،
ولا يعرف له
سرًّا، ولا
يقف له على
نوم ولا طعام
ولا شراب ولا
غير ذلك. فانّ
المريد إذا
وقف على شيء
من ذلك ربما
نقصت عنده
حرمة الشيخ« [68]
إذًا
يتّضح من هذه
التوجيهات
أنّ الغاية من
وراء ما
يُضمره شيوخ النقشبنديّة
بهذه الآداب،
ليس إلا إلقاء
الهيبة في
نفوس الجمهور
وتسخير
قلوبهم،
وليشتغل
الناس بذكرهم،
ولتخضع وتذلّ
الرقاب لعظمتهم.
وليس أدلّ على
هذا، ما جاء
في فصل آداب
المريد مع
شيخه من كلام
المؤلّف نفسه
إذ يقول:
»واقتصرنا
على بعض
المهمّات،
وأعظمُها أن يُوَقِّرَ
المريدُ
شيخَهُ،
ويعظّمه
ظاهرًا
وباطنًا معتقِدًا
أنّه لا يحصل
مقصوده إلاّ
على يده. وإذا
تشتّت نظره
إلى شيخ آخر،
حرّمه من
شيخه، وانسدّ
عليه الفيض.
ومنها أن يكون
مستسلمًا
منقادًا راضيًا
بتصرّفات
الشيخ، يخدمه
بالمال
والبدن. لأنّ
جوهر الإرادة
والمحبّة لا
يتبيّن إلا بهذا
الطريق. ووزن
الصدق
والإخلاص لا
يعلم إلا بهذا
الميزان.
ومنها أن لا
يعترض عليه
فيما فعله،
ولو كان ظاهره
حرامًا. ولا
يقول: لم فعلت
كذا؟ لأنّ من
قال لشيخه: لِمَ؟
لا يفلح
أبدًا...إلخ.[69]
ثم
يسجّل
المؤلّف
نقلاً عن
بعضهم شعرًا
في هذا الصدد،
ومطلعه:
»وكن
عنده كالميّت
عند مغسل *
يقلّبه ما شاء
وهو مطاوع« [70]
نعم
هكذا ينصح
شيوخ الطريقة النقشبنديّة.
وبهذا
الإقرار
والاعتراف
يتبيّن أنّ
موقفَهم من
المريد ليس
كموقف
الأستاذ
المعلّم من تلميذه.
إذ يبذل
الأستاذ
للطّالب من
حصيلة علمه،
ويلقنّه
القواعدَ،
ويشرح له ما
يخفى عليه من
غريب الموضوع
لدروسه،
ويبسط له من
دقائق مسائلها.
ويقوم بحلّ
عويصاتها وهو
لا يألو جهدًا
في الإجابة
على سؤاله،
ويتحمّل
المشقّةَ حرصًا
منه على
تعليمه
وتأديبه
وتهذيبه ليحلَّ
محله في إرشاد
الناس، ولينطلقَ
بإرادتِهِ الحُرَّةِ
في وجوه الخير
مستنيرًا
ومنيرًا بالعلم
والمعرفة.
ولكنّ شيوخ النقشبنديّة
يريدون أن
يصبّوا
المريدَ في
قالب هذه
الطائفة
ويصهروه في
بوتقتها
ليُدخِلوه
تحت رقابتهم
المطلقة بما
يسمّونه
آدابَ
الطريقة.
فيصبح المريد
بذلك مُعَرَّضًا
للاستغلال
بشخصيته وبكل
ما يملك من
مالٍ وجاهٍ؛
وقد يُستخدَمُ
في تحقيق
آمالٍ لا يمكن
ضبطها وتحديدها.
ولا يخفى دور
المريدين بعد
تسخيرهم في
نشر الطريقة،
وإذاعة شهرة
شيخ الجماعة
وإلقاء هيبته
وعظمته في
قلوب الناس
وبسط سلطانه
على المجتمع.
ومن
شاء أن يتأكّد
من هذا الواقع
فله أن يزور تكيةً[71]
من تكاياهم ثم
يقارن بينها
وبين أيّ بيتٍ
من بيوت
العلم.
***
* آداب
الذكر عند النقشبنديّة.
الذِّكْرُ
في اللّغة: هو
استحضارُ
شيءٍ في الذهن
معهودٍ فيما
سبق؛ أو النطقُ
به. وهو تحريك
اللّسان
لأداء
المنطوق به ولو
بصوتٍ خافضٍ.
وفي الاصطلاح:
هو ترديدُ
أسمٍ من
أسمائه تعالى
أو النداءُ
به، أو قراءةُ
شيءٍ من
القرآن
الكريم في
أوقاتٍ
معيّنةٍ.
والذكر
توقيفيٌّ
كسائر
العباداتِ،
لا يجوز إلاَّ
بالكيفية
الّتي وردت في
السنّة.
وضوابطها
منصوصة في
آثار السلف
الصالحِ.
أمّا
عند النقشبنديّة
فله تعريفٌ
يتعجّب منه
العاقل
المنصف العارف
بمعنى كلمة
الذِّكْرِ
ومفهومها. وله
آداب
يستغربها كلّ
من له علم
بكتاب الله
تعالى وسنة
رسوله r.
وإنما
ابتدعوها من
تلقاء أنفسهم
دونما حجّة
يعتمدون
عليها، وقد
استوحاها بعض
كبرائهم من
الأديان
القديمة، فبناها
المتأخّرون
منهم على أثر
سادتهم،
زعموا أنّ
الله أمر بالذكر
على هذه
الصورة
المزيّفة.
***
* الذكر
بلسان القلب
عند النقشبنديّة
يقول
أحد رؤسائهم
-وهو يشرح
كيفية الذكر
عندهم- ويزعم
أنّ له اثنين
وعشرين
أدبًا؛ يقول
في سياق
كلامه:
»- الثالث
عشر: تغميض
العينين،
وإلْصاق
اللّسان بسقف
الحلق،
والأسنان
بالأسنان،
والشفة بالشفة،
وإطلاق
النَفَسِ على
حاله.«؛
»- الرابع
عشر: ذكر الله
الله... بلسان
القلب الخياليّ
فقط، بلا
ملاحظة نقشٍ
ولا حبسِ
نَفَسٍ أصلا.
أعني أن
يتخيّل لقلبه
لسانًا يقول
الله الله...
وهو يسمع.«؛
»- الخامس
عشر: استحضار
مسمّى هذا
الاسم المقدّس،
وهو الذات
العليّة الإلهيّة
في القلب[72]« نعم
هذه كانت
نُبْذَةً من
آداب الذكر
عند هذه
الطائفة.
والله سبحانه
برئ من ذلك. إذ
يقول تبارك وتعالى:
{وَاذْكُرْ
رَبّكَ فِي
نَفْسِكَ تَضَرُّعًا
وخِيفَةً
وَدُونَ
الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلَ
بِالْغُدُوِّ
وَاْلآصَالِ،
وَلاَ تَكُنْ
مِنَ
الْغَافِلِينَ}[73]
فتبيّن أنّه
لا يتم الذكر
إلاّ بالقول.
أي بإخراج
الحروف من
مخارجها مع
صوتٍ أدناه أن
يُسْمِعَ
الذاكرُ نَفْسَهُ.
وإلاّ بطل
الحكم
بالقول،
واختفت
الحكمة،
واقتصر الأمر
على مجرّد التَّصَوُّرِ
وَالتَّفَكُّرِ؛
مع أنّ المراد
من الآية
الكريمة هو
القول دون
الجهر، وليس
التَّصَوُّرُ
وَالتَّفَكُّرُ؛
وإن كان
المطلوب من
الذَّاكِرِ
أن يكون حاضر
القلب
متأمِّلاً في
معنى كلّ كلمةٍ
يذكرها. وفي
هذا الباب
يقول الإمام
النووي رحمه
الله: »اعلم
أنّ الأذكار
المشروعة في
الصلاة
وغيرها واجبةً
كانت أو
مُسْتَحَبّةً،
لا يُحْسَبُ
شيء منها ولا
يُعْتَدُّ
بِهِ حتّى
يتلفَّظ به بحيث
يُسمِعَ
نفسَه إذا كان
صحيح السمع لا
عارض له« [74]
إذًا،
فالذِّكْرُ شيءٌ
وَالْفِكْرُ
شيءٌ آخر. وقد
جمع الله بين
هذين
المفهومين في
آيةٍ واحدةٍ
وهو مثالٌ
رائعٌ من
الإعجاز القرآنيّ،
وإفحامٌ لمن
عمي قلبه
فالْتبس عليه الأمران.
وبيّن سبحانه
وتعالى الفرقَ
بينهما في
مضمون قوله:
»إِنّ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَاْلأَرْضِ
وَاخْتِلاَفِ
اللّيْلِ
وَالنَّهَارِ
لآيَاتٍ
لأُولِي
اْلأَلْبَابِ*
الّذينَ
يَذْكُرُونَ
الله
قِيَامًا
وَقُعُودًا
وَعَلَى
جُنُوبِهِمْ
وَيَتَفَكَّرُونَ
فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ
وَاْلأَرْضِ«[75]
أمّا الذِّكْرُ
بالقول »دون
الجهر«، ففيه
تعظيم لجنابه
تعالى. إذ
يعلم الله ما
يجول في خلد
الإنسان وما
ينطق به لسانه
سرًّا كان أو
جهرًا. وكذلك
فيه اجتناب من
السمعة
والرياء.
وما
جاء في الآية
المذكورة من
قوله »ودون
الجهر« فليس
معناه تعطيل
اللّسان من
الذِّكْرِ
وإنما فيه
توضيح لوصف
طريقة الذكر
وذلك أن لا
يكون جهرًا
ولا خفاءً بل
يكون دون الجهر،
وفوق الخفاء.
أمّا
ما استحدثته النقشبنديّة
من بدعة الذِّكْرِ
القلبيّ فانّ
فيها سرًّا لا
يكاد يطّلع
على حقيقته
أحدٌ من
متأخري مشائخ
هذه الطائفة
لجهلهم بما
تعرّضتْ له
طريقتهم من
استحالاتٍ وَتَبَدُّلاَتٍ،
وما استوحتْ
من الأديان
والفلسفات من
أفكار
وتفسيرات،
وما تسرّب
إليها مع
الزمان من
مصطلحات دخيلة
وتعبيرات
غريبة.
ذلك
أنّ الطريقة النقشبنديّة
قفزت إلى
الهند في
القرن العاشر
الهجريِّ،
فاستوحتْ من
الديانة
البرهمية
والبوذية بعد
أن نشأتْ في
بلاد ما وراء النهر
وتأثّرَتْ
هناك بالشامانية
والمزدكية،
والمانوية في
سابقها خاصّة
فإنّ رجال هذه
الطائفة،
بدءًا من محمّد
الباقي
الكابُليِّ
ومَنْ بعده
إلى عبد الله
الدهلويّ المعروف
بشاه غلام علي،
كلّهم من أهل
الهند،
وكلّهم
متأثّرُونَ بالرهبنة
الهندية
بإقرار
مشاهيرهم.
ومنهم قسيم
الكُفْرَويّ.
إذ ينقل لنا
صورةً جليّةً
من حياة الروحانيّ
الشهير بين
أهل هذه
النحلة، شمس
الدين حبيب
الله ميرزا
مظهر جَانِ
جَانَان. وهو
من الطبقة
الثانية عشرة
بعد محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ
مؤسس هذه
الطريقة. يقول
الكُفْرَويّ: »إنّه كان
يقتصر على
التغذّي من
العُشب
والثمرات، ويعيش
في أماكن
خالية من
البشر، ولا
يرتدي إلا
قميصا« [76]
إذًا
يتبيّن لنا
بوضوح أنّ هذا
الرجل لم يكن
على سنّة محمّد
r، بل كان
على سنّة بوذا
الراهب مؤسّس
الديانة البوذيّة.
وإذا
كانت حياة
رجال هذه
الطائفة
صورةً من حياة
رهبان
البرهمية
والبوذية،
فلا محالة أنّ
عقائدهم
وعباداتهم
أيضا كانت طِبْقَ
عقائدِ أولئك
الرهبانِ
وعباداتهم
ومناسكهم،
خاصّة بعد أن
قامت عشراتٌ
من الدلائل
القاطعة على
ذلك. فثبت أنّ
موضوع الذِّكْرِ
في الطريقة النقشبنديّة،
وإن كان
يتناول اسم
ذات الله
تبارك وتعالى
أو كلمة
التوحيد؛ إلا
أنّ أسلوب
أداء الذِّكْرِ
فيها مأخوذ من
الديانة البوذيّة
والبرهمية
على الطريقة
الْجُوكِيَّةِ
(أي اليُوغِيَّةِ)
كما سيأتي
شرحه في باب الرابطة
إنْ شاء الله
تعالى.
تدعو
المناسبة هنا
(وقبل
الانتقال إلى
مسألة الرابطة)
أن نتطرّق
ثانيةً إلى
موضوع الذِّكْرِ
القلبيّ عند النقشبنديّة
مع »حبس
النفَسِ« وهي نقطة
هامّة جدًّا.
فعندما
نعود إلى
المصدر
السابق أي إلى
كتاب (السعادة
الأبدية فيما
جاء به النقشبنديّة)
لأديب
الطائفة عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ، نجد
أنفسنا أمام
ذلك التعريف
الغريب نفسه
للذّكر
القلبيِّ مع
إضافة شروط
أخرى أشدّ
غرابة من
الشروط
السابقة.
يباشر
عبد المجيد
الخانيّ في
تعريف هذا
الشكل من الذِّكْرِ
القلبيِّ
فيقول:
»الثاني،
ذِكْرُ النَّفْيِ
وَالإثْبَاتِ.
والمرادُ بِالنَّفْيِ
وَالإثْبَاتِ
، كلمة
التوحيد (لا
إله إلا الله ).
وهذا الذكر المبارك
يعلّمه
المرشد
للمريد بعد
ذكر اسم الذّات
باللّطائف
والتّمكّن من
سلطان الذِّكْرِ.
وآدَابُهُ،
هي آدابُ الذِّكْرِ
الأوّل؛ غير أنّه
بعد أن يلصق
اللّسان
والأسنان
والشفة
كالأوّل،
يحبس النَّفَسَ
تحت سرّته
ويتخيّل منها
نقش (لا)
ممتدّة إلى
منتها دماغه،
ويتخيّل من
دماغه نقش
(إله) ممتدّة
إلى كتفه
الأيمن،
ويتخيّل من
كتفه الأيمن
نقش (إلا الله)
مارًّا بها
على اللّطائف
الخمس ضاربًا
بلفظ الجلالة
على القلب
منفذّا إلى
قعره بقوة
يتأثّر
بحرارتها
جميع البدن مع
ملاحظة معنى
هذه الجملة.
وهو أنّه لا
مقصود إلا ذات
الله تعالى.
وينفي بشق
النفي جميع
المحدثات الإلهيّة.
وينظرها بنظر
الفناء ويثبت
بشق الإثبات ذات
الحق تعالى.
وينظره بنظر
البقاء. ويقول
في آخرها
بلسان القلب (محمّد
رسول الله).
ويقصد بها أنّه
متّبع له
ويكرّرها على
قدر قوّة
نَفَسِهِ،
ويُطلق
نَفَسَهُ من
فمه على الوتر
من العدد. وهو
المسمّى عند
ساداتنا
بالْوُقُوفِ
العدديّ« [77]
كان
هذا تعريفُ
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ للذّكر
القلبيِّ عند النقشبنديّة،
دون أن يكون
لهم سندٌ
يُثبِتون به
صلةَ هذا الشكل
من الذكر مع
القرآن
والسنّة.
ولكن
ما دام
المؤلّف يرشد
الناس إلى ذكر
الله بهذه
الكلمات »وذكر
الله أفضل كلّ
شيء« إذن فلا
غرابة فيها
عند أي إنسان
ساذج جاهل بهذا
الأسلوب
الماكر، ولا
بطُرُقِ الدسّ
وتأثيراتها،
واستحالة
الأمور إلى
صورٍ وأشكالٍ
مشوّهةٍ مع
الزمان؛ وكيف
يلتبس الحق
بالباطل على
الناس من حين
إلى آخر.
نعم
قد لا يستغرب
كثير من جهلةِ
الناس هذا
التعريف
الدجليَّ
المدلّس ولا
يقدِّرُون
خطورته »لأنّ
اليهود والنصارى
والمجوس أيضا
يذكرون الله
ويحبّونه ويعبدونه
كالمسلين« فما
عسى الغرابة
في هذا
التعريف؟
ولكن
أهل الإيمان
الصادق
والتوحيد
الخالص والعلم
الغزير لابدّ
وأن يستغربوه
ويتسائلوا عن »حبس النَّفَسِ«
خاصّة أثناء
الذكر. هذا
ومن الأهمية
بمكان، ومن الغرابة
جدًّا، أنّ
علماء
المسلمين لم
ينتبهوا إلى
هذه الهرطقة مع
أنها قديمة[78]
في عقائد
الطائفة النقشبنديّة.
يدل ذلك على
غفلة كثير من
أهل العلم
عَبْرَ عصور
الظلام. فلم
نَعْثُرْ على
شيء عن هذه
المسألة في
مؤلّفاتهم
ومصنّفاتهم
سوى ما قد
سجَّلَهُ
العلاّمة أبو
الحسن
الندويّ بإيجاز
في ثنايا
الجزء الثالث
من كتابه »رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام«. إذ يقول
في مقطعٍ منه
وهو يشرح
التطورات الّتي
حدثت في الطرق
الصوفيّة
المنتشرة على
الساحة
الهندية
وخاصة
الطريقة
الشطارية
وفرعَيْها؛
فيقول: »وينتمي
الفرع الثاني
إلى شيخ علي
بن قوّام
الجنبوريّ -
المعروف بشيخ
علي عاشقان
السرائي ميري
- بينه وبين
الشيخ عبد الله
الشطّاري
واسطتان. قد مَزَجَتْ
هَذِهِ الطَّرِيقَةُ
لأوَّلِ مَرَّةٍ
تَعَالِيمَ »يوكا«
بِالتَّعَالِيمِ
الصوفيّة، وَاخْتَارَتْ
مِنَ الأوُلَى
بَعْضَ الرِّيَاضَاتِ
وَالأَوْرَادَ،
وَحَبْسَ النَّفَسِ،
وَلَقَّنَتْ
هَذِهِ التَّعَالِيمَ
الْمُرِيدِينَ
وَالسَّالِكِينَ
كَمَا ضَمَّتْ
إلَى الطَّرِيقَةِ
»عِلْمَ
السِّمْيَاءِ«
وقد جاءت
تفاصيل هذه
الأوراد
وشروح
الرياضات
الخاصة في
الرسالة
الشطّارية
الّتي ألَّفها
الشيخ بهاء
الدين
الأنصاري
القادري. وتوجد
قصيدةٌ للشّيخ
محمّد
الشطّاري في
كتابه »كليد
مخازن«
ـ مفتاح
الخزاين ـ
تفيد عقيدةَ
وحدةِ الوجودِ،
وعدمَ التَّفْرِيقِ
بَيْنَ الْمَسْجِدِ
وَالْبِيعَةِ
وَالْمُسْلِمِ
وَالْبَرَهْمِيَّ« [79]
يقول
الندويّ قي
مقطعٍ آخر من
كتابه
المذكور: »وهنا
في الهند
-الّتي كانت
منذ آلاف السنين
مركز اليوك،
والتنسّك
والرهبانية-
واجه
الصوفيّة
الواردون من
الخارج،
اليوكيّين المحنّكين
المرتاضين
الّذين كانوا
ضاعفوا قوة
نفوسهم
ومتخيّلتهم
عن طريق حبس
الأنفاس والتأملات
اليوكيّة
المعروفة
لديهم. فتعلّم
بعض المتصوّفة
المسـلمين منـهم
هذا الفن« [80]
إلاّ
أنّ مسألة »حبس النَّفَسِ[81]«
تحتاج إلى شيء
من التوضيح
هنا بمناسبة
المقام،
تمحيصًا
للموضوع،
وإجلاءً لأيّ
شكٍّ قد يُخاتِلُ
ذهن الباحث عن
حقيقة هذه
النحلة.
من
المعلوم أنّ
الإنسان قد
اكتشف ببحوثه
وتحرّياته
وتجاربه منذ
الماضي
السحيق إلى
اليوم آلافًا
من أساليب المعالجة
لأزماته. ولا
شكّ في أنّه
قد حقّق
أهدافًا
عملاقةً
يتمتّع بما
قدّمت له في
العصر الحاضر
من السرعة
والرفاهية
والرخاء. إلا أنّه
مع هذا قد وجد
نفسه في وسطِ
ضجّةٍ هائلةٍ
من الأحداث
الّتي هي في
الحقيقة
صنيعة يديه.
وهو أمام هذه
العاصفة في
ارتباكٍ
غريبٍ، ومعاناةٍ
شديدةٍ واضطّرابٍ
رهيبٍ لا يدري
كيف ينجو من
وطئته.
ومن
جملة ما اهتدىَ
إليه العقلُ
البشريُّ من
أساليبِ
توفير
الطمأنينة
والهدوء، ثمّة
تطبيقات
غريبة من الطبِّ
البديلِ
وأشكال من
الرياضة
الذهنية،
اكتشفها
رهبان الديانات
الهندية في
القرون
الماضية من
خلال ممارساتهم
وتجاربهم
عَبْرَ
فَتَرَاتٍ
طويلة من التقشّف
والإنزواء
والتأمّل
والتركيز،
وما أشبه ذلك.
فأضفوا عليها
صبغةً من
التصوف
والروحانية؛
وذلك على سبيل
المحاولة
للاتّصال بما
وراء
الطبيعة،
حتّى غدت تلك
الممارسات من
الآداب
والأركان في
الديانات
البرهمية،
واعْتَقَدَهَا
مجوسُ الهندِ.
وسُمِّيَتْ
أخيرًا »اليوغا« [82]
وقد اختلف
فيها الناس:
هل أنها دينٌ،
أم أشكالٌ
مستحدَثةٌ من
الرياضة
الذهنية
والنفسية،
منها »حبس
النَّفَسِ«؛
وما
عسى الحكمة
والفائدة في
حبس النَّفَسِ؟
وهو في
الحقيقة
إحراج البدن
وإرغامه على
فعل يخالف
طبيعته.
لا جرم أنّ
هذا السؤال
يخامر
الإنسان بحكم
الطبع. لأنّ
في حبس
النفَسِ
مضايقة على
الرئتين وإخناق
لهما وتعطيل
لوظيفة هامّة
تقومان بها في
سبيل استمرار
الحياة.
إلاّ
أنّ الأمر ليس
في هذا
المستوى من
البساطة
والسطحية كما
تظنّه
العامّة. بل
إنّ »حبس
النَّفَسِ«
وبالأحرى »المراقبة
على عمل التَّنَفُّسِ« من
وجهة نظر الطب
النفسيّ
الجسديّ، هو
أمر هامّ جدًا
وخطوةٌ
أساسيةٌ في
تمرينات »اليوغا«
الّتي هي في
حدّ ذاتها
رياضةٌ
ذهنيةٌ
ونفسيةٌ
يمارسها كثير
من الناس
بصورة
عقلانية صرفة دونما
إلحاقِ صفةٍ
دينيةٍ أو
روحانيةٍ بها.
ذلك للتّخلّص
من
الاضطرابات
النفسية،
ولتوفير الطمأنينة
والهدوء
والصحة البدنيّة
والعقليّة
كما أنّها
تروّض
الإنسان على
الصبر
والسيطرة على
الأعصاب
بصورة طبيعيّة
قد أقرّها
علماء الطب
المعاصر.
يقول
شخصيتان من
خبراء هذا
الفن في وصف
نمط من أنماط
هذه الرياضة:
»إنّه
شكل لا يبحث
عنه إلاّ
القليل من
الناس وهو
يتطلّب
شروطًا خاصّة
من الحياة.
ولا يدركه إلا
المتصوفون
العظام؟ [83] «
يجب
هنا أن لا
نتغافل عما
يتداعى هذا
التوضيح الّذي
انطلق قدماء
النقشبنديّين
من منهله في
حقيقة الأمر
فبنوا على
جذور هذه
الفكرة شطرًا
من تعاليمهم.
وجعلوا ما
استقوا منها
أدبًا من آداب
طريقتهم في
الذِّكْرِ
القلبيّ،
وزعموا أنّ له
أساسًا من
الكتاب والسنّة
وذلك بهتان
عظيم.
إنّ »حبس النَّفَسِ« في
مصطلح
النقشبنديّين
معناه إمساك
النَّفَسِ
داخل الرئتين
قَدْرَ لحظات
وهو »التَّنَفُّسُ
الْيُوغِيُّ«
الموزون
المتواقت بعينه
في الأصل
والمنشأ كما
يقول
المستشرق ج. توندريو
وزميله -عالم
النَّفْسِ- ب.
ريال:
»ولا بد لِلتَّنَفُّسِ
الْيُوغِيِّ
من أهميّة في
احتفاظ هواء
الشهيق داخل
الرّئّتين
لفترة معينة« [84]
وإليك
وصفه على
لسانهما ـ
بشرط أن تتذكّر
الآن ما
نقلناه
سالفًا من
كتاب »السعادة
الأبديّة
فيما جاء به النقشبنديّة«
لأديب هذه
الفرقة، عبد
المجيد بن محمّد
بن محمّد
الخانيّ؛
حتّى تتمكّن
من الوقوف على
المشابهة
التامّة بين »حَبْسِ النَّفَسِ« في
الذِّكْرِ
النقشبنديّ
وبين »التَّنَفُّسِ
الْيُوغِيِّ«
الهنديّ
البرهميّ
بالمقارنة
بينهما. يقول
الباحثان:
»إجلِسْ
منتصبَ الجسمِ
متدلِّيَ الذِّرَاعَيْنِ.
اشهق مع تركيزِ
فكرِكَ على
طريق الهواء
(حسبما ورد
أعلاه) إحتفظ
بهواء الشهيق
لمدّة
ثانيتين، أو
ثلاث ثواني
على الأقل.
وهذا هو سِرُّ
وميِّزة هذه
الطريقة عن
سابقها. لا حظ
بأنّك تصبح أثناء
هذا الاحتفاظ
متوتِّرًا.
فترتفع كتفاك
ويَنْشَدّ
جسمك. جرّبْ
واستَرْخِ. اِزْفِرْ
الهواءَ
خارجًا من
الأنف دومًا. احتفظ
برئّتيك
فارغتين
لمدّة
ثانيتين أو
ثلاثة. ثم أعد
الكرّة من
جديد بالشهيق
الواعي. هذا
التمرين يسمح
لك بصورة
خاصّة أن تدرك
الفكرة، ولم يبق
لك سوى
التنفيذ حوالي
عشر مرات يوميًا« [85]
أليس
هذا الّذي
جعله
النقشبنديّون
مبدءًا من
مبادئ
ذكرهم؟
وهل يكتمونه
عنادًا ومكابرةً
حتّى لا يَدْخُلوُا
بذلك في عداد
المشركين من
اليوغية
الهندوس عن
وعيٍ واختيارٍ
وقصدٍ؟ كلا
والله! ولكن
الجهل قد بلغ
بهم إلى حدّ،
لو سمع منك
غوثهم الأعظم
كلمة »اليوغا«
لتعجّب
واستغرب؛
ولربما ظنّ
أنّها اسم
لنوع من الوحش
أو النبات، أو
العقاقير (كما
حدث ذلك أثناء
حوار مع أحد
شيوخهم). ولو سألتَ
أحدًا منهم عن
معاني كلمات:
Nirvana, Meditation
Trence, Mantra,
وما
شاكَلَهَا من
مصطلحات مجوس
الهند، لرأيته
شاخصًا عينيه
إليك وقد
بُهِتَ؛
ولكنّه يكاد يُزْلِقُكَ
بنظره الحادّ
وقد خيّم عليه
صمتٌ من حيرةٍ
مشوبةٍ
بالحقد،
تُعَبِّرُ
عما في ضميره
من تساؤلات
وأحاسيس
غريبة،
وهواجس
معقّدَة،
وتصورات
وأفكار؛ حتّى
هو بالذّات لا
يدري كيف
يتخلّص من
المأزق الّذي
انحبس فيه
أمام هذا السؤال
الطارئ بسبب
جهله معاني
هذه الكلمات التافهة
أو ربما طأطأ
رأسه وكأنّه
يستشير الشياطين
ليستوحي منهم
أخبث ما في
قاموسهم من كلمات
الشتم واللّعن
والتهكّم
ليقذفك بها
بعد قليل
انتقامًا منك
على سؤالك؛
وتهدئةً
للنار الّتي
تتوقّد في
صدره غضبًا
عليك!
إذًا
كيف بشيوخ النقشبنديّة
مع هذا الجهل
أن يتحقّقوا
مما تسرّب إلى
طريقتهم من
تعاليم
الديانة
البرهمية
عَبْرَ القرون؟
أما »حَبْسُ النَّفَسِ« أو
المراقبة
عليها بشروطٍ
حدّدها،
وأقرّها علماء
الطبِّ
النفسيِّ
الجسديِّ بعد
دراسات وبحوث
وتجارب كما هو
منصوص في
مصنَّفاتهم فإنّه
حقيقة عقلانيّة
تجربيّة وعلميّة
ثابتة
بالبراهين،
ولا صلة بين
هذه الحقيقة مباشرة
وبين الجانب
الروحانيِّ
من الدين
الإسلاميّ
كما لا يعقل
أن تمتَّ إلى
التصوّف
بشيءٍ.
أما
تطبيق هذه
الطريقة العلميّة
لأغراض
صحيّة، فإنّ
الحديث عنه
ليس من اختصاص
بحثنا، وإنما
هو موضوع الطبِّ
النفسيِّ
الجسديِّ. إلاّ
أنّ هذه
الظاهرة الغريبة
الّتي انتشرت
في الآونة
الأخيرة،
ترجع في الأصل إلى تعاليم
الديانتين
الوثنيتين: البوذيّة
والهندوسية. وهي
من الأعمالِ ذات
الصلة الوثيقة
بالصهيونية، تُستعرض
في أشكالٍ
وأنماطٍ من
الرياضة البدنيّة
والروحية،
وقد افتتحت
منظمة اليوجا
فرعًا لها في
القاهرة عام 1975،
وكان يقوم بالتدريب
به شاب من
الفليبين
وفتاة
أمريكية، وقد
استطاع
الاثنان أن
يجذبا إلى مقرّ
هذه المنظمة
عددا من
الشباب
الجامعي
للتدريب على
اليوجا
والإعداد
للقيام بنشاط اجتماعي
لتوعية أهالي
القرى والمدن.
وفى 16/7/1975
قبض رجال
الأمن على
الفتى والفتاة
بعد أن اتّضح
قيامهما
بنشاط ديني
وسياسي
والدعوة لتمييع
الأديان
والانتقاص من
القيم
الروحية، واتّضح
أنّ هذه
المنظمة تموّلها
جهات صهيونية
وأنّها فرع
لمنظّمةٍ مركزها
الرئيسي في
إسرائيل.
ولكن
ينبغي هنا التأكُّيد
على أنّ »حَبْسَ
النَّفَسِ« ليس
هو الأمر
الوحيد الّذي
استقاه قدماء النقشبنديّة
من تعاليم
اليوغية
البرهمية؛ بل
تركيزُ الفكر
على جسمٍ
بعينه أو تَخَيُّلُهُ
من غير اتصال،
أيضا هو من
الأمور الّتي
أخذتها
الطائفة النقشبنديّة
من تقاليد
الهندوس دون
أدنى شكّ، وهو
المعبَّرُ
عنه عندهم
باستحضار
صورة الشيخ في
الخيال، والمصطلحُ
في عقائدهم
باسم »الرابطة«
***
* الرَّابِطَةُ.
وما
أدراك ما الرابطة!
ألا إنّها
لفتنة عظيمة
انفجرت في
العراق فنشبت
بشرارة طارت
إليها من
الهند بعد
عودة خالد البغداديّ
من مدينة دلهي
عام 1226هـ.
كان
قد سافر إليها
من العراق سنة
1225هـ.
إلاَّ أنَّ
هذه الرّحلةَ
لم تكن صدفةً
ولاَ كأيّ سفر
مُعْتَاد، بل
ومن
الأهمّيّةِ
بمكان،
أنّها وقعت
في مرحلةِ
استيلاءِ
الإنجليز على
الساحة
الهندية حيث
يأبى دماغ الرجل
المسلم
الواعي أن
يصدّق
بمصادفة هذا الأمر
دون برنامج
سابق! فعادَ
البغدادِيُّ بأفكارٍ
جديدةٍ وآراءٍ
غريبةٍ
مستوحاةٍ من البوذيّة
والبرهميةِ.
فبدأ يبثُّ النقشبنديّة
على أساسها
باسم الطريقة الخالديّة.
وابتدع لها
ركنًا سمّاها »الرابطة«،
بعد أن لم تكن الرابطة
شيئًا معهودا
ولا مسموعًا
في الطرق
الصوفيّة
المنتشرة بين
المجتمعات
العجمية في
المملكة العثمانيّة.
فأثار ضجّة في
مختلف أنحاء
البلاد بهذه
البدعة الخطيرة،
وما دسّ معها
من مستحدثات
منكرة لم يكن القصد
منها في
الحقيقة إلا
ضرب الإسلام
من أساسه.
فالقصّة
طويلة
سنشرحها في
ترجمة خالد
البغداديّ ضمن
الفصل الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
أمّا
الرابطة في
عقيدة
البغداديّ
فهي من أعظم
الأركان في الطريقة
الّتي
استحدثها
بعنوان »الخالديّة«
إذ يغضب أشدّ
الغضب على من
وصفها
بالبدعة
فيقول:
»إنّّ
بعض الغافلين
عن أسرار حق
اليقين
يعدّون الرابطة
بدعة في
الطريق
ويزعمون
أنّها شيء ليس
لها أصل ولا
حقيقة. كلاّ!
إنها أصل من
أصول طريقتنا
العليّة النقشبنديّة.
بل هي أعظم
أسباب الوصول
بعد التمسّك
التامّ
بالكتاب
العزيز وسنّة
الرسول« [86]
جاءت
هذه الكلمات
في مستهلّ
رسالةٍ بعثها
إلى محمّد
أسعد أفندي
الإسطنبولي،
إذا صحَّ ممّن
أسندها إليه.
فقد عبث
المؤلّف في
هذه الرسالة
بالمفاهيم،
فجمع فيها بين
كلماتٍ
ومصطلحاتٍ
شتّى؛ وآرء
متباينة
ومتناقضة وهو
يحاول أن يجعل
بين طريقته
وبين الإسلام
صِلَةً. وذلك
من أساليب
الباطنية.
لأنهم
يتعرّضون في كلّ
عصرٍ لهجماتٍ
عنيفةٍ من
علماء
المسلمين، فإذا
عجزوا عن
مقاومتهم
لَجَأوا إلى
مدِّ الجسور
بين مذاهبهم
وبين الإسلام
ليبرّروا بها
حجّتهم.
فقد
شنّ
البغداديّ
هجومًا على من
عدَّ الرابطة
بدعةً، ثم
دافع عنها
بقوله: »كلاّ،
إنّها أصل من
أصول
طريقتنا...إلخ«. قد
يكون
البغداديّ
صادقًا في هذا
المقطع من كلامه.
لأنّه ما يسمى
»الطريقة«،
فإنها من صنع
الصوفيّة
بجميع
مباديءِها
وفلسفتِها وطقوسِها
وصورةِ
أدائِها. إذن لا
غرابة في
إضافة أشكالٍ
أخرى من البدع
إلى مبادئ
الطريقة
وأصولها متى
شاء زعيمها
الّذي يُذعن
له جمهورُ
المريدين.
أمّا
قوله »بل
هي أعظم أسباب
الوصول...إلخ«،
فإنها جرأةٌ
على الله
وجنايةٌ على
الإسلام،
وبهتانٌ
عظيمٌ على
كتاب الله وسنّة
رسوله! r.
نعم،
يجوز عقلاً أن
تكون الرابطة
أصلاً من أصول
الطريقة النقشبنديّة.
إذ هي في
الحقيقة
ديانة
مستقلّة
بأصولِها
وآدابِها
وأركانِها
وطقوسِها،
ولكن
طُلِيَتْ من
خارجها بصبغة
من الإسلام. إذن
فلا مانع من
أن يضيف إليها
الروحانيون
ما طاب لهم من
آدابٍ وأصولٍ
أو يلغوا منها
شيئًا.
أمّا
محاولةُ
البغداديِّ
من وُجْهَةِ
نظر الإسلام
في قوله: »بل
هي أعظم أسباب
الوصول...إلخ«
فانّ ذلك
رأيُهُ
الخاصُّ. وقد
اعتاد رجال
الطرق
الصوفيّة هذا
الأسلوبَ
قديمًا.
وغايتهم منها:
أنّ المريد
إذا استسلم
لشيخه بكمال
الإنقيادِ
وسلك وفقًا للخطّة
الّتي تَنُصُّ
عليها فلسفةُ التصوّف،
ظَفَرَ بالوصول
إلى الله !
بينما الكتاب
والسنّة، لا نجد
فيهما شيئا يؤكّد
على وصول
العبد إلى
الله بسلوكِهِ
على آداب
الصوفيّة
واشتراكه في
طقوسهم. بل
الّذي يظفر به
العبد ويحظى
من الفوز
(بالعمل
الصالح) هو
رحمةُ الله ومغفرتُهُ
ورضوانهُ
والأجرُ
الحسنُ والجنّةُ
ونعيمُها كما
قال تعالى:
{الّذينَ
آمَنُوا وَهَاجَرُوا
وَجَاهَدُوا
فِي سَبِيلِ
الله
بِأَمْوَالِهِمْ
وَأَنْفُسِهِمْ
أَعْظَمُ
دَرَجَةً
عِنْدَ الله
أُولَئِكَ
هُمُ الْفَائِزُونَ
*
يُبَشِّرُهُمْ
رَبُّهُمْ
بِرَحْمَةٍ مِنْهُ
وَرِضْوَانٍ
وَجَنّاتٍ
لَهُمْ فِيهَا
نَعِيمٌ
مُقِيمٌ *
خَالدِينَ
فِيهَا
أَبَدًا
إِنَّ الله
عِنْدَهُ
أَجْرٌ
عَظِيمٌ}[87]
وقال تعالى:
{وَعَدَ الله
الّذينَ
آمَنُوا وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ
مَغْفِرَةٌ
وَأَجْرٌ عَظِيمٌ}[88]
وقال تعالى:
{إِنَّ
الّذينَ
آمَنُوا
وَعَمِلُوا
الصَّالِحَاتِ
لَهُمْ
جَنَّاتٌ
نَعيِمٌ *
خَالدِينَ
فِيهَا،
وَعْدَ اللهِ
حَقًّا،
وَهُوَ الْعَزيِزُ
الْحَكيِمُ}[89]
هذا،
وفي كتابِ
اللهِ آياتٌ
كثيرةٌ غيرها
تبرهن على أنّ
الفوزَ
برحمةِ اللهِ
ورضوانهِ
وجنّتِهِ
ونعيمِهِ
إنّما
يتوقّفُ على
الْعَمَلِ الصَّالِحِ
الّذي ورد
البيانُ عن
طرائِقِ أدائِهِ
في الكتاب
والسّنّةِ
بالتفصيلِ
والتوقِيف. ويتبيّنُ
بفضل هذه
الآياتِ وبكل
وضوح: أنّ ما يُسمّى
بـ »الرَّابِطَةِ
النقشبنديّة« ليس
من العمل
الصالح في
شيء. ثم
المراد من
مفهوم »العمل
الصالح« في
الإسلامِ واضحٌ
في منتهى
الوضوح من
خلال ما جاء
في الآيات
القرآنية
والأحاديث
النبوية. وهي
أداءُ الفرائض
من الصلاةِ
والصومِ
والحجِّ
والزكاةِ
والجهادِ وما
يتّصل بها من
السننِ
والنوافلِ
والصدقاتِ؛
وكذلك تزكية
النفس
الإنسانية بالفضائلِ
والسِّيرَةِ
الحسنةِ وَالسُّلُوكِ
الْمِثَالِيِّ
الرفيعِ،
كالصبرِ،
والقناعةِ،
والزُّهدِ،
والعفّةِ،
والحيطةِ،
والتَّبَصُّرِ،
والوعيِ والْجُرْأَةِ،
وَحُبِّ
التعلُّمِ، وَحُبِّ
النَّظَافَةِ،
وَصَفَاءِ
السَّرِيرَةِ،
وتوقيرِ ذي
الشيبِ من
المؤمنين،
والرَّحْمَةِ
بِالصِّغَارِ
وَالضُّعَفَاءِ
وَالْمَرْضَى،
وَالشَّفَقَةِ
على خَلْقِ
الله من سائر
الإنس
والأحياء
-بشروطها- وَاللَّطَافَةِ
وَالْحِلْمِ
وَلِينِ الْجَانِبِ
في
المعاملةِ،
وتشميتِ
العاطسِ،
وإفشاءِ
السلامِ،
وبشاشةِ
الوجهِ، ومواساةِ
المغمومين،
وتعزيةِ
المحزونين،
وتسليةِ المهمومين،
والإحسانِ
بالجودِ
والكرمِ
والافتداءِ؛
والتحلِّي
بالأدبِ
والوقارِ،
والتعاونِ مع
أهل التوحيدِ،
ومشاركةِ
المؤمنين في
السرّاءِ
والضرّاءِ،
ومساعدتِهم
على تحقيق كلّ
هدفٍ يخدمُ
وحدةَ
المسلمين،
ويجمعُ
صفوفَهم
ويمهِّدُ
السبيلَ
لتوفيرِ
الحرّيّةِ
والعدالةِ الاجتماعيّة
والأمنِ والسِّلْمِ
والْهُدُوءِ
والطمأنينةِ
والسعادةِ
والرخاءِ
والازدهارِ
على وجه
البسيطة..
هذه
كلّها، هي
المراد بها من
كلمة »العمل
الصالح« الواردة
في مواطن
كثيرة من
القرآن
الكريم وعلى
صِيَغٍ
مختلفةٍ يضيق
المقام من
حصرها.
أمّا
قيام العبد
بإجراء مراسم النقشبنديّة
على وفق ما
ورد في شرح
مصطلحاتهم »هُوشْ
دَرْدَمْ، و
نَظَرْبَرْقَدَمْ،
و سَفَرْدَرْوَطَنْ،
و خَلْوَتْ
دَرْأَنْجمَنْ...
إلخ« بقصد
العبادة فإنّه
خروج على
الإسلام لا
جرم، وتحريف
لدين الله!
ومن
جملة ما عبث
به البغداديّ
وخلط في
عباراته
المذكورة
أيضا: إنّه
اختلق صلةً
موهومةً بين الرابطة
وبين كتاب
الله وسنّة
رسوله r.
فحاشا لله، أن
يكون في
كتابه، أو في
سنّة رسوله r
أدنى شيء يشير
إلى رابطة
الباطنيّة. بل
كتاب الله برئ
من هذه
الفرية. { لاَ
يَأْتِيهِ
الْبَاطِلُ
مِنْ بَيْنِ
يَدَيْهِ
وَلاَ مِنِ
خَلْفِهِ
تَنْزِيلٌ
مِنْ حَكِيمٍ
حَمِيدٍ}.[90]
كانت
هذه خلاصةٌ
لنشوب فتنة الرابطة
منذ أن أصبحت
ركنًا من
أركان هذه
النحلة بعد عودة
خالد
البغداديّ من
بلاد الهند،
فشوهد تطوّرٌ
كبيرٌ
وتغيُّرٌ جذريٌّ
في عقائد
الطائفة النقشبنديّة
عقب هذا الحدث
كما أثار
خلافًا كبيرًا
ونزاعًا
شديدًا بين
هذه الفرقة،
وبين رجال
الطريقة
القادرية. وهي
أيضًا فرقة من
الفرق
الباطنيّة.
أما
تعريف الرابطة،
فقد جاء في الرسالة
المذكورة نفسِها
لخالد
البغداديّ،
وهو يقول:
»إذ
هي في الطريقة
عبارة عن
استمداد
المريد من روحانيّة
شيخه الكامل
الفاني في
الله بكثرة
رعاية صورته
ليتأدّب،
ويستفيض منه
في الغيبة
كالحضور.
ويتمّ له
باستحضاره
الحضور والنور
وينزجر
بسببها من
سفاسف الأمور« [91]
لقد
ورد في هذا
المقطع من
كلام
البغداديّ
ثلاثُ نقاطٍ
خطيرةٍ لا
تتمّ الرابطة
إلاّ بها عند النقشبنديّة:
أُوّلُها: أن
يستمدّ
المريد من روحانيّة
شيخه؛ وثانيها:
أن يكون الشيخ
فانيا في الله
(؟!)؛ وثالثها: أن
يستحضر
المريدُ صورةَ
الشيخ في
ذهنه. وهكذا
تظهر خطورة
هذه العقيدة
بتمام
معناها؛
خاصّة عندما
يدّعي
أصحابها أنّهم
مسلمون!
***
* شروطُ الرابطة
وصورةُ
أداءِها.
فقد
جاءت
تعريفاتٌ
متفرّقةٌ في رسائلَ
مختلفة
لمتأخّري
شيوخ النقشبنديّة
حول شروط الرابطة
وصورة أدائها.
فالحقيقة،
وإنْ كان عددٌ
منهم قد
دوّنوا آدابَ
طريقتِهم،
كخالد
البغداديّ
ومن سار على
أثره من أمثالِ
محمّد بنِ عبدِ
اللهِ
الخانيِّ
وحفيدهِ عبدِ
المجيدِ بنِ محمّد
الخانيّ،
ومحمد أمينِ
الكرديِّ،
وجماعةٍ من
الترك؛ إلاّ
أنّنا لم
نَعْثُر لأحد
منهم حتّى
الآن على
كتابٍ يضمّ
بين دفتيه
جميعَ ما أُدْخِلَ
في عقيدةِ
هذهِ
الطائفةِ منذ
بدايتها إلى
اليوم. ولهذا
نجد شروطَ الرابطة
وصورةَ
أدائِها
متفرقةً في
رسائلَ
مختلفةٍ جمعناها
في هذا الباب.
وهو دليلٌ
آخرُ على أنّ كلّ
من أراد من
الشيوخ أنْ
يَفْرِضَ
هيمنتَه على
جماعةٍ من هذه
النحلةِ جاء
بشيء جديد.
وهكذا
استمرّت مسيرةُ
هذه الطريقة
ومصيرُ
أهلِها على أيديهم،
يتصرّفون في
توجيههم، وفي
آداب مَا تَلَقَّوْهُ
من ساداتهم؛
يزيدون فيها
تارة،
وينقصون منها
تارة أخرى، ممّا
لا يستقرّ
الأمر معهم
حتّى يتمكن
أحد من جمع مبتدعاتهم
في كاتب واحد.
***
خلاصة
ما قيل في
صورة أداء الرابطة
وشروطها:
أوّلها:
أنْ يكونَ
المريدُ قد
بايع »شيخًا
فانيًا في
الله« -على حدِّ
قولهم- وقد
وقعوا هنا في
تلفيق شديد
ينافيه العقل
السليم. إذ
أنّ المريد الّذي
يقصد شيخًا
ليبايعه، فهو
ما زال جاهلاً
بأمور
الطريقة
عندهم. إذن
فكيف به أن
يتأكّد من أنّ
الشيخَ الّذي
قصده قد فَنِيَ
في الله؟!
فضلاً عن أنّ
مثل هذه
الهرطقة حربٌ
علىالحنيفية.
هذا
هو أسلوبهم
المضّطرب
المتذبذب في
الصياغة
والتعبير
عمومًا وفِي
اخْتلاق
الآداب
والأركان
لِطَرِيقَتِهِمْ
خاصّة. يُطلقون
الكلمة على
عواهنها بصرف
النظر عمّا
سوف يطّلع
عليها أهل
العلم
والخبرة
فيفتضح
أمرهم؛ وذلك
إمّا عن جهلٍ
أو إمّا عن
حظِّ نفسٍ
والله أعلم
بما في
صدورهم.
ثانيها:
أن يكون
المريد
طاهرًا من
الحدث الأكبر
والأصغر.
وإنّما اشترط
من اشترط منهم
الطهارة
مكرًا،
ليواري هذه
البدعة
بلباسٍ من
شعار
الإسلام، وهو
الوضوء،
ولتكتسب الرابطة
بذلك صفةً
شرعيةً،
وصورةً من صور
العبادة، تفاديًا
لأيّ شكّ قد
يدبّ في مشاعر
المسلمين وتضليلاً
للغافلين. على
الرغم من أنّه
لم يتصدّ
أحدهم قائلا
بأنّها عبادة
إلاّ رجل من
أصل تركيّ
اسمه مصطفى
فوزي. وهو من
أتباع أحمد
ضياء الدين الْگُمُوشْخَانَوِيّ.[92] قال في
بيت من رسالته
المنظومة
باللّغة التركيّة
تحت عنوان »إثبات
المسالك في
رابطة السالك«
ومآله بالعربيّة:
»الرابطة
فريضة من جملة
الفرائض
الّتي
عَدَدُهَا
أربعة وخمسون
فريضة، وهي
دليل
العاشقين« [93]
وثالثها:
أن يكون الباب
مغلقا.
يستدلّون في
ذلك بحديثٍ.[94]
وحقيقة الأمر
ليس كذلك؛
وإنّما
ابتدعوا هذا الشرط
أسوة
بِرُهْبَانِ
البرهمية
الّذين ينـزعون
إلى الخلوات
استعدادًا
للّتأمّل
والتركيز.
علمًا بأن
العبادة في
الإسلام
عَلَنِيَّةٌ
كالصلاة
والصوم
والحجّ
والزكاة
والأضحية والجهاد
بمختلف
أشكالها. وإنّ
في ذلك لحكمةً
بالغةً
ودروسًا
وعِبَرًا
وتعليمًا
وتهذيبًا
للجمهور.
أمّا
إغلاق الباب،
فإنّه من أمر
البرهمية والرهبانيّةَ.
والرهبانيّةُ
سلوكٌ
روحانيٌّ
متطرّف،
وجمود، وخمول
وعزلة وتقشّف.
لها أشكال
متباينة من
الرياضة
الذهنيّة والبدنيّة؛
مؤدّاها
الكراهيّة
للحياةِ
ونضرتِها
وجمالِها
ونعيمِها
الّتي خلقها
الله ليتمتّع
بها عباده
بوجوه مشروعة.
ولا تمتّ
الرهبانيّة
بصلةٍ إلى
الإسلام.
وإنّما
الإسلام دين
حنيف،
ربّانيّ،
عَلَنِيٌّ،
ونظامُ حياةٍٍ؛
وسلوكٌ رفيعٌ؛
وعبادةٌ،
وطهارةٌ،
وفضيلةٌ،
وسياسةٌ،
ودراسةٌ،
وعلمٌ،
وبحثٌ،
ومعرفةٌ،
وهدايةٌ،
ونورٌ من وحيه
تعالى.
{يَهْدِي الله
لِنُورِهِ
مَنْ يَشَاءُ
وَيَضْرِبُ
الله اْلأمْثَالَ
للنَّاسِ
وَالله بكلّ
شيءٍ
عَلِيمٌ.}[95]
أما »التَّرْكِيزُ«
فما هو بشيء
في الإسلام؛
وليس له أدنى
علاقة بما جاء
في مواطن
كثيرة من القرآن
الكريم كقوله تعـالى
{ لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّرُونَ.}
وقوله تعالى {
لَعَلَهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ.}
وما في هذا
المعنى...
وَأَمَا »رابِطَةِ
النقشبنديّة«،
إنّما هو نوع
من تمارين »اليوغا«،
كما سبق البحث
عنه في موضوع »حَبْسِ النَّفَسِ«.
وأمّا ما
يتعلق بمفهوم »التَّرْكِيزِ«،
فيقول المؤلِّفان:
المستشرق ج.
توندريو، وعالم
النفس، ب.
رئال في
كتابهما »اليوغا«.
» التَّرْكِيزُ:
وهو تثبيت
الفكر على
نقطة واحدة،
أو شيء، أو فكرة،
أو عن المطلق«.
ويقولان
أيضًا: »هو
مقدرتك على
تثبيت الفكر
على نقطة
خاصّة معيّنة« [96]
فتبيّن
بهذا أنّ
التركيز، ليس
شكلاً من
أشكال العبادة؛
ولا فيه طلب
لمرضاة الله
تعالى بمحض
هذا المعنى،
وإن كان مُسْتَوْحى
من الديانات
الهنديّة.
وإنما هو
بمجرّد فعله
تمرينٌ
ذهنيٌّ
عقلانيٌّ غايته:
السيطرة على
الأعصاب،
ليتحكّم
الإنسان بها
على نفسه،
فيقودها إلى
ما فيه صلاحه.
وقد تكون فيه
مصالح كثيرة -
على أنْ لا
يتعدّى هذا
الحد غايته-
كترويح
الذهن،
وإجلاء
الهموم
والغموم،
ورفع الأعباء
عن العقل
والجسم،
خاصّة وفي عصرنا
الّذي تعاني
نفسيّة
الإنسان في
ظروفه
القاهرة
المدمّرة
للأعصاب من
جرّاء ما
يشاهد، أو
يقرع سمعه من
أحداثٍ
داميةٍ، وقلاقلَ
واضطراباتٍ
وضجيج. فقد
شاع بين الناس
استعمال
العقاقير
والمخدِّرات
والكحول؛ وانهمكوا
في اللّهو
والمجون
والدعارة
كنتيجة لهذه
الأسباب. لأنّ
الإنسان
المعاصر
التعيس الّذي
لم يعد يحظى
من قوّة
الإيمان
بالله واليوم
الآخر، فقد
ضعفت صلتُهُ
وثقتُهُ
بربّه وتلاشت
معنويّاته،
وبالتالي
أصبح في دوامة
عمياء تساوره
الهواجس،
وينتابه
القلق،
وتزدحم أفكار
رهيبة في
ذهنه.
فإذا
كان مراده
الخلاصَ من
مشاكله
النفسية، والقضاءَ
على ما يعاني
من التوتّر
والأرق
والخوف
والقلق،
كحلٍّ
طبّيٍّ؛ لا
نجد في
الإسلام ما
يمنعه من
القيام
بتمارين
رياضية لا
تتعارض في
شكلٍ من
أشكالها مع
شيء من تعاليم
الإسلام.
ولكن
شيوخ النقشبنديّة
قد جاوزوا به هذا
الحدّ إلى
تثبيت الفكر
على صورة
الشيخ. فجعلوا
منه شرطًا
أساسيًّا
للرّابطة.
أمَا
مَنْ رأى منهم
إغلاقَ الباب
أقرب إلى
الإخلاص في
العبادة،
فانهم أصلا لا
يعبدون الله
وحده -وإن
نفوا هذا
الاتهام بشدَّةٍ-
بل موقفهم من
مشائخهم
يتميّز
بإجلالٍ
خَاصٍّ، يظهر
من خلال ما
يصفونهم
ويرابطونهم
في صورة من
الإشراك
بالله.
هذا،
ولا يتمّ
الإخلاص لله
سبحانه إلاّ
بالتوحيد الْخالص
ونفي جميع
الأنداد. إذ
لا إخلاص مع الإشراك.
ثمّ إنّ
الإخلاص لا
يتوقّف على
الإسرار في
العبادة،
وإلاّ وجب حظر
الإعلان في
سائر الطاعات
وذلك مخالف
للشّرع، إلا
في أمورٍ
خاصّة ونادرةٍ،
كالتطوُّع
والتصدُّق،
تفاديًا لطلب
السمعة
والرياء. وهذا
لا يُسْحَبُ على
سائر العبادات.
ورابعها:
أن يختار
المريد
محلاًّ تغلب
فيه الظلمة
إذا كان الوقت
نهارًا. أو
يعدّه بصورة
خاصّة، كإسدالِ
الستائرِ على
النوافذِ أو
إطفاءِ
المصابيحِ
إذا كان الوقت
ليلاً.
وخامسها:
أن يغمض
المريد عينيه
أثناء الرابطة.
وسادسُها
: أن يراقبَ
أنفاسَه في كلّ
زفيرٍ وشهيق.
وسابِعُـها:
أن لا يتحرّك
من مكانه.
وثامِنُـها
: أن يستحضر
صورةَ شيخِهِ
في خياله على
المنوال
الّذي سبق في
موضوع التركيز.
وعلى هذا
الشرط مدارها.
وتاسِعُها:
أن يستمدَّ من
روحانية شيخه.
والمريد مُلْزَمٌ
بأداء الرابطة
لشيخه في معظم
أوقاته. وإلاّ
فهو
مُهَدَّدٌ
بانقطاع
البركة عنه!
فإنّ
جميع هذه
الأمور
مستوحاة من
الديانات الهندية
ما عدا الشرط
الثاني لسببٍ
ذكرناه آنفا.
***
* أوّل
مَنْ أحدث الرابطة.
إنّ
أوّل مَنْ
تصوّر هذا
الشكلَ
المخصوصَ لربط
المريد
بالشيخ في
الطريقة النقشبنديّة.
هو عبيد الله
الأحرار وإن
كانت جماعةٌ
من هذه
الطائفة
تدّعي أنّها مأثورة
عن أبي بكر
الصديق رضي
الله عنه. فلا
نعثر على اسم
من نطق بهذه
الكلمة قبل
الروحاني المعروف
بـ »الأحرار«
وذلك، ورد بحث
الرابطة
مرتين في كتاب
الرشحات.[97]
جاء فيهما أنّ
الأحرار أوصى
بها فحسب. ولم
يزد المؤلّف
على ذلك مما
يدل على أنّ الرابطة
لم تكن أمرًا
هامًا ولا »ركنا عظيمًا« من
أركان هذه
الطريقة
يومئذ كما
يدلّ على أنّ
هذه الفكرة
تطوّرت مع
الزمان
وخاصّةً بعد
أن قفزت
الطريقة النقشبنديّة
إلى الهند في
عهد الباقي
بالله
الكابُليِّ. ثم
بعد ذلك
تناولها شيوخ
هذه الطائفة
الّذين نشأوا
في تلك
البلاد،
وبنوها على
أسس مستوحاة
من البرهمية
والبوذية
المنتشرتين
في الهند. إلا
أنّ الرابطة
لم تكن أمرًا
هامًّا في
عهدهم أيضًا
إذ لم يتناولها
إلاّ رجلان
منهم. أحدهما
أحمدُ
الفاروقيُّ
السرهنديُّ
المعروفُ بين
أتباع هذه
النحلة بـ »الإمام
الربّانيّ«. فقد
جاء في رسالة
فارسية له،
بعثها إلى شخص
اسمه أشرف
الكابُلي،
جاء فيها:
»إنّ
هذه الرسالة
موجّهة إلى
خواجه أشرف
الكابلي في
بيان أنّ الرابطة
أنفع للمريد
من الذكر.
أمّا الّتي
كتبها الأصدقاء،
فقد نظرتُ في
مضمونها،
واطّلعت على
الأحوال
المسطورة
فيها. واعلموا
أنّ رابطة
الشيخ لكلّ
مريد بلا
تكلّف ولا
تصنّع هي
دلالة على
مناسبةٍ
تامّة بين
المرشد والمريد.
وهي سبب
للإفادة
والاستفادة
ولا طريق للوصول
أقرب من طريق الرابطة.
ومن سلكها فهو
سعيد.«
»لقد
ورد في كتاب
الفقرات
لخواجه
أحرار... إنّه
قال: القول
هنا باعتبار
النفع. يعني
ظلّ المرشد
أنفع للمريد
من أن يشتغل
المريد بذكر
الله...إلخ« [98]
إذًا
يتّضح لنا أنّ
الرابطة لم
تكن في عهد
الربّانيّ
ركنًا من
أركان الطريقة
النقشبنديّة؛
فضلاً عمّا
قبله. وإنّما
خالد
البغداديّ هو الّذي
وضع لها تعريفًا
خاصًّا، وزاد
على هذا
التعريف منَ جاء
بعده من خلفائه
كما وضعوا لها
شروطًا
ورتّبوها على
هيئة من النسك
حتّى اعتقدها
جماعة من
أتباعهم
أنّها شكل من
أشكال
العبادة. وسعى
كثير منهم
لأدائها
والدفاع عنها
تقرّبًا إلى
الله، وهم
يجهلون أنّه
لا يتقرّب
العبد إلى
الله إلا بما
جاء في كتاب
الله وسنّة
رسوله r من
أشكال
العبادات كما
يجهلون أنّ
الكتب المنـزلة
قبل سيّدنا محمّد
r
إنّما حرّفها
اليهود
والنصارى
بأمثال هذه البدع
{وَقَدْ كَانَ
فَرِيقٌ
مِنْهُمْ
يَسْمَعُونَ
كَلاَمَ
اللهِ ثُمَّ
يُحَرِّفُونَهُ
مِنْ بَعْدِ
مَا
عَقَلُوهُ
وهُمْ يَعْمَلُونَ}
وقد قال الله
تعالى فيهم: {
فَوَيلٌ
للّذِينَ
يَكْتُبُونَ
الْكِتَابَ
بِأَيْدِيهِمْ
ثُمَّ
يَقُولُونَ هَذَا
مِنْ عِنْدِ
الله
لِيَشْتَرُوا
بِهِ ثَمَنًا
قَلِيلاً،
فَوَيْلٌ
لَهُمْ
مِمَّا كَتَبَتْ
أَيْدِيهِمْ،
وَوَيْلٌ
لَهُمْ مِمَّا
يَكْسِبُونَ}[99]
أما
الرجل الثاني
الّذي تناول الرابطة
بعد عبيد الله
الأحرار، هو
تاج الدين بن
زكريا بن
سلطان
الهنديّ زميل
أحمد
الفاروقيّ.
جاءت في عُجَالَتَيْنِ
له عباراتٌ
مختصرةٌ حول الرابطة.
منهما
الرسالة
المعروفة بـ»التاجية«.
قال في مقطع
منها:
»الطريقة
الثانية:
طريقة الرابطة
بالشيخ الّذي
وصل إلى مقام المشاهدة
وتحقّق
بالتجلّيات
الذاتيّة.
فإنّ رؤيته
بمقتضى -هم
الّذين إذا
رأوا ذكر الله-
تفيد فائدة
الذكر. وصحبته
بموجب -هم جلساء
الله- ينتج
صحبة
المذكور،
وإذا تيسّر
صحبة مثل هذا
العزيز،
ورأيت أثره في
نفسك، فينبغي لك
أن تحفظ ذلك
الأثر الّذي
تشاهد فيك
بقدر الإمكان.
وإن حصل لك
ببركة ذلك
الأثر. هكذا
تفعل مرة بعد
أخرى، متى
تصير تلك
الكيفية ملكة
لك. وإن لم
يظهر من صحبة
ذلك العزيز
أثر، ولكن
حصلت به محبة
وانجذاب،
فينبغي أن
تحفظ صورته في
الخيال
وتتوجه للقلب
الصنبوريِّ،
حتّى تحصل لك
الغيبة
والفناء عن النفس.
وإن وقفت عن الترقي،
فينبغي أن
تجعل صورة
الشيخ على
كتفك الأيمن
في خيالك
وتعتبر من
كتفك إلى قلبك
أمرًا ممتدًّا.
وتأتي بالشيخ
على ذلك الأمر
الممتّد
وتجعله في
قلبك فإنّه
يرجى لك بذلك
حصول الغيبة
والفناء« [100]
***
وقال
تاج الدين بن زكريا
فيما دوّنه
تحت عنوان »آداب
المشيخة والمريدين«: »فطريق الرابطة
-وهي رابطة
القلب مع
الشيخ-:
فرؤيته
بمقتضى -الّذين
إذا ذُكر
الله- تحصل
لهم الفائدة
كما تحصل
الفائدة من
الذكر بموجب
-هم جلساء
الله- لأنّ
الشيخ
كالميزاب، ينـزل
الفيض من بحره
المحيط. وإنْ
وجد الفتور في
الرابطة،
فيحفظ صورة
شيخه في خياله
بموجب -المرء
مع من أحب-
فيحفظ
الصورة، يتحقق
ويتّصف
المريد
بأوصافِ
وأحوالِ
الشيخ كما كان
له« [101]
هكذا
يبدو أن الرابطة
لم تَعْدُ هذا
الحدَّ من التَّطَوُّرِ
إلا بعد مُضِيِّ
ثلاثمائةِ
عامٍ على موتِ
عبيدِ اللهِ
الأحرار؛
أوّلِ من نطق
بهذه الكلمة،
حتّى جاء خالد
البغداديّ
فبناها على
شروطٍ عِدَّةٍ
ذكرناها
آنفا؛ وجعل
منها »أصلاً
من أصول
الطريقة النقشبنديّة«؛
كما يبدو في
الوقت ذاتِهِ
من هذه
العبارات الرّكِيكَةِ
الجافّةِ
الخاليةِ من
آثارِ الذَّوقِ
السّلِيمِ
أنّ شيوخَ هذه
الطائفةِ كانوا
ولا يزالونَ
بِمنْأى عن
العلمِ والمعارِفِ
والبلاَغةِ
والثَّقَافِةِ...
***
* الغاية
من الرابطة
الرابطة
من حيث الغاية
ليست إلاّ
وسيلة لترويض
المريد على
تبعية الشيخ بكلّ
ما يملك من
نفس ومال
ومقدرة.
ويؤكّد على
هذه الحقيقة
ما قد ورد في
مقولات شيوخ
الطريقة من ترغيب
المريد على
الاستسلام المطلق
للشّيخ. بل
وإنّ طاعة
المرشد عند
هذه الطائفة،
من أهمّ آداب
المريد مع
شيخه. وقد
جعلوها شرطًا
مفروضًا على كلّ
من ينخرط في
سلكهم كما مّر
ذكره في باب »البيعة«.
كذلك رابطة
الشيخ (أي
استحضار
صورته في الذِّهْنِ)
أفضلُ من ذكر
الله عندهم،
كما ورد في
فقرات الأحرار.
إذًا
يجب هنا
التفريق بين
كلمتي »البيعة«
و »الاتّباع«
إذ لا مسَاغَ للإتّباع
في »آداب
المريد مع
شيخه« وإنّما
المطلوب من
المريد أن
يكون
تَبَعِيًّا
وليس
مُتّبِعًا
لأنّ
المتَّبِع
يتماشى مع
المتَّبَع عن
وعيٍ ويوافقه
عن فكرٍ
وتعقُّلٍ بعد
استكشاف
العلل ومقارنته
الأسبابَ،
وبحثه في
المقدمات؛
ليستخلص النتائج
منها بالحكم
والتصديق
وهذا من صفات المؤمنين
المتسنّنينَ بالأنبياء
عليهم الصلاة
والسلام؛
كأصحاب سيّدنا
محمّد r،
ورضوان الله
عليهم
أجمعين. أمّا
الإنسان
التبَعيُّ
فليس أمره
كذلك. وإنّما
هو مسلوب
الإرادة،
مضطرّ لا خيار
له، ولا علم
له بما قد
سُلب منه.
ولكّنه ليس
كمن هو
مضطهَدٌ
مقهورٌ
ومكرَهٌ على
فعل شئ أو
تركه؛ ولا مثل
من تحكّم فيه
ظالم لا طاقة
له به؛ ولا
كمن هو مولّعٌ
بشخص لحسنه
وجماله؛
ولكنّه
مغفَّلٌ مطبوعٌ،
جَذَبَهُ
دجّالٌ من
ورائه، فألقى
عليه
محبَّتَه
وهيبتَه بدعاياتٍ
خلاّبةٍ
ودعواتٍ
ماكرةٍ
وحِيَلٍ شيطانيةٍ
كما يفعله بعض
شيوخ
الصوفيّة من
طأطأة الرأس، والتصنع
في اللّباس
والكلام،
وأَمْرِ المريدين
بأورادٍ
غريبةٍ
ومناسكَ
دخيلةٍ مثل عدّ
الأذكار
بالْحُصِيِّ
والمسبحة،
وبكميات معينة
يحدّدها لهم.
ذلك أنّ
لِلْكثرة
والحجم
تأثيرًا
عظيمًا على
نفسية
الإنسان
الجاهل. إنّه يوقّر
الهامةَ
الضخمةَ،
خاصّة إذا
كانت فوقها
عمامة من
لفائف
مكدّسة؛
يتهيّب
الزحامَ،
وينجرف من
وراء الدهماء
وهو دومًا
ذَنَبٌ؛ لا
رأي له يستقلّ
به؛ وهو رمز
الحماقة في
التصفيق
عندما يصفّق
الناس، وإن
كان لا يدري
لماذا
يصفّقون،
ولماذا
يطبّلون!
ولهذا يجوز أن
نقول إنّ الرابطة
وسيلةٌ خاصّة
لاصطياد هذا
النوع من
العامّة ورَبْطِهِ
بالشيخ بحيث
لا يكاد ينفكّ
منه. وإنْ رآه
يرتكب
الحرام،[102]
ويطيعه في
معصية الله مع
أنّه »لاَ
طَاعَةَ فيِ
مَعْصِيَةِ
اللهِ،
إنَّمَا
الطاعَةُ فيِ
مَعْرُوفٍ« [103]
***
* عقوبة
المخلّ بآداب الرابطة
عند النقشبنديّة.
تتميّز
الطريقة النقشبنديّة
بين سائر طرائق
الصوفيّة
بنظامها
وآدابها
الّتي
ساعدتها على
التوسّع
والانتشار في
صفوف ملايين
الناس عَبْرَ
القرون. وهي
كفيلة
بقيامها
ودوامها حتّى
هذه الساعة بحكم
هيمنتها على
القلوب
وترسيخ
عقائدها في
قريرة النفوس.
ويعود السبب
الأساسيُّ في
ذلك إلى
الآداب الّتي
تقوم عليها
علاقةُ الخلف
بالسلف وموقفُ
المريد من
الشيخ في هذا
المذهب
الخطير.
لقد
سبق الكلام في
باب تعريف الرابطة
وشروطها،
بأنّ المريد
يجب عليه أن
يكون على صلة
دائمة مع شيخه
بأداء الرابطة
له. »وإلا
انقطعت
البركة عنه« فهو
يرى نفسه
مهدّدا بذلك
إذا فتر باله
عن شيخه ولو
لحظة. هذا من
جملة
اعتقادهم في
مسألة الرابطة.
وقد أحدث بعض
المتأخّرين
من شيوخ هذه
الطائفة
شرطًا آخر في
الطريقة
ليتأكّد به
صلة المريد
بالشيخ أكثر
مما هي في البداية.
وذلك أن يحملَ
المريدُ
نسخةً من
الصورة
الفوتوغرافية
لشيخهِ معه. فينظر
إليها كلّما
وجد فرصةً.
وهم أتباع
سليمان حِلْمِي
طُونُاخُانْ،
وأتباع الملاَّ
عبد الحكيم
البِلوانِسيّ.[104]
وإذا
كانت الرابطة
من أعظم أركان
الطريقة النقشبنديّة،
فانّ القاعدة
الأساسيّة فيها
(بالنسبة
للخليفة
المأذون) أن
لا يأمر المريدين
برابطة نفسه،
إذا كان شيخه
لا يزال على قيد
الحياة. بل
يجب عليه أن
يأمرهم
برابطةِ مَنْ
أَذِنَ له
بالخلافة.
أما
إذا خالف
النائبُ هذه
القاعدةَ
فإنّه يُعَدُّ
ممّن نقض
العهدَ. وَيَحْكُمُ
عليه شَيْخُهُ
بِالطَّرْدِ
من الطريقة.
وهو أشدّ
عقوبةً عندهم.
لأنّ من
طُرِدَ من
الطريقة،
فإنّه يُعَدُّ
كذلك مطرودًا
من باب الله
ومن باب رسوله
في اعتقادهم؛
فيتبرّؤن
منه، وإنْ لم
يَرِدْ في
مدوَّناتهم
ما يفيد أنهم
يحكمون عليه
بالكفر.
وبهذا
يفتضح سرٌّ
آخر من
أسرارهم
بأنهم يتقلّبون
في أمواج من
التعارض
والتناقض
وتزداد
الشقّة بذلك
بينهم وبين
الإسلام. لأنّ
المسلم لا يجوز
له أن يتبرّأ
من المسلم ما
لم يجده قد خلع
رقبة الإسلام
من عنقه.
أما
الطرد في
الطريقة النقشبنديّة،
كما شرحناه
فيما أصدرنا
تحت عنوان: »موقف ابن
عابدين من
الصوفيّة
والتصوف« [105] فإنه
موضوع هامٌّ
وعقوبة شديدة
عند هذه الطائفة.
ويبدو
أنّ الّذي
أحدث هذه
القاعدة هو
خالد البغداديّ.
فقد جاء فيما
كتبه بعض
النقشبنديّين،
أنّ خالدًا
طرد عبد الوهّاب
السوسيّ،[106] إذ كان
نائبًا عنه في
مدينة
إسطنبول. لأن
عبد الوهّاب
أمر المريدين
برابطة صورته،
فأصبح بذلك
منافسًا لمن
يستخدمه.
بينما كان يجب
عليه حسب آداب
الطريقة أن
يأمرهم برابطة
خالد
البغداديّ الّذي
أحدث قاعدة الطرد،
كما أحدث
للّرابطة شروطًا
وآدابًا
خاصّة. فتطوّر
النـزاع
بينهما إلى حدود
خطيرة. كما
سنشرحه في
نهاية الفصل
الرابع إنْ
شاء الله تعالى.
كذلك
نائبه الّذي
كان قد أرسله
إلى داغستان
-وهو إسماعيل
الشيرواني-
لما بلغ
خالدًا أنّ خليفتَه
هذا يأمر
المريدين
برابطة نفسه
(بدل أن يأمرَهم
باستحضار
صورة شيخه
-خالد-)، وجّه
إليه كتابًا
يهدّده فيه.
فقد
نَقَلَتْهُ
جماعةٌ من
النقشبنديّين
بنصّه الكامل
ضمن ما جرت به
أقلامهم من
رسائلَ
دوّنوها في
شؤون طريقتهم.
لا
شكّ أنّ
الطريقة النقشبنديّة
قد اكتسبت
مناعةً بهذه
الضوابط
الّتي هي بمنـزلة
نصوص من كتاب
الله عندهم.
إذ لها حرمة
عظيمة في
اعتقادهم،
كما لها إمكان
التنفيذ من قِبَلِ
مشائخهم في كلّ
ساحة انتشروا
فيها.
***
* استدلالهم
في إثبات الرابطة
ومقالاتهم في
الدفاع عنها
وما قيل في
ردّها.
لقد
حاول عدد من
مشائخهم أنّ
يدافعوا عن الرابطة،
فبذلوا ما
عندهم من
جهود،
وأفرغوا ما
يملكون من
طاقة تندهش
منها العقول.
ذلك أَبَوْا
إلاّ يكون لها
أساس من
الكتاب
والسـنّة؛
فضاق بهم
الأمر حتّى
استدلّوا
بآيتين
كريمتين من
كتاب الله،
وهي قوله
تعالى {يَا
أَيُّهَا
الّذينَ آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.}[107]
وقوله تعالى:
{يَا أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ.}[108]
وأَتْبعوهما
بحديث »المرء
مع من أحبّ« [109]
بهذا
الأسلوب
الغريب
أرادوا أن
يُثبتوا الرابطة
ويجعلوها
شكلاً من
أشكال
العبادة في
الإسلام. ولكن
فشلوا في
محاولتهم.
وقام عليهم
الدليل من
خلال ما
استدلوا به.
إذ لا نجد بين
طبقات المفسّرين
من علماء
الإسلام
أحدًا أشار
إلى الرابطة (وبشكلها
الّذي رسمها
رُهْبَانُ
هذه النحلةِ) في
تفسير
الآيتين
المذكورتين،
ولا محدّثًا رَمَزَ
إليها بكلمةٍ
واحدةٍ من
أحاديث
الرسول r.
فيبدو
وبكل وضوح أنّ
أحَدَهُمْ لم
يُرْهِقْ
نفسه حتّى
بمراجعة
مصدرٍ واحدٍ
من تفاسير علماء
الإسلام
ليتأكّد من
معنى الآيتين
المذكورتين.
أمّا
انصرافهم عن
مراجعة كتب
التفسير على
كثرة عددها،
فليس من علامة
ثقتهم بما
عندهم، أو لإعجابهم
بما سوّلت لهم
أنفسهم
فحسب، بل
يبرهن ذلك على
مبلغهم من
العلم بطرق
الاستدلال.
لأنّ من
استدلّ بآية
كريمة وجب
عليه في الخطوة
الأولى أن
يتأكّد من سبب
نزولها. ثم يترتّب
عليه أن
يتحرّى
المناسبة
بينها وبين
الموضوع
الّذي يربطه
بها.
إنّ
الآية
الكريمة { يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ.}
هي تتمّة لما
قبلها. وهو
قوله تعالى {
إِنَّمَا
جَزَاءُ
الّذينَ
يُحَارِبُونَ
اللهَ
وَرَسُولَهُ،
وَيَسْعَوْنَ
فيِ
اْلأَرْضِ
فَسَادًا، أَنْ
يُقَتَّلُوا
أَوْ
يُصَلَّبُوا،
أَوْ تُقَطَّعَ
أَيْدِهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ
مِنْ
خِلاَفٍ،
أَوْ
يُنْفَوْا
مِنَ
اْلأَرْضِ.
ذَلِكَ
لَهُمْ
خِزْيٌ فيِ
الدنْيَا.
وَلَهُمْ فيِ
اْلآخِرَةِ
عَذَابٌ
عَظِيمٌ *
إِلاّ الّذينَ
تَابُوا مِنْ
قَبْلِ أَنْ
تَقْدِرُوا
عَلَيْهِمْ،
فَاعْلَمُوا
أَنّ اللهَ
غَفُورٌ
رَحِيمٌ.}[110]
فقد
ورد في عددٍ
من مصادر
التفسير بأنّ
هذه الآيات
نزلت في
المشركين،
وليس فيها
أدنى دلالة
تَمُتُّ
برابطة
النقشبنديّين.
فالعجب العجب
من أمر هذه
الطائفة،
أنّهم كلّما
وجدوا عالمًا
من علماء
الإسلام
يستدلّ بآيةٍ
كريمةٍ على
شِرْكِِ مَنْ
يدّعي أنّه
مؤمن وهو
يتمرّغ في
أوحالِ الزندقة
والإشراكِ
باللهِ على
مرأى من
الناس، جُنَّ
جُنُونُهُمْ،
وثاروا عليه،
وتصنعّوا
بالدفاع عن أنفسهم:
أنّ »حَمْلَ
هذه الآيةِ
الكريمةِ منه
على عوام الموحّدين
زور وافتراء
وتلبيس«؛ وكيف
بهم أنّهم قد
تشبّثوا بآية
كريمة نزلت في
المشركين
فاستدلّوا
بها في إثبات
رابطتهم وليس
بينهما أدنى
قرينة؟!![111] لقد روى
البُخَاريّ
ومسلم في سبب
نزول الآية
المذكورة
آنفا »من
حديث
أَبِي
قِلاَبَةَ عن
أَنَس بْنِ
مَالِكٍ:
أَنَّ نَفَرًا
مِنْ عُكْلٍ
ثَمَانِيَةً
قَدِمُوا
عَلَى
رَسُولِ
اللهِ r
وَبَايَعُوهُ
عَلَى
الإِسْلاَم؛ِ
فَاسْتَوْخَمُوا[112]
اْلأَرْض،َ
فَسَقِمَتْ
أَجْسَامُهُمْ،
فَشَكَوْا
ذَلِكَ إِلَى
رَسُولِ
اللهِ r.َ
فَقَالَ
أَلاَ
تَخْرُجُونَ
مَعَ رَاعِينَا
فِي إِبِلِهِ
فَتُصِيبُونَ
مِنْ
أَبْوَالِهَا
وَأَلْبَانِهَا؟
قَالُوا
بَلَى.
فَخَرَجُوا،
فَشَرِبُوا
مِنْ أَبْوَالِهَا
وَأَلْبَانِهَا،
فَصَحُّوا، فَقَتَلُوا
الراعِيَ
وَأَطْرَدُوا
النعَمَ.[113]
فَبَلَغَ
ذَلِكَ
رَسُولَ
اللهِ r.
فَأَرْسَلَ
فِي
آثَارِهِم،ْ
فَأُدْرِكُوا.
فَجِيءَ
بِهِمْ،
فَأَمَرَ
بِهِم،ْ
فَقُطِّعَتْ
أَيْدِيهِمْ
وَأَرْجُلُهُمْ
وَسُمِرَتْ
أَعْيُنُهُم؛ْ
ثُمَّ
نُبِذُوا فِي
الشمْسِ حتّى
مَاتُوا« [114]
أمّا
الآية
الثانية وهي
قوله تعالى: {
يَا أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهَ وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}[115] فقد
أجمع العلماء
على أنّ هذه
الآيةَ وما
قبلها نزلت في
غزوة تبوك،
حيث لا يغيب
على ذي لُبٍّ
ما تتضمّن هذه
الآيات من
توبة الله
سبحانه على
النبي
والمهاجرين
الّذين اتّبعوه
في ساعة
العسرة،
وكذلك على
الثلاثة
الّذين
خُلِّفوا. وهم
كعب بن مالك،
ومُرَارَةُ
بن الربيع
العامري،
وهلال بن أميّة
الواقفي.
نعم
هذه الحقائق
لا تغيب عن
أيّ ذي علم
بكتاب الله
تعالى، ولكن
غابت عن شيوخ النقشبنديّة.
ولا نقول
أنّهم أرادوا
بذلك أن
يحرّفوا كتاب
الله ظلمًا
وعدوانًا،
فتواطؤا فيما
بينهم على
تأويل هذه
الآية في
إثبات الرابطة؛
ولكن نقول:
إنّهم
تورّطوا في
هذا المأزق
اغترارًا بمن
افترى على
الله كذبًا.
واقْتَفَوْا
أثَرَ مَنْ تَعَمَّدَ
بهتانًا عظيمًا،
فسوّلت له
نفسه أن
يستدلَّ بهذه
الآية الكريمة
ليُلْصِقَ
تلك الهرطقة
الْمُقْتَبَسَةَ
وَالْمُقَلَّدَةَ
مِنْ عقيدة
سَحَرَةِ
الهند بعقيدة
المسلمين.
وهذا من
غبائهم
وإعجابهم بمن
أصبح محلّ
الثقة منهم
فِيهِ حتى ولو حرّف
كتابَ الله! فاتَّبَعُوهُ
وخالفوا
الجمهور بهذا
الرأي السقيم
في تفسير الآيتين
المذكورتين،
وشذّوا بذلك
عن الجماعة
أيّما شذوذ!
أمّا
علماء
الإسلام فقد
جاءت نظرتهم
منسجمة متقاربة
في تفسيرهما
من حيث الأصل
وإن اختلفت
ألفاظهم كما
ستتبيّن من
عباراتٍ
نقلناها من
تصانيف عدد
منهم تمحيصا
للأمر:
قال
أبو جعفر محمّد
بن جرير
الطبري في
تفسير الآية
الخامسة والثلاثين
من سورة
المائدة:
{وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ}
يقول: اطلبوا
القرابة إليه
بالعمل بما
يرضيه، والوسيلة
هي الفعيلة. من
قول القائل
توسّلتُ إلى
فلان بكذا أي
بمعنى تقرّبتُ
إليه. ومنها
قول عنترة:
»إنّ
الرجال لهم
إليك وسيلة *
أن يأخذوك
تكحّلي
وتخضّبي«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة: »وإنّما معنى
الكلام
{وَكُونُوا
مَعَ الصادِقِينَ}
في الآخرة
باتقاء الله
في الدنيا (...)
فَسَّرَ ذلك
مَنْ فَسَّرَهُ
من أهل
التأويل بأنْ
قال معناه:
كونوا مع أبي
بكر وعمر أو
مع النبي r
والمهاجرين
رحمة الله
عليهم.«
»حدثنا
ابن وكيع عن
يزيد بن أسلم
عن نافع. قال: قيل
للثّلاثة
الّذين
خُلِّفوا {
يَا أَيُّهَا الّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِين.َ}
محمّد
وأصحابه« [116]
ومن
هؤلاء
المفسرين
صاحب الكشاف
أبو القاسم جار
الله محمود بن
عمر
الزمخشري؛
قال في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»الوسيلة:
كلّ ما يتوسّل
به. أي يُتقرب
من قرابة أو
صنيعة أو غير
ذلك.
فاستُعيرتْ
لما يُتوسَّل
به إلى الله
تعالى من فعل
الطاعات وترك
المعاصي.«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة: »{مَعَ
الصادِقِينِ}...وهم
الّذين صدقوا
في دين الله
قولاً وعملاً
أو الّذين
صدقوا في
إيمانهم
ومعاهدتهم
لله ورسوله
على الطاعة من
قوله { رِجالٌ
صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا اللهَ
عَلَيهِ.}.
وقيل هم
الثلاثة. أَي
كونوا مثل
هؤلاء في
صدقهم
ونياتهم« [117]
ومن
أعلام
المفسرين أبي
عبد الله فخر
الدين محمّد
بن عمر بن
الحسن بن
الحسين
الّتيميِّ
البكريّ
الرازي؛ قال
في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة »كونوا
متّقين عن
معاصي الله
متوسلّين إلى
الله بطاعات
الله.«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة: »{يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}
يعني مع الرسول
وأصحابه في
الغزوات؛ ولا
تكونوا
متخلّفين
عنها وجالسين
مع المنافقين
في البيوت« [118]
ومن
كبار
المفسّرين محمّد
بن أحمد بن
أبي بكر بن
فرج الأنصاري
الخزرجي الأندلسي؛
قال في تفسير
الآية
الخامسة والثلاثين
من سورة
المائدة:
»قوله
تعالى: {يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ}
الوسيلة: هي
القربة؛ عن
أبي وائل
والحسن
ومجاهد
وقتادة وعطاء
و السدي وابن
زيد وعبد الله
بن كثير، وهي
فعيلة من توسّلتُ
إليه أي
تقرّبت. قال
عنترة:«
»إنّ
الرجال لهم
إليك وسيلة *
أن يأخذوك
تكحّلي
وتخضّبي«
والجمع
الوسائل قال:
»إذا
غفل الواشون
عُدنا
لِوصلنا *
وعاد التصافي
بيننا والوسائل«
ويقال:
منه سلتُ
أسأل. أي
طلبتُ. وهما
يتساولان. أي
يطلب كلّ واحد
من صاحبه؛
فالأصل
الطلب؛
والوسيلة القربة
الّتي ينبغي
أن يطلب بها.
والوسيلة
درجة في الجنة
وهي الّتي جاء
في الحديث
الصحيح بها في
قوله u: »فمن
سألَ لي
الوسيلة حلّت
له الشفاعة«
وقال
المصنف أيضا
في تفسير
الآية
السابعة والخمسين
من سورة
الإسراء وهي
قوله تعالى: {
أُؤلَئِكَ
الّذينَ
يَبْتَغُونَ
إِلَى رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}
» قال: نفر
من الجنّ
أسلموا،
وكانوا
يُعبَدون.
فبقي الّذين
كانوا يَعبُدون
على عبادتهم،
وقد أسلم
النفر من الجنّ،
فاسلم
الجنّيون،
والإنسُ
الّذين كانوا
يَعْبُدُونَ
لا يشعرون؛ فنـزلت
{ أُؤلَئِكَ
الّذينَ
يَبْتَغُونَ
إِلَى رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشر
بعد المائة من
سورة التوبة:
»قال
الإمام أحمد:
حدّثنا أبو
معاوية
حدّثنا
الأعمش عن
شقيق، عن عبد
الله، وهو ابن
مسعود رضي
الله عنه قال:
قال رسول الله
r:{يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}
أي أصدقوا وألزموا
الصدق تكونوا
من أهله،
وتنجوا من المهالك،
ويجعل لكم
فرجًا
ومخرجًا. وقال
الإمام أحمد،
حَدَّثَنَا
أَبُو
مُعَاوِيَةَ،
حَدَّثَنَا
الأَعْمَشُ
عَنْ شَقِيقٍ عَنْ
عَبْدِ الله
-هو ابن مسعود- قَالَ قَالَ
رَسُولُ الله r:َ
عَلَيْكُمْ
بِالصدْق.ِ
فَإِنَّ
الصدْقَ يَهْدِي
إِلَى
الْبِرِّ،
وَإِنَّ
الْبِرَّ يَهْدِي
إِلَى
الْجَنَّة،ِ
وَمَا يَزَالُ
الرجُلُ
يَصْدُقُ
وَيَتَحَرَّى
الصدْقَ حتّى
يُكْتَبَ
عِنْدَ اللهِ صِدِّيقًا
وَإِيَّاكُمْ
وَالْكَذِبَ
فَإِنَّ
الْكَذِبَ
يَهْدِي
إِلَى
الْفُجُورِ وَإِنَّ
الْفُجُورَ
يَهْدِي
إِلَى النارِ وَمَا
يَزَالُ
الرجُلُ
يَكْذِبُ
وَيَتَحَرَّى
الْكَذِبَ
حتّى
يُكْتَبَ عِنْدَ
الله
كَذَّابًا.
أخرجاه في
الصحيحين« [119]
ومن
هؤلاء
المفسرين،
أبو سعيد ناصر
الدين عبد
الله بن عمر
البيضاوي؛ قال
في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»{
يَا أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ
} أي ما
تتوسّلون إلى
قرابه
والزلفىَ منه
من فعل الطاعات
وترك المعاصي.
من وسل إلى
كذا، إذا
تقرّب إليه،
وفي الحديث:
الوسيلة منـزلة
في الجنّة«.
قال
المصنِّف في
تفسير الآية
السابعة
والخمسين من
سورة الإسراء
وهي قوله
تعالى: {أُؤلَئِكَ
الّذينَ
يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ
إِلَى
رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}
»هؤلاء
الآلهة
يبتغون إلى
الله القربة
بالطاعة -أيهم
أقرب- بدل من
واو يبتغون.
أي يبتغي من هو
أقرب منهم إلى
الله تعالى الوسيلة،
فكيف بغير
الأقرب! {
وَيَرْجُونَ
رَحْمَتَهُ
وَيَخَافُونَ
عَذَابَهُ}
كسائر العباد.
فكيف تزعمون
أنهم آلهة؟!«
وقال
البيضاوي في
تفسير الآية
التاسعة عشر بعد
المائة من
سورة التوبة؛ »{يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ}
فيما لايرضاه
{وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}
أي في دين
الله نيةً
وقولاً
وعملاً« [120]
ومنهم
أبو البركات
عبد الله بن
أحمد بن محمود
النسفي؛ قال في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»{وَابْتَغُوا
إِلَيْهَ
الْوَسِيلَةَ}
هي كلّ ما
يُتوسّل به،
أي يُقترب من
قرابة أو
صنيعة، أو غير
ذلك،
فاستُعيرت
لما يُتوسل به
إلى الله
تعالى من فعل
الطاعات وترك
السيئات.«
وقال
في تفسير
الآية
السابعة والخمسين
من سورة
الإسراء: »{يَبْتَغُونَ
إِلَى
رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ
} يعني أنّ
آلهتهم أؤلئك
يبتغون
الوسيلة، وهي
القربة إلى
الله عز وجل.
(أَيّهُمْ)
بدل من واو
يبتغون. و(أي)
موصولة. أي
يبتغي من هو أقرب
منهم الوسيلة
إلى الله،
فكيف بغير
الأقرب! أو
ضمن يبتغون الوسيلة
معنى يحرصون.
فكأنه قيل:
يحرصون أيّهم
يكون أقرب إلى
الله وذلك
بالطاعة
وازدياد الخير.«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ.}
في إيمانهم
دون
المنافقين؛
أو مع الّذين
لم يتخلّفوا؛
أو مع الّذين
صدقوا في دين
الله نية
وقولاً
وعملاً.
والآية تدلّ
على أنّ
الإجماع
حجّة، لأنّه
أمر بالكون مع
الصادقين.
فلزم قبول
قولهم« [121]
ومنهم
علاء الدين
علي بن محمّد
بن إبراهيم
الشحي
المعروف
بالخازن. قال
في تفسير
الآية
الخامسة والثلاثين
من سورة
المائدة:
»قوله
عز وجل {يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ} أي
خافوا الله
بترك
المنهيات؛
{وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ}
اطلبوا إليه
القرب بطاعته
والعمل بما
يرضى وإنما
قلنا ذلك،
لأنّ مجامع
التكاليف
محصورة في نوعين
لا ثالث لهما. أحد
النوعين ترك
المنهيات،
وإليه
الإشارة بقوله
-اِتَّقُوا
اللهَ-؛
والثاني
التقرب إلى الله
بالطاعات.
وإليه
الإشارة
بقوله -وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ-
والوسيلة فعيلة
من وسل إليه
إذا تقرّب
إليه ومنه قول
الشاعر:«
»(إنّ
الرجال لهم
إليك وسيلة)
أي قربة. وقيل
معنى الوسيلة
المحبّة. أي
تحبّبوا إلى
الله عزّ
وجلّ.«
وقال
الخازن في
تفسير الآية
السابعة
والخمسين من سورة
الإسراء:
»قال
تعالى: {
أُؤلَئِكَ
الّذينَ
يَدْعُونَ} أي
الّذين
يدعونهم
المشركون
آلهة:
{يَبْتَغُونَ
إِلَى
رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}
أي القربةَ والدرجةَ
العليا. قال
ابن عباس: هم
عيسى، وأمه،
وعزير،
والملائكة،
والشمس،
والقمر،
والنجوم. وقال
عبد الله ابن
مسعود: نزلت
هذه الآية في
نفر من العرب
كانوا يعبدون
نفرًا من
الجنّ، ويعلم
الإنس بذلك
فتمسّكوا
بعبادتهم.
فعيّرهم الله
وأنزل هذه
الآية. وقوله
تعالى { أَيُّهُمْ
أَقْرَبُ }
معناه ينظرون
أيّهم أقرب إلى
الله،
فيتوسلون به.
وقيل أيّهم
أقرب يبتغي الوسيلة
إلى الله،
ويتقرّب إليه
بالعمل الصالح
وازدياد
الخير
والطاعة.«
وقال
المصنف في
تفسير الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة:
»قوله
عز وجل {يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهََ} يعني
في مخالفة أمر
الرسول r. {
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ }
يعني مع من صدّق
النبي r
وأصحابه في
الغزوات ولا
تكونوا مع
المتخلفين من
المنافقين
الّذين قعدوا
في البيوت
وتركوا الغزو« [122]
ومن
مشاهير
المفسرين
المعوّل
عليهم أبي الفداء
عماد الدين
الحافظ
إسماعيل بن
عمر بن كثير؛
قال في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»يقول
تعالى آمرًا
عباده
المؤمنين
بتقواه. وهي
إذا قرنت
بالطاعة، كان
المراد بها
الإنكفاف عن
المحارم وترك
المنهيات. وقد
قال بعدها: { وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ.}
قال سفيان
الثوري عن
طلحة عن عطاء
عن ابن عباس:
أي القربة.
وكذا قال
مجاهد، وأبو
وائل، والحسن
وقتادة، وعبد
الله بن كثير،
والسديّ وابن
زيد.«
قال
قتادة: أي
تقربوا إليه
بطاعته،
والعمل بما
يرضيه. وقرأ
ابن زيد:
{أُؤلَئِكَ
الّذينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ
إِلَى
رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}
وهذا الّذي
قاله هؤلاء
الأئمّة لا
خلاف بين
المفسرين فيه
وأنشد ابن
جرير عليه قول
الشاعر:
»إذا
غفل الواشون
عُدنا لوصلنا
* وعاد
التصافي بيننا
والوسائل.«
»والوسيلة:
هي الّتي
يُتوصل بها
إلى تحصيل المقصود.
والوسيلة
أيضًا عَلَمٌ
على أعلى منـزلة
في الجنة وهي
منـزلة رسول
الله r.«
وقال
ابن كثير في
تفسير الآية
السابعة
والخمسين من
سورة الإسراء:
»عن
ابن مسعود في
قوله: {
أُؤلَئِكَ
الّذينَ يَدْعُونَ
يَبْتَغُونَ
إِلَى
رَبِّهِمُ
الْوَسِيلَةَ...}
قال نزلت في
نفر من العرب
كانوا يعبدون
نفرًا من
الجنّ، فأسلم
الجنيّون
والإنس
الّذين كانوا
يَعْبُدُونَهُمْ
لا يشعرون
بإسلامهم، فنـزلت
هذه الآية.«
قال
المصنّف في
تفسير الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة
بعد أن نقل
حديثًا مطوّلاً
عن الإمام
أحمد مرفوعًا
من طرف كعب بن
مالك الّذي
نزلت فيه ومن
معه الآية
{وَعَلَى
الثَلاَثَةِ
الّذينَ
خُلِّفُوا...إلخ
} قال عبد الله
ابن عمر: »(اِتَّقُوا
الله وَكُونُوا
مَعَ الصَّادِقِينَ)
مع محمّد r
وأصحابه« [123]
ومن
علماء
التفسير أبو
طاهر مجد
الدين محمّد
بن يعقوب بن محمّد
بن إبراهيم
الشيرازي
الفيروزآبادي
قال في تفسير
الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»{يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ}
الدرجة
الرفيعة.
ويقال اطلبوا
إليه القرب في
الدرجات،
والأعمال
الصالحات.«
وقال
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
} أطيعوا الله
فيما أمركم {
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ }
مع أبي بكر
وعمر
وأصحابهما في
الجلوس
والخروج
بالجهاد« [124]
ومن مشاهير
علماء الترك
في فن التفسير
محمّد بن محمّد
بن مصطفى
المعروف بابي
السعود
العمادي قال في
تفسير الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا الله
َ} لَمَّا
ذُكر عِظَمُ
شان القتل
والفساد وبُيِّنَ
حكمُهما،
وأشير في
تضاعيف ذلك
إلى مغفرته
تعالى لمن تاب
من جنايته،
أمر المؤمنين
بأن يتّقوه
تعالى في كلّ
ما يأتون وما
يذرون بترك ما
يجب اتّقاؤه
من المعاصي
الّتي من
جملتها ما ذكر
من القتل
والفساد،
وبفعل
الطاعات
الّتي من
زمرتها السعي
في إحياء
النفوس، ودفع
الفساد
والمسارعة
إلى التوبة
والاستغفار. »وابتغوا«
أي اطلبوا
لأنفسكم »إليه«
أي إلى ثوابه
والزلفى منه، »الوسيلة«
هي فعيلة
بمعنى
مايُتوسل به
ويُتقرّب إلى
الله تعالى من
فعل الطاعات،
وترك
المعاصي، من
وسل إلى كذا،
أي تقرّب إليه
بشيءٍ....إلخ«
وقال
العماديُّ في
تفسير الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا }
خطاب عام يندرج
فيه التائبون
اندراجًا
أوّليًّا.
وقيل لمن
تخلّف عليه من
الطلقاء عن
غزوة تبوك
خاصّة -اتقوا
الله-في كلّ
ما تأتون وما
تذرون فيدخل
فيه المعاملة
مع رسول الله r
في أمر
المغازي
دخولاً
أوَّليًّا؛
{وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}
في إيمانهم
وعهودهم، أو
في دين الله
نيةً وقولاً
وعملاً؛ أو في
كلّ شأن من
الشؤون« [125]
ومن
مصادر
التفسير
المعتمدة عند
عامّة المسلمين
وحتّى عند النقشبنديّة
أنفسِهِمْ،
تفسير
الجلالين: جلال
الدين محمّد
بن أحمد
المحلّي،
وجلال الدين
عبد الرحمن بن
أبي بكر
السيوطي. جاء
في تفسير
الآية
الخامسة والثلاثين من سورة
المائدة بإيجاز
وهذا نصّه:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا الله
َ} أي خافوا
عقابه بأن
تطيعوه
-وابتغوا- اطلبوا
-إليه
الوسيلة- ما يُقَرِّبُكُمْ
إليه من
طاعته.«
أما الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة
فقد جاء
تفسيرها بالنّصّ
التالي:
»{ يَا
أَيُّهَا الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
الله َ} بترك
معاصيه {
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ}
في الإيمان والعهود
بأن تلزموا
الصدق« [126]
وقد
جاء في تفسير
هيئة من
الشيعة
الإماميّة تحت
إشراف آية
الله ناصر
مكارم شيرازي نحو
ما قال
المفسّرون من
أهل السّنّة
في تفسير
الآيتين
المذكورتين.
وهذا ما تيسّر
تعريبه من
عباراتهم
-باللّغة الفارسيّة-
لتفسير الآية
الخامسة
والثلاثين من
سورة المائدة
:
»{يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ}
أي اتّخذوا
وسيلةً
للتّقرّب إلى
الله واختاروها.
(...) إنّ -الوسيلة-
في الآية
المذكورة
أعلاه لها
معان كثيرة
وواسعة. فإنّ كلّ
سعي باعث
للتّقرّب إلى
الباب
المقدّس
للرّبّ
تشمله
الوسيلة. أمّا
الأهمّ منه
فهو الإيمان
بالله ورسوله
الأكرم،
وكذلك كلّ عمل
جميل وخير.«
وقالوا
في تفسير
الآية
التاسعة عشرة
بعد المائة من
سورة التوبة
بإيجاز:
»{ يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ }
اجتنبوا عن
مخالفة أمر
الله وكونوا
مع الصادقين« [127]
ثم
ورد في
تفسيرهم
تفصيلٌ عن أهل
الصدق، وأنّه
يجب ملازمتهم.
كانت
هذه نُبذة من
تفسير
العلماء
البارزين في
هذا الفنّ من
عناصر مختلفة.
وعلى الرغم من
اختلاف
لغاتهم
الأصلية، ومذاهبهم
ومواطنهم،
فقد أجمعوا
على أنّ الوسيلة
الواردة في
سورتي
المائدة
والإسراء هي كلّ
عمل يقرّب
العبدَ إلى
الله من فعل
الخيرات وترك
المعاصي. ولم
يربط أحد منهم
ولا من غيرهم
من علماء
التفسير، ولا
من علماء
الحديث بين
كلمة الوسيلة
وبين مفهوم الرابطة
المعهودة
بأدنى صلة،
كما هي الحال
بالنسبة لقوله
تعالى:
{وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ }
الوارد في
سورة التوبة.
كذلك جاء في
تفسير العلماء
له على نقيضِ ما
جاء في
تأويلات
النقشبنديّين
الّذين بذلوا
جهودًا بالغة
ليمدّوا
الجسر بين رابطتهم
المستوحاة من
البرهمية،
وبين آيات الله
بطرق ملتوية
يستحيل أن
يوافق عليها
أهل العلم
والبصيرة.
إنّ
الخلافَ الذي
أثبَتَهُ
الباحثونَ
بين الصوفية
وعلماءِ
الإسلامِ
قديمًا
وحديثًا، في
الحقيقةِ لم
يقتصر على
إمورٍ
هامشيةٍ كما يظنُّهُ
البعضُ؛ بل
تجاوز إلى حدودٍ
بعيدةٍ في
جميع
الوجهاتِ
بدءًا من
النّظرِ في
ذات الله
تعالى
وانسياقًا
إلى التعبير عن
أسرار الكونِ
والحياةِ
وإلى تأويل
آيات القرآن
من محكماتها
ومتشابهاتها
خاصّة، كما سبق
في تفسير
الآيتين
المذكورتين.
فقد ابتدعوا
طريقةً خاصّة
في تفسير
القرآنِ
سُمِّيَ بالتفسير
الإشاريِّ،
فاتّسعوا
بذلك في تأويل
الآياتِ إلى
حدود خرجوا
بها عن إجماع
أئمّةِ التفسير.
ذلك
ليستدلّوا
بها على صحّةِ
ما اختلقوه من
معتقداتٍ
شاذّةٍ، وما
اسْتَقَوْهُ
من مستنقعات
الأديان من
أفكارٍ
وفلسفاتٍ
غريبةٍ كلّما
أشارت لهم
أنفسهم؛
كقراءتهم »كلّ شَيْءٍ« -بالرفعِ-
في قولِهِ
تعالى »إنّا
كلّ شَيْءٍ
خَلَقْنَاهُ
بِقَدَرٍ«،
ليستدلّوا
بذلك على
صحّةِ فكرةِ »وحدة الوجود«،
وليقولوا »إنّ اللهَ هو
كلّ شيءٍ في
هذا الكونِ« .
لقد
جرت أقلام
طائفة من
متأخّري هذه
الفرقة في
إثبات الرابطة
وهم فريقان:
فريق منهم
أفردوا الرابطة
وحدها في
عُجالاتٍ،
دون غيرها من
مباحثِ هذه
النحلةِ؛
وفريق منهم
تناولوا الرابطة
كشطرٍ من
الموضوع،
وتطرّقوا إلى
ما بدا لهم من
شتّى مسائل
التصوف على
اختلافها.
***
* من
أهمّ ما كُتِبَ
في مسألة الرابطة
أمّا
الّذين
أفردوا الرابطة
واقتصروا عليها،
فقد عثرنا لهم
على تسعِ
عُجالاتٍ.
منها،
رسالة في
تحقيق الرابطة.[128]
لقد
سبق فيما
ذكرنا أنّ هذه
الرسالة خطاب
كتبها خالد
البغداديّ
باللّغة العربيّة
وبعثها إلى
أحد مريديه في
إسطنبول إذا
صحّ الإسناد.
وهو السيد محمّد
أسعد أفندي
نقيب الأشراف
ورئيس هيئة
المعارف
يومئذ،
ومؤسّس مكتبة
آياصوفيا.
فقد
أثارَ
المؤلّفُ
مشكلةَ الرابطة
بهذه الرسالة
على حين لم
يكن لها شأنٌ
وذكرٌ في
أوساط
الصوفيّة
حتّى أيّامه،
وإنْ ورد شيء قليل
منها في
الرسالة
التاجية لتاج
الدين بن زكريا
الهنديّ،
وعلى الرغم من
أنّ المؤلّف
لم يزد شيئًا
في تعريف الرابطة
على ما جاء في
التاجية إلاّ أنّه
قد بذل جهدًا
بالغًا في
إثباتها
بنقلٍ عشوائيٍّ
من أقوال مَنْ
سبق من الرجال
من أمثال الزمخشري،
والإمام أكمل
الدين،
والغزاليّ،
والسهروردي،
والشهاب بن
حجر، والجلال
السيوطي،
وغيرهم. فقد
اختار من
أقوال هؤلاء
ما أعجبه،
واستدلّ بها
على شرعية الرابطة
دون أن تكون
بينهما أدنى
مناسبة أو
قرينة. مما
يدل ذلك على
خبطه في
عمياء، كما
يثير الشكّ في
أنّ هذه
الرسالة قد
تكون من صنع
من أسندها إلى
خالد
البغداديّ
لأغراض لا
نعلم حقيقتها؛
فدسّ فيها من
أباطيله مالا
يُستساغ
لأمثال البغداديّ
لأنه لم يكن
جاهلا إلى هذا
الدرك من
العمى والضلال.
وعلى
الرغم من أنّ
المؤلّف لم
يحدّد شيئًا
كشروطٍ
للرّابطة ولا
ذكر شيئًا
لأداء صورتها
في هذه
الرسالة، فقد
اختلقها مَنْ
جاء بعده من
خلفائه.
من
جملة ما دوّنه
النقشبنديّون
في هذا الموضوع،
كتاب »الرحمة
الهابطة في
ذكر اسم الذات
والرابطة«.
كتبه الحسينُ
الدوسريّ. قال
في مستهلّه:
»أمّا
بعد، فهذه
الرسالة، قد
ألّفتُها سنة
سبع وثلاثين
ومائتين وألف.
ووريتُ
نسبتَها إلى غيري
لِغرضٍ
قَصَدْتُهُ،
والأعمال
بالنيات«
يعترف
الدوسريّ من
خلال هذه
الكلمات
بحقيقةٍ تبوح
بحقائق أخرى
رهيبة عن هذه
الطائفة
وأغراضها. إذ
أنّ من وقع نَظَرُهُ
على هذه
العبارات،
فقرأها
بوعيٍ، لابدّ
وأنْ يتساءلَ
في نفسه عمّا
أَجْبرَ
الدوسريَّ
حتّى استباح
الكذبَ لنفسهِ
فاسندَ هذه
الرسالةَ إلى
غيرهِ فترةً
من الزّمَنِ
ثمّ رجع عن
هذا الاسناد،
وهو الّذي
ألّفها بإقراره.
نعم
ما الّذي
أجبره على هذا
التـزوير، حتّى
تنكّرَ وورى
نسبةَ كتابه
إلى غيرهِ، مع
أنّه من أقدمِ
خُلفاء خالد
البغداديّ
الّذي يعظّمهم
النقشبنديّون
تعظيمَ
الأنبياءِ
والمرسلين،
ويعدّونهم من
أصحاب
الفضائل
والأخلاق
السامية
والصدق
والأمانة
والبركة
والكرامات! أم
تُبَرْهِنُ
هذه الحقيقةُ
الدّامغةُ في
واقع الأمر،
أنّ الرابطة
لم تكن شيئًا
معهودًا في
المجتمع
الإسلامي حتّى
جاء بها خالدٌ
من ديار
الهند؛ فبدأ
هو وخلفاؤه
يجسّون النبض
حول أحاسيس
المسلمين،
ويتحرّكون
بحيطة، وبخطوات
مرحلية
لتطبيع
المشاعر
وترويض النفوس،
محاذرين من أن
يتعرّضوا
لردودٍ
عنيفةٍ.
رتّب
الدوسريّ
كتابَهُ هذا
على سبعةِ
أبوابٍ، وخصّ
منها البابَ
الثالثَ
والرابعَ
والخامسَ
والسادسَ بالرابطة.
ثم
تَفَلْسَفَ
وعبثَ وهاجمَ
وحاولَ في شرحِ
ما هو بصدده
راعنًا فيها
من مُنْطَلَقِ
إنسانٍ
متطرّفٍ
ومُرْتَبِكٍ
ومغتاظ؛ كأنه
يصرخ، ويسبّ
المعارضين
لمشربه، مِمّا
تذبذب من
جرّائهِ
كلامُهُ،
وتفرّق
مرامُهُ.
كقوله »أقول
لم يقل أحد من
أهل التصوف
بوجوب الرابطة
ولا
باستحبابها
لِذَاتِهَا« [129]
فجاء
كلامه
تكذيبًا
واضحًا لِمَا
زعم مصطفى فوزي
في كتابه »إثبات
المسالك في
رابط السالك«: »أنّ الرابطة
فريضة من جملة
الفرائض
الّتي يبلغ
عددها أربعًا
وخمسين فريضة.«
ثم
قال الدوسريّ:
»نحن لا
نستدلّ
للرّابطة من
دليل. ودليل
مَنْ قلّدناه
من العلماء
كاف واف
بالمقصود.
فالإنكار
متوجّه إلى
الجنيد
والجيليّ
والدسوقي ونحوهم
الّذين
قرّروا الرابطة
بكيفيتها« [130]
لقد
انطلق
الدوسريّ
بهذه الكلمات
من منطق رخيص »ليصطاد
عصفورين
بطلقة واحدة« كما
قيل في المثل
التركيّ. ذلك
ليُثير
المعترضَ
الغبيَّ
فيدفعه إلى
مستنقعات
الصوفيّة حتّى
يتمرّغ في
أوحالها
فيتباحث عما
إذا سبق من الجنيد
والجيليّ
والدسوقي أنْ
تكلَّموا بشيء
في رابطة النقشبنديّة
ثم يعود صفر
اليدين.
إنّ
مثل هذه
المحاولة، لا
يغني شيئًا عن
الشاك في
أمرهم، إلاّ
الخسارة في
العمر. لأنّ
الدوسريّ لو
كان واثقًا من
نفسه لما غادر
صغيرةً ولا
كبيرةً إلاّ
أحصاها من
أقوال أولئك
الثلاثة
ونقلها؛ مع
أنّها لا تقوم
مقام دليل على
بِدْعِيَّةِ
الرابة
إطلاقًا.
وفي
الباب الرابع
قال الدوسريّ:
»إنّ الرابطة
من جملة
الوسائل
الموصلة إلى
الحضور في
عبادة الله،
والوسائل لها
حكم المقاصد.«
ثم
بعد إسهاب
وإطناب في
امتداح الرابطة
أتى بإجابة
على سؤال
مفروض. وهو
قوله:
»فانْ
قال الأخ
المنكر ـ تاب
الله عليه ـ:
قد عرفنا على
هذا القول،
أنّ الرابطة
تعلّق القلب.
وهذا القول
يمنعه. والحبّ
في الله واجب
ومحبّة
الصالحين
ثابتة؛ لكن من
أين لكم أنَّ
استحضارَ
صورةِ رجلٍ في
الذهن ولو كان
من الصالحين تحصلُ
به هذه
المطالبُ كلُّها،
وأنّ
استحضاركم
بسبب تعلّق
القلب، وأنّه
جائز؟«
»والجواب
عن هذا من
وجوه: الأوّل
قولك:«
»ـ من
أين لكم
استحضار صورة
رجل في الذهن
تحصل به هذه
المطالب
كلّها؟«
»أقول:
إنّ هذه
المطالب تحصل
لنا بما
ذكرناه، كما
حصلَتْ لك
أضدادُها
باستغراقك في
معبودك الّذي
نبّهناك عليه.
ولكنّها تعمى
القلوب الّتي
في الصدور.«
هكذا
يظهر ما في
ضمير
الدوسريّ
فتتطاير من كلماته
شرارات الغضب
على كلّ من
يتساءل عن
رابطته،
بإزاء ما في
أسلوبه من مجازفةٍ
وتكلّفٍ
وعُنجهيةٍ
وعجرفة
وتمييع. فيجعل
من هذه
الرسالة
لعنةً يتطاول
بها إلى كلّ
من يشكّ في
علاقة الرابطة
بالإسلام، أو
ربما تعود
عليه الرسالة
نفسُها نقمةً
من كلّ من
يُلقى نظرةً
فيها.
ومن
هذه
العُجالات،
وُرَيْقَاتٌ
عُنْوَانُهَا
»تبصرة
الفاصلين عن
أصول
الواصلين« [131]
سوّدها رجل لم
يَعُدْ قَدْرَهُ،
يدلّ على ذلك
ما تبعثرت على
هذه الوريقات
من عجمةٍ
وهفوةٍ وخلطٍ
وهَرْجٍ
واضطراب.
تخبّط
كاتبها
التعيس ـ
سليمان زُهْدِي ـ
وتلجلج فيما
قذف على هذه
الصفحاتِ من
كلمات لا
تَرَابُطَ
بينها ولا نظامَ
وَلاَ نسق،
واستهلّ
المسكين
بالعتاب والنّكير
على الطاعن في
الرابطة.
وربما تخيّل
خصمًا لا وجود
له في الحقيقة.
كلّ ذلك يدلّ
على ما ابْتُلِيَتْ
بِهِ هذه الطائفة
من رُعْبٍ
وفزع وذُعْرٍ
وارتباك. وما
استولى عليهم
من خوفٍ
يتوقعون
بسببه في كلّ
لحظةٍ أن
يداهم
المسلمون وهم
مستغرقون في
رابطتهم!
نقل
الرجل قسطًا
كبيرًا من
رسالة الرابطة
للبغداديّ. ثم
نقل الآيتين
المذكورتين
وهو يحاول
مستميتًا
لإثبات الرابطة
على أساسهما
بتعبيره
الّذي نسجه من
تركيبات
متنافرة، وسياقٍ
لا يتفق مع
قواعد اللّغة العربيّة
وآدابها، فجاءت
كلماتُهُ
ركيكةً
مُعقَّدةً حالتْ
دون ظهور ما
هو بصدده
لغرابة
الإستعمال؛
وأضفىَ أسلوبُهُ
الوعرُ غموضًا
على كلامه، مع
غلظته وقسوته في
للّهجهِ فتحوّلت
إلى حجّةٍ قامت
عليه فدلّتْ على
ما هو أهله.
***
ومن
هذه الرسائل
الغريبة
أيضًا، كتابٌ
منظومٌ باللّغةِ
التركيّة اسمه
»إثبات
المسالك في
رابطة السالك« [132]
يشتمل على 1123 بَيْتًا من
الرَّمَلِ.
كتبه شاعرٌ
نَقْشَبَنْدِيٌّ
من جماعة أحمد
ضياء الدين
الْگُمُوشْخَانَوِيّ
في إسطنبول؛
اسمه مصطفى
فوزي[133]
وَرَتّبَهُ على
ثمانية أبوابٍ
بعد توطئة
وجيزة استهلّ
بها.
يمتاز
هذا
الشَّاعِرُ بدفاعه
الشديد عن الرابطة
وبتأكيده على
أنّها من جملة
الفرائض. زعم
ذلك في البيت
الثامن من
كلماته
الواردة ضمن
الباب السادس
تحت عنوان »بيان رابطة
المرشد« وانفرد
برأيه هذا، عن
جميع
النقشبنديّين؛
بحيث لم يتصدَّ
أحدٌ من رجال
الطائفة لاَ قَبْلَهُ
وَلاَ بَعْدَهُ
بمثل هذا الدّعوى.
ينتمي
هذا الرجل إلى
أحمد ضياء
الدين الْگُمُوشْخَانَوِيّ،
كما ذكرنا
آنفا. وهو من
الطبقة
الثانية بعده.
أخذ العهدَ من
حسن حلمي بن
عبد الله القسطموني[134] الّذي
هو من خلفاء
الْگُمُوشْخَانَوِيّ.
فانخرط بذلك
في سلك الخالدييّن.
ولا بد هنا من
التنبيه على
أنّ حسن حلمي المذكور،
ليس هو حسن
حلمي بن علي،
وَالِدِ
الشيخ زَاهِدِ
الْكَوْثَرِيِّ؛
علمًا بأنّ
كليهما
منتسبان إلى
أحمد ضياء الدين
الْگُمُوشْخَانَوِيّ.
وقد يلتبس على
بعض الباحثين
اسمُ أحدهما
بالآخر.
للشّاعر
مصطفى فوزي
صحبة مع الشيخ
زاهد الكوثريّ
الشهير
بتصانيفه
وبلهجته
القاسية وتطاوله
على العلماء.
***
ومن
هذه الْعُجَالاَتِ،
رسالةٌ أعَدَّهَا
رجل اسمه عبد
الحكيم الأَرْوَاسِيُّ،
كتبها
باللّغة التركيّة
عام 1342 هـ.[135]
وهو
ثاني مَنْ ألَمَّ
بآدابِ الرابطة
وصورةِ
أدائِها بعد محمّد
أمين الكرديّ.
ثمّ شرحها،
وخلط ما خلط
في طي هذه
الرسالة أكثر
من كلّ مَنْ
سبقه ومن جاء
بعده.
قال
الأرواسيّ في
مستهلّ
رسالته بعد ما
أورد الآية
الكريمة: {يَا
أَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا اتَّقُوا
اللهَ
وَكُونُوا
مَعَ
الصادِقِينَ} قال
بالحرف
الواحد: »الرابطة
طريق مستقل
للوصول إلى
الله«
ثم قال على
سبيل التعريف
لها: »الرابطة
هي ربط القلب
بإنسانٍ
كاملٍ
مكمِّلٍ
واصلٍ إلى
مقام
المشاهدة
متحقِّقٍ
بالصفات الإلهيّة
الذاتيّة. وهي
عبارة عن حفظ
صورة ذلك
الشخص في
خزانة الخيال
بحضوره
وغيابه« [136]
وفي
رسالةٍ بَعَثَهَا
إلى أحدِ مُرِيدِيهِ،
اسمه سعيد،
اهتمّ الأَرْوَاسِيُّ
بمسألة الرابطة
فيها
اهتمامًا
بالغًا. فَعَرَّفَهَا،
وشرح
أركانَها،
وصورةَ
أدائِها،
وفوائدَها؛
وقارنها مع
الذكر، وَحَدَّدَ
مُدَّتَهَا
بِرُبْعِ
ساعةٍ من
الزمن.[137] بينما
يقول الشيخ
سَيْدَا الْجَزَرِيُّ:
»لاَحَدَّ
لِذَلِكَ. وَأَقَلُّهُ
خَمْسُ دَقِيقَاتٍ« [138] وردت
هذه الكلمات
في رسالة
للجزريِّ سماها
»الضّابطة
في الرابطة« كما
سيأتي بيانها.
ومن
أهمّ ما ورد
في رسالة الرابطة
للأرواسيِّ،
أقوالٌ في
رابطة المريد
للشّيخ الميت.
لأنّ هذه
الطائفة تعتقد
»أنّ
الشيخ إذا مات
أصبح طليقًا
من قيود الجسد،
كالسيف المسلول
من غمده.
وبذلك ازداد
تأثيرًا،
وازداد نفعًا
للمريد« [139]
وفي هذا الباب
نقل
الأرواسيّ عن
أبي الحسن الشاذلّي،[140]يستدلّ
بأقواله.[141]
ويحاول
إثباتَ الرابطة
بها.
***
ومن
هذه الرسائل، عُجالةٌ
لأحدِ المتأخّرين
من شيوخ
الأكراد اسمه
سعيد بن عمر
الزنجاني.
اشتهر باسم
الشيخ
سَيْدَا الْجَزَرِيِّ
نسبةً إلى
جزيرة ابن
عمر.
إنّه
كتب هذه
العُجالة
إجابةً على
سؤالٍ من شخص
اسمه الملاّ محمّد
شريف،
يستفسره الرابطة.
وهذا دليل يؤكّد
على أنّ
كثيرًا من
الملالي (وهم
علماء
الأكراد[142])
لا يزالون
يجهلون أمرَ الرابطة
بل ويشكّون
فيها؛ وأنَّ
هذه الهرطقة
لا يُقرّها
ولا يعتدّ بها
أحد سوى
النقشبنديّين؛
وأنَّ كثيًرا
من الناس
يسمعونها
لأوّلِ مرةٍ
كما نفهم من
استفسار
الملاّ محمّد
شريف، على
الرغم من رعونة
الْجَزَرَيِّ
في محاولة
إقناعه إذ
يقول:
»اعلم
يا أخي أسعدك
الله، أنّ
أمرَ الرابطة
الشريفة
مشهور
وسرَّها في
الزُّبُرِ
مذكورٌ
ومسطورٌ. ولكن
نذكر نُبذة من
ذلك
اطمئنانًا
للقلب، واستئصالاً
للرّيب،
ناقلين من
كتاب نور
الهداية
والعرفان«
أما
كتاب نور
الهداية والعرفان،
هذا الّذي
استقى منه الْجَزَرِيّ،
فقد ألّفه محمّد
أسعد صاحب،
وهو ابن أخي
خالد
البغداديّ
كتبه ردًا على
محمّد صديق
خان بن الحسن
البُخَاريّ،
وقد تطرّق
الباحثُ
العراقيُّ
عباس
العزّاويّ
إلى هذه
المسألة فقال:
»هاجم
السيد محمّد
صدّيق خان بن
الحسن الحسيني
البُخَاريّ
أميرُ مملكةِ
بهوبال في
الهند (الرابطة
والتَّوجُّهَ).
فتصدّى للرّدِّ
عليه وعلى
أمثالِهِ محمّد
أسعد صاحب
ذاده في كتابه
-نور الهداية
والعرفان في
سر الرابطة
والتوجه وختم
الخُوَاجَگَانْ.
أَتَمَّ
تأليفَهُ في
دمشق، في أول المحرّم
سنة 1305 هـ. وتمّ
طبعه في
المطبعة العلميّة
بالقاهرة في
شهر رمضان سنة
1311 هـ« [143]
كانت
هذه كلمات
عبّاس
العزّاويّ
حول الكتاب المذكور.
بيد أنّ لنا
مع هذا الكتاب
قصّة طويلة
نختصرها
لتكون عبرة
لأُولي
الألباب.
فخلاصتها:
أن دراسة هذه
البدعة لمّا
اقتضتْ
مراجعةَ عددٍ من
المصادر المتوفِّرةِ
الّتي لها
علاقة
بموضوعنا،
وعثرنا على
اسم هذا
الكتاب في
مواطن كثيرة
من كتب النقشبنديّة
كما كنّا
نسمعه
أحيانًا من
خلال حديثهم،
قمنا بالسعي
في طلبه سعيًا
حثيثًا؛ ولكن
لم نعثر حتّى
على نسخة
واحدة منها،
على الرغم من
تباحثنا
عَبْرَ سلسلة
المكتبات
الرسمية
والخاصة
بكافة أنحاء
تركيا، وما
أكثرها!
ثم
لجأنا في آخر
المطاف إلى
الشيخ عمر فاروق
أفندي، نجل
الشيخ
سَيْدَا الْجَزَرِيِّ
الّذي استقى
من الكتاب
المذكور. فلم
يُجْدِ هذا
الاتصال
أيضًا بنتيجةٍ؛
كما لم نَجِدْ
تفسيرًا
للاستغراب
الّذي أحاط
بمشاعرنا
أمام هذا اللُّغْز،
إلاّ ما قيل:
أنّ مؤلّفَ
هذا الكتاب
مرفوضٌ عند
طائفةٍ من النقشبنديّين
في تركيا. فما
عثروا على شيء
من آثاره إلا
محوه وأفنوه
بسرعة. ذلك »لأنّه كان
متميّزا عن
سائر شيوخ هذه
الطائفة بتفكيره
العلميّ
وأسلوبه
العصراني.«
وهذا يتعارض
مع العقليّة النقشبنديّة
الجامدة!
في
الحقيقة
عثرنا على
سلسلة من
مقالاته الّتي
نُشِرَتْ في
جريدة الرّأي
العام،
وطُبِعَتْ
سنة 1334 هـ.[144]
يتطرّق في هذه
المقالات إلى
موضوعاتٍ
شتّى، لا يكاد
القارئ يشعر
بأدنى أمارة
بين ألفاظه أنَّ
كاتبَ هذه
المقالاتِ
شيخٌ
نقشبنديٌّ، إلا
سطوره
الأخيرة الّتي
ختم بها
كلامَهُ؛ وهي
قوله: »خادم
سجّادة طريقة
السادة النقشبنديّة،
والقائم مقام
الحضرة الخالديّة
المجدّديّة
بدمشق الشام:
اسعد صاحب« [145]
ولكنّ
من جانب آخر،
تُنبئ هذه
الكلمات
بصورة جليّة
عن مدى إعجاب
هذا الرجل
بنفسه
وتعاظمه وتلوّنه
في لباسٍ من
التواضع! وربما
السبب الّذي
أثار
المنافسة
بينه وبين بقيّة
روؤس النقشبنديّة
هو موقفه هذا؛
كما جاء في
دراسةٍ
للباحث David Dean Commins أنّه
طَرَفٌ في هذه
الْمُنَافَسَةِ.[146]
كتاب
»نور
الهداية
والعرفان«، تسود
على أسلوبه
محاولة جدلية
لإثبات الرابطة،
وهذا يخالف
مبادئ الصوفيّة
الّتي تقوم
على التقليد
المحض
والتطّفل والاستسلام
للرّوحانيين
السابقين،
والتقيّد
بمقولاتهم مع
ما فيه من مخالفةٍ
صريحةٍ
للكتاب
والسـنّة-
علمًا بأنّ
النقشبنديّين
وإن كانوا
يهاجمون من لا
يوافقهم، إلا
أنّهم يحذِّرون
الطريقة
الجدلية في
مناظرة
الخصوم والمعارضين
أشدّ الحذر،
خوفًا من أن
تفتضح
أسرارهم بتطوّر
الجدال. وإلاّ
فانّ تركيا في
الحقيقة هي جنّة
النقشبنديّين.
لهم مؤسّسات
إعلامية ضخمة
في هذا البلد،
تقوم بنشر
وتوزيع
كمياتٍ عظيمةٍ
من كتب
الطائفة
ومجلاتِها
وصحفِها،
وبثِّ عقائدِها،
والدفاعِ عن
سمعتها. لذا
لا يجوز عقلاً
أن يرفض
النقشبنديّون
كتابًا يعاضدهم
ويؤكّد على
صحةّ دعواهم،
لولا أسبابٌ
لم نتأكد من
صِدْقِهَا،
غير ما نقلناه
منها.
وكلّ
هذه، في
الحقيقة ما هي
إلاّ مؤشّرات
تنبئ عمّا
تتوارى به
الطائفة النقشبنديّة
من غموض
وكتمان، وما تُضْمِر
ضدّ غيرها من
أسرار وأفكار
لاَ أمان من
عواقبها!
يَنْقُلُ
الْجَزَرِيُّ
ما ينقل من
هذا الكاتب
ومن رسالةٍ
للبغداديِّ
في إثبات الرابطة
حتّى ينتهي من
عجالته »الضابطة
في الرابطة« على
طريقة أسلافه
من الحشوية؛
ولا يأتي بشيء
من تلقاء نفسه
إلاّ كلمات في
سطور معدودة.
وبذلك يفتح بابًا
للشّك على
نفسه، بالرّغم
من غزارةِ
علمهِ
بالعقائدِ وباعِهِ
الطويلِ في الفقهِ
الإسلاميِّ
ومعرفتِهِ
الجامعةِ
بالآدابِ،
وما دوّن فيها
ودَرَسَ ودَرَّسَ
طوال عمره.
***
ومن
هذه الرسائل،
عجالةٌ
أعدّها
باللّغة التركيّة
أحدُ أساتذة
كلية
الإلهيات[147]
بجامعة مرمرا
في إسطنبول،
اسمه عرفان
جندوز.
فسّماها: Tasavvufi
Bir Terim Olarak Râbita أي، الرابطة
كمصطلحٍ
تصوفيٍّ. إلاّ
أنّها غير
مطبوعة.[148]
(وَهِيَ
مَنْسُوخَةٌ
علَى الآلَةِ
الْكَاتبةِ
وَمَحْفُظَةٌ
فِي مكتبتي
الخاصّة)
حاول
المؤلّف فيها
إثباتَ شرعية الرابطة
بمبرّرات
منطقية وبأسلوب
معاصر. فاستهل
بكلام مفاده:
»إنّ
في هذا
الموضوع شيئًا
يظهر
كخاصيّةٍ
مشتركةٍ بين
الثقافات. يجوز
انطلاقًا
منها ـ أن
يقال: إنّ
للمسلمين
أيضًا طريقةً
وأصولاً في
هذا الباب،
وأنّهم
رتّبوا لها
نظامًا على
هيئة الرابطة« [149]
يتبيّن
من هذه
المحاولة بوضوح،
أنّ الْمؤلّفَ
يُقَرِّبُ الرابطة
إلى عقل
الإنسان
المعاصر في
غلافٍ جديدٍ.
وذلك على حدّ
قوله: »هي
الخاصيّة
المشتركة بين
الثقافات
المتباينة.«
وكأنّه يقول:
مهما اختلف
الناس في
عقائدهم فإنّهم
لا محالة
يلتقون في
قِيَمٍ
متشابهة ويشتركون
في أسس
متجانسة. فالرابطة
إذن هي معدودة
من تلك
الْقِيَمِ
الإنسانيةِ
المشتركة،
يلتقي بها
المسلمون مع بقيّة
المجتمعات
الّتي لا تدين
بالإسلام!
يظهر من هذه
المحاولة
بصراحةٍ أنّ
المؤلف يرى ما
يدعو
المسلمين إلى
المشاركة مع
غير المسلمين في
بعض
مُعْتَقَداتِهم،
ويعدّها من
القِيَم
الإنسانية
المشتركة،
وإن كان ذلك
خروجًا على
الإسلام
ويسترسل
المؤلّف على
نحو هذا
الأسلوب، غير أنّه
يعود إلى
ضميره برهةً،
فيأبى إلاّ أن
يعترف بأن »المصادر
الّتي
تُنْبِئُ عن الرابطة
إنّما هي مِنْ
صَنِيعِ
الأيدي في
الماضي
القريب جدًّا«.
إنّ
هذا الاعتراف
لهو أقوى
البراهين
الّتي تقوم
على
المتطرّفين
من رجال هذه
الطريقة الّذين
لا يتورّعون عن
الاستدلال
بكتاب الله
وسنّة رسوله
على أصالة هذه
البدعة
ليدُسّوها في
الإسلام!
***
وآخر
ما صدر في
موضوع الرابطة،
كتابٌ أعدّهُ
أربعةُ
أشخاصٍ من
بُسطاء النقشبنديّين
بالتعاون
فيما بينهم.
كتبوه باللّغةِ
التركيّة وَبالْحُرُوفِ
اللاَّتِينِيَّةِ
لأنّهم
يجهلون
اللّغةَ العربيّة،
وطبعوه تحت
عنوان: Kuran ve Sünnet Işığında Râbıta أي »الرابطة
والتَّوَسُّلُ
في ضوء القرآن
والسنّة« إلاّ أنّه
يضمّ ركامًا
من هفواتٍ وتفسيراتٍ
شَاذَّةٍ وَتَأْوِيلاَتٍ
دَجَلِيَّةٍ،
تمخّضَ
الكتابُ عنها
في قَتَمَةٍ
من الأباطيل.
أَكْثَرُهُ
مُقتَبَسٌ
من
هَذَيَانَاتِ
عددٍ من ملالي
المنطقة
الكرديّة. فهو
بهيئته ليس في
الحقيقة إلا
خليطًا من سؤر
متشيّخي الأكراد،
أكثر من أن
يوصَف بتأليف
مدَوَّن في ضوء
الكتاب
والسنّة.
ومِنْ
هَرْفِ هؤلاء
المنتحلين
صفةَ أهلِ
التأليفِ،
أنّهم ذكروا
الغزاليّ مع
أولئك
الملالي فأنزلوه
إلى دركهم,
وعدّوا أبا
علي
الفارمديّ من
النقشبنديّين.
مع أنّه قد
مات قبل تأسيس
هذه الطريقة
بثلاثمائة
عام!
***
أمّا
الّذين
تناولوا الرابطة
كشطرٍ من
تفاصيل آداب
الطريقة النقشبنديّة.
فقد عثرنا على
نحو ثلاثين
رسالة لهم،
أقدمها كتاب الرشحات.[150] ألّفه
عليُّ بنُ الْحسينِ
الواعظُ
الكاشفيُّ
البيهقيُّ
إلاّ أنّ الرابطة
لا تَعْدو في
هذا الكتاب عن
وصيّةٍ
بسيطةٍ جدًّا؛
أوصى بها
عبيدُ الله
الأحرارُ،
مُؤَلِّفَ
الرشحات، كما
لا نجد لها
تعريفًا ولا
تفصيلاً في
هذا الكتاب.
ثم
تليه من حيث
الأقدميّة
رسالتان لتاج
الدين بن
زكريا
الهنديّ وقد
مرّ ذكرهما.
وكذلك خطابٌ
لأحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ
وجّهَهُ إلى
شخص اسمه أشرف
الكابلي. مرّ
ذكره أيضًا بنصّه
الكامل.[151]
أمّا
بقيّة
الرسائل
المذكورة
للفريق
الثاني، فانّ
كلَّها مسطورةٌ
بعد هذه
الأربعة. وهي
على سبيل
الإجمال:
1) شرح
السلسلة
المراديّة
للدرويش أحمد
الطربزوني،
مدوّنة بالعربيّة.[152]
2) الرسالة
المدنيّة،
كتبها نعمة
الله بن عمر،
باللّغة العربيّة
أيضًا. وهي
ضمنَ مجموعةٍ
من مثيلاتها
بين دفّتين
تحت عنوان »الزمرد
العنقاء«.[153]
3) ترجمة
الرسالة الخالديّة
المنسوبة إلى
خالد
البغداديّ،
ترجمها إلى
اللّغة التركيّة
(باللّهجة العثمانيّة)
رجل اسمه شريف
أحمد بن علي.[154]
4) الحديقة النديّة
في الطريقة النقشبنديّة
والبهجة الخالديّة.
كتبها محمّد
بن سليمان
البغداديّ بالعربيّة.
وهو من خلفاء
خالد البغداديّ.[155]
5) رسالةٌ
في آداب
الطريقة النقشبنديّة
كتبها بالعربيّة
أحمد خليل
البقاعي. وهي
أيضًا ضمن
مجموعة »الزمرد
العنقاء«
6) صحيفة
الصفا لأهل
الوفاء. كتبها
بالعربيّة
رجل اسمه
سليمان زُهْدِي،
ولكنّه فاشل
لجهله بلغة
الضّاد.
7) نهجة
السالكين
وبهجة
المُسلكين
لنفس الشخص
المذكور. وهي
وُرَيْقَاتٌ
خاليةٌ من
القيمة العلميّة.
8) البهجة
السنيّة في
آداب الطريقة النقشبنديّة،
كتبها بالعربيّة
محمّد بن عبد
الله الخانيّ.
وهو من خلفاء
خالد البغداديّ.
لها نسخ
منتشرة في
المكتبات
الرسميّة
والخاصّة.
9) السعادة
الأبديّة
فيما جاء به النقشبنديّة
كتبها بالعربيّة
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ وقد
نُسبتْ هذه
الرسالة إلى
جدّه محمّد بن
عبد الله
الخانيّ وذلك
خطأ.[156]
10) الرسالة
القدسيّة.
منظومةٌ
باللّغة التركيّة
العثمانيّة.
تتألّف من 1328 بيتًا.[157]
نظمه شخص اسمه
عصمت غريب
الله. وهو من
أتباع عبد
الله المكّي،
خليفة خالد
البغداديّ.
كان غريبُ
الله هذا،
رجلاً
خاملاً؛ لا
يُعُرَف عن
حياته شيءٌ.
تنتمي إليه
جماعةٌ
معروفةٌ بِالتّزَمُّتِ
فيُ إسطنبول.
يرأسها
حاليًّا رجل
اسمه محمود أسطى
عثمان أغلوا.
11) المجد
التالد[158]
كتبها بالعربيّة
إبراهيم الفصيح،
وله تحفة الْعُشَّاق
في إثبات الرابطة
أيضًا. وهو من
خلفاء خالد
البغداديّ.
فقد تحمّس
الفصيح في هذه
المحاولة
فقال: كتبتُها
في إثبات الرابطة
الّتي هي من
أعظم أركان
الطريقة
الصوفيّة ومدار
أمرهم. (...)
مقتصرًا فيها
على بيان
الأدلّة الشرعيّة
الدّالة على
وجودها في
السنّة
النبويّة«.
12) جامع
الأصول،
كتبها بالعربيّة
أحمد ضياء
الدين الْگُمُوشْخَانَوِي
وهو خليفة
أحمد بن
سليمان
الأرواديِّ
من خلفاء خالد
البغداديّ.
أكثرُ
عباراتِهِ خالصةٌ
من آثار العُجمة.[159]
13) رسالة
المشغوليّة.[160]
كتبه شخص اسمه
أحمد سعيد
المجدّدي. لكنّه
غير معروف في
الأوساط العلميّة
وحتّى بين
الصوفيّة.
ترجم هذه
الرسالة إلى العربيّة
رجل من مدينة
مغنيسيا التركيّة
اسمه علي
نائلي. غير
أنها أيضًا
شبه مجهول،
وحتّى لغة التأليف
مجهولة.
14) تنوير
القلوب في
معاملة علاّم
الغيوب. كتبه
باللّغةِ العربيّة
محمّد أمين
الكرديُّ
الأربليُّ.
ألّفه من
قسمين. الأوّل
في فقه
الشافعية،
والثاني في
مسائل
التصوف،
والطريقة النقشبنديّة.[161]
15) إرغام
المريد.[162]
كتبه زاهدُ
الكوثريّ
المشهورُ
بتصانيفه
وهجماته على
العلماء؛
كتبه شرحًا على
النظم الّذي
أنشأه سابقًا
بعنوان »النظم
العتيد لتوسّل
المريد«. تطرّق
المؤلّف إلى
موضوع الرابطة
في الصفحة 65 من كتابه
المذكور.
16) مقاصد
الطالبين.
كتبه شخص اسمه
محمّد رائف
عام 1888 م.
باللّهجة العثمانيّة،
وقد تمّ نقله
أخيرًا إلى
اللّهجة التركيّة
المعاصرة. وله
نُسَخٌ
مطبوعةٌ
بالحروف
اللاتنيّة.
17) الرسالة
الأسعديّة
للشّيخ أسعد
الأربليّ. وهو
مأذون من طه
الحريريّ
خليفة طه
الهكّاريّ.
كتب شطرًا
منها بالعربيّة،
وشطرًا بالتركيّة.[163]
18) مكتوبات
أسعد
الأربليّ. هي
مراسلاتُهُ
وخطاباته
الكتابيّة
الّتي بعث بها
إلى أتباعه.
يبلغ عددها 156 رسالة،
تتبلور من
خلالها العقليّة
المتخلّفة
لهذا الشيخ
النقشبنديّ؛
إذ لم يهتم
بقضية من
قضايا
المسلمين في كلّ
هذه الرسائل.
وبلغت الغفلة
منه عما كان
يجري في أيّامه
إلى حدٍّ لم
يشعر بصراخ
الداهية
الّتي كانت
وشيكة الوقوع،
حتّى ذهب هو
أيضًا مع
الطليعة
الأولى ضَحِيَّتَهَا،
كما سنشرح
عاقبتَهُ في نهاية
الفصل الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
جاءت
في بعض هذه
الرسائل
توضيحات له
حول آداب الطريقة
النقشبنديّة؛
كالرابطة
واللّطائف
والذكر وما
إليها؛ وجاء
في عدد منها
تفسيراته
لرؤيا بعض
مريديه.
19) الأخلاق
التصوفية.[164] سلسلة
أعدّها محمّد
زاهد كُوتْكُو
باللّغة التركيّة،
وهي مطبوعة
بالحروف
اللاّتنيّة.
20) ترجمة
أحمد ضياء
الدين الْگُمُوشْخَانَوِيّ
دراسة أعدّها
الدكتور
عرفان جندوز
باللّغة التركيّة.
21) كتاب
مدوّن باللّغة
التركيّة
اسمه Tarikat-i Nakşibendiyye Prensipleri. ورد
على الغلاف أنّه
نُقل إلى التركيّة
بقلم مفتي
متقاعد اسمه
رحمي سرين؛
وأنّ الاسم
الأصليّ للكتاب
Risâle-i Bahâiyye. ومؤلّفه
علي قدري. غير
أنّ مسألة
الترجمة
غامضة. لأنّ
عمليّة إجراء
التعديل على
اللّهجة العثمانيّة
أيضًا تعتبر
عند بعض
الأتراك
المعاصرين
نوعًا من
الترجمة.
ولذلك لم
نتأكّد عما
إذا دوّنه
المؤلّف
باللّغة العربيّة
(وهذا بعيد
الاحتمال)؛ أم
كتبه باللّهجة
العثمانيّة. قد
طُبع هذا
الكتاب في
إسطنبول عام 1994م. يتألّف من 293 صفحة، وقد
رتّبه
المؤلّف على
مقدّمة وخمسة
فصول. ورد في
الصفحات 54-56 شرح في
مسألة الرابطة.
22) روح
الفرقان. كتاب
غريب أقدم على
صياغته عدد من
النقشبنديّين
وعلى رأسهم
رجل اسمه
محمود أسطى
عثمان أوغلو.
تصدّوا فيه
لتفسير القرآن
بأسلوب باطنيٍّ
جرئٍ
وتأويلاتٍ
أثارتْ جمهورَ
المسلمين في
تركيا عام 1992م. دوّنوه
باللّغة التركيّة،
لأنّ معرفتهم
بالعربيّة
قاصرة على
قراءة نصوص
معيّنة فحسب.
أمّا التعبير
فإنّهم
عاجزون عنه
تمامّا.
لقد
استدلّوا في
هذا التفسير
الغريب بآيات
كريمة على
إثبات رابطة النقشبنديّة.
وتصرّفوا في
تأويل كلام
الله حسبما
بدا لهم في
مواطن كثيرة
من هذا الكتاب
الخطير الّذي
يُتَوَقَّعُ
أن يُثيرَ
ضجةً في صفوف
عامّة
المسلين إذا
ما تُرجم إلى العربيّة
أو شاع ما فيه.
إنّ
هذه الرسائل
والكتب ليست
مما يُلفِت
نظرَ العلماء
والمثقَّفين؛
ولا
لمحتوياتها
قيمة في ديوان
العلم أو في
ميزان العقل،
بل ذكرنا أسماءها
بالاختصار
علي سبيل
المساعدة
للباحثين. وثمّة
موسوعات أخرى
غيرها، وردت
في سطور قليلة
منها تعريفات
وجيزة
للرّابطة، مع
الإشارة إلى
أنّها من كلام
الصوفيّة
وآرائهم،
وتأويلاتهم.
***
* من
الآداب عند النقشبنديّة:
الذكر على
أساس اللّطائف
الخمس.
لقد
سبق توضيحٌ
ملخّصٌ في
آداب الذكر
عند النقشبنديّة
مع التنبيه في
البداية بأنّها
أمور
يستغربها كلّ
من له علم بكتاب
الله تعالى
وسنّة رسوله r،
ويفزع من
خطورتها ومن
جرأة من
استقاها من مستنقعات
الشرك
وألصقها
بعقائد
المسلمين.
إلى
جانب هذه
الآداب، فقد
اختلق
كبراؤهم مصطلحاتٍ
أخرى غريبةً
أطلقوها على
مُسَمَّيَاتٍ
باللّطائف.
زعموا أنّها
موجودة
وموزَّعة في
بنية البشر وحَمَّلُوهَا
معانٍ لم نعثر
على قرينة
تبرهن على
وجودها في جسد
الإنسان،
إلاّ القلب.
كما لم نجد
لها قرينة
بالذكر في
الكتاب
والسنّة سوى القلب
أيضًا. وهذه
اللّطائف
خمسٌ في
اعتقادهم كما
جاء في عدد من
كتبهم، منها
تنوير القلوب
لمحمد أمين
الكرديّ إذ
يقول.
»وأوّل
تلك اللّطائف،
القلبُ. وهو
تحت الثدي
الأيسر بقدر
إصبعين
مائلاً إلى
الجنب على شكل
الصنوبر. وهو
تحت قدم آدم u؛
ونوره أصفر.
فإذا خرج نور
تلك اللّطيفة
من حذاء كتفه
وعلا، أو حصل
فيه اختلاج،
أو حركة قوية
فيلقّن
بلطيفة الروح
وهي تحت الثدي
الأيمن
بإصبعين
مائلاً إلى
الصدر، وهي
تحت قدم نوح
وإبراهيم
عليهما
السلام. ونورهما
أحمر. فالذكر
في الروح
والوقوف في
القلب. فإذا
وقعت الحركة
فيها
واشتعلت،
فيلقّن بلطيفة
السر، وهي فوق
الثدي الأيسر
بإصبعين مائلاً
إلى الصدر،
وهي تحت قدم
موسى u،
ونورهما أبيض.
ويكون الذكر
فيها،
والوقوف في
القلب فإذا
اشتعلت أيضًا
فليلقّن
بلطيفة الِخَفِيِّ،
وهي فوق الثدي
الأيمن
بإصبعين
مائلاً إلى الصدر،
وهي تحت قدم
عيسى u،
ونورها أسود.
فإذا اشتعلت
أيضًا
فليلقّن بلطيفة
الأخْفَى. وهي
في وسط الصدر؛
وهي تحت قدم
نبينا محمّد r.
ونورها أخضر.
فليشتغل بها
كما تقدم« [165]
إنّ
من يطّلع على
هذه الكلمات
ويتأمّل
فيها، لابدّ أن
يتساءل عن
مصدر هذه
الأقاويل إذا
كان يشعر بمسئولية
ما يترتب عليه
في وجه كلّ من
يريد أن يعبث
بالكتاب
والسّنّة،
ويأتي ما شاء
من تلقاء نفسه
أو ينقل رواسب
الشرك من
الديانات
والفلسفات
فينسبها إلى
الإسلام باسم
الدين، ثم
يدرّب الناس
على فعلها
زعمًا منه
أنها ذكر
الله! أليس
اليهود
والنصارى
والصابئة
والمجوس
والهندوس
وسائر
المشركين
يعبدون الله ؟
إذن ما الفرق
بين المسلم
والمشرك إذا
أراد المسلم
أن يعبد الله
كما شاءت له
نفسه، وليس
كما رسمه الله
له وفَعَلَهُ
الرسول r؟!
ألاَ يكون
المسلم قد خلع
رِبْقَةَ
الإسلام من
عنقه إذا سنّ
لنفسه عبادةً
لم ترد عن
رسول الله r. خاصّة
الذكر عند النقشبنديّة
على أساس هذه
اللّطائف
الخمس، فانّ
الإنسان يتعجّب
عندما يطّلع
على صورة
أدائها.
أما
خطورة هذه
البدعة فإنها
لا شكّ تزداد
عندما نجدها
ممزوجة بكلمة
التوحيد
ومقصودًا بها
ذكر الله
تعالى كما
تظهر فيما ورد
ضمنَ رسائلهم.
هل يُعقل أن
النقشبنديّين
أنفسهم
يستطيعون حلّ
هذه الألغاز
فضلاً عن
غيرهم؟ ولعلّ
السر في
اشتهار بعض
السحرة
والمشعوذين
منهم بصفة أولياء
الله بين عوام
الناس
يكمن في مثل
هذه الألفاظ
الخرافية
المختلقة.
ولا
يفوتنا
الإشارة هنا
بالمناسبة
إلى أنّ
الإقدام على
التصرُّف في
مبادئ
الطريقة أمر لا
يملكه أيُّ
شيخ من شيوخ
هذه الفرقة
إلاّ من غلبت
شهرته على
أمثاله. كخالد
البغداديّ
والطبقة
الأولى من
خلفائه.
وإنّما
الكلمة
النافذة للشّيخ
المشتَهَرِ
بين عامّتهم.
لأنّه بمنـزلة
المجتهد
عندهم. ولهذا
نكتشف أنّ
مصدر الشرف
والمكانة
والكرامة
والبركات إنّما
هي الشهرة
الغالبة في
هذه الطريقة.
فمن ملكها ملك
أمر الطائفة
كلّه. وإلاّ
ليس بإمكان أيّ
شيخ من شيوخ النقشبنديّة
أن يقوم بوضع
مثل هذه
الألفاظ من
تلقاء نفسه إلا
أن يكون قد
سيطر على
دماغه أحد من
أكَابِرِ هذه
الفرقة
الّذين نسجوا
لهم ألوانًا
من الأساطير
بأمثال تلك
الحيل نفسها
على يد من
سبقهم. وهكذا
بالتسلسل خضع
الخلف للسّلف
بالطاعة العمياء.
واعتقد
اللاحقون
بالسابقين ما
يعتقد
النصارى في
رهبانهم
أنّهم ينوبون
عن الله في
مغفرة الآثام.
بل ازدادوا
على النصارى
أنّ شيوخهم
يتصرفون في
ملك الله
وملكوته
وكتابه وكلامه.
إنّ
هذه العقيدة
تنبت في قلب كلّ
نقشبندي نحو
شيخه وتتحول
إلى إيمان
راسخ لا يشوبه
وَهْمٌ ولا
شكٌّ.
ولهذا لا
يستغرب ما
يأمره به شيخه
إطلاقًا ولو استبدل
دينه كلّ يوم
بدين جديد!
***
* الختم
الخُوَاجَگَانِيّ
وكذلك
من طقوس هذه
الطائفة
أنّهم يقيمون
حلقةً سريّةً
في أوقات
معيّنة
يسمّونها »خَتْمِ
خُوَاجَگَانْ«
وكلمة »خُوَاجَگَانْ«: -كما
يترجمها محمّد
أمين الكرديّ-
»جَمْعٌ
فَارِسِيٌّ
لـِ »خُوَاجَهْ«
بِوَاوٍ ثُمَّ
أَلِفٍ. وَلاَ
تُقْرَأُ الْوَاوُ،
وَإنَّمَا
أوتِيَ بِهَا
لِتَفْخِيمِ
الْمَدِّ. وَالْخُواجَهْ
بِمَعْنَى
الشَّيْخِ« [166]
وأما
رأيهم
واعتقادهم
المتعلّقان
بهذه الحفلة
وآدابها على
لسانهم،
فيقول في ذلك
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ »اعلم
أنّ لهذا
الختم
المبارك
شرطين:
الأوّل أنْ لا
يحضر فيه أَمْرَدٌ
ولا أجنبيٌّ،
ليس داخلاً في
طريقتنا
لأَلاّ يُخِلّ
نِظَامَهُ.
الثاني: أنْ
يغلق الباب.
وله آدابها.
منها تغميض
العينين؛
والاستغفار
خمسًا وعشرين
مرةً؛
والجلوس متورِّكًا
عكس تورّك
الصلاة كما
تقدّم؛
وملاحظة الرابطة
الشريفة
الآتي بيانها.
وأركانه
قراءة
الفاتحة سبع
مرات؛ ثم
الصلاة على النبيّ
مائة مرة؛ ثم
قراءة »ألم
نشرح«
تسعًا وسبعين
مرةً؛ ثم سورة
الإخلاص ألف
مرة وواحدة؛
ثم الفاتحة
أيضًا؛ ثم
يهدي ثواب ذلك
إلى صحيفة
النبي r
وإلى آله
وأصحابه
والأولياء
والمشائخ
الكرام« [167]
كذلك
ورد مثل هذا
الكلام في بعض
وريقاتٍ
لِمُتَأَخِّرِي
هذه الطائفة
ممّن عاشوا
بعد خالد
البغداديّ فاقتبس
بعضهم من بعض
كما يبدو.
ويستدلّون
على شرعية هذه
الحفلة بحديث
كما مر في باب الرابطة.
إلاّ
أنّ حقيقة هذه
الحفلة ليست
كما يشرحها النقشبنديّون
في مثل ما
سجلناه آنفا
من عباراتهم.
بل هي شكل من
تقاليد
الباطنيّة،
بَقِيَتْ
بظاهرها في
حدود هذا
الرمز. إذ من
الواضح
البيّن أنّ
إغلاقَهم
للباب[168] عادةٌ
استورثوها من
قدمائهم من
رؤوس الباطنية
الّذين كانوا
يقومون بعقد
اجتماعات
سريّة لضرب
المسلمين
وإفساد
عقيدتهم،
وهدم دولتهم
ولكنّهم
وضعوا لها
آدابًا من
الذكر
والتلاوة
والصلوات،
تقيّة وحذرًا
من أن تفتضح
أسرارهم إثر
مداهمةٍ قد
تقوم بها سلطات
المسلمين. ثم
شاء الله أنْ
اختفت المقاصد
مع الزمان،
وبقيت الآداب
على هيئتها
بعد أن تعرضت
الطريقة النقشبنديّة
لاستحالات
وتغيّرات
عديدة على حسب
اتجاه الروحانييّن
الّذين آلت
إليهم أخيرا
أَزِمَّةُ
الطريقة، وهم
من أهل
التقشّف
والعزلة
والرهبنة.
يجهلون ما مرّت
بها طريقتهم
عَبْرَ
القرون من
ألوانِ التبدّلات.
إنّما هذا
الجهل هو
الّذي يؤدّي
بهم حتّى
يدّعي
المعاصرون من
أئمتهم، أنّ
عقائدهم
وعاداتهم
وحفلاتهم
متواترة من
لدن رسول الله
r،
وهم غافلون
بذلك عن أنّ
طريقتهم
تتميّز عن الإسلام
حتّى بِلُغَتِهَا.
يذكر
الكرديّ في
مقالته
السابقة
آنفًا أنّ كلمة
»خواجه«
فارسيّة. وهذا
يُْنِبِئُنَا
مرةً أخرى
بأنّ للفرقة النقشبنديّة
لُغَتُهَا
الخاصّة في
مناسكها،
ودعائها،
وطقوسِها... تختلف
عمّا للمسلمين
كما سَبَقَتْ
الإشارة
إليها في
بداية الفصل
الثاني. إذ
يعترف بهذه
الحقيقة كثير
من رجالهم.
ومنهم محمّد
بن عبد الله
الخانيّ،
يتطرّق إلى
هذه المسألة
في فصلٍ خاصٍّ
فيقول:
»إنّ
للقوم
مصطلحات لابدّ
لسالكي
طريقتهم من
ضبطها
ومعرفتها
والعملِ بمضمونها.
ولما كانت هذه
الطريقة
الشريفة قد
ظهرت في بلاد »ما وراء النهر«
واشتهرت
فيها، وكان
أعزّة تلك
البلاد يتكلّمون
بالفارسيّة
جرى أكثر تلك
المصطلحات
على لسانهم
بتلك اللّغة« .
***
* المصطلحات
الفارسيّة في
الطريقة النقشبنديّة
وأسرارها.
ثم
يشرع الخانيّ
في سرد هذه
المصطلحات المُخْتَلَقَةِ
والموضوعةِ
باللّغة الفارسيّة،
وهي مبنىَ
طريقتهم. وقبل
أن ندخل في
بيان المقاصد
الحقيقية
للنقشبنديّين
من هذه المصطلحات،
وإفشاءِ ما
أكنّه
صناديدُ
الطائفة في بطونهم
من أغراضٍ،
وما يتربّصون
من وراء الرابطة
خاصّة، يجب أن
نؤكّد على أنّ
جميعَ ما أحدثه
النقشبنديّون
باسم الذكر
وما أقرّوه من
أورادٍ
وآدابٍ
وشرائطَ في السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
الرُّوحَانِيِّ،
كلّها تختلف اختلافًا
كبيرًا عن
أذكار النبيّ r،
ونوافله
الشريفة
ومناسكه الطيّبة
الطاهرة. إذ
لم يكن بين
دعائِهِ
وأذكارِهِ وأشكالِ
تَعَبُّدِهِ
شيءٌ مّمّا اخْتلقتهُ
النقشبنديّة
من الرابطة،
والختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
والاستمدادِ من
أرواح الموتى
وأمثالِها.
وإنّما حياته
الروحية u
مشرقة،
واضحة،
وبيّنة؛
كحياته في
أمور دنياه،
مضبوطة في كتب
الرجال
بروايات
الثقاة، ومتواترة
عَبْرَ
الأجيال بين
المسلمين.
على
سبيل المثال
فان كتابَ »الأذكار«
للإمام
الجليل محي
الدين أبي
زكريا يحيى بن
شرف الدين
النووي،
حافلةٌ
بباقاتٍ من
أزاهير دعائه
الطيّبةِ
وأذكاره
العاطرةِ
ونوافلهِ
ومناسكهِ
الشريفةِ
المنسجمةِ مع
روح القرآن
الكريم. فإننا
لا نجد في هذا
الكتاب
القيّم ولا
فيما سبقه كـ» عمل اليوم
والليلة«
للإمام أبي
عبد الرحمن
النسّائي وكتاب
»عمل
اليوم
والليلة« للإمام
أبي بكر أحمد
بن محمّد بن
إسحاق السني.
لا نجد في هذه
المصادر
شيئًا اسمه الرابطة.
ولا نجد فيها
ما تفعله
الفرقة النقشبنديّة
من الحفلات
السرية
المعروفة
بينهم بـ »الختم
الخُوَاجَگَانِيَّة« ولا
ما تعتقده من »الاستمداد
بالروحانية« و»الاستغاثة
بالموتى«
والتعبّد على
أسلوب
الهنادك
بالتقشّف
والرهبنة.
فحاشا لرسول
الله r أن
يكون قد عمل
شيئّا مّمّا
كان يعمله
رهبان المجوس
والنصارى من
أشكال العبادات
والنسك.
* مباني
الطريقة النقشبنديّة.
إنّ
كثيًرا من
الناس
يعتقدون أنّ
الطريقة النقشبنديّة
طريقة
سُنِّيَّةٌ؛
ولكن »السُّنِّيَّةَ«
المعروفة
والمنتشرَة
الّتي جعل
بعضُ الكلاميّين
منها مصطلحًا
أطلقوه على
السواد الإسلاميّ
الأعظم
ليميّزوه عن بقيّة
الفرق الّتي
تدّعي
الإسلام؛ نعم
هذه السنِّية التقليديّة
نفسّها لا
تمثّل
السّنّة في
الحقيقة، ولا
توافق الإسلام
الخالص؛ بل تختلف
عنه بكثير من
جوانبها؛
وتتضارب مع
روح الكتاب
والسّنّة،
فضلاً عن أنّ
بين الطريقة النقشبنديّة
والإسلام
مقارعة شديدة
تتراءى بوضوح
إذا ما تمّت
أدنى مقارنة
بينهما.
هذا
بالرغم من أنّ
بعض الروحانيّين
قد أصرّوا على
أنّ الطريقة النقشبنديّة
هي الإسلام
نفسه، وفي هذا
يقول محمّد بن
عبد لله
الخانيّ:
»اعلم
أيّها الطالب
لمعرفة الله
تعال - وفّقنا
الله وإياك -
أنّ معتقَدَ
ساداتِنَا النقشبنديّة
قدّس الله
أسرارهم
الزكيّة، هو
معتقَدُ أهل
السّنّة
والجماعة.
ومبنى طريقتهم
على حفظ أحكام
الشريعة
المطهّرة« [169] بينما
هذه الكلمات
عينُها تُكَذِّبُ
الناطقَ بها،
وتفضحه فيما
يدّعيه بأشدّ
ما يقوم
الدليل على
صاحبه. ذلك إنّه
قد أتى بصيغة
غريبة من
الدعاء في
عباراته. وهي »قدّس الله
أسرارهم« إذ لا
نعثر على أدنى
شيءٍ يبرهن
على أنّ رسولَ
الله r، أو
أحدًا من
أصحابه قد نطق
بمثل هذه
الصيغة في
دعائه. بل هذا
من أسلوب
الغلاة
والباطنية. فإنّهم
يعظّمون
مشائخهم.
وربما تكون
هذه العادة قد
شاعت بين
خاصّتهم مع
الزمان
بتأثير النصارى.
لأنّ المسيحيّين
يقدّسون
رهبانهم
ويصفونهم
بالقداسة.
وما
أدلّ على أنَّ
الطريقة النقشبنديّة
تتعارض مع
الإسلام بكلّ
مُقَوِّمَاتِها
ومفاهيمها؛
من
اعترافاتهم
الّتي تتمثّل
في كلّ كلمة سجّلوها
على سبيل
التعريف
والتوضيح
لمصطلحاتهم.
منها مثلاً
قول بعضهم: »ومبنى هذه
الطريقة
العليّة على
العمل بإحدى عشرة
كلمة فارسيّة:
ثمانية منها مأثورة
عن حضرة الشيخ
عبد الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ.
وهي: هُوشْ
دَرْدَمْ،
نَظَرْ
بَرْقَدَمْ،
سَفَرْ دَرْ
وَطَنْ،
خَلْوَتْ
دَرْأَنْجُمَنْ،
يَادْ
كَرْدْ،
بَازْ
كَشْتْ،
نِكَاهْ دَاشْتْ،
يَادْ
دَاشْتْ« [170]
نعم
هكذا يظهر
بإقرار
أئمّتهم أنّ
مبادئ طريقتهم
كانت في البداية
ثمانية. ثم
أضاف إليه محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ
ثلاثةً أخرى
فصار بعدها
أحد عشر
مصطلحًا. وهي
تركيبات
فارسيّة، فيها
أجزاء عربيّة
للضّرورة.
فقد
ذكر بعضهم هذه
المصطلحات
على غير
الترتيب
الّذي جاء في
تنوير
القلوب،
ومنهم محمّد
بن عبد لله
الخانيّ
وحفيده عبد
المجيد بن محمّد
بن محمّد
الخانيّ؛
ولكن ترتيب
الحفيد أيضًا
لم يأت موافقا
تمامًا
لترتيب جدّه.
إذ أورد
الحفيد كلمة »نَظَرْ
بَرْقَدَم« في
المرتبة
الرابعة؛ و»هُوشْ
دَرْدَمْ« في
المرتبة
الخامسة في
تعداد
المصطلحات
المذكورة.
بينما كان جده
قد جعل »هُوشْ
دَرْدَمْ« هي
الرابعة. و»نَظَرْ
بَرْقَدَمْ« هي
الخامسة.[171]
ولا
نقصد
الاستدلال
بهذا الخلاف
البسيط علي بطلان
دعواهم ما دام
كلّهم
يتّفقون في
أصلٍ باطلٍ
بُنِيَتْ
طريقتهم على
أساسه. كما
تظهر هذه
الحقيقة إلى
العيان بوضوح
بعد استكشاف
المقاصد
البعيدة
الّتي أكنّها
قدماء الطائفة
في طيّ شروحهم
لهذه
المصطلحات.
***
يقول
الكرديّ في
شرح هذه
المصطلحات:
»أمّا
»هُوشْ
دَرْدَمْ«:
فمعناه حفظُ
النَّفَسِ عن
الغفلة عند
دخوله وخروجه
وبينهما. ليكونَ
قلبه حاضرًا
مع الله في
جميع الأنفاس.
لأَنَّ كلّ
نَفَسٍ يدخل
ويخرج
بالحضور فهو
حيٌّ موصول.
وكلُّ نَفَسٍ
يدخل ويخرج
بالغفلة فهو
ميّت مقطوع عن
الله« [172]
لقد
يبدو من ظاهر
هذه الكلمات
أنّها موافقة
للحق في
الوهلة
الأولى؛ إذ
فيها حثّ على
صحوة القلب،
ونكير على
الغفلة إلى
حدّ يستطيبه
المؤمن. ولكن
بعد إمعان
الفكر في شكل
هذا التركيب
وأسلوب
تفسيره، لا
يخفى على
العالم
الماهر بروح
الكلمات أنّ
هذه الصيغة
ماكرةٌ
تُنْبئُ عن
ضلالاتٍ دسّتْها
الزنادقةُ في
ثنايا تلك الألفاظ،
مع احتفاظها
بمخلّفاتٍ من
عقائد
البراهمةِ والبوذية.
والحال هذه،
فقد أنذرنا
الله تعالى عن
الغفلة بأشدّ
وأبلغ ما
يتّعظ به
الإنسان،
فقال سبحانه: {وَاذْكُرْ
رَبَّكَ فيِ
نَفْسِكَ
تَضَرُّعًا
وَخيِفَةً
وَدُونَ
الْجَهْرِ
مِنَ الْقَوْلِ
بِالْغُدُوِّ
وَاْلآصَلِ
وَلاَ تَكُنْ
مِنَ
الْغَافِلِينَ}[173]
كما نهانا
سبحانه عن
طاعة صاحب
القلب
الغافل، فقال:
{وَلاَ تُطِعْ
مَنْ
أَغْفَلْنَا
قَلْبَهُ
عَنْ
ذِكْرِنَا
وَاتَّبَعَ
هَوَاهُ
وَكَانَ
أَمْرُهُ
فُرُطًا.}[174]
وفي مواطن
أخرى كثيرة من
كتاب الله ورد
التشنيع
بالغافلين،
مما يؤكّد أنّ
المؤمنَ
بالقرآن،
والمحظوظَ
بمعرفة معانيه،
والمواظبَ
على تلاوته،
والمستنيرَ بهديه،
لن يفتقر إلى
كلمة »هُوشْ
دَرْدَمْ«،
ليكون حاضر
القلب مع
الله؛ ولن
يلتفت إلى هذه
الكلمة الّتي
ظاهرها خير من
باطنها
لأسباب:
منها:
أنّ واضع هذا
المصطلح (حسب
إسنادهم) ليس من
علماء
المسلمين
الّذين
أعلنتْ الأمّةُ
عن ثقتها بهم.
كالأئمّة
الأربعة
المجتهدين
ومن جاء مِنْ
بعدهم من
المتقدّمين
والمتأخّرين؛
من أمثال محمّد
بن إسماعيل
البُخَاريّ،
ومسلم بن
الحجاج
القشيريّ النيسابوريّ،
ومحمد بن
الطيب
الباقلانيّ،
والإمام
النوويّ
وغيرهم رحمة
الله عليهم
أجمعين؛ بل
كان صوفيًّا
مات في
بُخَارَى عام 575 من الهجرة.
وقد يكون
شخصيّةً
خياليّةً لا
حقيقةَ
لوجوده.
ومن
هذه الأسباب:
الانحراف عن
مسلك السلف
الصالح في
الأصول. ذلك
أنّ جميع العلماء
سواءً
الفقهاءَ
منهم
والمحدّثين،
حتّى المدلّسين
والزهّاد
والمعاصرين
لهم، لم يختاروا
وضعَ
مصطلحاتِهم
إلاّ باللّغة العربيّة،
بخلاف
النقشبنديّين
الّذين
يدّعون السير علي
نهجهم.
فالقشيريُّ
مثلاً، مع أنّ
الطائفة النقشبنديّة
تَعُدُّهُ من
كبار
الصوفيّة
وتبالغ في
تعظيمه،
وتستقي من
آثاره في كثير
من
المناسبات، نعم
هذا القشيريّ
لم نعثر على
شئ في رسالته
من هذه
المصطلحات الفارسيّة
الغريبة. فقد
ورد في رسالته
الشهيرة من
شتّى مصطلحات
الصوفيّة
كالقبض،
والبسط،
والجمع،
والفرق، والفناء،
والبقاء،
والغيبة،
والحضور،
والصحو،
والسكر،
والذوق،
والشرب، والسِّرِّ
والتّجلّي،
والمحاضرة
والمكاشفة
والمشاهدة،
وللّوائح،
والطوالع،
واللّوامع،
والمجاهدة،
والخلوة،
والعزلة،
والفتوّة،
والولاية،
والمعرفة،
والمحبّة،
والشوق
وغيرها مما
يضيق المكان
عن استيعابها،
ولكن لا نجد
فيها حتّى
مصطلحًا
واحدًا من تلك
الّتي وضعتها
زنادقة العجم
كقولهم: »هُوشْ
دَرْدَمْ،
نَظَرْ
بَرْقَدَمْ،
سَفَرْ دَرْ
وَطَنْ،
خَلْوَتْ
دَرْأَنْجُمَنْ...إلخ.«
وكذلك
من الأسباب
المثيرة
للشّكّ فيما
يحتويه مصطلح »هُوشْ
دَرْدَمْ«، بل
وما تبدو من
علامات
الخطورة فيما
يُقْصَدُ من
هذا التركيب، أنّه
رمز لمرحلة من
مراحل
الرياضة
النفسية
والوجدانيّة
على طريقة
المجوس
البرهمية
والبوذية؛
يقتنع السالك
بعد كمال هذه
الرياضة
بالاتحاد،
وينسلخ من
التوحيد
تمامًا كما ستبدو
هذه الحقيقةُ
بعد دراسة البقيّة
من هذه المصطلحات،
وإظهار ما
تتواري خلفها من
أغراض مدسوسة.
أمّا
خلاصة ما
يُقصد من هذه
الرياضة
الخاصّة (وإنْ
كذّبها
النقشبنديّون
وردّوها
بعنفٍ)، فما
هي في الحقيقة
إلاّ محاولةٌ لتمهيدِ
السبيلِ حتّى
يَقِرَّ السالكُ
في نفسِهِ عند
نهاية المطاف:
أنّ الله قد
حلّ فيه، أو
هو حلّ في
الله -سبحانه
عمّا يصفه
الفاسقون-
وذلك ليس إلاّ
مقدّمة
لعقيدة وحدة
الوجود كما
يبرهن على هذه
الخطّةِ إدماج
الباطل في قلب
الحق ضمنَ
مزيجٍ من ألفاظٍ
واردةٍ في شرح
هذا المصطلح
بأسلوبٍ
ماكرٍ قلّ من
ينتبه إلى الخطورة
الكامنةِ
فيها، وهي
عقيدة »الفناء
في الله«
إذًا
فلنعد مرةً
أخرى إلى ما
سجّله
الكرديّ من
تفسيرٍ لهذا
المصطلح
تمحيصًا لما
نتوقّع فيه من
مقاصد خفية
تتعارض مع
ظاهره.
يقول
الكرديّ، »فمعناه: حفظُ
النَّفَسِ عن
الغفلة عند
دخوله وخروجه
وبينهما، ليكون
قلبُهُ
حاضرًا مع
الله.«
حقًّا،
إنّ الغفلة عن
الله مقبوحة،
وقد سبقت
الإشارة
إليها آنفًا
بشهادة
الآيات
البيّنات من
كتاب الله عزّ
وجلّ؛ ولكن
الاجتناب
عنها، هل
ينبغي أن يكون
بهذه الطريقة،
أم للإسلام في
ذلك طريقته
الخاصّة؟
فإذا
طلبنا الجواب
عن هذا السؤال
وجدناه بصراحةٍ
وجزالةٍ في
مواطن كثيرة
من كتاب الله
العزيز.
منها
على سبيل
المثال قوله
تعالى
{فَانْظُرْ إِلىَ
آثَارِ
رَحْمَةِ
اللهِ كَيْفَ يُحْيِي
اْلأَرْضَ
بَعْدَ
مَوْتِهَا؛
إنّ ذَلِكَ لَمُحْيي
الْمَوْتَى
وَهُوَ عَلَى كلّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ}[175]
قد
أمر الله في
هذه الآية
الكريمة
بالنظر إلى آثار
رحمته
تحذيرًا عن
الغفلة،
وترغيبًا في
حضور القلب؛
وحثَّ الإنسانَ
على ذلك
ليعتبر بما
خلقه الله
وأبدعه، وأنّه
كيف يحيي
الأرض بعد
موتها بقدرته
تعالى حتّى
يلين قلبه،
وتتأثر
عاطفته،
وليثبت على
إيمانه بأنّه
الخالق
البارئُ
الواحد الفرد
الصمد الّذي ليس
كمثله شيْءٌ.
ولكنّ
الغاية من كلمة
»هُوشْ
دَرْدَمْ«،
ومتمّماتها
ليست هذه
بتاتًا. بل
الغرض الحقيقي
المكنون في
عمق هذه
الكلمة إنّما
هي ترسيخ
عقيدة »وحدة
الوجود« في قلب
سالك الطريقة
بترويضه من
خلال تمرينات
جوكية. وهي
كثيرة مشروحة
في كتبٍ
عديدةٍ بلغاتٍ
مختلفةٍ،
أقدمها كتاب »السُّطْرَايَات« للرّاهب
الهنديّ
باتانجالي (Patanjali).
لأنّه لم يرد
في كتاب الله
ولا في سنّة
رسوله r
أمرٌ مفروض
بمراقبة كلّ
نَفَسٍ، ولا
بيانٌ فيما
أنّ حضور
القلب مع الله
موقوف على مثل
هذه
المراقبةِ
وبالخلاصة
فمن أرهق نفسه
بمقارنة آداب النقشبنديّة
مع أمثالها
الموجودة في الديانات
الهندية، وجد
المطابقة
التامّة بينهما
»وكفى
الله
المؤمنين
القتال.«
» أمّا »نَظَرْ
بَرْقَدَم«:
فمعناه أنّ
السالك، يجب
عليه أن لا
ينظر في حال
مشيه إلاّ إلى
قدميه؛ ولا في
حال قعوده إلاّ
بين يديه.
فانّ النظرَ
إلى النقوشِ
والألوانِ يُفْسِدُ
عليه حالَهُ ويمنعه
مما هو
بسبيله. لأنّ
الذاكر
المبتدئ إذا
تعلّق نظرُه
بالمبصَرات
اشتغل قلبه
بالتفرقة
الحاصلة من
النظر إلى
المبصَرات
لعدم قوّته
على حفظ
القلب.« [176]
كانت
هذه ألفاظ محمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ أحد
رؤوس النقشبنديّة
وهي واضحةٌ
إلى حدّ لا
يقبل
التأويل،
إلاّ أنَّ
مِنْ وراء هذه
الألفاظ
غاياتٍ
مشبوهةً،
ودسائسَ
خطيرةً لا
يتمكّن مِنْ
كشف الستار
عنها إلاّ
مَنْ أنار
الله قلبَه بهدي
القرآن
والسّنّة. ذلك
أنّ ما جاء في
هذه العبارات
مِنْ نصيحة
المريد
المبتدئ »أنْ
لا ينظر في
حال مشيه إلاّ
إلى قدميه ولا
في حال قـعوده
إلاّ بين يديه« لا
يتضمّن شيئًا
مما جاء في
قوله تعالى
{وَاقْصِدْ
فيِ مَشْيِكَ}[177]
بل لا علاقة
بين الأمرين.
إذ أنّ القصد
في هذه الآية
الكريمة، هو
الاقتصاد. قال
ابن كثير: {وَاقْصِدْ
فيِ
مَشْيِكَ}: »أي امش مشيًا
مقتصدًا ليس
بالبطيء
المتبثّط،
ولا بالسريع
المفرط؛ بل عدلاً
وسطًا بين بين.«
إنّما
قدّمنا هذه
المقارنةَ،
إحباطًا لما قد
يتعمّد أحدهم
فيسرعُ إلى
الاستدلال
بهذه الآية
الكريمة
لتبرير باطله
بالحقّ كما هو
دأبهم.
أمّا
الغرض
الأصليُّ
مِنْ هذا
المصطلح ليس إلاّ
ترويض السالك
المبتدئِ على
الخنوع والذلّ
والمسكنة؛
حتّى يَنْسَدَّ
عليه أبواب
اليقظة
والوعي،
فيتقبّل كلّ
ما يأمره
شيخُهُ دون
اعتراضٍ؛
فيُصْبِحَ في النهاية
عبدًا مطيعاً
لا يخالفه
أبدًا؛ وإنْ
كلّفه
باقتحام
حرمةٍ، أو
اقترافِ
جريمةٍ؛ كما
سبق الحديث
عنه في باب
آداب المريد
مع شيخه.
وبجانب
هذا، فإنّ
إصرار
الإنسان على إثبات
نظره أمامه،
لم يرد إلاّ
في الصلاة.
وهو مطلوبٌ
أيضًا أثناء
الدعاء. أمّا
في غيرهما من
حالات
الإنسان،
وخاصّة إذا
كان مشغولاً
بأمرٍ من أمور
دنياه فلا.
لأنّ الإنسان
إمّا يكون في
حال السير
يتنقّل من
مكانٍ إلى آخر
لغايةٍ يريد
تحقيقها؛ أو
يكون جالسًا
مع أصحابه أو
شركائه أو
أهله في غالب
الأوقات. و في
كلتا
الحالّتين
ينبغي
للإنسان أنْ
يلتفتَ إلى جهاتٍ
مختلفةٍ عند كلّ
حدثٍ جديدٍ،
من صوتٍ أو
حركةٍ أو
ضوءٍ؛ ليتأكّد
ممّا يجرى
حوله؛
وليتّخذ
الموقفَ
اللاّزم مِنْ
حيطةٍ أو
استعدادٍ على
حسب ما يقتضي.
ولكنّ الّذي
يخفى على غالبيّة
الناس هنا،
أنّ إثبات
النظرِ إلى
أقرب مكان من
الأرض نحو
الأمام في
حالّتي المشي
والقعود بصورة
متواصلة، لهي
من أهمّ
الشروط لصلاة »اليوغا«
في الديانات
الهندية. وفي
ذلك مقاصد:
منها ترويض
الإنسان على
الذلّة
والمسكنة.
وهما من
الفضائل في
الديانة البوذيّة
الّتي
تستمدُّ من
حياةِ بوذا
الحكيم Buddha. و»يُقال إنّه
رأى وهو في
التاسعةِ
والعشرين،
ولأوّلِ مرّة،
عجوزًا
خرفًا،
ورجلاً
مريضًا،
وناسكًا مترحِّلاً،
وجثّةَ مَيْت.
فهالَتْهُ
مظاهر الحياة
هذه الّتي لم
تقع عليها
عيناه من قبل،
فانسلخ عن
ماضيه وتنسّك.
ولكنّه ما لبث
أن اطّرح، بعد
ستّ سنوات،
حياة التنسّك
الصارم،
واستغرق في
التأمّل
العميق
المُفضي إلى
التَّنَوُّرِ.
وسرعان ما
اجتمع حوله
عددٌ من
المريدين
كانوا نواة
جماعة »الرهبان
المتسوّلين«
الّتي أسّسها«
إنّ
هذه العبارات
المنقولة من
موسوعة المورد
لمنير
البعلبكي،
تدلّنا إلى
طبيعة
الرهبنة
الهندية على
تمامِ حقيقتِها،
وما
لِسَالِكيِهَا
من الإهمال،
وإسقاط
التدبيرِ،
والتأمّل
العميق الذي
يقتضي إثبات
النظر على
نقطةٍ
معيَّـنَةٍ
طوال ساعات
مديدة... وهذا
لاشكّ
استخفافٌ
ظاهرٌ بسنّةِ اللهِ
تعالى. علمًا
بأنّ الرهبنة
والتسوّل هما الذلّة
والمسكنة
بعينهما،
وهما من
العقوبات
الّتي أخذ
الله بها بني
إسرائيل عند
ما استبدلوا
الّذي هو أدنى
بالّذي هو
خير.
{وَضُرِبَتْ
عَلَيْهِمُ
الذلَّةُ
وَالْمَسْكَنَةُ
وَبَاؤُا
بِغَضَبٍ
مِنَ اللهِ.}[178]
هذا،
ومن المعجزات
الكامنة في
هذه الآية الكريمة،
أنّ المجتمع الهنديّ-البرهميَّ
قد حكم بالذات
على نفسه بالذلة
والمسكنة
جزاءً بما وقع
فيه من الشرك
البواح. لأنّ
هذا المجتمع
يتميّز من
جميع أصناف
المشركين في
العالم
بتقاليده
الّتي تُعَدُّ
من أشد مظاهر
المقاومة
للفطرة
الإنسانيّة
السليمة. إذن
فأولى بمن
تشبّه بهم، أن
يأحذهم الله
تعالى بنفس
العقوبة.
كذلك
من المقاصد
الّتي تكمُنُ
من وراء هذه
الرياضة
الهندية
المتمثّلة في
إثبات النظر،
هو »التركيز«.
ومؤدّاه:
الانصراف من
هموم الدنيا
والآخرة، تخلُّصًا
من متاعبها
ومشاقّها؛
وفقًا لتعاليم
»بوذا
الراهب الّذي
صدمته مشكلة
آلام البشريّة،
فقرّر أن يقطع
صلتَه
بالماضي
ويبحث عن
الحقيقة
السامية في
التأمُّل«[179] »وكان
بوذا يعتقد
أنّ الألم
ينجم عن
الرغبة. وأنّ
التخلّص من
الرغبة يأتي
بانتهاج
(الطريق الثمانيّ
النبيل) الّذي
يتمثّل
بالسيرة الحسنة،
والفعل
الحسن، وأنّه
من الممكن
نتيجةً لذلك
بلوغ النيرْفاَنَاNirvana . وهي حال
من السعادة
القصوى.«[180]
وأمّا
السعادة
القصوى (أي
النيرْفاَنَا)
تلك الّتي
طالما تتحدّث
عنها البوذيُّون
ويسعون من
وراءها؛
إنّما هو »الفناء
في الله«
بعينه عند
الصوفيّة.
إذًا
يتّضح لنا
بصورةٍ
جليّةٍ أنّ
مصطلحَ »نَظَرْبَرْقَدَمْ«
وما يشتمل عليها
من المعاني الفلسفيّة،
هو
مُقْتَبَسٌ
من البوذيّة
دون شكّ. وأنّ
الإسلام
بريءٌ من هذه
الهرطقة؛ كما
يبرهن على ذلك
حياة النبيّ u،
وحياة أصحابه
عليهم
الرضوان. إذ
أنّ رسول الله
r
قد قام بمهامّ
وأعمال عجز
العلماء
والمؤرِّخون
عن حصرها. فقد
قاد الجيوشَ،
واحتلّ منصبَ
أوّلِ رئيسٍ
للدولة الإسلاميّة،
وراسل الملوكَ،
وهادن العدوَّ،
وأبرم العقودَ
والمعاهداتِ،
وقضى بين
الناس، وحكم
بالعقوبات،
وأمر بتنفيذها
إلى غير ذلك
من الأمور
الّتي تستوجب
الحركة
والانتباه والإلتفات
إلى حيث
يقتضي. كلّ
ذلك يبرهن على
أنّ مقولة »نَظَرْبَرْقَدَمْ«
بدعةٌ دخيلةٌ استقوها
من رهبان البوذيّة
والبرهمية. »ومن
تشبّه بقوم
فهو منهم«. [181]
أمّا
»سَفَرْدَرْوَطَنْ«،
-وهو المبدأ
الثالث للطّريقة
النقشبنديّة-
فيقول محمّد
بن عبد الله
الخانيّ في
تفسير هذا
المصطلح: »فالمعنى
المراد بها إنّه
ينبغي أنْ
يكون سفر السالك
من عالم الخلق
إلى جناب
الحقّ سبحانه
وتعالى«[182]
لقد
سلك الخانيّ
طريقًا
ملتويًا
باختيار هذه
الكلمات
ليستعرض بها
من فنون
لباقته في التعمية.
بيد أنّه لا
يعزب عن
العقول
النيّرة »أنّ
السفر من عالم
الخلق إلى
جناب الحق«
عقيدة باطلة، »ما أنزل الله
بها من سلطان«.
لأنّ قولهـم »السفر من
عالم الخلق«
يعني الخروج
والنـزوح
والتطهّر من
الطبيعة
المخلوقية،
والتدرّج إلى
مقام
الخالقية،
والاندماج في
الله! وهذا هو
المقصود
بعينه من
كلمتهم »الفناء
في الله«. ولكن
جاءت هذه
الكلمة في
صيغة جديدة
كما هو دأبهم.
هذا
وقد تناول محمّد
أمين الكرديّ
كلمة »سَفَرْدَرْوَطَنْ«،
وفسّرها
بصيغة أكثر
مرونةً؛
وربما تفاديًا
لأيّ ردٍّ قد
يواجهون من
جرّاء ما
يحتمله تفسير
الخانيّ لهذه
الكلمة من
عقيدة وحدة
الوجود،
والوصول إلى
الله، و»الفناء
في الله«.
فقال
الكرديّ »فمعناه
الانتقال من
الصفات
البشرية الخسيسة
إلى الصفات
الملكية
الفاضلة.«
غير
أنّ هذه
الكلمات جاءت
على خلاف ما
ذهب إليه
الخانيّ؛
وهذه من
تناقضات النقشبنديّة.
وما أكثر من
تكذيب أحدهم
للآخر. وهي من
أعظم الحجج
القائمة
عليهم.
وأمّا
»خَلْوَتْ
دَرْأَنْجُمَنْ«:
فمعناه »الخلوة
في الجلوة«
على حسب تعبيرهم.
وهو المبدأ
الرابع
للطريقة النقشبنديّة.
فقد راوغ
الخانيّ في
تفسير هذا
المصطلح
المشبوه، وتفنّن
في تحميل
المعاني
السامية عليه.
فقد جاء في
مقطع من كلامه
»أنّ
الخلوة نوعان:
الأوّل؛
الخلوة من حيث
الظاهر. وهي
اختلاء
السالك في
بيتٍ خالٍ عن
الناس،
وقعوده فيه؛ ليحصل
له الإطّلاعُ
في عالم
الملكوت،
والشهودُ في
عالم الجبروت.
لأنّ الحواسّ
الظاهرة إنْ
احتبستْ عن
أحكامها؛
انطلقت
الحواسُّ
الباطنةُ
لمطالعةِ
آيات
الملكوت،
ومكاشفة
أسرار
الجبروت. والنوع
الثاني؛
الخلوة من حيث
الباطن. وهي
كون الباطن في
مشاهدة أسرار
الحقّ، والظاهر
في معاملة
الخلق بحيث لا
تُشغِلُهُ
معاملة
الظاهر عن
مشاهدة
الباطن. فيكون
الكائن البائن.
وهذه هي
الخلوة في
الحقيقة كما
أشار إليه
تعالى في
قوله: {
رِجَالٌ لاَ
تُلْهِيهِمْ
تِجَارَةٌ
وَلاَ بَيْعٌ
عَنْ ذِكْرِ اللهِ.}«[183]
هكذا
استدلّ
الخانيّ في
النهاية
بكلام الله
تعالى في غير
مورده. لأنّ
الآية
المذكورة لا
علاقة لها
إطلاقًا »بمن
يختلي في بيت
خال عن الناس
ويقعد فيه
ليحصل له
الإطلاع في
عالم الملكوت«. واللهُ
تعالى يقول، {
فَلاَ
يُظْهِرُ
عَلَى
غَيْبِهِ
أَحَدًا
إِلاَّ مَنْ
ارْتَضَى
مِنْ رَسُولٍ.}[184] وقد
خُتِمتْ
الرسالة في
جنس البشر
بمحمّد r
أمّا
الّذين أشار
الله إليهم في
الآية المذكورة
فإنما هم
رُسُلُ اللهِ
الأمناءُ على
سرّهِ
المكلّفون
بتبليغ
رسالاته،
وليس أولئك الكهنة
الّذين تَنْسُبُ
إليهم
الصوفيّةُ
أنواعَ
الكرامات
والخوارق.
وأمّا
لفظ »يَادْكَرْدْ«:
وهو خامس
المباني
للطريقة النقشبنديّة.
فيقول محمّد
أمين الكرديّ
في تفسيره
لهذا المصطلح:
»فمعناه
تكرار الذكر
على الدوام،
سواء باسم الذات
أو النفي
والإثبات«[185] لا شكّ
فيما أنّ ذكر
الله أفضل
الأعمال. وقد
قال تعالى: {
فَاذْكُروُنيِ
أَذْكُرْكُمْ.}[186] وقال
تعالى: {
وَاذْكُرْ
رَبّكَ كَثيِرًا
وَسَبِّحْ
بِالْعَشِيِّ
وَالإِبْكارْ.}[187] وقال
تعالى: {
وَاذْكُرِ
اسْمَ
رَبِّكَ
وَتَبَتَّلْ
إِلَيْهِ
تَبْتيِلاً.}[188] وقال
تعالى: { أَلاَ
بِذِكْرِْ
اللهِ
تَطْمَئِنُّ
القُلوُبُ.}[189] وجاءت
في القرآن
الكريم آيات
أخرى تحثّ على
ذكر الله.
إلاّ
أنّ الغرض من
الذكر في
الطريقة النقشبنديّة
يختلف عمّا هو
المقصود في
القرآن
اختلافًا كبيرًا.
ولا يَفْطَنُ
إلى هذا
الاختلاف
إلاّ من رزقه
الله المعرفة الواسعة
بعقائد مجوس
الهند، وبِمَدَى
تأثيره على
الطريقة النقشبنديّة
في مسألة
الذكر.
لأنّ
الذكر في
الإسلام بكلّ
معناه
اللغويِّ
والاصطلاحيِّ،
ليس هو الذكر
الّذي
يَقْصُدُ به
واضعُ
مصطلَحِ »يَادْكَرْدْ«.
فانّ الذكر في
الإسلام هو
الصلاة
المفروضة والمسنونة،
وتلاوة
القرآن،
والدعاء
المأثور عن
النبيِّ r؛
وقد يُطلق على
أوراد معروفة
بترديد
أسمائه تعالى
الواردة في
القرآن
الكريم
وغيرها من تسبيح
وتحميد
وتهليل
وتكبير وما
إلى ذلك. ولكن بالأعداد
الّتي وردت في
السّنّة
الصحيحة.
فالمقصود
بهذا الذكر،
ليس إلاّ
توحيد الله تبارك
وتعالى وتنـزيهه
من كلّ مالا
يليق بشأنه
سبحانه،
والإقرار
بالعبودية له
وحده.
أمّا
الذكر في
الطريقة النقشبنديّة
بمعناه
الحقيقي،
فليس هذا
الّذي
عددناه، ولا
الغرض الحقيقي
هو توحيد الله
أو العبودية
له؛ بل
المقصودُ الأصليُّ
الّذي لا
يعرفه إلاّ
الروحانيّون منهم،
هو طلب »المعرفة
بالله«
ومحاولة
الوصول إليه،
كما هو في
الديانة البوذيّة.
تعالى ربُّنا
عن ذلك علوًّا
كبيرًا. ذلك
أنّ المعتـنقين
لشعبة من هذا
الدين
الوثنيِّ
يعتقدون »أنّ
الله يحلّ في
أيّ صورةٍ
يختارها من
صور أفراد
الإنسان
ليكمِّلها
ويطهّرها«[190] ولهم
أوراد وأذكار
يردّدونها بأعداد
كبيرة تُقَدَّرُ
بالآلف طلبًا
لتلك الغاية
مع القيام بعمل
التركيز على شَيْءٍ
معيَّنٍ.
فقد
اطّلع بعض رجال
الدراسة
والبحث على
هذه الرياضة البوذيّة-البرهمية.
يقول أحدهم: »أمّا عن
ترويض
نفوسهم،
والتحكّم
بقواهم العقليّة،
فهم يمارسون
بالإضافة إلى
تلك الرياضات
طرقًا شتّى
مثل قطع
العلائق
والروابط
المجتمعيِّ،
والخلوة
الطويلة في
مكان مقفر،
وحبس الشهيق
في الصدر
وتحديق النظر
في شيْءٍ ثابت
لا تبارحه
العين،
وترديد كلمة
معيّنة على
نغم واحدٍ،
وحصر الذهن في
موضوع معيّن
لا يتعدّاه
الفكر... إلى
غير ذلك من
الممارسات
والتجارب
الّتي
يتوصّلون بها
إلى طرد كافّة
المؤثّرات
والمشاغل عن
الأذهان،
وإخراج الطاقات
البدنيّة والعقليّة
عن وظائفها
الأساسيّة
وتجميعها
لحساب غرض
واحد: وهو
الخروج عن
المظهر
العامِّ
للناس في كلّ
شيء، واختراق
القوانين
المألوفة
للحياة الطبيعيّة؛
والعجيب في
أمر هؤلاء
السحرة
الّذين يتّبعون
تلك الرياضات البدنيّة
الشاقّة
والإنتحارات
الذهنيّة
المتكرّرة،
أنّ أحدهم
يصير بعدها
وكأنه قد
تلاشت فيه
حدود
الأشياء،
وتساوت في نظره
الأضداد؛ فهو
لا يحبّ ولا
يكره، ولا يعرف
ولا يُنكر،
ولا يسرُّ ولا
يحزن، وهو
يذهل عن نفسه
حتّى لا يشعر
بما يصدر عنه
من انفعالات
أو يدخل عليه
من مؤثّرات؛
ولعلّ بفعل
ذلك تتولّد
عنده القدرة
على الإتيان
بأعمال السحر
أو التخييل أو
التنويم،
فيراه الناس
قادرًا على أن
يهدّئ الأسد
الغاضب
بنظره،
ويلاعب النمر
الجائع فلا
يأكله،
ويختفي عن
أنظار
المشاهدين
وهو في وسطهم
يحادثهم
ويسائلهم،
ويقرأ
الأفكار في
الأذهان حتّى
يتوهّم
البسطاء أنّه
يرى البعيد
ويعلم الغيب...«[191]
فقد
اقتبس قدماء النقشبنديّة
هذه الظاهرة
من البوذيّة،
وقمّصوها
مصطلح »يَادْكَرْدْ«
وحمّلوها معنى
الذكر،
وجعلوها
ركنًا من
أركان طريقتهم.
لذا يستحيل
على الجهلة
بطبائع
الأديان منهم
أن يكتشفوا
سرّ هذا الاقتباس،
وخاصّةً
الشيوخ
المعاصرين من
الأتراك
والأكراد
لهذه الطائفة
أغلبهم جهلة
لا ثقافة لهم،
فلا يتأتّى
لأحدهم أنْ
يقارن بين
الأديان
والمعتقدات،
فيكشف ما تسرّب
من بعضها إلى
بعض، وما طغى
بعضها على بعض،
تجلّى
بمعتقداتٍ
متباينةٍ وأشكال
مختلفة عبر
القرون. ومع ذلك
لا يُفرّق
شيوخهم بين »العبادة
لله« و»المعرفة
بالله«.
بينما الأوّل منهما،
هو مراد اللهِ
الّذي خلق
الإنس والجنّ
لأجله. أمّا
الثاني فهو
مستحيل بمعنى
التوصّل إلى
المعرفة بذات
الله.
***
إنّ
من الأوراد
المعروفة في
الديانة
الهندية أربع
كلمات مقدّسة
في اعتقاد الهنادكةِ،
وهي: Om, mani, padme, hum.
يردّدها
دراويشهم
ورُهْبانهم بأعداد
كبيرة ومحددة
تقدّر
بالآلاف،
بحيث يغيبون
عن أنفسهم
بتأثير
التكرار.
وأحيانًا تظهر
منهم أفعال
غريبة وأطوار
عجيبة وخوارق
للعادة
يتأثّر بها
الناظرون
ويندهش منها
المشاهدون.
كالمشي على الجمرِ،
وسحق الزجاج
بالأسنان
وابتلاع فُتَاتِهَا،
وطعن الجسمِ
بِرُمحٍ أوغيره...
فقد شاعت هذه
الأشكال من
الشعوذة بين
الصوفيّة
أيضًا،
وبخاصّةٍ
المنتسبين
منهم إلى الطريقة
القادريّة
والرفاعيّة.
أمّا
حال الغياب،
فإنها كذلك
تعرض لبسطاء النقشبنديّة
بعد تكرارهم
للأوراد
الّتي
يكلّفهم بها
شيخُهم
فيغيبون عن
أنفسهم مدّةً
ويظنّون بعد
الصحوة أنّ
الله قد حلّ
فيهم،
ويسمّون هذه
الحالة »الفناء
في الله«. فتتمثّل
هذه البدع بكلّ
ما سبق الحديث
عنه في كلمة »يَادْكَرْدْ«.
***
أمّا
لفظ »بَازْكَشْتْ«:
فمعناه في
اللّغة الفارسيّة،
الرجوع. فهو
من متمّمات »يَادْكَرْدْ«.
يقصد
النقشبنديّون
بهذا المصطلح
رجوع الذاكر
إلى المناجاة
بعد إطلاق
النفَسِ.
لأنّهم
يحبسون
النفَسَ أثناء
رياضة »اليوغا« كما
تفعله
اليوغيّة
اثناء صلاة »اليوغا«.
إلاّ أنّ من
حِيَلِ رؤوس
هذه الطائفة،
أنّهم قد
سنّوا نداءً
يستأنف بها
الذاكر
رياضته من جديد.
وهي قولهم: »إلَهي أنت
مقصودي ورضاك
مطلوبي«. فقد
مزجوا هذه
الصيغة في
آدابهم،
تحسينًا لها، وليجعلوا
منها سببًا
بين بدعتهم والإسلام؛
وليضفوا
عليها سربال
الأوراد الشرعيّة،
تعمية على
المغفّلين.
أما
في الحقيقة،
أنّ جميع
المصطلحات
بما فيها »بَازْكَشْتْ«،
لا تمتّ إلى
الإسلام
بصلة؛ لا
لفظًا ولا معنىً.
كما يتبيّن
ذلك من
الأغراض
المقصودة من
هذه الألفاظ
والمعاني
الكامنة
فيها؛ خاصّة
إذا نُزعت
منها
المفاهيم
المُقْتَبَسَةُ
من الإسلام.
***
أمّا
لفظ »نِكَاهْدَاشْت«:
فمعناه
اللّغويُّ في
القاموس
الفارسي: الحراسة
والحفظ. وعند
النقشبنديّين:
هو »أن يحفظ
المريد قلبه من
الخواطر ولو
لحظةً«.[192] يقصدون
بذلك في ظاهر
كلامهم
الاحتراز من
الغفلة.
والحقيقة غير
ذلك. فانّ
كلمة »نِكَاهْدَاشْت«
مبدأٌ هامٌّ
في العقيدة النقشبنديّة.
وفي الوقت ذاته
هو من الشروط المهمّة
الّتي يتوقّف
عليها »التركيز«
لأداء رياضة »اليوغا«.
إذ لا يمكن
إطلاقًا أنْ
يحقّق
الإنسانُ
حالة التركيز
التامّ إلاَّ
بمراعاة خمسة
أمور،
وبالتزامٍ
دقيق.
الأول
منها: الجلوس
على هيئة
معيّنة، وهو
الشكل
المعروف بـ»اللّوطوس
«Lotus عند
الجوكية »اليوغية«.
في مقابلة »الجلوس على
عكس التورّك
في الصلاة«[193] عند النقشبنديّة.
والثاني:
النفَسُ
الموزونُ
بإيقاعٍ
طبيعيٍّ. والثالث:
تثبيت الفكر
على شيء
بعينه. والرابع:
الاسترخاءُ
التامُّ. والخامس: منع
الحواسِّ من
التذبذب. وذلك
بالابتعادِ إلى
مكانٍ لا
حركةَ فيه ولا
صوتَ ولا
ضياءَ. وقد
استوحى
النقشبنديّونَ
الشروط
السالفة من »اليوغا«،
وعليها بنوا
أسس طريقتهم،
ومنها »نِكَاهْدَاشْت«؛
وهو في مقابلة
الشرط الثالث
المذكور
آنفًا. أي »تثبيت
الفكر على شيء
معيّنٍ«
حتّى تتحقّقَ
بذلك حالةُ
التركيز
ومنها تتطوّر
إلى حالة أخرى
تسمّى »الغيبوبة
الواقعة وراء
الخبرة
البشرية = Transcendental
absence.« وهي »الجذبة«
عند النقشبنديّة.
أمّا
لفظ »يَادْدَاشْتْ«:
وهو المبدأ
الثامن
للطريقة النقشبنديّة
وآخر الكلمات
الثمانية
الّتي وضعها
عبدُ الخالقِ الْغُجْدُوَانِيُّ؛
فمعناه على
لسان محمّد
أمين الكرديّ:
هو »التوجّه
الصرف
المجرّد عن
الألفاظ إلى
مشاهدة أنوار
الذات
الأحديّة،
والحقّ إنّه
لا يستقيم
إلاّ بعد
الفناء
التامّ
والبقاء السابغ«
إذًا
- بعد هذا
القدر من
الإطّلاع على
الجانب المستور
لهذه الطريقة
-، من البساطة
جدًّا أن
يظلَّ الإنسانُ
متسائلاً عما
إذا كان
النقشبنديّون
يريدون بهذه
الرياضة
عبادةَ لله:
إقرارًا
بأنّه الواحد
الأحد الفرد
الصمد الّذي
ليس كمثله شيْءٌ؛
وحاشاه أن
يحلّ في شيء
من خلقه؛ أم
يسعون للفناء
فيه، والوصول
إليه،
والانصهار في
ذاته،
والاتحاد
معه؟!!
إنّما
هذه العقيدة
هي خلاصة ما
جاء به الْحُلُولِيُّونَ
الزنادقةُ من
أمثال حسين بن
منصور الحلاّج،
وفريد الدين
العطار، ومحي
الدين بن
عربي، وعبد
الحق بن
إبراهيم بن
سبعين المرسي،
وسليمان بن
على بن عبد
الله
التلمساني، والحسين
بن علي بن
هود، وعبد
الكريم
الجيليّ ومَنْ
على شاكلتهم
من زنادقة
العرب والعجم.
فقد زعموا أنّ
الله عين كلّ
شيء؛ وهو هذه
المخلوقات
على كثرتها
واختلاف أنواعها
وأجناسها
وألوانها
وأحجامها
ومعانيها
ومبانيها وأصولها
وفروعها من
إنسٍ وجنٍّ
وملائكةٍ
وحيوانٍ
ونباتٍ
وجمادٍ
وكبيرٍ
وصغيرٍ ورطبٍ
ويابسٍ
وطاهرٍ ونجسٍ.
إنّ
قدماء
النقشبنديّين
وخاصّتهم لا
يختلفون عن
هؤلاء في هذا
الاعتقاد.
ولكن لا يصل
إلى ذلك
المستوى أحدٌ
(في رأيهم) إلاّ
إذا التـزم
آدابَ السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
وفق
المصطلحات
الأحد عشر.
فمتى تدرّج
المريدُ في
هذه المراتب
وبلغ إلى
منتهى
المنازل وتحقّقت
فيه حالة »يَادْدَاشْتْ«،
أصبح فانيًا
في الله وتأكد
من أنّ اللهَ
قد حلّ فيه،
وأنّه جزءٌ
منه، وأنّه كلّ
شيء. تعالى
الله عن ذلك
علوًّا
كبيرًا.
نعم
هذه هي حقيقة
مرادهم، وإنْ
دافع المتأخّرون
المعاصرون من
شيوخ النقشبنديّة
عن ساداتهم
بأنّهم لم
يقصدوا ذلك.
بلى، إنّهم
على هذا
الاعتقاد؛
وتشهد عليهم
مراسلاتهم الخاصّة
وأخبارهم
الّتي سجّلها
أسلافهم
بالذات،
ونقلوها عنهم
صراحةً. منها
ما قد فشت
أسرارُها
وافتضح،
ومنها ما لم
تزل تحت ستار
الكتمان في
ذمّة خواصّهم.
أمّا جهل
عامّتهم بهذه
الحقائق فله
أسبابٌ سوف
نشرحها في الفصل
الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
***
أمّا
المباني
الثلاثة
الأخيرة
الّتي وضعها مؤسّسُ
هذه الطريقة محمّد
بهاء الدين
نقشبند؛ فالأوّل
منها: هو »الوقوفُ
الزمانيُّ«.
وجاء تفسيره
على لسان محمّد
أمين الكرديّ »إنّه ينبغي
للسّالك بعد
مُضِيِّ كلّ
ساعتين أو
ثلاث، أن
يلتفتَ إلى
حال نفسه كيف
كان في هاتين
الساعتين أو
الثلاث.« [194]
لاشك
أنّ هذه
المراقبة
النفسيّة
امتداد
للحالات الّتي
يمرّ بها
السالك (أي
المريدُ
النقشبنديّ)
عبر الرياضه الصوفية
وسلوكها وفقًا
لما سبق
شرحُهُ من
آداب هذه
الطريقة كما
يُفْهَمُ من
تعريف
الكرديّ لهذا
المصطلح. ويعني
هذا إنّه لابدّ
للدرويش
القائم بهذه
الرياضة أنْ
يتأكّد من نفسه
في نهاية كلّ
ساعتين أو
ثلاثِ
ساعاتٍ، هل
تحقّق له الفناء
في الله
والبقاء
بالله، أم لا
يزال في ريب
من ذلك، ولا
يكاد يجد
نفسَهُ
متلبّسًا
بالبشريّةِ.
فإذا وجد أنّه
لم يقتنع بعد،
وجب عليه أن
يواصل رياضته
حتّى يَقِرَّ
في نفسه أنّ
الله موجود في
كلّ ذرّة من
الكائنات،
وبالتالي
فيكون قد حلّ
فيه وأصبح
السالكُ هو
الفاني في
الله والباقي
به. هذا من
أصول
اعتقادهم وإنْ
كتموا ذلك عند
غيرهم
واحتاطوا عند
العوامّ منهم.
أمّا
»الْوُقُوفُ
الْعَدَدِيُّ«
و »الْوُقُوفُ
الْقَلْبِيُّ«،
فإنّهما من
متمّمات »الوقوفُ
الزمانيُّ«.
إذ على السالك
أن يحافظ على
عدد الوتر في
الذكر بالنفي
والإثبات
عَبْرَ مراحل
الرياضة.
علمًا بأنّ
الغرض الأصليَّ
من هذا الذكر
ليس إلاّ تحقيق
حالات نفسية
معيّنة. وهي »التركيز
الفزيولوجي«Consantration physiologic = ومنه
التطوّر إلى
حالة »الغيبوبة«Transcendental absance = .
لأنّ السالك
إنّما يتطبّع
تمامًا
بالصبغة الّتي
يريدها
شيخُهُ عندما
يكون قد تدرّج
إلى هذه الحالة
النفسية في
نهاية المطاف.
كلّ
هذه المقولات
المشبوهة،
مؤدّاها
إذلالُ كرامة
الإنسانِ،
وإلحاق
الضمور
بعزّته، وتحويله
إلى بهيمةٍ
مُدَرَّبَةٍ
على الطاعة
العمياء. وليس
فيها شيءٌ
ممّا أمر به
الإسلامُ من
التواضعِ والإحترام
والإطمئنان والمروءة
والسكينة
والوقار. وإذا
تأمّلنا غاية
ما في هذه
المقولات من
التوجيه على
لسان شيوخ النقشبنديّة،
وجدنا الصواب
منها ما جاء
في كتاب الله
تعالى وسنة
رسوله r بأفصحِ
عبارة
وأفضلها
وأوجزها، وفي
أساليب القرآن
من تمام
البيان
والتحقيق ما
ليس في هذه
المقولات
وغيرها مثله.
قال تعالى:
وَلاَ
يَأْتُونَكَ
بِمَثَلٍ
إِلاَّ
جِئْنَاكَ
بِالْحَقِّ
وَأَحْسَنَ
تَفْسِيراً.[195]
***
الفصل
الثالث
* مفاهيم،
ومصطلحات،
ومعتقدات
أخرى عند هذه
الطائفة.
------------------------
*
التصوّف.........................................................................................................................................
* السَّيْرُ
وَالسُّلُوكُ............................................................................................................................
* العشق
الإلهيّ..................................................................................................................................
* المعرفة
بالله.......................................................................................................................................
* الفناء
والبقاء.................................................................................................................................
* وحدة
الوجود................................................................................................................................
* وحدة
الشهود...............................................................................................................................
* الولاية،
والوليّ، وتصرّف
الميّت................................................................................................
* المكاشفة
والإلهام،
وعلم الغيب..................................................................................................
* الأُوَيْسِيَّةُ.........................................................................................................................................
* الكرامة،
والمناقب.........................................................................................................................
*
مفهوم
التوسّل في
معتقد النقشبنديّة
وما ركّبوا
عليه من أمور..............................................

الفصل
الثالث
* مفاهيمُ
ومصطلحاتٌ
ومعتَقَداتٌ
أخرى عند هذه
الطائفة.
إنّ
الطّرَائِقَ الصوفيّةَ
عامّةً، (بما
فيها الطريقة النقشبنديّة)
هنّ أصلاً
منظّماتٌ
شبهُ
سرّيّةٍ، بل
هنّ أديانٌ
مشبوهةٌ
نشأتْ - في
حقيقة الأمر -
لضرب الإسلام
من الداخل على
يد زنادقة
متنكّرين بلباس
الزهد
والعفّة
والإخلاص. لهذا،
كلّما تعمّقنا
في البحث من
وراء حقيقة الطّرَائِقِ
الصوفيّة
وَجَدْنَا أنفسنا
أمامَ رُكامٍ
من مخلّفات
الأديان
والفلسفات
تتمثّل في
مفهوم التصوف.
***
*
التصوّف:
أمّا
التصوّف، فإنّه
نَفَقٌ مُظْلِمٌ
تتزاحم فيه
أفكارٌ
غامضةٌ
وعقائدُ
غريبةٌ وتأويلاتٌ
خطيرةٌ
وفلسفاتٌ
دخيلةٌ
وألفاظٌ مُعَقَّدَةٌ
وأساطيرُ
عجيبةٌ
وحكاياتٌ رهيبةٌ
تراكمتْ في
مجَلَّدَاتٍ
من كتب
الصوفيّةِ
وانتشرتْ بين
آلافٍ مؤَلّفَةٍ
من أصحاب
النفوس
الضعيفةِ
والمغفّلين
الّذين لم
يفطنوا إلى ما
فيه من أخطار
على الإسلام
والمسلمين
ضمنَ ذلك
المزيج الباطني
المُخْتَلَقِ.
»ينبغي
أنْ يُفْهَمَ
جيّدًا أنّ
التصوّف لا يعني
الزهد في
الدنيا أو
تزكية النفس
وتصفيتها،
وإنّما هو
فلسفة كاملة
شاملة وعقيدة
لها معالمها
الخاصّة بها.
ولم يكن المتصوّفة
هم أوّل من
ابتدعوا
التصوّفَ
واخترعوه، بل
هو فكرة
فلسفيّة
قديمة جدًّا،
كان لها
أتباعها في
اليونان
والهند
والصين
والفارس. وكان
في البوذيّة
والهندوسيّةِ
واليهوديّة
والنصرانيّةِ
متصوّفتها
الخاصّة بها.
ولم يوجد
التصوّف بين
المسلمين
إلاّ بعد
ترجمة كتب
الفرس
واليونان
والهنود إلى العربيّة.
والدارسُ
لعقائد
الصوفيّة يجد
لها أصلا في
الديانات السماويّة
والوضعيّة
الأخرى. فوحدة
الوجود عند المتصوّفة
مستمدّة من
الهندوسيةِ،
والحلولُ
والفناءُ في
ذات الله
مستمدٌّ من
النصرانيّة
الّتي تُؤمن
بحلول ذات
عيسى
البشريّة بالذات
الإلهيّة.
وكذلك عقيدةُ
الحقيقةِ المحمّديّة
مأخوذةٌ من
تصوّرٍ
مشابهٍ
للنّصرانيّةِ
حول عيسى
ومكانته في
الدنيا...«[196]
لقد
اختلف
الباحثون في
ردِّ كلمةِ
التصوّفِ إلى
أصولٍ متباينةٍ،
وكلٌّ
حمَّلَها
معنىً على
حسبِ رأيِهِ
وظنِّهِ؛
وغَفَلَ
جميعُهُمْ عن
أصلِها
الحقيقيِّ
كما سنفضحهم
بالدليل
القاطعِ في
نهاية البحث إنْ
شاء الله
تعالى.
زعم
فريقٌ منهم:
أنّ التصوّفَ
مشتقٌّ من
الصفاءِ أو
الصفوِ. فقد
وقعوا بهذا
الزعمِ في
ورطةٍ كشفتْ
عن جهلهم
باللّغة العربيّة؛
إذ أنّ الأصلَ
الثلاثيَّ
للتّصوّفِ
يتركّبُ من
الصادِ
والواوِ
والفاءِ
(صَوَفَ)،
بينما الأصلُ
الثلاثيُّ
للصّفاءِ أو
الصفوِ يتركّبُ
من الصادِ
والفاءِ
والواوِ
(صَفَوَ). وبهذا
قد افتضحوا
إلى حدٍّ لا
مجال
للاعتبارِ برأيهم
وهم أصحابُ
هذا المستوى
من السطحيةِ
والجهلِ.
وقال
فريقٌ منهم:
إنّ كلمة »التصوّفِ«
تعودُ إلى »الصُّفَّةِ«
الّتي كانت
جماعةٌ من
فقراءِ
الصحابةِ
يأوون إليها؛
بينما الربطُ
بين هاتين
الكلمتين غيرُ
جائزٍ بوجهٍ
من الوجوهِ.
فالمناسبةُ
الاشتقاقيةُ
ممنوعةٌ. لأنّ
»التصوّف« (إذا
فرضناه كلمةً
عربيةً وهي
غيرُ عربيةٍ
إطلاقًا كما
سيتّضحُ في
نهاية البحثِ
بالدليل
القاطعٍ)،
فأصلُهُ
الثلاثِيُّ
يتركّبُ من
الصادِ والواوِ
والفاءِ
(صَوَفَ). أمّا
الأصل
الثلاثِيُّ
لكلمة »الصُّفَّةِ«،
فإنّه
يتركّبُ من
الصادِ
والفاءِ
مضعّفًا (صَفَفَ).
فالخلافُ بين
الكلمتين
ظاهرٌ لا يترك
المجالَ لأيِ
مناقشةِ.
ثم
المناسبةُ
بين
المفهومين من
حيث المعنى، ممنوعةٌ
أيضًا. لأنّ »التصوّف«
مصطلحٌ
اختلفت
الآراءُ في
تعريفِهِ
وشرحِهِ،
وعجز الناسُ
عن فهمِ
حقيقتِهِ
حتّى اليوم. أمّا »الصُّفَّةُ«،
فإنّها كانت
بيتًا بسيطًا
مسقوفًا بقضبان
النخلِ يسكن
فيه الضعفاءُ
من أصحابِ رسول
الله r
ثم
المناسبةُ
بين
الصوفيّةِ
وأهلِ
الصُّفّةِ
ممنوعةٌ
أيضًا. لأنّ
الصوفيّةَ
يعيشون ويتعبّدون
على أساس قهر
النفسِ
بالجوعِ،
والرهبنةِ،
ولبس
المسوحِ،
وترديد
الأورادِ على الطريقة
البوذيّة،
ورابطةِ
الشيخِ، وحلقات
الذكر،
والسماعِ
والرقصِ... لا
يعتدّون في كلّ
ذلك بمبدأ
»التوقيفيةِ«
في الأسلام.
بينما كان
أصحابُ
الصُّفّةِ
كلّهم يقتدون
برسول الله r في سيرهم
وسلوكهم
وكلامهم،
وتعبّدهم
وأخلاقهم
وتعاملهم.
وقال
فريقٌ آخرُ:
إنّ أصل
التصوّفِ
مشتقٌّ من الصوفِ
الّذي كان منه
لباس رجالٍ
رفضوا زينةَ
الدنيا
وملذّاتِها،
وعرفهم
الناسُ
بالتواضُعِ
والقناعةِ
والاستقامةِ
في أمر
الآخرةِ.
إنّ
الربطَ بين
كلمتَيِ
الصوفِ
والتصوُّفِ بهذه
المناسبةِ
واهيةٌ جدًّا.
لأنّ التواضُعَ
والقناعةَ
والاستقامةَ
لا يتوقّفُ
على لبس
الصوفِ، ولا
على لبس القطنِ؛
بل الأخلاقُ
في الإسلامِ
سلوكٌ متكاملٌ
قد حدّده
الكتابُ
والسّنّة.
أمّا
كلمة
التصوّفِ،
فإنّها في
الحقيقةِ منقولةٌ
من اللّغة
اليونانيةِ.
وضبطُها:
الثيوصوفيةُ (Theosophy)،
على غرارِ
كلمة
الفلسفةِ.
لأنّها أيضًا
يونانيةٌ،
وضبطُها:
الفيلسوفيةُ (Philosophy)،
كما جاء في
موسوعة
المورد
لمؤلّفه منير
البعلبكي.
يقول
المؤلّفُ:
»يُقصَدُ
بالثيوصوفيةِ
بالمعنى
العامِّ: معرفة
الله من طريق
الكشف
الصوفيّ أو
التأمّل الفلسفيِّ،
أو من طريق
الكشف
الصوفيّ
والتأمّلِ
الفلسفيِّ
معًا. وهي
بهذا المعنى
ظاهرةٌ قديمةٌ
عرفتها
الأديانُ على
اختلافِها«.
هكذا
افتضح أصحابُ
الأسانيدِ
الواهيةِ الّذين
بنوا آراءَهم
في مسألةِ أصل
التصوّف، على
اجتهاداتٍ
ونظريّاتٍ
وفرضيّاتٍ لا
تقوم على
برهان من
الكتابِ
والسّنّة،
ولا على دليلِ
علميٍّ
ثابتٍ؛ ربما
لقلّةِ
عِلْمِهِمْ
بالأديان،
والفِرَقِ
والعقائدِ
وتطوّراتِها،
وَجَهْلِهِمْ
بظاهرةِ
الاستحالةِ وما
يتعرّض له
المعتقداتُ
من التحريفِ
مع الزّمانِ،
وَكذلِكَ
جَهْلِهِمْ باللّغات
الأجنبيّة.
لقد
نشأت الطريقة النقشبنديّة
كسائر الطّرَائِقِ
الصوفيّة في
هذا الدّهليز
وتغذّت من
مستنقعات
التصوّف
فتطوّرت
عَبْرَ
القرون من
شكلٍ إلى
شكلٍ،
وتغيّرت من
لونٍ إلى
لونٍ؛ كلّما
زيد فيها أو
أُلْغِيَ
منها. فحملت
من غُثَاءِ
عددٍ من
الأديان،
وجرفت من قاذوراتِها
على امتداد
مجراها في
تاريخ الشعب
التركيّ بعد
إسلامهم إلى
أنْ امتلأت
حاويتُها
بأصنافٍ من
عقائد الهنود
والنصارى
واليهود؛ وإن
استنكر هذه
الحقيقةَ
صناديدُ
الطائفةِ
وعفاريتُها
بملامة
ومعاتبة وعُنفٍ
وردود. وما
أدلّ على
تحريفهم
للإسلام ما قد
نسبوا إليه من
مفاهيمَ
ومصطلحاتٍ
ومُعْتَقَدَاتٍ
دخيلةٍ لا
تمتُّ بصلةٍ
إلى الإسلام في
واقع الأمر.
وقد
حان الوقت
وناسب المقام
لشرح ما تبنّتْهُ
النقشبنديّة
من أغراضٍ وما
اختلقَتْهُ
من مفاهيمَ
باطنيّةٍ
أخرى،
فأقامتْ على
أساسِها
سلسلةً من آدابٍ
وأركانٍ
تعتمد على تلك
المفاهيم،
وهي: السَّيْرُ
وَالسُّلُوكُ،
والعشقُ
الإلهيُّ،
والمعرفةُ
باللهِ،
والفناءُ
والبقاءُ، و وحدةُ
الوجودِ، و
وحدةُ الشهودِ،
والولايةُ،
والوليّ،
وتصرّفُ
الميّتِ،
والإلهامُ،
والأُوَيْسِيَّةُ،
والكرامةُ،
والمناقبُ،
والاستغاثةُ
بالموتى،
وتقديسُ
قبورهم،
وزيارتُها،
والتَّبَرُّكُ
بِهَا،
والتوسُّلُ بِهَا.
***
*
السَّيرُ
والسُّلُوكُ.
أمّا
السَّيْرُ
وَالسُّلُوكُ،
فهو مصطلح
هامٌّ عند النقشبنديّة.
وقد يذكرون
واحدًا منهما بقصد
الجمع بينهما
كما اختاره
أحمد ضياء الدين
الْگُمُوشْخَانَوِيّ.[197]
قال
السيد محمود
أبو الفيض
المنوفي - وهو
أحد أدباء المتصوّفة
وأعلامهم في
عصرنا - قال في
كتابه
المعروف بعنوان
»معالم
الطريق إلى الله«:
»معنى
سلوك الطريق،
التحقّق
بمقامات
اليقين
وأحوال القرب
من الله عزّ
وجلّ بالعلم
والعمل
والمقام
والحال سلوكًا
على يد شيخٍ
عارف بمعالم
الطريق
ومفاوزه،
فيدلّ السّالك
على السّبيل
الأقرب إلى
الله بما
يرشده إليه من
أنواع الرّياضة
والذكر
والخلوة وغير
ذلك.«[198]
هذا
هو المراد
العامّ الظّاهر
من السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
في التصوّف.
أمّا عند النقشبنديّة
فينحصر السّلوك
في الخلوة.
وقد أفردها
بعضهم في فصلٍ
مستقلٍّ
كمحمد أمين
الكرديّ، إذ
يقول:
»اعلم
أنّه لا يمكن
الوصول إلى
معرفة الأصول
وتنوير القلوب
لمشاهدة
المحبوب إلاّ
بالخلوة
خصوصًا لمن
أراد إرشادَ
عبادِ الله
إلى المقصود.«
يتبيّن
من كلام
الكرديّ هنا
مرّة أخرى أنّهم
يختلفون مع
جمهور
المسلمين في
معاملة ربّ العالمين.
ذلك أنّهم لا
يقصدون
عبادةَ الله
بشهادة هذا
الإقرار. وإنّما
يريدون
الوصولَ إليه
ويبتغون
مشاهدتَهُ. وعلى
الرّغم من هذا
التصريح فانّّ
فريقًا منهم
يُخفون ما في
صدورهم،
وفريقًا يجهلون
الغرض
الحقيقيَّ
الّذي
يُضْمِرُهُ
قُدَمَاؤُهُمْ
الّذين لهم
الهيمنة على
نفوس عامّة
النقشبنديّين.
ألا وهو
الحلول والاتّحاد.
ولهم
في هذه
المسيرة طرقٌ
ملتويةٌ
وآدابٌ مشبوهةٌ
تتمثّل في
رياضاتٍ
هنديةٍ،
أحدثوا لها
أغلفةً من
مفاهيم
الإسلام
وقِيَمِهِ،
بحيث لا ينتبه
إلى مقاصدهم
مَنْ قَصُرَ
علمُهُ أو غلبتْ
عليه الثقة
فيهم بما
يشاهد في
مظاهرهم من السّكينة
والوقار
والورع
والصلاح.
وهذه
الرياضة
الّتي
يسموّنها
(خلوة) يدّعون
أنّهم إنّما
يمارسونها
أسوةً
بالرسول r في
أحواله قُبيل
بِعثته.
ويقولون: »وقد
كان النبيّ r
يخلو بغار
حراء حتّى
جاءه الأمر
بالدعوة«[199]
ويتناسون أنّه
u
لم يفعل ذلك
بعد البعثة،
ولا أمر أحدًا
من أصحابه
بالخلوة
(الّتي تختلف
عن الاعتكاف).
وإنّما كانت
خَلَوَاتُهُ
قبل البعثة
اندفاعًا وُجدانيًّا
ينساق معه
بتوفيقٍ من
الله
واستعدادًا
لما سوف
يتحمّله من
أعباء النبوّة؛
وأنّها كانت
حالةً
استثنائيةً
خاصّة به دون
غيره، اقتضت
في بداية
أمره.
أمّا
الّذي يريده
النقشبنديّون،
فليس إلاّ استغلال
مفهوم الخلوة
بهذه
الذريعة،
ليتمكّنوا
بها من ضمّ
شعارات هنديّة
إلى شعائر
الإسلام تحت
ستار العبادة
والتقرّب إلى
الله بتقليد
السّحرة
والمشعوذين
من الجوكية
(اليوغية)
والفقراء
الهنود.
وللخلوة
عندهم عشرون
شرطًا
مشروحةً في
كتبهم.[200] لا حجّة
لهم في
إثباتها
بشيءٍ من كتاب
الله، ولا من سنّة
رسوله r.
وقد
باح بالسِّرِّ
المقصود من السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
بعضُ
المعاصرين
منهم، وخاصة
جماعة غالية
من هذه الطائفة
في إسطنبول.
وذلك لما
وجدوا عامّة
المسلمين في
شغل عنهم
فتصدّوا
لتفسير كتاب الله
بأسلوبٍ
باطنيٍّ،
أصدروه
باللّغة التركيّة
تحت عنوان »روح الفرقان« عام 1992م.، وتطرّقوا
فيه إلى السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ.
ومن
جملة ما جرت
به أقلامهم
بهذا التفسير
الشاذِّ، قولهم
(مُعَرَّبًا):
»إنّه
بعد ما يضمحلُّ
جميعُ ما سوى
الله من نظر
السّالك بفضل
المولى وكرمه
بحيث لا يكاد
يرى غير الله
شيئًا
أجنبيًّا - اسْمًا
كان أو صورةً -
تَحَقَّقَ له
الفناءُ في
الله، أي
الانصهارُ في
ذاته. وحصلتْ
بذلك الدولة،
وانتهت
الطريقة،
واكتمل السّير
إلى الله (أي
المِشْيَةُ
المعنوية نحو
المولى)«[201]
كانت
هذه تَرَجَمَةٌ
حَرْفِيَّةٌ
لِنُبْذَةٍ
من كلامهم في
تفسير السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ،
ولا يحتاج إلى
تعليق. وخلاصةُ
ما ينبغي أن يؤكّد
في النّهاية
عما يتعلّق
بهذا التفسير
الجريء، أنّهم
يختلفون عن
المسلمين
بعقيدتهم في
ذات الله أكثر
من اختلاف النّصارى
عن المسلمين
في هذه
العقيدة.
***
*
العشقُ
الإلهيُّ
أمّا
العشق
الإلهيُّ،
فهو من أهمّ
مباحث الصّوفيّة.
فقد جرى
كلامُهم حوله
نثرًا ونظمًا
كما في تائيّة
عمر بن
الفارض،[202] وديوان
المُلاّ أحمد
الجزري
الكرديّ،
وأشعار رابعة
العدويّة.[203] وقد
كثرتْ في هذه
المسألة
هذياناتهم
قديمًا
وحديثًا. غير
أنّ هذا
التعبير لم
يكن شيئًا
مُتَدَاوَلاً
بين قدماء النقشبنديّة،
فانتشرتْ هذه
الفكرةُ في
أوساطهم منذ
أَمَدٍ غير
بعيد، وربما
بتأثير بعض
الشيوخ منهم.
إذ أنّ كلّ ما
يقوله شيخ الطّريقة،
ويختلقه من
تلقاء نفسه لا
يُعدُّ بِدْعَةً
عندهم، وإنْ
تعارضتْ
أقواله مع
نصوص الكتاب
والسّنّة؛
ولأنّ شيخ الطّريقة
لا ينحصر
مجاله في حدود
اختصاص
معيّن، ولا
تقتصر
مهمّتُهُ في
نطاق
الاجتهاد
والتفسير
والتأويل
فحسب. بل هو في
اعتقاد الطّائفة
»وكيل
الله ونائبه«[204] يتصرّف
كيف يشاء،
ويتفوّه بما
يبدو له. إذن فله
أن يُضِيفَ
إلى مبادئِ
الطّريقة
وآدابِها
وأركانِها
وطقوسِها ما
يشاء، أو أنْ
يُلْغِيَ
منها ما يشاء.
وهذا ما جعل الطّريقة
تتغيّر فيها
أمور بين
الفينة
والأخرى.
فقد
أفرد محمّد أمين
الكرديّ
فصلاً في الْمحبّة
والشوق
والوجد. وقال
في مقطعٍ منه:
»اعلم
أنّ المحبّين
على ثلاثة
أقسام: عوامٌّ
وخواصٌّ،
وخواصُّ
الخواصِّ.
فأما
العوامُّ فمحبّتهم
له تعالى لِوُفُورِ
إحسانه، وأما
الخواصّ فمحبّتهم
خالصة عن
الشوائب.
وأمّا خواصّ
الخواصّ، فمحبّتهم
عبارة عن
التعشّق
الّذي به
ينمحي العاشق
عند تجلّي نور
معشوقه.«[205]
لقد
يظهر من خلال
هذه الكلمات
أنّ
النقشبنديّين
اكتشفوا
أخيرًا
أسلوبًا
ثانيًا
لتفسيرِ ما
يعتقدونه من
وحدة الوجودِ
والحلولِ
والاتحادِ.
ألا وهو »العشق
الإلهيُّ«.
لأنّهم
يقصدون بذلك
الانصهارَ في
ذاته تعالى عن
ذلك علوًّا
كبيرًا.
إنّ
تَشَبُّثَهُمْ
بمثل هذه
الفكرة تَطَوُّرٌ
جديدٌ وغريبٌ.
لأنّ
النقشبنديّين،
من أهمّ
مزاياهم الصّمتُ
والتأمّل
والذكر
القلبيّ
بالتركيز على
أسلوب الجوكيّة
(اليوغيّة) في
الدّيانة البوذيّة
- البرهميّة.
وأنّهم لم
يلتفتوا منذ
القديم إلى
الأشعار
والغزل كما قد
اتّخذوا
موقفًا
معارضًا
للرقص والسّماع
عَبْرَ
تاريخهم. لأنّ
الحركة من
أكبر موانع
التَّرْكِيزِ.
وإلاّ ليست
معارضتهم
للرقص
والسماع من
منطَلَقٍ
إسلاميٍّ
صحيح في حقيقة
الأمر.
أمّا
تعبير العشق
في كون
الإنسان أن
يعشق الله،
فقد كان من ضلالات
الأقدمين من
متصوّفة
العراق. كانوا
يتفوّهون به
في غزلهم. ولم
يعبأ بهم
علماء
الإسلام
يومئذ لِخِسَّةِ
شأنهم وقلّة
عددهم. ولكن
هذه الفكرة قد
أصبحت اليوم
خطرًا على
العقيدة الإسلاميّة
بعد أن
تَبَنَّاها
النقشبنديّون.
علمًا بأن العشق
في اللّغة
يفيد معنى الاشتياق
إلى الجنس
المقابل بقصد
النكاح والجماع.
ولم يرد في
الكتاب
والسّنّة ما
يفيد أنّ
العبد يجوز له
أن يعشق الله.
بل ورد فيهما
الترغيب في
محبّة الله
ومحبّة رسوله r.
إذ قال الله
تعالى: { قُلْ
إِنْ
كُنْتُمْ
تُحِبُّونَ
اللهَ
فَاتَّبِعُونيِ
يُحْبِبْكُمُ
اللهُ وَيَغْفِرْ
لَكُمْ
ذُنُوبَكُمْ.}[206]
ورغم
السّبيل الذي
طرقه النقشبنديّون
في تأويلهم
لمفهمو »العشق
الإلهيّ«،
فإنّه لم يُغْنِ
عنهم في الوقوع
فيما يكتمه
خاصّتُهم
ويجهله
عامّتُهم من
نزعات باطنيّةٍ
بهذا التأويل
الشَّاذِّ
لمفهوم العشق.
لأنّ كلمة
العشق تختلف
اختلافًا كبيراً
عمّا تفيد
كلمةُ
المحبّةِ في
التعبير عن
عواطف
الإنسان. فانّ
المحبّةَ
بمعناها المتعارَف
هو إحساس
عاطفيٌّ
نبيل، لا
يشوبه ميل شَهَوِيٌّ
وابتذالٌ
جسديٌّ. وأمّا
مفهوم العشق،
فانه ينبئ عن
نزعاتٍ آثمةٍ
وهَوَاجِسَ شَهَوِيَّةٍٍ
تثور في
النفوس
المتلهّفةِ
بالغرام
والهيام،
والمشتاقةِ
إلى إشباع
الرغبات الجنسية
وما يتصل بها.
ولقد
دأب شعراءُ
الصوفيّة
دائمًا على
وصف الله
بصفات المرأة
الجميلة
الفتّانة؛
يحملونها
عليه أنّه
يتجلّى في
جمالٍ غزليٍّ
خلاّب، يفتتن
به العاشقون؛
ويتخيّلونه
في صورة من
الأنوثة بشعور
تتلظّى إليها
نفوسهم وهي
تراودهم عن نفوسهم.
حاشا لله!!!
بينما
نجد
النقشبنديّين
على درجة من
الإفراط
والمبالغة بأولئك
الشعراء
المبتذلين من
الصوفيّة
ويشاركونهم
في العقيدة
والموقف
بإقرارهم
لمفهوم »العشق
الإلهيِّ«
على غرار ابن
الفارض
والمُلاّ
الجزري وأمثالهما.
***
* المعرفة
باللهِ
وأمّا
فكرة »المعرفة
بالله«
عند
الصوفيّة،
فهي عقيدة
خطيرة
تبنّاها الأقدمون
منهم؛ ثم
تطوّرت منها
سائر عقائد
القوم. إذًا
فهي بمنـزلة
القاعدة
الأساسية لها.
فقد
أفرد
القشيريّ في
هذه المسألة
بابًا وهو من
قدماءِ
الصوفيّةِ
وأعلامِهم.
قال في رسالته
المشهورة:
»وعند
هؤلاء القوم
المعرفة: صفةُ
مَنْ عَرَفَ الحقَّ
سبحانه
بأسمائه
وصفاته، ثم
صدّق الله في
معاملاته. ثم
تنقّى عن
أخلاقه
الرديئة
وآفاته...« [207]
من
الأهمية
بمكان، أنّ
هذا التعريف
لا يتعارض مع
العقيدة الإسلاميّة
لو لا أنّ
القشيريّ
تحيّل في
إيراد هذه العبارة
أنْ جعلها
تعريفًا
لمفهوم »المعرفة
بالله«.
بل كان أولى
به أن يقول
»الإيمان:
صفةُ مَنْ
أيقن بالحق
سبحانه وعَرَفَ
أسماءه وصفاته،
ثم صدّق الله
في معاملاته.«
هكذا
يتبيّن
بوضوحٍ أنّ
الصوفيّة قد
حرّفوا عقائد
الإسلام
بِحِيَلٍ
دقيقةٍ قلّ من
انتبه إليها في
أيّامها.
وبذلك سنحت
لهم الفرصة
فطوّروها
بتدرّجٍ عبر
القرون حتّى
التبستْ
المفاهيم
الدخيلة
والعقائد
الخطيرة
بالمفاهيم
القرآنية على
عوامّ
المسلمين
فانحدر من هذا
الالتباسِ ركامُ
البدعِ
والأباطيلِ
على كرِّ
الزمانِ
فتكوّنتْ
منها جبالٌ
عجز المسلمون
في هذا العصر
عن التخلّص
منها.
أمّا
في الحقيقة،
فانّ مقولة »المعرفة
بالله«
ليست من
الإسلام في
شيء، ولا ورد
في الكتاب
والسّنّة ما يؤكّد
ذلك. بل دعا
اللهُ عبادَه
أن يؤمنوا به
قبل كلّ شيء.
والآياتُ في
ذلك كثيرةٌ.
ثم أمرهم
بالعمل
الصالح
والتقوى. إذ
لم يرد في
القرآن أمر بـ
»المعرفة
بالله«
على الإطلاق.
بينما الأمر
بالإيمان ورد
فيه أكثر من
أن يُحصى.
كقوله تعالى
{فآمِنُوا
بِاللهِ
وَرَسُولِهِ
وَالنوُرِ
الّذي
أَنْزَلْنَاهُ
وَاللهُ
بِمَا
تَعْمَلُونَ
خَبِيرٌ.}[208] ولم
يقتصر الأمر
في توجيه
الدعوة
للكافرين إلى
الإيمان
فحسب، بل قد
أمر الله
المؤمنين
كذلك أن
يؤمنوا به
(وإن كان ذلك من
باب تكميل
الكامل وليس
من باب تحصيل
الحاصل) فقد
قال سبحانه:
{يَأَيُّهَا
الّذينَ
آمَنُوا
آمِنُوا
بِاللهِ
وَرَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ
الّذي
نَزَّلَ
عَلَى
رَسُولِهِ
وَالْكِتَابِ
الّذي
أَنْزَلَ
مِنْ قَبْل،ُ
وَمَنْ يَكْفُرْ
بِاللهِ
وَمَلاَئِكَتِهِ
وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ
فَقَدْ ضَلَّ
ضَلاَلاً
بَعيِدًا.}[209]
هكذا
فالآيات في
الدّعوةِ إلى
الإيمان كثيرةٌ
وفي هذا القدر
كفايةٌ. كذلك
وردت آيات
بيّناتٌ في
الدّعوة إلى
عبادةِ اللهِ
سبحانه.
قال
تعالى: يَا
أَيُّهَا
النّاسُ
اعْبُدوُا
رَبَّكُمُ
الّذيِ
خَلَقَكُمْ
وَالّذيِنَ مِنْ
قَبْلِكُمْ
لَعَلَّكُمْ
تَتَّقوُنَ. (بقرة/21). وقال
تعالى:
وَاعْبُدوُا
اللهَ وَلاَ
تُشْرِكوُا
بِهِ شَيْئًا...
(نساء/36). وقال
تعالى: يَا
أَيُّهَا
الّذيِنَ
آمَنوُا
ارْكعوُا وَاسْجُدوُا
وَاعْبُدوُا
رَبَّكُمْ
وَافْعَلوُا
الْخَيْرَ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحوُنَ.
(الحج/77)
وقد
رُوِيَ عَنْ
ابْنِ
عَبَّاسٍ
رَضِيَ اللهُ
عَنْهُمَا
أَنَّ
رَسُولَ
اللهِ r
لَمَّا
بَعَثَ
مُعَاذًا
رَضِيَ اللهُ
عَنْهُ عَلَى
الْيَمَنِ
قَالَ
إِنَّكَ
تَقْدَمُ
عَلَى قَوْمٍ
أَهْلِ
كِتَابٍ
فَلْيَكُنْ أَوَّلَ
مَا
تَدْعُوهُمْ
إِلَيْهِ
عِبَادَةُ
اللهِ
فَإِذَا
عَرَفُوا
اللهَ
فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللهَ
قَدْ فَرَضَ
عَلَيْهِمْ
خَمْسَ
صَلَوَاتٍ
فِي
يَوْمِهِمْ
وَلَيْلَتِهِمْ
فَإِذَا
فَعَلُوا
فَأَخْبِرْهُمْ
أَنَّ اللهُ
فَرَضَ
عَلَيْهِمْ
زَكَاةً مِنْ
أَمْوَالِهِمْ
وَتُرَدُّ
عَلَى
فُقَرَائِهِمْ
فَإِذَا
أَطَاعُوا
بِهَا فَخُذْ
مِنْهُمْ
وَتَوَقَّ
كَرَائِمَ
أَمْوَالِ
النَّاسِ
(رواه
البُخَاريّ)
أمّا
قوله u »فَإِذَا
عَرَفوُا
اللهَ«، معناه
فإذا عرفوه
بصفاته التي
جاءت في كتابه
العزيز، وهو
الإيمانُ
بهِ، وليس
التّعرُّف
إلى كُنْهِ ذاتِهِ.
وهنا
يتبادر إلى
الذهن أن
يُطرَح سؤالٌ
هامٌّ، وهو:
لماذا دعا
اللهُ
عبادَهُ
للإيمان به عن
طريق النظر
إلى آثاره
والمعرفة
بصفاته والعبادةِ
له فحسب، ولم
يكلّفهم
بالتعرّف إلى
ذاته ؟
لو
أنّ المسلمين
استيقظوا من
غفلتهم
واستطاعوا أن
يُدْرِكُوا
ما لم يدركه
أسلافهم في
عصور الظلام
من أسباب
الانحراف، وطرحوا
حتّى هذا
السؤال
البسيط مرة
واحدة فحسب؛
لاصطدموا
بحقائق مدهشة
اختفت عنهم؛
أدناها أنهم
قد أصبحوا
اليوم قلّةً
حتّى بين صفوف
المصلّين في
مساجدهم.
لأنهم إنما
يعبدون الله
تصديقاً لما
جاء من عنده
وإقرارًا
بالعبودية
له؛ بينما
تختلف الغاية
في محاولة
الآخرين من
العبادة تمام
الاختلاف.
لأنهم لا
يعبدون الله
إلاّ
ليتعرّفوا
على ذاته
وليحلّوا فيه.
تعالى رَبُّنَا
عن ذلك علوًّا
كبيرًا.
نعم
كيف تجوز
المعرفة بذات
الله؟ كيف
يجوز للإنسان
أن يحيط الله
الخالق
الأزليَّ
الأبديَّ، والإنسانُ
بِكَامِلِ
وجوده حادثٌ
ومخلوق؟... هل
يجوز أن يتّسع
عقل الإنسان
المخلوق
العاجز
المحدود حتّى
يستوعب ربّ
العزّة
بذاته؟ وما
دليل من يدّعي
ذلك من
المنقول
والمعقول؟
ألم يَنْهَ
رسول الله r
عن التفكّر في
ذات الله
تبارك
وتعالى؟[210] لأنّ
الإنسان
عاجزٌ عن
الإحاطة بِكُنْهِ
ذَاتِهِ عزّ
وجلّ. وإنما
هذا العجز هو
ذلك الحاجز
الرَّهِيبُ
الّذي يعترض
سبيلَ
الإنسانِ التَّعِيسِ،
ويقفُ في وجهه
على مدى
حياته، لا
يبرح أمامه في
كلّ لحظة. تلك
هي المشكلة
العظمى الّتي
تَكْمُنُ
فيها أسرارُ
الكفرِ
والإيمانِ،
بل وأسرار
الكون
والحياة بتمامها.
ذلك أنّ
الإنسان لو
استطاع أن يجد
أدنى سبيلٍ
للتّحقُّقِ
من ذات الله
سبحانه عن
طريق المشاهدة
أو التجربة،
لما اضطرّ أن
يواجه أعباء الحياة
والممات بكلّ
مرارتها. ولكن
الله تعالى
يقول { خَلَقَ
الْمَوْتَ
وَالْحَيَاَة
لِيَبْلُوَكُمْ
أَيُّكُمْ
أَحْسَنُ
عَمَلا.ً}[211] وإنما
يتوقّف حسن
العمل ـ
أوّلاً وقبل كلّ
شيء ـ على
الإيمان
بالغيب. وهو
الإيمان بذات الله
تعالى في حدود
المعرفة
بصفاته،
وبالنظر إلى
خلقه وآثاره
دون أن يتعدّى
الأمرُ إلى المعرفة
بِذَاتِهِ،
وهي محال.
كذلك قال الله
تعالى: { وَلاَ
يُحِيطُوَن
بشيءٍْ مِنْ عِلْمِهِ
إلاَّ بِمَا
شَاءَ.}[212] إذًا
فكيف
بالإنسان أن
يتمكّن من
الإحاطة بذات
الله وهو لا
يحيط بشيءٍ من
علمه إلاّ بما
شاء! لأنّ
علاقة المؤمن
بالله لا تعدو
عن التسليم
المحض له
تعالى؛ وهي
منحصرة في
حدود اليقين
التامّ به
والعبادة الخالصة
له فحسب.
هذا
ويتبيّن جليًّا
بأنّ الّذين
يرون معرفة
الله من الأمور
الجائزة
والممكنة،
يدّعون أنّها
قد تحققت لبعض
ساداتهم. إذ
يخلعون عليهم
صفة العارف بالله
{ كَبُرَتْ
كَلِمَةً
تَخْرُجُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ
يَقُولُونَ
إِلاَّ
كَذِبًا.}[213] يتبيّن أنّه
قد بلغ الحمق
والغباء بهم
إلى درجة، أنّهم
يدرسون عقائد
المسلمين في
مدارسهم
ويتداولون
كُتُبَ
أعلامنا؛
كشرح العقيدة
الطحاوية
للإمام أبي
جعفر أحمد بن محمّد
بن سلامة
الأزديّ،
وكتاب
التوحيد
للإمام أبي
منصور محمّد
بن محمّد
الماتريديّ،
وكتاب
التمهيد من
تصانيف أبي بكر
محمّد بن
الطيب
الباقلانيّ ورسالة
العقائد
النسفية لأبي
حفص عمر بن محمّد
النّسفيّ،
وشرح العقائد
النّسفية
للعلاّمة سعد
الدّين مسعود
بن عمر
التفتازانيّ.
ومع هذا، لا
ينتبهون إلى
أنّ الإيمان
ينافي عقيدة »المعرفة بذات
الله«. إذ
أنّ الله
سبحانه
وتعالى »ليس
بِعَرَضٍ ولا
جِسْمٍ ولا جَوْهَرٍ
ولا مصوَّر
ولا محدود.« كما
ورد في
العقائد
النسفية.
وخلاصة هذا:
أنّ الإنسان
المخلوق
الحادث
العاجز
والمحدودَ،
يستحيل عليه
أن يحيط
بالله،
ويتعرّفَ إلى
ذاته الأزليّ
الأبديّ
الّذي ليس
بمحدود.
إنّ
الصوفيّة قد
خبطوا في
تناقض شديد
إلى درجة أنّهم
يدرسون كتب
المسلمين
ويدرِّسونها
ويحفظون
منها، ثم
يعتقدون ما يجعلهم
في مقامٍ بين
الصدق
والكذب، بحيث
إذا صدّقوا ما
قد درسوا من
كتب
المسلمين،
شهدوا على
أنفسهم
بالكذب في
مصطلحهم
ومعتقدهم بما
سمّوه »المعرفة
بالله«؛
وإذا صدّقوا
هذه الفريةَ،
أصبحوا من
المكذّبين
لِماَ درسوا
من عقائد
المسلمين.
هكذا
فإنّ النقشبنديّين
أيضًا قد
تورّطوا في
هذا المأزق
تبعًا لبقيّة
الصوفيّة.
والدليل
عليهم، أنّهم
يُكْثِرُونَ
من وصف
ساداتهم بـ»العارف
بالله«.
***
*
الفناءُ
والبقاءُ.
وأمّا
»الفناء
والبقاء«
في عقيدة
الخاصّة منهم
دون عامّتهم،
فإنّها بمنـزلة
الحلقة
الأخيرة بعد »المعرفة
بالله«. ويتصوّرون
أنّهم يلتقون
فيها بذات
الله »لأنّهم
قد عرفوا الله
حق معرفته،
فاستحقّوا
بذلك أن
ينصهروا فيه
فيتحقّق
البقاء«، حاشا
لله!!! وذلك بعد
المرور بجميع
مراحل السَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ؛
من البيعة
والخلوة
وممارسة
الذكر الخفيِّ
والرابطة
ومراعاة »المباني
الأحد عشر«
وما يتصل بها
من آدابٍ
وأركانٍ سبق
شرحها في الفصل
الثاني. إلاّ
أنّهم لا
يُفشون سِرَّ
عقيدةِ
الفناءِ بهذا
الوضوح
خَوفًا مِنْ استنكارِ
المسلمين
وردودِ فعلهم.
بل يمضغون
الكلام في هذه
المسألةِ وأمثالها
احتياطًا
وتقيّةً، ويُخفون
ما في صدورهم
حتّى عن
عوامّهم
فضلاً عن المسلمين.
إنّ
فكرة »الفناءِ
في الله
والبقاءِ
بالله«
ليس أمرًا
حديثًا عند
الصوفيّة. بل
تكلّم به الأقدمون
منهم
كالقشيريّ.
إلاّ أنّ
عقيدة الفناءِ
قد تطوّرتْ
عند هؤلاء خاصّة.
فانّ
النقشبنديّين
قد أوّلوها بل
حرّفوها عن
معناها الّذي
أراده السابقون.
وعلى
سبيل المثال
فقد قال
القشيريّ »أشار القوم
بالفناءِ إلى
سقوط الأوصاف
المذمومة،
وأشاروا
بالبقاءِ إلى
قيام الأوصاف
المحمودة«[214]
إنّ
هذه كلمة حقٍّ
أرادوا به
باطلاً. إذ
أنّ إسقاط
الأوصاف
المذمومة
وإبقاء
الأوصاف المحمودة
قد وصّى بهما
الإسلام،
ولكنهم لجأوا
إلى
الإلتواءِ
والتلبيسِ عند
ما أطلقوا اسم
»الفناءِ«
على إسقاط
الأوصاف
المذمومة؛
وأطلقوا كذلك
اسم »البقاءِ«
على إبقاءِ
الأوصاف
المحمودةِ.
لأنّهم فتحوا بهذا
المصطلح
المبتَدَعِ بابًا،
استغلّه أخلافُهم
فأدخلوا منه سيلاً
من رموز الزندقةِ
والضلالِ كما
مرّت
الإشارةُ
إليها، وهى
تنحصر في عقيدة
الاتحاد مع
الله عند
خاصّتهم.
والدليل على
ذلك نعتهم لساداتهم
بصفة »الفاني
في الله
والباقي
بالله«. بينما
لم يرد عن
رسول الله r
ولا عن أحد من
الصحابة أنّه
وصف شخصًا
بهذا النعت.
لقد
تظهر أمارات
التطوّر
والتحريف في
هذا المفهوم
أيضًا بعد أن اختلقها
قدماؤهم
الأوّلون؛
كما قد حرّفوا
وطوّروا
الكثيرَ مما
وضعها
ساداتُهم على
مدى تاريخ النقشبنديّة.
ذلك أنّ
الأقدمين
منهم عند ما
جاؤوا بهذه الزندقة
لم يزيدوا على
أنّها تركُ
الأوصاف الذميمة
والبقاءُ على
الأوصاف الحميدة.
علمًا بأنّ
هذا البيان لم
يكن حافزًا مثيرًا
لانتباه
المسلمين
يومئذٍ. لأنّ
الاجتنابَ عن
الأوصاف
الزميمة
والبقاءَ على
الأوصاف
الحميدة شيء
مرغوب فيه،
وإن سُمِّيَ
بالفناء
والبقاء. غير
أنّ المسلمين
لما سكتوا عن
هذه التسمية
الشاذة؛ ولم
يتوقعوا أنّ مِنْ
ورائها حيلة
سوف تعود
بعواقب
وخيمة،
يتخذها المتأخّرون
ذريعة لبناءِ
عقائد أخرى
باطلة على
أساس مفهوم
الفناءِ،
فتطوّر الأمر
حتّى زعم
بعضهم »أنّ
الفناء هو أن
يتخلّص العبد
من غائلة ما
سوى الله.
ومعنى ذلك : أنّ
الفناء هو
غياب الصفات
البشرية في
صفات الحق،
كما أنّ الفناء
في الرسـول،
هو غياب
الصفات الإنسـانية
في صفات
الرسول.«[215] لأنّ
صفات الرسول
أيضًا صفات
إلهية عندهم.
إنّ
هذه الكلمات
في الحقيقة لا
تحتاج إلى أيّ
تعليق ولا
توضيح ولا
تفسير. ولقد
زاد المتأخّرون
من تطوير هذه
الزندقة حتّى
قسموها على ثلاث
مراتب: الفناء
في الشيخ،
والفناء في
الرسول،
والفناء في
الله. قال نعمة
الله بن عمر
حول هذه
الهرطقة، وهو
من معاصري
خالد
البغداديّ.
قال في كتابه »الرسالة
المدنيّة«[216] في باب الرابطة:
»وإذا
تأمّلتَ
مجرّدَ ذكر
القلب، لا
يعدل عليه
شيء. فهذه
النعمة تحصل
بالمحبة بين
المريد وشيخه
من الجانبين.
لأنّ الفناء
في الشيخ
مقدّمة
الفناءِ في
الرسول؛
والفناء في
الرسول مقدمة
الفناء في
الله والبقاء
بالله.«[217]
هكذا
تطوّرت
الطريقة النقشبنديّة
واستمرّت في
مسيرتها بين
تبديل وتحريف
وزيادة
ونقصان
واقتباس
وتكييف
وتأويل
وتقليد وتعطيل
على يد شيوخ
هذه الطائفة إلى
أن ألبسوها
كسوة من هذا
التأويل
الخطير للفناءِ
والبقاءِ
خلافاً لمن
وضعهما من
قدماءِ
الصوفيّة.
وبهذا
الأسلوب
الّذي يدلّ
على عدم
استقرار
الطريقة النقشبنديّة،
كتموا تارةً
مقصودَهم
الحقيقيَّ من
هذين المفهومين،
وتارةً
بَاحوُا به
كما جاء في
المواهب
السرمديّة لمحمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ
نقلاً عن أحمد
الفاروقيّ،
وهذا نصُّ
كلامهِ:
»وجدتُ
الله عين
الأشياءِ كما
قال أرباب
التوحيد
الوجوديِّ من
متأخري
الصوفيّة. ثم
وجدتُ الله في
الأشياء من
غير حلول ولا
سريان. ثم ترقيت
في البقاءِ.
وهو ثاني قدم
في الولاية.
فوجدتُ الأشياءَ
ثانيًا.
فوجدتُ اللهَ
عينها، بل عين
نفسي. ثم
وجدتُهُ
تعالى في
الأشياءِ بل
في نفسي؛ ثم
مع الأشياءِ
بل مع نفسي.«[218]
كذلك
جاء من نحو
هذا في كتاب
خطير دوّنته
جماعة من
النفشبنديين
باللّغة التركيّة
تحت عنوان »تفسير روح
الفرقان«[219]
***
* وحدة
الوجودِ.
أمّا
فكرة »وحدة
الوجود«
فإنّها مذهبٌ
فلسفيٌّ قديم.
قالت بها
جماعة من
قدماء فلاسفة
اليونان. وهم؛
بارمينيديس،
وزنون،
وأفلطون،
وبلوتينوس،
وطائفة
الرواقيين. ثم
اغترّ بهذه
الفكرة واعتنقها
بعض المتصوّفة؛
كحسين بن
منصور الحلاّج،
ومحي الدين بن
عربي،
وسليمان بن
على بن عبد الله
التلمساني، وابن
الفارض، وفريد
الدين
العطار، وعبد
الكريم
الجيليّ، ويونس
أمراه
التركماني
ومَنْ على
شاكلتهم.
تتمثّل
فكرة وحدةُ
الوجودِ في
القولِ: بأنّ كلّ
شيء في الكون
ليس إلاّ
أجزاءً من
الله، وَأنّه
ليس ثمة فرق بين
ما هو خالق وما
هو مخلوق. يستدلّ
أصحاب هذه
العقيدة (وهم
جلّ
الصوفِيّةِ) بقوله
تعالى:
{فَأَيْنَمَا
تُوَلّوُا
فَثَمَّ
وَجْهُ
اللهِ.}[220] يعنون
بذلك أنّ كلّ
شيء في
السماوات
والأرض من
صغيرٍ
وكبيرٍ، وإنسيٍّ
وجنِّيٍّ
وملائكةٍ
ودوابٍّ
ونباتٍ وجمادٍ
ورطبٍ ويابسٍ
وطاهرٍ
ونجسٍ، إنّما
هي جميعاً
أجزاءٌ متفرِّقةٌ
من الذات الإلهيّة؛
وأنواعٌ
وألوانٌ
وعكوسٌ من
سحرهِ
وجلالهِ وجمالهِ؛
وهو عينها
وحقيقتها؛
وليس في الوجود
إلا الله.
بهذه العقيدة
يتناولون
قولَهُ تعالى{
هُوَ
الأَوّلُ
وَالآخِرُ
وَالظاهِرُ وَالْبَاطِنُ.}[221]
ويتأوَّلونها
ويقصدون بهذا
في
مُعْتَقَدِهِمْ
: أنّ الله هو
هذه الأشياء
والأعيان
والكائنات
بتمامِها،
وهيئاتِها
وأشكالِها
وأبعادِها وأجسامِها
وأحجامِها
وهي كثرةٌ في
وحدةٍ و وحدةٌ
في كثرةٍ. ومن
ذلك قول عمر
بن الفارض:
وجهٌ
تعدّد في
المرائي *
وبه تـحيّر كلّ
رائي
فالكــائنات
بأمره *
موج على
صفحات ماء
فالأمر
أمر واحـد *
فيه
التـقارب
والتـنائي.
ويقول
محي الدين بن
عربي » ألا ترى
الحقّ يظهر
بصفات
المحدثات،
وأخبر بذلك عن
نفسه، وبصفات
النقص وبصفات
الذمّ؛ ألا
ترى المخلوق
يظهر بصفات
الحق من
أوّلها إلى آخرها،
كلّها حقّ له
كما هي صفات
المحدثات حق للحق«.[222]
كانت
هذه خلاصةٌ
لما سبق. وقد
عُنِيَ
بالموضوع أهل
البحث
واختلفوا فيه
بين رادٍّ
ومدافع. ففي
مقدّمةِ مَنْ
ردّ عليهم،
العلاّمة علي
القاري. له
رسالة قيّمة
بعنوان »الردّ
علي القائلين
بوحدة الوجود«.[223] وممن
تناول هذا
الموضوعَ على
سبيل الدفاع
عنه، شخصٌ
اسمه عمر فريد
كام. له »رسالة
وحدة الوجود«
باللّغة التركيّة[224]. وقد
تطرّق إلى هذا
البحث أبو
الحسن
الندويّ في
المجلّد
الثاني من
كتابه
المعروف »رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام«[225]
أمّا
موقف
النقشبنديّين
من هذه
المسألة، فانّ
تعظيمَهم
وإجلالَهم
للوجوديين
والحلوليين
يدل على
استحسانهم
لفكرة وحدة
الوجود
والحلول
والإتحاد. إذ
لا يكاد أحد
منهم يرضى بما
ورد عن
العلماءِ من
الطعن في
الحلاّج،
وابن عربي
وغيرهما من
الوجوديين
والحلوليين.
بل يتعاطون
حديثَهم في
مجالسهم مع
الاحترام
والتوقير
لشأنهم،
ويطالعون
كتبَهم، ويعدّونهم
من أهل
الفيوضات
الربّانيّة
والكرامة
والبركة؛
ويقولون عن
الحلاّج إنّه
شهيد، ويصفون
ابن عربي بـ»الشيخ
الأكبر«.
والأغلب
أنّ ذلك ناشيء
عن جهلهم بما
تتضمّنه
عقيدةُ وحدة
الوجود من
زندقةٍ
وإلحاد في
صفات الحق سبحانه
بما يستحيل
عليه، إلى
سخافات
يتجافى لسان
المؤمن عن
النطق بها.
لأن شيوخ النقشبنديّة
- في حقيقة
الأمر- هم
أبعد الناس عن
ساحة العلم
والمعرفة،
وأكثرهم
خمولاً، وأشدهم
تعصُّبًا،
كما سنشرح
أحوالهم،
ونبيّن سلوكهم،
وننقل
معلوماتٍ
شافيةً عن
مستوياتهم وشخصيّاتهم
في الفصل
الرابع إنْ
شاء الله
تعالى.
هذا،
وإن لم يكن
للنقشبنديّين
إلمام كبير بعقيدة
وحدة الوجود
مباشرةً،
ولكنّهم
يدخلون في
عداد مَنْ
يُقِرُّ بهذه
العقيدة على
أقلّ تقدير؛
وذلك لأسباب
ثلاثة:
أوّلها:
أنّهم
يُوَقِّرون
مَنْ ذهب هذا
المذهب كما
سبق الحديث
عنه آنفا.
وثانيها:
أنّ كثيرًا من
عقائدهم
منبثقة من الديانة
البوذيّة
الّتي تعتمد
على عبادة
المخلوقات.
فالبوذيُّ
يعبد الشجر
والحجر
والقرد
والبقر. وكذلك
النقشبنديُّ
يؤلِّهُ
الشيخَ
ويقدّسه في
حياته وبعد
مماته إلى
درجة لا يراه
محتاجًا إلى
رحمة الله؛ بل
يراه
مستغنيًا عنها
ومُنَزَّهًا
من أن يدعو له
بالمغفرة،
بأن يقول »رحمه
الله« أو »رحمة
الله عليه«
إن كان قد مات.
ولكن يقول »قَدَّسَ
اللهُ سِرَّهُ«.
إذ يعدّه جزءً
من الله. يدلّ
على اعتقادهم
هذا، ما نقله
إبراهيم
الفصيح في
مستهلّ كتابه »تحفة
العشاق« إنّه
»قال
القاضي عياض
في الباب
الرابع من
القسم الثاني
في الشفاء
نقلاً عن أبي
بكر القشيريّ:
أنّ الصلاة من
الله لمن دون
النبيِّ
رحمةٌ؛ وقال
الشارح الشهاب:
أي طلب أن
يرحمه الله.
وأما النبيُّ
فمرحوم بأعلى
أنواع
الرحمة، فهو
غير محتاج لأن
يُدعى له بها.«
وقد
جاءت عباراتٌ
في موسوعةٍ
للنقشبنديّين
ضمن ترجمة طه
الهكّاريّ
تفيد أنّهم
يترحّمون على
من لا يزال في
قيود نفسه،
ويقدّسون مَنْ
كان قد حظي
بالنجاة من
قيودها على
حسب زعمهم. كذلك
كلّ شيء يتّصل
به فهو مقدّس
عندهم؛ حتّى
كلبه وقطّه،
بل وَحتّى
مخاطه وبوله
وفضلاته!
وكثيرًا مّا
يعبّر المريد
عن محبّته
وصداقته
وتفانيه
لشيخه بقوله »أنَا مِنْ كِلاَبِ
السَّادَاتِ« [226] هذا لفظ
خالد
البغداديّ
بالذات. فما
بالك بالمريد
البدوي البدائيّ!!
كذلك
يعتقد
النقشبنديّون
بالفناءِ
والانصهار في
الذات الإلهيّة.
ومعنى ذلك أنّ
المخلوق يحلّ
فيه، أو هو
يحلّ في
المخلوق. إذًا
يجوز عندهم أن
تكون الأشياء
أجزاءً منه؛
أو أن يكون هو
هذه الأجزاء
المتفرّقة في
الكون. تعالى
الله عن ذلك
علوًّا
كبيرًا.
وثالثها:
سببٌ
تاريخيٌّ
وعصبيٌّ. وهي
أنّ الحلاّج
كان فارسيَّ
الأصل يكره
العربَ، ويرى
أنَّ دولةَ
آبائِهِ
انقرضتْ على
أيديهم. فكان
شعوبيًّا
يتعصّب لقومه
المجوس، حتّى
دفعته أغراضُهُ
النفسيةُ
وحقدُهُ على
إشعال ثورةٍ على
الدولة
العبّاسية،
إستعدادًا
للإطاحةِ بها،
إلى أن
كُشِفَتْ
أسرارُهُ
ومؤامراتُهُ
التى كان
يحيكها
ويُخفيها من
وراء حياةٍ
صوفيةٍ
متصنَّعةٍ،
فقُتل.
كذلك
النقشبنديّون
(الأتراك على
وجه الخصوص) يكرهون
العربَ،
ويعتقدون أنّ
جميع العرب وهّابيُّون
وعصاةٌ
خارجون على الدولة
العثمانيّة »المقدّسة«
في اعتقادهم.
ذلك لتعصّبهم
القومي الّذي
أدّى إلى
نتائج خطيرة.
منها أن الأغلبيّة
من العنصر
التركيّ
اليوم قد
أصيبت بمركّب
النقص، لغلبة
اللّغة العربيّة
على لغتهم عبر
حُقبةٍ تقرب
من ألف سنة.
وهم يبحثون في
الآونة
الأخيرة عن
سبيل التخلّص
من هذا
التأثير. ويرى
الكثير من
المارقين من
أبناء هذا
الشعب »أنّ
الخروج من هذا
المأزق لا
يمكن إلاّ أن
يحلَّ
المجتمعُ
التركيّ ربقة
الإسلام من
عنقه تمامًا«.
وإذا كان
اليوم تتحدّى
جموع غفيرة من
ملاحدة
الأتراك بهذه
الفكرة
الخطيرة عن
جدٍّ، واستعدادٍ،
فان للتعصّب
القوميّ
الّذي أثاره
النقشبنديّون
تأثيرًا كبيرًا
في إبداءِ هذه
الجرأة
والغطرسة.
وهذا التعصّب
هو القاسم
المشترك
بينهم وبين
الحلاّج. وفي
هذا دلائل
كثيرة. فقد
أفتى شيخ لهم
أخيرًا »بأنّ
الصلاة
باطلةٌ عند
الإقتداءِ
بإمام وهّابيّ،
ولا يجوز
الإقتداء
بأئمة الحرمين؛
لأنّهم وهّابيُّون!«
فزجر مريديه
عن ذلك
وألزمهم
بإعادة
الصلاة إذا
اضطرّ أحدهم
أن يقتدي
بإمامٍ
عربيٍّ في ديار
الحجاز.
وقد
أثّر موقفهم
السلبيُّ هذا
على معظم الشعب
التركيّ،
بحيث لا يكاد
أحد منهم يشعر
في نفسه بمحبّة
العرب إلاّ
قلّة، ولا
يدور حديث
العرب في مجلس
من مجالس النقشبنديّة
الأتراك إلاّ
وضربوا
مثالاً من
قذارتهم وخيانتهم
للدولة العثمانيّة.
لأنهم
يقدّسونها
ويعدّونها
صانعة
أمجادهم على
أنهم
وَرَثَتُهَا
دون بقيّة
العناصر من
المسلمين.
ولهذا
يحمّلون
قسطًا كبيرًا
من مسؤولية
سقوطها على
العرب الّذين
عملوا على
استقلالهم
وانفصلوا عن
الدولة العثمانيّة
بعد الحرب
العالميّة
الأولى؛ كما
يقدّسون
أضرحة
سلاطينها،
ويعدّون
زيارة قبورهم
من
القُرُبَات.
إذ يعتبرونهم
جميعًا من
أولياء الله
الصالحين. (أى
من أولئك
الأولياء
الموصوفين في
عقيدتهم
الخاصّة.)
كذلك
يوقّرون ابن
عربي بسبب
المصاهرة.
لأنّه أقام في
مدينة قونية.
وهي من كبريات
مدن تركيا منذ
القديم.
وتزوّج من والدة
صدر الدين
القُنَوِي
الّتي كانت
أرملة. والصدر
القُنَوِيُّ،
من مشاهير
متصوّفة الأتراك،
الّذين تفخر
بهم النقشبنديّة.
وهو ممن شرح
فصوص الحكم،
ونحى منحى
مؤلّفه.
تتاكّد
الإشارة هنا
إلى أنّ
الّذين
يتعصّبون
للحلاّج وابن
عربي وابن
عطاء الله
الإسكندريّ
وأمثالهم،
إنما يدافعون
عنهم وعن
أفكارهم لسببين
رئيسيّين.
أوّلهما:
أن فريقًا من العربِ
المتبحّرين
في اللّغة العربيّة
وآدابها
الّذين
أصبحوا من
فحولها، قد
غبطوا طائفةً
من أُدباء
الصوفيّة
وشعرائَهم،
وافتتنوا
بسحر ما نسجته
أقلامهم،
وأحسّوا
بتأثير بالغ
في نفوسهم،
فانهمكوا في
مطالعة
تصانيف هؤلاءِ
الصوفيّة
حتّى خطفت
أبصارَهم
لمعةُ جمالها
الأدبيّ
البارع،
وحارت عقولهم
في عمق معانيها
النابعة من
حكمة فلاسفة
الأغريق، فاهتزّت
نفوسهم
لهديرها
ونبراتها،
وحنَّتْ
عواطفهم
وفارت لاطّراد
أبوابها وحسن
تراكيبها
الموزونة
المرصوفة في
بناءِ
عباراتها وهم
قلّة. كجلال
الدين عبد
الرحمن
السيوطيّ،
وعبد الوهّاب
الشعراني،
وعبد الغني
النابلسيّ.[227]
ذلك
أن مشاهيرَ
صوفيّةِ
العرب، وعلى
رأسهم ابن
عربي، قد انتقوا
ألفاظًا من
قاموس هذه
اللّغة
كأنّهم استخرجوا
الجواهر من
بحورها.
فكتبوا
ببيانٍ زاخرٍ،
وأسلوبٍ
خلاّب فاخرٍ،
نظموا يواقيت الكلام
في جيد
السطور،
ونثروا من درر
الكلمات على
الصفحات؛
فجاء تعبيرهم
ناطقًا عن
أروع تصوّرات
النفس
البشريِّةِ
وخيالاتها.
فاستطاعوا بذلك
أن يدسّوا
السمَ في
العسلِ، كما
سوّلت لهم
أنفسهم؛
فنفذوا إلى
أعماق قلوبٍ
مريضةٍ، وتسرّبوا
إلى قرارة
نفوسٍ ضعيفةٍ
حتّى شاعَ
صيتُهم،
وبلغتْ
شهرتُهم
الآفاقَ،
فظنّ جمهورٌ
من الناس أنّ
هؤلاء
الصوفيّة هم
أحبّاء الله
وخاصّته،
آتاهم الله
الحكمة بهذه
البلاغة الّتي
تبهر العقول.
فلم يكد أحدٌ
قادرًا بعد
ذلك على إحباط
ما أذاعوا من
الباطل
المنوَّه في
صورة الحقّ
المشوَّه،
فغدا هذا
الإعجاب
والاعتقاد بهم
أمرًا
متصلّبًا في
ضمير معشرٍ من
أُناسٍ عاطفيّين
في كلّ عصرٍ
تسلسل عَبْرَ
الأجيال حتّى
اليوم.
وثاني
هذين السببين:
أنّ فريقًا
آخر من
بُسَطَاءِ
المتعلّمين
المتطبّعين
بالتقليد
المحض
والمحرومين
من الذوق
والنظر
والاعتبار،
انخدعوا بما حاكتْ
أقلامُ
الفريق
الأوّل من
عبارات الدفاع
عن الزنادقة،
وما تفوّهوا
به من مدائحَ
لهم، وما
أطنبوا في
مناقبهم
ومآثرهم
المختَلَقَةِ،
وما بالغوا في
الثناءِ
عليهم
والإعجاب بهم.
فاستيقنتْ
أنفسُهم
وصاروا لهم من
التابعين.
وغالب هؤلاء
المقلّدين هم
الشيوخ
الجهلة
للطائفة النقشبنديّة.
بالإضافة
إلى هذا، فانّ
فكرة »وحدة
الوجود«
لها جاذبيّة
شديدة في سحر
العقول
وتشويش
العواطف وتخدير
الأدمغة،
فينساق من
وراء أحلامها
التائهون في
دياجي
الشبهات،
ويلهث المتحيّرون
نحو سرابها
فيحسبون أنّ
هذه الفكرة حكمة
منبثقة من
الوحي
الإلهيِّ
انصبّت على قلوب
هؤلاء
الصوفيّة من
ملكوت الله.
فلا يتوقَّعون
منهم أنْ
كانوا قد
نطقوا بشيءٍ
فيه معصية اللهِ،
لما في قلوبهم
من عظمة أولئك
الزنادقة،
حتّى لو وجدوا
في عباراتهم
من ألفاظ
الكفر والإلحاد،
ترى
المنبهرين
بهم من
النقشبنديّين
يدافعون عنهم:
أنّ هذه
الألفاظ فيها
حِكَمٌ
ومعانٍ لا
يدركها إلاّ
أهلُهُ، أو
صدرتْ منهم في
حالةٍ من السكر
لا يفهمها ولا
يقدّرُها
غيرهم!
ولكن
بالرغم من هذا
الدفاع
الواله،
فانَّ
ألفاظَهم
مفهومةٌ
ومقاصدَهم
واضحةٌ كلّ
الوضوح كقول
الحلاّج:
أنا
مَنْ أهوى ومَنْ
أهوى أنا *
نحن روحـان
حللـنا بدنا.
فإذا
أبصرتَني
أبصـرتـَهُ *
وإذا
أبصـرتَـهُ
أبصـرتَنا.[228]
ومنها
ما قال ابن
عربي؛ »فانّ
العارف من يرى
الحقّ في كلّ
شيء؛ بل يراه
عينَ كلّ شيء.«[229] وقد
فرّط في جنب
الله بكلام
صريح لا مجال
للتأويل فيه.
فقال »فهو
الأوّل
والآخر
والظاهر
والباطن، فهو
عينُ مَا ظَهَرَ،
وعينُ مَا بَطَنَ
في حال ظهوره،
وما ثمّ من
يراه غيره،
وما ثم من
يبطن عنه؛ فهو
ظاهر لنفسه،
باطن عنه. وهو
المسمّى أبا
سعيد الخراز
وغير ذلك من
أسماءِ
المحدثات.«[230]
ولما
عرض كتاب »فصوص
الحكم«
على سليمان بن
علي بن عبد
الله
التلمساني
الصوفيّ وقيل
له: »- كلّ
ما في هذا
الكتاب يخالف
القرآن!«
أجاب
بقوله: »- القرآن
كلّه شرك،
وإنما
التوحيد في
قولنا«.
هكذا
دافع
التلمسانيّ
عن ابن عربى
وعن فكرة وحدة
الوجود في
الوقت ذاته.
ولمّا قيل له: »- فما
الفرق بين
أختي وزوجتي؟«.
قال: »- لا
فرق عندنا،
ولكن هؤلاء
المحجوبون
قالوا حرام،
قلنا حرام
عليكم.«[231]
كانت
هذه عدد من
الدلائل
الواضحات على
عقيدة وحدة
الوجود. وهي
قطرة من بحر.
وما من شخصٍ
رزقه الله
العقل
والبصيرة والمعرفة
باللّغة العربيّة
إذ يطّلع على
هذه
العبارات،
فلا يشكّ في
أنّ عقيدة
وحدة الوجود
ليست إلاّ كما
قال بعضهم:
»وما
الكلب
والخنزير
إلاّ إلهنا *
وما الله إلاّ
راهب في كنيسة«[232]
لذا
من زعم أنّ ما
جاء في كتب
الصوفيّة من
أمثال هذه
العبارات،
إنّما هي
كلمات صدرت
منهم في حالة
سكرٍ وغلبةٍ
من العشقِ
الإلهيِّ، لا
يقف على
حقيقتها إلاّ
أهلها؛ فقد
شهد على نفسه أنّه
كاتم لما
يُضْمِرُهُ
من الحرب على
الله كما يفعله
قدماء
الروحانيّين
من النقشبنديّة
عن قصدٍ،
فيتبعهم بقيّة
الشيوخ وآلاف
من المريدين
الجهلة
تقليدًا بهم
في هذا الاعتذار.
لهذا،
فانّ
النقشبنديّين
أيضًا يدخلون
في عداد
الوجوديّين
بالتأكيد؛
لحسن ظنّهم
بابن عربي
وأمثاله. يدلّ
على ذلك
تعظيمهم لهذه
الطائفة
وثناؤهم
عليها في
مواطن كثيرة
من حديثهم،
خاصّة مَنْ
اشتهر منهم بالعلم
والثقافة. وقليلٌ
مّاهم!
لم
ينج أحد منهم
من هذا
التأثير،
لرسوخ نزعة
التقليد الأعمى
فيهم، فلم تكن
محبّتهم أو
كراهيتهم
لشيءٍ إلاّ
تقليدًا بمن
اعتقدوا فيه.
لذلك تجدهم
دائمًا يبالغون
في إظهار
أحاسيسهم
سواء في
محبّتهم أو في
بغضهم
وكراهيّتهم. كزاهد
الكوثريّ. وهو
من متعصّبي
هذه النحلة كما
يبدو ذلك
واضحًا من
عباراته في كلّ
ما قد دوّنه
وصنّفه. فقد
انعكس إعجابُهُ
بنفسه واغترارُهُ
بعلمهِ في
مواطن كثيرة
من كلماتِهِ
اللاّذعةِ
ولهجته
القاسيةِ
وتحدّياتهِ
وهجماتهِ على
أهل العلم
واحتقاره لهم.
لا يخلو كتاب
من كتبه إلاّ
وفيه
استخفافٌ بعالمٍ،
أو طعن في
رجلٍ من أهل
المعرفة
والاجتهادِ. وربما
كان اتّخاذه
الموقفَ المتنافرَ
من أهل
التوحيد في كلّ
مناسبةٍ،انتقاماً
منهم، ليشفي
بذلك غليله
وليستريح من
كبته بسبب
كتمانه لما
كان يعتقده من
فكرة وحدة
الوجود. يبرهن
على هذه
الحقيقة ما قد
سجّله أبو
الفضل بن عبد
الله
القُنويُّ في
مقدّمته لكتاب
»الردّ
على القائلين
بوحدة الوجود«
تأليف علي بن
سلطان القاري.
فقال:
»ويحسن
بي قبل أن
أُنْهِيَ هذا
التقديمَ أن
أُشِيرَ إلى
شيءٍ يهمّ
الباحث في
ترجمةِ جهميِّ
عصرِهِ وسوءِ
علماءِ
بلدِهِ
الكوثريّ وقصّته
مع مصطفى
صبري، وذلك أنّه
جرت بينهما من
الخصومة العلميّة
ما يجدر أن
يُكتَب في
كتاب مستقلّ،
ولكنّي سأذكر
من ذلك نبذًا لعلّه
لم يشر إليها
كاتب قبلي ما
علمت:«
»فقد
أخبرني
الأستاذ أمين
القدسيّ، وهو
كاتب وباحث
قونويّ يتقن العربيّة
أنّ الكوثريّ
يُبطن
اعتقادَ مذهب
أهل وحدة الوجود،
وبخاصّةٍ يوم
هاجر إلى مصر،
فبلغ بي العجب
يومئذ غايته؛
إذ المعروف عن
الكوثريّ أنّه
حامل لواء
التنـزيه
بزعمه، فكيف
يقول بمذهب
الوحدة وهو
أشنع التجسيم،
وأخبث
التمثيل؟!
وقال لي: إنّه
سمع ذلك من
خاله علي
القدسيّ، وهو
من علماء التُّرْكِ
الّذين
هاجروا إلى
دمشق، وإنه
جرت مناظرة بين
الكوثريّ
وعليّ القدسيّ
في وحدة
الوجود،
الكوثريّ
يؤيّدها
والقدسيّ
ينكرها، حتّى
كان من آخر ما
قاله القدسيّ
للكوثريّ في
المجلس: أنت
تقول بقول أهل
الوحدة، فأنا
أستأذنك
لأذهب إلى بيت
الخلاء لأقضي
حاجتي، فغضب
الكوثريّ
وعرف مقصده،
وقال أمين: إن
من أدلة
اعتناقه هذا
المذهب كتابه (إرغام
المريد) في
التصوف،
فطلبت الكتاب
وقرأته،
فرأيت من
الطامة ما
ينضم إلى سجله
المحترق
تجهمًا فيه من
تصديق بدع المتصوّفة
وخرافاتهم
وتقديس
مشائخهم ما شئت.«
***
*
وحدة الشهودِ
وأمّا
فكرة »وحدة
الشهود«،
فهي أيضًا
بدعة فلسفيّة
مماثلة
لهرطقة »وحدة
الوجود«.
أوّل مَنْ قال
بها مِنْ
قدماء النقشبنديّة،
هو أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ
المعروف بين أتباعه
بـ »الإمام
الربّانيّ«. أثار
هذه الفكرة
فتذرّع بها
للرّدِّ على
عقيدة »وحدة
الوجود«
على حسب ما
ادّعى
المفتتنون به.
يبدو أنّهم قد
حاولوا بذلك
أن يُبْرِؤُا
سَاحَتَهُ ممّا
أصاب ابنَ
عربي
وأمثَالَهُ
من
الوجوديّين من
الطعن
بالتكفير
والإلحاد،
حتّى لا يتعرّض
هو الآخر
لتشنيغ أهل
التوحيد.
بينما الفاروقيّ
أيضًا تخبّط
في متاهاتٍ
أخرى لا تقلّ
خطراً عما وقع
فيه
الوجوديّون
قبله. إذ أنّ رسائلَهُ
الشهيرةَ
المتداولةَ
بين المغترّين
به، والمعروفةَ
بعنوان »المكتوبات«
شاهدةٌ على ما
قد بثّ ودسّ
من أنواع
البدع في عقائد
المسلمين
بهذه
الرسائل، وهي
أصلاً مستوحاة
من ديانات
مجوس الهند،
كما سنشرحها
في ترجمته إنْ
شاء الله
تعالى.
والغريب،
أنّ بعض
المغفّلين قد
انخدعوا بِدِعَايَةِ:
أنّ »وحدة
الشهود«
صيغةٌ
دفاعيةٌ عن
العقيدة
الحنيفة ضدّ
هرطقة »وحدة
الوجود«.
بينما هي
نفسها هرطقة
أخرى وبدعة
غالية ليست من
الإسلام في
شيء. إذ أنّ
كلمة »وحدة
الشهود«
تعبيٌر
غامضٌ، حتّى
لو كان المراد
به »وحدةَ
المشهود«؛
ولكن بأيّ
صفة؟ فانّ
النقشبنديّين
لم يذكروا
شيئًا بوضوح
يُبيّن لنا
أنّ وحدة
الشهود يعني:
وحدة جميع
الأشياءِ
المشهودةِ
على صفة
المخلوقية
لله الخالق
الواحد المنـزّه
عن المشابهة
بالمشهود.
فقد
قال رجل من
كبرائهم في
صدد هذه
العقيدة »أنّ
الممكن في
التوحيد
الشهوديِّ،
مرآةٌ لشهود
ذات الحقّ
سبحانه«.[233] ولكن
إذا كان مراده
من هذه
الصيغة: أنّ
وجود المخلوق
يدلّ على وجود
الخالق،
فلماذا لم
يعبّر عن
مقصوده هكذا
بوضوح على
طريقة علماء
الإسلام، ولم
يقتبس آية مناسبة
للموضوع،
مثلا كقوله
تعالى:
{أَفَلاَ يَنْظُرُونَ
إِلىَ
الإِبْلِ
كَيْفَ
خُلِقَتْ...إلخ.}؛
ولكن صاغ
عبارتَهُ
بذلك الأسلوب
الدسّاس
الغامض على
طريقة
الروحانيّين؟!!!
لأنّ
عقيدة »وحدة
الشهود«
في حقيقة
الأمر ليستْ
إلاّ نسخة
أخرى من عقيدة
»وحدة
الوجود«.
ولكنهم جاؤا
بها في لباسٍ
جديدٍ،
وتكلّفوا
أخيرًا هذه
الصيغة
الماكرة في الدعاية
لها بعد أن
فشلوا في
محاولة
دعوتهم لعقيدة
»وحدة
الوجود«. وذلك
ليُلبِسوا
الحقَّ
بالباطل على
البُسَطَاءِ
بحيلةٍ أخري
في بداية
الأمر، إلى
حينٍ تتحقّق
لهم الهيمنة
على دماغ من
ينخرط في
سلكهم ويعتنق
عقيدتهم بعد
مرحلة من
الرياضة. وهذا
دأبهم في الاصطياد
الباطني
يشرح
السرهنديّ
هذه العقيدة
الّتي
ابتدعها بقوله:
»إنّما
يتحقّق
التوحيد
الشهوديُّ
بالفناءِ وبنسيان
ما سوى الله،
فيستطيع
السالك أن
يتقدّم من
البداية إلى
النهاية دون
أن يظهر له
شيء من العلوم
والمعارف
المتعلّقة
بالتوحيد الوجودِيِّ؛
بل يحتمل أن
يُنكر هذه
العلوم«.[234]
إنّ
هذه العبارة
المنقولة من
إحدى رسائل
الفاروقيّ
الّتي يَرُدُّ
بها على عقيدة
»وحدة
الوجود«،
فيها كفاية عن
حقيقة وحدة
الشهود في
الوقت ذاته،
وكذلك عن
معتقدات
الفاروقيّ
جملةً وتفصيلاً،
وهو من أكابر
النَّقْشَبَنْدِيِّينَ.
إذ يبدو فيها
واضحًا أنّه مُقِرٌّ
بعقيدة
الفناءِ في
الله، ثمّ
بالسلوك. وهو
فنٌّ ماكر وأسلوب
خطير من
أساليب المتصوّفة
عامّة
والنَّقْشَبَنْدِيّينَ
خاصّة لترويض
المبتدئِ على
أفكارهم
واتجاهاتهم..
إنّ
مقولة »وحدة
الشهود«،
في الحقيقة
تعبير دخيل
مثل كلمة »وحدة
الوجود«.
لا صلة لها
بمفهوم الإسلام.
إذ لم يرد عن
رسول الله r،
ولا عن
الصحابة، ولا
عن التابعين
لهم بإحسان؛
أنّهم نطقوا
بمثل هذا التعبير.
ثم إنّ الغرض
الحقيقيَّ من
هذا التعبير
لا يبدو
بسهولة. وهو
كلام غامض.
يتشوّش فيه المتأمل.
بينما
الإسلام
ومفاهيمه
واضحة جليّة،
تتبدّى حتّى
للأميِّ
فضلاً عن
العالم؛ كما
قال تعالى:
{قَدْ
بَيَّنَّا
لَكُمُ
اْلآيَاتِ
إنْ كُنْتُمْ
تَعْقِلوُنَ.}؛[235] وقال
تعالى، {قَدْ
بَيَّنَّا
لَكُمُ
اْلآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلوُن.َ}؛[236] وقال
تعالى،
{كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ
تَعْقِلوُن.}؛[237]
وقال تعالى،
{كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمُ
اْلآيَاتِ
لَعَلَّكُمْ
تَتَفَكَّروُن.َ}؛[238]
وقال تعالى،
{كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللهُ
لَكُمْ
آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ
تهْتَدوُنَ.}؛[239]
وقال تعالى،
{هذا بيانٌ
للناس وهدىً وموعظةٌ
للمتّقين.}؛[240]
وقال تعالى،
{ونَزَّلْنَا
عَلَيْكَ الْكِتَابَ
تِبْيَانًا
لِكُلِّ شيء
وَهُدىً
وَرَحْمَةً
وَبُشْرىَ لِلْمُسْلِميِنَ.}؛[241]
وقال تعالى،
{كَذَلِكَ
نُفَصِّل اْلآيَاتِ
لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّروُن.َ}؛[242]
وقال تعالى،
{وَلَقَدْ
يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ
فَهَلْ مِنْ
مُدَّكِرٍ.}[243]
أمّا
بُسَطَاءُ النقشبنديّة
فانهم على
نقيضٍ من هذه
الصراحة
اللاّئحة في كلّ
آيةٍ من
القرآن
الكريم. يأتون
بكلام غامض
ربما لا
يفهمونه
بالذات. لأنّهم
لا يدرون ماذا
يقصدون به؛
ولأنّهم كثيرًا
ما يُطْلِقُونَ
الكلمةَ من
غير تعقّل،
إمّا لجهلٍ
مزدوج: وهو
الجهل المركب
الّذي لا علمَ
لصاحبه بجهل
نفسه، أو إمّا
بسبب التقليد
الأعمى الّذي
قد يتعرّض له
حتّى الرجل
العالم لثقته
الشديدة بمن
يقلّده
كموقفهم من
الوجوديين.
نراهم
يبتدعون فكرة »وحدة
الشهود«
لكي لا
يتورّطوا
فيما وقع فيه
ابن عربي
وأمثالُهُ من
الوجوديّين؛
ثم نراهم على
أشدّ هيئةٍ من
الإجلال
والتعظيم لهم.
في
الحقيقة، إنّ
جميع
النقشبنديّين
هم بُسَطَاءُ
الصوفيّة وحثالتهم.
لذا، هم أقلّ
الفرق
الباطنية
مرونةً، وأشدّهم
تقليدًا
وتعصّبًا.
يبهرون بأخسّ
كلمة ينطق بها
متحزلقٌ من
صناديدهم.
فيتأوّلونها،
ويشرحونها،
ويحشدون في
بطنها
تفسيرات غريبة
يتعجّب
الإنسان من
محاولتهم.
هذه
التبعيّة هي
الّتي دفعتهم
من وراءِ كاهنٍ
هنديّ، فظنّوا
أنّ بدعته
الّتي زيّنها
لهم باسم »وحدة
الشهود«
تعني تنـزيهَ
الخالق عن
صفات المخلوق.
بينما هذه
التبعية
تتجاوز حدودَ
حسنِ الظنّ
إلى تقليدٍ لا
مبرِّرَ له.
إذ أنّ
الوجوديين
والشهوديين
لو أخلصوا لله
في تنـزيهه
سبحانه عما
يصفون،
لتقيّدوا
بحدودِ ما قال
تعالى عن
نفسه، وما ذكر
من صفاته؛
كقوله جلّت
عظمتُهُ
{اللهُ لاَ
إلَهَ إلاَّ
هُوَ
الْحَيُّ
الْقَيّوُمُ
لاَ
تَأْخُذُهُ
سِنَةٌ وَلاَ
نَوْمٌ...}.[244] وقوله
تعالى {وَهَوَ
الّذي خَلَقَ
السمَاوَاتِ
وَاْلأَرْضَ
بِالْحَقِّ،
وَيَوْمَ
يَقُولُ كُنْ
فَيَكوُنُ.
قَوْلُهُ
الْحَقُّ وَلَهُ
الْمُلْكُ
يَوْمَ
يُنْفَخُ فيِ
الصورِ
عاَلِمُ
الْغَيْبِ
وَالشهَادَةِ
وَهُوَ
الْحَكيِمُ
الْخَبيِرُ.}.[245] وقوله
تعالى
{أَفَمَنْ
يَخْلُقُ
كَمَنْ لاَ يَخْلُقْ
أَفَلاَ
تَذَكَّرَونَ.}.[246] وقوله
تعالى
{فَاطِرُ
السمَاوَاتِ
وَالأَرْضِ
جَعَلَ
لَكُمْ مِنْ
أَنْفُسِكُمْ
أَزْوَاجًا
يَذْرَؤُكُمْ
فِيهِ،
لَيْسَ
كَمِثْلِهِ
شيء، وَهُوَ
السميِعُ
الْبَصيِرُ*
له مَقَاليِدُ
السمَاوَاتِ
وَالأَرْضِ
يَبْسُطُ
الرزْقَ
لِمَنْ
يَشَاءُ
وَيَقْدِرُ، إنّه
بكلّ شيء
عَليِمٌ.}.[247]
نعم
لو أنّ
النقشبنديّين
اقتنعوا بهذه
الآيات
البيّنات -
وما أكثرها في
كتاب الله -
لكفتهم مؤنة
القول بـ »وحدة
الشهود«
في محاولاتهم
لتنـزيه
الخالق عن
صفات المخلوق.
ولكن غرضهم في
حقيقة الأمر
ليس تنـزيه
الله سبحانه
عما لا يليق
بشأنه تعالى.
ولأنّهم لو
كانوا صادقين
في ادّعائهم:
أنّ أحمد الفاروقيّ
إنما تصدّى
بهذه
المقولة، ليردّ
على ابن عربي؛
لما ثبتوا على
تعظيمهم للوجوديين
بعد ذلك ومنهم
ابن عربي،
ولنبذوا ما أضلّهم
به سادتهم
وكبراؤهم من
عقائد
البراهمة وتقاليد
اليوغيّين؛
ولدخلوا صفوف
أهل التوحيد
وأخلصوا لهم، وساندوهم
في جهادهم ضدّ
الفرق الضالّة
والمتطرّفين
والزنادقة
والمشركين.
***
* الولايةُ
والوليُّ في
معتقد
النقشبنديّين.
إنّ
مفهومَ
الولايةِ وَالْوَلِيِّ
- بالوصف
الصوفيّ -
مسألةٌ خطيرةٌ
جدًّا؛
أثارها
الروحانيّون
منذ عصور. وقد
نسجوا حولها
ما نسجوا من
أنواع
الأساطير في
بطون الكتب
مالا يتمكّن
الإنسان من
إحصائها.
فقد
تشبّثوا بآيةٍ
من كتاب الله
العزيز
بالتحديد،
فتناولوها
بالتأويل على
سبيل الإثبات
لِمَا أرادوا
من وراء هذا
المفهوم. وهي
قوله تعالى:
{أَلاَ إِنَّ
أَوْلِيَاءَ
اللهِ لاَ
خَوَفٌ عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ
يَحْزَنوُنَ.}.[248] إنّ
معنى هذه
الآية
الكريمة
واضحةٌ جليةٌ
في الحقيقة؛
لا يحتاج إلى
أيِّ شرحٍ أو
تفسير. فقد
بيّن الله
سبحانه صفاتِ
الْوَلِيِّ
في آيتين
بعدها. قال
تعالى
{الّذينَ
آمَنوُا وَكَانوُا
يَتَّقوُنَ*
لَهُمُ
الْبُشْرىَ فيِ
الْحَيَاةِ
الدنْيَا
وَفيِ
الآخِرَةِ لاَ
تَبْديِلَ
لِكَلِمَاتِ
اللهِ،
ذَلِكَ هَوَ
الْفَوْزُ
الْعَظيِمُ.}.[249]
لذا
لم يجد علماءُ
الإسلامِ
ضرورةَ أيّ
تفسيرٍ آخرَ
بعد هاتين
الآيتين
غالبًا، لكمال
وضوحها
وتبادرها إلى
الذِّهْنِ
بسهولةٍ. أمّا
من أبى منهم
إلاّ ليقول
شيئًا، فقد
اضطر أنْ يُعيدَ
الآيةَ
نفسها، أو
جزءًا منها؛ -
كما فعل ابن
كثير رحمه
الله - ولكن
ليس ذلك مساعدةً
منه للقارئِ
على فهم معنى
الآيةِ؛ بل
تأكيدًا لشأنها،
وَرَدْعًا
لمن قد يهمس
إليه الشيطان
ليوقعه في
العبث بها
وتأويلها بما
لا تتحمّل.
{فَأَمَّا
الّذينَ فيِ
قُلُوِبِهِمْ
زَيْغٌ
فَيَتَّبِعوُنَ
مَا
تَشَابَهَ
مِنْهُ
ابْتِغَاءَ
الْفِتْنَةِ
وَابْتِغَاءَ
تَأْوِيِلِهِ.}.[250]
لذا
قال ابن كثير -
رحمه الله -
وربما ليس
بقصد التفسير،
بل تفادياً
لأيِّ لَبْسٍ
قد يتورّط فيه
قاصر الفهم،
وتنبيهًا على
تأويلات
المشعوذين من
الصوفيّة قال:
»يخبر
تعالى أولياءَهُ
- وهم الّذين
آمنوا وكانوا
يتّقون - كما
فسّر ربُّهم؛
فكُلُّ مَنْ
كان تقيًّا،
كان وليًّا؛
وأنّه لا خوفٌ
عليهم فيما
يستقبلون من
أهوال
القيامة، ولا
هم يحزنون على
ما وَرَائَهُمْ
في الدنيا.«[251]
نعم
كان هذا معنى
الآية في
حقيقة الأمر.
غير أنّ عامّة
الصوفيّة
وخاصّةً
النقشبنديّين
لم يتورّعوا عن
تحريف معنى
هذه الآية
الجليلة على الرغم
من وضوحها. بل تصوّروا
لِلْوَلِيِّ
شخصيةً
أسطوريةً كما
سنشرحها في
باب الكرامة
عندهم.
إنّ
الأولياء في
اعتقاد
النقشبنديّين
ليسوا هم
الّذين وصفهم
الله بأربعة
نعوت فحسب، في
تلك الآيات
الآنفة الذكر.
بل هم رجالٌ
عمالقةٌ لا
تُدرِكُ عُقُولُ
الْبَشَرِ أسْرَارَهُمْ
وَجَلاَلةَ شَأْنِهِمْ.
الكائناتُ
بأسرها مُسَخَّرَةٌ
لِمَشِيئَتِهِمْ.
»فالملائكة
تهبط إليهم
بالطعام
والشراب؛ والوحوشُ
والكواسرُ
تخافهم وتُطَأْطِيءُ
رؤوسها لهم،
والأرضُ
تُطْوىَ لهم،
فيطوفون في
أرجائها بمثل
لمح البصر.«[252]
هكذا،
فإنّ
التَّصَوُّرَ
الصُّوفِيَّ
لِلْوَلِيِّ
أقرب إلى
الخيال
المحلّق، بل
قد يتجاوزه. فلا
حقيقة لهذا
التصور طبعًا.
لأن الخيالَ
لا حدودَ له.
يسرح
الإنسانُ فيه
ويحلمُ ما
يحلوُ له، وقد
يعتادُ على
ذلك، وعندها
يغدو رَهِين
مَرَضٍ
نَفْسِيٍّ، فيصدّق
كلّ ما يجول
في خاطره من
وساوس النفس
ووحي الشياطين.
ومتى بلغ هذا
المرضُ فيه
مبلغَهُ، صار
لايَشُكُّ في
صحة شيء من
تلك الأساطير
الّتي نسجتها
الصوفيّة؛
بطلت عندئذ
سنّةُ الله في
نظره. فانه في
هذه الحالة
سواء زعم أنّه
مؤمن بالله أو
كافر أو مشرك،
يعاني
ازدواجيةً
غريبةً في
عقيدته
وسلوكه
وآرائه
وأعماله. وبالتالي
لا يكاد يعبأ
بالإنسان
المتّصف
بالإيمان
والتقوى. (وهما
من صفات
أولياء الله).
لأنّ الإيمان
والتقوى -
بالمنظور
القرآنيِّ -
لا يكاد يمثّل
شيئًا في
اعتباره.
خاصّة فانّ الإيمان
بالله يستوجب
القيام بأمور
ينافي إيمان
الصوفيّ
كالأمر
بالمعروف،
والنهي عن المنكر،
وإقامة حدود
الله على
أرضه،
والجهاد في
سبيله... أمّا
الصوفيّ،
فانّ إيمانه
يأمره بِالسَّيْرِ
وَالسُّلُوكِ
الْيُوغِيِّ-البرهميِّ،
وَالْعُزْلَةِ
وَالتَّقَشُّفِ،
وَالْغِيَابِ
وَالتَّعْطِيلِ
الّذي يسمونه
الفناءَ
والبقاءَ إلى
غير ذلك مما
لا مساس له
بالإسلام.
لهذا،
فانّ شخصيّة
الْوَلِيِّ الّذي
وصفه الله
بالإيمان
والتقوى،
وأنه لا يخاف
ولا يحزن؛
تختلف
اختلافًا
كبيرًا عن تلك
الشخصيّة
الّتي تتّصف
بالولاية في
عقيدة
الصوفيّةِ
عامةً والنقشبنديّة
خاصّة. لأنه
يستحيل في
عقيدتهم
المزدوجةِ أن يكونَ
اللهُ هو
المُسَيِّرَ
الوحيدَ
للكائنات
بأجمعها؛
وإنْ هم
ينطقون بكلمة
التوحيد.
فانَّ هذا
النطق عادةٌ
تقليديّةٌ في
خاصّتهم وَكُبَرَائِهِمْ.
وربما هي
وسيلة لِلتَّقِيَّةِ.
والبرهانُ
قَائِمٌ على
ازدواجية
العقيدة عند
النقشبنديّين:
»بِأنهم
لا يَشُكُّونَ
قيد نملةٍ فِي
استقلال
أوليائهم عن الله،
ولا في استغنائهم
عنه
بتصرّفاتهم
في الْكَوْنِ،
وَهُمْ
أَجْزَاءٌ
مِنْهُ«. وَيعتقدون
»أنَّ كُلاًّ
مِنْهُمْ يُحْيِي
وَيُمِيتُ وَيَرْزُقُ
وُيُحَرِّمُ
وَيَغْفِرُ وُيُعَذِّبُ
وَهُوَ عَلَى كلّ
شَيْءٍ قَدِيرٌ!«. لذا
لم ترضَ نفُوسُهُمْ
بأن تقتصرَ
صفاتُ
الْوَلِيِّ على
عدم الخوف
والحزن وعلى
كونه مؤمنًا
تقيّا فحسب،
بل تَعَدَّوْها
بخلع صفاتٍ
ذاتيّةٍ إلهيّةٍ
على
أوليائهم، ونسبة
القدرة
الخارقة
إليهم. ومعنى
ذلك أنّ
الْوَلِيَّ عند
النقشبنديّة »هو وكيلُ
الله في أرضه،
وخليفتُهُ
القائمُ بالتصرّف
عنه.«[253] كما جاء
في تفسيرٍ لجماعةٍ
منهم في
إسطنبول.
وإنما أرادوا
بهذه المقولة:
أنّ الْوَلِيَّ
يتصرّفُ في مُلْكِ
الله كما
يشاء. وقد
أنشد بعضهم
باللّغة التركيّة
أبياتًا لا
تترك مجالاً
للشّكِّ فيما
يقصدونه من
وراءِ مفهوم الْوَلِيِّ.
وإليك ما
تيسّر لنا
تعريبُهُ من
كلمات هذا
الشاعر
الصوفيّ
نظْمًا:
إنّ الْوَلِيَّ
له التـصرُّفُ
في الحياةِ
وبعدها؛
إيّاك
قولَ
مُعَنِّدِ
الْمُغترِّ: - إنّه
ميّــتٌ.
الروح
سيف الله
والبدن
الْمُكَثَّفُ
غِمْدُهُ؛
فالصارم
المسلول
أنشطُ،
والمُغَمَّدُ
بيِّتٌ.[254]
نعم
لا يشُكُّون
قيدَ نملةٍ
فيما جاء ضمنَ
هذه الأبيات.
ذلك أنّ الْوَلِيَّ
في معتقدهم
إذا مات خلصتْ
روحُهُ من كُدُورات
الجسم
الكثيف،
وتحررتْ من
قيودها، وغدت
أكثرَ
استعدادًا
وقدرةً على
تنفيذ ما تريده.
لذلك يضربون
لها المثال
بالسيف المسلول.
ولهم
عباراتٌ
ملفّقةٌ في
هذه المسألة.
قد مزّجوا
فيها بين
الحقّ
والباطل. يقول
بعضهم »فمذهب
أهل الحق:أنّه
تبقى الكرامة
بعد الموت كما
أنّ النبوة لا
تنقطع بعد
الموت.«[255]
لقد
نَسِيَ
المتنطّعُ
بهذه الألفاظ
أو جَهِلَ
(وهو أقرب
للجهل): إنّه
لا وجهَ
للتشبيه بين
الكرامةِ
والنُّبُوَّةِ؛
ولا بين
الكرامة
والإيمان
إطلاقًا. وإنّما
للتَّشْبِيهِ
وجهٌ بين
الولاية وَالنُّبُوَّةِ،
وكذلك بين
الكرامة
والمعجزة.
لأنَّ النُّبُوَّةَ
صفةٌ ذاتيّةٌ
كالولاية؛
وليست صفةً
فعليّةً
كالمعجزة (وهي
من براهين النُّبُوَّةِ).
أمّا الكرامة
(بمعنى
الخوارق حسب
اعتقاد الصوفيّة)،
فإنها صفة
فعليّة
كالمعجزة،
وليست صفةً
ذاتيّةً
كالولايةِ
(وهي سبب
الكرامة، أي
سبب حدوث الخوارق
على يد الْوَلِيَّ
في معتقدهم
أيضًا). ولأنّ
مفهوم
الكرامة في مصطلحهم
يشتمل على
الخوارق
الّتي
تُمَثِّلُ الصفة
الفعليّة
وليست الصفةَ
الذاتيّةَ.
فهي بالنسبة
للولِيِّ عندهم
كالمعجزة
للنّبيِّ،
وكالسحر
بالنسبة للساحر.
إذًا فكيف
يجوز التشبيه
بين الكرامة وَالنُّبُوَّةِ؟!
لا
شكّ يظهر
مستوى هذا
الصوفيِّ
ونصيبُهُ من
العلم بوضوح،
من خلال تلك
المقارنة
الواهية.
لهذا، فإنّ
جماهير أهل
العلم والمعرفة
لو اجتمعوا
ليقيموا
الحجّة على كلّ
ما ادّعاه
الصوفيّة،
لعجزوا عن
إحصائها، فضلاً
عن دحضها
وإحباطها.
وهذا من أكبر
الأسباب
الّتي تفسح
لهم المجال
وتُنْبِتُ في
نفوسهم
الجُرأة
فتُردِيهم في
الغيِّ
والتمادي.
إنّ
الصوفيّة
عامّةً
والنقشبنديّين
خاصّة يُدافعون
عن عقيدتهم في
مسألة الْوَلِيِّ
والولاية
بإصرار، ويلجئون
إلى تأويل
الآيات
والأحاديث كي
تستقيم
لاستدلالهم
وحجاجهم. فقد
أظهر بعضُهم
عقيدتَهُ في
الولاية بِجُرْأَةٍ
حيث ادّعى أنّ
الولاية أفضل
من النبوّة.[256] إنهم لا
يختلفون
أصلاً في هذه
العقيدة.
ولكنّ شيوخهم
يحتاطون في
إظهار هذا
المعتقد
الخطير،
خاصّة إذا كان
عندهم أحد من
المسلمين!
ربما
لجأ النقشبنديّون
الأتراك إلى
هذا التصوّر
الرهيب،
ليتمكّنوا
بذلك من
التحدّي على
أنَّ منهم
أولياء،
يفوقون الأنبياء
بدرجاتٍ؛
ليتخلّصوا
بذلك من تبعية
العرب في
الدين والثقافة.
وليبرّروا
حجّتّهم في
تعظيم كبرائهم
والدعاية
لهم،
ولتستطيعَ كلّ
جماعةٍ منهم
العملَ على
تصعيد شيخِها
وتفخيمهِ إلى
أن تعترفَ بقيّة
الْفِرَقِ
الباطنية به،
فيدخلَ اسمُه
في قائمة
أولياء
الصوفيّة.
ولهذا ليس من
الأمور الخفيّة
(كما ورد بقلم
بعضهم)، »أنّ كلّ
مريدٍ لابدّ
يعتقد
الولاية في
شيخه«.[257] رجمًا
بالغيب؛
وبالرغم من
انْتِفَاءِ الإطلاع
على وجود صفة
الْوَلِيِّ في
شخصٍ بعينه،
متَّفَقٌ
عليه عند
قدمائهم.[258] وهذا
برهان أخر على
تخبُّطهم
جميعًا في
عمياءَ، وتقلُّبهم
في أمواج من
التلفيق
والتناقض
والتضارب مع
أنفسهم.
يتكلّفون
كلّ هذه
المحاولة مع
ما فيها من
المسؤولية
العظيمة،
ليدّعوا في
النهاية أنّ
شيخهم قطب
الفرد، وغوث
الزمان،
وغياث
الخلائق،
تظهر على يده
ما لا عين
رأت، ولا أذنٌ
سمعت من
الخوارق،
وأنّه لو أراد
أن يقلّب
الجبال ذهبًا
لفعل، وأنّه إنْ
مَشَى على
البحر لما
أصاب نعلَهُ
شيء من البلل،
وأنّه لو دَعَا
على قومٍ لجعل
الله عاليهم
سافلهم. وأنّه
يحضر الصلاة
في الأوقات
الخمس
بالمسجد
الحرام في
الحين الّذي
هو في بلده،
ولو كان بينه
وبين الحرم
بُعْدُ المشرق
والمغرب،
وأنه يحضر
جبهة القتال
في طليعة جيوش
الإسلام
ينصرهم على
عدوّهم، وكيت
وكيت!
يبرهن
على هذه
الحقيقة ما
يُرَدِّدُهُ
عوامُّ النقشبنديّة
من الأكراد
بلغتهم »شَيْخِ
مَهْ
دِكَارَهْ
صُولِ
جَنَّتيُِو جَهَنَّمِيَانْ
زِهَفْ
فَرْقْ
بِكَهْ.«؛ ذلك
يعني: أنّه
باستطاعة
شيخنا أن
يميّز بين
نعال أهل
الجنّةِ وأهل
النارِ. أي له
علم بالغيب في
هذا التمييز
حتّى ولو لم
يعاين أصحاب
النعال.
إنّ
المفتتنين بكلّ
شيخ من شيوخ النقشبنديّة
يحاولون بمثل
هذا التعبير
ليذكروا من
صفاته الّتي لا
يمتاز بها شيخ
آخر،
اعتزازًا به.
وهكذا تجري
المنافسة،
وأحيانًا
يتطوّر
الحديث بين الجماعات
التابعة
لشيوخ هذه
الطائفة
بالأسلوب
نفسه، فيؤدّي
إلى مضاعفات
من الخصومة
والبغض
والشحناءِ..
إن
هذه المنافسة
قد أورثت النقشبنديّين
معتقداتٍ
غريبةً
ومتنوّعةً
حول مفهومَيِ
الْوَلِيِّ والولاية،
وفي النظر إلى
شخصية شيخ
الطريقة. فإنّهم
مختلفون في
فهم هذه
المسائل،
وكذلك مواقفهم
وتعاملهم مع
مشايخهم بهذا
السبب يختلف
اختلافًا
بارزًا من جماعةٍ
إلى أخرى؛
بعضهم
يقدّسون مشايخهم
ويعظّمونهم
تعظيم العبد
لربِّهِ،
وربما
يعتقدون فيهم
جزءًا من الإلهيّة؛
وبخاصّةٍ
الأكراد من
هذه النحلةِ
يحلفون برؤوس
مشايخهم
وبقبورهم
وكذلك
بأنسابهم.
فيقولون:
»بِسَريِ
شَيْخْ«.
أي أُقسِمُ
بِهامةِ
مولانا الشيخ.
ويقولون »بِجَديِّ
شيخ«. أي
أقسم بنسب
مولانا
الشيخ؛ أو أقسم
بآبائهِ. ويقولون
»بِكُمْبَتَا
شَيْخْ«.
أي أقسم
بالقبّةِ
الّتي على
ضريح مولانا
الشيخ. ذلك من
عاداتهم
الشائعةِ أنّه
إذا مات شيخ
من مشايخهم
أقاموا على
قبره قُبّةً -
إلاّ من أوصى
بخلافه،
وقليل مّا هم -
ثمّ ركّبوا
على لحده صندوقًا
من الخشب،
فزيّنوه
بالأقمشة، وجعلوه
مزاراً
يشدّون إليه
الرحال،
ويتبرّكون
به، ويحملون
إليه
مجانينهم
ومرضاهم استشفاءً
به، كبقيّة
الطوائف من
الصوفيّة.
ولبعض
جماعاتٍ منهم
عاداتٌ أخرى؛
كالضرب على
الدفوف،
والتغنّي بمناقب
الشيخ أمام
الموكب
أثناءَ تشييع
جِنازتهِ من
المصلّى إلى
المقبرةِ. وهي
بدعة اعتادها
النقشبنديّون
من سكّان
مدينة سِعِردْ
الواقعة
بأقصى جنوب
شرقي تركيا.
وكذلك
من صيغ القسم
عند الأكراد
النقشبنديّين
قولهم »بِأُوْجَاخَا
شَيخْ«[259] أي
أُقسم
بموقده،
(كناية عن
أسرته). وربما
يستمدُّ هذا
القَسَمُ من
عقائد
أسلافهم
الّذين كانوا
عليها في العهد
الوثنيِّ.
لأنّ الأكراد
كانوا
مجوسًا، يعبدون
النار
ويقدّسون
مواقدها قبل
الإسلام تبعًا
للفرس؛
فتسرّبتْ
عكوسُها إلى
ما بعد
الإسلام،
وأخذتْ
طابعاً
دسّاسًا لا
يفطن لحقيقته
إلاّ قليل من
أهل العلم
والبحث.
كانت
هذه نبذة من
ميّزات الولِيِّ
وصفاته
والخوارق
المزعومة عن
أولياء
الصوفيّة
وموقفهم من
شيوخهم. وليت
شعري من رأى منهم
بعينه - ولو
شخصًا واحدًا
-، لعلّ ظهر
منه مرّةً
واحدةً شيء من
هذه المزاعم!
وعند
ما نتساءل،
فنقول:
ـ هل
الأولياء، هم
الّذين {لاَ
خَوَفٌ
عَلَيْهِمْ
وَلاَ هُمْ
يَحْزَنوُنَ *
الّذينَ آمَنوُا
وَكَانوُا
يَتَّقوُن.َ}.
كما وصفهم
الله تعالى في
كتابه؛ أم هم
الّذين
تُنسَبُ
إليهم إظهار
الخوارق
كأنّهم
خُلِقُوا
لذلك! كما
وصفهم أتباعهم؟!
تختلف
إجابةُ كلّ
فردٍ من هذه
الطائفة عن
إجابة الآخر
عند مثل هذا
السؤال، بحيث
يَدْهَشُ
الإنسان من
أمرهم ولا
يستطيع أن
يجدَ الاتّفاقَ
بين ما يقول
اثنان منهم
فضلاً عن الاتّفاق
بين هذه
الفِرَقِ
المتشابهة في
الظاهر. وهذا
ما جعل
الإثباتَ
والتحقّقَ من
معتقدات
الصوفيّة
أمرًا
مستحيلاً على
الباحثين
وأهل الدراسة
والتنقيب.
ولعلّ اختلاف رجال
البحث في
تحليل قضايا
الصوفيّة.
ناشيء عن هذه
الفوضى
السائدة في عالم
المتصوّفة.
وبالخلاصة،
يبدو وبكلِّ
وضوح أنّ
الولاية في
اعتقاد
الصوفيّة
ليستْ هي
الصفةَ
الذاتيةَ
الّتي يُكرم
الله بها
عبدَه المؤمن
التقيَّ بما أنّه
لا يخاف ولا
يحزن. بل
الولايةُ
عندهم هي صفةٌ
يكتسبها
الإنسانُ بعد
مجاهداتٍ
ورياضاتٍ شاقّةٍ
بتعذيب النفس
والجوع
والسهر
والصمت والعزلة
إلى أن يتحقّق
له الفناء ثم
البقاء،
فيكون بذلك من
أصحاب النفوس
الفاضلة حتّى
إذا نُزِعَتْ
روحُهُ من
بدنه صار من »المدبّرات
أمرًا«
أي »ملحقة
بالملائكة،
أو تصلح هي
لتكون مدبّرة«[260]
»فقد
ظهر من هذه
العبارات أنّ
للأولياء بعد
الوفاة مدد
روحانيٌّ«[261] عند
الصوفيّة.
لم
تكتف الطائفة
بهذا القدر،
بل أفرط بعضهم
في جنب الله
وفي جنب رسوله
u،
حتّى
تَقَوَّلَ
على لسانه
بأنّه قال » إذا
تحيّرتم في
الأمور،
فاستعينوا
بأهل القبور«.[262] نقلوه
على أنّه
حديثٌ، كما وَرَدَ
بِلَفْظِهِ في
الصفحة الثانية
والثمانين من
المجلّد
الثاني لتفسير
»روح
الفرقان«؛
بينما أنكر بعضهم
الآخر على من
أسنده إلى
رسول الله r،
ورماه بسخافة
العقل. ومن
جملة ما سفّه
بعضهم بعضًا: محاولةُ
حمدِ الله الداجويِّ
وهو من
متصوّفة بلاد
الهند. نقل
الداجويُّ عن
شهاب الدين
محمود بن عبد
الله الآلوسي
مقطعاً في هذا
الصدد. قال
فيه »وكذا
في حَمْلِهَا
على النفوس
الفاضلة
إيهامُ صحّةِ
ما يزعمه سخفة
العقول من أنّ
الأولياء
يتصرّفون بعد
وفاتهم بنحو
شفاء المريض
وإنقاذ
الغريق والنصر
على الأعداء
وغير ذلك مما
يكون في عالم
الكون
والفساد على
معنى أنّه تعالى
فوّض إليهم
ذلك. ومنهم
مَنْ خصّ ذلك
بخمسة من
الأولياءِ
والكلّ جهل،
وإن كان
الثاني أشدَّ
جهلاً.«[263]
هكذا
أقوالهم
وحكاياتهم
ونقولاتهم
تتناقض وتتضارب
وتتذبذب في
اضطراب بين
الإفراط والتفريط،
في كثير من
المواطن وإن
ظهرت في صورة
الحق في بعض
الأحيان
لقصور النظر
فيها؛ كما في
مسألة الولِيِّ
والولاية.
***
* المكاشفة
والإلهام
وعلم الغيب في
اعتقاد النقشبنديّين.
إنّ
من جملة
الصفات التي يعتقدها
النقشبنديّون
في شيوخهم على
سيبل تمييزهم
من العامّةِ،
علمُ الغيب. فقد
أفردوا في
كتبهم
أبوابًا
بعنوان
الكرامات؛
وذكروا ضمنَ
مناقب شيوخهم
ما لا يُحصى
من قصصِ
المكاشفاتِ
والإلهاماتِ
وعلمِ الغيبِ،
تَحَارُ منها
العقول. منها
كتاب »الحدائق
الورديّة في
حقائق
أجلاّءِ النقشبنديّة«
لرجل من
متأخري هذه
الزمرة. اسمه
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانِيِّ.
لقد نقل في
ثنايا كتابه
أفظع ما يمكن
أن يتصوّره
الإنسانُ من
أساطيرَ
اختلقها النقشبنديّون
عَبْرَ
تاريخهم.يقول
في صدد كرامات
أحمد
الفاروقيّ
المعروف بين
النقشبنديّين
بـ »الإمام
الربّانِيِّ«:
»لقد
خصّه الله
تعالى بفضيلة
نشر العلوم الدينيّة،
والكشف عن
أسرار العلوم
اللَّدُنِّيَّةِ.«[264]
والعلوم
اللَّدُنِّيَّةُ،
هي الّتي يقصد
بها الصوفيّة
علمَ الغيب.
لذا، ميّز
الخانِيُّ
بينها وبين
العلوم الدينيّة.
وهي العلومُ الإسلاميّة
النابعةُ من
قلب القرآن
العظيم،
المستمدّةُ
من الوحي
الإلهيِّ،
والمعروفةُ
بمقدِّماتِها
وتفاصيلِها:
من توحيدٍ
وفقهٍ
وتفسيرٍ وحديثٍ
وما يتعلّقُ
بها.
إنّ
النقشبنديّين
يحتقرون هذه
العلوم
الشريفةَ
كسائر
الصوفيّة؛
ويفضّلون
عليها ما
سمّوهُ
بالعلوم اللَّدُنِّيَّةِ.
وهي في
اعتقادهم
إشراقٌ رُوحُانِيٌّ،
وَعِرْفَانِيٌّ
وَوُجْدَانِيٌّ
يُفيض على قلب
السَّالِكِ
من عند الله
بإلقاءٍ
ربّانِيٌّ عن
طريق الإلهام.
ويتفلسفون في
تحقير العلوم الدينيّة
المعتمِدة -
بجانبها
الكسبيِّ -
على الحسّ والعقل
والتجربة
والنظر
والقياس.
يزعمون أنّ مجرّد
المعرفة عن
طريق هذه
المسمَّيَات
لا تؤدّي إلى
كنه أسرار
الكون
والحياةِ
وإدراك الحقيقةِ
الخفيةِ من
وراء
الطبيعةِ.
فيبلغ تحقيرهم
للعلوم
القرآنية إلى
حدود السخرية
بها؛ كما جاء
في نفس المصدر
المذكور
آنفًا ضمنَ
ترجمة محمّد
زاهد
السمرقنديّ
أحدِ شيوخِ
هذه الطائفةِ
في قصةِ
اتصاله بعبيد
الله الأحرار
الّذي نصبه
شيخًا على أن
يكون خلفًا من
بعده على
أتباعه. يقول
الْخَانِيُّ
نقلاً عنهُ:
»فلمّا
وصلنا إلى
قرية
شَادْمَانْ،
أقمنا فيها أيّامًا
من شدّة
الحرِّ.
فبينما نحن
كذلك إذ حضر
إلينا سَيِّدُنَا
الشيخ رضي
الله عنه وقتَ
العصر فذهبنا
لزيارته.
فسألني من أين
أنت؟ فقلتُ من
سَمَرْقَنْد.
فطفق يحدّثنا
أجمل الحديث.
وذكر خلالَ
كلامِهِ
جميعَ ما
أكننتُهُ في
سرّي فردًا
فردًا. حتّى
أخبرني عن سبب
سفري إلى هَرَاةَ[265].
فلمّا وجدتُ
ذلك تعلّق
قلبي به كلّ
تعلُّقٍ. ثمّ
قال لي: إن كان
مَقْصُودُكَ
طَلَبَ الْعِلْمِ
فهو متيسّرٌ
هنا. فتيقّنتُ
أنّه ما من
خاطرٍ إلاّ
وقد اطّلع
عليه هذا ولم
يخرج من قلبي
محبّة السفر
إلى هراة. فلمّا
كوشِفَ بذلك
قال لي أحد
أتباعه إنّه
مشغول
بالكتابة،
فتربّص
قليلاً. فلمّا
فرغ قام من
مقامه وأقبل
نحوي ثمّ قال: -
أخبرني بجليّة
أمرك، هل
مرادك من هراة
تحصيل الطريق
أو العلم ؟
فدهشتُ من
جلالته
وسكتُّ. فقال
له رفيقي: - بل
الغالب عليه
الطريق،
وإنّما جعل
العلم
تستُّرًا.
فتبسّم وقال: -
إن كان كذلك
فهو أفضل
وأحسن«[266].
إنّ
هذه
العبارات،
مَنْ أمعنَ
النظرَ فيها، وجد
أنّها
تُغنيِهِ عن
مجلّداتٍ من
أساطير هذه
الطائفةِ وَخُرَافَاتِهَا
وَسَخَافَاتِهَا؛
واحتقارِ
شيوخِها
للعقل،
وسخريتهم من
العلم
والشريعة
المطهّرة. ولا
يعزب عن
الباحث
المحنّك، أنّ
غايةَ
كبرائهم من مدحهم
للشريعة المحمّديّة
في بعض
المواطن من
كلامهم، ليست
إلاّ وسيلة دعائيّة
يلجؤون إليها
على سبيل
الحيطة، تفاديًا
لما يتوقّعون
من ردودٍ
داخلَ
الطائفة وخارجَها.
خاصّة فإنّهم
يحذرون تَيَقُّظَ
وَانْتِفَاضَةَ
العلماءِ الّذين
تورّطوا بالانخراط
في صفوفهم دون
علمٍ بحقيقة
تعاليم هذه الطريقة
وفلسفتها!
لقد
بلغتْ
مجازفات
الخانِيِّ في
مسألةِ
الإلهامِ
وعلمِ الغيبِ
والمكاشفةِ
إلى حدودِ
الازدراءِ
بالعقلِ،
فاسترسلَ في
سرد »كرامات
مشائخه« ليخلع
بها أنماطًا
من آيات
الثناءِ
والمدح على
رجلٍ اسمه محمّد
زاهد
السمرقنديّ.
وهو أحد رؤوس
هذه الطائفة. ثم
استخدم
الخانيّ قُدْرَتَهُ
الأدبيّةَ في
تنميق
عباراته
وتنسيق
كلماته فقال:
»فهو
المفرد العلم
في العلم
والقلم الّذي
قام بأعباءِ
الأسرار
والإمداد،
وتدبير دولة
إرشاد العباد.
فتبارك مَنْ
شيّد بالإلهامات
الصادقةِ
قدرَهُ،
وسدّدَ
بالكرامات الخارقةِ
أمرَهُ«.[267]
هكذا
في اعتقادهم
أنّ جميع
شيوخهم
يطّلعون على
الغيب،
ويعلمون ما في
الصدور
بالكشف والإلهام.
أمّا
الإلهام، فهو
في الحقيقة
مفهوم غامض، احتاط
العلماءُ في
إبداءِ
الرأيِ حوله؛
وامتنع
الكثير منهم
عن الخوض فيه.
جاء تعريفه في
المعاجم
بخلاصةٍ يمكن
الجمع بينها
تقريبًا: أنّه
إلقاءٌ من
الله في نفس
الإنسانِ
أمرًا يبعثه على
فعلِ الشيءِ
أو تركهِ.
كأنه
أُلْقِيَ شيء في
روعه فالتهمه.
وكلمة »ألهمه
الله« أي
لقّنه إيّاه؛
و»ألهمه
شيئًا«
أي أوعزه إليه
وأوحاه.
قال
مصطفى بن محمّد
الْكَسْتَلّيِّ
في حاشيته على
شرح العقائد
للعلاّمة سعد
الدين مسعود
بن عمر
التفتازاني
تفسيرًا لقول
النسفيِّ »والإلهامُ
عند أهل
الحقّ؛ قال
إحترازًا
عمّا نقل عن
بعض المتصوّفة
وبعض الرافضة أنّه
من أسباب
العلم
مستدلّين
بقوله تعالى
{فَأَلْهَمَهَا
فُجوُرَهَا
وَ
تَقْوَاهَا}[268]
والجواب، أنّ
المراد
إعلامها
بإرسال الرسُلِ
وإنزال
الكُتُبِ، أو
بدلالة العقل«.
فقد
اتّضح من هذه
العبارات
مرةً أخرى أنّ
علماء
الإسلام في كلّ
عصرٍ قد
حذّروا
المسلمين عن
الاغترار
بتأويلات المتصوّفة
والرافضة.
***
*
الأويسيّةُ
أمّا
الأويسية: فإنّها
مصطلحٌ غريبٌ
ومثيرٌ،
اختلقها
النقشبنديّون
ليتّخذوه
ضربًا آخر من
دعوى علم
الغيب لشيوخهم.
يزعمون أنّ
عددًا من
قدمائهم
تلقّوا علومَهم
من روحانيةِ
مَنْ ماتوا
قبلهم؛ ويصفونهم
بـ »الأُوَيْسِيَّةِ«
فيقولون
لكلٍّ منهم »شيخٌ
أويسيٌّ«
نسبةً إلى أُوَيْسِ
الْقَرَنِيِّ.
وهو »أويس
بن عامر بن
جزء بن مالك
القرنيّ، من
بني قرن بن
ردمان بن
ناجية ابن
مراد، أحد
النسّاك العبّاد
المقدّمين من
سادات
التابعين.
أصله من اليمن
يسكن القفار
والرمال،
وأدرك حياة النبيّ
r
ولم يره. فوفد
على عمر بن
الخطّاب؛ ثم
سكن الكوفة
وشهد وقعة صفّين
مع عليّ رضي
الله عنه.
ويرجِّح
الكثيرون أنّه
قُتِلَ فيها«[269]. قيل إنّه
كان يتشوّقُ
لزيارة
النبيِّ r. فلم
يستطع إليه
سبيلا. وعلى
هذا، زعم
النقشبنديّون
أنّه تلقّى عن
رسول الله r
علومًا بظهر
الغيب.
فاتّخذوا من
هذه المزعمة ذريعةً
ليختلقوا بها
ما اشتهته
نفوسهم بوضع
هذه الأسطورة
المتمثّلة في
كلمةِ: »الأُوَيْسِيَّةِ«.
يقول
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ في
هذا الصدد:
»اعلم
أنّ الإمام
بهاء الدين
الشاه نقشبند،
أخذَ الذكرَ
الخفيَّ عن
روحانيّة
الشيخ عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ
(...) ولم يجتمع
معه في عالم
الأجسام. لأنّ
بين الإمام
بهاء الدين
والإمام عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ
(...) خمس وسائط من
رجال السلسلة
العليّة كما
مرّ آنفًا.
وكذلك الشيخ
أبو الحسن الْخَرَقَانِيُّ
المتقدّم
ذكره أخذ
الطريقة
المرضيّة عن
روحانيّةِ
الإمام أبي
يزيد طيفور بن
عيسى
البسطاميّ (...)؛
وذلك في ظهوره
له في عالم
السير إلى
الله تعالى.
فانّ
الروحانيّات
تجتمع في ذلك
كاجتماعهم في
المنام، وبعد
الممات. وهو
عالَمُ
اللاّهوت الخارج
من عالم
الأجسام
والأرواح.
الخلقُ كلّهم
- الأحياء
والأموات - في
ذلك العالم.
منهم مَنْ
يدبّر الله له
جسمًا في
عالَمِ
الأجسام وهم
الأحياء؛
ومنهم من لا
يدبّر الله له
شيئًا من
الأجسام، وهم
الأموات. ومن
لم يُنفَخ فيه
الروح مما لم
يُسَوَّ
جسمُهُ. ولمّا
كان هذا الأحذ
من
الروحانيّات،
نبّهنا عليه.
لأنّ أبا
الحسن
الخرقانيّ لم
يجتمع
بجسمانية أبي
يزيد
البسطاميّ (...).
لأنّ بينه
وبينه زمنًا
بعيدًا. فانّ
أبا يزيد توفّي
سنة إحدى وستّين
ومائتين. وقيل
أربع وستّين
ومائتين.
وأبوالحسن
ولد بعده
بكثير. وأبو يزيد
(...) أيضًا
لَبِسَ خرقة
الطريق
ظاهرًا وباطنًا
من روحانية
الإمام جعفر
الصادق رضي
الله عنه كما
تقدّم في
الشيخ أبي
الحسن. وما
اشتهر بين بعض
أهل الطريق من
خِدْمَةِ
الشيخِ أبي
يزيدٍ (...)
للإمام جعفرَ u
وصحبتِهِ له،
غير صحيح.
لأنّ وفاة
الإمامِ جعفرِ
الصادقِ رضي
الله عنه، قبل
ولادة الشيخ أبي
يزيد (...) وكلّ
مَنْ أخذ من
الروحانيّات،
يسمّى »أُوُيْسٍيًّا«
في اصطلاح
ساداتنا النقشبنديّة.«[270]
من أنعم
النظر في هذه
العبارات، وفي
ضوء الإيمان
والعلم بكتاب
الله وسنّة
رسوله r،
حار لجرأة
شيوخ هذه
الزمرة على
الله تعالى، كيف
يَتَقَوَّلُونَ
على الدين
بهذا القدر من
التحرّر من
ضوابط الكتاب
والسّنّة
وهما بين
أيدينا. ليت
شعري إنْ
كانوا صادقين
مع أنفسهم في
القول بهذه
المعتقدات
الغريبة؛ وهل
يتمتّع أحدهم
بالفطرة السليمة
أو يملك
عقلَهُ
ووعيَهُ في
تلك اللحظة
الّتي يتفوّه
بمثل هذه
الكلمات؟
أليس من العجيب
أنّهم لا يَدَّخِرُونَ
وُسْعًا في
إشعار الناس بتمسّكهم
بكتاب الله
وسنّه رسوله r
ولا يتفكّرون
لحظةً عمّا
إذا صدر عن
رسول الله r أنّه
أوصى
الأحياءَ بأن
يتلقّوا
علومهم من
الأموات؟ ومن
ذا الّذي يعلم
شيئًا من
أحوالهم سوى الله؟
قال
الله تبارك
وتعالى {وَمَا
أَنْتَ
بِمُسْمِعٍ
مَنْ فيِ
الْقُبوُرِ.}.[271] وقال
رسول الله r »إذا مات
الإنسان
انقطع عنه
عمله إلاّ من
ثلاثةٍ: إلاّ
من صدقةٍ
جاريةٍ، أو
علمٍ
يُنتَفَعُ
بِهِ, أو ولدٍ
صالحٍ يدعو له.«[272] فإذا
كان عمل
الإنسان
ينقطع بموته
تمامًا إلاّ
من هذه
الأشياء
الثلاثة
الّتي ليستْ
من نتيجة فعله
المباشر،
وإنّما هي
بالواسطةِ؛
فكيف به أنْ
يُعَلِّمَ
غَيْرَهُ بعد
موته كما في
حياتِهِ!
ولكنّ
النقشبنديّين
لم يتوقّفوا
عند هذه
الحدود، بل لا
حدود
لتصوّراتهم وخيالاتهم،
كما سوف
تتبلور أمام
عيوننا أكثر
وضوحًا
عَبْرَ
متابعتنا
لدراسة بقيّة
معتقداتهم
حول مفهوم
الكرامةِ
والتوسّلِ والتبرّك
بالقبور
والاستمداد
من الموتى.[273]
***
* مفهوم
الكرامة في
معتقد
النقشبنديّين.
إن
قسطًا كبيراً
من نشاطات
الطريقة النقشبنديّة
يتمثّل في
اختلاقِ
حكاياتٍ
بهلوانيةٍ
وأساطيرَ
عجيبةٍ
دوّنوها
بعنوان
الكرامات
ضمنَ مناقب
أوليائهم. وهي
مشحونةٌ في
بطون كُتُبِهِمْ،
لم يطّلع
عليها كثير من
علماء
المسلمين
الّذين لم
يعاصروهم أو
لم يجاوروهم.
أمّا المتأخّرون
من أهل العلم،
فانّ كثيرًا
منهم أيضًا لا
علمَ لهم بهذا
الجانب من
الطريقة النقشبنديّة.
ذلك لأنّهم لم
يعبؤا بهذه
الطائفة ولم
يخالطوا
شيوخها
أَنَفَةً
واستنكافًا.
فَخَلاَ الجوُّ
بذلك لأصحاب
الأقلام من
هذه النحلة
وسنحتْ لهم
الفرصةُ حتّى
نسجوا ما طاب
لهم من أفانين
القصص
الأسطورية،
وحشدوا ما
استطاعوا
منها في طيّات
كتبهم على
سبيل التنويه
بعظمة أسلافهم
ومكانتهم عند
الله. وقد تأثّر
بهذه الكتب
كثير من
المتعلمين
والملالي وجماهير
من العوام
الّذين وجدوا
في حكايات الشيوخ
ما تنبهر بها
عقولهم
البسيطة
الساذجة. ولربما
سرى ذلك التأثير
إلى عدد من
متأخري
الفقهاء
فأظهروا حسنَ
ظنِّهم بهذه
الطريقة مثل
ابن حجر
الهيتميّ، وَعَلِيِّ
الْقَارِي،
وغيرهما، لما
خفي عليهم من
أمورٍ يكتمها
كبار زعماء النقشبنديّة
ولا
يُبْدوُنَها
حتّى لمن
يليهم من شيوخ
الطائفة
الّذين هم من
الدرجة
الثانية؛
خاصّة التطوّرات
والتغيّرات
الّتي حدثت في
عقائدها وآدابها
عَبْرَ
المرحلة
الأخيرة على
يد خالد البغداديّ
وبطانته، لم
يعلمها
السابقون. ثم
اتّخذ شيوخُ النقشبنديّة
أقوالَ بعض
أولئك
السابقين
حجّةً في
الدفاع عن
طريقتهم؛
ومنهم محمّد
بن عبد الله
الخانيّ، فقد
نقل عبارةً من
فتاوي ابن حجر
الهيتميّ في
الصفحة
الثامنة من
كتابه البهجة
السنيّة جاء
فيها: »وذكر
العلاَّمة
المتبحّر
الشيخ ابن حجر
الهيتمي
المكّي رحمه
الله تعالى في
خاتمة الفتاوى
الطريقة
العلية النقشبنديّة
مستطرداً من
بحث آخر
معبّراً عنها
بقوله: الطريقة
العلية
السالمة من
كدورات جهلة
الصوفيّة،
وهي الطريقة النقشبنديّة.«
من
كتبهم الّتي
حشدوا بين طيّاتها
أنواعَ
الأساطير
باسم
الكرامات: »الحدائق الورديّة
في حقائق
الأجلاّء النقشبنديّة«،
لعبد المجيد
بن محمّد بن محمّد
الخانيّ؛
وكتاب »المواهب
السرمدية في
مناقب
السادات النقشبنديّة«،
لمحمد أمين
الكرديّ
الأربليّ؛ و»جامع كرامات
الأولياء«ِ، ليوسف بن
إسماعيل
النبهانيّ؛ و»الأنوار
القدسية في
مناقب النقشبنديّة«
لمؤلّفه
ياسين بن
إبراهيم
السنهوتي
وغيرها. فقد
نسجوا على
صفحات هذه
الكتب ما
يُثير غيرةَ كلّ
مؤْمنٍ بالله
واليوم
الآخر، ولا
يُستَبْعَدُ
أن يتّخذ نفسَ
الموقف منها مَنْ
يحترم العقل
من غير
المسلمين
أيضًا.
أمّا
الكرامة في
حقيقتها، فهي كلّ
مِنْحَةٍ
يُكرِمُ
اللهُ بها
عبدَهُ
المؤمن التقيَّ
ليكافئه بها
على سعيه
المقبول؛ أو ليجعلها
وسيلة
الهداية لبعض
عباده وعبرةً
لأولي
الألباب. غير
أنّ الكرامة،
يستحيل أنْ
تكون مخلّةً
بسنّة الله،
كما لم تكن
معجزات
الأنبياءِ
مخلّةً ومبطلةً
لها. لأنّ
نواميس الكون
والحياة كلَّها
جارية على نسق
واطّراد
وضعها الله
سبحانه على
شكل مترابط
ومتكامل لا يتم
نظامها وبقاؤها
إلاّ بهذا
الترابط
والتكامل؛
بحيث إذا بطل
قانون واحد من
تلك القوانين
اختلّ نظامُ
العالمين
وسَادَ الفوضى
على الكائنات
بأسرها وقامت
الساعة. كما أنّ
المعجزةَ
والكرامةَ من
تقديره
تعالى، وبتدبيرٍ
منه
تتحقّقان،
وبقدرته
وهيمنته تتأثران
على نفوس مَنْ
كُتِبَتْ له
الهداية إلى الصراط
المستقيم؛
{وَلَنْ
تَجِدَ
لِسُنَّةِ
اللهِ تَبْديِلاً.}.[274]
إنّ
الكرامة مع
ندرة وقوعها
في صورة حدثٍ
خارقٍ
للعادةِ قد
يستعرضها
الوليُّ
ليتحدّى بها
المنكرين
والملحدين
على أنّه
صادقٌ في
دعوته إلى
شريعة
النبيِّ
الّذي يتبعه
ما عسى أن
يهتدوا
للإيمان
بالله واليوم
الآخر وما جاء
به النبيُّ من
عند الله.
وهذا يبرهن
على أنّ
الكرامة لا
ينبغي
إظهارُها للمؤمنين؛
كما لا مساغ للاحتجاج
بها في وجههم؛
لأنّهم
مؤمنون بجميع
ما يؤمن به
صاحبُ
الكرامة؛
ولأنّ القصدَ
لتحصيل
الحاصل لغو.
إنّ
الكرامة في
اعتقاد
النقشبنديّين
ليست هي
مِنْحَةُ
الله الّتي
يُكرِمُ بها عبدَهُ
المؤمنَ التقيَّ
ليكافئه على
سعيه
المقبول، أو
ليجعلها
وسيلة
الهداية لبعض
عباده
الضالين. بل
هي عندهم
أنماطٌ من
الخوارق
وألوانٌ من
قبيل السحر؛
يدّعون أنّ
شيوخ الطريقة
يُظهرونها، فيتميّزون
بها عن سائر
الناسِ على
أنّهم من أولياء
الله، ومن
خاصّة عبادهِ
المصطفين. كما
يعتقدون أنّ
شيوخهم
يتصرّفون بها
في ملك الله،
تؤيّدُهم على
دعواهم تلك
الأعمالُ
الخارقةُ
الّتي تصدر عنهم.
كالمشي على
الماءِ،
والطيران في
الهواءِ،
وقطع
المسافات
الشاسعةِ في
لمح البصرِ، وتحقيق
النصر للجيوش
وغيرها مما لا
يمكن حصره.
ولكنّ
هذه
الأقاويل، لم
تتعدّ حدودَ
الزعم المحض،
ولم يتحوّل
شيء منها إلى واقعٍ
مُشَاهَدٍ حتّى
الآن. وذلك
حجّةٌ دامغة
على كلّ من
تورّط
فاستسلم لهذا
الاعتقاد
الباطل؛ سواء
أكانت الحجّة
تتّسم بقيمةٍ
في اعتبارهم
أم لا. فليس
وراء بيان
الله ورسوله
بيان، ولا
قرية بعد
عبادان.
لقد
دعتْ
المناسبةُ هنا
أن ننقل من
كُتُبِ
النقشبنديّين
أمثلةً مِمَّا
كتبوه بعنوان
الكرامات
وأسندوها إلى
شيوخهم؛
ننقلها
ليتأكّدَ
القارئُ من
مدى خيالاتهم
وتصوّراتهم،
وموقفهم
المستخفّ من
العقل والحقائق
العلميّة،
واستهزائهم
بسنّة الله
الّتي خلق
الحياة
والممات
والكون والفساد
على أساسها.
يقول
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ - وهو
أديب
النقشبنديّين
وداهيتهم - إذ
يترنّم
بمدائحه
المسجّعةِ
لإمام طريقتهم
محمّد بهاء
الدين
المعروف
بينهم بـ»شاه
نقشبند«.
يقول »لم
يدع نَفْسًا
إلاّ بأنفاسه
القُدسيّة
زكّاها، ولا
نارَ هِمّةٍ
إلاّ بأسراره المحمّديّة
أذكاها، ولا ظُلْمَةَ
جهلٍ إلاّ
بأنواره
البهائيّةِ
أخفاها، ولا
شبهةَ خاطرٍ
إلاّ
ببراهينه
الجليّةِ نفاها،
إلى كراماتٍ
كريماتٍ
وآياتٍ
عظيماتٍ طالما
أحيتْ من
القلوب
مواتَها
وآتتْ
الأرواحَ
أقواتَها،
ارتضع ثديَ
التصرّفاتِ
الغوثيةِ وهو
في المهد
صبيًّا، وتضلّع
من رحيقِ
مختومِ
العلومِ
الْختمية بأكواب
الإرثية، فلو لم
تُخْتَمِ
النبُوَّةُ
لكان نبيًّأ«[275]
هكذا
يقول الخانيّ
في معرض
ترجمته
لمؤسّس طريقتهم،
وهكذا يعتقد
في هذا الشخص
الّذي ربما ليس
لوجوده أثر من
الحقيقة؛ أو
قد يكون درويشًا
بسيطًا لم
يلتفت إليه
أحد في حياته
أصلا؛ ثمّ حَظِيَ
من الشهرة مع
الزمان وَعَبْرَ
قرونٍ بعد أن
اتّخذه بعضُ
الْمُتَحَذْلِقِينَ
رمزًا لِبَثِّ
معتقداته بين
السفلة
والرعاع،
فنُسِجَتْ حَوْلَهُ
سجلاّتٌ من
الأساطير
حتّى
عظّمَتْهُ
آلافٌ من
الناس
بالتقليد الصِّرْفِ،
لم يكن عبدُ
المجيدِ
الخانيُّ آخِرَهُمْ.
يواصل
الخانيّ في
سرد مناقبه
فيقول:
»وحَكَى
سَيِّدُنَا
علاءُ الدين:
أنّ الشيخَ
تاج الدين أحدَ
أصحابِ
الحضرة
البهائية،
كان إذا أرسله
الشيخُ إلى
حاجة من قصر
العرفان[276] إلى
بُخَارَى،
يعود ببرهةٍ
قليلة. وذلك إنّه
كان إذا غاب
عن أعين
المريدين يطير
في الهواءِ.
قال وأرسلني
يومًا في أمرٍ
إلى بُخَارَى،
فذهبتُ على
هذه الكيفية
فوجدتُ الشيخ
في طريقي.
فرآني على هذه
الحالة،
فسلبها منّي؛
فلم أقدر بعد
ذلك أن أفعلها
أبدًا«[277]
يستطرد
الخانيّ في
صدد كرامات
هذا الشيخ قائلاً:
»ثم
إنّ الشيخ
سافر إلى
خوارزم، وفي خدمته
الشيخ شادي.
فلمّا بلغا
نهر حرام،
أمره أن يمشي
على الماءِ؛
فخاف الشيخ
شادي. فأمره
غير مرّةٍ،
فلم يفعل.
فنظر إليه
نظرةً
عظيمةً، غاب
بها عن نفسه
بُرْهَةً.
فلمّا أفاقَ وَضَعَ
قَدَمَهُ على
وجه الماءِ وَمَشَى
والشيخ خلفه.
فلمّا
جاوزاه، قال
انْظُرْ هل
ابتلّ شيءٌ من
خفّك أو لا؟
فنظر، فلم يجد
فيه بللاً
أصلا بقدرة
الله تعالى.«[278]
وينقل
الخانيّ عن
أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ
المشهور بين
النقشبنديّين
بـ»الإمام
الربّانيّ« إنّه
قال »أطلعني
الله على
أسماءِ مَنْ
يدخلون في
سلسلتنا من
الرجال
والنساءِ إلى
يوم القيامة؛
وأنّ نسبتي
هذه تبقى
بوساطة
أولادي إلى
يوم القيامة
حتّى أنّ
الإمامَ
المهديَّ
سيكون على هذه
النسبة
الشريفة.«[279]
وقال
أيضًا »أطلعني
الله على قبور
الأنبياءِ
المبعوثين إلى
أرض الهند
بحيث أرى
أنوارًا
ساطعةً من قبورهم.«[280]
ويُسجّل
الخانيّ أنّ
هذا الشيخ »نظر مرةً إلى
السماءِ وهي تُمْطِرُ،
فقال لها
أقلعيِ إلى
وقت كذا، فحبس
المطر إلى ذلك
الوقت.«[281]
وينقل
المؤلّف
أيضًا عن
الابن الأكبر
للسرهندي، محمّد
سعيد أنّه قال:
»كثيرًا
ما كان يخبرني
الشيخ
بالأمر،
خيرًا كان أو
شرًّا قبل
وقوعه، فيقع
كما يقول، بلا
تفاوت أصلا.«[282]
إنّ
هذا الشيخ
الّذي كان
مطّلعًا على
السرائر،
وعالمًا
بمغيبات
الأمور،
والّذي »كان
يخبر ابنه
بالأمر خيرًا
كان أو شرًّا
قبل وقوعه
فيقع« (على
حَدِّ
اعتقادهم)،
كما ينقل
الخانيّ؛ ليت
شعري لماذا لم
يهتم بمستقبل
المسلمين،
ولم يُخبرهم
بما سوف يلاقونه
على أيدي
الظلمةِ من استعمارٍ
وَاضطهادٍ وإرهابٍ
وقمعٍ وإبادة؟!
فهلاّ أخبر
أمّة الإسلام
بالحروب الّتي
اندلعت بعده،
حتّى يأخذوا
حذرهم ولا
يذهبوا ضحية
ما دارت عليهم
رحاها
وأُزهقت
الملايين من
الأرواح
البريئة!
إنّهم
بحكم طبيعتهم
لن يسكتوا عن
هذه المحاجّةِ،
ولربما تراهم
يلجؤن إلى
الكتاب
والسّنّة في
الحين الّذي
يضربونهما
بعرض الحائط،
وهم يردّون في
محاولة
المتَّهَم البريء:
أنّ الغيبَ
لله. ويتناسون
بذلك جميعَ ما
قاله إمامهم
السرهنديّ
وغيره من
شيوخهم من دعوى
علم الغيب!
***
* حقيقة
مفهوم الغيب.
أما
الغيب، فانّه
مفهوم هامّ
ومعقّد،
ومشكلة عظيمة
أشغلتْ عقولَ
البشر منذ
القديم. لقد
دار الجدال
حول
الغيبيّات
بمختلف
أساليبه بين العلماء
والفلاسفة
والكلاميّين
والمتصوّفة،
فأعيت فيها
مذاهبهم.
الغيب
في اللّغة هو
عكس الشهادة؛
وهو الأمر الخفيّ
وليس العدم.
فانّ العدم
مفهوم فلسفيّ
أخر.
ويختلف
الغيب إلى قسمين
رئيسيّين
باختلاف
ماهيته.
الأوّل
منهما، الغيب
الممتنع أو
المطلق. وهو
ما يستحيل
إدراكه على
العقل
البشرىِّ
تمامًا، وإن
سُمّيَ، أو
أُخْبِرَ عن
قرائنه.
كالروح،
وأحوال ما بعد
الموت، وأشراط
الساعة
وقيامها،
وحياة
الآخرة؛ بالإضافة
إلى كلّ ما هو
مستغرق في علم
الله وحده على
انفراد.
وتسمّى هذه
الأمور بـ »حقائق ما
وراء الطبيعة
= «Metaphysic.
تلك الّتي لا
سبيل إلى
الإيمان بها
إلاّ عن طريق
ما أنزل الله
على رسله من
الوحي. ولا
يُدْرِكُ
الإنسانُ
شيئًا من
حقيقة هذه
المسمّيات
الغيبيّة في
هذه الحياة
الدنيا إلاّ
ما شاء الله
أنْ يُظْهِرَ
عليها طائفةً
من عباده.
وهو{عاَلِمُ
الْغَيْبِ
فَلاَ
يُظْهِرُ
عَلىَ غَيْبِهِ
أَحَدًا
إِلاَّ مَنِ
ارْتَضىَ
مِنْ رَسوُلٍ.}[283] وهم
المكلّفون من
الملائكة
والبشر خاصّة
دون غيرهم من بقيّة
الإنس
والملائكة
وعموم الجنِّ.
أمّا
النوع الثاني
من الأمور
الغيبيّة،
فهو الّذي
يجوز إدراكه
ببداهة العقل
البشريِّ،
ولكن
بوسائلها
الخاصّةِ
الّتي لها ضوابطها.
إلاّ ما
تُكِنُّهُ
الصدور
{وَاللهُ عَليِمٌ
بِذَاتِ
الصدوُرِ.}؛[284] وكذلك
ما هو آتٍ؛
فانّ علمه عند
الله {وَيَقوُلوُنَ
مَتىَ هَذَا
الْوَعْدُ
إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقيِنَ.}[285]
{وَيَقوُلوُنَ
مَتىَ هَذَا
الْفَتْحُ
إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقيِنَ.}[286] {وَلاَ
تَقوُلَنَّ
لِشَيْءٍْ
إِنّيِ فَاعِلٌ
ذَلِكَ غَدًا
إِلاَّ أَنْ
يَشَاءَ
اللهُ...}[287] {وَمَا
تَدْرىِ
نَفْسٌ
مَاذَا
تَكْسِبُ غَدًا
وَمَا
تَدْريِ
نَفْسٌ
بِأَيِّ
أَرْضٍ تَموُتُ
إِنَّ اللهَ
عَليِمٌ
خَبيِرٌ.}[288] ويمكن
أنْ نسمّي بقيّة
الغيبيّات في
هذا الكون
المادّيِّ بـ »الحقائق
الطبيعية
المجهولة«
إذ هي خاضعة
لنواميس
الكون وما
يتبعها من قوانين
المنطق
والعلوم
التجربيّة،
دون أية علاقة
للكَهَانَةِ
بها. وإنّما
يتمكّن
الإنسان من
إدراكِ شيء
على حقيقته
إذا ملك
الوسيلة
الّتي
تُقَرِّبُ
ذلك الشيءَ إلى
ذهنه؛
فيتحوّلُ من
مجهولٍ إلى
معلوم. ولكن ليست
كلّ هذه
الوسائل
ميسورةً، مع
أنّها ممكنةٌ.
بل كثير منها
صعب المنال،
وبعضها داخل
في المجهولات
أيضًا.
فيتعقّد
الأمر هنا،
وتشتدُّ
الأزمة على
بعض الناس
عندما
تتعرّضُ
أموالُهم
للسرقةِ
وأمثالها وهم
يجهلون
الفاعل، فيلجؤن
إلى السحرة
والمشعوذين
وشيوخ الطرائق
الصوفيّة
للكشف عن
ضالّتهم.
فيكلّفهم ذلك
مالاً
ووقتًا،
ويُرهِقُهم.
وأحيانًا
يضيق الأمر
ذرعًا برجال
الأمن في إثبات
الجرائم
والجنايات،
فلا تكاد
تُسْعِفُهم
تلك الأجهزة
الفنّية الّتي
يستخدمونها
للكشف عن
أسرار
المجرمين؛ فيندفع
بعضهم بضغوطِ
غرائزهِ
الوحشيةِ إلى
استعمال
العنف
والتعذيب
لانتشال
الاعترافات
من المتّهمين
بطرقٍ
قسريّةٍ.
كلّ
ذلك ناشيء عن
جهلهم
بأساليب
الوصول إلى
المجهول
الّذي
يطاردونه. وقد
يكون بسبب
عجزهم عن العلم
بشيءٍ ممكن في
حد ذاته،
مستعصٍ عليهم.
وكلّما دام
العجز عن
اكتشاف
الوسائل،
امتنع العلم
بالمجهول. وهذه
القضايا
مرتبطة أصلاً
بقانون
السببيّة؛
وهو في تسلسل
دائم
ومعقَّدٍ.
لأنّ كلّ شيءٍ
في هذا الكون
قائمٌ بشيءٍ
آخر، محتاجٌ
إليه.
فالمحتاج
إليه هو
السبب؛ - وقد
يسمّى علةً في
اصطلاح
الكلاميّين -
وأمّا
المحتاج فهو
المعلول.
وعلى
هذا النسق
والنظام تجري
الأحداث
وتتفاعل
الأشياء بين
تناقضٍ،
وتناسبٍ،
وتوالدٍ، وتكاثرٍ،
وتناقصٍ؛ إلى
غير ذلك من
التقلّبِ والتغيُّر
والتجدُّد
والتقادُم
والتطوُّر.
وهي آيات في
آياتٍ دالّةٍ
على قدرة
الخالق
البارئ
العظيم،
وعجائب
تجلّياته،
وحسن إبداعه
{صُنْعَ اللهِ
الّذي
أَتْقَنَ كلّ
شيء إنّه
خَبيِرٌ
بِمَا
تَفْعَلوُنَ.}[289]
ولكنّ
النقشبنديّين
نراهم غير
مقتنعين، لا بِسنُّةِ
اللهِ الّتي
أقامها
سبحانه على أساس
الْعِلِّيَّةِ،
ولا بالنصوص
القرآنية الّتي
تُنْبِؤُنا بقانون
السببيّة[290] في
الحين الّذي تؤكّد
على أن الغيب
لله وحده.
فانّ
الأساطير - الّتي
حشدوها في
طيّات كتبهم
على سبيل
الكرامة
لشيوخهم
ونسبةِ
عِلْمِ الغيب
إليهم -،
شاهدةٌ على
موقفهم
المتناقض مع
ما جاء في
كتاب الله من
انفراده
تعالى وحده
بعلم الغيب
كقوله سبحانه
{وَمَا كَانَ
اللهُ
لِيُطْلِعَكُمْ
عَلىَ الْغَيْبِ،
وَلَكِنَّ
اللهَ
يَجْتَبيِ
مِنْ
رُسُلِهِ
مَنْ يَشَاء.}[291] وقوله
تعالى {قُلْ
لاَ أَقوُلُ
لَكَمْ عِنْديِ
خَزَائِنُ
اللهِ، وَلاَ
أَعْلَمُ
الْغَيْبَ،
وَلاَ
أَقوُلُ
لَكُمْ
إِنّيِ
مَلَكٌ؛ إِنْ
أَتَّبِعُ
إِلاَّ مَا يوُحىَ
إِلَيَّ.}[292] وقوله
تعالى
{وَعِنْدَهُ
مَفَاتِحُ
الْغَيْبِ
لاَ
يَعْلَمُهَا
إلاّ هُوَ...}[293] وقوله
تعالى{قُلْ
لاَ أَمْلِكُ
لِنَفْسيِ نَفْعًا
وَلاَ ضَرًّا
إِلاَّ مَا
شاء الله، وَلَوْ
كُنْتُ
أَعْلَمُ
الْغَيْبَ
لاَسْتَكْثَرْتُ
مِنَ
الْخَيْرِ
وَمَا
مَسَّنيِ السوُءُ،
إِنْ أَنَا
إِلاَّ
نَذيِرٌ
وَبَشيِرٌ
لِقَوْمٍ
يُؤْمِنوَنَ.}[294] وقوله
تعالى
{وَيَقوُلوُنَ
لَوْلاَ
أُنْزِلَ
عَلَيْهِ
آيَةٌ،
فَقُلْ
إِنَّماَ
الْغَيْبُ
للهِ
فَانْتَظِروُا
إِنّيِ
مَعَكُمْ مِنَ
الْمُنْتَظِريِنَ.}[295] وقوله
تعالى{قُلْ
لاَ يَعْلَمُ
مَنْ فيِ السمَاوَاتِ
وَالأَرْضِ
الْغَيْبَ
إِلاّ اللهُ، وَمَا
يَشْعُروُنَ
أَيَّانَ
يُبْعَثوُنَ.}[296]
لابدّ
وأنّ عددًا من
أهل العلم
والبحث
يتساءلون في أنفسهم
عن الحكمة
المكنونة في
الغيب؛ أي ما
هو القصد
الحقيقيُّ من
وجود عَقَبَةِ
الغيب أمام
الإنسان
تمنعه من
العلم بواقعِ
كثيرٍ من
الأشياءِ
والأحداث لا
يكاد
يتجاوزها، وهو
في تساؤلٍ
وقلقٍ وجهلٍ
وحيرةٍ على
كرّ العصور
إلى هذا اليوم
الّذي يتمتّع
فيه باستخدام آلاتٍ
وأجهزةٍ
رهيبة السرعة
في الاتصال
والمواصلات؛
ولا يكاد
يتمكّن من أن
يزعزع هذه العقبة
من مكانها
بعدُ.
لقد
فات هؤلاءِ أن
يلاحظوا
برهةً قليلةً:
لو كُشِفَ لهم
ما سيلاقونه في
مستقبلهم من
جميع
الأحداث،
حلوِها ومرِّها
على هيئة
شريطٍ
سينمائيٍّ.
فما عسى كان
أمرهم وهم
يشاهدون فيها
أنفسهم
تتقلّب من
نعيمٍ إلى
عذابٍ
وبالعكس! وما
رأيُكَ فيما
لو كان قد
رُفِعَ
الحجابُ عنكَ
وأنت مراهق،
فشاهدتَ
يومئذٍ
مسبقًا جميع
ما سوف يمرّ
بك في حياتِكَ
من الوقائع
حتّى آخر
لحظةٍ أنتَ
فيها؟!
هل
تريد أن تختبر
نفسك كما لو
اطّلعتَ إلى
مُستقبلك
بتمامه، فعلمتَ
بالتأكيد
مثلاً أنّك
بعد عشرين
سنةً سوف
تحتلّ منصبَ
رئيس الدولة
ثم لم تلبث
تتعرض لمؤامرة
اغتيالٍ
فتذهب ضحيتها
بعد أن تقضي
أعوامًا في
المعتقل،
وأيّامًا تحت
التعذيب؛ هل
تتمكّن بعد
العلم بهذا المستقبل
الغريب الّذي
ينتظرك، أن
تملك شعورَك
فتستمرّ في
مسيرة حياتك
بصورة
عاديةٍ؟ فما بالك
بالناس لو علم
كلهم جميعًا
بما سوف يلقونه
من نعيم
وعذاب،
ومكاسب
وخسارات،
وسعادة وشقاءِ!
ألا يقتضي ذلك
أن يعيش كلّ
فرد من بني
البشر بعد
العلم
بمستقبله في
ارتباك وخوف
وذعر وفزع؟..
وهل يشهد بعد
ذلك عالم البشر
إلا الفوضى
والجنون
والخراب
والدمار؟!
إنّ
هذه
الفرضيّات
تقودنا إلى
فهم شيء من
الحكمة
المكنونة من
حقيقة الغيب.
وذلك برهان
عظيم على أنّ
الغيب لله
وحده دون
غيره؛ كما هي
حجّة دامغة
على كلّ من
اعتقد علم
الغيب في
أولياء
الصوفيّةِ.
***
* مفهوم
التوَسُّلِ
في معتَقَدِ
النقشبنديّين
وما ركّبوا
عليه من
أُمور.
التوسّل
لغةً: هو أن
يتمسّك
الإنسان
بشيءٍ يبتغي
به الوصول إلى
غايتهِ؛
فيكون ذلك
الشيءُ هو
الّذي يسمّى
الوسيلة.
وفي
اصطلاح علماء
التوحيد
والتفسير: هي
القربةُ إلى
الله. وهو
الإيمان
الصادق
والعمل الصالح.
هذا هو المراد
من لفظ
الوسيلة، كما
أثبتنا ذلك
بأدلّةٍ
واضحةٍ في
بابه.[297] من خلال
تفسيرات
منقولة لعدد
من مشاهير
العلماءِ.
يمكن
إضافة أضعاف
هذه النماذج
الّتي تُبَرْهِنُ
على اتّفاق
العلماءِ على
تفسير مفهوم
الوسيلة والتوسّل
في الآيتين
المذكورتين
كما تُبَرْهِنُ
على حصر معنى
الوسيلة في
القربة
والزلفىَ،
وأنّ التوسّل
منحصر في
التقرّب إلى
الله بالإيمان
الصادق
والعمل
الصالح فحسب.
غير
أنّ
النقشبنديّين
لا يقتنعون
بهذه
البراهين؛
لاستخفافهم
بعلماءِ
الإسلام
وعلومهم.
وتشهد على ذلك
هفواتهم في
احتقار
العلماءِ؛
كقول محمّد بن
سليمان
البغداديّ:
»وهؤلاءِ
العلماء
الّذين
تَرْكُ
مُخَاَلَطَةِ
بعضهم موجبٌ
للفتح على
القلب في طريق
الله تعالى،
هم المتفقّهة
الّذين
قدّمنا ذكرهم
قبل ذكر
الفقهاءِ. وهم
موجودون في كلّ
زمان من عصر
الإمام
الشافعيِّ،
بل من قبله إلى
يوم القيامة.
خذلهم الله
تعالى
وأذلّهم، إنْ
لم يكن لهم
نصيب في
الْهداية
والتوبةِ.«[298]
هكذا
يصبُّ جام
غضبه على »المتفقّهة«.
يقصد بهم
الّذين لا
يوافقونهم،
ويستثني
طائفةً أخرى
يسمّيها »الفقهاء«
وهم
المتواطؤن
معهم على
تأويلاتهم
الشاذّةِ،
وتحريفهم
للمفاهيم
القرآنية. لعلّ
سببَ هذه
العداوةِ، هو
أنّ
النقشبنديّين
يجدون في
تمسّك
العلماءِ
بالفقه
الإسلاميِّ وبنصوص
الكتاب
والسّنّة،
عقبةً كبيرةً
أمام محاولاتهم
في العبث
بِقِيَمِ
الدين الحنيف
ومفاهيمه. إذ
لا يتناولون
آيات الله ليتّبعوا
ما تشابه
منها، إلاّ
اصطدموا بهذه
العقبةِ كما
مرّ في تفسير
العلماءِ
لكلمة »الوسيلة«.
يبدو
أنّهم سوف
يصرّون في
عنادهم كسائر
أتباع الفرق
الباطنية،
على الرغم من
أنّهم سيلاقون
معارضةً
شديدةً من
علماءِ
الإسلام أَبَدًا
ما داموا
يتشبّثون بكلّ
ما قد وضعها
أسلافهم من
أشكالٍ غريبة
للتّعبُّد.
مثل »الرّابطة«،
و»الختم
الخُوَاجَگَانِيّةِ«،
وممارسة »الأركان
الأحد عشر«
وغيرها من
أوراد
مزخرفةٍ،
وأدعيةٍ
منفوخةٍ مستحدثةٍ،
وأذكارٍ
مبتدَعَةٍ؛
يدندنون بها
على غرار »المانترا
«mantra في
الديانات
الهندية. بل
وقد يتشبّثون
بوسائل أخرى
على هذا
الأسلوب
العناديِّ
الّذي أبعد
الكثيرَ من
الناسِ عن
ساحةِ
الإسلام، كما
شرعوا
لأنفسهم
التوسّلَ
بالأمواتِ
وقبورِهم،
والتبَرُّكَ
بها، فزعموا
أنّهم لم
يقصدوا بكلّ
ما ذُكِرَ
إلاّ وجهَ
اللهِ. مع أنّ
طلبَ وجهِ
الله لا يجوز
إلاّ باتّباع
ما قد رسمه
الله وَرَسُولُهُ
من أشكال
السعى
والعمل، دون
غيرها من
صُوَرِ التعبُّد
والتنسُّك
والرهبانيّة
الّتي
ابتدعها
اليهود
والنصارى
والمجوس.
هذا
وجدير
بالإشارةِ
إلى أنّ عموم
الضلالة - خاصّة
في المسائل
الإعتقاديّة -
ينشأ من التأويل
أكثر من
التعطيل. وهما
من أسباب التحريف.
وأثر الجهل
فيهما أكثر
بأضعاف من أثر
القصد
والتعمُّد.
وأنّ الجاهلَ
تابعٌ
للمتعمّدِ
وبطانتهِ
وعملائهِ
بالتقليد
الأعمى عادةً.
وما أكثر
أبناء الجهل
في كلّ أرض!
بذلك يستفحل
الأمر. لأنّ
الدجاجلةَ
يصطادونهم بكلّ
سهولةٍ.
فيتفاقم الشرّ
بسبب انسحاب
جماهير
البسطاء من
ورائهم؛ فيزدادون
بهم قوّةً
وجُرأةً.
ومن
العواقب
الوخيمة لجهل
الإنسان، وتبعيّته
بالتقليد
الأعمى فيما
يتعلّق بموقفه
من الله: أنّه
يشعر بضعفٍ
بالغٍ أمام
مخلوقٍ
عَظَّمَهُ
الناسُ حتّى
جعلوا منه
إلهًا؛ فيراه
مَلاَذًا
يلجا إليه
لِيُنَفِّسَ بِهِ
عنْ نَفْسِهِ
التَّعِيسَةِ
كربَهَا، وليجيرهَا
بِاللُّجُوءِ
إِلَيْهِ من
عدوّهَا؛
وليفرَّ إلى
هَذَا
الصَّنَمِ كلّما
استوحش،
ويطلبَ منه
الفرج كلما
ضاق به الأمر
ذرعًا، ويشكوَ
إليه كلّما
اشتدّ حُزْنُهُ
وآلامُهُ، وَليتسلّى
به إِذَا
داهَمَتْهُ
الهمومُ.
وإنّما
فشتْ بين
الناس فتنةُ
هذا الاعتقاد
الفاسد بسبب
ذلك الضعف
الناشيء من
الجهل بحقيقة
ما أنزل الله
على سيدنا محمّد
r
من آياتٍ
عديدةٍ في
المشركين
كقوله تعالى {
قُل
أَرَأَيْتَكُمْ
إِنْ
أَتَاكُم
عَذَابُ اللهِ
أَوْ
أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ،
أَغَيْرَ
اللهِ
تَدْعوُنَ
إِنْ كُنْتُمْ
صَادِقيِنَ *
بل إيَّاهُ
تَدْعوُنَ فَيَكْشِفُ
مَا
تَدْعوُنَ
إِلَيْهِ
إِنْ شَاءَ
وَتَنْسَوْنَ
مَا
تُشْرِكوُنَ.}[299] وقوله
تعالى
{أَيُشْرِكوُنَ
ماَ لاَ
يَخْلُقُ
شَيْئًا
وَهُمْْ
يُخْلَقوُنَ *
وَلاَ يَسْتَطيِعوُنَ
لَهُمْ
نَصْرًا
وَلاَ
أَنْفُسَهُمْ
يَنْصُروُنَ.}[300] وقوله
تعالى
{وَإِذَا
مَسَّكُمُ الضُّرُّ
فيِ
الْبَحْرِ
ضَلَّ مَنْ
تَدْعوُنَ إِلاَّ
إِيّاهُ،
فَلَمَّا نَجَّاكُمْ
إِلىَ
الْبَرِّ
أَعْرَضْتُمْ
وكَانَ
الإِنْسَانُ
كَفوُرًا.}[301] وقوله
تعالى { يَا
أَيّهَا النَّاسُ
ضُرِبَ
مَثَلٌ
فَاسْتَمِعوُا
له: إِنَّ
الّذينَ
تَدْعوُنَ
مِنْ دوُنِ
اللهِ لَنْ
يَخْلُقوُا
ذُبَابًا
وَلَوْ
اجْتَمَعوُا
له؛ وَإِنْ
يَسْلُبْهُمُ
الذُّبَابُ
شَيْئًا لاَ
يَسْتَنْقِذوُهُ
مِنْهُ؛
ضَعُفَ الطَّالِبُ
وَالْمَطْلوُبُ.}[302] وقوله
تعالى
{وَالّذينَ
تَدْعوُنَ مِنْ
دوُنِهِ مَا
يَمْلِكوُنَ
مِنْ قِطْميِرٍ
* إِنْ
تَدْعوُهُمْ
لاَ
يَسْمَعوُنَ
دُعَائَكُمْ،
وَلَوْ
سَمِعوُا مَا
اسْتَجَابوُا
لَكُمْ،
وَيَوْمَ
الْقِيَامَةِ
يَكْفُروُنَ
بِشِرْكِكُمْ،
وَلاَ
يُنَبِّؤُكَ مِثْلُ
خَبيِرٍ.}[303]
يدافع
النقشبنديّون
عن أنفسهم
بشدّةٍ عند ما
تُتلى هذه
الآيات على
مسامعهم،
فيثورون غضبًا
واستنكارًا
بأنّها نزلت
في المشركين. نعم،
ولكن ألا يعلمون
أنّه لا يَدْعوُ
أحدًا مِنْ
دون الله إلاّ
مشرك؟! أفلا
يكونون قد شهدوا
على أنفسهم
بهذا الذنب
العظيم؛ إذ
يصدّقون من
تعمّد الكذبَ
على لسان
النبيِّ r.
فزعم أنّه قال
»إذا
تحيّرتم في
الأمور،
فاستعينوا
بأهل القبور.«
وردت
هذه الكلمات
في كتابٍ
ألّفه محمّد
زاهد كوتكو،
شيخ جماعةٍ من
النقشبنديّين
في إسطنبول.[304] فما
دامت هذه
الطائفة
تعتقد أنّ شيخ
الطريقة وكيل
عن الله، كما
ورد ذلك في
تفسير »روح
الفرقان«
لجماعةٍ أخرى
منهم؛[305] ما دام
هذا اعتقادهم
في شيوخهم،
وأنَّ جميعَ شيوخهم
أولياء الله
وخاصّتُهُ -
رجمًا بالغيب
- إذن فلا مانع
عندهم من أن
يطلب المريدُ
قضاءَ
حاجتهِ،
ومغفرةَ
ذنوبِهِ من
شيخه فضلاً عن
أن يتوسّلَ به
إلى الله في كلّ
سؤاله.
أمّا
موقف بعضهم في
الدفاع عن النقشبنديّة
في هذا
المعتقد كما
نقل يوسف بن
إسماعيل النبهانيّ[306] عن شيخ
آخر على
شاكلته »إنّه
يجوز التوسّل
بأهل الخير
والصلاح«[307] فإنما
هو محاولة
يمهِّدُ بها
السبيل ليقول
في النهايةِ »ولا يظنّ
عامّيٌّ من
العوامِّ
فضلاً عن الخواصّ،
أنَّ نحو
سيّدي أحمد
البدوي
يُحْدِثُ شيئًا
في الكون،
وإنّما يرون
أنّ رتبتهم
تقصر عن السؤال
من الله تعالى
فيتوسّلون
بمن ذكر تبرُّكًا
بهم كما لا
يخفى.«[308]
هكذا
يقولون. لأنّ
كلاًّ من أحمد
البدوي وأمثاله
من الشيوخ
مستجاب
الدعوةِ
عندهم؛ لايشكّ
في ذلك أحد
منهم؛ ولأنّ كلّ
مَنْ اشتهر
بينهم
بالولاية -
مهما كانت
طريقة هذا
الاشتهار -
حتّى ولو
بوساطة المافيا،
أو باستغلال
رجال السياسة
والتجارة - لابدّ
وأنّ الله
يستجيب دعوته
في اعتقادهم.
أمّا
إذا قيل لهم: -
أنّ الفلان
الّذي
تعدّونه من
أولياء الله،
وتعظّمونه،
وتتوسّلون
بجاهه، فما
دليلكم على
صحّة
اعتقادكم هذا
فيه، وكيف
تعلمون أنّ
الله لا يردّ
دعوته؟ فيكون ردّهم
عنيفًا
وبلهجة مَنْ
رَكِبَ رأسه؛
كقول
الخليليِّ:
»ولا
يُنكر ذلك
إلاّ من ابتلى
بالحرمان، أو
سوء العقيدة
نعوذ بالله!«[309]
هذا
هو المنطق
الصوفيّ
والمنهج
النقشبنديّ عند
كلّ موقفٍ.
ومن هذا
المُنْطَلَقِ
فقد خاضَ أديبهم
يوسف بن
إسماعيل
النبهانيّ
مثار الدفاع
عن التوسّل
الفاسد
والاستغاثة
والتبرّك بالمخلوق
حيًّا
وميّتًا،
وذلك
بكتابَيْهِ: شواهد
الحق، وجامع
كرامات
الأولياء.
فحشد فيهما ما
زيّنت له نفسه
من الغثّ
والسمين حتّى
اشتهر
بالشعوذة
والتنطّع
وإثارة
الخرافات.
***
الفصل
الرابع
* حقيقة
ما تُسمّيهِ النقشبنديّة
»سلسلة
خُوَاجَگَانْ«،
وأسماءُ
الّذين
هم
بمنـزلة
حلقاتها المقدّسة
في اعتقاد هذه
الطائفة.
* مزعمة »سلسلة
السادات«.
*
الروحانيّون
في هذه
الطريقة
المعروفون بـ »رجال السلسلة«.
* شخصيّاتهم،
ومستوياتهم العلميّة
والاجتماعيّة،
وترجمة
أحوالهم
بالتفصيل.
----------------------------------
1.أبو بكر
الصدّيق رضي
الله عنه...................................................................................................
2.سلمان
الفارسي رضي
الله عنه....................................................................................................
3.قاسم بن محمّد
بن أبي بكر
الصدّيق رضي
الله عنهم...............................................................
4.جعفر
الصادق بن محمّد
الباقر رضي
الله عنهما.........................................................................
5.أبو
يزيد
البسطاميّ........................................................................................................................
6.أبو
الحسن
الخرقانيّ.......................................................................................................................
7.أبو
علي
الفارمديّ........................................................................................................................
8.أبو
يعقوب يوسف
الهمدانيّ.........................................................................................................
9.عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيّ....................................................................................................................
10.عارف
الرِّيوَگَرِي..........................................................................................................................
11.محمود
الإنْجِيرْفَغْنَوِيّ...................................................................................................................
12.علي الرَّامِتَنيّ.................................................................................................................................
13.محمّد بَابَا
السمَّاسيّ......................................................................................................................
14.أمير
كُلاَلْ بن
حمزة.......................................................................................................................
15. محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ
المعروف بـ »شاه
نقشبند«......................................................
16. محمّد
علاء الدين
العطّار..........................................................................................................
17. يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ....................................................................................................................
18. ناصر
الدين عبيد
الله الأحرار...................................................................................................
19. محمّد
زاهد الْبَدَخْشِيّ................................................................................................................
20.
درويش محمّد
السمرقنديّ........................................................................................................
21. محمّد
الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲّ......................................................................................................
22. محمّد
باقي بالله
الكابُليّ...............................................................................................................
23.
أحمد الفاروقيّ
السرهنديّ
المعروف بـ »الإمام
الربّانيّ«..................................................
24. محمّد
معصوم
الفاروقيّ...........................................................................................................
25. محمّد
سيف الدين
الفاروقيّ..................................................................................................
26. نور محمّد
الْبَدَوَانِيّ...............................................................................................................
27. شمس
الدين حبيب
الله مِيْرْزَا
مَظْهَر جَانِ
جَانَانْ...............................................................
28. غلام
علي عبد الله
الدَّهْلَوِيّ...............................................................................................
29.
خالد
البغداديّ
المعروف بين
النقشبنديّين
بـ »ذي
الجناحين«.....................................
* خالد
البغداديّ
ومعارضوه.............................................................................................................
* خلفاء
البغداديّ
وأسلوب
تعامله معهم........................................................................................
*
مميّزات
الشخصيّة
لشيوخ
الطريقة النقشبنديّة
ومستوياتهم العلميّة
والثقافيّة..............

الفصل
الرابع
* حقيقة
ما تسمّيه النقشبنديّة
»سلسلة
خُوَاجَگَانْ«
وأسماء رجالها
* مزعمة »سلسلة
السادات«؛
* الروحانيّون
في هذه
الطريقة؛
أسماؤهم، وشخصيّاتهم،
ومستوياتهم
العلميّة
والاجتماعيّة.
-----------------------------------
* حقيقة
ما تسمّيه النقشبنديّة
»سلسلة
خُوَاجَگَانْ«،
أو»السلسلة
الذهبيّة«
يزعم
النقشبنديّون
أنّ جميعَ
معتقداتِهم
وأساليبَ
تعبّدِهم
مأثورةٌ عن
رسول الله r،
وعن أصحابه
والسلف
الصالح عليهم
الرضوان. كما
يدّعي ذلك محمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ -
أحدُ رؤوسِ
هذهِ الطائفةِ
- فيقول »إنّ
طريقة السادة النقشبنديّة
هو معتقد أهل
السّنّة
والجماعة. وهي
طريقة الصحابة
رضي الله عنهم
على أصلها، لم
يزيدوا فيها،
ولم ينقصوا
منها.«[310]
هكذا
يقولون
ليتذرّعوا
بهذا
الإدّعاء أنّ
شيوخهم إنّما
تلقّوا هذه
الأصناف
الدخيلة من المعتقدات
والأشكال
الغريبة من
الطقوس والعبادات؛
إنّما تلقوها
بعضًا عن بعض،
وطبقةً عن
طبقةٍ،
متسلسلاً
بالتصاعد إلى النبيّ
u
(على زعمهم).
يَدَّعُونَ
أَنَّ
النَّبِيَّ u هو
الّذي لقّن
الطريقةَ أبا
بكرٍ رضي الله
عنه لأوّل
مرّةٍ! ثمّ
تسلسلتْ منه
بالتدريج حتّى
وصلت إلى
شيخهم الّذي
يلازمونه في
الوقت الحاضر،
كما سنعرض من
مقولاتهم فِي
ذلك
اقتبسناها من
مصادرهم.
إنّ
هذه الدعوى الّتي
لا حقيقة لها
في ميزان
العلم ولا في
ميزان
الإسلام،
يعتقدها كلّ
موُلِعٍ
بتعاليم هذه
الطريقة
اعتقادًا أكيدًا.
وكثير منهم
يحفظون أسماء
كبرائهم
بالتسلسل
المذكور في
مصادر هذه
الطائفة،
ويسمّونها بـ »سلسلة
السادات«؛
وكذلك بـ »السلسلة
الذهبيّة«.
***
* مزعمة »سلسلة
السادات«
يقول
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ، »سمعتُ أسماء
سادات سلسلة
الطريقة
الجليلة؛ جعلتُ
أتشوّقُ
للوقوف على
تراجم
أحوالهم المقدّسة
مدّةً غيرَ
قليلةٍ. وإذ
لم أرها مجتمعةً
باللّغة العربيّة
في كتاب واحد.
لأنّ أكثرهم
من بلاد الفرس
والهند وتلك المعاهد.
عزمْتُ وأنا
للعزم
بِأَلِفٍ،
سنة ثلاث
وثلاثمائة
وألفٍ. على أن
أجمعَ أحوالَ
مَنْ ترجموه؛
وأخدمَ
بالترجمة
مَنْ لم
يخدموه،
بادئًا
بالمبدأ
الفياض،
وخاتمًا
بسيّدي الوالد.«[311]
إنّ
من يُلقيِ
نظرةً على هذه
العبارات
الْمُزَخْرَفَةِ،
لا يخفى عليه
ما قد اعترف صاحبُها،
وما أقرّ وشهد
على نفسه
بالذات وبلسانه
وقلمه، حتّى
قال: إنّه سمع »أسماء
ساداته ولم
يرها مجتمعةً
باللّغة العربيّة
في كتابٍ
واحد، لأنّ
أكثرهم من
بلاد الفرس والهند«.
علمًا بأنّ
هذا الرجل من
أكبر شيوخ النقشبنديّة
في أيّامه
الّتي عاشها
ما بين 1847-1900م. من
الميلاد. وهذا
مع أنّه من
أسرةٍ نقشبنديّة
شهيرةٍ في
بلاد الشام.
ألا
يبرهنُ هذا
الاعترافُ
الرهيبُ من
رجلٍ بارزٍ
بين أساطين
هذه النحلة،
على »أنّ
هذه الأسماء
مازالت
غريبةً عليه -
وعلى النقشبنديّين
بأسرهم فضلا
عن جمهور
المسلمين-؛
وغيرَ
مجتمعةٍ
باللّغة العربيّة
في كتابٍ
واحدٍ«؟! إذًا
فكيف بهذه
العُصْبَةِ
من الصوفيّة
المجهولين
الخاملين أن
يكونوا قد
لبسوا الخرقة،
وأخذوا العهد
خلفًا عن سلف؛
وما عسى دليل
النقشبنديّين
بعد هذا
الاعتراف
الصريح أن يكون
هؤلاءِ قد
نقلوا تلك
المعتقداتِ
الدخيلةَ،
والمبادئَ
والآدابَ المختلَقَة
من لدن رسول
الله r
عَبْرَ هذه
السلسلة
المزعومة؟! ثم
كيف بهؤلاء
الدراويش
المساكين أن
يكونوا بمنـزلة
أولئك
العلماء من
سائر
الطبقات؛ من
المحدّثين
والفقهاء
والمفسّرين
واللغويين
والأطباء
والرياضيين
والأدباء
والحكماء
الّذين شاع
صيتهم، وبلغت
الآفاقَ شهرتُهم،
بما كتبوا
وصنفوا
وألّفوا
ودرسوا وارشدوا
حتّى امتلأت
مكتبات
العالم
بآثارهم القيّمةِ،
وانتشرت
معارفهم في أرجاء
المعمورة،
كما تبرهن على
هذه الحقيقة ما
نشهده اليوم
من تطوّراتٍ
هائلةٍ في
حضارة العصر
الحاضر الّتي
هي من امتداد
علومهم وتأثير
جهودهم؛
وعكوسٍ لامعةٍ
من أشعّةِ
ذكائهم ودهائـهم.
فأين أولئك
الّذين
يتشوّف
الخانيّ »للوقوف
على تراجم
أحوالهم
المقدّسة«!
أين بهم من
هؤلاء
الفحول، ومن
الأئمة
المجتهدين
أعاظم
الأمّة؟ وما
عساها قد عملت
تلك الشرذمة
العاطلة من
صوفية الفرس
والهند لأجل
أمّة الإسلام
ومستقبلها
ياترى؟!
سوف
نطّلع إنْ شاء
الله على
قائمة أسماء
هؤلاء الشيوخ
الّذين تُعظّمهم
النقشبنديّة،
وتَعُدُّهُمْ
من الّذين
اصطفاهم الله
على العالمين
حتّى »استطاعَ
بَعْضُهُمْ
أن يتّصلَ
بأرواح البعض
الآخر في عالم
اللاّهوت،
ويتلقىَّ منه
العلومَ
والأوامرَ« (على
حدِّ قولهم)؛
فينصبَ
نفسَهُ شيخًا
على النقشبنديّة.
سوف نطّلع على
أسمائهم
وصفاتهم وشخصيّاتهم
وصراعهم مع
منافسيهم،
ونصيبهم من
العلم والهداية؛
كما سوف نطّلع
على تصرّفات كلّ
منهم في هذه
الطريقة،
وذلك في
الأبواب
الآتية إنْ
شاء الله
تعالى.
يقول
محمّد أمين
الكرديّ
الأربليّ، »ينبغي
للمريدين أن
يعرفوا نسبةَ
شيخِهم ورجالَ
السلسلةِ
كلّها من
مرشدهم إلى
النبيِّ r.
لأنّهم إذا
أرادوا أن
يطلبوا المدد
من روحانيتهم،
وكان
انتسابهم
إليهم صحيحًا
حصل لهم المدد
من روحانيتهم.
فمن لم تتّصل
سلسلتُهُ إلى
الحضرة
النبوية،
فإنّه مقطوع
الفيض، ولم يكن
وارثًا لرسول
الله r.«[312]
كان
هذا هو
نموذجًا آخر
للمنطق
الصوفيّ النقشبنديّ
الغريب الّذي
لا يحتاج إلى
أيِّ تعليق،
والّذي تبدو
من خلاله
نظرتهم إلى
شخصية الرسول r،
وقسطاسهم في
تحديد
الوراثة له.
أمّا
أسماء رجال
هذه السلسلة
المزعومة،
فقد ذكرها عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ على
سبيل الإجمال
فقال:
»وهي
السلسلة
المتّصلة من
أبي الأرواح
الأكبر،
الرؤوف
الرحيم
الأبرّ،
سيّدنا رسول
الله r،
إلى حضرة
الصديق
الأعظم؛ إلى
سيّدنا سلمان الفارسيِّ؛
إلى سيّدنا
القاسم حفيد
أبي بكر الصدّيق؛
إلى سيّدنا
جعفر الصادق؛
إلى سيّدنا
أبي يزيد
البسطاميّ؛
إلى سيّدنا
أبي الحسن
الخرقانيّ؛
إلى سيّدنا
أبي علي
الفارمديّ؛
إلى سيّدنا
يوسف
الهمدانيّ؛
إلى سيّدنا
عبد الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ؛ إلى
سيّدنا عارف الرِّيوَگَرِي؛ إلى
سيّدنا محمود
الإنْجِيرْفَغْنَوِيّ؛
إلى سيّدنا
عليّ الرَّامِتَنِيّ؛
إلى سيّدنا الْمِيرْ
كُلاَلْ؛ إلى
سيّدنا محمّد
بَابَا سَمَّاسيّ؛[313] إلى
سيّدنا محمّد
بهاء الدين ـ
الشاه
النقشبند؛
إلى سيّدنا علاء
الدين
العطار؛ إلى
سيّدنا يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ؛ إلى
سيّدنا عبيد
الله
الأحرار؛ إلى
سيّدنا محمّد
الزاهد؛ إلى
سيّدنا
الدرويش محمّد؛
إلى سيّدنا
الخواجكيّ محمّد
الأَمْكَنَگِيّ؛ إلى
سيّدنا محمّد
الباقي
بالله؛ إلى
سيّدنا أحمد
الفاروقيّ السرهنديّ؛
إلى سيّدنا محمّد
المعصوم؛ إلى
سيّدنا سيف
الدين؛ إلى
سيّدنا نور محمّد
الْبَدَوَانيّ؛
إلى سيّدنا
حبيب الله
مظهر؛ إلى
سيّدنا عبد
الله
الدهلويّ؛
إلى سيّدنا
خالد العثمانيّ؛
إلى سيّدنا
الجد محمّد
الخانيّ؛ إلى
سيّدنا
الوالد محمّد
الخانيّ«.[314]
أمّا
زَعْمُ
النقشبنديّين
بأنّ
طريقتَهم
هكذا تسلسلتْ إليهم
من لدن رسول
الله r إلى
آخر شيوخهم في
كلّ عصر، فإنّه
كلام باطل لا
يُعتدّ به،
ولا يستحقّ
النظر فيه.
فقد وردت على
لسان بعض
شيوخهم
بالذات
كلماتٌ شبه
اعتراف بهذه
المزعمة. ألا
وهو الشيخ
قسيم
الكُفْرَويّ،
الّذي احتلّ مكانًا
مرموقًا بين
جموعٍ كبيرةٍ
من النقشبنديّين،
ونال شهرةً
واسعةً، وقضى
حياته في دراساتٍ
وبحوثٍ
علميّةٍ
بجانب ما
حَظِيَ من المكانة
بين رجالات
السياسة
والثقافة
طوال خمسين عاماً
في تركيا.
يقول
الكُفْرَويّ
في رسالته
الّتي حصل بها
على شهادة
الدكتوراه
عام 1949م.
بجامعة
إسطنبول،
يقول، » إنّ
أقدمَ
الأسانيدِ
للسّلسلةِ
بين الصوفيّة،
هو إسنادُ
جعفر الْخُلْدِي.«[315] ذلك
يعني أنّ
سلسلتهم
منقطعة
الأسانيد
قبله. هذا،
إذا كان الغرض
من إسناد الْخُلْدِيِّ
هو السلسلةَ النقشبنديّة
خاصّة بغضّ
النظر عن
سلاسل بقيّة
الطرق
الصوفيّةِ.
وقد يكون
الغرض عامًّا.
فيتّفق إذًا
جميعهم على
هذه المزعمةِ.
وعلى
الرغم من هذا
الاعتراف، فإنّه
لا يستقيم مع
الواقع
التاريخيِّ.
إذ أنّ الطريقة
النقشبنديّة
لم تكن قد
تكوّنتْ بعدُ
في أيّام جعفر
الْخُلْدِيِّ.
وذلك أيضًا
بإقرارٍ
صريحٍ من قسيم
الكُفْرَويّ
نفسِهِ إذ
يقول:
»بما
أنّ تاريخَ
التأسيس
للطريقة النقشبنديّة
قد تمّ
إثباتُهُ
بالاعتماد
على المصادر
الموجودةِ،
أنها قد
تكوّنت في عهد
الغزنويّين؛[316] فقد ثبت
أنّ الطريقة
إنّما اكتسبتْ
طابِعَها
الحقيقيَّ
منذ حكم هذه
السلالة. ولذا
أصبحتْ
التطوّرات
الّتي مرّتْ
بها الطريقة
منذ البداية
حتّى عهد يوسف
الهمدانيّ هي
الموضوعُ
الأساسيُّ
للدراسة.«[317]
هكذا
انقشع الظلام
عن أسرارهم
بإقرارهم واعترافهم
على لسان
شخصيةٍ من
أعلم
رجالاتهم المشهورين
في العصر
الحاضر،
وَكَفَى
اللهُ
الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ.
***
*
الروحانيّون.
الروحانيّون
في هذه
الطريقة
المعروفون بـ»رجال
السلسلة«؛
شخصيّاتهم،
ومستوياتُهم العلميّة
والاجتماعيّة،
ومعتقَداتُهم،
واتجاهاتُهم،
وترجمةُ أحوالِهم
بالتفصيل.
إنّ
من أصول
الطريقة النقشبنديّة،
أخذُ العهد
على المريد؛
أى إدخالُه في
سلك هذه
المنظمة
الصوفيّة. وهو
من أكبر مهامّ
شيخ الطريقة
في كلّ بقعةٍ
ينشرون فيها دَعْوَتَهُمْ
منذ أن شرعوا
هذا المبدأ
لمذهبهم. وعلى
هذا الأساس
يدّعي كلّ
مَنْ تصدّى
لمشيخة هذه
الطريقة إنّه
أخَذَ
الإجازةَ
والرُّخْصَةَ
للقيام بهذه
المهمّةِ كما
يقول محمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ:
»قد
تشرّفتُ بأخذ
العهد
والإجازة
بالتوجّه ثم
بالإرشاد
وتلقين الذكر
بعد السلوك
أعوامًا في
الطريقة النقشبنديّة
عن القطب
الأرشد
والغوث
الأمجد شيخنا
وأستاذنا
الشيخ عمر...
إلخ«؛
ويعدّد أسماء
رجال السلسلة
الّذين
ذكرناهم
أنفاً؛
يعدّدهم واحدًا
بعد واحدٍ
بالتصعيد على
غرار سلسلة
الرواة عند
المحدّثين،
حتّى ينتهي
إلى اسم أبي بكر
الصدّيق رضي
الله عنه،
فيقول، »وهو
عن النبيّ r.[318]«
يظهر
اعتقادهم من
خلال هذه
الصيغة بصورة
واضحة، أنّ
الرسول u، هو
الّذي بنى
أساسَ
طريقتهم، ونَفَخَ
سرَّها في روع
أبي بكر {إِذْ
هُمَا فيِ
الْغَارِ، إِذْ
يَقوُلُ
لِصَاحِبِهِ
لاَ تَحْزَنْ
إِنَّ اللهَ
مَعَنَا}[319]
كما يؤكّد ما
جاء في
الحدائق الورديّة
لعبد المجيد
بن محمّد
الخانيّ،
أنّهم على هذا
المعتقد من
غير شَكٍّ. إذ
يقول الخانيّ:
»ثُمَّ
سَرَى هَذَا
السِّرُّ،
وتحوّل من
إمام الأمم
رسول الله r
إلى خليفتهِ
الأوّلِ،
ومَنْ عليه في
الدين
والدنيا
المعوَّل، سيّد
سادات
الطريقة
الإمام أبي
بكر الصديق
رضي الله عنه«.[320]
لابدّ
وأن نتساءل
هنا: أنّ
النبيَّ u، ما
دام هو الّذي
قد بَنَى أسَاسَ
الطريقةِ النقشبنديّة،
ووَضَعَ اللّبِنَةَ
الأولى
لتكوينها -
على حدّ زعمهم
واعتقادهم - فهل
ثبت عنه u أنّه
قد نطق حتّى
بكلمة
التصوّف ولو
مرةً واحدةً في
حياته
الشريفةِ،
بغضّ النظر عن
أن يكون قد تحدّثَ
عمّا ابتدعتْهُ
الصوفيّةُ
عامةً والنقشبنديّة
خاصّة من
رموزٍ
ومصطلحاتٍ
ومبادئَ
وآدابٍ
وأذكارٍ
ومفاهيمَ،
حشوا بها بطونَ
ركامٍ من
الكتب! وهل
شهد شاهدٌ من
أهل العلم
والثقة
والإيمان والأخلاق
والإخلاص،
أنّ رسول الله
r
قد تكلّم عن
الطريقة النقشبنديّة
أو عن أدنى
شيء من أصولها
وآدابها؛ كـ»الرّابطة«،
و»الختم
الخُوَاجَگَانِيَّةِ«،
وعدِّ الأوراد
بالحصى،
والجلوسِ بعكسِ
التورّك في
الصلاة،
والاستمدادِ
من روحانية
الموتى،
والتبرُّكِ
بقبورهم؛ وهل
ورد شيءٌ من
مصطلحاتهم الفارسيّة
ولو في حديث
واحد من تلك
الأحاديث
الموضوعة المكذوبة
على لسان
الرسول r،
فضلاً عن
الصحاح؟!
إذًا
فما حجّة
النقشبنديّين
فيما يدّعون
بدون تأمّل -:
أنّ سرَّ
طريقتهم قد
انتقل من رسول
الله r إلى
خليفته أبي
بكر الصديق؟
ولماذا
يجعلون أبا
بكر هو الحلقة
الأولى من
سلسلتهم،
فيحتاطون أن
يبدأوا
بالنبيّ u؟ أم
يحذرون من أن
ينـزلوا به منـزلة
صوفيٍّ خاملٍ
متـزمّت!
حاشا
رسولِ الله r
أن يوصَفَ بما
ينافي جلالةَ
قدرهِ؛ بل »كان خلقه
القرآن.«[321] وقد
خاطبه الله
تعالى بقوله
{وَإِنَّكَ
لَعَلىَ
خُلُقٍ
عَظيِمٍ.}[322] وكتاب
الله بين
أيدينا؛ وهو
العروة
الوثقى، والحبل
المتين،
والبرهان
المؤيّد،
والشاهد
المجسّد
الّذي يخبرنا
من خلال
إعجازه وتصويره
وإيجازه
وتفصيله وعكوسه
النورانيِّ
على مدى كرامة
الرسول r،
وشرفه العظيم
ومهمّته
العالية،
ورسالته الخالدة،
وقلبه الطاهر
وسلوكه
الربّانيّ الرفيع،
وشخصيته
الفذة الّتي
ملأت
العالمين بأخبارٍ
وآثارٍ
وأنوارٍ
وأطوارٍ لا تسعها
كتب
الصوفيّةِ؛
ولا تدنو من
ساحل بحره المحيط
عقولهم. {ذَلِكَ
مَبْلَغُهُمْ
مِنَ
الْعِلْمِ،
إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ
أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ سَبيِلِهِ
وَهُوَ
أَعْلَمُ
بِمَنِ
اهْتَدىَ.}[323]
فهو -
عليه أفضل
صلوات الله
وأتمّ
تسليماته - في
الحقيقة برئٌ كلّ
البراءة من أنْ
يَكُونَ هُوَ
الَّذِي نفخ
سرَّ الطريقة النقشبنديّة
في روع أبي
بكر الصدّيق
رضي الله عنه.
ولا يكاد يصدّق
هذه المقولة
أحد اطّلع على
شيء من سيرته الطيبةِ
وعرف مضمونَ
النبوة
ومفهومَ
الرسالة؛
خاصّة فانّ
سيّدنا
محمّدًا r هو
أفضل النوع
البشريِّ
وأعظمه
وأكرمه؛ اصطفاه
الله لحمل آخر
رسالاته فقال
له: {ثُمَّ جَعَلْنَاكَ
عَلىَ
شَريِعَةٍ
مِنَ
الأَمْرِ
فَاتَّبِعْها،
وَلاَ
تَتَّبِعْ
أَهْوَاءَ
الّذينَ لاَ
يَعْلَموُنَ.}[324] فهو - لا
شكّ - أجلُّ من
أن يفهمه
الطائشون
المفتتنون
بعقائد
الهنود،
المتربصون في كلّ
مُعترك
بذريعة
الانتساب
إليه.
***
سلسلة
أسماء الّذين
يزعم
النقشبنديّون
أنّ طريقتهم
انحدرت بوساطتهم.
* الحلقة
الأولى من هذه
السلسلة:
يتشبّث
النقشبنديّون
بأبي بكر
الصدّيق رضي
الله عنه، على
أنّه هو
الحلقة
الأولى من
سلسلة
رجالهم؛
ويزعمون » أنّ
أَلْقَابَ
السلسلة
تختلف
باختلاف القرون«[325] وأنّ
طريقتَهم
كانت تسمّى »الطَّرِيقَةَ
الصِّدِّيقِيَّةَ«
في مرحلتها
الأولى،
بدايةً من عهد
أبي بكر الصديق
رضي الله عنه
إلى عهد أبي
يزيد
البسطاميّ.
وهو الحلقة
الخامسة من
هذه السلسلة
عندهم.
أمّا
هذه التسمية،
لا شكّ في أنّها
وضعٌ محضٌ؛ لا
برهان لهم في
إسنادها إلى
أبي بكر
الصدّيق. ولا
في نسبتها
إليه قيمةٌ علميةٌ
أو دينيةٌ.
لأنّ التصوّف
لم يكن له أيّ
أثرٍ في حياة
الصحابةِ
رضوان الله
عليهم أجمعين.
وإنّما كانوا
في سلوكهم
وتعبُّدهم،
وسعيهم
ومعاشهم في
جميع مجالات
الحياة
يقتدون برسول
الله r؛
ويسيرون على
هديه لا
محالة. وكانوا
كما وصفهم
الله في آخر
سورة الفتح
بقوله تعالى
{وَالّذينَ
مَعَهُ
أَشِدَّاءُ
عَلىَ الْكُفَّارِ
رُحَمَاءُ
بَيْنَهُمْ
تَرَاهُمْ
رُكّعًا
سُجَّدًا،
يَبْتَغوُنَ
فَضْلاً مِنَ
اللهِ
وَرِضْوَاناً،
سيِمَاهُمْ فيِ
وُجوُهِهِمْ
مِنْ أَثَرِ
السجوُدِ.}[326] ويقول
سبحانه فيهم
أيضًا
{فَالّذينَ
آمَنوُا بِهِ
وَعَزَّروُهُ
وَنَصَروُهُ
وَاتَّبَعوُا
النوُرَ الّذي
أُنْزِلَ
مَعَهُ
أوُلَئِكَ
هُمُ الْمُفْلِحوُنَ.}[327] ويقول
تعالى فيهم
أيضًا
{وَالّذينَ
تَبَوّؤوُا
الدارَ
وَالإيِمَانَ
مِنْ
قَبْلِهِمْ يُحِبّوُنَ
مَنْ هَاجَرَ
إِلَيْهِمْ
وَلاَ
يَجِدوُنَ
فيِ
صُدوُرِهِمْ
حَاجَةً مِمَّا
أُوتوُا،
وَيُؤْثِروُنَ
عَلىَ
أَنْفُسِهِمْ
وَلَوْ كَانَ
بِهِمْ
خَصَاصَةٌ.}[328] كانت
حياتهم
الروحيّة
محدّدةً
بضوابط الوحي
وإرشادات
الرسول r؛
فلم يكن من
شأنِ أحدِهم
أن يزيدَ في
دين الله
شيئًا، أو
يُلغِيَ منه
شيئًا أصلا.
فقد مُثِّلَ
التزامهم
التامُّ في
بيتٍ من تلك
القصيدة
المشهورة
الّتي
تَغَنَّى بها
أهلُ المدينة
يوم طَلَعَ
الْبَدْرُ
عليهم من ثنيّات
الوداع. وهذا
قولهم:
وَتَعَاهَـدْنَا
جَمِيعًا
يَوْمَ
أَقْسـَمْنَا
الْـيَمِين،
لَنْ
نَخُونَ
الْعَهْدَ
يَوْمًا
وَاتَّخَذْنَا
الصدْقَ دِين.
ومن
الحجج
الدامغة على
النقشبنديّين،
عجزُهم عن
إقامة أدنى
دليلٍ على أنّ
أبا بكر
الصدّيق قد
نطق بكلمة »التصوّف«
ولو مرةً
واحدةً على
مدى حياته؛
فضلاً عما إذا
كان له علم بالنقشبنديّة
وعقائدها
وتعاليمها
وطقوسها.
أمّا
حياة أبي بكر
الصدّيق رضي
الله عنه، فإنها
غنيّةٌ عن
الشرح لكثرة
ما في بطون الكتب
من سيرته
الطيّبة
الحسنة،
وشهرته الواسعة
بزهده وتقواه
وبطولاته
الخالدةِ
وشجاعته
وافتدائه في
سبيل الله،
وعقله الراجح
في السياسة
والتعامل. وهو
من السابقين
الأوّلين في
الإسلام.
صَحِبَ رسولَ
الله r
بصدقٍ
وأمانةٍ في
جميع
المواقف،
وآزره ونصره وذاقَ
ألوانًا من
العذاب على
ذلك، وشهد معه
المشاهد
كلَّها، وثبت
في صفوف
القتال
بجانبه،
واحتلَّ مقامَه
في القيادة
والرياسة
للأمة بعد
وفاته. هذا هو
أبو بكر
الصدّيق
الصحابيُّ
الجليل رضي الله
تعالى عنه.
فإنّه
برئٌ من أن
يتصوّره
الإنسان على
هيئة صوفِيٍّ
جامدٍ صامتٍ
مُطَأْطِئٍ
ومقبّعٍ على
نفسه. بل إنّه
بصفته رئيس
الدولة الإسلاميّة
بعد النبيِّ r،
كان في حركةٍ
دائبةٍ
ونشاطٍ
مستمرٍّ.
حملَتْهُ
مهمَّتُهُ
العاليةُ
ومسؤوليّتُهُ
العظيمةُ أن
يخوضَ مثار
الأحداث، وأن
يكون على أُهْبَةِ
الاستقبال
لأيِّ
تطوُّرٍ قد
يحدث. لذا فهو
بعيد كلّ البعد
عما يتصوّره
النقشبنديّون
من الشخصية الصوفيّة
فيه. في
الحقيقة ليس
بينه وبين تلك
الشخصية
المختلَقَةِ
وجه من
المشابهة؛
ولا وجود
لصلةٍ تربط
بينه وبين
النقشبنديّين؛
ولا يتعدّى
زعمُ شيوخِ
هذه الطائفةِ
في نسبتهم إليه
عن زعم
الرافضة في
نسبتهم إلى
أمير المؤمنين
عليّ بن أبي
طالب كرّم
الله تعالى
وجهه. وَمَثَلُهُمْ
في هذا
الإنتماء
المزعوم كَمَثَلِ
الوهّابيّين
في انتمائهم
إلى الأمام
الجليل أحمد
بن حنبل رضي
الله عنه وإلى
العلاّمةِ
ابن تيمية
الحرانيِّ
عليه الرحمة
والرضوان، وهم
في الحقيقةِ أبعد
الناس عنهما!
***
* الحلقة
الثانية من
سلسلتهم.
يَعُدُّ
النقشبنديّون
سلمانَ
الفارسيَّ رضي
الله عنه هو
الحلقةَ
الثانيةَ من
سلسلة ساداتهم.
وهذه من
ميّزات الفرق
الباطنية.
فكلّ فرقةٍ
منها إمّا
تدّعي
النسبةَ إلى
شخصيةٍ بارزةٍ
من الصحابة،
أو إلى آل بيت
النبيّ الطاهرين،
لتخفي بهذه
النسبةِ
الزائفةِ
حقيقتها
ومكائدها.
يقول
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ في
الحدائق الورديّة
»ثمّ
تلقّى سرّ هذه
النسبة
الشريفة منه
(أي من أبي بكر
الصدّيق )
سيّدنا سلمان
الفارسيّ رضي الله
عنه.«
استرسل
الخانيّ في
قصّة حياته
العجيبة وما كان
عليه قبل
الإسلام وكيف
اعتنق المسيحية
بعد أن كان
مجوسيًّا في
شبابه. وذكر ما
ذكر من أيّام
إقامته عند
عددٍ من
القساوسة في
الشام والموصل
ونصيبين
والعمّورية؛
ثم قصَّ
إسلامَه وبقيّة
حياته في
الإسلام
بالتفصيل؛
نقلا من رواية
أبي الفرج »بسنده إلى
ابن عباس رضي
الله عنهما.«[329] حتّى
إذا أقترب من
نهاية كلامه
قال »ثم
توفّي رضي
الله عنه،
وذلك سنة ستٍّ
وثلاثين، أو
أربعٍ
وثلاثين في
داء البطن في
المدائن في
خلافة عثمان
رضي الله عنه؛
وعمره مائتان
أو ثلاثمائة
وخمسون سنةً.
أمّا الأوّل،
فعليه عند
المؤرّخين
المعوّل.«[330] ولم
يذكر لنا أسماء
هؤلاء
المؤرّخين.
ولا شكَّ في أنّ
هذا القول لا
يستقيم، إذ فيه
مبالغة
يستغربها أهل
العلم
والخبرة، كما
نستغرب نحن : أنّ
الخانيّ لم
يذكر شيئًا
حول تلقّي هذا
السر الّذي
سرى إلى سلمان
الفارسيّ من
أبي بكر
الصدّيق،
وكيف أصبح
نقشبنديًّا أو
صوفيًّا؛ بعد
أن كان
صحابيًّا
جليلاً، وربما
لم يسمع في كلّ
حياته
الطويلة من
أحدٍ نَطَقَ
بكلمة التصوّف،
فضلاً عن النقشبنديّة
ومصطلحاتها الفارسيّة
على الرغم من أنّه
كان فارسيَّ
الأصل! وهل
كان يتعبّد
على أساس الرّابطة،
والختم
الخُوَاجَگَانِيَّة،
وعدِّ
الأوراد
بالحصى؛ وهل
كان يعلم شيئًا
حول عقيدة
الفناء والبقاء
والأويسية
وما إلى ذلك
من تعاليم النقشبنديّة
وفلسفتها
وطقوسها...
يتبيّن
من هذا أيضًا،
أنّ نسبة
سلمان الفارسيِّ
إلى هذه
السلسلة
باطلة؛ لا
برهان لهم في
إثباتها
بصورة قطعية.
***
* الحلقة
الثالثة من
سلسلتهم.
ورد
في عددٍ من
كتابات
النقشبنديّين
أنّ القاسم بن
محمّد بن أبي
بكر الصدّيق،
هو الحلقة
الثالثة من سلسلة
ساداتهم.
ويعتقدون »أنّه تلقّى
سرّ هذه
النسبة« من سلمان
الفارسيِّ.
وهذا يعني
بتعبيرٍ آخر: أنّ
القاسم رضي
الله عنه
يُعَدّ من
الصوفيّة. بينما
تشهد الوثائق أنّه
كان فقيهًا
جليلاً من
أولئك السبعة
المشهورين
بالعلم
والفضل.[331]ولم
يتمكّن
النقشبنديّون
من الاستناد
إلى أيّ دليل
على أنْ يكون
القاسم قد
انخرط في صفوف
منظّمةٍ
باطنيّةٍ
سرّيةٍ، كما
لم تكن الطريقة
النقشبنديّة
قد خرجت في
عهده إلى
حَيِّزِ
الوجود بعدُ.
ولا نجد في
كتبهم أنّه
أقرّ شيئًا من
تعاليمهم
ومصطلحاتهم وطقوسهم
بما فيها »السلسلة«.
وهذا أمر في
منتهى
الغرابة. لذا
تعمّد النقشبنديّون
الإغضاء عن
نسبة شيء من
تعاليمهم إليه.
بل اقتصروا
على مدحه أنّه
»العالم
المفتيُّ
الفقيه الورع
الزاهد الحجّة
النبيه...إلخ.«[332] وهذا لا
يختلف فيه
معهم أحد من
أرباب البحث والخبرة
بين أهل
السّنّة
والجماعة.
وردت
ترجمة القاسم
بن محمّد في
وفيات
الأعيان لابن
خلّكان[333] كما
وردت في مصادر
أخرى، وهي
خالية تمام
الخلوّ من كلّ
ما أُسندَ
إليه من أنّه
تلقّى سرّ
الطريقة أو
التصوّف من
سلمان الفارسيّ
وما يتبع هذا
الإسناد من
احتمالات
أخرى؛
كالتعبّد على
أساس
الرّابطة،
والختم
الخُوَاجَگَانِيَّة،
والتمرينات
اليوغية وما
إليها.
* الحلقة
الرابعة من
سلسلتهم.
يعتقد
النقشبنديّون:
أنّ الإمامَ
جعفرَ الصادقَ
بنَ محمّد
الباقر هو
الحلقة
الرابعة من
سلسلتهم؛ كما
أشار إلى ذلك
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ
بقوله »ثُمَّ
سَرَى سِرُّ
هذه النسبةِ
الشريفةِ - أي
من القاسم بن محمّد
- إلى شبله
سيّدنا جعفر
الصادق.«[334]
ويبالغون في
تعظيمه
بأوصافٍ
يستبشعها أهل
المروءةِ
والإيمان.
والشِّبْلُ
اسمٌ
يُطْلَقُ على
ولد الأسدِ. تَنَطَّعَ
الخانِيُّ
بمثل هذا
الاستعمال المجازيّ
تنويهًا إلى
الْقرابة الرحميّةِ
بَين جعفر بن محمّد
الباقر وقاسم
بن محمّد بن
أبي بكر
الصّدِّّيقِ.
ذلك لأنّ
جعفر، أمَهُ
هي: أمُ فروة
بنتُ القاسم
بن محمّد بن
أبي بكر
الصديق. وَأُمُّهَا
-أي جدتُهُ من
قِبَلِ أمهِ -
هي أسماءُ
بنتُ عبد
الرحمن بن أبي
بكر الصديق
رضي الله عنهم
أجمعين ، فإذا
كان هذا أصلُهُ
والصّدّيقُ
جدهُ من
الجهتين فلا
يتصورُ في
مثلِ جعفر بن محمّد
-وهو مَنْ هو
في دينهِ
وقربهِ من
الدَّوحَةِ
النبويّة
الشريفةِ- أن
يكون
رجلاً
صوفِيًّا
نقشبنديًّا
يتعبّدُ على
أسلوبِ مجوسِ
الهندِ بطريق
الرابطةِ والختم
الخُوَاجَگَانِيَّة،
وعدِّ الأوراد
بالحصى
وأمثالها من
أشكال مناسك
الباطنيّة
الحشّاشينَ.
يواصل
الخانيّ
طريقَتَهَ
المزخرفَةَ
وكلماتِهِ
الْمُسَجّعَةَ
في وصف جعفر
بن محمّد بقوله
»ناهيك
بإمامٍ وَرَثَ
مَقَامَ
النبُوَّةِ
والصدّيقية،
فازدهرتْ في
طلعته أنوار
العلوم
والمعارف
الحقيقية.«[335]
لا
شكّ أنّ
عامّةَ أهل
الإسلام
يذكرون هذه
الشخصيّة
الكريمة
بالثناء عليه
والرحمة له من
الله، وينظرون
إليه بعين
التوقير
والإجلال.
ولكنّ أهلَ
العلم والبحث
لم يعثروا على
أدنى شيء يبرهن
على إنتمائه
إلى فرقةٍ من
الفرَقِ
الصوفيّةِ. ولا
أثبتَ أحدٌ أنّه
تكلّم في التصوّف
ومصطلحاته؛
أو تعبّدَ على
نحو ما يتعبّد
بِهِ النقشبنديّونَ،
كَترديد لفظة
الجلال خمسة
آلاف مرّة يوميًّا،
أو إجراءها
على القلب
بدون تلفّظٍ
بها، أو التركيز
على جسمٍ أو
صورةٍ...إلخ.
في
الحقيقة أنّ
الإمام جعفر
الصادق رضي
الله عنه، لم
يرد في ترجمته
أنّه كان يعلم
شيئًا عمّا
يمارس
النقشبنديّون
من هذه
الأمورِ وما
اختلقوها من
مفاهيم
دجليّةٍ؛
كالأويسيّة،
والفناء،
والبقاء،
والاستمداد
من روحانيّةِ
الشيوخ، وما
إلى ذلك من
بِدَعٍ
وخرافات
وقصصٍ
بهلوانيّة
باسم الكرامات
على كثرة ما
قد تُرُجِّمَ
لَهُ.[336]
***
*
الحلقة الخامسة
من سلسلتهم.
يزعم
النقشبنديّون
أنّ أبا يزيد
طيفور بن عيسى
بن آدم بن
سروشان
البسطاميّ هو
الرجل الخامس
من سلسلتهم.
وبسطام، »يقال
انها أوّل
بلاد خراسان
من جهة العراق
وقومس.«[337] »كان
جدّه
مجوسيًّا ثم
أسلم«[338] ويغلب
أنّ الخلط
والتذبذب
الّذي يظهر في
مقاطع من كلامه
يبرهن على
تأثير أسلافه
المجوس. لأنّ
تأثير
المعتقدات والعادات
والتقاليد قد
يستمرّ عبر
حياة الأسرة
ويتسرّب إلى
طبقاتٍ من
أجيالها؛ ولو
اعتنق
الأحفادُ
معتقداتٍ
جديدةً تختلف
عما كان عليه
آباؤهم
الأولّون.
وقد
يكون أستاذه
أبو علي
السندي[339] هو
الّذي أوقعه
فيما جعل بعضُ
الباحثين
يرمونه
بالزندقة. ومن
هؤلاء الباحثين،
عبد القادر بن
حبيب الله
السنديّ. فقد
نقل عن طبقات
الأولياء
لابن ملقّن
مقاطع من
مقولات
البسطاميّ؛ ينتقده
تارةً
بالمخالفة
الصريحة
لسنّة رسول الله
r؛
وتارة يشنّع
عليه تمسّكه
بالرهبنةِ؛[340] وتارةً يحمل
قوله على
الكفر
والإلحاد
والزندقة؛
واستقى من »البداية إلى
النهاية« للإمام
ابن كثير، ومن
»الميزان«
للإمام
الذهبي. حيث
ينقل بعضهم عن
بعضهم في هذه
المصادر أنّه »حُكِيَ عن
البسطاميّ
شطحاتٌ
ناقصات. وقد
تأوّلها كثير
من الفقهاء
والصوفيّة،
وحملوها على
محامل بعيدةٍ.
وقال بعضهم: إنّه
قال ذلك في
حال الإصطلام
والغيبة. ومن
العلماء مَنْ
بدّعه
وخطّأه، وجعل
ذلك من أكبر
البدع، إنّه
تدلّ على
اعتقاد فَاسِدٍ
كَامِنٍ في
القلب، ظهر في
أوقاته والله
أعلم.«[341]
يعتقد
النقشبنديّون
فيه إنّه
سلطان
العارفين،
وينقلون عنه أنّه
قال: »سبحاني
ما أعظم شاْني.«[342]
يقول
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ »كان
أبو يزيد
البسطاميّ
يشير عن نفسه أنّه
قطب الوقت.«[343] غير أنّ
له مقولة
تبرهن على حسن
اعتقاده
وكمال معرفته
ومتانة
أسلوبه على
طريقة أهل
العلم في
توضيحه لمعنى
التكبير. فقد
قيل عنه - إذا
صحّ - »إنّه
سمع رجلاً
يكبّر. فقال:
»- ما معنى
الله أكبر؟
قال:
-
الله أكبر من كلّ
مَنْ سواه.
فقال أبو
يزيد:
- ليس
معه شيء فيكون
أكبر منه! قال:
- فما
معناه؟ قال:
-
معناه: الله
أكبر من أن
يقاس بالناس،
أو يدخل تحت
القياس، أو
يدركه
الحواسّ.«[344]
لعلّ
أقواله
الموافقة
لحدود الكتاب
والسّنّة
وَرَدَتْ عنه
قبل أن يفارق
العلماء ويتّصل
بالصوفيّة.
وعلى الرغم من
كلّ ما
أُسْنِدَ
إليه من الحقّ
والباطل لم
يثبت عنه
بدليلٍ قاطعٍ أنّه
ادّعى
الأويسيّة،
ولا أنّه
تعبّد على
أساليب النقشبنديّة؛
كالعمل
بالرّابطة،
والختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
وتعداد الذكر
بالحصى
وأمثالها...
ولو كان قد
عمل ذلك، وثبت
عنه، لذكروه
في كتبهم
بالذات على
سبيل الحجّة.
كما لم يثبت
عنه شيء يدلّ
على إنّه أقرّ
سلسلة
الطريقة. ولكن
المؤلّف يقول »وهو أويسيّ
التربية. فإنّه
ربّته
روحانية
سيّدنا جعفر
الصادق. ووصل إليه
هذا السِّرُّ
الجليلُ منه
بالروحانيّة -
كما قدّمنا -
لأنّ سيّدنا
جعفر، كانت
وفاته سنة
ثمانٍ
وأربعين
ومائة. وهي
قبل ولادة أبي
يزيد بنحو
أربعين سنةً
كما رأيتَ.
ثمّ إنّ كلّ
مَنْ ربّته
روحانية أحد
السادات،
يقال له أويسيٌّ؛
نسبةً لسيّدنا
أويس القرني،
سّيد
التابعين. فإنّه
على القول
بوجوده وهو
الصحيح
المؤيّد
بالأدلة
المعتبرة
والكشف الصريح؛
ربّته
روحانية سيّد
العالمين
بالخصوص.«[345] يبدو
أنّ هذا
الرأْيَ
اختلقه بعض
النقشبنديّين
على حساب
الآخرين دون
علمهم،
فتقوَّلَ على
لسان كلّ من
جعفر الصادق
وأبي يزيد
البسطاميّ في
دعوى هذه
النسبة
بينهما. وهذا
برهانٌ قاطعٌ
على المستوى
الأخلاقيّ
الّذي يتميّز به
أفراد هذه
الطائفه،
حتّى
المتعلّمون
منهم.
يزعم
النقشبنديّون:
أنّ طريقتهم
تسمّتْ بـ»الطيفورية«
بدايةً من عهد
أبي يزيد
البسطاميّ
إلى زمن عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ؛
نسبةً إلى
اسمه (طيفور).
بيد أنّ هذه
التسميةَ غير
مُوَثَّقَةٍ.
إذْ أنّ كلاًّ
من هذين اللّقبين:
»الصدّيقيّة«
و»الطيفورية«،
لم يرد ضمنَ
تراجم
الشخصيتين
المقصودتين بهما
على الإطلاق.
أمّا
التقدير،
بأنّهما كانا
على أدنى شيء
من العلم
بنسبة
الطريقة النقشبنديّة
إليهما أو
نطقا بهذين
اللّقبين، أو
حتّى سمعا
بهما، فانّ
ذلك باطل
إطلاقاً؛ لن
يملكَ أحدٌ من
عقلاء النقشبنديّة
الجرأةَ على
الدفاع عن هذه
الدعوى
الواهية إلاّ
الجاهل منهم !
لقد
ثبت هكذا
واتّضح مرةً
أخرى وبهذه
الصراحة،
أنّهم قد
أضافوا إلى
تعاليم الدين
مالا يُحصى من
مفاهيمَ
ومصطلحاتٍ
وعقائدَ
اقتبسوها من
دياناتٍ
مختلفةٍ لا
صلة لها
بالإسلام؛
كما قد ألغوا مبادئ
هامةً من
أصوله
وأبطلوها؛
وخالفوا مبدأ
التوقيفية في
الإسلام، وتصرّفوا
فيه بدون
حدود. كذلك
ابتدعوا
أسماءَ
جديدةً،
ومصطلحاتٍ
غريبةً كُلَّمَا
وجدوا لذلك
مساغًا من
تلقاءِ
أنفسهم. وتقوّلوا
على بعضهم
البعض؛ بل وحتّى
على النبيّ r،
ومن يليه من
الصحابة
والتابعين
رضوان الله عليهم
أجمعين؛ كإسْنَادِهِمْ
الطريقةَ النقشبنديّة
إلى الصحابة
والتابعين؛
وادِّعَائِهِمْ:
»إنّ
طريقة السادة النقشبنديّة
هو معتقدُ أهلِ
السّنّةِ
والجماعةِ.
وهي طريقة
الصحابة رضي
الله عنهم على
أصلها، لم
يزيدوا فيها،
ولم ينقصوا
منها.«[346]
هكذا
فقد دخل
النقشبنديّون
في دوّامةٍ
خطيرةٍ حارتْ
العقولُ من
أمرهم.
***
* الحلقة
السادسة من
سلسلتهم.
تزعم
النقشبنديّة
أنّ أبا الحسن
على بن أبي
جعفر الْخَرَقَانِيّ
هو الحلقة
السادسة من
سلسلتهم. يقول
عبد المجيد بن
محمّد الخانيّ،
»ثمّ
تلقّىَ سرَّ
هذه النسبةِ
الشريفةِ من
سيدِنا أبي
يزيد أيضًا
بالروحانيّة،
سيّدُنا أبو
الحسنِ الْخَرَقَانِيُّ«[347] »وهو
أويسيُّ
التربية،
رَبَّتْهُ
روحانيةُ سيّدَنا
أبي يزيد
البسطاميّ«[348]
ينقلون
عنه أنّه قال: »أطلب
القصّةَ
لتظهر الدموع.
فإن ّالله يحب
الباكين.«[349] هذه
الكلمة
تُذَكِّرُنا
بقوله تعالى
{فَلْيَضْحَكوُا
قَليِلاً
وَلْيَبْكوُا
كَثيِرًا
جَزَاءً
بِمَا
كَانوُا
يَكْسِبوُنَ.}[350] وذلك
إذا كان غرضه
من القصّة ما
لا يتعارض مع الروح
القرآنيِّ.
وينقلون
عنه أيضًا أنّه
قال »كلّ
شيء يطلب
العبدُ به
اللهَ،
فالقرآن أحسن
منه؛ فلا
تطلبوا الله
إلا به«. وهذه
كلمة حق.
فيبدو من هذه
المقولات،
أنّ الشيخ أبا
الحسنِ الْخَرَقَانِيَّ
كان رجلاً من
الصالحين
بخلاف مَنْ
تصفه النقشبنديّة
من الشيوخ
الروحانيّين.
ويحتمل أنهم
قد طمعوا في
استغلال
شهرته
فأضافوا اسْمَهُ
إلى أسماء
مشائخهم دون
أن تكون له
علاقة بهذه
الطريقة. إذ
أنّ الطريقة النقشبنديّة
لم يكن لها
وجود في
زمانه. ويغلب أنّه
من أصلٍ
فارسيٍّ كأبي
يزيد
البسطاميّ.
قيل إنّه
عاصر السلطانَ
الْغَزْنَوِيَّ
محمودَ بْنَ سُبُكْتَكِين،
ونال محبّتَهُ
وتوقيرَهُ.
إلاّ أنّه غير
مذكور في
المصادر
الْمُعتَبَرَةِ
لِسِيَر
الأعلام
وتراجم الرجال.
ولم يذكره
القشيريّ في
رسالته ضمنَ
الأعلام وهو
معاصره. وقد
ذكر
البسطاميَّ؛
(وهو شيخ الْخَرَقَانِيِّ
في اعتقاد
النقشبنديّين).
وبخاصّةٍ
فإنّ أبا القاسمِ
الْقُشَيْرِيَّ
هو أستاذ أبي
علي الفضل محمّد
الفارمديّ
الّذي يدّعي
النقشبنديّون
أنّه تتلمذ
على أبي الحسن
الْخَرَقانِيّ
في الوقت
ذاته، وصار
خليفتَهُ في
الطريقة!
كلّ
هذه
المُعطيَات
الّتي تبرهن على
تعارضٍ رهيبٍ
في أقوال
النقشبنديّين
ودعواهم في
نسبة طريقتهم
إلى أشخاص، لم
تكن فكرةُ النقشبنديّة
ولا شيءٌ من
تعاليمها
موجودةً في
عهدهم، تدلُّ
في الوقت ذاته
على أنّه لو
كان لأبي
الحسن الَخَرَقَانِيِّ
وجودٌ
حقيقيٌّ،
لذكره
المصنّفون
ضمنَ تراجم
الأعلام،
وعلى رأسهم
القشيريُّ.
لذا
قد يكون هذا
اسمًا
مُخْتَلَقًا
لشخصيّةٍ
خياليّةٍ لا
حقيقة لها.
وهذا يؤكّد
أيضًا على مدى
زعم
النقشبنديّين
في دعواهم عن
صحّةِ هذه
السلسلةِ.
***
* الحلقة
السابعة من
سلسلتهم.
يزعم
النقشبنديّون
أنّ أبا عليّ
الفضل بن محمّد
الفارمديّ هو
الحلقةُ السابعةُ من
سلسلتهم،
وأنّه »تلقّىَ
سرَّ هذه
النسبة من أبي
الحسن الخرقانيّ.«[351]
ورد
في بعض
المصادر »أنّه
صَحِبَ
القشيريّ،
وأخذ عنه حجّةُ
الإسلام
الغزاليّ«[352] تَرْجَمَتْ له جماعةٌ من
المصنّفين.
منهم؛ تاج
الدين
السبكي،[353] وعبد
الحيّ بنِ أحمد بنِ محمّد بن
العماد العكبريّ
الحنبليّ،[354] وياقوت
الحموي،[355] وعلي بن محمّد
بن عبد الكريم
بن عبد الواحد
الشيباني
الجزري
المعروف بابن
الأثير.[356]
يغلب
الظن أنّ أبا
عليّ
الفارمديّ هو
عربي الأصل
كأستاذه أبي
القاسم
القشيريّ. بيد
أنّه تشرّبَ
العقيدةَ
الصوفيّةَ بدافع
نشأته في
منطقة خراسان
الّتي كانت
ملتقى الجموع
للعقائد الوثنيّة
منذ القديم.
إلاّ أنّنا لا
نعثر على أيّ
دليلٍ يبرهن على
إقراره بهذه
السلسلةِ وعن
تعبّده على
غِرَارِ النقشبنديّة.
قيل إنّه كان
وجيهًا عند
الوزير
السلجوقيّ
حسن بن على المعروف
بـ»نظام
الملك«،
ولكن ابن
خلّكان لا
يذكره حيث
يذكر مكانةَ شيخه
أبي القاسم
القشيريّ عند
نظام الملك.[357]
***
*
الحلقة
الثامنة من
سلسلتهم.
هذه
الحلقةُ
يمثّلها في
اعتقاد
النقشبنديّين
رجلٌ اسْمُهُ أبو يعقوبَ يوسفُ بنُ أيّوبَ بنِ يوسفَ بنِ الحسينِ
الهمدانيَّ. يزعمون أنّه
أخذ سِرَّ هذهِ
الطريقةِ من أبي
عليّ الفضلِ بنِ محمّد
الفارمديِّ. فيكون
بذلك معاصرًا
لمحمّد بن محمّد
الغزاليّ، وَمُصَاحِبًا لنفس
الأستاذ
الّذي أخذ عنه
الغزاليُّ، مع ذلك
لا نَعْثُرُ على ما يُثْبِتُ اجْتِمَاعَهُمَا.. وهذا أمرٌ
غريبٌ يبعث
الشكوكَ فيما
أورده بعضُ
النقشبنديّين
من ترجمةِ هذا
الرجلِ. ذلك، مِنْ شأنهم: أنّهم
يحرصون على
إشاعةِ فضائلِ مشائخهم بكلّ
وسيلةٍ. ولا يألون
جهدًا في
إسناد ما ليس
فيهم من صفاتٍ عالياتٍ،
ويبحثون عن
أدنى قرينة
تجمع بين
شيوخهم وبين
مشاهير
العلماءِ. ولا
يقصدون من ذلك
إلاّ العملَ
على توسيعِ
نطاقِ
الشهرةِ
لرجالهم.
هذا،
فلو كان
الهمدانيُّ قد اجتمع
بالغزاليِّ لظهر
ذلك بوضوح من
خلال التراجم.
- لأنّ الهمدانيّ
أيضًا من
تلامذةِ الفارمديِّ على
حدِّ قول
النقشبنديّينَ - ولكان
ذلك وسيلةً
لمباهاتهم.
لأنهم يملكون الفرصةَ
بذلك ليزيدوا
من مبالغتهم
في المدح والثناء
على هذا الرجل
بمجرّد
صِلَتِهِ بالغزاليّ
الّذي ملأ
الآفاقَ
بشهرته!
وقيل
أنّ الشيخ عبدَ القادرِ
الجيليَّ إجتمع
به وهو شابٌّ
يدرس في النظامية.
إنّ هذا الاحتمالَ يُنبؤُنَا عن ضعف ما
قد نسجه
النقشبنديّون
حول
الهمدانيّ من
حكاياتٍ
وأقاصيصَ
خياليّةٍ لا يمكن
أن تظهرَ
الحقيقةُ من
خلالها. كما جاءت
تلفيقات بين
كلمات
المترجمين
للهمدانيِّ. فقد
ورد في
الحدائق الورديّة
»أنّه
تفقّه علي
مذهب الإمام
الشافعيّ«.[358] مع هذا
يدّعي شخصٌ
أرّخ لرجال
هذه الطريقة »أنّه كان على
مذهب الإمام
الأعظم«.[359] أي على
مذهب الإمام
أبي حنيفة رضي
الله عنه.[360]
يقول
الأستاذ فؤاد
كوبرولو (باللّغة التركيّة
وقد عرّبناه
كما يلي): »أمّا
الهمدانيّ، فإنّه
كان طويلَ
القامةِ،
أزهريَّ اللّون،
أشقرَ اللّحية،
رجلاً
نحيفًا،
يكتسي ثوبًا
من صوفٍ مُرَقَّعٍ. لا
يهتمّ بأمور
الدنيا ولم
يتردّد على
الملوك. يُنْفِقُ كلّ
ما يصيب من
مالٍ. لم يقبل
من أحدٍ
شيئًا، ولم تكن
له معرفة
باللّغة التركيّة.
(...) يصنع
العقاقير
لتهدئة
الآلام
ومعالجة الجراح،
ويكتب
التمائم للشّفاء
من الحمّى.«[361] ويقول
المؤلّف
أيضًا:
»إنّ
الشيخَ يوسفَ الهمدانيَّ، الّذي
ينتمي إلى
أسرةٍ
همدانيّةٍ
مجوسيةٍ
اعتنقتْ الإسلامَ منذ
ثلاثة أجيال،
لم يكن من
أولئك المتصوّفة
الأعاجم
الّذين عملوا
على تأليف
العقائد الهنديّة مع
العقائد الإسلاميّة
بتصوّراتهم
المطلقة من
العنان.
ولكنّه كان مُتَعَمِّقًا في
العلوم الشرعيّة،
وكان عالمًا
بالحديث.
ولهذا كان
يفضّل الكتابَ
والسّنّةَ على كلّ
شيء.«[362]
هذه
النقولات
تبرهن على
شخصيّة
الهمدانيّ من كلّ
وجهٍ وبكلِّ
وضوحٍ حيث لا
يحتاج إلى أيّ
تعليق آخر.
وعلى الرغم من
كثرة الحكايات
المنسوجة حول
هذا الرجل، فإنّه
لم يرد عنه أنّه
تكلّم بشيءٍ يوهم
أساليبَ التعبُّد
المبتدَعَةِ
من قِبَلِ
الطائفة النقشبنديّة.
وجاءت
ترجمتُهُ في
عدد من
المصنّفات.[363]
***
* الحلقة
التاسعة من
السلسلة النقشبنديّة
ورد
في مصادر
المتاخّرين
من
هذه النحلةِ: أنّ
الحلقةَ التاسعةَ من
سلسلتهم هو
عبد الخالق الْغُجْدُوَانِيُّ.
وهو أوّل رجلٍ تركيِّ
النَشأةِ بين
قدماء هذه
السلسلة. وهو
الّذي أحدث
ثمانيةَ أركانٍ للطريقة
كما مرّ في
باب »مبادئ
الطريقة النقشبنديّة« من
الفصل الثاني. قال محمّد
بن عبد الله
الخانيّ في
هذا الصدد:
»ومن
تلك
المصطلحات:
الكلمات
القدسية
المأثورة من حضرة
الخواجة عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ،
وهي إحدَى عشرةَ كلمةً. وعليها مَبْنَى طريقة
السادات النقشبنديّة«.[364] وعدّ
كلاًّ على حدة
كما نقلناها
من مصادرهم
فيما سبق.
جاء
في تراجم
النقشبنديّين
لعبد الخالق
الْغُجْدُوَانِيِّ
أنّه ولد في
قرية غُجْدُوَان - وهي
على مقربة من
مدينة
بُخَارَى -
وأنَّ نسبه
يتّصل
بالإمام مالك
بن أنس رضي
الله عنه؛ وأنّ
والده الشيخ
عبد الجميل
كان من سكّان
مدينة ملاطية
(الواقعة
اليوم في شرقي
تركيا).ثم
سافر إلى
بُخَارَى.
بينما نحن لا
نعثر على
ترجمةٍ له في
التصانيف
المعتبرة.
وهذا ما يزيد
من الشكوك حول
كلّ ما قيل
عنه خاصّة
فيما ورد أنّه
درس تفسير
القرآن
العظيم عند
الشيخ صدر
الدين
البُخَاريّ.
لأنّ ما ورد
عنه من البدع
يثير الوهم
حول جهله
بالإسلام إذا
صحّ قول من
زعم أنّه
الّذي وضع
المصطلحات
الثمانية.
وتؤكّد ذلك
روايات غريبة
أخرى وردت
عنه.
منها
»إنّه
قال: لمّا
بلغتُ اثنين
وعشرين سنة
أوصى الخضر u
الغوث
الهمدانيّ
بتربيتي.«[365]
ورد
في مواطن أخرى
من تراجم
النقشبنديّين
له أنّه »جاء
الخضر u
إليه، فقال له
أنت ولدي،
ولقّنه
الوقوف العدديَّ
وعلّمه الذكر
الخفيَّ؛ وهو أنّه
أمره أن يغمس
في الماء
ويذكر بقلبه: لا إله
إلاّ الله محمّد
رسول الله.
ففعل كما
أمره. ودام
عليه فحصل له
الفتح
العظيم،
والجذبةُ
القيّوميةُ«.[366]
لا
شكّ في أنّ
الإسلام بعيد كلّ
البُعدِ عن
مثل هذه
الهرطقة
اليوغية؛ كما
لا شكّ
في أنّها
شعبذة من
تمرينات
رهبان البرهميّة،
أثارها الرجل
كخطوةٍ أولى
لتمهيد
السبيل إلى
وضع ما أشارت
له نفسه من
تلك
المصطلحات البرهمية،
ودسّها في
عقائد
الإسلام (إذا
صحّت
الروايات إنّه
الّذي وضعها). وقد
تعاقبت بعدها
ألوانٌ متباينةٌ من
أفانين
الشعبذة
لرجال هذه
الطائفة من
أمثاله.
فامتلأت كُتُبُهُمْ بها إلى
أن وجد
المسلمون
اليوم هذه
الطائفة عقبةً
خطيرةً في وجه
الإسلام،
خاصّة على
الساحة التركيّة
حيث لا قبل
لهم بها!
يطلَق
على هذا الرجل
أسم »رئيس
الخُوَاجَگَانْ«[367] أي رئيس
شيوخ هذه
الطريقة.
ويقول
النقشبنديّون
أنّ طريقتهم أَخَذَتْ
اسمَ »خُوَاجَگَانِيَّة«
بدايةً من
عهده حتّى زمن
محمّد بهاء
الدين
البُخَاريّ
المعروف
عندهم بـ »شاه
نقشبند«.
وكلمة »الخُوَاجَگَانْ«
فارسية. وهي
جمع خواجه »بتفخيم
الخاء
المفتوحة.
وتُرْسَمُ
بالواو ولا
تُقْرأْ،
وإنّما هي
علامة
التفخيم«.[368]
ومن
الحكايات
الأسطورية
الّتي نسجتها النقشبنديّة:
ما جاء في
موسوعة
أعدّتها
طائفةٌ
تركيةٌ من هذه
النحلة يطلق
عليهم اسم «The Modernist Naacshabandis» أى
النقشبنديّين
العصرانيّين.
ورد في موضع من
موسوعتهم »أنّ عبدَ
الخالقِ الْغُجْدُوَانِيَّ
كان يصلّي
الصلوات
الخمس في
المسجد
الحرام، ويرجع
في لمح البصر
إلى مدينة
بُخَارَى.«[369]
يبدو أنّ
عدّة مصطلحات
فارسية أخرى
قد دخلت في
قاموس النقشبنديّة
بجهود هذا
الرجل. منها
كلمة »خانقاه«. يقول
في ذلك عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ ضمنَ
ترجمة عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيِّ:
»ثمّ
سافر إلى
الشام، وأقام
بها مدّة
أعوام، وبنى ثَمَّ
خانقاه. وهي
كلمة فارسية
بسكون النون بمعنى
الزاوية«.[370]
هذا
على الرغم من كلّ
ما أُسند إليه
من حقّ وباطل
فإنّ عبدَ
الخالقَ الْغُجْدُوَانِيَّ
لم تَثْبُتْ عنه أدنى
إشارة توهم
الرّابطةَ والختمَ
خُوَاجَگَانِيَّةَ،
وتعدادَ الذكر بالْحَصَى،
والقولَ بسلسلة الروحانيّين؛
عدا ما أُحْدِثَ في
الطريقة من
مصطلحاتٍ فارسيةٍ ترمز
إلى الأركان
الّتي أقامها
لأوّل مرة.
إلاّ
أنّ إحداثَهُ
لهذه
المصطلحات
الغريبة في
لباسِ مناسكَ
دينيةٍ يبرهن بكلّ
وضوح على أنّ
الطريقة النقشبنديّة
قد أخذتْ من
البداية
تستقي من
فلسفاتٍ
ودياناتٍ وعقائدَ
شتّى، وأنّها
قد استمرّتْ عَبْرَ
تاريخها على
هذا المنوال.
***
*
الحلقة
العاشرة من
سلسلتهم.
جاء
في موسوعةٍ
النقشبنديّين
العصرانيّين،
أنّ عارفًا الرِّيوَگَرِي هو
الحلقةُ العاشرةُ من
سلسلتهم. إلاّ
أنّ التصانيف
المعتبرة لتراجم
الرجال
خاليةٌ مِنْ هذا الاسم.
وقد لا يتجاوز
هذا الاسم عن
شخصية خيالية.
لأنّ عبد
المجيد بن محمّد
بن محمّد
الخانيّ
الّذي أفرغ
طاقته في جمع
معلومات حول
رجال
السلسلة،
حتّى هو
بالذات عجز عن
المعرفة
بتاريخ ولادة
هذا الرجل
وتاريخ وفاته.
فسطورُهُ
شاهدةٌ على
هذا العجز.
لأنّه لَمّا
استهلّ بخلع
آيات الثناء
والمدح على
هذه الشخصية
الغامضة فقال:
»عارفٌ
ظهر أنوارُ صَادِقِ فَجْرِهِ. فأشرقتْ بعد
الغروب شمس
المعارف في
عصره« ثمّ قال »ولد
سنة...«[371] ولم
يذكر شيئًا
بعده؛ فلم
يؤرّخ
لولادته ولا لموته.
كما تؤكّد
كلماتُهُ
الأخيرةُ على هذا
الغموض؛ إذ
يقول: »وله
عدّة خلفاء.
ولم أقف لهم
على أسماء«.[372] فكيف به
أن يقف على
مناقبه
وأحواله
وأطوار حياته
بالتفصيل إذا
صح له وجود
حقيقي ما دام
لم يقف حتّى
على اسم من
أسماء خلفائه!
فعلى الرغم من
هذه المناقضة
والتعارض،
ومن هذا العجز
الّذي نلمسه
من خلال كلمات
الخانيّ وما
تتوارى فيه
هذه الشخصيةُ
من غموض،
يحاول
المؤلّف ليجعل
منه شخصيةً
حقيقيةً
فيقول: »أصله
من بُخَارَى.
وكان مستغرِقًا في
تحصيل علم
الظاهر.[373] فلقي
الشيخ مرة في
السوق، قد
اشترى لحمًا
وحمله[374] فقال له
أنا أحمل عنك.
فأعطاه إيّاه.
فلمّا وصل إلى
بيته،
التَفَتَ
إليه وقال له
تأتي بعد
ساعةٍ حتّى
آكل الطعام
معك. فلما
انصرف، لم يجد
في قلبه ميلاً
للعلم. بل وجد
متصرّفًا
لخدمة الشيخ.
فعاد إليه في
الوقت،
فتقبّله. وقال
له أنت ولدي.
وعلّمه
الطريق.
فاشتغل به وترك
الذهاب إلى
أستاذه. فكان
كلّما رآه
أستاذه عنّفه
وشتمه على ترك
العلم، وأمره
بالحضور إلى
المدرسة وهو
يُقبِل ولا
يجيبه بشيءٍ.
فاتّفق أنْ
اقترف
أستاذُهُ ذات
ليلةٍ كبيرةً
من الكبائر.
فلمّا التقيا
في النهار أطال
لسانه عليه
على العادة.
فقال له: - يا
سيّدي كنتَ في
الليلة كذا
وكذا من
الفسق، والآن
تمنعني عن
طريق الحقّ.
فخجل الأستاذ
خجلاً عظيمًا؛
وعَلِمَ مراتب
الصوفيّة
وأحوالهم.
وحضر عند
الشيخ عبد
الخالق في
الحال وتاب
وأخذ طريقته
وصار من المقبولين
لديه«.[375]
يحاول
الخانيّ بهذه
الكلمات
ليؤكّد على
أنّ هذا الرجل
كان يعلم
الغيب ويطّلع
على عورات الناس
في ظلمات
الليل ويعلم
ما يصنعون وهم
في بيوتهم. غير
أنّ الخانيّ
غفل عمّا حطّ
من شأن هذا
الرجل عند ما
قال: »فلمّا
انصرف لم يجد
في قلبه ميلاً
للعلم (...) وترك
الذهاب إلى
أستاذه«.[376] أى أعرض
عن دراسة
العلم وانهمك
في تقليد الصوفيّة.
كانت
هذه خلاصة من
قصة الحلقة
العاشرة من
سلسلة
النقشبنديّين
على لسانهم
بالذات!
***
* الحلقة
الحادية عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
ورد
في مصادرهم
أنّ الحلقة
الحادية عشرة
من سلسلتهم هو
محمود الإنِجِيرْفَغْنَويُّ. وَ»إنِجِيرْفَغْنىَ«
قريةٌ من
ضواحي مدينة
بُخَارَى.
يستهلّ
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ
ترجمته
بالمدائح
كعادته في
ترجمة سائر
شيوخ الطريقة.
وهذه صيغةٌ من
كلماته
المسجّعة:
»مرشدٌ تفجّرتْ من بين
أصابعه مياهُ الحكمةِ، أنعم
الله تعالى
بوجوده على
قلوب هذه
الأمّة (...) فهو
أعظم نعمة
وأعمّ رحمة«.[377]
ثم
يقول »كان
مع جلالة قدره
يشتغل بصنعة
البناء. فلما
أقيم مقام
سيّدنا الشيخ
عارف، انقطع لهداية
الخلق إلى
الحق، وقد عدل
إلى الذكر الجهريِّ
منذ مرض
أستاذه
لمقتضى
خُلُقِ الوقت والخلق«.[378]
فعلى
الرغم من هذا
التنطّع
الّذي
استعرضه الخانيّ
لينوّه بمدى
تواضع هذا
الشيخ الّذي »كان مع جلالة
قدره يشتغل
بصنعة البناء«؛
على الرغم من
هذه
المحاولة، لا
يكاد يَقْتَنِعُ أيُّ ذي
عقلٍ، أنّ
الفغنويّ
كانت له مكانة
مرموقة،
وأنّه كان من
العلماء فترك
مِنَصّة العلم
واشتغل بصنعة
البناء
تواضعًا، أو
لأيّ سبب
معقول!
أمّا
الذكر الجهريُّ الّذي
يجهله كثيرٌ من
الناس،
فيناسب هنا
وبهذا
المقتضى أنْ
يُسَلَّطَ
الضوءُ على
هذا النوع من
الذكر بأنّه
مخالف للكتاب
والسّنّة.
لأنّهم
يجتمعون في
أوقات
معيّنة،
ويقيمون
حلقاتٍ
استعراضيّةً في
التكايا،
يرفعون
أصواتهم
ويترنّمون
بترديد لفظة
الجلال أو
كلمة التوحيد
بإيقاعات
ونغمات
خاصّة؛
يُشرِفُ
عليهم شيخهم أو
من ينوب عنه،
فيوجّههم
بالانتقال من
صيغة إلى
أخرى،
فيستمرّ
الذكر على هذا
المنوال مدّةً
غير قصيرة؛
وقد يُغشىَ
على بعضهم
بدافع ثوران
العاطفة، أو
بسبب تراكم
مادّة
الأُكسيجين
في الأوعية
الدموية
نتيجة السرعة
في توالي
الشهيق
والزفير.
ينحدر
الفغنويّ من
أصلٍ تركيّ
كسائر شيوخ هذه
الطريقة
الّذين برزوا
في منطقة
ماوراء النهر
المعروفة بـ »بلاد
تركستان«.
قيل إنّه عاش في
مدينة
بُخَارَى
وضواحيها؛
ومات عام 715 من الهجرة.
لم يؤرّخ له
أحد من مشاهير
المترجمين
وعلماء
التاريخ
والأنساب.
وإنّما وردت كلمات
وجيزة حوله
ضمنَ تراجم
النقشبنديّين.
***
*
الحلقة
الثانية عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
هو
عليّ
الرامتنيّ
المعروف بـ »خواجه
عزيزان«.
ولد في قرية »رَامِتَنْ«
الّتي هي على
بُعد فرسخين
من مدينة
بُخَارَى.
يدلّ ذلك على أنّه
تركيّ الأصل.
لم يقف
الباحثون على
تاريخ ولادته،
ولا على
معلومات
واسعةٍ عن
حياته؛ سوى ما
قال بعضهم إنّه
كان نسّاجًا،
عاش مدةً
طويلة في هذه
المنطقة ومات
فيها عام 721 أو 728 من
الهجرة. قيل
وافته المنية
وهو ابن مائة
وثلاثين سنةً!
اختلفت
الآراءُ فيما
إذا كان عليُّ
الرامتني من
أهل التصوّفِ
أم من أهل
العلمِ. يبدو
هذا الخلاف من
مقولةٍ
شعريةٍ
يردّدها
النقشبنديّونَ،
وهي قولهم:
لَوْ لِحَالٍ
لَمْ يَكُنْ
فَضْلٌ عَلَى
قَالٍ لَمَا *
كَاَن أعْيَانُ
بُخَارَى
عَبْدَ
نَسَّاجٍ
عَلِي.
وعلى
الرغم من
الغموض الّذي
يواري حياة
هذا الرجل،
فقد وردت
مقولات عنه
مضيئة تبرهن على
سلامة
اعتقاده،
وعسى أن تكون
الرواية
صحيحةً.
تُنسَبُ
إليه رسالةٌ
مسجّلةٌ تحت
رقم 265/2
بمكتبة
السليمانية -
خزانة طاهر
آغا - في إسطنبول.
ربما ليس من
كلامه جميع ما
نُقِلَ عنه، ما
دامت شخصيّته
لا تتبلور
بالدلائل
القاطعة. كما
يغلب أن يكون
النقشبنديّون
قد طمعوا في
نسبته إلى
قائمة
الروحانيّين
بسبب ما كان له
من السمعة الحسنة
في عهده مع
عدم علاقته
بهم؛ والله
أعلم بالصواب.
هذا
ولم يرد عنه أنّه
تكلّم بأدنى
شيء عن
الرّابطة،
ولا عن الختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
ولا عن تعداد
الذكر بِالْحَصىَ،
ولا عن
السلسلة النقشبنديّة.
***
* الحلقة
الثالثة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
كان
للرّامتنيِّ
خلفاء أربعة.
اسم كلّ منهم محمّد.
وكان أشهرهم محمّد
بابا الّذي
حلّ مكان شيخه
وأصبح هو
الحلقة الثالثة
عشرة لهذه
السلسلة على
ما جاء في
الحدائق الورديّة
لعبد المجيد
بن محمّد
الخانيّ.
ولد
ونشأ محمّد
بابا في نفس
المنطقة وهو
أيضًا تركيّ
الأصل، من
سكّان قرية »سَمَّاس«
الواقعة بقرب
مدينة
بُخَارَى. وهي
على مسافة ثلاثة
أميال منها،
وعلى ميل واحد
من قرية »رَامِتَنْ«
الّتي كانت
مقرّ شيخه.
ولهذا يسمّى
صاحب الترجمة
محمدًا بابا
السمَّاسيّ.
وكلمة
»بابا«
يعني »الأب«
في اللّغة التركيّة.
ومن عادة
الأتراك
أنّهم ينادون
كبار السن
بهذه الكلمة
على سبيل
الاحترام. كما
يُطلقونها
على بعض رجال
الصوفيّة،
وعلى بعض
أصحاب القبور
الّذين
تقدّسُهم
العامّة، ويتبرّك
غالبُ الناس
بأضرحتهم في
تركيا؛
لاعتقادهم
أنّهم أولياء
الله
وخاصّتُهُ. فيبدو
أنّ الشيخ
محمدًا، هذا
الّذي يعدّه
النثشبنديُّون
الحلقةَ
الثالثةَ
عشرة
لسلسلتهم هو
أيضًا من
أولئك
الباباوات
القدّيسين
على غرار عادة
النصارى
الّذين
ينادون
أوليائهم
بهذا العنوان
مما يؤكّد أنّ
الطريقة النقشبنديّة
قد اقتبست
أيضًا من
المسيحية
قليلاً أو
كثيرً؛ وإن لم
يكن ذلك بقدر
ما استقت من
البرهمية والبوذية
من أشكال
المناسك
والتعبُّد.
هذا
ومن الغريب أن
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ قد
أراد أن يؤرّخ
لولادة محمّد
بابا
ولوفاته،
فقال، »ولد
سنة...«؛ ثم قال »توفي سنة...«[379] ولم
يسجّل بعدهما
شيئا، مما
يدلّ على أنّه
لم يتمكّن من
الوقوف على
تفاصيل
حياته، وأنّ
هذا الاسم قد
يكون عَلَمًا
على شخصية
خيالية لا
حقيقةَ لها.
لأنّ وثائقهم
وحتّى كتاب
الرشحات الّذي
هو أقدم مصادر
النقشبنديّين
لا يشتمل على
شيء يستحق
الذكر من
أخباره. كما
لم يرد عنه
أيضًا أنّه
تعبّد على
أساليب النقشبنديّة،
أو تكلّم
بشيءٍ عن
أشكال
عباداتهم
كالرّابطة، والختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
والتوجُّهِ،
وتعدادِ ألفاظ الورد
بِالْحَصَى. قيل توفّي
السمَّاسيّ
عام 755 من
الهجرة
بالقرية
نفسها.
***
* الحلقة
الرابعة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
ورد
فيما كتبه
النقشبنديّون
أنّ الحلقة
الرابعة عشرة
من سلسلتهم هو
رجلٌ اسمه
كُلال بن
حمزة. ويزعمون
أنّه ينحدر من
سلالة الحسين
بن عليّ بن
أبي طالب رضي
الله عنهما؛
وأنّ أباه
حمزة هو الّذي
غادر موطنَه
الأصليَّ؛ إذ
كان مقيمًا
بالمدينة
المنوّرة؛
فقصد بلادَ
ماوراء
النهر، حتّى
وصل منطقةَ
بُخَارَى،
فأقام هناك
بقريةٍ اسمها
أفْشَنَهْ. إلاّ
أنّ الغموض الّذي
يواري حياة
رجال هذه
السلسلة في
تلك الحقبة، يُخَيِّمُ
على هذه
الأسرة
أيضًا؛ فلم
تكد تتبلور صورته.
فالّذي
يتناقله
أتباعُ هذه
الطائفة عن
كُلال بن
حمزة، ليس
إلاّ لفيفًا
من الأساطير.
ومن جملة هذه
الأقاصيص
الّتي وردت في
موسوعةٍ لهم
باللّغة التركيّة،
حكاية غريبة
حول تسمية هذا
الشيخ؛ وهي: » أنّ
رجلاً من
الصالحين نزل
ضيفًا عند
أبيه حمزة، إذ
هو في بطن أمه.
فبشّره بغلام
ينال شهرةً
عظيمةً، وأوصاه
أن يسمّيه
كُلالاً«.
غير
أنّ هذه
الكلمة
عجميّة تقابل »صانع
القُحُف
الخزفية«
في اللّغة العربيّة.
وهذا الأمر
يثير الشكوك
في جلّ ما
نُقِلَ عن
صاحب الترجمة.
منها، أنّه
اشتغل بصناعة
القِحْفِ.
وهذا استدلال
باطل. لأنّه
سُمّيَ بهذا
الاسم وهو
وليد لا يعلم
شيئا من هذه
الدنيا؛ لا من
قحوفها ولا من
تُحَفِهَا.
ومنها، أنّ
شيوخ النقشبنديّة
يأنفون أن
يمارسوا
حرفةً من حرف
العامّة استنكافًا.
وذلك للحفاظ
على مكانتهم،
وشهرتهم، وهيبتهم
بين الناس.
إنّ
النقشبنديّين
إنّما يقصدون
بمثل هذه الأقصوصة
أن يروّجوا
الاعتقاد بين
الناس بعلم الغيب
لساداتهم،
فلا يكادون
ينفكّون من
هذه النـزعة
كأنّهم جبلوا
على ذلك.
ويتورّطون هكذا
في تناقضاتٍ
كثيرة. منها أنَّ
مفهوم
الكرامة تكاد
تنحصر عندهم
في خرق العادة.
كالعلم
بالغيب، وطيّ
الزمان
والمكان،
والهيمنة على
نظام الكون.
ينسب
النقشبنديّون
صفة »الأمير«
إلى كُلال بن
حمزة في
مصادرهم. ولا
نجد لهذا الوصف
مناسبةً
مُلحّةً. إذ
لم يسبق أنّه
تولّى إمارةً
أو مهمّةً
سياسيةً أو
إداريةً. سوى أنّه
كان في شبابه »اشتغل بفنّ
المصارعة
فكان يجتمع
عليه أرباب الشجاعة
وأولو
المعاركة
والنظارة.
فاتّفق ذات
يوم أنّ رجلاً
من الواقفين
خطر بباله أنّ
هذا سيّدٌ
شريفٌ. فكيف
يشتغل
بالمصارعة،
ويسلك سبيل
أهل البطالة! فلم
يلبث أنْ غلب
عليه النوم؛
فرأى في منامه
أنّ القيامة
قد قامت،
وأنّه وقع في
وحلٍ عظيمٍ؛
فغرق فيه إلى
صدره، واضطرب
اضطرابًا
عظيمًا؛ وفزع
فزعًا كبيرًا.
فأتى إليه السيّد
الأمير
وأنقذه من هذه
الورطة. ثمّ
أفاق؛
فالْتَفَتَ
إليه السيّدُ
الأميرُ وقال
له:«
»- أرأيتَ
همّتي وعلمتَ
ما معنى
المصارعة؟! «[380]
هكذا
قد
الْتَفَّتْ
حول الأمير
كُلال بن حمزة
أحابيلُ من
غرائب
الحكايات
والأقاويل،
ولا يمكن
تمييز صحيحها من
باطلها.
وقد
تكون تسميته بـ »الأمير«
بسبب
العلاقات
الّتي جرت
بينه وبين
تيمورلنك. إذ
ورد في موسوعة
النقشبنديّين:
»أن
الأمير
كُلالَ بنَ
حمزةَ، بعث
رسولَهُ
الشيخ
منصورًا إلى
الملك
تيمورلنك،
يحرّضه على
استيلاء بلاد
خوارزم.
فامتثل تيمور
لأمره فورًا؛
فانطلق
زاحفًا بجيشه
على منطقة خوارزم.
ونجا بذلك من
خطّةِ
اغتيالٍ كان
قد دبّرها
أعداؤه. إذ
أنّهم وصلوا
إلى معسكره
وقد غادره.
فلم يتمكّنوا
منه«.[381]
يستدلّ
النقشبنديّون
الأتراك بهذه
القصّة أنّ
الملك تيمور
عرف أنّه كانت
نجاته بفضل
كُلال بن
حمزة، فيعدّونها
من جملة
كراماته.
ويزعمون أنّ
الملك تيمور
قد أراد أن
ينصبه
أميرًا؛ فلم
يوافقه استعفافًا
وزهدًا في
الدنيا
وحطامها. وعلى
الرغم من كلّ
هذه
الحكايات، فإنّ
كُلالَ بنَ
حمزةَ لم يرد
عنه أنّه
تعبّد على
أساليب
النقشبنديّين؛
أو تكلّم عن
آدابهم
ومصطلحاتهم؛
لم يرد عنه
ذلك حتّى في الوثائق
الّتي خلّفها
شيوخ هذه
الطائفة.
***
*
الحلقة
الخامسة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
إنّ
هذه الحلقة
يمثّلها شخص
يعظّمه
النقشبنديّون،
ويصفونه
بأسمى درجات
الكمال؛
ويعتقدون فيه أنّه
ترقّى إلى
أعلى مدارج
الولاية وكاد
أن يكون نبيًّا!
وينسبون إليه
طريقتهم
ويتسابقون في
الثناء عليه.
هذا
الرجل هو محمّد
بهاء الدين بن
محمّد بن محمّد
البُخَاريّ
المعروف بين
هذه الجماعة
بلقب »شاه
نقشبند«
أو »خواجه
نقشبند«.
يتفنّن
عبد المجيد
الخانيّ في
مدحه وتعظيمه بعباراته
المسجّعة،
فيقول:
»بحر
من العرفان لا
ساحل له؛ نسجت
أمواج أمواه العلوم
الربّانيّة
حلله؛ وفاض
على العالمين
بحر برّه؛
فأروى بأرواح
إمداده جميع
الكون بحره
وبرّه«.
يسترسل
المؤلف على
هذا النمط إلى
أن يقول:
»إرتضع
ثدي
التصرّفات
الغوثية وهو
في المهد صبيًّا؛
وتضلّع من
رحيق مختوم
العلوم
الختميّة
بأكواب
الإرثية؛ فلو
لم تُختَم
النبوّةُ لكان
نبيًّا«.[382]
إنّ
هذا الأسلوب
الغريب
المتكلّف،
لغنيٌّ عن أيّ
تفسير أو
تعليق يُراد
به تعريفُ ما
يعتقده الشخص
النقشبنديّ
في هذا الرجل
خاصّة، وفي
جميع مشائخه
عامّةً. وهذا
من أقوى
البراهين في
الوقت ذاته
على مدى حظّ النقشبنديّين
من الدين والأخلاقِ
والإيمان
والإسلام.
على
الرغم من أنّ
النقشبنديّين
قد بالغوا في وصفه
ومدحه
وكراماته
ومناقبه
بأقصى جهودهم،
فانّ ترجمة
هذا الرجل لم
يرد في المصادر
المعتبرة وَكُتُبِ
ثقاة
الباحثين
والمؤرّخين.
وهذا يثير
الشكوك في
صحّة ما
نُقِلَ حول
شخصيته من كلّ
الوجوه.
وإنّما جميع
ما نُقِلَ
إلينا عن حياته
من الأقاويل
والأقاصيص
فهو مقتَبَسٌ
من كتاب
الرشحات
لرجلٍ حشويٍّ
منهم لم
يعاصره.
لا
يخفى أنّ
مشاهير
الرجال من
سائر طبقات
البشر على
اختلاف
ألسنتهم ولغاتهم
ومُعْتَقَداتهم
وثقافاتهم،
قد وردت أسماؤهم
في كتب
الوفيات
والتراجم
والأنساب والتواريخ.
ولم يخلُ عصرٌ
ممن أرّخ
لأصحاب الشهرة
مهما كانت
اتجاهاتهم
ومُعتقداتهم
ومَواقفهم.
لذا من الغريب
أن يضيق
تاريخُ البشر
الّذي قد حوى
آلافًا
مؤلَّفةً من
أسماء
الأنبياء والعلماء
والأُدباء
والفاتحين
والرواد
والمصلحين
والعباقرة
والثوّار
والطغاة؛
وحتّى المشهورين
من أهل السفهِ
والمجون
والخلاعة والبخل
والتطفّلِ؛
من الغريب
جدًّا أن يضيق
تاريخ البشر
عن استيعاب
مناقب هذا
الرجل الّذي
بذل النقشبنديّون
ما عندهم من
طاقات وجهود
في الحديث عن
عظمته وجلالة
قدره. وذلك
لإذاعة صيته
وإشاعة اسمه
وشهرته
الكاذبة
المُخْتَلَقَةِ.
فقد
قال عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ في
علوّ منـزلته
وشأنه
ومكانته:
»فأَعْظِمْ
به من مجدّدٍ
خفق قلب
الخافقين
فرحًا به؛ وأصبحت
أكاسرة
الملوك
وقوفًا في
رحابه؛ وملأ
صيت إرشاده الملا؛
فلا وربّك لا
يبقى أحد إلاّ
استمدّ من إمداده
حتّى وحوش
الفَلا. فهو
الغوث
الأعظم، وعقد
جيد المعارف
الأنظم،
انزاحت
بأنوار هدايته
أعيان
الأغيار،
وعادت
الأشرار
ببركة أسراره
من أخيار
الأعيان
وأعيان
الخيار«[383]
إلى
هذه الدرجة
يبالغ
الخانيّ في
إجلاله،
ويتكلّف بهذا
الأسلوب
المزخرف
لغرضٍ لا سند
له في إثباته،
إذ لا تقوم
دعايته هذه
على أساس من
الحقيقة؛ ولا
أصل لما
يدّعيه بملءِ
شدقيه؛ ولا حتّى
لكلمةٍ من
مقاله. لأن
خواجه
نقشبند، لا
ذكر له في
طبقات رجال
العلم.
ويُسْتَبْعَدُ
أنْ يكون قد
اشتهر في
حياته. ولربما
كان درويشًا
مسكينًا
يتصدّق عليه
الناس؛ فعاش
زمنًا في تلك
المناطقِ بين
قبائل
الأتراك
يتكفّف من هذا
وذاك؛ ثمّ رُوِّجَتْ
حول اسمه
حكاياتٌ
نسجها
القصّاصون من
أمثال الأسرة
الخانيّة
للوصول إلى
مآربهم من جمع
المال
والثروات،
وازدياد
الشهرة
والجاه،
واستغلال
الضمائر؛
واستمالة
القلوب؛
فتطوّرت
الأقاويل؛
وتضخّمت الروايات
مع الزمان؛
إلى أن تكوّنت
من هذه الحكايات
قاعدةٌ
بُنِيَ عليها
اختلاقُ شخصيّات
أسطوريةٍ
وأشكالٌ من
عقائدَ
غريبةٍ،
ومناسكَ
متباينةٍ
تختلف عن
شعائر
الإسلام،
سُمِّيَتْ
أخيرًا بـ »الطريقة
النقشبنديّة«.
كما يعترف
معتنقوها
بالذات أنّ
هذه التسميةّ
وقعت بعد محمّد
البُخَاريّ
المعروف بـ»شاه
نقشبند«.[384]
إنّ
شخصية محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ
أيضًا من خلال
ما ورد عنه
بقلم أتباعه
لهي من أقوى
الدلائل على
مدى بُعد هذه
الطريقة عن
حدود الإسلام.
وربما
كان خواجه
نقشبند رجلاً
تقيًا صالحًا ولكنّ
أتباعه
اختلقوا له
صورة غير
الّتي كان عليها،
فأشاعوها بين
جموع البسطاء
لإكثار العدد
- وهو مطلب كلّ
منظّمة -؛
فظهرت شخصيته
في صفات رجلٍ
مشعوذٍ،
مبتدعٍ
ومتوغّلٍ في
أنواع
الضلالات. إذ
ينقل عنه
الخانيّ أنّه قال:
»أمرني
(أي أمرني
شيخي) أن
أشتغل بخدمةِ
كلاب هذه
الحضرة
بالصدق
والخضوع،
وأطلب منهم
الإمداد. وقال
لي إنّك ستصل
إلى كلب منهم
تنال بخدمته
سعادةً
عظيمةً،
فاغتنمتُ
نعمة هذه الخدمة
ولم آل جهدًا
بأدائها حسب
إشارته،
ورغبةً ببشارته؛
حتّى وصلتُ
مرّةً إلى
كلبٍ، فحصل لي
من لقائه أعظم
حال، فوقفتُ
بين يديه واستولى
علىّ بكاءٌ
شديدٌ،
فاستلقى في
الحال على
ظهره، ورفع
قوائمه
الأربع نحو
السماء. فسمعتُ
له صوتًا
حزينًا،
وتأوّهًا
وحنينًا؛ فرفعتُ
يدي تواضعًا
وانكسارًا،
وجعلتُ أقول آمين،
حتّى سكت
وانقلب«.[385]
إنّ
هذه القصة إذا
صحّتْ عنه فلا
تدلّ إلا على
ضلالته وفرط
شقاوته
وخروجه عن
جادّة الحق.
لأنّ موقفه من
الكلب بالصورة
المذكورة لا
تدلّ على
امتثاله بما ورد
في السّنّة
النبوية من
الشفقة على
خلق الله؛ بل
كان موقفَ
احترامٍ
وتوقيرٍ
للكلب واستمدادٍ
منه. وهذا لا
يتّفق مع روح
الإسلام. بل
هو من تقاليد
مجوس الهند. فإنّهم
يعبدون
الدوابّ.
ولذلك قد
حرّموا أكل اللحم
على أنفسهم.
فاقتصر
النقشبنديّون
الأوّلون على
تعظيم الكلاب
أسوة بهم دون
تحريم اللحم.
إلاّ أنّ
المتأخّرين
من هذه
الطائفة قد
تصرّفوا في
تعاليم أسلافهم
فغيّروا منها
الكثير
أمّا
الإمداد
والاستمداد،
فإنّهما من
جملة
معتقداتهم الهامة
وحلقة من
الحلقات
الأساسية
لضوابط الإيمان
في الديانة النقشبنديّة.
يتمثل هذا
المبدأ
الروحانيُّ
في مفهومهم بوجود
قدرةٍ إلهيةٍ
فائقةٍ يمتاز
بها أولياؤهم؛
يفرّجون بها
عن المغمومين
والمكروبين
والمقهورين
بنوائب الدهر
من مريديهم؛
ويتصرّفون
بها في حكم
الله وملكه -
على حدّ
اعتقادهم -.
إذًا
فكيف برجلٍ
يطلب الإمداد
من كلبٍ وقد
يراه وليًّا
من أولياء
الله نائبًّا
عنه بالتصرّف؛
أو حتّى
مخلوقًا في منـزلة
الإنسان
الّذي كرّمه
الله وفضّله
على جميع
الخلائق،
وأنعم عليه
بالإيمان والعلم
والعمل
الصالح؛ فكيف
برجلٍ هذه
حاله حتّى
يستحقّ
الثناء أو
يدخل في عداد
المؤمنين؟!
ثم
ينقل الخانيّ
في موضع آخر
من ترجمته أنّه
»دعاه
بعضُ أصحابه
في بُخَارَى.
فلمّا أُذّن للمغرب
قال للمولى
نجم الدين
دادَروُكْ:
»-
أتتمثل كلّ ما
آمرك؟ قال: نعم.
قال: فان أمرتُكَ
بالسرقة
تفعلها؟ قال: لا.
قال: ولم؟! قال: لأنّ
حقوق الله
تكفّرها
التوبة، وهذه
من حقوق
العباد. فقال: إن
لم تتمثّل
أمرَنا فلا
تصحبنا! ففزع
المولى نجم
الدين فزعًا
شديدًا،
وضاقت عليه
الأرض بما
رحبت، وأظهر
التوبةَ
والندم، وعزم
على أن لا
يعصيه أمرًا«.[386]
هذا
هو »الغوث
الأعظم«
عند
النقشبنديّين؛
»فلولم
تُخْتَمِ
النبُوَّةُ
لكان نبيًّأ« (في
اعتقادهم).
يفرض على
مريده أن لا
يعصيه أمرًا،
وإن أمره
بالسرقة! وهنا
يتبيّن بكمال
الوضوح أنّ
شيخ الطريقة
عند هذه
الطائفة »هو
وكيل الله
ونائبه في
ملكه«؛ له أن
يتصرّف بما
يشاء، وله أن
يُحلَّ
الحرام
ويُحرِّم
الحلال. لا يشكّون
من ذلك قيد
نملةٍ وإن
كتموه ظاهرًا.
فانّ
التقيّةَ عند
خاصّتهم أشد
من تقية
الرافضة!.
ولا
يُسْتَغرَبُ
كما لو يتأوّل
النقشبنديّون
مفهومَ
السرقة في هذه
القصّة،
فيقولون
قيلاً: أنّ
رسول الله r
أيضًا صدر منه
أن تصدّى
بجماعةٍ من
أصحابه
للاستيلاء
على قافلة أبي
سفيان
التجارية.
وذلك محاولة
لصوصية من قبيل
السرقة لولا
أن كانت بوحي
من الله
تصديقًا لقوله
تعالى {وَإِذْ
يَعِدُكُمُ
اللهُ إِحْدَى
الطائِفَتَيْنِ
أَنَّهَا
لَكُم...}[387] إذن فهي
بادرة تحوّلت
من عملية غصب
إلى عمليةٍ
جهاديةٍ؛ أى
من معصيةٍ إلى
طاعةٍ بمجرد
توجيه من الله!
فالشيوخ
أيضًا لا
يتصرّفون
إلاّ بتوجيه
من الله.
ليس
من الغريب
أصلاً لو
تصدّى أحدهم
بمثل هذا الدفاع
المفتَرَضِ.
إذ أنّ باب
التأويل عندهم
مفتوح على
مصراعيه،
وأنّ
تأويلاتهم لا
تقلّ عن هذه
الفرضية
الواهية
بطلانًا.
ورد
في مصادر النقشبنديّة
أنّ أركان
طريقتهم
الثمانية
الّتي كان قد
وضعها عبدُ
الخالقِ الْغُجْدُوَانِيُّ،
أضاف إليها
خواجه نقشبند
ثلاثةً أخرى
فغدت بذلك أحد
عشر ركنًا.
كانت
هذه خلاصةٌ
لما سجّله
النقشبنديّون
حول هذا الرجل
وما اعتقدوا
فيه وما قالوا
عنه بروايات
أتباعه.
فالذنب على من
نقل واعتقد،
إذا كان هو
بريئًا عما
نُسب إليه
{إِنّ رَبَّكَ
هُوَ
يَفْصِلُ
بَيْنَهُمْ
يَوْمَ
الْقِيَامَةِ
فيِمَا
كَانُوا
فيَهِ
يَخْتَلِفوُنَ.}[388]
أمّا
وضعه
الاجتماعيُّ
فقد ورد في
موسوعةٍ للنقشبنديّن
أنّه من أبناء
الأسرة
الهاشمية؛
وأنّه يتّصل
نسبُهُ
بالحسين بن عليّ
بن أبي طالب
رضى الله
عنهما. فقد
يكون هذا من أهمّ
الأسباب
الّتي
استغلها
دعاةُ النقشبنديّة
في نشر مذهبهم
بين الناس.
سواء أكانت
هذه النسبةُ
صحيحةً أم لا،
فانّ كثيرًا
من الناس طالما
اتخذوا
الإنتسابَ
إلى البيت
الهاشميِّ وسيلةً
لاستغلال
ضمائر الناس
في تحقيق
المصالح
عَبْرَ
القرون؛
وخاصّةً في
المناطق
الّتي عمّ فيها
الجهل والبدع
وانتشر فيها
المغرضون
وأربابُ
الحِيَلِ
يدَّعون
الإنتسابَ
إلى الأسرة الهاشمية
لاستمالة
قلوب
البُسطاءِ
والرعاع. يبدو
أنّ نزعة
الإنتساب إلى
الهاشميّين
قد شاعت بعد
أن عُرِفتْ
هذه الأسرة
بالسيادة
الخاصّةِ وأصبح
الإعتزاز
بالآباء
المشهورين من
العادة. ويشير
إلى ذلك ما
ورد في مقدمة
الناشر للكتاب
المعروف »أنساب
الأشراف«
تأليف أحمد بن
يحيى
البلاذري أنّه
»يطلق
الشريف في
اللّغة على
الرجل
الماجد، أو من
كان كريم
الآباء. ثم
أُطلِقَ لقب
الشريف على من
كان من آل بيت
الرسول r
شاملاً
العلويّين
والجعفريّين
والعباسيّين.
ومن الناس
مَنْ قصّره
على ذرية
الحسن والحسين
على أنّ
التخصيصَ بآل
البيت
وبخاصّةٍ نسل
علي، لم يشتهر
إلاّ في القرن
الرابع
الهجريِّ؛
ويغلب أنّه
كان في أواخره«.
فما
أكثر الأدعياء
من أمثال
ميمون بن
ديصان
القدّاح اليهوديّ
الّذي كان
يدّعي أنّه
هاشميٌّ، فما
أكثر
أمثالُهُ بين
الأعجام وفي
البلاد الّتي
انتشرت فيها
الطرقُ
الصوفيّةُ،
وازدادت فيها
نشاطاتُ
السحرة
والمشعوذين!
أمّا
جميع ما نُقل
إلينا من
مناقب خواجه
نقشبند
وأقوالِهِ،
فانه لا يخلو
عن الشكّ في
النسبة إليه.
ولم يثبت منه
شيء بالدليل
القاطع أنّه
من كلامه، مما
يغلب أنّه كان
أمّيًّا. يدلّ
على ذلك قيامه
بخدمة أميرٍ
اسمه خليل آتا
مدةَ ستِّ
سنين بعيدًا
عن العلم
وأهله؛ حتّى
آل ملكُهُ إلى
الزوال.
أمّا
نسبته إلى
البيت
الهاشميّ،
فمشكوك فيه
أيضًا. لأنّ
أبناء هذه
الأسرة، قلّ
من يجهل منهم
اللّغة العربيّة.
بينما
بَلَغَنَا »أنّ
جدَّتَهُ قد
بشّرته
بنصيبٍ يناله
من شيوخ التُّرْكِ«،
حين فسّرت له
ما قصّ عليها
من منامه.
وهذا من قبيل
الاعتزاز
بالعشيرة. ولا
يعتز الإنسان
إلاّ بقومه؛
كما ينطبق نفس
الأمر على
شيخه كُلال بن
حمزة أيضًا.
وهنا
تعترضنا
عَبْرَ هذا
التحليل
موجةٌ من التعارض
بين مواقف
النقشبنديّين
وأقوالهم ورواياتهم،
سوف نتطرّق
إليها في
بابها بالتفصيل
إنْ شاء الله
تعالى.
هذا،
ومع أنّ
النقشبنديّين
لم يتوانوا عن
نقلِ كثيرٍ من
حكاياتٍ
أسطوريةٍ بعنوان
الكرامات
ضمنَ ترجمة
خواجه محمّد
البُخَاريّ،
ولكنهم قد
أمسكوا عن
تسجيل أدنى
إشارةٍ تدل
على أنّه
تكلّم عن
الرّابطة، أو
الختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
أو السلسلة،
أو عدِّ
ألفاظِ
الوردِ بالحُصِيِّ,
إلاّ ما سبق
إليه الكلام
أنّ المصطلحات
الثلاثة
الّتي أضيفت
إلى أركان
الطريقة النقشبنديّة،
هو الّذي
وضعها على ما
ورد في
مصادرهم. وهي »الوقوف
الزمانيُّ«
و»الوقوف
العدديُّ«
و »الوقوف
القلبيُّ[389]
***
* الحلقة
السادسة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
جاء
فيما كتبه
النقشبنديّون،
أنّ هذه الحلقة
يمثّلها رجل
خوارزميٌّ من
سكّان بُخَاريّ
أسمه علاء
الدين العطّار.
يغلب
أنّه تركيّ
الأصل كسائر
الروحانيّين
الّذين ظهروا
في هذه
المنطقة. إلاّ
أنّ حياته
وشخصيته الحقيقية
غير مذكورة في
تراجم الرجال.
وعلى الرغم
مما يزعمه
المتأخّرون
من شيوخ هذه
الطائفة أنّه »اختار
التجرّدَ
لتحصيل
العلوم في
مدارس
بُخَارَى
حتّى نبغ في
جميع الفنون
وبلغ منها فوق
ما تتعلّق به
الظنون...«؛[390] إلاّ
أنّ هذه
الرواية لا
سند لها، كما
تبدو في الوقت
ذاته أنّها
بعيدة عن
الحقيقة. لأنّ
علاء الدين
العطّار، لو
كان له أقلّ
نصيب من العلم
لظهرت ثمراته،
وَلَوَصَلَتْ
إلينا ضمنَ
إنتاجِ مَنْ
عاصره من
العلماء
كالشريف
الجرجانيِّ
الّذي نقل عنه
نور الدين عبد
الرحمن
الجامي أنّه
قال:
»لمّا
اتصلتُ
بالشيخ زين
الدين علي
كُلال، خلصتُ
من الرفض؛ و
لمّا وصلتُ
إلى الشيخ
علاء الدين
العطّار
عرفتُ الله
تعالى«.[391]
وقد
يسأل سائل:
بأنّ عالمًا
مثل
الجرجانيِّ يعترف
بقدر هذا
الرجل، ويقول »
لمّا وصلتُ
إلى الشيخ
علاء الدين
العطّار
عرفتُ الله«، مع
أنّ هذه
الكلمة لا
يجرؤُ على
التّفوّهِ بها
إلاّ
الزنادقةُ؛
لأنّهم يعنون
بها التعرّف
إلى ذات الله؛
فكيف يجوز لنا
أن لا نشكّ في
أمر
الجرجانيِّ؟
قلتُ:
أقرّ
الجرجانيُّ
أوّلاً على
نفسه بهذه
الكلمات
الواردة عنه
بالذات أنّه
إنّما خلص من
الرفض لمّا
اتّصل بالشيخ
زين الدين
عليِ كُلال.
ومعنى ذلك أن
غزارةَ علمه -
الّتي تشهد
عليها
تصانيفُهُ
القيمةُ -،[392] لم تُغن
عنه شيئّا،
فلم تخلص به
من ضلالة الرفض،
ولكنّه خلص
بعد ما اتّصل
بالشيخ زين الدين!
لقد تظهر
عقليةُ
الجرجانيِّ
وطبيعتُهُ العاطفيةُ
بكمال الوضوح
من خلال هذا
التحليل. فهو
كما قيل »علمه
أكثر من عقله«
فكيف إذن نضعه
موضعَ ثقةٍ
وهو يأتي
باعتراف أشد
وبالاً عليه
إذ يقول »لمّا
وصلتُ إلى
الشيخ علاء
الدين عرفتُ
الله تعالى. وقد مرّ
أنْ
شَرَحْنَا
مفهومَ »المعرفة
بالله«
في عقيدة
الصوفيّة.[393]
كان
علاء الدين
العطّار من
أبناء رجلً
غنيٍّ في
مدينة
بُخَارَى. »لمّا توفّي
والده ترك
ثلاثة أنجال.
خرج من ميراثه
لأخويه.«[394] واختار
أن يدخل غمار
التصوّف
بإيعاز من محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ. وأعرض
عن ملازمة
العلم كَعَدِيدٍ
من رجال هذه
السلسلة.
طالما
بذل
النقشبنديّون
جهودَهم
ليحشدوا من
أخبار
قدمائهم في
طيّات ما قد
صنّفوه. ولكنهم
لم يتوصلوا
إلى معرفةٍ
تفصيليةٍ عن
حياةِ عددٍ
كبيرٍ منهم.
لأنّ شيوخهم
الّذين عاشوا
قبل أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ،
في الحقيقة لم
يكونوا من ذوي
الجاه
والشهرة في
العهد
والمنطقة
اللّتين قضوا
فيهما حياتهم.
بل كلّ ما
نُسب إليهم من
الفضل
والكرامة
والعلم والزهد،
إنّما افترضه
واختلقه ذوو
الأهواء من أخلافهم
الّذين طمعوا
في الاشتهار
بعد ما علموا
أنهم لن
يتمكّنوا من
ذلك إلاّ
بالانتساب إلى
من
يُوَقِّرُهُ
الناسُ.
فنسجوا
حكاياتٍ
أسطوريةً حول
أسماء بعض
الدراويش
الّذين كانوا
قد ذهبوا مع
الريح، ولم
يعلم أحد أين
وقعت عظامهم
ورفاتهم. ثم
افترضوا لهم
أضرحةً فبنوا
علها
قِبَابًا
ضخمةً هابت
منها الناس
وعظَّمَتْهَا
وقدَّسَتْهَا.
ومن
جملة هؤلاء
الدراويش،
علاء الدين
العطّار. فانّ
الحكايات
المنسوجة
حوله، لا
يتسلى بها
العاقل ولا
يقتنع بها
العالم. ومع
ذلك لم يرد
ضمنَ هذه
الترجمة أدنى
إشارة إلى أنّ
علاء الدين
العطّار قد
تعبّد على
أسلوبهم أو
تكلّم عن
مصطلحالتهم
وتعاليمهم
وآدابهم.
***
* الحلقة
السابعة عشرة
من سلسلتهم.
هذه
الحلقة
يمثّلها رجل
اسمه يعقوب بن
عثمان بن محمود
الـﭽﺮخِيّ.
ولد الـﭽﺮخِيّ بقرب
غزنين. وهي
مدينة من مدن
أفغانستان.
تقع بين
قندهار
وكابول. وتوفّي
في قرية هلفتو
في تلك
المناطق عام 851. من الهجرة.
وأمّا تاريخ
ولادته، فلم
يتمكّن أحد من
إثباته حتّى
النقشبنديّون
أنفسهم. إلاّ
أنّ من بين
رجال هذه
الطائفة في تلك
الحقبة لعلّ
أبرز شخصية
جرى قلمُ
البحث في
أحواله هي
شخصية يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ لأسباب
هامّةٍ.
منها،
قيل إنّه درس
وتعلّم »ورحل
لتحصيل
العلوم إلى
هراة، ثمّ إلى
مصر المحروسة،
وتلقّى
العلوم الشرعيّة
والعقليّة عن
علمائها. ومن
أعظمهم
علاّمة عصره
الشيخ شهاب
الدين الشيرواني.«[395]
هكذا
ينقل عبد
المجيد
الخانيّ في
ترجمته. ومهما
كانت هذه
الأقوال
بعيده
الاحتمال فقد
نُسبت إلى
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ رسالة
عنوانها »الرسالة
الأُنسية«،
تدلّ على أنّه
كان يحسن
القراءة
والكتابة ولو
بالفارسيّة، -
إذا صحّ
إسنادها إليه
-. لأنّه لو صحّ
ذلك، لكان ورد
اسمه ضمنَ
تراجم الرجال
في تصانيف
الباحثين غير
النقشبنديّين.
وعلى اقل
تقدير، فانّ أوّل
باحثٍ منهم
عليّ بن
الحسين
الواعظ قد
اهتمّ بهذا
الرجل، وأولاه
شأنًا في
كتابه »الرشحات«
وهو أقدم مصدر
يعتمد عليه
النقشبنديّون.
جاءت
في كشف الظنون
عباراتٌ يقول
فيها المصنّف »رشحات عين
الحياة -
فارسيّ - في
مناقبِ النقشبنديّة
ورسومِ طريقتِهِمْ
ضمناً. لحسين
بن عليّ
الواعظ
الكاشفيّ
البيهقيّ
المشتهر
بالصفيِّ. قال
»ولمّا
شُرّفْتُ
بصحبة الشيخ
ناصر الدين
خواجه عبيد
الله مرة سنة 889 (تسع
وثمانين
وثمانمائة)،
وأخرى في سنة 893 (ثلاث
وتسعين
وثمانمائة)،
وكتبتُ ما
استفدتُ في
مجلسه
الشريف، أردتُ
أن أجمع في
ضمن مناقبهم
العلية «[396]
ثبت
بهذا أنّ
باحثًا
مؤرّخًا يخبر أنّه
اجتمع بشيخٍ
من قدماء هذه
الطائفة
مرّتين. وهو
عبيد الله
الأحرار
الّذي حلّ
مقام يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ شيخًا
للطائفة النقشبنديّة.
وستأتي
ترجمته إنْ
شاء الله
تعالى. يدلّ
هذا على شأن الـﭽﺮخِيّ في
الوقت ذاته.
ومن
الأسباب
الّتي تُثير
الاهتمامَ
بهذه الشخصية،
هو أنّه
معاصرٌ
لخواجه
نقشبند -
الّذي تُنسَب
إليه الطريقة النقشبنديّة-؛
وأنه صاحبه
وتلقّى منه
آدابَ هذه
الطريقة.
فانّ
اعتقادَه
العميقَ
بأستاذ
أستاذه خواجه
نقشبند، يبدو
من خلال ما
ينقل عنه
بالذات، فيقول:
»أقبل
عليَّ بوجهه
الكريم؛
فوجدتُ له
هيبةً في نفسي
وعظمةً في
قلبي،
وجلالةً في
نظري حتّى لم
أطق الكلامَ
في حضوره.
فقال لي قُدّس
سرُّهُ؛ ورد
في الأخبار:
العلم علمان؛
علم القلب
وذلك العلم النافع،
عَلِمَهُ
الأنبياءُ
والمرسلون؛ وعلم
اللسان، وذلك
حجّة الله على
خلقه. وأرجو
الله تعالى أن
يكون لك نصيب
من علم
الباطن. ثمّ
قال ورد في
الخبر إذا جالستم
أهلَ الصدق
فجالسوهم
بالصدق فإنّهم
جواسيس
القلوب
يدخلونها
وينظرون إلى
قلوبكم.«[397]
إنّ
نسبة هذه
العبارات إلى
خواجه
نقشبند، وإن
كانت لا تقوم
على برهان
قاطع، ولكنها
تدل على
معرفةٍ دقيقة
للنّاقل، على أنّه
يمتاز بمهارة
في فنون الأدب
والبلاغة
والإنشاء، -
طبعًا إذا
كانت هذه
الترجمة العربيّة
مطابقةً
للنّص
الفارسي من
كلام يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ
ولعلّ
أهمّ الأسباب
الّتي تُثير
الاهتمامَ بشخصية
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ، هو أنّه
أوّل من نطق
بكلمة »الرّابطة
وإنْ ظلّت
الرّابطة
محصورةً في نطاق
تصوّرٍ
محدودٍ في
عهده.
كلّ
هذه
المُعطيات
نستدلّ بها
على أنّ لهذا
الرجل دورًا
هامًّا في
بناء هذه الطريقة
الصوفيّة.
لأنّه قد رأى
في نفسه حقَّ
التصرُّفِ،
فأضاف إليها
مبدءًا أصبح
فيما بعد من
أهمّ أركان العقيدة
النقشبنديّة.
***
* الحلقة
الثامنة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
هذه
الحلقة لا
تقلّ شأنًا عن
الحلقة
السابقة
للسلسلة
بدءًا من
خواجه نقشبند.
يمثّلها رجل
اسمه ناصر
الدين عبيد
الله الأحرار
بن محمود بن
شهاب الدين.
ولد
خواجه أحرار
عام 806 من
الهجرة
الموافق 1403 من الميلاد
بمدينة
طاشكند في
غضون الحروب
الّتي نشبت
بين تيمورلنك
وبين أبي يزيد
يلدرم بن مراد
العثمانيّ.
وتوفي عام 895 هـ. الموافق 1490م. بمدينة
سمرقند. وهو
تركيّ الأصل
كسائر رجال
السلسلة
الّذين ظهروا
في تلك
المنطقة.
ويزعم بعضهم
أنّ أمّه تتصل
بعُمر بن
الخطاب نسبًا.
يمتاز
الأحرار
بمكانته الاجتماعيّة
وقدرته
المالية على
الرغم من
إعراضه عن
الدراسة
والتعلم. جاء
في ترجمته أنّه
تَرَبَّى في
حجر خاله
الشيخ إبراهيم
الشاشي. ويقول
الأحرار عن
خاله هذا:
»لم
يألُ جهدًا في
أن أتعلّم
حتّى أرسلني
من طاشكند إلى
سمرقند رجاء
ذلك. فكنتُ
كلما ذهبتُ
إلى الدرس
أصابني مرض
يمنعني عنه.
فذكرتُ له
حالي: وإنّك
إن كلّفتني
بالتحصيل
ربما أموت.
فتوقّفَ،
وقال يا ولدي
أنا لم أعلم
حقيقة حالك،
فاذهب وافعل
ما تريد.
وأردتُ أن
أقرأ يومًا
فرمدتْ
عيناي؛ ولم
أزل كذلك خمسة
وأربعين يومًا.
فحينئذ
تركتُ، ولم
أصل في
القراءة إلاّ إلى
المصباح في
النحو.«[398] ولعلّ
الكتاب
المذكور هو
المصباح
للإمام ناصر
الدين عبد
السيد
المطرزي
المتوفى سنة 610 هـ.
بهذا
نهتدي إلى أنّ
شيوخ النقشبنديّة
قد ألَمُّوا
بالدراسة
والتعلّم
بدءًا من عبيد
الله الأحرار
على الرغم من
احتقارهم
للعلوم العقليّة
واكتفائهم
بقليل منها. وَرَدَ
في مكتوبات
الربّانيّ
أنّ للخواجه أحرار
رسالة فارسية
بعنوان »الفقرات«[399]
يمتاز
عبيد الله
الأحرار
خاصّة بعلاقاته
مع ملوك عصره،
وبتداخُله في
مناسباتهم وخلافاتهم.
يقول في ذلك
عن نفسه:
»لو
أنِّي تصدّرتُ
للمشيخة ما
أبقيتُ لأحد
من مشائخ
العصر مريدًا؛
ولكنّ الله
أمرني بأمر
آخر. وهو
إنقاذ
المسلمين من شرّ
الظلمة وأيدي
المخالفين.
ولهذا خالطتُ
السلاطين
ابتغاء
تسخيرهم لنفع المسلمين.«[400]
حقًا
ليس للإنكار
على هذا القول
من سبيل، لولا
قال »ولكن
الله أمرني«.
إلاّ أنّ
الأحرار لم
يتوقّف عند
هذا الحدّ؛ بل
تجاوزه
بادّعاء
غريب، قال
فيه:
»أعطاني
الحقُّ تعالى
في التصرّف
قوةً عظيمةً
بحيث لو
أرسلتُ ورقةً
إلى ملك الخطى
وهو يدّعي
الألوهية، لجاء
حافيًا بلا
توقّف. ومع
هذا لا أتصرّف
في ملكه تعالى
بقدر ذرة؛ بل
أقف عند حدّ
أمره عزّ
وجلّ. فانّ من
آداب هذا
المقام أن
تكون إرادتُكَ
تابعةً
لإرادته جلّ
وعلا، لا
العكس.«[401]
يتظاهر
الأحرار في
نهاية هذه
العبارات
باعتقادٍ لا
يخالفه مسلم.
وهو الّذي
أظهر في قوله »أن تكون
إرادتك
تابعةً
لإرادته جلّ
وعلا.« ولكنّ
هذا الاعتقاد
يتعارض مع ما
أفصح به في مستهلّ
كلامه »أعطاني
الحقُّ تعالى
في التصرّف
قوةً عظيمةً...«!
انتقلت
إلينا جلّ
المعلومات
الخاصّة
بالأحرار عن طريق
عليّ بن
الحسين
الواعظ صاحب
كتاب الرشحات
وهو عديل نور الدين
عبد الرحمن
الجامي، أى
زوج أخت
امرأته.[402] ومرّ
ضمنَ ترجمة
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ، أنّه
زار عبيد الله
الأحرار مرّتين
كما ورد في
موسوعةٍ
للنقشبنديّين،
أنّه أقام
سنين في مجالس
الأحرار.[403] ولا غرو
أن من أسباب
شهرة الأحرار،
احتفاء
العلماء به؛
وعلى رأسهم
نور الدين عبد
الرحمن
الجاميّ. وَرَدَ
في الرشحات أنّه
اجتمع به أربع
مرّات وراسله
مرارًا.[404] وما قيل
عنه أنّه
تدخّلَ في
مصالحة
الملوك، يغلب
أنّ له أساسًا
من الصحة. حيث
جاء ذلك في
كتاب الرشحات
بصراحةٍ
وتفصيل.[405]
إنّ
عبيد الله
الأحرار هو
ثاني من أقرّ
الرّابطة من
رجال هذه الطائفة؛
وزادها شأنًا
في الطريقة.
لأنّه بدأ يلقّنُها
المريدين كما
يشهد على ذلك
قول عبد المجيد
بن محمّد
الخانيّ إذ
يقول:
»المير
عبد الأوّل هو
صهره الأطهر،
والوارث
لسرّه
الأنور؛ اشتغـل
برابطته سبع
سنين.«[406] ولكن لا
نعتقد أن تكون
الرّابطة قد
تحولت إلى ركن
للطريقة في
تلك الحقبة
على خلاف ما
يدّعيه
النقشبنديّون.
ويزعمون أنّ
الطريقة
تسمّت
بالأحرارية بدايةً
من عهده إلى
زمن أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ.
كلّ
هذه المعطيات
تبرهن على أنّ
عبيد الله
الأحرار كان
رجلاً
مرموقًا، ذا
شأنٍ ومكانة
في بلاد
ماوراءالنهر؛
وكان أوسع
شهرةً من
أسلافه؛ بحيث
قفزت الطريقة النقشبنديّة
إلى إسطنبول
بجهود تلميذٍ
له يُدعى عبد
الله الإلهي.
وَرَدَ
في رسالة
للشيخ قسيم
الكُفْرَويّ:
أنّ ملوك المغول
الّذين ظفروا
بإقامة دولةٍ
لهم في الهند،
كانوا على
صلةٍ قويّةٍ
بأبناء عبيد
الله الأحرار
وخلفائه،
أسوةً بسيرة
آبائهم مع
الأحرار.[407]
***
* الحلقة
التاسعة عشرة
من السلسلة النقشبنديّة.
هذه
الحلقة هو
القاضي محمّد
زاهد البدخشيّ.
استخلفه
الأحرار
لمكانته
عنده؛ وربما
لقرابته إلى
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ (شيخ
الأحرار).
لأنّ قاضي محمّد
زاهد هو ابن
أخت يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ.
توفي
البدخشيُّ
سنة 936 من
الهجرة،
الموافق لعام 1529 من الميلاد
بقرية الوحش
من ضواحي قصبة
الحصار على
مقربة من مدينة
سمرقند. أمّا
تاريخ
ولادته، فإنّه
مجهول.
صحب
عبيدَ الله
الأحرارَ اثنا
عشر عامًا و»صنّف كتابًا
في فضائله
وشمائله
سمّاه سلسلة العارفين
وتذكرة
الصدّيقين.«[408] وينسب
إليه كتاب آخر
بعنوان »المسموعات«[409] جمع فيه
ما سمع من
شيخه عبيد
الله الأحرار.
يبدو
من عبارات
مَنْ ترجم له أنّه
قد درس
وتعلّم،
ولكنه أعرض عن
دراسة العلم
بعد أن التقى
بخواجه
أحرار؛
فانثنى إلى
التصوّف
والسلوك في
الطريقة النقشبنديّة.
هذا
ومع أنّه
معروف بالقاضي،
لا نعلم ما
إذا تولّى
منصبَ القضاء
في حياته، أم
كان ذلك مجرّد
لقبٍ أُطلقَ
عليه لمناسبة
ما. إنّ البدخشيَّ
والحلقتين
بعده، لم
يتمتّعوا بالشهرة
المتعارفة
لشيوخ النقشبنديّة
بدءًا من
الأحرار حتّى
يومنا هذا؛ وربما
لعدم توغّلهم
في التصوّف
والشعوذة.
***
* الحلقة
العشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
يلوح
لنا من خلال
متابعتنا
لسلسلة
الروحانيّين
في هذه
الطريقة، أنّ
القرابة
الصهرية والنسبيّة
بدأت تؤثّر
على رأيهم بعد
إمامهم خواجه
نقشبند وأصبح
استخلاف
الأقارب من
العادة الشائعة
عندهم. بينما
كانوا سابقًا
يتلقّون
عقائدهم من
أبعد الناس
إليهم، وحتّى
من الأموات -
على حدّ قولهم
-.
إذ
نكتشف أنّ
محمدًا
البدخشيَّ قد
حلّ مكان عبيد
الله الأحرار.
ولعلّه أحرز
هذا المقام لقرابته
ممن استخلف
الأحرار كما
ذكرنا آنفًا.
ثمّ نكتشف أن
محمدًا
البدخشيَّ هو
الآخر قد استخلف
الدرويش
محمدًا السمرقنديّ،
وهو ابن أخته.
فصار الدرويش
بهذا الاستخلاف
هو الحلقة
العشرين
للسلسلة النقشبنديّة.
إنّ
هذا الرجل لا
نجد له ولا
لشيخه ذكرًا
في تراجم
الرجال. وهو
تركيّ الأصل
كسائر أسلافه
الّذين ظهروا
في هذه
المنطقة.
مات
الدرويش محمّد
السمرقنديّ
عام 970 من
الهجرة الموافق
لسنة 1562 من
الميلاد. أمّا
تاريخ
ولادته، فلم
يقف عليه أحد
حتّى النقشبنديّون
أنفسهم.
***
* الحلقة
الحادية
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
جرت العادة
نفسها في
استخلاف هذا
الرجل أيضًا
إذ هو ابن
درويش محمّد
السمرقنديّ؛
ولا ذكر له في
التراجم، سوى
ما جاء في بعض
وريقات
النقشبنديّين
أنّ اسمه محمّد
الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲ - بالكاف
الفارسيّة -،
وأنّه ولد عام
918 من
الهجرة
الموافق لسنة 1512 من الميلاد؛
ومات عام 1008 هـ. الموافق
لـ 1599 من
الميلاد.
يبدو
أنّه قد قضى
جميعَ حياتهِ
في قريةِ
أَمْكَنَهْ
بضواحي مدينة
بُخَارَى؛
وعاش تسعين
عامًا
معزولاً عن الدنيا
وخاملاً في
هذه القرية.
***
* الحلقة
الثانية
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
قفزت
الطريقة النقشبنديّة
من بلاد التُّرْكِ
إلى الساحة
الهندية بوساطة
هذه الحلقة.
وهو الباقي
بالله
الكابُلى، خليفة
محمّد الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲ.
ولد
الباقي بالله
سنة 971 من
الهجرة (1563م.)
بمدينة كابُل
عاصمة
أفغانستان
اليوم. ومات
عام 1012 هـ.
الموافق 1603 م. بمدينة
دلهي
(جهانآباد)
الهندية.
ورد
في مصادر
النقشبنديّين
أنّه سافر إلى
سمرقند،
وتعلّم على
الشيخ صادق
الحلوائيّ.
ولكن لا ذكر
له ولا لهذا
الشيخ في
تراجم الرجال.
وأعرض عن
الدراسة
استخفافاً
بالعلم
كعامّة أسلافه
بإقرار مَن
ترجم له من
أعيان هذه
الطائفة. مع
ذلك يحاول
النقشبنديّون
أنْ
يُفَخِّموُهُ
ويجعلوه من
ذوي الشأن
والمكانة في
عصره كعادتهم
في مدح سائر
مشائخهم.
ورد
في موسوعةٍ لهم
»أنّ
شخصيةً اسمه
عبد الرحمن
خان المشتهر
بـ (خانِ
خانان)، كان
على كمال
المحبّةِ له
وعالقًا به.«[410] وكلمة »خان خانان«
فارسية
معناها ملك
الملوك. غير
أننا لا نعثر على
شيء من
الاشتهار
لهذا الاسم في
تلك الحقبة
والمنطقة. بل
كانت مقاليد
الأمور يومئذ
في الساحة
الهندية بيد
الطاغية
المغول جلال
الدين محمود
المشتهر بـ »أكبر شاه«،
ملك الدولة
الّتيمورية.
ومعلوم أنّ
الملك المذكور
كان شديد
العداوة للمسلمين
من جراء ما
وجد في شيوخ
الصوفيّة من التعصب
والتطرّف.
فدفعه الأمر
إلى قهر
المسلمين
وإذلالهم
واضطهادهم،
ومساندة المشركين
الهندوس.
ومن
جملة هذه
المبالغات في
تفخيمه
والدعاية له
قول عبد
المجيد
الخانيّ: »فأقبلَتْ
إليه الأمم
بما جذبهم من
علوّ الهمم
وقوّة
التصرّفات الإلهيّة.«.
ويدّعي أنّ
قبره على غربي
مدينة دلهي
عند أثر قدم
النبي r[411]
والحقيقة أنّ
النبيّ u لم
تطأ قدمُه
الأراضي
الهندية أصلا!
كان
الباقي بالله
على طبيعةٍ لا
يأنِسُ إلاّ في
الخرائب،
يبحث عن أهل
المسكنة من
الدراويش
والكسالى
باعتراف من
ترجم له من
مفتتني هذه النحلة[412]
أمره
شيخه الأَمْكَنَگِيّ
بالرجوع إلى
بلاد الهند.
فرجع وزاول
نشاطه في بثِّ
عقائد النقشبنديّة
حتّى اتصل به
رجل سرهنديٌّ
اسمه أحمد
الفاروقيّ.
كان ذلك من أكبر
حظوظه. لأنّه
إنّما اشتهر
بجهود
السرهنديّ
الّذي لعب
دورًا هامًّا
في استمالة
قلوب الناس
إليه بأسلوبه
الخاصّ. ولمّا
اشتهر مريده السرهنديّ،
اشتهر هو
الآخر بدوره.
وما
قيل أنّ الشيخ
أحمد بن عبد
الرحيم
المعروف بـ »شاه ولي الله
الدهلويّ«
قد مدحه في
كتابه »الانتباه
في سلاسل
الأولياء«[413] لا عبرة
به، ولا ذكر
لهذا الكتاب
ضمن قائمة مصنّفات
أحمد بن عبد
الرحيم
الواردة في
كُتُب التراجم
المعتبرة.[414] كما أنّ
الدهلويّ
هذا، هو أيضًا
لم ينجُ من
التأثّر
بالعقائد
الهندية على
ما يبدو من محبّته
لشيوخ
الصوفيّة رغم
باعه الطويل
في علوم
الحديث. وربما
رجع عن رأيه
فيهم.
وقد
جاء في
الحدائق الورديّة
لعبد المجيد
بن محمّد
الخانيّ أن
خالدًا
البغداديّ قد
زار ابنَهُ عبد
العزيز
الدهلويّ، أيّامَ
إقامته
بالهند،
فاستقبله
بحفاوة. وَرَدَ
ذلك ضمنَ
ترجمة خالد
البغداديّ في
الكتاب
المذكور. من
الجدير بالإشارة
هنا، إلى أنّ
هذه النـزعة
هي القاسم المشترك
بين غالب
علماء الهند،
حتّى السلفيّين
منهم. ولهذا
نلمس من آثار
التسامح مع
الصوفيّة
فيما كتبه أبو
الحسن
الندويّ
وغيره من النابغين
على الساحة
الهندية.
أمّا
قيام الباقي
بالله بدعوة
الناس إلى
الطريقة النقشبنديّة
في بلاد
الهند، فغير
واضحة
المعالم، على
خلاف ما
يدّعيه
النقشبنديّون.
وربما كانت
دعوته على غير
الأسس الّتي
وضعها رجال
هذه الطائفة. لأنّ
النقشبنديّين
أنفُسَهم لم
يذكروا: هل إنّه
كان يمارس
الرهبنة على
أساس المبادئ
الأحد عشر،
وهل كان يأمر
بإقامة حفلة »ختم
الخُوَاجَگَانْ«
سوى ما ورد في
الموسوعة
المذكورة: أنّه
كان يأمر
مريديه
بملاحظة
صورته في
ذهنهم فحسب.[415]
***
*
الحلقة
الثالثة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة
لقد
بذل
النقشبنديّون
قصارى جهودهم
في تفخيم مَنْ
جعلوه رمزًا لهذه
الحلقة من
سلسلتهم حتّى
سمّوه »الإمام
الربّانيّ«.
ولا يجوز
عرفًا أنْ
يكون هو الّذي
عظّم نفسَه
بهذا العنوان
على الرغم مما
نُقل عنه وعن
غيره من شيوخ
هذه الطائفة
من مدائحَ
ذاتيةٍ لا تُسْتَحْسَنُ
من أهل العلم
والشأن بحجّة
التحدّث
بنعمة الله.
وهذا يدلّ على
المستوى
الأخلاقيّ
لأرباب هذه
النحلة، وأنّهم
كيف يتصرّفون
بالمدح
والذم..
أمّا
اسمه الّذي لم
يشتهر به بعد
أن طغى عليه عنوانه
الشائع
المذكور
آنفًا، فهو
أحمدُ بنُ عبدِ
الأحدِ
الفاروقيُّ
السرهنديُّ.
يزعم
النقشبنديّون
أنّه ينحدر من
سلالة أمير
المؤمنين عمر
بن الخطاب رضي
الله عنه.[416]
وُلِدَ
السرهنديّ
عام 971 من
الهجرة
الموافق لسنة 1563 من الميلاد؛
وذلك في عهد »أكبر
شاه«[417] ثالث
ملولك الدولة
الّتيمورية
المغولية في الهند.
شاهد تلك
الأحداث
الرهيبة
الّتي أقدم على
إجرائها »الملك
أكبر«
للقضاء على
الإسلام. غير
أنّنا لا نعثر
على مقاومةٍ
أكيدةٍ
وجادّةٍ
للسرهنديِّ
في وجهه إلاّ
القدر اليسير
الّذي جاء في
سطور ضمنَ
مقدّمة كتابه »إثبات
النبوّة«[418] وعلى
أيّ حال فانّ
دفاعه عن
نبوّة محمّد r
في وجه سلطان
جائر ومارق،
لا شكّ
يُعَدُّ مثالاً
من البطولة
والغيرة الإيمانيّة
الصادقة لولا أنّه
عبث
بالقِيَمِ
وأطال
واسترسل في
مسائلَ
فلسفيةٍ
كلامية
أَرْبَكَ بها
كثيرًا من
الناس حتّى التبس
عليهم الحق
بالباطل.
يتنافس
النقشبنديّون
في مدحه
وإجلاله وتقديسه
بأساليب
غريبة على
الإسلام. منهم
محمّد مراد بن
عبد الله
القازاني[419] الّذي
عرّب
مكتوباته.
يقول
القازانيُّ:
»فهذه
درر مكنونات
منيفة برزت من
أصداف عبارات
المكتوبات
الشريفة
للإمام
الربّانيّ،
والغوث
الصمدانيّ،
والقطب
السبحانيّ،
والعارف
الرحمانيّ،
نقطة دائرة
الإرشاد،
رحلة الأبدال
والأوتاد،
قدوة
الكمالات
الأفراد، واقف
الأسرار الإلهيّة،
كاشف الدقائق
المتشابهات
القرآنية،
برهان
الولاية
الخاصّة المحمّديّة.«[420]
هذا
الأسلوب، قد
اعتاده
النقشبنديّون
في حديثهم عن كلّ
من اتفقت
كلمتهم على
تعظيمه خاصّة
بعد موته. ذلك
أنّ
المشهورين من
شيوخهم، لم
يكن أحدهم قد
ذاع اسمه في
حياته بالوجه
الّذي يذكره
ملايين
النقشبنديّين
بعد موته بهذا
الأسلوب إلا
قليل. كعبيد
الله الأحرار
وخالد البغداديّ.
لا شكّ
تُنبؤنا
عادتهم هذه،
عن العقليّة
الّتي تسود
على اتجاههم
وتفكيرهم في
الإنسان
وقيمته
الشخصية. ولكن
الّذي لابدّ
هنا أن نتساءل
عنه، هو
قسطاسهم في
تعظيم الإنسان
وتبجيله
بأوصاف لا
يقره الإسلام
بوجه من الوجوه.
فليت شعري كيف
عرف
القازانيُّ
أنّ أحمد
السرهنديّ »واقف على
الأسرار الإلهيّة«؛
وما عسى هي
تلك الأسرار؟!
هذا،
وحتّى ربّ
العزة جلّ
سلطانُهُ لم
يمدح الّذين
اصطفاهم على
العالمين من
عباده المرسلين
بأمثال هذه
الألفاظ مع
جلالة قدرهم
ومكانتهم
عنده. وعلى
سبيل المثال،
فقد قال
سبحانه في
خطابه لنبينا محمّد
صلّ الله عليه
وسلّم
وَإِنَّكَ
لَعَلى خُلُقٍ
عَظِيمٍ.[421] ولم يقل
له إنّك واقف
على أسراري.
كذلك مَدَحَ
طائفةً من
الأنبياءِ
فَقَالَ: وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى
قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاء إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ
* وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَقَ وَيَعْقُوبَ كُلاًّ هَدَيْنَا وَنُوحًا
هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ
وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ
* وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَى وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كلّ مِّنَ الصَّالِحِينَ
* وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلاًّ فضَّلْنَا عَلَى
الْعَالَمِينَ.[422] ولم يقل إنّهم
واقفون على
أسراري.
ويقول
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ في
مدح
السرهنديّ
أيضًا:
»دُرَّةُ
إكليل
الأولياء
العارفين، وغُرَّةُ
جبين
الأصفياء
الغُرِّ
الْمُحَجَّلين،
كنـز فضائل
السلف
والخلف،
وجامع فرقان
المحامد والمكارم
والشرف، طور
التجلّيات
الذاتية، وسدرة
منتهى العلوم
الأحدية،
ومنهل معارف الوراثة
المحمّديّة،
ومظهر إرشاد
الحقائق
الأحمدية...«
ولكن
الخانيّ لم يتوقّف
عند هذا
الحدّ؛ بل
ازداد
تكلّفًا
وتنطّعًا فقال:
»أخبر
بوجوده رسولُ
الله r
فقال، يكون في
أمتي رجل يقال
له صلة. يدخل
بشفاعته كذا
وكذا...«[423]
على
الرغم من
إطناب
النقشبنديّين
في مدح هذا الرجل
وتعظيمه
وإجلاله، وما
حشو في بطون
كتاباتهم من
قصصٍ أسطوريةٍ
بعنوان
مناقبه
وكراماته،
فإننا لم نجد
في كتب أرباب
الدراسة
والبحوث
التاريخية
شيئًا يبرهن
على صدق هؤلاء
الدراويش
المتنطّعين،
سوى سطورٍ
يسيرةٍ لِبَاحِثَيْنِ[424] لا تعدو
عن ذكر مولده
وموته وأسماء
مؤلّفاته فحسب.
أما
أبو الحسن
الندويّ
الّذي أفرد
مجلّدًا خاصّا
في ترجمته،
فلا عبرة به.
أولاً:
لأنّه معروف
بموقفه
الحياديّ،
وإعجابه بكلّ
من اشتهر،
سواء أكان على
الحق أم على
الباطل؛
ثانيًا:
إنّه من أبناء
وطن
السرهنديّ، ومن
المتشرّبِين
عقائد
الديُوبنديّةِ،
وهي طريقة
صوفيّة خطيرة
تستقي مع
الطريقة النقشبنديّة
من منهل واحد. فلا
غرابة إذن في
إلمامه بصاحب
الترجمة أكثر من
أي باحث
أجنبي، خاصّة
فانّ الطبيعة
المضطربة
للعنصر
الهنديّ لابدّ
وأنْ يكون
للندويّ
أيضًا منها
نصيب ولو
بأقلّ نسبةٍ.
فقد
شرح الندويّ
أوضاعَ
المرحلة
الّتي عاش فيها
السرهنديّ،
وذكر المشاكل
بالتفصيل، والمرارة
الّتي ذاقها
المسلمون
يومئذ على يد
الطاغية »أكبر
شاه«
المغولي ضمن
الجزء الثالث
من سلسلة »رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام«.
إلاّ أنّه
استقى أكثر
معلوماته
الخاصّة
بالسرهنديّ
من مصادر
النقشبنديّين
الحشويّين
المتوغّلين
في السجع
والأساطير.
وبالخلاصة
يظهر أنّ الندويّ
ليس من عادته
الانتقاد،
ولو على سبيل
التنبيه
والتصحيح.
أمّا
السرهنديّ،
فقد ترك ورائه
أكداسًا من
رسائل
متفرّقةٍ،
بعثها إلى هذا
وذك؛ لم يستقر
في جميعها
بجانب الصواب
دائمًا. بل
تذبذبت
أقواله بين
الحقّ
والباطل كما
سيشهد القارئ
هذه الحقيقة
في نماذج مختلفة
منها
أوردناها
فيما يلي
للمقارنة.
كتب
السرهنديّ
جميع رسائله
باللّغة الفارسيّة
سوى عدد قليل
منها جدًّا.
وعرّبها رجل اسمه
محمّد مراد
القازانيّ.
إنّ
هذه الرسائل
في الواقع لا
تمثّل أيةَ
قيمةٍ علميّةٍ
أو ثقافيّةٍ
أو أدبيّةٍ
بمحتوياتها.
لأنها لا تأتي
بشيءٍ جديدٍ،
ولا تنحلُّ
بها مشكلةٌ من
مشاكلِ المسلمين؛
ولا تظهر
المقاصد فيها
بوضوح. يؤكّد
على هذه
الحقيقة
استغناء رجال
العلم عنها.
فلا تكاد تجد
عالمًا من
علماء
المسلمين
يعتدّ بها أو
يستدلّ بشيءٍ
من مضامينها.
وإذا كان بعض
الناس
يتدارسونها،
فإنّهم جموع
من البسطاء والنقشبنديّين
الّذين لا
يدخلون ضمنَ
أهل العلم في
حقيقة الأمر.
يتبيّن
بوضوح أنّ
أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ لم
يبال بما
سيُسْفِرُ عن
كلماته
وعباراته الّتي
ألقاها على
عواهنها
وسجّلها بين
الفينة
والأخرى على
هيئة رسائل
وجّهها
للنّاسِ. فجاءت
آراؤه
متضاربةً في
الغايةِ. وعلى
سبيل المثال،
يقول في
رسالةٍ بعثها إلى
شخصٍ اسمه
نظام
التهانيسري:
»اعلم
أنّ مقرّبات
الأعمال إمّا
فرائض، وإمّا
نوافل.
فالنوافل لا
اعتبار لها في
جنب الفرائض
أصلاً. فانّ
أداء فرض من
الفرائض في
وقت من الأوقات
أفضل من أداء
النوافل ألف
سنة.«[425]
هذه
كلمة حقٍّ
ربما لا يختلف
فيها أحد من
المسلمين معه.
ولكن يناسب
هنا أن ننتقل
إلى رسالة
أخرى من مكتوباته
الّتي وجّهها
إلى شخصٍ اسمه
محمود. يقول
فيها:
» فاعلم
أيها المخدوم[426] ولابد
للإنسان من
ثلاثة أشياء
حتّى تتيسّر
النجاة
الأبدية:
العلم،
والعمل،
والإخلاص. والعلم
على قسمين:
قسم المقصود
منه العمل.
وقد تكفّل بيانَه
علم الفقه؛
وقسم،
المقصود منه
مجرّد الاعتقاد
واليقين
القلبيِّ.
وذُكر هذا
القسمُ في علم
الكلام
بالتفصيل على
مقتضى آراء
أهل السّنّة
والجماعة
الّذين هم
الفرقة
الناجية. ولا
إمكان
للنّجاة ولا
مطمع لأحد
فيها بدون إتّباع
هؤلاء
الأكابر. فان
وقعت
المخالفة لهم مقدار
شعرة، فالأمر
في خطر أي خطر!
وهذا الكلام
قد بلغ من
الصحّة مرتبة
اليقين
بالكشف الصحيح
والإلهام
الصريح«.[427]
لقد
ظهر في سطوره
الأخيرة من
هذا التفسير
الصوفيّ أنّ
غرضه
الحقيقيَّ لم
يكن التأكيد
على تلك
الأشياء
الثلاثة
الهامّة،
وإنّما كان
همه وقصده أن
يجلب الانتباه
إلى الكشف
والإلهام ليس
إلا! ذلك لأنّ عامة
الصوفيّة،
والنقشبنديّين
على وجه الخصوص،
لا يتكلّمون
عن شيء إلاّ
ويربطونه
بعلم الغيب،
ولا يتصدّون
للحديث في أمر
إلاّ ويجعلون
له قرينةً
بعلمٍ سابقٍ،
ولا ينقلون من
قولٍ أو عملٍ
عن شيوخهم
إلاّ
ويحملونه على
إشارات ورموز
منهم لما سوف
يقع في
مستقبلٍ من
الزمان على
أنّها من
كراماتهم.
وهكذا لو نطق
أحدهم بكلمةِ
حقٍّ لا يبرح
حتّى يعبث بها
فيجعلها مما
ثبت بشهادة
أهل الكشف
والإلهام؛
كما سبق في
عبارات
السرهنديّ
آنفًا؛ في
الحين الّذي
لم تكن هناك
أدنى مناسبة
بين الموضوع
الّذي طرق
إليه
السرهنديّ،
وبين الكشف
والإلهام على
الإطلاق. وهذه
الحقيقة
ثابتة
بإقراره في كلامه
المنقول
بالذات. إذ
قال بعد ما
قسم العلوم
إلى شطرين: »قِسْمٌ،
المقصود منه
العمل، وقد
تكفّل
بيانَهُ علمُ
الفقهِ؛
وقسم، المقصود
منه مجرّد
الاعتقاد
واليقين
القلبيِّ. وذُكر
هذا القسم في
علم الكلام
بالتفصيل.«
إذًا،
فما الّذي
يحتاج هنا إلى
الكشف والإلهام؛
وما هي
العلاقة بين
هذه الألفاظ،
وبين قوله »وهذا كلام قد
بلغ من الصحّة
مرتبة اليقين
بالكشف
الصحيح
والإلهام
الصريح«؟!!
ولهذا
السبب، من نظر
في دفاع أبي
الحسن
الندويّ عنه
بأنّه »أثبت
عَجْزَ
العقلِ
والكشفِ
وقصورَهما في
إدراك الأمور
الغيبيّة«[428] اطّلعَ
بالتأكيد،
على مدى
ارتباك
السرهنديّ
والاضطراب
الّذي في
كلامه،
وتناقضاته مع
نفسه؛ وأدرك
أيضًا أنّ أبا
الحسن
الندويّ قد أحسن
الظنّ بهذا
الرجل دون
رويّةٍ وبلا
اعتماد على أي
حجّةٍ، بل قد
باء بفشل ذريع
في هذا الدفاع
العاطفيّ
الرخيص.
لقد
بلغ عددُ
مكتوباته
ستًّا
وثلاثين
وخمسمائة
رسالة تشتمل
على ما سجّل
من الغث
والسمين؛
ووجّهها إلى ناسٍ
أكثرهم
الملالي
والدراويش
وأبناء الخانقاهات
المُقَبِّعُونَ
على أنفسهم في
جوٍّ من
الرهبنة،
ومبتعدون عن
الحياة الاجتماعيّة
والسعي
والإنتاج. وله
عُجالاتٌ
وكُتيباتٌ وَرَدَ
أسماؤها في
ترجمته، وهي:
رسالة
المبدأ
والمعاد، وإثبات
النبوّة، والمعارف
اللدنّية، وَرَدُّ
الشيعة.
عاش
السرهنديّ في
عهد الطاغية
المغول عدوّ الإسلام
والمسلمين
محمود جلال
الدين
المعروف بـ »أكبر
شاه«
الّذي كان
متأثّرًا
بالديانة
البرهمية والزرادشتية،
حتّى خلع ربقة
الإسلام من
عنقه واختلق
دينًا
شيطانيًّا
على أساس
الكفر بالوحي
والنبوّات.
فدعا الناس
إليه؛ فلم
يستجب له إلا
ثمانية عشر
رجلاً؛ على
الرغم من
إمكاناته الواسعة
للدعاية
والدعوة
وتسحير
العقول. فزاده
ذلك غضبًا على
الإسلام.
فأوقع
بالمسلمين
وأرهبهم
بأبشع مظاهر
القهر و أشدّ
أساليب
الإذلال
والتنكيل.
من
الجدير
بالإشارة هنا
للمناسبة إلى
أنّ هذا الملك
الدمويَّ
الجاهل
الزنديق إنما
وقع في أحابيل
الشيطان
بتأثير مَنْ كانوا
حوله يومئذ من
علماء السوء
وشيوخ الصوفيّة
المتنافسين
في احتلال
المناصب
والمتنازعين
على المصالح؛
وبسبب ما كان
يشهد من الخلاف
والصراعِ
بينهم؛
والابتذال في
سلوكهم؛ والانحراف
في عقائدهم
وأفكارهم؛
مما جعله يفقد
ثقته بهم. هذا
على كثرة شيوخ
الطرق
الصوفيّة في الساحة
الهندية؛
وعلى الرغم من
اشتهار عدد منهم
بالغوثية
والقطبيّة في
تلك المناطق؛
ومع هيبتهم
على الناس
وقدرتهم في
توجيه
المجتمع؛
بحيث لو
اتّفقت كلمتهم
لأرغموه على
أن يمصَّ
بَظْرَ
أُمِّهِ! لأنّه
كان يعظّمهم
ويقف منهم
موقف الإجلال
والتوقير في
المرحلة
الأولى من
حكمه. وليس
معنى هذا أنّ
السرهنديّ لم
يعارضه. ولكنّ
مشائخ الطرق
الصوفيّة
عامّةً، والسرهنديّ
خاصّة لم
يكونوا على
شيء من صفات
النبيِّ r
وأصحابِهِ من
أخذ الأمور
بالحكمة
والحيطة؛ وبذل
المال
والمُهْجَةِ
في ساعة
الكفاح؛ والوقوف
في وجه العدوّ
بروح البسالة
والبطولة؛
والمعرفة
بفنون الجهاد
والقتال حتّى
يتمكّنوا من
ردّ الأمور
إلى نصابها. لأنّ
حياة
الروحانيين
تتميّز
بالعزلة والصمت
والمسكنة
والرهبانية؛
فهي تختلف عن
حياة الأنبياء
والمرسلين،
والتابعين
لهم في سنّتهم
وسلوكهم
الّذين لا
يبخلون
بأموالهم وأنفسهم
في سبيل الله
عند ما يترتّب
عليهم البذل
بمقتضى الحال
والظروف.
فإنّهم
أولياء الله
{أَلاَ إِنَّ
أَوْلِيَاءَ
اللَّهِ لاَ
خَوْفٌ
عَلَيْهِمْ
وَ لاَ هُمْ
يَحْزَنُونَ.}[429]
أمّا
أولياء
الصوفيّة،
فلم يَسمع أحد
من المؤمنين
أنّهم دخلوا
معركةً
وقاتلوا
لحظةً في سبيل
الله. فهذا
الغزاليّ ـ
على سبيل
المثال ـ
الّذي
تُعظّمه
الصوفيّة
بعنوان »حجّة
الإسلام«،
وتبالغ في
تفخيمه
والثناء
عليه، وتُشيّد
بذكر
تصانيفه؛ »إنّه كان
خلال الحروب
الصليبيّة
مشغولاً في
خلوته تارةً
في منارة دمشق
وتارة في صخرة
القدس، يغلق
بابهما عليه
في مدةٍ تزيد
على سنتين. بل
إنّ الغزاليّ
شهد سقوط
القدس في أيدي
الصليبيّين،
وعاش اثنتي
عشرة سنة بعد
ذلك، ولم يشر
إليه في
كُتُبه.«[430]
فلمّا
تولّى نور
الدين
جهانكير بن »أكبر
شاه«
السلطنة فور
موت أبيه لم
يكن يومئذ
للسّرهنديِّ
شخصية بارزة
في أوساط
العلماء
بالساحة الهندية،
ولا كان يمتاز
بشهرةٍ لدى
علماء البلاط
الملكيِّ.
أقرَّ الندويّ
بالذات عن هذه
الحقيقة، في
كتابٍ أفردَهُ
لذكر حياة
السرهنديّ
ومع أنّه لم
يدخل في هذا
الموضوع إلاّ
ليعظِّمَ من
شأنه،
وليؤكِّد أنّه
»الإمام
الربّانيّ«!
اعترفَ
بالواقع فقال:
»إنّه لم
يتوصّل إلى
نقطة البداية
للتأثير على
أصحاب
السلطة،
وسياسـة
الدولة فيما
يتعلّق بالإسـلام
والمسلمين،
وتوجيه
الميول والنـزعات
إلى الإسـلام.«[431]
فمادام
السرهنديّ لم
يتوصّل إلى
نقطة البداية
للتأثير على
أصحاب السلطة
يومئذ ولم يسـتطع
أنْ يحرّك
ساكنًا؛
بإقرار هذا
الباحثِ الهنديّ
الْمُعْجِبِ
به، والمؤكِّد
على وصفه بـ »مجدّد الألف
الثاني«؛ فما عسى
إذن هي
الأعمالُ
التجديديةُ
الّتي قام بها
السرهنديّ؛
وما هي
آثارُهُ و
إنجازاتُهُ -
وقد بلغ من
العمر اثنين
وأربعين
عامًا يوم
تربّع
جهانكير على
عرش المملكة -
؟!! هذا بالإضافة
إلى أنّ الملك
جهانكير
إنّما أمر باعتقاله
بعد مضيِّ
أربعة عشر
عامًا على
تولّيه
السلطنة. وذلك
سنة 1028 من
الهجرة؛ وقد
بلغ
السرهنديّ
يومئذ من العمر
سبعًا وخمسين
عامًا. زد على
ذلك أنّ السبب
الحقيقيَّ
لاعتقاله ليس
كما قيل هي
مضامينُ رسالته
الموجَّهة
إلى شيخه،
ومحتوياتُهَا
الخطيرةُ
الّتي أثار غضبَ
الملك لما
فيها مخالفة
صريحة لروح
الكتاب
والسّنّة،
كما ليس
رفضُهُ سجدةَ
التحيّةِ
للسّلطان هو
السببَ
الأصليَّ
لاعتقاله
بخلاف ما
يزعمه
النقشبنديّون.
بل الذريعة
الّتي اتخذها
الملك لإصدار
الأمر
باعتقاله، هو
ما كان يجري
بينه وبين
رجال البلاط
من علاقات
خاصّة، وما
كان من حبّهم
وإجلالهم له،
كما يقول الندويّ
[432]» وما زال
سلاطين
المغول
يتوجّسون
خيفةً من مغالاة
الناس في
اعتقادهم
وحبّهم
وإجلالهم للمشائخ،
والْتفافهم
حولهم،
وتهافُتهم
عليهم تهافت
الفراش على
النور«.
كلّ
هذه الحقائق
تدلّ على أنّ
السرهنديّ لم
يستحق ذلك الشأن
العظيم الّذي
يُعزىَ
إليه بصفة »المجدّد
لألف الثاني«. في
الحقيقة إنّ
النقشبنديّين
وحدهم، هم
الّذين خلعوا
هذا العنوان
عليه ليستفيدوا
من طنينه
وليواصلوا
مسيرتهم بهذا
الأسلوب من
الاستغلال.
ولو كان
السرهنديّ
مجدِّدًا بالمعنى
الحقيقيِّ
لحرّر
الإسلامَ عما
أُلصِق به من
بدع البرهمية
والبوذية؛
ولحارب شيوخَ
الصوفيّة
الّذين كانوا
يدسّون تعاليم
»اليوغا«
في العقائد الإسلاميّة،
كما يبرهن على
هذه الحقيقة
ما جاء في
كلام أبي
الحسن
الندويّ
بالنسبة
للطريقة الشطّارية.
إنّه يقول:
»وقد
مزّجتْ هذه
الطريقة
لأوّل مرةٍ
تعاليم
اليوكا
بالتعاليم
الصوفيّة،
واختارت من الأولى
بعضَ
الرياضيّات،
والأورادَ،
وحبسَ النفَسِ؛
ولقّنَتْ هذه
التعاليمَ
المريدين والسالكين؛
كما ضمّتْ إلى
الطريقة علمَ
السيمياءِ.
وقد جاءت
تفاصيل هذه
الأوراد
وشروح الرياضيات
الخاصّة في
الرسالة
الشطّارية الّتي
ألّفَها
الشيخ بهاء
الدين
إبراهيم
الأنصاري
القادري،
وتوجد قصيدة
للشيخ محمّد
الشطّاري في
كتابه (كليد
مخازن) - مفتاح
الخزائن -
تفيد عقيدة
وحدة الوجود،
وعدم التفريق
بين المسجد
والبيعة،
والمسلم
والبرهميِّ«[433]
أمّا
ربّانية
السرهنديّ،
فهي أيضًا صفة
لا نجد لها
وجهًا من وجوه
المشابهة
بالربّانيّة
الجامعة
لصفات المؤمنين
في كتاب الله
العزيز.
وإنّما
الربّانيّون
هم
{الْمُؤْمِنُونَ
الّذينَ
إِذَا ذُكِرَ
اللهُ وَجِلَتْ
قُلُوبُهُمْ
وَإِذَا
تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ
آياتُهُ
زَادَتْهُمْ
إِيمَانًا
وَعَلَى
رَبِّهِمْ
يَتَوَكَّلُونَ
* الّذينَ يُقِيمُونَ
الصلاةَ
وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ
يُنفِقُونَ.}[434] هم
{الّذينَ
قَالَ لَهُمْ
الناسُ إِنَّ
الناسَ قَدْ
جَمَعُوا
لَكُمْ
فَاخْشَوْهُمْ
فَزَادَهُمْ
إِيمَانًا
وَقَالُوا
حَسْبُنَا
اللَّهُ
وَنِعْمَ
الْوَكِيل.ُ}[435] هم
الّذين
يعترفون
بذنوبهم،
ويقرّون
بالعجز
والتقصير،
ويرفضون
الشهرة
والسمعة
والأبّهة
والخدم
والحشم، ولا
يطمعون في
الثراء
والمكانة عند
الناس؛ بل
يحرصون
ليحظوا بما
عند ربهم؛
و{لاَ
يُرِيدُونَ
عُلُوًّا فِي الأَرْضِ
وَلاَ
فَسَادًا.}[436] هم
الّذين قال
الله تعالى
فيهم {مِنْ
الْمُؤْمِنِينَ
رِجَالٌ
صَدَقُوا مَا
عَاهَدُوا
اللهَ عَلَيْهِ،
فَمِنْهُمْ
مَنْ قَضَى
نَحْبَهُ
وَمِنْهُمْ
مَنْ
يَنْتَظِرُ
وَمَا
بَدَّلُوا
تَبْدِيلاً.}[437]
أمّا
الّذين
بدّلوا دين
الله بفكرة »وحدة
الوجود«
و »وحدة
الشهود«
و »الكشف«
و »الإلهام«
و »الأويسية«؛
وحرّفوه
بممارسة
أشكالٍ من
مناسك مجوس
الهند؛ كصلاة »اليوغا«
الّتي سموها »الرّابطة«،
و »الختم
خُوَاجَگَانِيَّة«،
وعدّ الأذكار
بالحصى،
والتركيز على
صورة شيخ
الطريقة وما
إليها من
تقاليد عبدة
الأوثان
وطقوسهم؛
فكيف بنا أن
نَعُدَّهُمْ
من أبناء
الأمّة المحمّديّة
والملّة
الإبراهيمية
الحنفاء؛
فضلاً عن أن يستحقّ
أحدُهم صفة
المجدّد لهذا
الدين وهو
غارق في عالم
التصوّف
والشعوذة
والوهم
والخيال!!
إنّ
هذا العالَمَ
الغامض الوعر
المشبوه الّذي
نصطدم ببعض
معالمه من
خلال رسائل
السرهنديّ،
يثير
انتباهنا نحو
بلاد الهند
الشهيرة بمجتمعاتها
المتباينة،
ولغاتها
وعاداتها المتنوّعة،
وتقاليدها
الغريبة،
وعقائدها
الخليطة، وفلسفاتها
المعقَّدَة،
ورهبانها
ومتصوِّفتها
وسَحَرَتِهَا
الطائشة
المتزاحمة،
وما إلى ذلك
من مظاهرَ
عجيبةٍ لا
تتّصف بها
بلدٌ آخرُ في بقيّة
أنحاء العالم.
وكذلك هذه
الحقائق تفتح
لنا نافذةً
هامّةً إذا
أطللنا منها
على العالَمِ
الهنديّ بكلّ
مظاهره،
وبحثنا في
طيّات تاريخه
بِعُمْقٍ وإمعانٍ
اصطدمنا
بحقيقةٍ
رهيبة أخرى.
وهي أن الأكثرية
من المجتمع
الإسلاميِّ
في تلك المناطق،
قد تأثّروا
قليلاً أو
كثيرًا
بالأفكار والديانات
والعقائد
والعادات
والتقاليد الغريبة
المتباينة
والمتزاحمة
على امتداد
ساحاتٍ
شاسعةٍ في
الديار
الهندية. وإذا
كان »الملك
أكبر« قد
انبهر
بالديانة
البرهمية
والزرادشتية
تمامًا، فانّ
ذلك لا يعني
أنّ
السرهنديّ لم
يتأثر بشيءٍ
منها وعلى
الرّغم من دفاعه
عن الشريعة المحمّديّة
وتحريضه على
متابعة
السنّة
النبويّة من
خلال رسائله
المذكورة،
إلاّ أنّنا نعثر
في الوقت ذاته
على مقالاتٍ
له تستمدّ من لبِّ
تلك العقائد الوثنيّة.
وكأنّها
تتسرّبُ من
قلوب
الفلاسفة
والرهبان.
يقول في إحدى
هذه المقالات:
»اعلم
أنّ العناية الإلهيّة
جذبتني جذب
المرادين
أوّلاً، ثم
يسّرت لي طيَّ
منازل السلوك
ثانيًا؛
فوجدتُ الله
سبحانه
أوّلاً عين
الأشياء؛ كما
قال أرباب
التوحيد
الوجوديِّ من
متأخّري
الصوفيّة؛ ثم
وجدتُ الله في
الأشياء من
غير حلولٍ ولا
سريانٍ؛ ثم
وجدتُ سبحانه
معها بمعيّة
ذاته؛ ثم
رأيتُهُ
بعدها؛ ثم
قبلها. ثم
رأيتُهُ سبحانه
وما رأيتُ
شيئًا. وهو
المعنى
بالتوحيد الشهوديِّ
المعبَّرِ
عنه بالفناء.
وهو أوّل قدمٍ
توضَع في
الولاية،
وأسبق كمالٍ
في البداية.
وهذه الرؤية
في أيّ مرتبةٍ
من المراتب
المذكورة
تحصل أوّلاً
في الآفاق، ثم
ثانيًا في الأنفس.
ثم ترقيتُ في
البقاء. وهو
ثاني قدمٍ في
الولاية.
فرأيت
الأشياء
ثانيًا.
فوجدتُ اللهَ
عينَها بل
عينَ نفسي. ثم
وجدتُهُ
تعالى في الأشياء،
بل في نفسي؛
ثم مع الأشياء
بل مع نفسي. ثم
قبل الأشياء
بل قبل نفسي.
ثم بعد
الأشياء بل
بعد نفسي. ثم
رأيتُ
الأشياء وما
رأيتُ الله
تعالى أصلا.
وهي النهاية
الّتي هي
الرجوع إلى
البداية
والعود إلى
مرتبة العوام.
وهذا المقامُ
هو أتمُّ
مقامِ دعوةِ
الخلقِ إلى
الحقِّ،
وأكمل منازل
التكميل
والإرشاد لتمام
المناسبة
للخلق
المقتضية
لكمال الإفادة
والاستفادة.[438]
هل
يجد من ذاق
حلاوةَ
الإيمانِ
بالله واليوم الآخر،
هل يجد
مَسْحةً من
كلام أهل
اليقين الصادق
في هذه
العبارات
الخطيرة الّتي
تُنبئ عن
غطرسة
قائلِها
وتطاوله في
وجه الحق
سبحانه؟! تُرى
ما الّذي جعله
يتحدّى بهذا
الادعاء
الجريء؛ وما
الّذي دفعه
ليتمرّد على
الله بهذه
الكلمات
الّتي لا تدلّ
بوجه من الوجوه
على إيمانه
بالله الواحد
الأحد الفرد الصمد
الّذي ليس
كمثله شيء؛
وما الّذي
أغراه حتّى
وجد نفسَه
مضطرةً
لتزخرف له ما
لم يقل به
رسولُ الله r،
ولا أحدٌ من
الصحابة
والتابعين،
ولا أحدٌ من
العلماء
المحقّقين
الّذين لم
يخرجوا عن
جادّة الحق!
لعلّ
السبب - على
حسب رأيه - أنّ
الّذي خُيِّل
إليه هو نعمة
من الله (!)
لأنّه يذكر في
مستهل مقال
آخر له،
الآيةَ
الكريمةَ
{وَأَمَّا
بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ
فَحَدِّث.ْ}[439] ثمّ
يستطرد
قائلاً: »كنتُ
في حلقة الذكر
مع أصحابي
فخطر لي أنّي
في قصور ونقص.
فأُلْقِيَ
إليَّ في
الحال: أنّي قد
غفرتُ لك ولمن
توسّل بك
بوساطة أو
بغير واسطةٍ
إلى يوم
القيامة.[440]
يبدو
بوضوح من هذه
العبارات أنّ
السرهنديّ
كان يعاني
حالاتٍ
نفسيةً
خطيرةً، إذ
بلغت به
المعاناة
حتّى ادّعى
أنّ الله أوحى
إليه وقال له »إنّي غفرتُ
لك ولمن توسّل
بك بوساطة أو
بغير واسطةٍ
إلى يوم
القيامة«.
هذه
الألفاظ
الجريئة لا شكّ
قد أحبط
أعمالَ
الباحثين
الّذين
شمّروا عن ساق
الجدّ ليدافعوا
عن السرهنديّ
بأنّه لم يخرج
من دائرة
الكتاب
والسّنّة؛
خاصّة الّذين
شاركوا النقشبنديّين
في خلع
العناوين
المصطَنَعَةِ
عليه، ووصفوه
بالقطبيّة
والغوثيّة،
بل وبالمجدّديّة؛
كما يبرهن على
سطحية البحث
الّذي تناول
فيه أبو الحسن
الندويُّ
حياةَ
السرهنديِّ، وعمّا
كتبَ في الجزء
الثالث من
سلسلة رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام. فإنّ
الندويَّ -على
الأقل- قد
ألّفَ هذا
الكتابَ بدون
رويةٍ
وتعمُّق. ولا
يفوتها بهذه
المناسبة أن
نذكر اسمَ
باحثٍ آخر لم
يغفل عمّا
ارتكب
السرهنديّ من
الجنايات على
الإسلامِ،
وهو حسن
بن على العجمي، ألّف
كتابًا سمّاه:
العصب
الهندي
لاستئصالِ
كفريات أحمد
السرهندي. شَرَحَ
فيه ما يُغني
القارئَ عن كلّ
ما كُتِبَ عن
الشرهنديّ
مدحًا وذمًّا.
***
يزعم
النقشبنديّون،
أنّ
السرهنديّ
جاء ليجدّدَ
الإسلامَ؛ ولِيُعيد
له طراوته
وحيويته.
ولهذا
يعظّمونه
بعنوان »المجدّد
الألف الثاني«. كما
يُطلِقون
بهذه
المناسبة
اسمَ »المجدّديّة«
على الطريقة النقشبنديّة،
بدايةً من
عهده إلى زمن
خالد
البغداديّ.
ولكنَّ
التاريخَ
يشهد على ما
قد ذهب من
جمال الإسلام
وصفائه على يد
السرهنديّ
وخلفائه ربما
أكثر مما أذهب
به الطغاة
الّذين
أنزلوا ضربات
قاصمة
بالإسلام
والمسلمين من
أمثال الملوك الأمويين،
والعبيديين،
وهولاكو،
وتيمورلنك،
وأكبر شاه،
وموشي غوميل
السالونيكي!
وبالخلاصة
فانّ رسائلَ
السرهنديّ
وعُجَالاَتِهِ
تشتمل على
أفكارٍ
غريبةٍ،
وعقائدَ خطيرةٍ،
وآراءَ
متناقضةٍ،
وأساليبَ
فلسفيةٍ
وكلاميةٍ؛
يرتبك بها
الجاهل
ويتعجّب منها
العالم
وتستشكل على
المخلص في
حياده، فلا
يكاد يستخلص
صحيحَها من
سقيمِها
ليبرهن به على
ما يعتقد في
قائله من
الاستقامة
وحسن
الالتزام
بالكتاب
والسّنّة.
وبالتالي
فانّ حسن الظن
به لايُغْنِي
عن الباحث
المحايد في
محاولته
لإبراء ساحة السرهنديّ
مهما تأوّل
أقوالَهُ.
لاجرم
أنّ أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ
كان ذا شأن،
ولكن ليس
بعلمه؛ بل
بِالْتفافِ
جمهورٍ من
حثالة الناس
حوله؛ كغالب
شيوخ هذه
الطائفة.
وربما لهذا
السبب كان له
تأثير على بعض
الملوك ورجال
السلطة. فقد
جاء في
موسوعةٍ
للنقشبنديّين
أنّه أرسل كتابًا
كان قد ألّفه
بعنوان »رد
الروافض«،
أرسله إلى عبد
الله خان، ملك
الأُزبك؛
يندّد فيه
بالشيعة،
ويرميهم
بالحمق
والسخافة؛ ويطلب
من الملك
المذكور أن
يرسل كتابه
هذا إلى العبّاس
الصفوي شاه
إيران. فإذا
اعترف بما فيه
وتاب، فبها.
وإلاّ وجب
قتاله.[441] فامتثل
الملك عبد
الله خان
لأمره وعرض
الكتابَ على
شاه إيران؛
ولكنّ الشاه
رفض المطلوب
منه بحكم
الطبع. إذ ليس
من السهل أن
يتخلّى
الإنسانُ عن
عقيدةٍ تشرّبَها
إلى أعماق
ضميره منذ
نعومة أظفاره،
فيتبرّأ منها
في لحظةٍ مهما
كانت باطلة،
ليعتنق عقيدة
جديدة؛
وبخاصّة إذا
اصطدم بإكراه
على ذلك. ولا
يخفى أنّ
أعمال
الإرشاد
والدعوة لا
تنتهي
بالنجاح إلاّ
بأسلوبه
الخاص الّذي
أوضحه الله
تعالى في
كتابه العزيز
بقوله {ادْعُ
إِلَى
سَبِيلِ
رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ
بِالّتي هِيَ
أَحْسَنُ
إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ
أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ
سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِين.َ}[442]
ولكن
يبدو أنّ
الملك عبد
الله خان قد
اختار أسلوبَ
الملوك على
الأسلوب
القرآنيِّ
الحكيم بتأثير
السرهنديّ.
ذلك {إِنَّ
الْمُلُوكَ
إِذَا
دَخَلُوا
قَرْيَةً
أَفْسَدُوهَا
وَجَعَلُوا
أَعِزَّةَ أَهْلِهَا
أَذِلَّةً
وَكَذَلِكَ
يَفْعَلُونَ.}[443] فما كان
من الطرفين
إلاّ وحَمِيَ
الوطيسُ بينهما
ذهبت في غمرته
ألاف من
الضحايا!
تأصّل
بُغض الرافضة
في قلوب
النقشبنديّين
بعد هذه
الواقعة
وأصبح ميّزة
تتّصف بها
السنيّة التقليديّة
وانتشر
بانتشار
الطريقة النقشبنديّة.
وهو السبب
الرئيس للخلاف
والصراع
والحروب
المستمرة بين
الأتراك
والفرس عبر
العصور. ولكنّ
كثيرًا من
الناس يجهلون
أنّ هذه
العداوة
الّتي بثها
السرهنديّ
بين أتباع هذه
النحلة، لم
تنبت في قلبه
لما كان يرى
في عقيدة
الشيعة من
الخروج على
الإسلام؛ بل
نشأت بسببِ
منافسِتِه
لبعضِ رجالِ
الْبلاطِ
الملكيِّ
الّذين كانوا
من الشيعة.
لقد كان بين
السرهنديّ
وبينهم صراع
شديد على
المصالح. فغلب
تأثير الفريق
الشيعي منهم
على الملك
جهانكير حتّى أوعزوا
إليه
بتنكيله؛
فأمر
باعتقاله في
قلعةِ »كُوَالْيَارْ«،
لبث فيها ثلاث
سنين.
لابدّ
وأن نشير أخيراً
إلى أنّ أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ هو
رجلٌ وجوديٌّ
بشهادته على
نفسه وإطرائه
على كبير الوجوديّين
محي الدين بن
عربي؛ إذ
يقول:
»قد
كُشِفَ لي
التوحيد
الوجوديُّ
وأُلْقِىَ
إلىَّ علوم
كثيرة ومعارف
جمّة ورقائق
وافية من هذا
المقام؛
ولاحت لي
معارفُ
مُظهِرِ
الصفة العلميّة
الشيخ
الأكبر...
وتشرّفتُ
بالتجلّي
الذاتيِّ الّذي
بيّنه الشيخ
وجعله نهاية
العروج وخصّه
بخاتم
الولاية
مفصّلاً
وموضّحًا«.[444]
هكذا
يبدو جليًّا أنّه
قائلٌ بوحدة
الوجود،
وواقف موقفَ
الإجلال من
محي الدين بن
عربي، بخلاف
ما ادّعىَ
البعضُ من هذه
الطائفة: »إنّه
برئٌ من تلك
العقيدة،
وأنّه إنّما
قال بوحدة الشهود
ليبرهن به عن
بطلان وحدة
الوجود«. ومهما
كان، فانّ فكرة
»وحدة
الشهود«
أيضا عقيدة
غامضة.
وإنْ
فَرَضْنا أنّ
غرَضَه من »وحدة
الشهود«
هو وحدة
المشهود، أي
هو إقرارٌ
بوحدة الموجودات
القابلة
للشهود بصفة المخلوقية
على سبيل تنـزيه
الخالق
الباري عن
إحاطة العبد
به في نطاق ما
يُبصره؛ فان
هذا الغرض، بل
هذا الإقرار
لا يقوم مقام
حدّ جامع
لكافة
المخلوقات.
وإنما يشتمل
على كلّ ما
يدخل في نطاق
البصر فحسب،
ويخرج من هذا
الحدّ بقيّة
المخلوقات من
المحسوسات
وغيرها؛
فضلاً عن أنّ
كلمة »وحدة
الشهود«
تعبير كلاميّ
غريب ومعقّد،
لم يرد في
الكتاب والسّنّة،
ولم يتكلّم به
أحد من السلف
الصالح.
إنّ
هذه الأفكار
الدخيلة،
وأنماطًا
أخرى من أمثالها
إنّما تسرّبت
إلى الطريقة النقشبنديّة
في عهد أحمد
الفاروقيّ
وخلفائه،
فتحوّلت هذه
الطريقة إلى دينٍ
مستقلٍّ
برسومها
وطقوسها
وآدابها وأركانها،
خاصّة بحكم
كون هؤلاء
الرجال من
عناصر هنديةٍ
مجبولة على
التقليد بسبب
صلتهم الدائمة
مع البراهمة
والسيخ
والبوذيّين
في الهند. وهي
ساحة نائية عن
قلب بلاد
الإسلام. وأنّ
الإسلام
إنّما انتشرت
في تلك
المناطق عن
طريق الوفود
من رجال
التجارة
والسياحة
الّذين لم يكونوا
أصلاً من أهل
العلم
والإختصاص في
الدعوة
والإرشاد؛
ولم تكتمل
فيهم الكفاءة
في توجيه
المشركين إلى
الدين الحنيف
بالوجه
الصحيح؛ وإن
فرضنا أنّ
عددًا كبيرًا
من تجّار
المسلمين قد
احتسبوا لله
في نشر
الرسالة المحمّديّة
بين مجوس
الهند عبر
العصور.
هكذا
تغذّت
الطريقة النقشبنديّة
بالعقائد
المحلّية في
ديار الهند
ونمتْ على
قاعدةٍ من
تعاليمها مدة
مائتين
وخمسين عامًا
منذ عهد
السرهنديّ
حتّى وجدتْ
مَنْ يقفزُ بها
إلى الساحة
العراقيّة
عام 1811م.؛ ويَبُثُّهَا
في ربوع
المملكة العثمانيّة.
ألا وهو خالد
البغداديّ
الّذي طوّرها
وصبّها في
قالب آخر مع
خلفائه كما
سنشرح
أحوالَهم
فيما يلي كلاًّ
على حدة إنْ
شاء الله
تعالى.
***
* الحلقة
الرابعة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
استخلف
أحمد
الفاروقيّ
ابنه محمدًا
المعصومَ؛
فأصبح هذا
الخلفُ بذلك
هو الحلقةَ
الرابعةَ
والعشرين من
سلسلة
الروحانيّين
للطّريقة النقشبنديّة.
وصار
استخلافُ
الأولاد
والأقارب بعد
الفاروقيّ من
العادة
الشايعة بين كُبَرَاءِ
هذه الطائفة؛
كما تحوّلتْ
عائلاتُ
شيوخِ النقشبنديّة
إلى سلالاتٍ
مقدّسةٍ،
ذاتِ مكانةٍ
مرموقةٍ ومتفوّقةٍ
على طبقات
الناس في
المجتمعات
العجمية
الخليطة من التُّرْكِ
والكرد
والفرس
والهنود
والمغول
والأقلّيات
القوقازية
نتيجة هذه
العادة.
ولد
المعصوم عام 1007 من الهجرة
الموافق لسنة 1599 من الميلاد
بقرية »مُلْكِ
حَيْدر«
التابعة
لمدينة
سرهند، ومات
في هذه
المدينة عام 1079 من الهجرة
الموافق لسنة 1668 من الميلاد.
كان محمّد
المعصومُ
أيضًا على
عقيدة
الوجوديّة
كوالده. ولكنه
جاء بتفسير
باطنيٍّ
جديدٍ لهذه
العقيدة
فطوّرها
بإضافة مفهوم »الْقَيُّومِيَّةِ«
إليها. إلاّ
أن هذا
التفسير لم
يحظ بشيءٍ من
الاهتمام
والشيوع بين
الصوفيّة. بل
ظل مهمَلاً في
تضاعيف ما
كتبه وخلّفه
من رسائلَ غيِر
ذاتِ قيمةٍ لا
يلتفت إليها
اليومَ أحدٌ حتّى
النقشبنديّون.
ذلك أنّ مفهوم
»الْقَيُّومِيَّةِ«
فكرةٌ غامضةٌ
معقَّدَةٌ
جدًّا؛ يأبى
التصوّر
البشريُّ أنْ
يستوعبها،
لصياغتها
بنسيجٍ من
هفواتٍ غريبة
وعبارات
متشابكةٍ
بأسلوبٍ
صوفيٍّ صلبٍ
ومركَّز.
ومن
جملة ما سجّله
محمّد
المعصوم في
هذا الصدد -
على ما نقله
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ -،
قوله: »القيّوم
في هذا
العالم،
خليفة الله
تعالى ونائب
منابه؛
والأقطاب
والأوتاد
والأبدال والأفراد
مندرجون تحت
ظلاله«.[445]
هكذا
قال بصراحة،
وهذا يدل على
عقيدته
بالاختصار.
وما
رُوِيَ عنه في
تراجمه على
سبيل
الكرامات والخوارق
الظاهرة على
يده، كتحويل
الورق إلى
الذهب والفضة
وما أشبه[446] يبرهن
على أنّه كان
يتعاطى السحر
والشعوذة.
وذلك ليس
ببعيد عن
الشيوخ ذوي
الأصول
الهندية.
***
*
الحلقة
الخامسة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
عاد
الاستخلاف في
الأسرة
الربّانيّة
ثانية فأنتجت
لهذه الطريقة
شيخًا
ثالثًا، وهو
سيف الدين بن محمّد
المعصوم
الفاروقيّ
الّذي
يُعَدُّ هو
الحلقةَ
الخامسةَ
والعشرين من
سلسلتهم.
ولد
سيف الدين عام
1049 من
الهجرة
الموافق لسنة 1630 من الميلاد
بمدينة
سرهند؛ ومات
بها سنة 1098
الموافقة
لعام 1696 من
الميلاد.
تعلّم
سيف الدين على
عمِّهِ محمّد
سعيد
الفاروقيّ.
وتولىّ تربية
الملك »أوْرَنگْزِيبْ
عَلَمْگِيرْ بن
شهاب الدين محمّد
شاه جِهَانْ«،
ملك الدولة
المغولية
الهنديّة. ثم
تربّع على عرش
النقشبنديّة
بعد أبيه، واتّخذ
أسلوب جدِّهِ
في بَثِّ
عقيدته عن
طريق
المراسلة. بلغ
عدد رسائله
مائة وتسعين
مكتوبًا
جمعها ابنه محمّد
الأعظم.
يغلب
أنّ الشهرة
الّتي امتاز
بها سيف
الدين، لم تكن
بسبب تفوّقه
في العلم
والمعرفة؛
وإنّما كانت
وراثيةً.
لأنّه لم
يتغيّر به شيء
في الطريقة النقشبنديّة
ولا حدث أيّ
تطوّر
وازدهار في
الدولة
المغولية
الهندية في
عهده.
***
* الحلقة
السادسة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
هذه
الحلقة
يمثّلها رجل
اسمه نور محمّد
البدوانيّ.
لم
يتّصل ذكره
بأيّ إنجاز أو
نجاح أو بطولة
حظي المسلمون
بشيءٍ من
آثارها. أمّا ما
قَصَّتْهُ النقشبنديّة
من حكايات
أسطورية على
سبيل الكرامة
له، فإنها
ليست مما
يُعتدُّ بها.
يبدو
أنّه كان
رجلاً
خاملاً،
مغمورًا،
نازعًا إلى
التطرّف
والشعوذة.
حُكِىَ أنّه »أَدخل مرةً
رجلَه اليمـنى
إلى بيت
الخلاء،
فانقبض ثلاثة
أيّام من مخالفته
للسّنّة«[447] كما
حُكِيَ أنّه »لكثرة ما كان
يُطَأْطِئُُ
رأسَهُ
ويُقَبِّعُ، تقوّس
ظهره«.[448]
يبالغ
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ في
مدحه بأسلوبه
المسجّع،
فيقول: »وافتخر
به فريق
الطريق شرقًا
وغربًا،
فانظُرْ كيف
سلّم نفسَه
للسيف لينال
شهادة السعادة
وسعادة
الشهادة
ويحيا الحياة
الأبديةَ (من
قَتَلْتُهُ
فأنا ديتُهُ)«[449]
تفنّن
الخانيّ هنا
في استعراض
بلاغته - إذ هو أديب
النقشبنديّين
-؛ فاستعمل
كلمة »السيف«
على سبيل
المجاز في
قوله »فانظر
كيف سلّم نفسه
للسيف...« وهو في
الحقيقة ليس
إلا الشيخ سيف
الدين الفاروقيّ.
ولكن الخانيّ
استعار منه
معنى السيف
الّذي هو
السلاح
التقليدي المعروف.
هذه
الصيغة
المنسوجة
بلهجة المكر
ولغة الحيلة،
قد يرمز إلى
حقيقة رتّبها
الخانيّ في
صورة لُغْزٍ
لكي لا يتبلور
الأمر أمام كلّ
الناّس
فيُصبِحَ
موضوعَ
النقاش
والتحليل والتأويل،
حفظًا على
سُمعة
الروحانيّين
في المجتَمَع،
وخشية أن تسقط
هيبتهم من
قلوب الناس.
ذلك
أنّ قوله »فانظر
كيف سلّم نفسه
للسيف...« يحتمل
معنيين:
أحدهما
حقيقيٌّ. وهو
أنّ نور محمدًا
البدوانيّ قد
قُتل بصورةٍ
فعليةٍ. وهذا
قد يكون له
أساس من
الصحّة. لأنّ
الربّانيّ كان
قد شدّد
النكير على
الرافضة.
فأدّى ذلك إلى
عدائهم على
خلفائه. كما
قيل أنّ شمس
الدين حبيب
الله ميرزا
مظهر جان
جانان قد
قُتِلَ على
أيديهم؛ وهو
من خلفاء نور محمّد
البدوانيّ.
وثاني
المعنيين
مجازيٌّ،
سبقت إليه
الإشارة
آنفًا. يعني
ذلك: أنّ نور
محمدًا
البدوانيّ سلّم
نفسَهُ للشيخ
سيف الدين
الفاروقيّ،
فنال بذلك
مرتبة
الشهادة. لأنّ
ما تكابده في
سلوكه تحت
إشراف الشيخ
سيف الدين
يُعَدُّ نوعًا
من الفداء
بالنفس.
هذا
الرجل الّذي
تكلّف
النقشبنديّون
في تبجيله
وتعظيمه
بأساليبَ
مزخرفةٍ، لا
علم لأحد بتاريخ
ميلاده على
الرغم من
زعمهم بـ »أنّ
كشفَ حضرة
السيد كان على
غايةٍ من
الصحّةِ«.[450] فلم
يسبق منه أن
ذكر شيئًا فيه
تصريح بتاريخ ميلاده.
وقيل مات
البدوانيّ
عام 1135 من
الهجرة
الموافق لسنة 1722 من الميلاد.
***
*
الحلقة
السابعة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة
يحمل
سمة هذه
الحلقة رجل
اسمه شمس
الدين حبيب الله
ميرزا مظهر
جان جانان.
وهو هنديّ
الأصل
كمشائخه
الأربعة
الّذين قبله.
ويبرهن هذا
الاسم
الموزون على حقائقَ
هامّةٍ
تتميّز بها
شخصيتُهُ
وحياتُهُ؛
كما وردت في
عبارات
سجّلها الشيخ
قسيم الكُفْرَويّ،
أحد البارزين
بين شيوخ هذه
الطائفة في
عصرنا.
يقول
الكُفْرَويّ
عنه: »انتسب
إلى
البدوانيّ
ولم يتجاوز
عمره الثامنة
عشرة. كان
يرتدي بأدنى
ما يستر به
عورته، يجول
في الصحاري
ويأكل من ورق
الشجر. وهكذا
أمضى أربع سنين
حياة
الدراويش،
فأذاق أربابَ
الطريقة ألوانًا
من الحُبّ
الأفلاطونيِّ«.[451] يبدو من
هذه العبارات أنّه
لم يأكل اللّحم
لما تأثّرَ بعادات
البوذيين
ومعتقداتهم.
إذا
تأمّلنا في هذه
الشخصيّةَ، بِعُمْقٍ
وإمعان؛ لا
نكاد نجد
وجهًا من وجوه
الشبه بينها
وبين شخصية
الرسول r.
وإنّما فيها
ملامح ظاهرة
من شخصية بوذا
الراهب الّذي
تُنسَبُ إليه
الديانة البوذيّة.
وهذه من
البراهين
الّتي تؤكّد
على أنّ الطريقة
النقشبنديّة
قد تأثّرت بتعاليم
البوذيّة إلى
أبعد الحدود؛
وأخذت منها
روحًا جديدةً
بعد قفزها من
بلاد
ماوراءالنهر
إلى الساحة الهندية
منذ عهد
الباقي بالله
الكابُليِّ
إلى زمن خالد
البغداديّ
الّذي حملها
من بلاد الهند
إلى الشرق
الأوسط
وطوّرها إلى
شكلها الّذي
هي عليه
اليوم.
ولد
جان جانان عام
1111 من
الهجرة
الموافق لسنة 1699 من الميلاد.
وقُتِلَ
غيلةً بمدينة
دلهي عام 1195 من الهجرة
الموافق لسنة 1781 من الميلاد.
وذلك على يد
نفر من الشيعة.
وقيل كانوا من
مجوس المغول.[452]
يزعم
النقشبنديّون
أنّه من البطن
الثامن والعشرين
من سلالة عليّ
بن أبي طالب
رضي الله عنه؛
وأنّ
المتأخّرين من
آبائه كانوا
أمراء. إلاّ
أنّ أباه ترك
منصبه زهدًا،
وأنفق أمواله
الطائلة على
الفقراء تصدُّقًا.
كلّ هذه
المُعْطَيات
تبرهن أيضًا
على التغيُّرِ
الّذي دبّت
أماراتُهُ في
أسرة جان
حانان، والاتجاهِ
الّذي نزعتْ
إليها أسوةً
بحياةِ
الرهبان
الهندوس.
وأمّا
جميع ما قصّه
النقشبنديّون
من حكايات أسطورية
على سبيل
الكرامة له،
فهي لا تتجاوز
مزاعم غريبة
عدّوها من
علامات
الصالحين ونسبوها
إليه؛ كما قد
نسجوا من
أمثالها لبقيّة
الروحانيّين.
وهي في
الحقيقة
واردة في
سِيَرِ
الرهبان
والعابدين من
أهل العزلة في
سائر الأديان.
ولم يكن
الرهبان
يومًا من الأيّام
ورثةً
للأنبياء
والصالحين
الّذين أناروا
طُرُقَ
الحياة
السعيدة
للنّاس في هذه
الدنيا،
ودلّوهم على
العمل
الصالح،
وسلوك سُبُل السلام
إلى النجاة
الأبديّة. بل
كان شأن الرهبان
ومن على
شاكلتهم من
شيوخ الطرق
الصوفيّة؛
كان شأنهم
العزلةَ،
والتقَشُّفَ،
ولبسَ
المسوح، وكراهيةَ
الحياة،
ورفضَ نعم
الله،
وتعذيبَ الجسد
بأنواعٍ من
الرياضيات
الشاقة.
إنّ
هذا الشيخ
الهنديّ، لا
أثر له
يُذْكَر. ولهذا
لا نعثر على
اسمه في
مصنَّفات أهل
البحث والدراسة،
سوى كلماتٍ
قليلةٍ
سجّلها أبو
الحسن
الندويّ في
الجزء الرابع
من كتابه »رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام«.[453]
أمّا
قصّة حياته
الّتي دوّنها
تلميذه غلام على
عبد الله
الدهلويّ
بعنوان »المقامات
المظهرية«،
فانّ العقل
الراجح غنيٌّ
عن الاشتغال
به.
***
*
الحلقة
الثامنة والعشرون
من السلسلة النقشبنديّة
يستحق
الإلمام
بشخصية الرمز
الّذي يُمَثِّلُ
هذه الحلقةَ؛
وهو غُلاَمْ
علي عبد الله
الدهلويّ.
وذلك لسببٍ
هامٍّ، يمكن
تلخيصه بأنّه
استطاع أن
ينهض بالطريقة
النقشبنديّة
في مرحلة
حسّاسة من
الزمن لم يكن
القيام فيها
من السهل
بنشاطاتٍ
روحانيةٍ.
وبخاصّةٍ
فانّ الطريقة النقشبنديّة
كانت قد بلغت
الغاية من
التوسّع
والانتشار. فالمعقول،
أن يكون
نهايةُ
الكمالِ
بدابة الزوال
لكلِّ شيءٍ
سوى اللهِ،
وكان الملحوظ
أن يبدأ الإنحطاط
في الطريقة النقشبنديّة
فتتقلُّص،
لظروف الوقت
والمنطقة.
فانّ الأوضاع
لم تكن تسمح
لقيام أيّ
فكرة تتعارض
مع روح النـزاع،
أو تتّسم
بالسلمية
والهدوء
والحياد. إذ
أنّ الوضع كان
على أشدِّ حالٍ
من الفوضى بين
الجموع
المتباينة في
الساحة الهندية
يومئذ. أمّا
الدين
والنشاطات
الروحية والفلسفيّة
والعلميّة
والفنية،
فإنها تختفي
غالبًا في مثل
هذه الظروف،
لشغل الناس
بالدفاع عن
حياتهم وعِرْضِهِمْ
وأموالهم.
ولكنّ
الدّهلويَّ على
الرغم من ذلك
تمكّن من
استمالة
القلوب بدعاياته
المتواصلة
الّتي قام بها
عن طريق المراسلات
على غِرَارِ
أحمد
الفاروقيّ
وابنه محمّد
المعصوم؛ كما تبرهن
على ذلك
رسائله الّتي
بلغ عددها
مائة وخمسًا
وعشرين
قطعةً، جمعها
شاه رؤوف أحمد
(وهو أحد خلفائه)
بعنوان »المكاتيب
الشريفة«
ولد
غُلاَمْ علي
عبد الله
الدهلويّ عام 1158 من الهجرة
الموافق لسنة 1745 من الميلاد،
في خضم
الحركات
الثورية
والفتن
المتفاقمة والحروب
الدائرة بين
ملوك الطوائف
على الساحة
الهندية وعلى
حين من احتضار
الدولة المغولية
الّتيمورية.
وكان من أشدّ
هذه الفتن زحف
المراهتة
المجوس على
مدينة دلهي
عام 1760م. كان غُلاَمْ
على يومئذ
شابًّا
مراهقًا.
قضى
غُلاَمْ علي
مرحلة شبابه
في عهد خمسة
من ملوك
الدولة الّتيمورية[454] الّذين
بلغت القلاقل
والاضطرابات
والأحداث
الدامية
غايتها عبر حكمهم.
ولم تتمتّع
البلاد بشيء
من الهدوء
والاستقرار إِبَّانَ
هذه المرحلة
حتّى فرض
الإنجليز
سيطرتَهُم
على البلاد
الهندية
بصورة
نهائية؛ وذلك
سنة 1214 من
الهجرة
الموافقة
لعام 1799 من
الميلاد، إِثْرَ
معركةِ سَرَنْكَابْتِنْ
و استشهاد
سلطان تيبو.
على
الرغم من هذا
الجوّ
الخانق،
استطاع غُلاَمْ
علي أن يُثير
اهتمامَ
جمهورٍ من
الناس من أولئك
الّذين لم
ينبض في أحدهم
عرق الحمية
والإيمان
أمام الكارثة
الّتي حلت
بالمجتمع
الإسلامي
يومئذ في
الهند. كان
يبث الدهلويّ
عقائد الأسرة
السرهنديّة
بحماس وجلد،
ويعمل على
إشاعة صيتها.
يدلّ على
نجاحه في مهمّتهِ
اجتذابُهُ
رجلاً من
أكراد
العراق، لينفث
في روعه من
هذه العقيدة،
ولِيُلْقِيَ
على كاهله
مسئوليةَ
القيام
بنشرها. ألاَ
وهو خالد
البغداديّ
الّذي سوف
نركّز على
أحواله وأطواره
وتلوّنه إنْ
شاء الله تعالى.
إنّ
تأثير
الديانات الوثنيّة
يظهر بوضوح في
عقيدة غُلاَمْ
علي عبد الله
الدهلويّ
أيضًا من خلال
ما جاء في
رسائله.
أولاً،
إنّه قائل
بوحدة
الوجود،
ووحدة الشهود.
فقد كتب بِجُرْأَةٍ
واستمرارٍ وإصرارٍ؛
وأسهبَ
واسترسلَ في
هذه المسألة
أكثر ممن
تكلّم فيها.[455]
ثانيًا،
تطرّق إلى
آدابِ
الطريقة النقشبنديّة
وأركانِها
ومبادئِها في
عدّةٍ من
رسائله بمرونةٍ
و مراوغةٍ،
أَوْهَمَ
فيها القارئ
أنها
منبَثَقَةٌ
من روح الكتاب
والسّنّة.
وبخاصّةٍ ذكر
في الرسالة
التسعين من
أهمّ مصطلحات
هذه الطريقة.
تلك
المصطلحات
الدخيلة
المشبوهة. كالشهود،
والوجود،
والمشاهدة،
واللطائف،
والكشف،
والأسرار،
وحبس النفَسِ
أثناء الذكر، والرّابطة،
والجذبة،
وخرق الحجب،
والفناء،
والبقاء،
والوحدة،
والكثرة،
والأنس، والوحشة،
والاستغراق،
والسكر،
والولاية
الصغرى
والكبرى،
والسير،
والسلوك،
والقيومية، والحقيقة
المحمّديّة
والأحمدية،
والذوق،
والشوق،
والتجلّي، والمقامات
العشر،
والأركان
الأحد عشر،
وغيرها.
إنّ
موقفه
المتجاهل
للواقع الّذي
كان يعيش في
غِمَارِهِ،
يبرهن على
تأثُّره
البالغ بتعاليم
الأديان
والعقائد
السائدة في
مجتمعه من
البرهمية
والبوذية.
فانّ
رسائلَهُ
شاهدةٌ على ما
يتميّز به من
روح
الاستسلام
والسبات
والغفلة عمّا
كان يجري حوله
يومئذ. وهي من
نتائج هذه
العقائد
الهندية الوثنيّة
الّتي
تُفَضِّلُ
الخضوعَ
والاستسلامَ
على المقاومة
والدفاع. ذلك
أنّنا لا نعثر
في مضمون جميع
رسائله على
كلمة واحدة
فما فوقها،
تُنْبِؤُنَا
عن ردّ فعله
ضدّ الغُزَاةِ
الإنجليز
المستعمرين
الّذين
ارتكبوا المجازر
الوحشية ضدّ
سكّان الهند،
خاصّة المسلمين
منهم؛
وانتهكوا
الحرمات،
وانقضّوا على
البقاع
الآمنة
فأهلكوا فيها
الحرث والنسل.
كان موقف غُلاَمْ
علي الدهلويّ
عكس موقف
علماء
الإسلام من
هذه الحملات.
وعلى سبيل
المثال، فانّ
الشيخ احمد بن
عبد الرحيم
المعروف بشاه
وليّ الله
الدهلويّ -
وهو من معاصري
غُلاَمْ علي
ومن الأعلام
الّذين نبغوا
في تلك المناطق
-، نجده على
منتهى درجات
الوعي
والحماس للدفاع
عن دماء
المسلمين
وعرضهم،[456] و
يتحمّل
المسئولية،
ويخاطب
الملوك
والأمراء بحميةٍ
إسلاميةٍ،
وهِمَّةٍ
عاليةٍ،
ويستنجد بهم
لإيقاف أسباب
الفساد،
ويحاول بجهودٍ
متواصلةٍ،
وإيمانٍ
صادقٍ،
لتوفير الأمن
والحرية في
ربوع المجتمع
الإسلاميِّ.
بينما نطلّع
على ما ورد عن
غُلاَمْ علي، أنّه
يتهافت
ويتخبّط
ويعبث
بالمفاهيم
والقِيَمِ،
ويتكلّم
بلغةٍ لم يتكلّم
بها رسول الله
r
ولا
صحابَتُهُ مع أنّه
يُتقن لغة
القرآن،
ويعدّه
أتباعُهُ من
ورثة النبيّ r.
هذا إلى جانب
ما يتخطّى
الواقعَ
بأسلوبٍ متجاهلٍ،
ويتبنّى
أمورًا لا
تعود بخير على
مجتمعه الّذي
يعاني
الفسادَ
والانحلالَ؛
ولا تُخرجهم
من المأزق
الّذي تورّط
فيه أبناء
أمّته.
***
* الحلقة
التاسعة
والعشرون من
السلسلة النقشبنديّة.
هذه
الحلقة
يمثّلها رجلٌ
من أهمّ الشخصيّات
البارزين في
تاريخ
الطريقة النقشبنديّة،
وأكثرهم
معرفة
بالعلوم العقليّة
والنقليّة،
وأوسعهم شهرة
بين الخاصّة
والعامّة،
وانجحهم
تلوّنًا في
استمالة قلوب
الناس
والاستيلاء
على ضمائرهم
وإلقاء هيبته
عليهم. هذه
الشخصيّة هو
أبو البهاء،
ضياء الدين
خالد بن أحمد
بن الحسين
الشهرزوري
البغداديّ
المعروف بين
أتباعه
بعنوان »مولانا
خالد ذو
الجناحين«[457]
ولد
البغداديّ
عام 1192 من
الهجرة
الموافق لسنة 1778 من الميلاد
بمحل اسمه »قره طاغ« على
مقربة من
مدينة
السليمانية
العراقيّة. ومات
بالطاعون في
مدينة دمشق
عام 1242 من
الهجرة
الموافق لسنة 1826 من الميلاد.
نشأ
وتربّى ودرس
مقدّمات
العلوم التقليديّة
في المنطقة
الّتي ولد
فيها. ثم خرج
منها لطلب المزيد
من المعرفة.
فقرأ على بعض
الْمَلاَليِ في
تلك النواحي،
أخذ عن الشيخ
عبد الكريم
وأخيه الشيخ
عبد الرحيم
البرزنجيّ،
والشيخ محمّد
الكرديّ،
والشيخ
إبراهيم
البياريّ،
والشيخ عبد
الله
الخربانيّ،
حتّى أكمل
دراسته التقليديّة
حسب العرف
المتّبَع في
تلك المرحلة
من العهد العثمانيّ.
إذ لم تكن
يومئذ مقررات
تعليمية
معتمَدة من
قِبَل الدولة
للمدارس
الشعبيّة. ثم
واصل دراستَه
في فنونٍ أخرى
كالحساب والهندسة
والهيئة
زيادةً على
أمثاله. وذلك
تحت إشراف
الشيخ قسيم
السنَنْدَجيِّ.
يدّعي
بعض
المترجمين
له، أنّه من
سلاسة عثمان
بن عفان رضي
الله عنه.[458]
ويقولون في
الوقت ذاته إنّه
من أبناء
العشيرة
الميكائيلية
الكرديّة[459] وهذا
كلام متناقض
كما يبدو.
لأنّ عثمان بن
عفان رضي الله
عنه، هو ثالث
الخلفاء
الراشدين، عربيّ
الأصل من بني
أمية، وهم بطن
من بطون قريش.
أمّا العشيرة
الميكائيلية،
فهي قبيلة
كردية لا صلة
لها
بِقُرَيْشٍ
ولا بشخصيّة عربيّة.
اشتغل
خالد
بالتدريس
مدةً في
السليمانية
وبغداد. بيد
أنّ الباحث
الحاذق
الدقيق إذا
اطّلع على ما
قد خلّف هذا
الشيخ من
رسائلَ
وحواشٍ وملاحظاتٍ،
وما تناقلته
اللُّسُنُ
عنه من صفاتٍ،
وسلوكٍ،
وأقوالٍ،
وتعليماتٍ
موجّهَةٍ منه
إلى مريديه
وخلفائه؛
وإذا أنعم النظرَ
في عباراته
وعلاقاته؛
اصطدم
بحقائقَ
رهيبةٍ،
وعَلِمَ
بالتأكيد أنّه
كان يمتاز
بمزاج
متوتّر، ونفس
مترقّبة مُتَجَسِّسَةٍ،
وطبيعة نشيطة
دسّاسة. كان
خالدٌ ذا طموح
وعزيمة لا
حدود لهما.
أثارتْهُ
آمالُهُ إلى
المغامرة بما
لم يتجرّأ على
اقتحامه أحد
من رجال الدين
في عصره ولا
بعده! هذه
الطبيعة
المستفحلة هي
الّتي
دفعَتْهُ
ليكون دائمّا
هو في الصورة.
لذلك لم يتّسم
بالاستقرار،
فلم يصبر على
مواصلة
البقاء في
الأجواء العلميّة.
بل تلاطمت به
الأفكار
والتصوّرات،
فجعلته يتطلّع
إلى عالَمٍ لا
يحيط به
الزمان
والآفاق، ولا
يسعه نطاق
الكلمات
للتّعبير عن
حدوده
المترامية
وجماله
البارع؛
اشتاقت نفسه
إلى مثل هذا
العَالَمِ لِيُرَفْرِفَ
سرمدًا
بجناحين من
نورٍ في
مقدّمةِ
موكبٍ من الملائكة
فوق جنانه
وَالنَّبِيُّونَ
يَغْبِطُونَهُ،
كَمَا يَتَصَوَّرُهُ
خَاصَّةُ
النَّقْشَبَنْدِيِّينَ
وَيَتَوَاطؤُونَ
عَلَيْهِ!
ربما
كانت هذه
النفسيّة
الفعّالة
المتناشطة هي
الّتي حالت
بينه وبين
الحياة العلميّة،
وأضرمت في
قلبه النيران
إلى طلب مَنْ
يُصَدِّقه و
يبشّره بقرب
سعادته
وتحقيق آماله
الأبديّة
وأحلامه
وتصوّراته
الّتي لا
نهاية ولا حدود
لها؛ وأهدافه
الّتي لم يظفر
بها صناديد
الرجال من
الرواد
والحكماء
والأباطرة،
ولا حتّى
الأنبياء
والمرسلون! لم
يزل خالدٌ
يجوب ويتجوّل
في هيام
واشتياق إلى
هذا المطلب
الموهوم،
ويتكهّن
بتفسيرِ أدنى
حدثٍ يجري
حوله بهذه
النفسيّة
الغريبة، إلى
أن أدركه رجل
من أهل الهند؛
ثم لم يلبث
الهنديّ حتّى
أحسّ بما
يخامره،
فأوعز إليه أن
يرافقه إلى مَنْ
سوف تتحقق على
يده أمالُهُ
في عاصمة الهند.
نقتطف
الآنَ مقاطعَ
من قصّة دخوله
في هذه المغامرة؛
فيقول وهو في
المدينة
المنوّرة
يتأهّب للحج: »وكنتُ أفتّش
على أحد من
الصالحين
لأتبرّك ببعض
نصائحه لعلّي
أعمل بها كلّ حينٍ،
فلقيتُ شيخًا
يمنيًّا متريّضًا
عالمًا
عاملاً صاحب
استقامة
وارتضاء، فاستنصحتُهُ
استنصاح
الجاهل
المقصّر من
العالم
المتبصّر
فنصحني
بأمورٍ منها:
لا تبادر في
مكة بالإنكار
على ما ترى ظَاهِرَهُ
يخالف
الشريعةَ. فلمّا
وصلتُ إلى
الحرم وأنا
مصرٌّ على
العمل بتلك النصيحة
البديعة بكّرتُ
يوم الجمعة
إلى الحرم،
لأكون كمن
قرَّبَ بدنة
من النعم
فجلست إلى
الكعبة
الشريفة
لأقرأ الدلائل[460]،
إذ رأيتُ
رجلاً ذا لحية
سوداء عليه زيّ
العوامّ قد
أسند ظهره إلى
الشاذروان
ووجهه إلىَّ
من غير حائل
فحدَّثَتْنِي
نفسي أنّ هذا
الرجل لا
يتأدّب مع
الكعبة ولم أُظْهِرْ
عَيْبَهُ. فقال
لي: أما عرفتَ
أن حرمة
المؤمن عند
الله أعظم من
حرمة الكعبة!
فلماذا تعترض
على استدباري
الكعبة
وتوجّهي إليك؟
أما سمعتَ
نصيحةَ مَنْ
في المدينة
وتأكيدَهُ
عليك؟! فلم
أشك أنّه من
أكابر
الأولياء وقد
تستّر بأمثال
هذه الأطوار
عن الخلق،
فانكببتُ على
يديه وسألتُهُ
العفوَ، وأنْ
يُرْشِدَنِي
بدلالته إلى
الحقّ. فقال
لي: فُتُوحُكَ
لا يكون في
هذه الديار.
وأشار إلى
الديار الهنديّة،
وقال: تأتيك
إشارةٌ من
هناك فيكون فُتُوحُكَ
في تلك
الأقطار.
فأيستُ من
تحصيل شيخ في
الحرمين
يرشدني إلى
المرام،
ورجعتُ بعد
قضاء النسك
إلى الشام«.[461]
يستطرد
المترجم
قائلاً:
»وكان
متشوّقًا بعد
رجوعه من
الشام إلى
مرشدٍ من فحول
الرجال حتّى
جاء إلى
السليمانية
رجلٌ هنديٌّ
يسمى »مِرْزَا
رحيم الله بِكْ«
المعروف
بمحمد درويش
العظيم آبادي.[462] أحد
خلفاء الشيخ
الدهلويّ،
فاجتمع به
وعرض عليه
مطلبه. فقال
له: »إنّ لي
شيخًا كاملاً
مرشدًا
عالمًا
عارفًا بمنازل
السائرين إلى
ملك الملوك،
خبيرًا بدقائق
الإرشاد
والسلوك،
نقشبنديّ
الطريقة، محمديّ
الأخلاق،
علماً في علم
الحقيقة.
فَسِرْ معي
حتّى نرحل إلى
خدمته في جِهَانْ
آبَادْ، وقد
سمعتُ منه
إشارةً بوصول
مثلك ثم إلى
المراد«.[463]
إنّ
هذه العبارات
فحسب تدلّ على
شخصيّة خالد بكلّ
ميّزاتها
دلالةً
كافيةً - وإن
أهملنا جميع
ما نُقل عنه
وعن غيره حول
صفاته
وأخلاقه
ومواقفه -
يتضح لنا من
خلال هذه
الكلمات مدى
جانبه العاطفيِّ
وَتَكَهُّنِهِ
وميله إلى
الكهنة وحرصه
في طلب مَنْ
ينفخ فيه
الروح
ليتأكّد من أنّه
على حقّ في كلّ
ما يحلم
ويتصوّر
ويصبو إليه.
فكان بحاجةٍ
إلى من يحرّك
فيه النقطةَ
الحسّاسةَ
بحذاقة ويُطلقه
من عنانه
ليكون هو
مقصودَ
العالمين على
وجه البسيطة.
لسنا
بحاجة هنا إلى
نقل ما ذَكَرَ
هو وغيره من
صفحات رحلته
إلى الهند،
وأخذِهِ
رخصةَ
المشيخةِ
والخلافة
المطلقة
للطريقة النقشبنديّة
من غُلاَمْ
علي عبد الله
الدهلويّ؛
ولكنّنا
بحاجة إلى طرحِ
أسئلة عدّة
والبحثِ عن
معلوماتٍ
صحيحةٍ تكون
بمنـزلة
الإجابة
عليها،
لتتبلور من
خلالها شخصيّة
هذا الرجل
وأسرارُ
رحلته إلى
الهند.
نتساءل
أوّلاً عمّا
أطمع خالدًا
في الاتصال بشيخٍ
من صوفية
الهند حتّى
غادر وطنه
وتكبّدَ
ألوانًا من
المشاقّ،
وعرض نفسَهُ
لأخطار رهيبة
مُدَّةَ سنةٍ
كاملةٍ حتّى
وصل مدينة
دلهي عاصمة الهند
عام 1810م.
فما
عسى كان يأمل
أن يناله هناك
من علم وفضل ومعرفة
بقضايا جديدة؟
هذا مع أنّ
المحيط الّذي
تركه وراء
ظهره والمناطق
المجاورة له
في الشرق
الأوسط، تمتاز
بأصالتها
التاريخية،
وتراثها
العلميّ
والثقافيّ
الزاخر. وهي
أرض الأنبياء
والمرسلين
والصحابة
والحواريّين،
ومشاهير
العلماء
والصالحين. طالما
يقصدها
الباحثون
ورجالُ العلم،
والمستشرقون،
وتتوافد
إليها
الطلبةُ
دائمًا من بقيّة
العالم
الإسلاميِّ.
أمّا
بلاد الهند،
فإنّها على
نقيضِ هذه
المزايا
والصفات. وهي
أرضُ مجوسِ
البرهمية،
عبدةِ الشجر
والبقر
والقرد والحجر؛
وطنُ أهلِ
الرهبنة
والبطالة
والمسكنة؛
مسرحُ
المشعوذين
اليوغيّين
والسحرة والكهنة
والعرّافين؛
نائيةٌ عن قلب
بلاد الإسلام
ومهبط الوحي
والإلهام. وإن
كان في بعض
نواحيها
نشاطات علمية
ولكنها لا
تداني المدنَ
الشهيرةَ
بمكتباتها
الغنية،
ومدارسها
العامرة مثل
القاهرة
وبغداد
والقدس ودمشق.
كما يقرّ بهذه
الحقيقة علاّمة
بلاد الهند
الشيخ أبو الحسن
الندويّ بالذّات
فيقول:
»ولقد
تضافرت عوامل
كثيرة؛ من
أهمّها
بُعْدُ الهند
عن مراكز
الإسلام
الدينيِّ
والثقافيِّ -
بلاد الحجاز
ومصر والشام
والعراق -؛
ووصول
الإسلام إلى
الهند بعد
تعرّجه على
تركستان وإيران،
وقلّة شيوع
اللّغة العربيّة
فيها؛ وعدم
الاعتناء
بنشر علم
الحديث الّذي
لا يزال يَبُثُّ
روح الدين
الصحيح
ويميّز
السّنّة عن
البدعة ويقوّي
الشعور
بضرورة الأمر
بالمعروف
والنهي عن
المنكر؛
ويوجد ملكة
الاحتساب
الديني الصحيح؛
ومنها صعوبة
السفر للحجّ
والرحلة في طلب
العلم إلى
البلدان
الأخرى؛
وبقاء أقلية المسلمين
مغمورة في
أكثرية غير
مسلمين
الّذين كانوا
متشبّثين
بعقائدهم،
متمسّكين
بتقاليدهم
وعاداتهم غير الإسلاميّة،
وغارقين في
الخرافات
والأوهام.
وتضافرت هذه
العوامل كلُّها
على تحويل
المسلمين
مرتعًا خصبًا
للدعوات
المضطّربة
والفِرَقِ
الضالة
والمحترفين
بالدين؛
خرجوا
يمثّلون دورَهم
ويجرِّبون
حظَّهم في
إضلال
المسلمين«.[464]
نعم،
إذًا ما الّذي
دفع خالدًا
إلى هذه
المغامرة الّتي
لم يجنِ من
ورائها شيئًا
انتفع به
المسلمون من
علمٍ أو قوةٍ
أو أخلاقٍ أو
رُقيٍّ
وازدهار غير
تلك الرياضيات
والتأمّلات
الّتي رَكِبَ
ذنبَ الريح
إلى الديار
الهندية
لأجلها
واستغرق فيها
عامًا،
والّتي مهّدت
له طريق
الشهرة
والهيمنة على
قلوب مئات
آلاف الناس
حسبما تفوّه
به بعض
معارضيه كما
سنشرحه إنْ
شاء الله
تعالى.
هنا
يتبادر إلى
الذهن سؤال
آخر. وهو أنّ غُلاَمْ
علي عبد الله الدهلويّ
كيف عَلِمَ
بوجود خالد
البغداديّ حتّى
أشار بوصوله
كما نفهم من
كلام رسوله
مرزا رحيم الله
بِكْ، ذلك
الرجل
الهنديّ
الّذي زار
خالدًا في السليمانية
وأخبره بذلك
حسبما يسجّله
الخانيّ في
حدائقه على
سبيل الكشف
والكرامة لِغُلاَمْ
علي الدهلويّ.
هذا، على
الرغم من تلك
المسافة
الهائلة بين
الهند
والعراق،
بالإضافة إلى
الظروف الّتي
كانت تحيط
بقارّة أسيا،
والقلاقلِ
والفتنِ
والحروبِ
الّتي كانت
تجري على
ساحات كبيرة
منها يومئذ.
ثم أيُّ غبيٍّ
يصدّق بمثل
هذه الكرامة
المختَلَقَة على
حساب هذا
الصوفيّ
الهنديّ
الّذي داهمتِ
القوّاتُ
الإنجليزيّةُ
بِلاَدَهُ
أمام عينيه
وهو لا يهمّه
إلاّ»وحدة
الوجود،
ووحدة
الشهود،
والفناء،
والبقاء،
والسكر،
والعشق
الإلهي،
والتركيز، وحبس
النفَسِ« وما إلى
ذلك من عقائد
البرهمية
وتعاليم البوذيّة
ورياضيات
اليوغيّين! ثم
مَنْ يَضمَنُ أنّه
لم يكن على
صلةٍ برؤوس
قوات
الاحتلال، ما
دام لم ينله
منهم سوء، بل
كان هو
وأصحابه في
أمان منهم دون
غيرهم من سكان
البلاد! لابدّ
وأنّ هذا
السؤال
الهامّ سوف
يُشْغِلُ بَالَ
رجالِ البحث
والدراسة إلى
أن تظهر الحقيقة
بكمال الوضوح
إلى العيان إنْ
شاء الله.
نتساءل
ثانيًا، ما
الّذي أنجزه
خالدٌ في سبيل
النهوض
بالمجتمع
الإسلاميِّ
الّذي كان
يعاني أرذلَ
درجاتِ
الجهلِ
والتخلُّفِ
والعمى. وهل
أقدمَ - ولو
بخطوة - على
تخفيف بلايا
عظيمة داهمت
المسلمين من
الداخل
والخارج في أيّامه
على كثرة
أتباعه
المستعدّين
للفداء بأموالهم
وأنفسهم في
سبيله بأدنى
إشارة منه؟!
و
يناسب هنا أنْ
نتطرّق إلى
بعض المشاكل
العظيمة
الّتي كان
المسلمون
يقاسونها في
تلك المرحلة
الزمنيّة، وعلى
سبيل المثال: كانت
المنظماتُ
السّرّيّة،
وعلى رأسها
الحركةُ
الفرمسونيّة
الّتي
جنّدتها دول
الغرب، وبدأت
في تأسيس محافلها
في المدن
الكبيرة
بالعالم
الإسلاميِّ
في تلك
الفترة،
كمدينة
سالونيك، والقسطنطنية،
وقونيا،
وقيروان،
وإسكندريّة،
ودمشق،
وبغداد،
وإصفهان،
وتبريز،
وبومباي،
ودلهي؛ كانت
هذه المنظمة
الخطيرة
تحاول اصطياد
الرجال
البارزين في
المجتمع
الإسلاميِّ
من العلماء
والسياسيّين
والأثرياء،
وذلك لهدم
القِيَمِ
السامية بأيدي
هؤلاء، وتشكيك
المسلمين في
دينهم
وعقائدهم،
بالإضافة إلى
أنّ هذه الدول
اتّفقت على
تمزيق الوطن
الإسلاميِّ،
فزحفت على بلاد
المسلمين،
وارتكبت فيها
مالا يمكن حصره
من الجنايات والمجازر
والاستهتار بحرماتهم،
بل استعبدتهم
بعد أن احتلّت
أراضيهم.
وعلى
رأس هذه الدول
المتغلّبة
كانت بريطانيا
قد استولت على
الديار
الهندية في
الفترة الّتي
سافر إليها
خالدٌ ليُصبح
نقشبنديًّا
فيرجع إلى
بلاده بأسرار
هذه الطريقة
ويبثّها بين
الناس.
نتساءل
ثالثًا، إذا
كان خالدٌ
رجلاً صوفيًّا
- ومادام
الإنسانُ
الصوفيّ
مغمورًا في
حياة من
العزلة
والتقشّف
والرهبنة،
تنحصر مهامّه
في رياضات
نفسيّة،
وتأمّلات
عميقة ذهنيّة،
وتركيز
واستغراق -
إذن فلماذا
كان يكتم ما اللهُ
مبديه على
لسان خليفته محمّد
بن عبد الله
الخانيّ في
قوله:
»إنّ
هذه الطريقة
هي الملاميّة
المناسبة لما
يكون عليه من
الصحو
الصدّيقيِّ،
والرجوع إلى
البقاء
الأتمّ الحقيقيِّ
بدعوة الخلق
وهدايتهم إلى
الحق برئاستي
الظاهر
والباطن وفتح
القلاع
والمواطن«.[465]
هذه
العبارات، لا
يردّدها إلاّ
الملوك وقادة
الجيوش؛
وليست من
كلمات شيوخ
الصوفيّة. وربما
يبرهن على هذه
النيّة
المُبْطَنَةِ
ما قد سجّله
الباحثُ
العراقيّ
عباس
العزّاويّ في
ترجمة خالد،
بعد أن خلع
عليه من المدح
والإطراء فقال:
»وكان
حكيمًا
قادرًا على
إحياء الدولة العثمانيّة
من جديد،
وإفراغها في
قالب آخر،
خصوصًا في حالتها
البالغة من
الوهن
والفتور في
جوارحها والعلل
والأمراض
الطارئة
عليها، ولكن
لم يركن إلى
الدنيا وما
فيها ولم
يتدخّل في شيء
مِنْ شُؤُون
الدولة«.[466]
هذه
الكلمات
الّتي تبدو
وكأنّها قد
طارت من بين
شفتي
العزّاويّ
دون أن يشعر
بما قد أفشى
من خلالها عن
أسرارِ لُغزٍ
هامٍّ جدًّا،
لقد يكمُنُ
فيها جانب خطير
من شخصيّة
خالد
البغداديّ
وما كان يتّصف
به من التلوّن
وانتهاز
الفُرَصِ!
تشهد على هذه
الحقيقية ما
نقلناه آنفا
من كلماتٍ فيها
شبه اعتراف
قالها خليفته محمّد
بن عبد الله
الخانيّ، وهي
بمنـزلة
الإجابة عن كلّ
التساؤلات في
هذا الصدد.
ولعلّ ما قاله
بعض معارضيه
على سبيل
الطعن فيه،
يوضّح لنا ما
يغيب عن
إدراكِنا من
خفايا هذه
الشخصيّة. ذلك
هو الشيخ
معروف
البرزنجيّ
العراقيّ
الّذي ألّف رسـالةً
بعنـوان »تحرير
الخطاب في
الردّ على
خالد الكذّاب«.[467] بعث بها
إلى والي
بغداد سعيد
باشا. قال
فيها بعد أن
اتّهم خالدًا
بالكفر
والزندقة:
»إنّ
الأكراد
كلّهم قد
اتبعوه. وملأ
ببدعته
الآفاق، وإنّه
يدّعي
التصرّف في الكائنات،
ويدّعي علم
الغيب، وإنّه
ذهب إلى الهند
فتعلّم من
السحرة الجُوكِيّةِ
ومن نصارى
الإنجليز
دينًا ظهر
عندهم«.[468]
نحن
لسنا بصدد
استغلال هذه
الكلمات
لنُقيمَها
حجّةً على
خالد
البغداديّ.
لأنّ
الاستدلالَ
بطعنِ
المعارض
يُبَرِّرُ
المعارضةَ
ضدَّ
الاستدلال،
وقد يتسلسل
منه الخلاف،
ويتمخّض عنه
الفساد. هذا من
الجانب
المنطقيِّ
والأخلاقيِّ،
وكذلك من الجانب
الواقعيِّ.
لأنّ
البرزنجيّ
كان شيخًا من
روؤس الطريقة
القادرية، ذا
شهرة في المنطقة
العراقيّة،
وربما خاف
منافسةَ خالد
البغداديّ له
و توقّع أنّ
دائرة محيطه
سوف تتقلّص باشتهار
منافسه،
فقاومه
بالسعاية
والشكاية والطعن
فيه كما مرّ.
وإلاّ فإنّ
معارضتَه لم
تكن حميّةً
اسلاميّةً وحمايةً
خالصةً لأصالة
الإسلام خشية
أن تتعرّض
قِيَمُ الدين
الحنيف
للاستحالة
والفساد
بانتشار بدع النقشبنديّة.
لأنّه أيضًا
كان صوفيًّا
من أمثالهم،
بل كان أقدمهم
في نشر البدع
وإفساد
تعاليم الدين
الحنيف بوساطة
الطريقة
القادرية.
ولكنّ
هذا الصوفيّ
الخامل، كيف
اهتدى إلى
المعرفة بـ »السحرة الجُوكِيّةِ«
وعَلِمَ
أنّهم من أهل
الهند، وأنّ »الجُوكِيّةَ« أي
»اليوغا«
نوع من السحر -
كما يظنّه بعض
الناس -، مع أنّه
في حقيقته
شكلٌ من عبادة
مجوس
البرهمية؛
قوامها التأمّل،
والتركيز
والاستغراق
وحبس النفَسِ.
فقد اصطلحها
النقشبنديّون
بعنوان
الرّابطة، كما
سبق شرحها في
بابها.
نعم،
مَنْ أخبر
البرزنجيَّ عن
كلّ هذه
الحقائق
الّتي لم
يسمعها شيوخ
الطرق
الصوفيّة في
الشرق الأوسط،
لسطحية
مستواهم
الثقافيِّ
وغفلة أكثرهم
عن واقع
المجتمعات
وجهلهم بصنوف
الأديانِ
والمذاهب
والفِرَقِ
والمنظّماتِ؟!
زد
على ذلك أنّ
خالدًا
البغداديَّ
بالذّات،
يُقِرُّ في
مقطعٍ من
ديوانه: أنّ
الناسَ
أنكروا عليه
عَزْمَهُ السفر
إلى الهند
محتجّين على
مغادرتِهِ
بلادَ الإسلام
إلى ديار
الكفر،
يقصدون بذلك
السلطة الإنجليزية.[469]
هذا،
بالإضافة إلى
ما جاء في
ثنايا كتابٍ
ألّفه محمّد
أمين بن عليّ
السويديّ
بعنوان »دفع
الظلوم عن
الوقوع في عرض
هذا المظلوم« ردًّا
على أبي سعيد
عثمان
الجليليِّ
الموصليّ؛
جاء في ثنايا
كتابه كلامٌ
منقولٌ عن
الجليليِّ
يذمّ فيه
خالدًا ويطعن
فيه »أنّه
ذهب إلى الهند
وتعلّم من الجُوكِيّةِ
ونصارى
الإنجليز،
ظهر عليهم؛
وظهوره صار
سببًا لإزالة
ملوك الهند المسلمين
عن كراسيّهم
وتملّكها
النصارى...«[470]
هذه
الكلمات، ولو
فرضنا أنّ
فيها مبالغة،
ولكن
يُستَبْعَدُ
أن تكون كلها
بهتانًا
محضًا على
خالد
البغداديّ
لأسبابٍ
هامّةٍ جدًّا.
منها:
أنّ الطاعن
أبا سعيد
عثمان بن
سليمان باشا
الجليليّ كان
من أمراء
الموصل. وهذا
يبرهن
منطقيًّا ـ على
أقلّ تقدير ـ أنّه
كان رجلاً
متفتّحًا
خبيرًا بما
كان يجري داخل
البلاد
وخارجها من
أمور وأحداث بحكم
منصبه
ومسئوليته.
وبالتالي فإنّه
لابدّ وقد
استند إلى
مبرّر تجرّأ
بحكمه على هذا
الإسناد
الخطير.
ومنها:
أنّ ما نسبه
الجليليُّ
إلى خالد
البغداديّ من
علاقته
بالإنجليز،
ومشاركته معهم
ضد ملوك
المسلمين في
الهند؛ فإنّه
أمر في منتهى
الخطورة،
يستوجب
الاعتماد على
ما يستحيل
إحباطه من
أقوى الدلائل
والبراهين.
لأنّه
يُستَبْعَدُ
أن يقوم رجل
صوفيٌ عراقيٌّ
غريبٌ في ديار
الهند
بمشاركة
الإنجليز في
القضاء على
حكم المسلمين
في تلك
الديار؛ كما
يُستَبْعَدُ
في الوقت ذاته
أن يبادر هذا
الأمير
العالم
المرموق
بشخصيّته العلميّة
ومكانته الاجتماعيّة
فيخسر كرامته
بمثل هذا
الإسناد
الواهي الّذي
يجعل من خالد
الصوفيّ
الغريب
المسكين بطلاً
يزيل الملوك
عن كراسيّهم،
وهو في أرض من
أبعد المناطق
على وطنه وعشيرته،
معزولاً عن
السلاح
والعتاد!
ولكنّ
خالدًا
البغداديّ
يمتاز
بشخصيّة رهيبةٍ
كلّما انكشف
للباحث منها
جانبٌ أثاره
البحثُ
ليتابع فيه سيرَه،
فلا يكاد
ينتهي منه.
ومن
ميّزات
البغداديّ أنّه
لم تسنح له
فرصةٌ إلاّ
وقد استغلّها
ليزداد بها
شهرةً إلى
شهرته. ومن
دلائل هذه
النفسيّة
الحريصة: أنّه
اقتبس ثلاثَ
كلماتٍ من
لهجة سكان
الهند فاستخدمها
في إشباع
أغراضه
وتحقيق
طموحاته.
الأولى
منها: هي كلمة »مولانا«
الّتي اتّصف
بها ليفخّم
شأنَهُ، ولم
يكن من العادة
استعمال هذه
الصفة للعلماء
أو الروحانيّين
في المجتمع
العثمانيّ؛
بل كان من
عادة الفرس
والهند. كما
عُرف بهذا اللّقب
جلالُ الدين
الروميِّ
الّذي هاجر
إلى مدينة قونية
من خراسان في
العهد
السلجوقي. فلم
يتلقّب بهذا
العنوان أحد
من علماء
آناضول
تقليدًا به،
على الرغم من
شهرته
البالغة. وقد
انتقد خالدًا
عددٌ من خصومه
على اتّصافه
بهذا العنوان
وعلى رأسهم
العثمان الجليليُّ.
وثانيها:
هي كلمة »صاحب«.
كان
استعمالها
شائعًا بمعنى
الصديق على
لسان
المنتسبين
إلى الإسلام
في الساحة
الهنديّة.
فأطلَقَ
خالدٌ هذه
الصفةَ على
أخيه محمود بعد
عودته من
الديار
الهندية،
فاشتهر أخوه
بها.؛ ثم
انتقل إلى
أسعد بن محمود
حتّى عُرف هو
الآخر بهذا
اللّقب
وناداه الناس
بـ»الشيخ
أسعد صاحب
ذاده«
ثالثها:
هي كلمة »ميان«
(بكسر الميم
وفتحها).
استعملها
طائفة من مريديه
بتأثيره. وهي
أيضًا بمعنى
الصاحب
والصديق.
يبرهن
حتّى هذا
التقليد
الطفيليُّ
التافه على
نفسيّة خالد
البغداديّ
وطبيعته.
والله وحده
يعلم كم بذل
خالدٌ من
الجهود وما
همس إلى أمناء
سره ودعاته وبطانتِهِ
من أوامر
وتعليمات
لاستمالة
الناس إليه
وإلقاء هيبته
ومحبته في
قلوبهم بكلّ
طريقةٍ
ووسيلةٍ
أجادوها. إذ
أنّ أيَّ فردٍ
ذاع صيته في
حياته،
يستحيل أن
يكون قد نال
ما نال من
الشهرة دونما
رغبة منه واشتياق،
ومن غير
تحبّبٍ منه
وتصنُّعٍ إلى
الناس، ما عدا
أهل الإيمان
الصادق والإخلاص
من أولئك
الّذين يمتاز
دعواهم بالشمول
والعالمية؛
وهم
الأنبياءُ
والمرسلون وأنصارُهم
من الحواريين
والصحابة
والصديقين
والتابعين
لهم بإحسان.
إذًا
فانّ أسرار
شخصيّة خالد
البغداديّ
قضيّةٌ
مهمّةٌ
مرهونة بالإطّلاع
على واقعها من
خلال بحثٍ
مستقلٍّ
يستوعب جوانِبَها
الخفيّةَ
بتمامها. ولا
نبالغ إذا
قلنا: أنّ هذه
السلسلة من
التوضيحات
الّتي ما زلنا
في متابعتها،
لا تبخل بكشف
القناع عن قسط
كبير من هذه
الشخصيّة
وإزالة ما
يواريها من
سرابيل الزهد
والإخلاص
والعبادة
والتقوى؛
وذلك بأقصى
قدر من
التفصيل
بدقائقها على
حقيقتها؛
لتكون وثيقةً
تاريخيةً،
وعبرةً لأولي الألباب!
مكث
خالدٌ
البغداديّ في
مدينة جهان
آباد (دلهي) مُدَّةَ
عام كامل. عدا
ما أمضى من
الوقت في
السفر ذهاباً
وإياباً.
لأنّه بدأ رحلته
عام 1224 من
الهجرة وعاد
سنة 1226هـ.
يُقِرُّ بهذه
الحقيقة من
أرّخ له من
النقشبنديّين
أيضًا. ولكنه
ماذا عمل وما
ذا تعلّم في هذه
الْمُدَّةِ؟ على أي
حال، فقد أجاب
النقشبنديّون
عن هذا السؤال
حسبما قصّ
عليهم
البغداديّ من ذكرياته.
ولكنّنا لا
نعثر على كلمة
واحدة مّا عسى
يكون قد صرفها
دفاعًا عن
دماء
المسلمين من
سكّان الهند
وحمايةً
لعرضهم وكرامتهم
ضدّ السلطة
الإنجليزية
الّتي لم تعرف
الأمان ولا
الاحترام
لحقوق أهل
الإسلام في
تلك الديار. بينما
نعثر على
عبارات له في
رسالته الّتي
وجّهها إلى
عبد القادر
الحيدريّ
ردًّا على كتابه،
يعبّر فيها عن
ابتهاجه
بغلبة الجيش
العثمانيّ
على العرب الوهّابيّين،
وهذه كلماته:
»ثمّ
بشّرتُمْ
فيها دَاعِيَكُمْ
ببعض الأخبار
السارّة من
جهة الحرمين
الشريفين
وغلبة عساكر
الإسلام
وانتظام
أمرهم، وذلّة
الفرقة
المخذولة الوهّابيّة
وقربهم على
الدمار
والبوار،
ووقوفهم على
شفا جرف هار«.[471]
من
عجائب قدر
الله وآثار
قدرته أنّ
الغلبة صارت
في النهاية
لجيش الوهّابيّين،
وانتظم أمرهم
حتّى أعلنوا
عن قيام
دولتهم. أمّا
عساكر
النقشبنديّين،
فإنّهم باؤوا
بفشل ذريع
وأصبحوا هم
الفرقةَ
المخذولةَ،
بخلاف ما كان
يتوقّعه
غوثهم الّذي
يعظّمونه
بصفات لا
يعتقدونها في
أحد من
الأنبياء والمرسلين.
فلم يتحقّق
لهم النصر
ليباهوا بذلك
خصومَهم على أنّه
من كراماته[472]. {وَمَا
النصْرُ
إِلاَّ مِنْ
عِنْدِ اللهِ الْعَزِيزِ
الْحَكِيمِ}.[473]
اشتهر
خالدٌ
البغداديّ
بعد عودته من
الهند بصورة
غير معهودة،
وذهب صيته إلى
أقصى بقاع المملكة
العثمانيّة مِمَّا
أثار الشكوكَ
حوله في نفس
الخليفة العثمانيّ
السلطان
محمود الثاني
بالذّات وفي
أوساط حكومته.
لأنّ أتباعَ
خالدٍ البغداديّ
كانوا يسعون
بحماسة شديدة
لنشر طريقتهم
في جميع أنحاء
المملكة،
وكانت لهم
نشاطات كثيفة
حتّى في مدينة
إسطنبول عاصمة
الدولة.
فقد
ورد على لسان
أحد
المؤرّخين
العثمانيّين
ما قد عرّبه
عباس
العزّاويّ
كما يلي:
»منذ
خمسة أشهر
مضت، ورد إلى
إسطنبول بعضُ
خلفاءِ الشيخ
خالد
المتوطّن في
الشام، وهو من
علماء
السليمانيّة،
وانتشروا في
مساجد
إسطنبول
وجوامعها، وبثّوا
الدعوةَ إلى
طريقتهم،
فانتسب إليها
جماعةٌ من
أكابر
إسطنبول
وعلمائها،
ونالوا شهرةً في
بلاد العربِ
والتُّرْكِ،
وصاروا يسمّون
دعاتهم
(الخلفاء)؛
فأذاعوا هذه
الطريقة، وسعوا
سعيًا حثيثًا
في ترويجها
وكسب المريدين
لها«.
»وهى وإن
كانت لا ضرر
منها في
الظاهر،
فالأَولى أن
لا يُتْرَكَ
المجالُ
لتكثير (سواد
الصوفيّة)
وإقرارهم على
هذا. والواجب
يقتضي مراعاة
الأحوال
الموجودة
والمعهودة في
الإسلام«.
»وعلى
هذا نُفي من
إسطنبول
مشاهيُر
الطريقة النقشبنديّة
وأعوانُهم في 21 من شهر
رمضان سنة 1234هـ. 1817م. ليلاً.
وجيء بهم إلى
الميناء،
وأُركِبوا في
زورق إلى
(قارتال)[474] ومنها
إلى سيواس[475] فأحلّوهم
فيها. وفي
اليوم التالي
نُفِيَ من
مشاهيرهم علي
أفندي
أُرْﮔُﱯ من
علماء
إسطنبول إلى (ﭼَﺮْكَشْ)
داخل مدينة
أنقره. وصالح
أفندي، وأحمد أفندي
إلى (سيواس). ثم
أُرْسِلَ
خليفةُ الشيخ
خالد وأَعْوَانُهُ
إلى أنحاء
السليمانية
على أن لا
يعودوا إلى إسطنبول«.[476]
»فأدّى
هذا التطوّر
إلى إصدار الأوامر
بالبحث
والتحقيق مع
خالد
البغداديّ،
رئيس الطائفة.
وذلك بإيعاز
من أحد رجال
الدولة يُدْعَى
حَالَتْ
أفندي.[477] فقام
بهذه المهمّة
داود باشا
والي بغداد.
إلاّ أنّه
أعرب في
التقرير
الّذي أعدّه؛ أنّ
خالدًا لا قصد
له إلاّ إحياء
السّنّة السّنيّة،
وأنّه مشغول
بإرشاد
مريديه، غير
ساع بذلك إلى
تحقيق أيّ
مصلحة له.
وأنّه بعيد كلّ
البُعد عن الشؤون
السياسيّة«.
وتعهّد
الوالي داود
باشا في نهاية
التقرير: أنّ
خالدًا لن
يتدخّل في
أيِّ شيء من شؤون
الدولة أبدًا«.[478]
اطمأنتْ
السلطةُ لا شكّ
بعد هذا
التحقيق
الّذي أثبتَ
ولاءَ خالدٍ للخليفة.
إلاّ أنّ في
هذا الحدثِ
مسألة هامّة.
تلك أنّ
نشاطات خالد
البغداديّ بما
فيها رحلته
إلى الهند،
والتطوّرات
الّتي
تعاقبتْها؛
كانتشارِ
صيته إلى
الآفاق بسرعةٍ،
وإقبالِ
الأعيان
عليه، إذا لم يكن
ذلك كلّه خطّةً
قد أعدّتْها
أيادي السلطة العثمانيّة
بالذّات في وقت
سابق
لاستخدامها
في أَوَانِهِ
لجمعِ شملِ
الدولةِ،
فانّ وجودَ
خالدٍ صدفةً
وبغتةً بهذه
الشهرة
المتزايدة
أصبح فرصةً
ذهبيةً
للتوصّل إلى الغرض
المنشود،
وبخاصّة لما
اتّفق مع هذه
المرحلة
الخطيرة
الّتي تزاحمت
فيها الويلات
على الدولة العثمانيّة،
والتفّتْ
بخناقها حتّى
كادت تُشرف
على الدمار.
وعلى
سبيل المثال
فانّ الوهّابيّين
أعلنوا
الثورةَ على
السلطة العثمانيّة
في جزيرة
العرب.
فأرسلتْ
الدولةُ إليهم
محمّد علي
باشا عام 1812م. كذلك وقعت
ثورات عديدة
في منطقة
البلقان؛ من
أشدّها ثورة
الصرب في
بلغراد الّتي
أُرسِلَ
خرشيد باشا
لإخمادها عام 1813م. ثم انعقدت
جمعيةٌ سريةٌ
يونانيةٌ
باسم: أتنيكي
أترياEthniki Etaireia عام 1814م. لفصل
المنطقة
اليونانية عن
الدولة العثمانيّة
وإعلان
استقلالها.
وكانت الدول
الأوربية قد اتّفقت
في خضم هذه
الثورات على
إجبار الدولة العثمانيّة
للاعتراف بالوجود
السياسي
للأقليّات.
ولم يكن الغرض
الحقيقيّ للدّول
المتحالفة من
هذا الإجبار
إلاّ تمهيد
الوسط
لاقتسام
الأراضي العثمانيّة
فيما بينها.
كانت
هذه نُبذةً
يسيرةً عن
مشاكل الدولة العثمانيّة
في الخارج.
أمّا في
الداخل، فانّ
الدولة كانت
قد فقدت
الهيمنة على
المنطقة
الكرديّة.
وعندما كلّف
السلطانُ
عشائرَ الأكراد
بحمل السلاح
والالتحاق
إلى معسكرات الدولة
لتغطية
الفراغ الّذي
بقي بعد
القضاء على
الجيوش
الإنكشارية،
رفضوا
أمرَهُ، وأعلن
بدرخان باشا
(أميرُ
كردستان)
الثورةَ عام 1831م. وكانت
الطائفة
اليزيدية
القاطنة
بجبال سنجار
بقرب مدينة
الموصل،
كانوا قد
أعلنوا
العصيان منذ
عام 1830م. إنّ
الدولة العثمانيّة
لم تكن قد
تعرّضت إلى
هذا القدر من
المخاطر عبر
تاريخها
المديد.
إذًا
فلم تكن
مضايقة خالد
البغداديّ في
مثل هذه
الظروف من
مصلحة الدولة
بحكم الطبع.
بل كانت
الحكمة في
استغلاله،
وتجنيد
أتباعه
المنتشرين في
أنحاء
المملكة، واستخدامهم
بجانب قوّات
الدولة، مِمَّا
دفعت السلطةَ
إلى التعاون
معه؛ كما
تبرهن على هذه
الحقيقة
كلمات الباحث
العراقيّ،
عباس
العزّاويّ
بالنسبة
لداود باشا
والى بغداد،
فيقول
العزّاويّ »وبعد أن
استولى على
بغدادا وصار
واليا عليها،
استغلّهم
سياسيًّا
وجلب رضاهم...«[479] خاصّة
وأنّ عقائد
النقشبنديّين
لما كانت تختلف
عن عقائد
السلفيّين
اختلافًا
كبيرًا - والوهّابيُّون
يعدّون
أنفسَهم من
السلفيّين -
استغلّتْ السلطةُ
العثمانيّة
هذا التنافرَ
أكبر فرصة في
تحريض خالد
البغداديّ
وأتباعه على
الوهّابيّين
الثوّار،
وكانت
الأسباب
متاحة لهذا
الاستغلال.
إذ
أنّ الموقع
الجغرافيَّ
الّذي اتخذته
الفرقة الخالديّة
مركزًا لها
يومئذ - وهو
بلاد الشام
والعراق - كان
على تخوم
منطقة الوهّابيّين،
خاصّة و أنّ
هذا الموقع
كان بمنـزلة
الدرع لمنطقة
آناضول التركيّة
ضد انتشار
عقيدة
التوحيد
بدافع نشاطات
النقشبنديّين
على امتداد
هذه الساحات
الشاسعة.
إنّ
هذه الحقيقة
ما زالت خافية
على المثقّفين
العرب حتّى
الآن، وأنّ
البحوث العلميّة
الّتي قد خاض
فيها علماء
العرب منذ
بداية النهضة
الحديثة لم
تتناول هذا
الجانب من
التطوّرات في
أبعادها
الواقعية
والموضوعية،
ذلك لأنّ
الطريقة النقشبنديّة
لم تنتشر في
صفوف العناصر العربيّة
بشكل ملحوظ.
ولذلك لم
ينتبه
الباحثون
العرب إلى مدى
علاقات
النقشبنديّين
بالسياسة
وأهلها في
الداخل
والخارج، ولا
إلى دورهم في
محاربة الوهّابيّين،
سواء في العهد
العثمانيّ وفي
العهد
الجمهوريّ.
كما سنشرحه في
بابه إنْ شاء
الله.
إنّ
الّذين
يدّعون أنّ
خالدًا جاء
بتربية جديدة
ونفخ في الناس
روحَ الزهد
والعفّة
والقناعة
بفضل طريقته
وآدابه
الخاصّة، فأدّى
ذلك إلى هبوطٍ
ملحوظٍ في
أحداث النهب
والسلب
والقتل، وسَادَ
الهدوءُ
والأمنُ
والطمأنينةُ
في المنطقة
الكرديّة
بتأثير هذه
الطريقة؛ فانّ
هذا الادّعاء
قد يكون له
أساس من
الصحة. إلاّ
أنّ هذا
الدفاع
الحماسيَّ
العاطفيَّ لا
يبرهن على
مشروعية
الأساليب
المخالفة لروح
الإسلام
بتاتًا؛ مهما
كانت هذه
الأساليب تتبنّى
ما يُرْشِدُ
إليه الإسلامُ
نفسُهُ من الفضائل
والأخلاق
السامية. فإنّها
لا تعدو عن الإقرارِ
بالإسلامِ
وآدابهِ
الأصيلةِ
وعظمتهِ وحّقَّانِيَّتِهِ
وَرَبَّانِيَّتِهِ
الّتي استوحتْ
منه النقشبنديّة
أمورًا كما
استوحتْ من
أديان أخرى
وعلى رأسها
الهندوكية،
إذن تسقط هذه
الأساليب من
الاعتبار
تلقائيّا في
ميزان العقلِ
والقساس المنطقيّ
لأنّها تبقى
زائدة على
الإسلام
وتفضله بدون
حكمة؛ وتقع
تلك
الأساليبُ
موقعَ دينٍ مستقلٍّ.
لأنه قد تكون
ثمّة طرق
لتدريب
الإنسان على
الصدق
والقناعة والعفّة
وصفاء
السريرة مع
الشرك بالله.
كما في الأديان
الباطلة
المحرَّفة.
فانّ ذلك ليس
من الحكمة في
شيءٍ. إذ لا
يخفى أنّ اليهوديّة،
والمسيحيّة،
والبرهميّة،
والبوذيّة،
والزرادشتيّة
وَغَيْرَهَا
من الأديان؛
كلِّها تحرّم
الكذب،
والغش،
والسرقة،
والإيذاء والقتل،
والزنا؛ مع
أنّها أديان
محرَّفة
باطلة بحكم
الله القاطع
في كتابه
العزيز. {إِنَّ
الدين عِنْدَ
اللهِ الإِسْلاَمُ.}.[480] {وَمَنْ
يَبْتَغِ
غَيْرَ
الإِسْلامِ
دِينًا
فَلَنْ
يُقْبَلَ
مِنْهُ
وَهُوَ فِي
الآخِرَةِ
مِنْ
الْخَاسِرِينَ.}.[481]
أما
اختفاء
الوقائع
الإجرامية
بتأثير خالد البغداديّ
وطريقته،
فإنه أمرٌ
ثانويٌّ أسفر
عن الطاعة
المطلقة
الّتي
أظهرتْها جماهيُر
النقشبنديّين
له
ولِخلفائه؛
والّتي أثّرتْ
على نفوس
الآلاف من
غيرهم. وله
سبب غريب
جدًّا. يكمُنُ
سرُهُ في
صلاةٍ خاصّة
بهم تسميَّ »الرّابطة«
عندهم. وهي »التركيز«
على صورة
الشيخ بشروطٍ
معيّنةٍ سبق
شرحها بالتفصيل
في باب آداب
الذكر عند النقشبنديّة
من الفصل الثاني.
ذلك لَمَّا انتشرت
هذه العقيدة
بجهود خلفاء
البغداديّ ودِعَايَاتِهِمْ
الكثيفة على
الساحة
الكرديّة
الّتي كانت يومئذٍ
مهدّدَةً
بأخطار اللّصوص
وقطّاع الطّرقِ
والحراميّين،
وَانْجَذَبَ
غالبُ
الأكراد بدافع
هذا التّيّارِ
الصوفيّ إلى
صفوف
النقشبنديّين؛
لُوحِظَ بعد
ذلك انحطاطٌ
بالغٌ في
أحداث
النـزاع
والجنايات في
المنطقة. وهذا
شيءٌ ليسَ
مماَّ
يُسْتَغْرَبُ.
لأنّ هذه
الصلاةَ
السحريةّ لها
تأثير عظيم في
تهدئة
الأعصاب
وإماتة
الشعور
والقضاء على البطر
والميول
الشهوانية.
نعم إنّ هذا
الشكلَ
الغريبَ من
مناسك النقشبنديّة
له تأثيرٌ
بالِغٌ في
تَهْدِئَةِ
ما يثورُ داخل
الإنسانِ
مِنْ
نَزَواتٍ
وخَلَجاَتٍ
وهيجان
وأطماع. فقد
أثبتتْ
البحوثُ في
علم النفسِ أنَّ
التَّرْكِيزَ
على شيءٍ
بعينه في
فتراتٍ
معيّنةٍ
وبتكرارٍ
مُطَّرِدٍ
يَربِطُ الْمُرَكِّزَ
بذلك الشيءِ
ربطاً
لايكادُ ينفكُ
عنه، إنْ
كانتْ هذه
الرياضةُ
الذهنيةُ قد
دامتْ مُدّةً
طويلةً؛
فيزدادُ
المُرَكِّزُ
وَلَعاً بِهِ
وشَغَفاً،
فينقطعُ من
جميعِ ما كانَ
قد شَبَّ
عليهِ من ذي
قبل؛
ويتحوّلُ
ارتباطُهُ به
إلى عبادةٍ
وافتِتانٍ
وانصهارٍ
وانحلالٍ في
النهايةِ،
فلا يلتفت بعد
ذلكَ إلى شيءٍ
من ملذاَّتِ
هذه الدنيا.
فلماَّ
أثّرَتْ هذه
التعاليمُ الخالديّة
السحريةُ في
نفوسِ عامّةِ
الأكرادِ
ودّجَّنَتهُمْ
وسَلَخَتْ
غِلظَةَ
طبعهم، لا
شكَّ فِي
أنّهم
تحوّلوا بعد
ذلك إلى
جماعاتٍ خاضعةٍ،
بل إلى
قطائِعَ
صوفيةٍ
يُخْفِضونَ
للشيخِ جناح
الذُّلِّ من
مُنطَلَقِ
هذه العقيدة
وليس من
الاسلام!
وقد
أثبتتْ
التطوّرات
الّتي شاهدها
محيط
النقشبنديّين
في تركيا، أنّه
ما من شيخٍ من
مشائخ هذه
الطائفة
اهتمّ بتطبيق
الرّابطة
وشدّد على
مريديه
بملازمتها،
إلاّ وقد
انتشر صِيتُهُ
وتَهَافَتَ
الناسُ عليه تَهَافُتَ
الْفَرَاشِ
على النار، ودامت
المشيخة في
أسرته جيلاً
بعد جيلٍ،
كالأرواسيّين
وأتباعهم من
شيوخ الأكراد
والتُّرْكِ.
وما من شيخ
منهم استخفّ
بأمر
الرّابطة ولم
يُشَدِّدْ
على مريديه
بملازمتها،
إلاّ انتهتْ
أعماله
بالفشل، وخسر
أبناؤه من
شهرتهم وسقطوا
إلى منـزلة
عوامّ الناس
في مدةً
قصيرة، كعائلات
الشيوخ ذات
الأصول العربيّة
من
النقشبنديّين
في جنوبي
تركيا.
أمّا
الغاية
الحقيقية
والنهائية من
هذه الصلاة،
إنّما هي
ترويضُ
المريدِ على
تبعيّةِ
الشيخ و
الاستسلامِ
له بكلّ ما
يملك من مال
وجاه وروح؛
بكمال الرّضىَ،
وعن طيبِ نفسٍ
وفداءٍ
وإخلاصٍ، كما
سبق شرحه
بالتفصيل.
***
كلّ
هذه
المُعطَيات
الهامّة
الّتي نُثْبِتُهَا
ونَتَحَقَّقُهَا
من خلال
ميّزات خالد
البغداديّ
وتأثير آدابه
الّتي فرضها
على أتباعه،
تقودنا إلى
التأكُّد
بأنّ السلطة العثمانيّة
كانت في تلك
المرحلة
بحاجةٍ
مُلحّةٍ إلى
هذا الرجل
الفريد في
مكره ودهائه
وذكائه
ولباقته
ومرونته وحذاقته
في جذب الناس
والاستيلاء
على عقولهم،
والتحكّم في
إرادتهم. هذا
الرجل الّذي
أصبح شيخًا
روحانيًّا
عملاقًا،
استهوتْهُ
قلوبُ مئاتِ
آلاف الناس
وتعلّقتْ به
الضمائر، ومع
ذلك ارتجفت من
بطشه الفرائص،
واقشعرّت من
هيبته الجلود،
وافتتنت
بشهرته
النفوس،
وثارت
لاستغلال
جاهه ومكانته
الأطماع.
ولهذا
لم تَدَّخِرِ
السلطةُ وُسْعًا
في تأييد خالد
البغداديّ،
والدعاية له، والقيام
بنشر صيته
سرًّا
وعلنًا؛ ذلك
لكسب تأييده
بمقابلة
المثل في
إخماد
الثورات الّتي
انفجرت في
المناطق
الكرديّة والعربيّة
يومئذ؛
ولتوفير
الأمن
والهدوء في
ربوع البلاد.
إنّ
هذا الموقف
الّذي قامت
على أساسه
العلاقات بين
السلطة العثمانيّة
وبين خالد
البغداديّ،
يُعْتَبَرُ
هو العاملَ
الأساسيَّ
لانتشار
الطريقة النقشبنديّة
الخالديّة في
صفوف الأتراك
والأكراد
عَبْرَ
المرحلة الأخيرة
من العهد
العثمانيّ
والعهد
الجمهوريّ
على السواء؛
والّذي جعل من
هذه الطائفة
اليوم جمهورًا
في تركيا،
تحسب
الحكومات
حسابها في كلّ
تقلّبٍ وقرار
لكسبها.
***
* خالدُ
البغداديّ
ومعارضوه.
تفيد
أخبار
النقشبنديّين
أنّ خالدًا
لقي معارضةً
شديدةً من
رجالٍ بارزين
في العراق فور
عودته من
الهند. هذه
المعارضة،
على الرغم من
أنّ
النقشبنديّين
يحملونها على
الحسد المحض
من هؤلاء
الأشخاص، لها
سببان مهمّان،
كما سنطرقهما
بالإيجاز،
بعد أن نُلقي
نظرة سريعة
على شيء من
كلمات مَنْ
ندّد بالمعارضين
ورماهم
بالحسد؛
يتحمّس
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ بخلع
صفات الإجلال
على خالد
مدافعًا عنه
بأسلوبه
المسجّع
الخاصّ وعلى
سبيل التشنيع
والإدانة
لخصومه فيقول:
»لمّا
اطّردت سنة
الله في
الّذين خلوا
من قبل، أن
يجعل
حُسّادًا
لكلّ من تفرّد
بالفضل، وكلّما
كان الكمال
والمحبوبية الإلهيّة
أشدّ، كان
الإنكار والحسد
أشدّ؛ هاج
عليه بعض
معاصريه
ومواطنيه بالحسد
والعدوان
والبهتان،
ووشوا عليه
عند حاكم
كردستان
بأشياء تنبو
عن سماعها
الآذان، وهو
برئٌ منها
كلّها بشهادة
البداهة
والعيان«.[482]
ثم
يستطرد
الخانيّ
بقوله:
»فألّف
أحد
المعروفين من
المنكرين
الّذي تولّى
البهتان كبرًا
وغرورّا،
رسالةً
مُلِئَتْ
منكَرًا من القول
وزورًا،
وأرسلها مع
سُعاة الفساد
إلى سعيد باشا
والى بغداد،
متّخذين
الجرأة فيها
على نكيره
لتنفيره منه
سببًا، كبرت
كلمة تخرج من
أفواههم، إن
يقولون إلاّ كـذبًا«.[483]
هذه
العبارات
الّتي استعرض
فيها الخانيّ
تفوّقه الأدبيَّ،
لا تُنبئ عن
تمام الحقيقة
لذلك الحدث. وإنّما
الواقع، هو الّذي
أثاره »أَحَدُ
الْمَعْرُوفَيْنِ
مِنَ
الْمُنْكِرِينَ«
بتعبير
الخانيّ -، (وهو
معروفٌ
البرزنجيُّ،
والثاني لم
نعثر على شيءٍ
من أخبارِهِ). فالواقع
الّذي أثاره
البرزنجيُّ،
هو مقالُهُ عن
خالدٍ (وما
جاء في
خلالِهِ: أنَّ
خالدًا حمل من
الهند إلى
العراق من
عادات
البراهِمَةِ
وعقائدهم، فجعلها
أساسًا
لطريقته فجذب قلوبَ
الناسِ بها.)
يبدو
من ظاهر طعن
البرزنجيِّ في
خالد
البغداديّ،
أنّ السبب
لهذه
المعارضة، هو
ما يقصده
بقوله: »إنّه
ذهب إلى
الهند،
فتعلّم من السحرة
الجُوكِيَّةِ
ومن نصارى
الإنجليز
دينًا ظهر
عندهم« خشية أن
يدسَّهُ في
عقائد
المسلمين (!)
إلاَ أنّ
السبب
الحقيقيَّ هو
مخافةُ معروفِ
البرزنجيِّ
من أن يخسرَ
أتباعَهُ
وشهرتَه،
فيُصبِحَ
مهجورًا وحيدًا
بعد أن رأى
خالدًا
ينافسه بنجمه
الّذي بدأ يلمع
في الآفاق ويتألق.
من
الجدير
بالإشارة
هنا، أنّ
محاولة
البرزنجيّ في
هذه
المعارضة،
تبرهن بكافّة
جوانبها على
قلّةِ حظِّهِ
من العلم
والمعرفة
والسموّ
الأخلاقيِّ؛
و على عدم كفاءته
ومروءته
وإخلاصه. ولكن
تدلّ على أنّه
كان هو الآخر
صوفيًّا
متطرِّفًا
بعيدًا من الفضائل
والكمالات
الّتي يتميّز
بها علماء
الإسلام من
الصلابةِ في
وجه الدجاجلة
المحرِّفين؛
جبانًا، لا يملك
الجرأةَ على
أهل الأهواء
والبدع
والفاسقين؛
جاهلاً بفنون
المجادلة
وأساليب
إفحام المتنطّعين.
لذا
وجد نفسَه في
النهاية
مضطرًّا
للاستسلام
تحت ضغط
النقشبنديّين،
ورضي بالذّلّة
والمهانة
أمام زعيمهم،
فاعتذر كما
يذكره الخانيّ
في حدائقه
ويشرحه بحماسة
ورغبة
ابتهاجا
بانتصار خالد
البغداديّ
عليه، فيقول:
»ثم
اعترف معروفٌ
بافترائه،
وتشفّع إليه (...)
مع جملةٍ من
أحبّائه،
فقبل به
شفاعتهم،
وكتب له ما
أوجب مسرّتهم.
ونصّه:«
»من
العبد المسكين
والفقير
المستكين إلى
جناب سيّدي
الجامع لشرف
العلم والأدب
الحائز
لكرامتي
الحسب والنسب،
سيدنا
ومولانا
السيد معروف،
سامحه بفضله
الكريم
الرؤوف. وبعد؛
فقد بلغني ما
وصّيتم به أخي
ملاّ حسين
القاضي
وأمرتموه
بتبليغه
إلينا من حسن العبارات
ولطائف
الإشارات؛ ثم
ما ألقيتموه
مع قرة عيني
العالم
العامل السيد
إسماعيل من
مكارم
الأخلاق،
والاشتياق
إلى التلاق،
وإظهار الأسف
على ما صدر
منكم في حق
الفقير على
سبيل الاتّفاق،
بسعاية أرباب
الأغراض وأهل
الشقاق؛ والاعتذار
عن جميع ما
جرى به
اليراع، في
رسالتكم
المعهودة
الناشئة عن
تقليد الوشاة
وعن عدم
الإطّلاع،
المهيّجة عند
بعض عوام
المريدين
لفرط الوحشة
وشدة النـزاع،
الحاكمة على
هذا المسكين
بأمور تنبو عن
استماعها
الأسماع؛ من
استحلال
المحرّم،
والكلمات
الدالة على
الكفر،
وداعية الاستيلاء
على البقاع،
وغير ذلك مما
لا يليق بشأن
الأوغاد
والرعاع.
وتفصيله لا
يخفى على
ذهنكم
الوقّاد
وطبعكم النقاد.
و إني لبرئٌ
عما نسبتم
إلىَّ من فنون
المثالب
والفساد
والإفساد.
وأمرتم السيد
المذكور أن
يستكتب مِنِّي
أُلوُكَةً
تنطق ببراءة
الذمّة من
جميع ما صدر
وغبر وجرى به
القلم بمقتضى
القضاء
والقدر،
لتصير مفتاحًا
لأبواب الائتلاف
ومصباحًا لِدَيَاجِيرِ
المراء
والخلاف. وبلغني
من السفيرين
تصميمكم على
الإمساك فيما
بعد أمثال ما
مضى من
النـزاع
والمناحرة، وملافاة
ما فات بطيب
التحابّ وحسن
المعاشرة وتبديل
المعارضة
والمنافرة
بالفكاهة
والمسامرة؛
فسرّتني هذه
الحكاية غاية
المسرة؛ وحمدتُ
الله على هذه
النعمة مرةً
بعد مرةٍ،
شكرًا لمن
بدّل الشقاق
بالاتّفاق،
وهيّأ أسباب
الوصول بعد
طول الفراق.
أدامنا الله
على هذه
النية، وأتمّ
لنا بمنّه هاتيك
الأمنيّة؛ ثم
الأمر بإرسال
المكتوب، امتثلنا
وهو أحسن
المطلوب،
ونريد جوابه
على أبلغ
أسلوب.و أمّا
الإبراء، فهو
يصدر منّي
ليلاً
ونهارًا،
وأفصحتُ به في
المحافل
جهارًا، كما
قرع سمعكم
مرارًا.وأمّا
حب الإلتآم
وترك
الاختلاف،
فأمرٌ يَشتاق إليه
أهل الإنصاف.
فكيف بمن يدّعى
له قدم في
طريق التصوّف
ولو بالجذاف.
ولا يخفى
عليكم أنّ
السبب
الأصليَّ
لهذه الوحشة إنّما
هو ترك التردّد،
وتقليد أقوال
الناس.فانْ
صحّ ما بلغني
عنكم، فعليكم
بالإعراض عن
الكلمات
المؤدّية إلى
الشكّ
والوسواس.
فانّ أحوال
أهل الفقر
وراء العقل،
والعلم يدرك
بالقياس. وبعد
اللُّتَيَّا
والّتي، يَضْمَنُ لك هذا
المسكين - إن
ثبت قدمك، وما
طغى قلمك بعد
اليوم - أن ترى
نتائج لا يحمل
أكثرها
السفير،
وتزيد على حوصلة
التقرير
والتحرير.
ومن
بعد هذا ما
تدقّ صفاته *
وما كتمه أحظى
لديّ وأجمل.
والسلام
عليكم ورحمة
الله وبركاته«.[484]
إنّ
في هذا الخطابِ
لَعِبْرَةً
لأولى
الألباب! نلمس
من خلال
مضمونه ما
يمتاز به خالد
من لباقةٍ
وتلوّنٍ
ومهارةٍ
بفنونِ
التفنيدِ ولو
كان
مُنَاظِرُهُ
على حقّ.
ونجده في
انتقاء
الكلمات
بارعًا
محنَّكًا،
يُتقن أساليب
حرب الجدال،
ويعلن
انتصاره
بجمال
التعبير، وكمال
النطق
والتقرير،
ونظام
الإنشاء
والتحرير،
بحيث يضطرّ
المخاطب أن
يُرخِيَ له
جناحَ الذلّ
من الهيبة
فيعلنَ
الاستسلامَ
والخنوع
أمامه، ويكتم
الحقَّ والواقعَ،
ويعترفَ
بغلبته
وعظمته.
هذا
ما وقع لمعروف
البرزنجيّ.
فتهيّب ظلّ
خالدٍ
واستعظمه،
ودبّ الذُعر
في قلبه حتّى
أظهر الندامة؛
وكأنّه لم يكن
هو الّذي طعن
في خالد بقوله:
»إنّه
ذهب إلى
الهند،
فتعلّم من
السحرة الجُوكِيَّةِ
ومن نصارى
الإنجليز
دينًا ظهر عندهم«.[485]
***
وهنا
يتبادر إلى
الذهن بهذه
المناسبة أنْ
نتساءل عن السِّرِّ
الحقيقي
الّذي
يَكْمُنُ في
رحلة عددٍ من
رجال
الصوفيّة إلى
بلاد الهند
بما فيهم خالد
البغداديّ؛
وذلك لسببٍ
غير شديد.
يقول
الباحث سميح
عاطف الزين في
هذا الصدد:
»ومنهم
من سافر إلى
بلاد الهند كي
يلتقي المهرة
ممن يمارسون
فنون السحر؛
فيأخذ عنهم ما
يحقّق له
غايته. ومن
هؤلاء، كان
الحسين بن
منصور الحلاّج
الّذي سافر
إلى الهند
أكثر من مرة،
وقضى فيها بضع
سنوات، حيث
تعلّم وتدرّب
وعاد يُظهر للناس
ما يبهر
العيون، ويجمع
الأتباع
والمريدين.
فمن الأعمال
الّتي كان
يقوم بها: إنّه
كان يدخل
تنّورًا
يضطرم بالنار
فيجلس في ناحية
منه، والخباز
يخبز في ناحية
أخرى. ثم يخرج دون
أن يمس جسمه
النار. أما في
الواقع، فانه
كان يَعْمِدُ
قبل دخوله
التنّورَ إلى
دهن جسمه
بمادّة الطلق
الّتي لا تؤثر
فيها النار.
وهي مادّة
الأسبستوس
المعروفة
اليوم،
والّتي
تُصنَع منها
الملابسُ خاصّة
لرجال
الإطفاء
يرتدون عند
مكافحة الحرائق«.[486]
هذا
ومن الأمور
الشائعة بين
الطائفة
الرفاعية
والجراحية
والقادرية -
خاصّة في
تركيا والعراق
- أنّهم
يقومون بطعن
الأسياخ من
الحديد في
مختلف البقاع
من أجسامهم؛ يدخل
السيخ مثلاً
في ناحية من
البطن، ويخرج
من العَجُزِ
وهو يرقص في
حالة من
الاستغراق.
كذلك
يدخلون النار
فلا تحرقهم،
ويقرِضون الزجاجَ
فيسحقونه
بأسنانهم ثم
يبتلعونه على
رؤوس الأشهاد.
وهذه
الاستعراضات
كثيرةُ
الوقوعِ،
يشهدها جماهيرُ
من الناس
الّذين
يحضرون
حفلاتهم
بعيونٍ شاخصةٍ،
واستفهامٍ في
أذهانهم، لا
يجدون له ردًّا،
ولا
لمشكلتِهم
حلاًّ. فيظنُّ
غالبهم أنّها
كراماتٌ،
ويحسب بعضهم
أنها أشكال من
السحر.
والحقيقة
أنها ليست من
الكرامة في
شيءٍ ولا هي
معدودة من
السحر؛ وإنما
هي طبائعُ
مكتسبةٌ
نتيجةَ
رياضاتٍ
يوغيةٍ شاقةٍ
من تقاليد الهنود،
قلّ من يتحمّل
ثقلها
وآلامها
والحرمان
الّذي يعرض له
جسمه.
يمارسونها
مدة طويلة حتّى
يصـلون إلى
هذا الحـدّ من
قوة التحكم في
الأجهـزة
الدقيقة من
البنية
البشرية
ووظائفها؛ وهي
حالة خطيرة تسـمّى
بالتعبير
العلميِّ Concentration Physiologic
أي »التركُّز
الفزيولوجي«
وقبل أنْ
نخرجَ من بحثِ
معارضةِ
البرزنجيّ،
ينبغي أن
نتطرّق
بإجمالٍ إلى
المهاجمة والردود
الّتي تعرّض
لها في مقابلة
عتابه على
خالد
البغداديّ
قبل أن يتصالح
معه.
يقول
الباحث
العراقيّ
عباس
العزّاويّ:
»إنّ
الشيخ
معروفًا
النودهيّ
البرزنجيّ
(وهو العلاّمة
الشيخ محمّد
بن الشيخ
مصطفى.) فقد
نظم رسالة
بعنوان: تحرير
الخطاب في
الردّ على
خالد الكذّاب.
وأرسلها في
سنة 1228 هـ./1813م. إلى
الوزير سعيد
باشا والي
بغداد في ذمّ
الشيخ خالد،
ولم يكتف بذلك
حتّى أسند
إليه الكفر.
وناصر الشيخ
معروفًا
كثيرٌ من
الأهليّين في
السليمانية.
كانوا
يعتقدون
بسادات بَرْزَنْجَة
وطريقتهم
(قادرية)؛
فثقل عليهم
أمر الشيخ خالد؛
وحاولوا
إخمادَ شهرته
فلم يفلحوا«.[487]
يمكن
اختصار ما جاء
بعد هذا
المقطع ضمن
كلام العزّاويّ
في هذا الصدد:
أنّ تلك
المعارضة لقيتْ
ردًّا عنيفًا
من بطانة خالد
ومناصريه بما
فيهم والى
بغداد سعيد
باشا بن
سليمان باشا؛
فتصدّى للردّ
على
البرزنجيّ كلّ
من الشيخ محمّد
أمين بن محمّد
صالح
الطبقجليّ،
مفتي الحلّة؛
والشيخ يحيى
المزوريّ؛
والشيخ عبيد
الله
الحيدريّ؛
والشيخ محمّد
أمين السويديّ.
أمّا الشيخ محمّد
أمين بن محمّد
صالح
الطبقجليّ، فإنّه
ردّ على
البرزنجيّ
بعجالة سمّاها
»القول
الصواب، بردّ
ما سُمّي
بتحرير
الخطاب«؛
وأمّا
الشيخ يحيى
المزوريّ،
فرسائله
الّتي نصح
فيها
البرزنجيّ
وهي سبعة
رسائل،
يضمُّها كتاب »بغية
الواجد«[488] للشيخ محمّد
أسعد الصاحب، جمع
فيه مكتوبات عَمِّهِ
خالد
البغداديّ.
ومن
جملة هذه
الردود »صكٌّ«
مُوَقَّعٌ
عليه من ملالي
السليمانية
الّذين كانوا
تحت تأثير
خالد
البغداديّ
بحكم الجوار.
يفخر
النقشبنديّون
بهذا الصكِّ
على لسان ناقله
إذ يقول بعد
ما يعدُّ
أسماءَ هؤلاء
الخواجوات
المتواطئين
على إصداره
بتوقيعاتهم »هم من
العلماء
الأفاضل
والسادات
الأماثل. ومضمون
الصكِّ
المذكور:
الثناء على
حضرة مولانا
خالد، والحطّ
على رسالة
الشيخ معروف
وتكذيبها؛ مع
أن أغلب العلماء
المذكورين
أبناء عَمِّهِ«[489] أَمَّا الصكّ
المذكور، فقد
أورده أسعد
الصاحب بكامل
نَصِّهِ في كِتَابِهِ:
»بغية
الواجد«،
بعد هذا
التوضيح
مباشرةً. أوّله
»الحمد
لله الّذي
أراح الفقراء
مع كثرة تعرّض
الظالمين...«
كذلك
تصدّى الشيخ محمّد
أمين السويديّ
للرّدّ على
رسالةٍ كان قد
كتبها الحاج
أبو سعيد
عثمان بك بن
سليمان باشا
الجليليّ
بعنوان »دين
الله الغالب
على كلّ منكر
مبتدع كاذب«. كان
شَرَحَ بها
رسالةَ »تحرير
الخطاب«
للشيخ معروف
البرزنجيّ؛
ردّ عليهما
السويديُّ
بكتابه الّذي
سمّاه
تارةً »دفع
الظلوم عن
الوقوع في عِرْضِ
هذا المظلوم«؛ ثم
قال »ويناسب
أن يسمّى
القول الصواب
في ردّ ما
سُمّي بتحرير
الخطاب«؛ ثم قال »والأنسب أن
يسمّى السهم
الصائب لمن
سمّى الصالح
بالمبتدع
الكاذب«[490]
نقل
أسعدُ الصاحب
ترجمةَ محمّد
أمين السويديّ
وامتدحه
بقوله »إنّ
هذا الْجِهْبِذَ
الْمِفْضَالَ
قد قام في
الانتصار
لحضرة مولانا
العم حق القيام؛
يتحتّم عليَّ
أنْ أذكرَ
نُبذةً من
ترجمته أداءً
بحق خدمته«.[491] إلاّ أنّ
الشيخ أسعد
هذا، لم يملك
نفسه في الوقت
ذاته من
مهاجمة
الجليليّ
بلهجة قاسية
يتحاشى من
أمثالها أهلُ
العلم، فقال
في ثنايا عباراته
»فلما
اطّلع
العلماء
الأعلام، في
العراق والشام،
على تحاملهم
على هذا القطب
الكامل، طفقتْ
تترى ردودُهم
على رسالة الشيخ
معروف وشرحها
الشنيع الّذي
سوّدَه عثمان
بك الجليليّ،
سوّد الله
وجهَهُ يوم
تسودُّ وجوهٌ
وتبيضُّ
وجوهٌ«.[492]
نستحسُّ من
هذا الغيظ
الّذي يفور من
كلمات الشيخ
أسعد الصاحب،
أن يكون الشيخ
عثمان الجليليّ
قد قُتِلَ على
يد
النقشبنديّين
أثناء فتنة وقعت
في الموصل عام
1829م. والله
أعلم بالصواب.
وعلى
أيِّ تقدير،
فانّ النـزاع
الّذي اندلعت
نيرانُهُ بين
النقشبنديّين
ومُعَارِضِيهِمْ
- بعد انتشار
نشاطاتهم في
الشرق الأوسط
-، يبدو مدى
نطاقِ
خطورتهِ
بمجرّد ما قد
سجّلَهُ أسعد
الصاحب فحسب،
فضلاً عمّا كتبه
قدماء الفرقة الخالديّة
وما تناقله
الناس من
أخبار هذا
النـزاع؛ كما يظهر
مِمَّا
أَثَارَتْهُ تلك
الحربُ
الشعواءُ من
هولٍ ودهشة
وشغب في أوساط
المجتمع
يومئذ. ومن
أهمّ أحداث
هذه الحرب
وأخطرها،
قيام النقشبنديّين
بإحراق الكتب
والرسائل
الّتي أُعِدَّتْ
للرّدّ عليهم.
من جملتها
كتابٌ بعنوان »البدور
الجلية في
الردّ على النقشبنديّة«
ألّفه الشيخ
محمود بن
الشيخ عبد
الجليل الموصليّ.
فقد اختفت
نُسَخُ هذا
الكتاب
بتمامها إلاّ
ثنتان منها
نجتْ من
بطشهم. قيل
نسخة منها
بحوزة الشيخ
جميل
الطالقانيّ،
فلم نتعرّف
عليه؛ أمّا
النسخة
الثانية فإنها
في قرية »بريفكان«
بالمنطقة
الكرديّة من
العراق، وليس
الوصول إلى
هذه المنطقة
من الأمور
السهلة كما هو
معلوم!
هذا،
فلم تقتصر
محاولةُ
إفحامِ
النقشبنديّين
وإحباطِ
أعمالهم في
الساحة
العراقيّة
فحسب، بل تصدّى
لهم آخرون في
بقاعٍ
مختلفةٍ من
أرض الإسلام.
منهم محمّد صدّيق
حسن خان
القنوجيّ
البُخَاريّ
أمير مملكة
بهوبال في الهند.
تصدّى للرّد
عليه محمّد
أسعد الصاحب
في كتابه »نور
الهداية
والعرفان في
سرّ الرّابطة
والتوجّه[493] وختم
الخُوَاجَگَانْ« قال
في أوائله:
»وقفتُ
على التاريخ
المسمّى
بالتاج
المكلَّل
تأليف الفاضل
المشهور (صدّيق
حسن خان)
البُخَاريّ
القنوجيّ نوّاب
بهوبال؛
فرأيتُ فيه
سؤالاً
واردًا عليه من
الأديب
الفاضل
السيّد نعمان
بن الإمام العلاّمة
الكبير والحجّة
المفسّر
الشهير السيّد
محمود
الآلوسي مفتي
بغداد، عن
الرّابطة الشريفة
الّتي
تستعملها
ساداتنا
الأئمة النقشبنديّة
زبدة القادة
الصوفيّة (...).
وملخّص ذلك
السؤال: ما
قولكم في حكم
الرّابطة
المستعملة
عند أصحاب
الطريقة النقشبنديّة
(...)؛ وهل لها أصل
من السّنّة
والكتاب، أم
هي اختراع
واجتهاد؟ فان
كان لها أصل
فما هو؟ وإلاّ
فهل ذلك شرك
أصغر وتضليل؟
لأنّها تصوّر
المريد شيخه
الغائب؛
وكلّما ذكر الله
تصوّر صورته
في سويداه. أم
ليس في ذلك بأس،
حيث قال بها
جمع من
الأواخر؟ وهل
يعارض ما استدلّوا
به من قصّةِ
يوسفَ عند ما
همَّ، ورأَى
يعقوب عليهما
السلام (...).
فأميطوا عنّا
غبار الشكّ
والترديد. إلخ«.
جاءت
هذه العبارات
في كتاب »التاج
المكلّل«
بصيغة تختلف بعضُ
ألفاظها عما
نقله أسعد
الصاحب في
السطور
المذكورة
آنفًا؛ وهذه
نصّها على
لسان مؤلف »التاج«
بالذّات وهو
صدّيق بن حسن
خان
البُخَاريّ
القنوجيّ،
فقال:
»ومما
كتبه إلينا
صاحب الترجمة
هذه ما نصّه:
ما يقول
مولانا
الأمير السيد
النحرير النوّاب
المفسّر
الشهير مقتدى
الأعاظم ومن
لا تأخذه في
الله لومة
لائم متّع
الله سبحانه
المسلمين
بطول بقائه،
وقمع به البدع،
وأناله في
الدارين
مناه، في حكم
الرّابطة
المستعملة
عند أصحاب
الطريقة النقشبنديّة
- أفاض الله عز
شأنه علينا من
علومهم
المرضية - وهل
لها أصل قويّ
من الكتاب
والسّنّة، أم
هي اختراع
واجتهاد من
بعض ذوي
الألباب؟ فان
كان لها أصل،
فما ذلك عند
أرباب العقد
والحلّ، وإن
لم يكن لها
دليل، فهل في
ذلك شرك أصغر
و تضليل؟
لأنها كما هو
المشهور:
تصوير المريد
شيخه الغائب
وكأنه في
الحضور، وكلّما
ذكر الله
تصوّر صورة
شيخه في
سويداه، أم ليس
في ذلك بأس
لدى الأكابر؟
حيث قال بها
جمع من الأواخر؛
وهل يعارض ما
استدلّوا به
من قصّة يوسف u -
عند ما همّ،
ورأى يعقوب
النبيّ
النبيل؟ قوله u:
أعبد الله
كأنك تراه،
الحديث
الطويل.
فأميطوا عنّا
غُبارَ الشكّ
والترديد
بأبين جواب، وميّزوا
الخطأ عن
الصواب،
فإنكم من فضله
عزّ وجلّ من
الوافين
بالعهد
والميثاق لتبيين
الكتاب،
جعلكم الله
للسلفيّين
وكافّة
الموحّدين
حصنًا
حصينًا،
وأنالكم
وسائر
العلماء مزيد
الثواب آمين.
سنة 1198 هـ.
شعبان«
»فأجبتُهُ
- عافاه الله
وعن المكاره
وقاه - مرتجلاً
بما هذا لفظه:
أمّا مسألة المرابطة،
فلا يخفى على
شريف علمكم
أنّها من
البدع المنكَرة.
وقد صرّح
بالنهي عنها
الشيخ أحمد
وليّ الله
المحدّث
الدهلويّ
إمام هذه
الطبقة
وزعيمها،
ومسند وقته
ومجدِّدِ
عصره وفرد
الملّة المحمّديّة
وحكيمها في
كتابه (القول
الجميل في
بيان سواء
السبيل)، وهذه
عبارته: قالوا
والركن
الأعظم، ربط
القلب بالشيخ
على وصف
المحبّة والتعظيم،
وملاحظة
صورته. قلتُ:
إنّ للهِ تعالى
مظاهرَ كثيرةً؛
فما من عابد ـ
غبيًّا كان أو
ذكيًّا ـ إلاّ
وقد ظهر
بحذائه شيء
صار معبودًا
له في مرتبته. ولهذا
السّرّ نزل
الشرع
باستقبال
القبلة
والاستواء
على العرش.
وقال رسول
الله r: إذا
صلّى أحدكم
فلا يبصق قبل
وجهه. فان
الله بينه
وبين قبلته.
وسأل جاريةً
سوداءَ، فقال:
أين الله؟ فأشارت
إلى السماء.
(الحديث). فلا
عليك أن لا
تتوجّه إلاّ
إلى الله، ولا
تربط قلبك
إلاّ به ولو
بالتوجّه إلى
العرش،
وتصوّر
النوّر الّذي
وضعه عليه.
-وهو أزهر
اللون كمثل
نور القمر-،
أو بالتوجه
إلى القبلة:
كما أشار إليه
النبي r،
فيكون
كالمراقبة
لهذا الحديث«
»وقد
أفاد الشيخ
العلامة محمّد
إسماعيل
الشهيد
الدهلويّ في
كتابه »الصراط
المستقيم«
بالفارسيّة:
أنّ هذه
الرّابطة من
الشرك بمكانٍ
لا يخفى على
من له أدنى
إلمام بعلوم
الكتاب والسنّة.
وأقول: ما لنا
ولقلبنا،
وربطه بالشيخ
كائنًا مَنْ
كان، وإنما
تُرْبَطُ
قلوب العباد
إلى بارئها.
(ألا بذكر
الله تطمئن
القلوب).
وبالجملة،
هذه المسألة
وإنْ فاه بها
جمع من
المشائخ
قديمًا
وحديثًا، فهي
من البدع بلا
مرية، وحكمها
حكم سائر
البدع وسائر
الأشياء الّتي
أحدثها المتصوّفة
من غير أساس
على دليل من
كتاب وسنة.
ويكفي في ردِّ
مثل هذه
البدعة قوله r
المستفيض
المشهور: كلّ
أمر ليس عليه
أمرنا فهو ردّ.
وكلّ بدعة
ضلالة وكلّ
ضلالة في
النار.«.[494]
من
الجدير
بالذّكرِ،
أنّ هذه
العبارات
التي اقتبسها
السيّد محمّد
صدّيق خانْ بن
الحسن
القنوجي
البخاري، من
الكتاب
المسمّى
(القول الجميل
في بيان سواء
السبيل)،
للشّيخ أحمد
بن عبد الرحيم
(شاه ولي الله
الدهلوي)، قد
تمَّ حذفُها
تمامًا من
الكتاب
المذكورِ في طبعه
الّذي
أعدَّهُ
رَجلٌ
مُتُطَرِّفٌ
اِسْمُهُ محمّد
صالح بن أحمد
الغرسي؛ ولم
يكتفِ الرَّجل
بالحذفِ
فحسب، بل
حّرَّفَ
الكتابَ تحريفًا
شَنيعًا. وقد
استبدل
العبارات
المذكورةَ
بكلماتٍ لاَ
يجوزُ أن
يَكونَ
الشَّاهُ
وليُّ اللهِ
الدهلويُّ
قَد قالَهَا
أَبَدًا.
فَنَسُوقُ
لَكَ الآَنَ
تلكَ
الألفاظَ الموضوعةَ
علىَ لسانِ
الشَّاهُ
وليُّ اللهِ الدهلويُّ
لِتتأكّدَ من
خطورةِ ما
يقترفه
النّقشبنديُّونَ
من الكذِبِ
والبهتانِ
علىَ
العلماءِ.
وَرَدَتْ
في الصّفحةِ
الحادية
والثمانينَ بعد
المائِةِ في
النسخة
الْمُحُرَّفَةِ
من الكتاب
المسمّىَّ:
(القول الجميل
في بيانِ سواءِ
السّبيل)،
ألْفاظٌ،
وهذه
نصُّهَّا
حرفيًّا:
»وثالثها
الرّابطة
بشيخه: وشرطها
أن يكون الشيخ
قويّ
التوجّه،
دائم (الياد
داشت)، فإذا
صحبه خلى نفسه
عن كلّ شيءٍ
إلاَّ
محبّته،
وينظر لما
يفيض منه.
ويغمض عينيه
أو يفتحهما،
وينظر عيني
الشيخ، فإذا أفاض
شيءٌ فليتبعه
بمجامع قلبه
وليحافظ عليهِ.
وإذا غاب عنه
الشيخ، يخيّل
صورته بين
عينيهِ بوصف
المحبَّةِ
والتعظيمِ،
فتفيد صورته
ما تفيد
صحبته.«[495] إنَّ
الْمُحِرِّفَ
(محمّد
صالح بن أحمد
الغرسي، وهو من
سكّان مدينة
قونيا في
تركيا)، لم
يقف عند هذا
الحدّ في
محاولاته
التحريفيّةِ،
بل ازداد
تمرُّدًا
وتجرّؤًا
فَحَرَّف
اسْمَ كِتَابِ
»القول
الجميل في
بيان سواء
السبيل«،
فأصْدَرَ
الْكِتَابَ
بعنوان جديد
مُخْتَلَقٍ،
سمّاه: »الفكر
الإسلامِيّ
عند الإمام
وليّ الله الدّهلويّ
وما ابتكره من
العمل
النموزجي«.
ويبدو أنّه
أحسّ بضرورة
الحذر من أن
يفتضح أمره،
عاد فسجّلَ
على الغلاف
الداخليّ
للكتابِ: »يحتوي
على ما يلي: القول
الجميل في
بيان سواء
السبيل
للإمام الدهلوي«.
أثْبَتْنَا
هذه الحقيقةَ
أثناءَ
الْمُقَارنةِ
بين نُسخةٍ من
(القول
الجميل) وبين
(التاج
المُكلّل)،
فوجدنا
المقطعَ
المُقتَبَسَ
مُحَرَّفًا
تمامًا. إذْ
أنّ
المُؤَلِّفَ
الذي ذَمَّ
الرّابطة
وعَدَّهَا من
علامات
الشِّرْكِ،
يُسْتَبْعَدُ
أنْ يَكونَ
قَدْ عادَ بعد
ذلكَ فَمَدَحَهَا.
إنّه أمرٌ لا
يستقيم مع
العقل السليم.
وَلِخُطُورَةِ
الأمرِ، يجب
على
القرَّاءِ أن
يلتزموا جانبَ
الحيطةِ في
مطالعةِ هذه
النسخةِ
المُحَرَّفَةِ
الّتي تولّىَ
طبعَهَا محمّد
صالح بن أحمد
الغرسي
بِالتعاون مع
بَعضِ الناسِ
من الأتراك في
مدينة قونيا التركيّة
حديثًا.
لقد
اقتبس محمّد
أسعد الصاحب كلمات
الشاه ولي
الله
الدّهلويّ
الْمُتُعَلِّقَةِ
بمسألة
(الرّابطة) من
التاج
المكلَّلِ،
بشكلها
الصحيح، ولكنه
تصرّف فيها قليلاً
عند نقلها إلى
كتابه (نور
الهداية
والعرفان/ص:3) وبذل جهدًا
بالغًا بعد
هذه النقولات
وأفرغ ما لديه
من الطاقة في
الردّ على
هؤلاء
العلماء الّذين
عدّوا
الرّابطة من
الشرك بحكم
صريح. فاسترسل
الصاحب وأسهب
ونقل وكتب ما
كتب حتّى فرغ
من كتابه
المذكـور.
وقال في كلمته
الأخيرة »ولنكتف
في هذا الباب
بهذا المقدار
من العبارة.
فانّ المنصف
الموفَّقَ
تكفيه
الإشارة،
والبليد لا
ينفعه
التطويل؛ ولو
تُلِيتْ عليه
التوراة
والإنجيل«[496]
نلمس
حَالَتَهُ
النَّفْسِيَّةَ
وَمَوْقِفَهُ
الْمَرَضِيَّةَ
مِنْ خلالِ هَذَا
السَّجْعِ
المتكلّفِ في
الحين الّذي يسجّل
هذه الألفاظَ،
كأنّه غاصٌّ
بالغضب على
منكري رابطة النقشبنديّة.
وَإلاَّ فَما
علاَقةُ
التّوراةِ
والإنجيل بِمسْأَلَةِ
الرّابطة؟! هذا،
على الرّغم من
مركزه
ومكانته
المرموقة بين
الطائفة النقشبنديّة
في بلاد الشام
والعراق،
بالإضافة إلى
غزارة علمه
وثقافته
الّتي كان
يَمتاز بهما
عن سائر شيوخ
الصوفيّة.
وربما كان
بسبب هذه المزايا
محسودًا فيهم.
كان
هذا شطرًا من
الصراع الّذي
جرى بين خالد
البغداديّ
وبين بعض
خصومه في
العراق؛ إذ لم
تقتصر
المعارضة على
ردودِ فعلٍ من
البرزنجيّ والجليليِّ
فحسب، بل كان
هناك أناس
آخرون ضده في
البداية،
فلما رجحت
إحدى كفتي
الميزان
لمصلحة خالد
البغداديّ
لكثرة أنصاره
والدعم الّذي كان
يتلقاه من
السلطة
العليا
للدولة العثمانيّة،
باءت محاولات
المعارضين
بالفشل
وانتهى أمرهم
بالخزلان.
ولكنّ
خالدًا اصطدم
بخصوم آخرين
بعد انتقاله
إلى دمشق عام 1238هـ. كان في مقدّمتهم
رجل اسمه عبد
الوهّاب
السوسيّ. ورد
ذكره في الحديقة
النديّة
لمحمد بن
سليمان بن
مراد بن عبد
الرحمن العبيديّ
البغداديّ
الّذي كان أحدَ
المقرّبين
إلى خالد
البغداديّ.
يذكره في سياق
التعداد
للخلفاء
البارزين
المأذونين
على يد مرشده.
يعدّهم ويصف
كلاًّ منهم بنعوت
الإجلال؛
فيقول عند ذكر
السوسيّ:
»ومنهم
العالِمُ ابن
العالمِ
الفطنُ
الملازمُ
لأمر الطريقة
بالعلمِ
والعملِ والذّكرِ
الدّائمِ؛
المحقّقُ
الذكيُّ،
المدقِّقُ
الألمعيُّ
الشيخ عبد الوهّاب
السوسيُّ
المتفرّعُ من
أصل شجرة
العالم
الشهير،
المحشّي
المدقّق
بأوجز التحرير،
محمّد بن عمر
السوسيّ رحمه
الله تعالى.
وقد كان خليفة
مرشد
السالكين في
الطريقة النقشبنديّة
مقيمًا في
بلدة
العمادية«.[497]
من
الغـريب أنّ »هذا الشيخ
الفطن
الملازم لأمر
الطريقة بالعلم
والعمل
والذكر
الدائم« على لسان
رفيقه وصديقه
في المشرب
والمعتقد (الشيخ
محمّد بن
سليمان
البغداديّ)؛
من الغريب أن
يعود هذا
الشيخ
الممدوح (أي
عبد الوهّاب
السوسيّ) بعد
مدّة رجلاً
مطرودًا من
باب خالد
البغداديّ،
ومقبوحًا من
طرف جميع
أتباعه!
-
ولكن لماذا؟!
لأنّ
خالدًا
البغداديّ -كان
- ولا يزال في
معتقد أتباعه
الّذين
يعظّمونه
تعظيمَ نبيٍّ
مرسَل-، كان لابدّ
أنْ يطّلعَ
على سريرة هذا
الرجل
فيتحقّقَ من أمره
قبل أن يفوّض
إليه مهمَّةَ
بثِّ الطريقة
وينصبَه على
مِنَصَّةِ
الإرشاد،
تفاديًا لكل
ما قد حدث من مشاحناتٍ
وفتنٍ عقب ذلك
التفويض، وأشغل
أذهان الناس
إلى يومنا
هذا! نعم،
مادام خالدٌ
لم يعزب عن
علمه مثقالُ
ذرةٍ فِي
الأَرضِ ولا
في السماءِ، وكان
عليماً بذات
الصدور (على
حسب اعتقاد
النقشبنديّين
كما سنتأكّد
من هذا الواقع
على لسان عبد
المجيد
الخانيّ)؛
فلماذا أَذِنَ
للسّوسيِّ أن
ينوب عنه حتّى
يناهضه
بأعمالٍ تطوّرتْ
إلى فتنة لن
يبرح الناس
فيها فريقين يتخاصمان،
ربما إلى يوم
القيامة؟!
ولأنّ خالدا
البغداديّ،
يستحيل عليه
(في تصوّر
النقشبنديّين)
أن يجهل شيئًا
ما دامتْ
الحجب قد كُشِفَتْ
عن بصره وهو
مطَّلِعٌ على
أسرار الكائنات،
يعلم كلّ شيء
قد جرى عَبْرَ
الماضي
السحيق، وما
سوف يجري في
المستقبل
المغيب
البعيد.
ولكن
أغرب من ذلك
أنّ هذا
الحدث، ليس هو
المثال
الوحيد للغرائب
الّتي يعتقده
النقشبنديّون؛
بل ثَمَّ
أمورٌ متناقضةٌ،
وتأويلاتٌ
معقّدةٌ،
ومعتقَداتٌ
ملفّقةٌ لهذه
الطائفة سوف
نطرقها في
بابها إنْ شاء
الله.
أمّا
عبد الوهّاب
السوسيّ
ومسألة طرده
من الطريقة،
فقد وردت
قصّتُه
مطوَّلةً في
كُتَيْبَاتِ
النقشبنديّين.
منها، »الحدائق
الورديّة«.
يقول مؤلّفه
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ:
»أخبرني
الوالد
الماجد، أنّه
وقع لحضرة
مولانا - وهو
في دمشق الشام
- تطيّر ما وقع
له في بغداد
من بعض
الفئام. وذلك أنّه
كان أرسل من
أتباعه رجلاً
اسمه عبد الوهّاب
السوسيّ
ليبثّ
الطريقة
العليّة في
دار السلطنة
السنيّة. فما
لبث أنْ اعتقد
فيه شيخ
الإسلام
وجمهور علمائها
ووزرائها
العظام. فزاغ
بصره ومال إلى
حبّ الشهرة،
فبلغ الشيخَ
أمرُهُ،
فاستحضره،
واستخلف
غيرَه،
واستتابه.
فأضمر المكرَ
وأظهر الإنابةَ.
فأطلعه الله
على جليّة
أمره، بأنْ
وصل إليه
مراسلات بخطّه
إلى أتباعه في
القسطنطنية،
تُنبئُ عن
مكره. فطرده
طردًا عامًّا
من طريقته«.[498]
أيُّ
مؤمنٍ بالله
وملائكته
وكتبه ورسل
واليوم الآخر
يقرأ هذه
العبارات
فحسب، -وهو
على علمٍ تامٍّ
بحقيقة
الإسلام
وعالميّتهِ
وشمولهِ
وعظمتهِ-؛ لا
يملك نفسَه من
الدّهشة في
أمر هذه
الطريقة
الصوفيّة
حتّى يعيد النظر
فيها ويتباحث
عمّا إذا كانت
لها أدنى
علاقة بهذا
الدِّينِ
العظيم الّذي
جاء به محمّد r،
قبل أن
يطَّلِعَ على
صفحات تلك
الحرب الّتي جرت
بين خالد
ونائبه عبد الوهّاب
السوسيّ؛ كما
أنّ الطريقة
المذكورة
ليست هي
المسألة الوحيدة
الّتي تتبلور
حقيقتها من
خلال هذه الكلمات؛
بل وإنّ
المجتمع
الّذي كان
يستقطبُ اهْتِمَامُهُ
يومئذ على هذه
المهزلة، هو
الآخر يستحقّ
أن يتدارسه
الباحثون
اليوم بقسطاس
العقل السليم
ومِحَكِّ
القرآن
الكريم،
ليتمكّنوا من
الإطّلاع على
مدى حظّه من
الإسلام
الّذي عاشه
الصحابة
والتابعون
والسلف
الصالح
وطبّقوه في حياتهم.
لأنّ
هؤلاء الشيوخ
والصوفيّة
والدراويش، كانوا
قد أَلْهَوُا
الناس عن
الإسلام
وسحروا عقولَهم
بهذا الدِّينِ
المستحدث،
فلم تتمكّن
العامّةُ من
الانتباهِ
إلى الإسلامِ
ولا إلى شيءٍ
من أمور
دنياهم في خضم
الأحداث
الّتي كان قد أثارها
النقشبنديّون
بطقوسهم
ورسومهم ورياضاتهم
ومناسكهم
ونشاطاتهم
الدائبة
ومراسلاتهم
ودِعَايَاتِهِم
الكثيفة
وخلافاتهم
والفتن الّتي
كانت تتصاعد
نيرانها في
صفوفهم بين
الفينة
والأخرى إلى
حدٍّ أصبح الناس
في
غِمَارِهَا كَقُطْعَانِ
الغنم وهم
حيارى وسُكارى
وما هم بِسُكارى؛
فلم يملك أحد
منهم عقلَه
يومًا من الأيّام
حتّى يتساءل -
على الأقلّ -
فيقول:
- من
يكون خالد،
هذا الّذي
استعلى على
الناس حتّى
اختلقوا له
جناحين ياترى!!!
وما هي طريقته
الّتي أكمل
بها ما نقص عن
الإسلام،
وأرسل نَائِبَهُ
إلى إسطنبول
ليبثّها بين
سكان العاصمة
- ولم يكن
غَرَضُهُ في
الحقيقة سوى
تمهيد السبيل
للتّسَلُّل
إلى أوساط
رجال الدولة،
والسيطرةِ
على ضمائرهم طمعا
في الشّهرة
وشغفا بحطام
الدّنيا
الخسيسة
بأساليبَ
دجليّةٍ
ماكرة- في
الحين الّذي
كانت الويلاتُ
تنصبُّ على
المسلمين من كلّ
صوبٍ، ودولتُهم
على شفا جرف
هار. نعم من
يكون هذا
الصوفيّ الكرديّ
الّذي »اعتقد
في نائبه شيخُ
الإسلام
وجمهورُ
علماءِ
العاصمة و
وزراءُ حكومة
الإمبراطورية
العثمانيّة«،
حتّى أذعن له
خليفة
المسلمين
بالذّات،
فأصدر
(الفرمانَ) أي
الرسم
الملكيَّ
بشأن معاقبة
نائبه الّذي
عصاه؟!
في
الحقيقة كانت
المأساةُ - بموتِ
القلوب
وغيابِ
الشعورِ
يومئذ - قد غلبت
الناسَ إلى
حدود رهيبة،
بحيث لم يكن
أحد ينتبه إلى
الفرق بين
الإسلام وبين هذا
الدِّينِ
الجديد الّذي
اتّخذ من
الإسلام
غلافًا يصطاد
به على أرضه بكلّ
سهولة وفي
أمان.
سوف
نتساءل طبعًا
فيما بعد، عن
سبب سقوط
المسلمين إلى
هذا الدرك
الرهيب من
الظلمة
والتخلّف
والجهل
والعمى، حتّى
أصبح مجتمعٌ
بأسره يتلهّى
بالحرب
المتصاعدة
بين رجلين من
الصوفيّة. ولكن
ما الّذي كان
يجري بينهما،
وما قيمة هذا
الحدث في ميزان
الإسلام
والعقل
والعلم؛
وماذا استفاد
المسلمون من
وراء هذه
الحرب التي
اندلعت
نيرانُها بين
خالد
وقرينِهِ عبر حقبة
تزيد عن قرن
من الزمن؟
إنّ
أيّة محاولة
جادّة
للإجابة عن هذا
السؤال، لن
تتعدّى السخرية
بعقول الناس،
والاستهانة
بالوقت. ولكنّ
هذا الحدث في
ذات الأمر
الّذي أقلق
جماهير
المجتمع
العثمانيّ في
وقت مّا،
يستحق - من
جانب خاصّ - أن
يُتطرَّقَ له
بإيجاز ومن
خلال وثائق
النقشبنديّين،
حتّى تتّضح
أمام القارئ
الكريم
عقليةُ أولئك
الناس، وتظهر
بها تلك الهوة
الّتي كانت
بينهم وبين الإسلام
يومئذ.
هذه
الوثائق -
المنقولة
فيما يلي - هي
الرسائل
الثلاث الّتي
بعث بها خالد
البغداديّ
إلى أتباعه في
إسطنبول. يقول
في الأولى
منها:
»بعد
السلام، من
العام الأول،
الفقير
تبرّأتُ من
عبد الوهّاب
لما ظهر منه
من الأمور
المخالفة
للطريقة والشريعة،
وأنه صار
سببًا
للدّسائس
الّتي
اختلقها المتشيّخون
حتّى توهّم
كثير من الناس
في حقّنا أموراً
لا تليق
بأراذل
العوامّ،
وأردتُ أن أكتب
هذا إلى
الآستانة
العليّة -
صينت عن البليّة
- ليعلم الناس أنّه
مطرود عن
الطريق، فلا
يلتفت إليه
أحدٌ لئلاّ يصير
مظهرًا لجلال
سادات
الطريقة
البهيّة
البهائيّة.
فتوسّل بي وجعل
روحانية
مشائخ
السلسلة
شفيعًا أن لا
أكتُب هذا.
وحلف الأيمان
المؤكّدة أنّه
يكتب هذا
المضمون بخطّه.
ثم ظهر أنّه
بلّغ تقريرًا
مع بعض
المرسِلين من
طرفه وتحريرًا
إلى بعض
المخلصين: أنّه
كان بعض
إخوانه في
الطريقة
افتروا عليه
عندي، ثم ظهر
افتراؤهم
لديَّ، وأنّه
صار مثل
الأوّل
وأكثر، حتّى
أنّ بعضكم ترك
طلب الدعاء
والمكاتبة
إلى بعض أهل
الطريقة
رعاية لجانبه.
والمرء
يُعذَرُ
لجهله.
فالآن
أخبركم بأنّي
وجميع رجال
السلسلة تبرّأنا
من عبد الوهّاب.
فهو مطرود عن
الطريقة. فكلّ
مّنْ تصادق
معه لأجل
الطريقة
فليتركْ مُصَادَقَتَهُ
وَمُكَاتَبَتَهُ،
وإلاّ فهو
برئٌ من إمداد
هذا الفقير
وإمداد السادات
الكرام. ولا
أرضى أن
يكاتبني؛ ولا
أن يستمدّ همّتي
بعد وصول هذا
المكتوب إليه.
وأنت مأمور
بإيصاله إلى كلّ
مُخلصٍ. فمن
كان مريدَ
الطريقة
فليُظهِرِ الْبَرَاءَةَ
منه، ومن كان
مريدَ نفسهِ
فلا يلومنّ
إلاّ نفسَه
إذا هلك مع
الهالكين«.[499]
إنّ
هذه الرسالة
الّتي لا يكاد
الإنسان (المؤمن
بالله واليوم
الآخر) يفهم
شيئًا منها،
كأنّها قد
كُتِبتْ
بلغةٍ غريبةٍ
على المسلمين.
إلاّ أنّها في
الحقيقة
وثيقة رهيبة
تتضمن ما يخفى
على أهل العلم
والبصيرة من
شخصيّة خالد البغداديّ
ومُعتقَداته
وأسرار
طريقته وتَعَامُلِهِ
مع الناس.
لعلّ
سائلاً يسأل عمّا
يخالف
الإسلام من
مضمون هذه
الرسالة
وربما يقول:
ـ ما
الّذي يستوجب
هذا القدر من
الاستغراب والتعجُّب؟
إنّ
الإنسان
المتمتّعَ
بنعمة العلم
والمعرفة
بحقيقة
الإسلام، لا
ينبغي له أصلاً
أن يلتفت إلى
مثل هذه
التساؤلات،
ولكن - لإظهار
الحقّ فحسب-
نحن نتساءل
عمّا إذا كان
أدنى شيء
يوافق روح الإسلام
في هذه
الرسالة
المحرّرة؟
- ما
الّذي ارتكب
عبد الوهّاب
السوسيّ
إهانةً بحق
خالد، حتّى
اضطرّ خالدٌ أنْ
يفضّحه أمام
مريديه
الّذين كان
السوسيّ قد
اسطادهم في
إسطنبول
نيابةً عنه؟!!
هل كان وراء كلّ
هذه الجلبة
والضوضاء
العمياء أيّ
مصلحة للمسلمين
المغلوبين
على أمرهم
يومئذ أمام
عالم الكفر،
سوى التهارش
على جيفة
الدنيا وكسب
الشهرة
والسمعة؟
وإلاّ فما
كانت علاقة
المسلمين
بالرّابطة
الّتي هي من
أهم طقوس
اليوغية، سواء
أكان السوسيّ
أمرَ الناسَ
بها لنفسه أو
للبغداديِّ.
يقول
الشيخ قسيم
الكُفْرَويّ
في صدد هذه
المشكلة:
»كان
مولانا خالد
قد أرسل في
بداية أمره
عبدَ الوهّاب
السوسيّ إلى
إسطنبول.
ولكنّه تولّى
كبره، ولقّن
المريدين
رابطة نفسه؛
فعند ذلك بعث
مولانا خالدٌ
مِنْ خلفائه
عبد الفتّاح
العقريَّ
للبحث عن
أمره. وبعد
طرده عبدَ الوهّاب
السوسيَّ مِنْ
طريقتهِ
جزاءً بما
ارتكب، تمّ
نصبُ الشيخ
أحمد الأغريبوزي
مكانه«.[500]
هكذا
اتّضحت
الجريمة (!)
الّتي
ارتكبها عبد
الوهّاب
السوسيّ! حسب
نظام هذا
الدِّينِ وضوابطهِ.
وهي أنّ
السوسيّ كان
قد لقّن
المريدين
رابطة نفسه.
ومعنى ذلك إنّه
أمَرَهُمْ
أنْ يُحضِروا
صورتَهُ في
خيالهم، بدل
أنْ يأمرهم
برابطة مرشده
خالد
البغداديّ. إذ
أنّ الطريقة النقشبنديّة
تحّرّم
الرّابطةَ
للنائب مادام
شيخه على قيد
الحياة. ولا
نعلم من أيّ
دين استوحت
هذا الضابط!
كان
هذا هو السبب
لانفجار
قنبلة
النقشبنديّين
الّتي ظلّ
المجتمعُ
العثمانيّ
التعيسُ
ينشغل بصداها
مدةَ قرنٍ
كامل والناس
في غفلتهم
يعمهون - في الوقت
الّذي كانت
القُوىَ اليهوديّة-الصليبية
تتداعى على
الأمّة
المسلمة-. ولا
تزال بقيّة من
شيوخهم وممّن
حولهم من
العوامِّ
يردّدون هذه
الحكاية
ويعدّنها من
أمجاد مرشدهم
البغداديّ
الّذي ربما
تتألّم رفاته
اليوم بسبب هذه
الزندقة!
إن
هذا القدر من
تفاصيل
الخلاف
الواقع بين البغداديّ
والسوسيِّ،
إنما
تحصّلناه من
خلال كلماتٍ
يسيرةٍ
للبغداديِّ
ضمنَ رسالته
المنقولةِ
آنفًا. وكأنّ
السبب
الحقيقيَّ لم
يظهر بصورة
جليّة بعدُ.
لأنّ البحوث
الّتي
أجريناها
بأمل الحصول
على كلماتٍ أو
سطورٍ يمكن أن
يكون السوسيّ
قد خلّفها، لم
تُجْدِ بأدنى شيء،
مما يدلّ على
أنّ
الخالديّين
قد محوا جميعَ
ما تبقّى من
آثار هذا
الرجل، سوى
كلماتٍ يسيرة
نقلها ابن
عابدين في
رسالة له. يبرهن
ذلك على شدة
الهجمات
الّتي شنّها
الخالديّون
على السوسيّ.
ومن وثائق تلك
الحرب
الشعواء، رسالة
»سلّ
الحسام
الهنديّ في
نصرة مولانا
خالد النقشبنديّ«
للفقيه ابن
عابدين
الدمشقيّ
الّتي ردّ بها
على رسالة
كتبها عبد الوهّاب
السوسيّ؛
يتّهم فيها
خالدًا
بالسحر والكفر
والزندقةِ.
يقول
السوسيُّ في
هذه الرسالة: »إنّ الشيخ
خالدًا يقوم
بتسخير الجنّ
ويستعين
بالأرواح
الأرضية
الخبيثة،
ويدّعي علمَ الغيبِ
عن إخبار
الجانّ له،
ويدّعي أنّه
قد قتل وربط
كثيرًا من
العفاريت
والجانّ، كلّ
ذلك بإقراره،
مع أنّه يدّعي
الولايةَ
والارشادَ في
نفس الوقت«.
من
الغريب جدًّا
أنّنا لم نعثر
في عجالة ابن
عابدين
المذكورة على
قولٍ للسوسيّ
غير هذه
الكلمات
الوجيزة!
وحتّى اسم عبد
الوهّاب لم
يذكره
المؤلّف إلاّ
مرة واحدة،
وذلك من خلال
عبارة منقولة.
يدل أسلوب ابن
عابدين على مدى
استحقاره
عبدَ الوهّاب
السوسيّ!
أمّا
السبب
الحقيقي لهذا
النـزاع،
فكأنّه ظهر
إلى العيان
بعد أن عثرنا
على كلمات
للباحث عباس
العزّاويّ إذ
يقول:
»إنّ
الشيخ عبد الوهّاب
البغداديّ
كان قد تلقّى
إرشادَهُ من
الشيخ عبد
الله
الدهلويّ،
كما تلقّاه
الشيخ خالد.
فصار من
مشاهير خلفائه.
فأقام الشيخ خالد
في الشام،
وأمّا الشيخ
عبد الوهّاب،
فاستقرّ في
المدينة
المنوّرة،
فحدثت بين الاثنين
مشادّة
حادّة، ونفرة
شديدة.
كان
الشيخ عبد الوهّاب
ورفيقه العلاَّمة
الحاج حمدي
الداغستاني
قد خرجا على
مولانا خالد،
ونسبا إليه
أمورًا
مخالفةً
للواقع. فانتصر
له مفتي دمشق
وعلماؤها.
فأصدروا
فتاوى،
وأودعوها
رسالة، والْتَمَسُوا
من الباب
العالي لزومَ
تأديبهما،
وكفّ لسانهما.
فلمّا
عُرضت على
السلطان وعلى
المشيخة، وبعد
استطلاع آراء
العلماء في
إسطنبول، صدر
الأمر بأنّ
أعمال المومى
إليهما
مخالفة
للشرع، ويجب
نفيهما. ولكنّ
النفي من المدينة
المنوّرة
يستدعي إثبات
أنّهما قاما
بما يخالف
الأدب. ولذا
عُدِلَ عن ذلك
و نُبِّها أن
يكونا
مشغولَيْنِ
بأحوالهما.
فصدر الفرمان بذلك
وبُلِّغا
بموجبه من شيخ
الحرم
النبويِّ«.[501]
يتبيّن
من هذه
الكلمات بشكل
لا يقبل
الشكّ: أنّ
السبب
الحقيقيَّ
لهذا الخلاف،
إنما كانت
المنافسة ليس
إلاّ. إذ أنّ
عبد الوهّاب
السوسيّ لم
يكن أصلاً من
خلفاء خالد،
وإنّما كان من
خلفاء شيخه.
ويعني ذلك أنّه
كان من طبقةِ
خالدٍ وَنظِيرُهُ
في السلسلة النقشبنديّة
. وهذا لا يسمح
لعبد الوهّاب
السوسيّ أن
يدخل تحت طاعة
خالد إلاّ
بأمر من شيخه.
ولو فرضنا أنّ
عبد الله
الدهلويّ قد
أمره أن يتبع
خالدًا، وهذا
شيءٌ مجهولٌ
حتّى الآن -
ذلك مِنْ عُرْفِ
النقشبنديّين،
أن شيخَ
العصرِ يختار
من بين خلفائه
شخصًا واحدًا
للنّيابة
عنه، خاصّة في
المناطق
النائية عن
مقره؛ على أنْ
يتبعه بقيّة
خلفائِهِ-.
فانّ المسافة
الشاسعة الّتي
بين الديار
الهندية
والشرق
الأوسط، لا
بدّ وقد شجّعتْ
عبدَ الوهّاب
للخروج على
خالد لصعوبة
الرقابة عليه
من مقام أعلى.
كما وقع شِبه
هذا الحدث
بنفس السبب
لعدّة من شيوخ
هذه الطريقة.
***
*
خلفاء خالد
البغداديّ
وتعامله معهم
إنّ
خالدًا هو ذا
الرجل الحاذقُ
بإلقاء
تأثيره في
نفوس الناس،
وبالاستيلاء
على ضمائرهم؛
المتلوّنُ
اللّبقُ القلِقُ
المترقّبُ في
تعامله مع
خلفائه
وتلامذته. كما
كان شأنه مع
خصومه
ومعارضيه. يتبيّن
موقفهُ
المتعاظمُ
المتغلّبُ الحذرُ
من خروجهم
عليه في كلّ
كلمة وجّهها
إليهم.
نجده
تارة يخاطب
أحدَ خلفائه
بكمال
التواضع
والتذلّل،
كأنّه هو
تلميذه. لم
يفعل ذلك في
الحقيقة إلاّ
لِيَجُسَّ
نبضه،
وليختبر صِدْقَهُ
في الانتماءِ
والاستسلام، ومن
إيمانهِ
التامِّ
بتعاليمهِ، وهل
يتحرك فيه عرق
التمرُّد عند
ما يُرخىَ له
العنان، حتّى
يحتاط في أمره
ويكبح جماحه
في الوقت اللاّزم،
كما فعل
بخليفته
إسماعيل
الشيرواني؛
وستأتي
قصّتُهُ.
ونجده تارةً
أخرى يخاطب
أحدَهم بلهجةٍ
قاسيةٍ،
وغضبٍ
واستنكارٍ
وتعاظُمٍ في
أدائه، لا
يتساهل معه،
فلا يُظهر
تمام الثقة
فيه؛ ولا
يقبضه بأسنّة
مخالبه.
وكمثالٍ
على رِقَّتِهِ
وتواضعه،
سطورُهُ من
كتابه الّذي
بعث به إلى
نائبه الملاَّ
رسول في
مهاباد، يقول
فيه:
»بسم
الله الرحمن
الرحيم، أخصّ
بالسلام التامِّ،
المقرون
بمزيد العزّ
والإكرام
جناب سـيّدي
وسندي
العالمَ
الفاضلَ
والنحـريرَ
الكاملَ
مولانا
الملاّ رسول،
حصّله الله كلّ
مأمول«.[502]
وأمّا
شدّته على من
أحسّ منه أدنى
شمة من
الاستخفاف
بتعاليمه، أو
أدنى إهمال
لتعليماته،
فإنّها ربما
يضيق عن وصفها
كلام غيره.
وكمثال
على هذا
الجانب الّذي
طالما ظلّ
خافيًا على
الناس من صفات
خالد
البغداديّ.
أوردنا فيما
يلي،
رسالتَهُ
الّتي وجّهها
إلى خليفته
الشيخ
إسماعيل
الشيروانيِّ.
إنّ
نائِبَهُ هذا
الّذي تمّ
نصبه ليبثَّ
الطريقةَ النقشبنديّة
في بلاد
القوقاز
يومئذ، يبدو أنّه
لم يعد يشعر
بهيبة شيخه
بعد أن وصل
إلى تلك المنطقة
النائية،
وحال بينهما
المسافاتُ
البعيدةُ،
وأحسّ في نفسه
بالجرأة أن
يقول لمريديه:
-
رابطوني. أي
أحضروا صورتي
في خيالكم
أثناء صلاة
الرّابطة
بدلاً من
إحضار صورة
الشيخ خالد.
هذه
لا شكَّ إهانة
بسلطان شيخ
الجماعة،
وخروج عليه في
نظر خالد وحسب
تعاليم
دِينِهِ. لذا
وما أنْ قرع
سمعَهُ طنينُ
هذا الحدث حتّى
نهض من مكانه
ونفخ في
الصور، فقامت
القيامة في
المملكة العثمانيّة،
بل واجتازت
جلجلتُهُ
حدودَ
المملكة إلى
ما وراء جبال القوقاز.
هذا نصّ كتابه
الّذي وجّهه
إلى الشيخ
إسماعيل
الشيرواني:
»بسم
الله الرحمن
الرحيم
من
العبد
الذليل،
الأقل من
القليل، إلى
خادم بابه
وقدوة أحبابه
الشيخ
إسماعيل،
عصمه الله عما
وصمه، وصانه
عمّا شانه،
آمين.
أمّا
بعد فقد قال
كثير من نجوم
الاهتداء
ومصابيح الإقتداء
بأنّ الكفران
هو نسيان
المنعم بسبب
الاشتغال
بنعمته. وصرح
محقّقو
طريقتنا بأنّ
رابطة من لم
يفْنَ عن
وجوده لا يُورِثُ
الفناءَ
للسالك، بل قد
تورّطه في
المهالك.
وأنتم
ما كان
المأمول منكم
أن تقطعوا
عناّ السلامَ
والكلامَ، بل
كمال المروءة
والوفاء كان
مقتضيًا أن
تواجهونا
أحيانًا
بأنفسكم
وإلاّ فتراجعونا
في النقير
والقطمير،
وتذكرونا دائمًا
بالتحرير مع
السفير. ومن
خدّامنا من هو
أبعد شقةً
منكم، وأقدم
صحبةً، وأكثر
خدمةً لا يتحرّك
بدون
إشاراتنا. ولا
تَقِسْ هذه
الطريقة بخزعبلات
متشيِّخي
العصر، وتُرّهات
أرباب الخداع
والمكر.
فالشيخ المحقِق
واسطة بين
المريد وربّه.
والإعراض عنه
إعراضٌ عنه.
فلا
تعلّموا رابطةَ
صورتِكم
لأحدٍ، ولو
ظهرت له فإنّه
من تلبيس
إبليس. ولا
تستخلفوا
أحدًا منهم إلاّ
بأمري، فضلاً
عن مزاحمتهم
لخلفاء الأطراف
من نحو
(أرزنجان) و
(بدليس).
ولئن
تماديتم في
هذا التغافل
الّذي
تستعملونه
لنعرضنّ عنكم
بالكليّة،
وخرط القتاد
دونه. ومن
أُنذِر فقد
أُعذِر.
والسلام«.[503]
هكذا
تمكّنّا من
المعرفة
بشخصيّة خالد
البغداديّ من
خلال ما قد
جرى به قلمه
بالذّات، وما
نَقَلَ إلينا
خلفاؤه من
الوثائق
عَلَى
حقيقتها. ومن
وقف على قصّةِ
حياتهِ
بتمامها
وأمعن النظر
بإنصاف وحياد
فيما حدث بينه
وبين أصناف
الناس من
علاقات طارئة
وغريبة، أيقن
بلا مرية أنّ
ما حظي هذا
الرجل من
الشهرة
والعزِّ
والإقبال
بصورة غير
متوقعة، إنما
هو مثال رهيب
من الاستدراج!
ولكن مهما
عثرنا في كلّ
تلك
المخلّفات
الكتابية
الّتي تركها
هو وخلفاؤه
وراءهم مما لا
يسهل ضبطه
وإحصاؤه من
أمور خارجة عن
رحاب كتاب
الله ونطاق
السّنّة
النبوية؛ فانّ
لهذا الرجل
كلمات تنبئُ
عن ندمه وهو
في آخر عهده
من هذه
الدنيا؛
كترديده
للآية
الكريمة {يَا
حَسْررَتىَ
عَلىَ مَا
فَرَّطْتُ
فيِ جَنْبِ
اللهِ...}[504] وكقوله
في وصيته: »لا
تزيدوا
التكايا عما
في عهدي. ومن
أراد الإحداث
فليعمّر جامع
العدّاس«.[505]
فعسى
أن يكون قد
تاب في آخر
أنفاسه من
جميع ما قد
أحدث في الدين
الحنيف من بدع
مجوس الهند، وما
أحيا من
أساطير
الشامان
وهرطقات
جاهلية
الأتراك.
والله سبحانه
وتعالى غني عن
عذابنا
جميعًا،
ورحمته وسعت كلّ
شيء لعلّه
يغمرنا وإياه
بغفرانه وهو
الغفور
الرحيم.
إذا
كان خالد
البغداديّ قد
استطاع أن يثير
اهتمام
المجتمع
العثمانيّ في
جميع أنحاء
آناضول
والمشرق
العربي، -
وذلك في ظروفٍ
غير عاديةٍ -
فأصبح محطّ
آمال الرجال
حتّى اعتنى به
خليفة
المسلمين بالذّات
وأولاه
اهتماما
كبيرًا وأصدر
الفرمان بمعاقبة
خصومه
وتأديبهم؛
فلا يُعقل أن
ترجع هذه
الشهرة
العظيمة إلى
غزارة علمه،
ولا إلى جزالة
نطقه وبلاغته
فحسب؛ بل
لخلفائه دور
كبير في إذاعة
صيته، وإلقاء
هيبته
ومحبّته في
قلوب ملايين
الناس. إذن
يناسب هنا أن
نعدّ أسماء
مشاهيرهم
بالإضافة إلى
ذكر شيء من
أعمال مَنْ
سعى منهم
لترسيخ
تعاليم خالد
البغداديّ
واستمرّ في
الصورة
الأمامية
باستغلال
شهرته.
كذلك
سوف نتعرّض
إلى ذكر بعض
أخلافهم
الّذين لا
يزالون
يعملون على
نهج خالد،
وعلى تخليد
ذكره في
عصرنا،
وبخاصة منهم
البارزون في
الساحة التركيّة.
يزعم
النقشبنديّون
أنّ خالدًا
البغداديّ كان
»له
خلفاء حنفاء،
أولياء
صلحاء، علماء
عظماء،
سائحون
عابدون، لا
يدرِك
كثرتَهم
العادّون«[506].
كانت
هذه الكلماتُ
المسجّعةُ
لعبد المجيد بن
محمّد الخانيّ.
ثم يقول: »ولكن
أذكر فئةً
منهم مقتصرًا
على من توفي
وهو راض عنهم
غير جانح إلى
عدّ خلفائهم.
فإنّهم
يبلغون إلى
مائة ألفٍ أو
يزيدون«.[507]
عثرنا على
أسماء واحد
وأربعين
شخصًا من مشاهير
خلفاء خالد
البغداديّ في
حدائق
الخانيّ وهم: محمّد
البغداديّ
الإمام، وعبد
الله القادريّ
الشمزينيّ
الهكّاريّ، وعبد
الرحمن
الكرديّ
العقريّ، وعبد
الفتاح
الكرديّ
العقريّ، ومصطفى
اﻟْﮕُﻠْﻌَﻨْﺒَﺮِيّ،
وعبد الله
الجليّ، وَالملا
عباس الكوكيّ،
وعبد القادر
البرزنجيّ، والملاَّ
هداية الله
الأربليّ، وإسماعيل
البرزنجيّ، وأبو
بكر
البغداديّ، وطاهر
العقريّ، ومعروف
التكريتيّ، وأحمد
القسطمونيّ،
ومحمّد بن
سليمان
البغداديّ،. ومحمّد
عاشق، وموسى
الجبّوريّ، وعبد
الغفور
الكرديّ
الكركوكيّ، وأحمد
الأربليّ
الخطيب، وعثمان
الكرديّ
الطويليّ، وعبد
الله
الأرزنجانيّ،
وخالد
الكرديّ، وإسماعيل
الشيروانيّ،
وأحمد الأغربوزيّ،
وأحمد
البرزنجيّ، وعبيد
الله
الحيدريّ، وعبد
الغفور
المشاهديّ، ومحمّد
الجديد
البغداديّ، وعبد
القادر
الديملانيّ،
ومحمّد
الناصح، وحسن
القوزانيّ، ومحمّد
المجذوب
العماديّ، وخالد
الجزريّ، وطه اﻟْﮕَﻴﻶنيّ
الهكّاريّ، وإسماعيل
البصريّ، ومحمّد
الفراقيّ
الكرديّ، والملاَّ
خالد
الكرديّ، وعبد
الله الفرديّ،
وإسماعيل
الأنارانيّ،
وعبد الله
الهرويّ، ومحمّد
بن عبد الله
الخانيّ...
هذه
القائمة لا
نجد فيها
أسماءَ عددٍ
آخر من مشاهير
خلفاء خالد،
كأحمد بن
سليمان الطرابلسيّ
الأرواديّ،
وحسين
الدوسريّ،
وإسماعيل
الزلزلويّ،
ومحمود
الصاحب (شقيق
خالد
البغداديّ).
وهذا يثير الشكَّ
فيما إذا كان
بين هؤلاء
وبين الباقين
من الفرقة الخالديّة
نزاع وتنافر؛
كما لو كان
المؤلّف
مناوئًا لهم.
في الحقيقة لم
يهتم
النقشبنديّون
الأتراك أيضًا
بهؤلاء
الأشخاص، ليس
ذلك إلاّ
لأنّهم من
أصولٍ عربيةٍ
وعاشوا في
المناطق العربيّة
حتّى اختفت
أسماؤهم
وغدوا نسيًا
منسيًّا.
ولا
يخفى على
الباحث
المدقّق، أنّ
النـزاع
دائمًا سجال بين
أهل التصوّف
عمومًا وبين
شيوخ النقشبنديّة
على وجه
الخصوص؛ وإنْ
غابت هذه
الحقيقة عن كثير
من الناس،
وذلك لسرّيّة
أمورهم،
وصمتهم وكتمانهم.
وأحياناً
تفتضح أسرار
الخلاف بين
أشخاص وجماعات
منهم؛ سوف
نشرحه في بابه
إنْ شاء الله.
هذا
وجدير
بالتنويه،
أنّ الأسرة
الخانيّة كانت
قد حظيت بشهرةٍ
بالغةٍ، ولمع
نجمها بعد موت
خالد
البغداديّ
بسرعةٍ. وذلك
أنّ وصيَّه
الأوّلَ
والثانيَ لم
يلبثا حتّى
أدركتهما
المنية بعد
موته بمدة
قليلة.[508] فأتاحت
الفرصة بذلك
لخليفته
الثالث محمّد
بن عبد الله
الخانيّ؛
فحلّت أسرته
بسبب هذا التطوّر
محلّ أسرة
البغداديّ.
ولكن دبّ
القلق في صفوفِ
ورثةِ خالدٍ،
واستمرّ
الأمر كذلك
حتّى بلغ
التنافس والتنافر
بين الأسرتين
شأوَ
المعاداة
والتباغض في
عهد الجيل
الثالث
للطرفين.
إن
الشيخ محمدًا
أسعداً
الصاحب ابن
شقيق خالد
البغداديّ
كان ساخطاً
على
الخانيّين
وبينهما
هجران. ويدلّ
على ذلك
بصراحةٍ: أنّ
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ لم
يذكر اسم والد
محمّد أسعد
ضمن قائمة
الخلفاء في
كتابه
(الحدائق الورديّة
في حقائق
أجلاء النقشبنديّة)
وهو محمود
الصاحب شقيق
خالد
البغداديّ.
فقد تناساه
الخانيّ لهذا
السبب.
ظلّت
الأسرة
الخانيّة
هكذا في
الصورة، فالتفّتْ
جموع
النقشبنديّين
حولها في بلاد
الشام،
وتقلّصت شهرة
أسعد الصاحب.
لذا، كانت
كُتُبُ
الخانيّين ( البهجة
السنيّة لمحمد
بن عبد الله
الخانيّ؛
والحدائق الورديّة،
والسعادة
الأبدية
لحفيده عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ) كانت
رائجة بين
ملالي
الطائفة النقشبنديّة
عمومّا. بينما
كُتُبُ أسعد
الصاحب (بغية
الواجد، ونور
الهداية
والعرفان، و
الجوهر المكنون،
والفيوضات الخالديّة،
ورجال الطريقة
النقشبنديّة)
مهجورة، لا
تتداولها
الأيدي؛ بل
بعضها غير معروفة
من قبل
النقشبنديّين
وغير موجودة،
خاصّة في
مكتبات
إسطنبول.
كان محمّد
بن عبد الله
الخانيّ ثالث
أوصياء
البغداديّ؛
رجلاً ماهرًا
في الرياسة،
ناجحًا في
قيادة أتباع
خالد. مارس
سياسةً
حكيمةً في التعامل
مع الخاصّة
والعامّةِ
منهم. ظلّ
مهيبًا وموقّرًا
فيهم. لذلك
استمرّت
الفرقة الخالديّة
في نشاطها
وحيويتها على
الرغم من
مشاكل تلك المرحلة؛
وما كان يعاني
المجتمع
والدولة من أزمات
سياسيّة
واجتماعيّة
واقتصاديّة
وأخلاقيّة
حادّة.
استطاعت
الطريقة النقشبنديّة
أن تحتفظ
بتأثيرها على
السكّان
العرب في ديار
الشام كنتيجة
لجهوده. مع
أنّ العرب هم
أقلّ استعدادًا
للانفلات من
ربقة الإسلام
بنـزعات
باطنية دخيلة.
إنّ
ولاة السلطة العثمانيّة
على المنطقة
الشامية
يومئذ - ومنهم
الفريق محمّد
رشيد باشا،
والمشير محمّد
نامق باشا، و
والى الأيالة
السوريّة
موسى صفوتي
باشا، كانوا
يستفيدون كثيرًا
من شهرة محمّد
بن عبد الله
الخانيّ في
ضبط الرعيّة،
وتوفير الأمن
في المنطقة.
لأنّه كان
نافذ الكلمة.
و مقابل هذا،
كانوا
يبالغون في
إجلاله، مِمَّا
زاد في تقوية
جاهه وتأثيره.
كان محمّد
بن عبد الله
الخانيّ
بجانب ذلك
يتلقىَّ
دعمًا مَادِّيًّا
قوامه ألف
وخمسمائة
ليرة ذهبيّة
من خزانة
الدولة العثمانيّة
سنويًّا. وذلك
بوساطة والى
سوريّة موسى
صفوتي باشا
الّذي سافر
معه حاجًّا
ورئيسًا
لجماهير حجّاج
الأتراك عام 1846م. وعندما
زار محمّد بن
عبد الله
الخانيّ
عاصمةَ السَّلْطَنَةِ
العثمانيّة
عام 1853م.
استقبله جمع
من أركان
الدولة
استقبالاً فخمًا
على غرار
الملوك،
وأقام
الخانيّ في
قصر موسى
صفوتي باشا
بإسطنبول
أربعة أشهر
ضيفًا معظّمًا
عنده.
ألّف
محمّد بن عبد
الله الخانيّ
كتابًا
بعنوان »البهجة
السنيّة في
آداب الطريقة النقشبنديّة«.
وهو أوّل كتاب
شامل مرتّب
ترتيبًا
حسنًا في آداب
هذه الطريقة
باللّغة العربيّة
وبأسلوبٍ
واضحٍ سَلِسٍ.
إذ أنّ جميع
شيوخ هذه
الطريقة قبل
شيخه، هم عناصرُ
عجميةٌ؛ قُدَمَاؤُهُمْ
من الأتراك
والأكراد،
وبقيَّتهم من
سكّان الديار
الهندية. لم
يُتقنوا اللّغةَ
العربيّة،
ولم يتذوّقُوا
ثمارَ آدابها.
ويغلب أنّهم
لهذا السبب لم
يتمكّنوا من
فهم حقائق
القرآن
والسّنّة
فهمًا صحيحًا؛
ولا كان لهم
إلمام
بالعلوم. ولكن
محمّدًا بن
عبد الله
الخانيّ كان
عربيَّ
النشأة والقريحة؛
فأصبح
التدوينُ في
آداب هذه
الطريقة، وتَرْجَمَةُ
رِجَالِهَا
من الهواية
بين أبناء هذه
الأسرة بعد
تأليف كتاب »البهجة
السنيّة«.
فتابعه
وقلّده في هذه
العادة،
حفيده عبد المجيد
بن محمّد
الخانيّ
بتأليفه
كتابه
المعروف: »الحدائق
الورديّة في
حقائق أجلاء النقشبنديّة«
ورسالته »السعادة
الأبدية فيما
جاء به النقشبنديّة«.
أخطأ
عدد من
الباحثين،
فنسبوا كتاب »السعادة
الأبدية فيما
جاء به النقشبنديّة«.
نسبوه إلى
جدّه محمّد بن
عبد الله
الخانيّ. وهذا
غير صحيح. بل
حفيده عبد
المجيد بن محمّد
بن محمّد
الخانيّ هو
الّذي ألّف
الكتابَ
المذكورَ.
ودلائلُ ذلك
كثيرةٌ في
سطوره. منها،
قوله في الديباجة:
»وبعد،
فيقول أضعف
النوع
الإنساني،
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ
الخالدي
النقشبنديّ،
أنقذ الله من الأوحال
أحوالَه،
وأنفذ له من
الكمال آمالَه؛
لمّا تكرّر
طلب الإخوان
لرسالةٍ
مختصرةٍ في
طريقتنا الخالديّة
العليَة
الشأن. من
خزينة
المفاخر
والفضائل،
وزينة الأواخر
والأوائل،
علاّمة
الزمان،
وأكبريِّ العرفان،
سيّدي الوالد
الماجد،
داماد قطب الإرشاد،
حضرة مولانا
خالد
النقشبنديّ
العثمانيّ
الكرديّ...
أشار إليَّ،
وإشارته فرضٌ
عليَّ؛ أنْ
أُجيبَ
سؤالَهم، ولا
أنظرَ بعين السوى
لهم. فاسرعتُ
امتثاله،
وشرعتُ بهذه
الرسالة وسمّيتُها:
السعادة
الأبدية فيما
جاء به النقشبنديّة«.
والدليل
الثاني في
إثبات نسبة
هذه الرسالة إلى
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ:
كلماته في
نهاية
الرسالة
المذكورة،
وهذه نصّها:
»يقول
أضعف العبيد
جامعُهُ عبد
المجيد: لقد
جمعتُ هذه
الموارد
الهنيّة، من
أنواء أنوار البهجة
السنيّة،
لمشيّد المجد
المؤبّد،
سيّدي الجدّ
الأمجد... في
دمشق الشام،
عاشر ذي
القعدة
الحرام عام 1313هـ.«.
والدليل
الثالث هي
كلمات محمّد
أبي السعود
أفندي مراد،
على سبيل
التقريظ لهذه
الرسالة في
أبيات نظمها،
يقول في
بعضها:
سما
في فضله حتّى
غدا فيــ * ـه
من شمس الضحى
أسمى وأشهر؛
ألا
وهو الملاذ
الشيخ عبد ال*
مجـيد
الخالـدي الشـهم
المـوقر.
وقد
ألّفتَ فيه
خـير سُفرٍ *
به صبح
الطريقة منك
أســـفر.
***
مات محمّد
بن عبد الله
الخانيّ سنة 1862م. والطريقة الخالديّة
المجدّديّة النقشبنديّة
مازالت تحتفظ
بقوّتها، على
الرغم من
مُضيّ ستّة
وثلاثين
عامًا على موت
خالد
البغداديّ؛
بالإضافة إلى
ما وقعت من
أحداثٍ
هامّةٍ
غيّرتْ الأفكارَ،
وزعزعتْ
العقائد،
وشوّشت الأذهان
في تلك
المرحلة.
إلاّ
أنّ هذه
الأحداث
لَمَّا أخذت
تشتدُّ
وتتنوّع
بدافع سلسلة
من تطوّرات
العصر، بدأت
تنعكس نتائجُها
على الجيل
الصاعد بما
فيهم أبناء
الطائفة النقشبنديّة
في عهد أخلاف محمّد
بن محمّد بن
عبد الله
الخانيّ. لذا
نلمس توقّفًا
ملحوظًا في
نشاط هذه
الطريقة على
الساحة
الشاميّة في
عهد ابنه محمّد
بن محمّد
الخانيّ،
وحفيده عبد
المجيد بن محمّد
الخانيّ. وإذا
تأمّلنا
قليلاً فيما
كان يحدث
يومئذ في
العالم بصورة
عامّةٍ، وفي
المناطق العربيّة
(سيما في
منطقة الهلال
الخصيب) من
ثورات وحركات
فكريّة وعقديّة
و إيديولوجيّة،
لابدّ أن
نقدّرَ ما كان
لهذه الحركات
من الأثر الكبير
على العقليّة
السائدة في
تلك المرحلة.
ثم إنّ
خليفة محمّد
بن عبد الله
الخانيّ (وهو
ابنه محمّد) - في
الحقيقة - لم
يتميّز
بشخصيّة
بارزة، خاصّة،
وكانت قد طغت
شهرة الأمير
عبد القادر
الجزائري على
سمعة
الخانيّين
بصورة طبيعيّة
ومن غير نزاع.
وهذا أيضًا له
أثر بالغ على
هبوط مكانة
النقشبنديّين.
وما أن تصاعدتْ
التّيّارات
الفكريّة والسياسيّة
(الشائعة باسم
اليقظة
والوعي
القوميِّ
والنهضة الحديثة
والدّعوة
السلفية
وغيرها)،
ازدادتْ سرعةُ
إنحطاط
الطريقة الخالديّة.
فلم يستطعْ
أديبُ
النقشبنديّين
عبد المجيد بن
محمّد بن محمّد
الخانيّ أن
يقاومَ هذه
التّيّارات.
على الرغم من
لباقته وتحذلقه
وأسلوبه
الدعائيِّ
المسجَّع
والمزخرف. ولا
نَفَعَتْ
جهودُ
الباقين من
رؤوس النقشبنديّة
من أمثال محمّد
أسعد بن محمود
الصاحب و
أعوانه.
وربما
دبّ في قلوبهم
القلق على
مستقبلهم بعد هذه
التطوّرات،
بأن يهجرهم
الناس في أمد
غير بعيد،
(إنْ استمرّت
تلك الحركات
الّتي لم تكن
تعرف الهوادة
في المنطقة)،
حتّى غيّروا
شيئًا كثيرًا
من سياستهم في
التعامل مع روّاد
الوعي
الإسلاميِّ.
ويشهد على ذلك
الموقف
المتصالح
الّذي اتخذه
عبد المجيد بن
محمّد
الخانيّ من
السلفيّين،
وعلاقاته مع
الشيخ محمّد
عبده في منفاه
بمدينة بيروت
عام 1883م.
ولكن
الطريقة النقشبنديّة
انزاحتْ منذ
أوائل القرن
العشرين
واختفتْ من
الساحة
الشاميّة،
إلاّ في بعض
البقاع من
المنطقة
الشمالية الآهلة
بالأكراد.
الّذين
تشرّبوا
عقائد هذه الطريقة
لانسجامها مع
عقليتهم
القاصرة عن فهم
حقائق الكون
والحياة
والقرآن.
فلما
بدأت علامات
الاحتضار على
الدولة العثمانيّة،
انحصرت
نشاطات
الطريقة النقشبنديّة
في نطاق
الساحة الّتي
يسكنها
الأتراك
والأكراد
فحسب. وهي
الأراضي التركيّة
في الوقت
الحاضر. إلاّ
أنّ هذه
النشاطات
دامتْ
واستحكمتْ،
وإنْ اختلّتْ
في بعض
الفترات
بظهور الخلاف
بين رؤوس هذه
الطائفة وبين
الحُكّام في
عهد الاتحاديّين
في آخر أيّام
الدولة العثمانيّة،
وفي المرحلة
الأولى من
العهد
الجمهوريّ. ولكنها
أخذتْ طابعَ
دينٍ مستقلٍّ
تمامًا في
أيّامنا، سوف نشرح
هذا الجانب في
الفصل الخامس إنْ
شاء الله
تعالى.
في
الحقيقة،
مئاتٌ من شيوخ
الطريقة النقشبنديّة
كانوا ولا
يزالون
يبذلون
جهودًا
بالغةً في نشر
تعاليم
الطريقة الخالديّة
على الساحة التركيّة
بين العنصر
التركيّ
والكرديّ منذ
حقبة تزيد على
مائة وخمسين
سنة. إلاّ أنّ
نجاح الطريقة
في هذه الساحة
إنّما يعود
بالدرجة
الأولى إلى شخصين
منهم. وما ذلك
في الحقيقة إلاّ
من نتائج
سعيهما
المتواصل،
ودعاياتهما
المغرية،
وأسلوبهما في
التعامل مع
الناس،
وتأثيرهما في
توجيههم،
بالإضافة إلى
علاقتهما
الوطيدة
بحكّام السلطة
العليا. وإلاّ
ليس بسبب
إطلاع الناس
على كنه هذه
الطريقة
وغاياتها. بل
العامة تجهل
حقيقتها تمامًا.
أحد
هذين الشخصيّتين
البارزتين هو
الشيخ طه
النهريُّ
الشمزينيُّ
الهكّاريُّ اﻟْﮕَﻴﻶنيُّ. وهو من
الطبقة
الأولى في
سلسلة
الطريقة بعد
خالد
البغداديّ
كما مرّ ذكره.
والثاني،
هو الشيخ أحمد
ضياء الدين
الگُموُشْخانويُّ.
الّذي أخذ
الخلافة من
أحمد سليمان
الأروادي
(خليفة خالد
البغداديّ).
وأمّا
بقيّة شيوخ النقشبنديّة
- مهما اشتهر
بعضُهم وأصبح
في الصورة،
لتقادم سمعة
الأوّلين -
فإنّهم لم يحقِّقُوا
شيئًا جديدًا
سوى منافسة
الأمثال في
اصطياد الناس.
***
*
الشيح طَهَ بْنُ
الملاّ أحمد
بن صالح
النهريّ
الهكّاريّ اﻟْﮕَﻴﻶنيّ.
ينحدر
طه النهريُّ
من سلالة
الحسن بن علي
بن أبي طالب
رضي الله عنهما.
أسرته من تلك
العائلات
المهاجرة من
ذراري بني
هاشم الّذين
فرّوا من زحف
المغول عام 656 من الهجرة،
الموافق: 1258 من الميلاد،
وأقاموا في
هذه المنطقة؛
ثم غلب على
كثير منهم
الطابعُ
الكرديّ.[509]
كان
طه وعمُّهُ عبد
الله من خلفاء
خالد
البغداديّ.
إلاّ أنّ طه
غلب عمَّه في
الشهرة. لأنّه
كان يمتاز
بتسليط هيبته
على الناس،
والتمكٌّن
منهم، والمعرفة
بطرق
تسخيرهم؛
بخلاف عمِّهِ
الخامل المعزول
عن الناس،
الّذي لا ذكر
له أصلاً سوى
ما جاء في بعض
مكتوبات
البغداديّ
فحسب.
أمّا
طه، فان ولاة
المنطقة
وأعيانها
كانوا ينظرون
إليه بعين
التوقير
والإجلال لما
رأوا طاعة جميع
العشائر
الكرديّة له.
وربما هذا
السبب المزدوج
هو الدافع
الرئيسيّ
لِتَدَرُّجِهِ
في سُلّم
الشهرة حتّى
استطاع أن
يكتسب قوةً
سياسيّةً في
المنطقة إلى
جانب مركزه
المرموق عند
السلطان
العثمانيّ. ثم
حظي من هذه
الشهرة خلفاؤه
أيضًا.
إنّ
أهمية دوره في
نشر تعاليم
الطريقة النقشبنديّة
على الساحة التركيّة
تكمُنُ في
جهود أُسرتين
من أتباعه.
وهما الأسرة
الأرواسيّة،
والأسرة
الكُفْرَويّةِ.
لذا مَنْ أراد
البحثَ في سير
الطريقة النقشبنديّة
ومتابعة
نشاطها إبّان القرن
الأخير في هذه
البلاد،
ينبغي له أنْ
يتعرّف
أوّلاً على
كنه هاتين
الأسرتين.
وحتّى المعرفةُ
بشخصيّة طه،
تتوقّف أيضًا
على المعرفة
بالأسرتين
المذكورتين.
لأنّ أتباعه
لم يدّخروا
وسعًا في
تعظيم شأنه
إلى درجة إلهٍ
لا ينبغي (في
اعتقادهم) أن
يتمكّن أيّ
إنسان من
الإطلاع على
شيء من صفاته
البشرية.
لذا
وعلى الرغم من
أنّه كان
رجلاً سياسيًّا
معروفًا،
بصفته في
المجلس
العثمانيّ،
فانّ أتباعه
قد بذلوا
قصارى جهودهم
في القضاءِ على
أدنى وثيقة من
دلائل حياته السياسيّة
لما قد
تُسَبِّبُ
زوالَ
هيبتِهِ من
قلوب المريدين؛
وقد نسجوا
حوله تلافيفَ
من حكاياتٍ أسطورية
غريبة على
سبيل الذكر
لما كان يتّصف
به من العظمة
والشموخ
والشأن
الرفيع والكرامة
والبركة؛
يتلهّى بها
الغافل عن
التأمُّل
فيما إذا كان
هذا الرجل
بشرًا يأكل
ويشرب ويتغوّط.
كان
طه من أشهر
أبناء
الشرفاء
النهريّين
(نسبة إلى
نهري). وهي
قرية على
مَقْرُبَةٍ
من مدينة »شَمْزِينَانْ«
التابعة
لولاية
الهكّارية.
وكان في الوقت
ذاته يمثّل
أكبر جماعة من
النقشبنديّين
في المنطقة
الكرديّة
الشماليّة من
المملكة العثمانيّة.
قام
بدوره (بعد
وفاته)، ابنُهُ
عُبَيْدُ
الله. وكان قد
أخذ الخلافة
من عمّه صالح
بن أحمد،
فاستغلّ شهرة
والده في
أغراض خطيرة
بدرتْ منه
لميّزاتٍ
شخصيّة فيه.
ذلك لأنّه كان
جريئًا
مقدامًا. عارض
سياسة
السلطان عبد
الحميد الثاني
ضدّ موقفه
المتهاون من
الأكراد.
ولكنّ عقليّته
المتخلّفة لم
تسمح له
بملازمة جانب
الحكمة في
تعامله مع
السلطة العثمانيّة.
فلم ينجح في
معارضته. لأنه
كان
مُعْجِبًا بقدرته
إلى حدود
الاغترار
حتّى لجأ إلى
استعمال
العنف ضدّ جهة
غير ذات علاقة
بالأمر. فاتّخذ
العداء
السافر على
العشيرة
المسيحيّة
الآشوريّة
ذريعةً لهذه
المعارضة.
فأنذز
زعمائَهَا وطلب
منهم أن
يُعلنوا
إسلامَهم على
وجه السرعة
جميعًا،
وإلاّ لَيُداهمنَّم
ببطشه وليحطمنّهم
بجنوده! فجمع
من مريديه
جيشًا بمنطقة
زاب، قوامه
عشرون ألفَ
شخصٍ، ودخل
المنطقة على
حين غفلة من
أهلها؛ ففعل بهم
ما فعل، ثم
دخل الأراضي
الإيرانية
زاحفًا يتحدّى
بذلك
السلطتين العثمانيّة
والإيرانيةَ؛
فداهمته
القوات العثمانيّة،
فأُلْقِيَ
القبض عليه
وعلى أبنه عبد
القادر عام 1881م. فصدر
الفرمان
السلطانيُّ
بنفيهما إلى
مكة المكرّمة.
ثمّ مات عبيد
الله في منفاه
بعد أن قضى
هناك سبع
سنين. وذلك
عام 1888م.
قيل
أنّ الغرض من
ثورة عبيد
الله بن طه
النهريّ عام 1881م.، كان
إقامة دولة
كردية في
منطقة جنوب
شرقي المملكة العثمانيّة.
وتبرهن على
هذا، عدّةُ
أحداث وقعت
بعد موته.
منها،
أنّ ابنه عبد
القادر، قام
بتأسيس جمعية
كردية في 2. أكتوبر. 1908م. مقرّها
الرئيسيّ
بمدينة
إسطنبول. وكان
لها عدّة فروع
في المنطقة
الكرديّة.
ومنها،
ثبتتْ علاقة
عبد القادر بن
عبيد الله
النهريّ بالثورة
الّتي قادها
الزعيم
الكرديّ أمين
علي البدرخاني
عام 1889م.؛ كذلك
ثبتتْ
علاقتُهُ مع
زحف
الأرواسيين
على مدينة
بدليس بقيادة
الشيخ شهاب
الدين بن
الشيخ صبغة
الله
الأرواسيّ
الحيزانيّ
عام 1913م. كما كانت له
علاقة
بالثورة
الّتي انفجرت
أخيرًا بقيادة
الشيخ سعيد
اﻟﭙﺎلوي عام 1924م.
جاءت
معلومات
مفصّلة عن
القضايا
المذكورة في
تقاريرَ عدة ٍلجهاز
المخابرات التركيّة
فور إعلان
الجمهوريّة
وإثر اعتقاله
مع ابنه محمّد،
تُلِيَتْ هذه
التقارير
أمام المحكمة
العرفية
بمدينة دياربكر
أثناء
التحقيقات
الّتي
أُجريتْ معهما
عبر الجلسات
من شهر أبريل
ومايو عام 1925م. وذلك
بتهمةِ
اشتراكهما
وتعاونهما مع
الثوار
الأكراد النقشبنديّين.
ثم نُفِذَ حكمُ
الإعدام
فيهما صبيحة
يوم الأربعاء 17. مايو. 1925م.
بمدينة
دياربكر.
يبدو
أنّه كان
يستوحي الجرأة،
ويستمد
القدرة من
وراثته لشيخٍ
من أقوى زعماء
النقشبنديّين،
وهو جدّه
الشيخ طه النهريّ؛
حتّى صدرت منه
هذه البوادر
الخطيرة، فأَوْدَتْ
بحياته وحياةِ
ابنهِ محمّد إلى
الهلاك في
سبيل هدف لا
مساس له
بالإسلام مباشرةً.
وإن كان بعض
الزعماء لهذه
الثورات ينطلقون
باسم الإسلام
ويهتفون به.
ولكنّها في
الحقيقة كانت
حركات نضالية
وثورات كردية
ضدّ الحكم الفاشي
لحزب الاتحاد
والترقي
وامتداده
الّذي تجسّد
في النظام
اليهودي بعد
إعلان
الجمهوريّة. بينما
كان الشيخ
المذكور عربي
الأصل من
سلالة الحسن
بن علي بن أبي
طالب رضي الله
عنهما، وإن
كان هو كردي
النشأة من حيث
الذوق والعقليّة
والاتجاه.
إنّ
الشيخ عبد
القادر بن
الشيخ عبيد
الله بن الشيخ
طه النهريّ،
هذا الّذي قام
بتلك المغامرات
الخطيرة، كان
من أعضاء مجلس
الأعيان في البرلمان
العثمانيّ
سابقًا، كما
تقلّد منصب رياسة
مجلس الشورى
في حكومة داماد
فريد باشا،
عامي 1919-1920م. من
عهد السلطان
وحيد الدين.
ولكن العبرة
الّتي يجب
استخلاصها من كلّ
هذه الوقائع،
هو أنّه لم
ينل هذه
المناصب ولا
حظي بهذه
الشهرة إلاّ
لأنّه كان
شيخًا
نقشبنديًا وابن
شيخ
نقشبنديٍّ
شهير!
أمّا
الأُسرتان
المذكورتان
من أتباع
الشيخ طه
النهريّ،
فانّ قصّتهما
غريبة جدًّا.
وقع
التنافر بين
الأسرتين فور
موت الشيخ طه،
ثم اشتدّ
الصراع
بينهما بسبب
المنافسة في
استغلال
شهرته، حتّى
بلغ ذلك إلى
أبشع أشكال التباغض
والشحناء.
فبدأ كلّ من
الطرفين
يقابل الآخر
بالسخرية
والتهكُّم
والسبّ
والتكفير.
ذلك
أنّ الشيخ
صبغةَ الله
الأرواسيّ
والشيخ محمدًا
الكُفْرَويّ،
كلاً منهما
كان قد حصل على
الخلافة من
الشيخ طه
النهريّ
الهكّاريّ. وهذا
ليس أمرًا
شاذًّا عن
أصول النقشبنديّة.
لأنّه قد يأذن
شيخ الجماعة
لأكثر من واحد
بالخلافة.
إلاّ أنّه
يقيم لنفسه
وصيًّا خاصًّا،
على أن يرجع
إليه بقيّة
خلفائه بعد
موته في
قراراتهم. وأن
يرابطوه ويعظِّموه
بصفته نائبًا
عنه.
وما
أنْ مات الشيخ
طه النهريّ
الهكّاريّ،
حتّى ادّعى كلّ
من الخليفتين أنّه
الوصيُّ
القائم مقام
شيخه وانتصر
له أتباعه
بحماس. فزاد
في هذه الحملة
أتباعُ
الكُفْرَويّ: »أن الشيخ
صبغةَ الله
الأرواسيَّ زنديقٌ
دجّالٌ مطرودٌ
من الطريقة وأنّه
لن يجد عرف
الجنّة!«،
زعمًا على
لسان عبيد
الله النهريّ.
فتطوّر الأمر
إلى حدّ، لم
يأل أيُّ طرفٍ
منهما جهدًا
في التشنيع على
الآخر، إلى
أنْ قام أبناء
صبغة الله
الأرواسيّ
بثورة على
النظام عام 1913م.
فلمّا
زحفوا على
مدينة بدليس،
استغلّ أتباع الشيخ
الكُفْرَويّ
هذه الفرصة،
فانحازوا إلى
القوات العثمانيّة
ضدّ الثوّار.
وساعدهم رجل
اسمه الشيخ محمّد
الغريب من
أتباع الشيخ محمّد
الحزين
الفرسافي
الهاشمي.
فاستولى على
مخزن العَتَادِ
والذخيرة
للجنود
الّذين كانوا
قد هربوا من
وجه الثوار.
فوزّع
الأسلحةَ على
سكان
المدينة؛
فاشتدّتْ
المقاومة ضدّ
الأرواسيّين
حتّى عاجلتهم
الهزيمة.
فأُلْقِيَ
القبض على
قادتهم: الشيخ
شهاب الدين،
والسيد علي،
والشيخ محمّد
شيرين، كبارِ
الأسرة
الأرواسيّة؛
ونُفِذَ فيهم
حكمُ الإعدام
بسرعةٍ في مدينة
بدليس. فزاد
الطين بلّةً
بين الأسرتين بعد
هذا الحدث،
واستمرّت
العداوة
بينهما إلى
يومنا هذا.
كانت
قد أصابت
الأسرةَ
الكُفْرَوِيَّةَ
أيضًا نكبةٌ
في تلك
المرحلة بسبب
بدعةٍ أثارها
رجلٌ
متطرِّفٌ من
أتباعها
الأكراد في مدينة
آغري[510] اسمه »بَكّو«.
ذلك،
أنّ هذا
الرجلَ ظهر
ينبح في
الشوارع
نُبَاحَ
الكلاب. فزعم
أنّ هذا الفعل
يصدر منه
تلقائيًّا
وبغير إرادة،
كما زعم أنّ
ذلك جذبات
إلهية تنتابه،
فلا قدرةَ له
على الامتناع
عنها. بيد أنّه
لم يقتصر
بنفسه على
ذلك؛ بل بدأ
يدعو الناس أيضًا
إلى النُباح
بإصرار وقد
يشتدّ عليهم أحيانًا
إلى حدود
الإجبار.
فاغتر به كثير
من البُسطاءِ،
وأطاعه آخرون
على كراهيةٍ
منهم، مخافةَ
أن يمسّهم
بسوء. فلم
يلبث أنْ
تفاقمت البدعة
وانتشرت
الفتنة بين
قبائل
الأكراد الّذين
كانوا ينتمون
إلى الشيخ محمّد
الكُفْرَويّ،
ويعتقدون أنّه
أعظم أولياء
الله على وجه
البسيطة.
فتطوّر الأمر
وتصاعدت
أصوات العواءِ
على المنطقة
بتمامها
وبصورة مرعبة
عجزت الإدارة
المحلّيّةُ
عن التحكّم
فيها والحيلولة
دونها؛ حتّى
لجأت إلى طلب
المدد من
العاصمة
إسطنبول. فتم
القضاء على
هذه البدعة
باتّخاذ
إجراءات أمنيّة
صارمة. ثم بعد
أن صدر
الفرمان بتنفيذ
العقوبة
اللاّزمة ضد
كبار الأسرة
الكُفْرَوِيَّةِ،
بصفتهم
مسئولين عن
حدوث هذه
الفتنة، تمّ إبعاد
الشيخ عبد
الهادي
والشيخ عبد
الباقي (ابني
الشيخ محمّد
الكُفْرَويّ)؛
تمّ إبعادهما
إلى برية
فزان. وهي
منطقة نائية
عن البقاع
المسكونة في
قلب الصحراء
بليبيا. وذلك
في أوائل
القرن
العشرين
الميلادي.
والغريب
أنّ تلك
التطوّرات لم
تُجْدِ بأيّ سلبيةٍ
على الطريقة النقشبنديّة،
ولم تخفّف
شيئًا من سرعة
انتشارها
ورسوخها، على
الرغم من
ابتلاء
المجتمع
العثمانيّ بنكبات
المجاعة
والهجرة بعد
الحرب
العالميّة الأولى،
وزحف جيوش
روسيا القيصرية
على المناطق
الشرقية
الّتي كانت معظمها
آهلةً
بالأكراد.
فنفذت محبة
هذه الطريقة
إلى قرارة
نفوسهم،
فتشرّبتها
دماؤهم وخلاياهم.
مع أن الطريقة
النقشبنديّة
كانت حديثة
العهد في تلك
المرحلة
بالإضافة إلى
أنّ الأكثرية
الساحقةَ
منهم، ما
كانوا ولا
يزالون
يعرفون شيئًا
من تعاليمها
ومبادئها
الأساسيّة
وفلسفتها. كما
وأنّهم
يجهلون
تمامًا من أين
تستوحي
عقائدها. وما
هو الغرض
الحقيقيُّ
لهذه الطريقة.
هكذا
سادت العقائد النقشبنديّة
ورسخت في نفوس
الأكراد
بالمنطقة
الشرقية نتيجة
جهود الشيخ طه
النهريّ
وخليفتيه
بالرغم من
النـزاع
الّذي دام
بينهما وبين
أتباعهما منذ
مائة وثلاثين
عامًا. وكان
لعددٍ آخر من
الشيوخ أيضًا
أثرٌ كبيرٌ في
انتشار هذه
الطريقة على
المنطقة
المذكورة.
منهم؛ الشيخ
خالد الجزري،
والشيخ حامد
المارديني الحسيني
الهاشمي،
والشيخ صالح
السِّيبْكِي، والشيخ محمّد
الحزين الحسني
الهاشمي.
أمّا
المنطقة الغربيّة،
فانّ جهود
الشيخ أحمد
ضياء الدين
الگُمُوشْخَانَوي
يغلب على جهود
سائر شيوخ
الأتراك في
نشر هذه
الطريقة. ذلك
لأنّه أعلمهم
باللّغة العربيّة،
وأكثرهم
ثقافةً،
وأنجحهم في
التعامل والتفاهم
مع خاصّة
المجتمع. لذا
كان نافذ
الكلمة عند
رجال الدولة
والسياسة في
عهد السلطان
عبد الحميد
الثاني. جاءت
ترجمتُهُ
بالتفصيل في »إرغام
المريد«
للشيخ محمّد
زاهد
الكوثريّ.
وهو
من الطبقة
الثانية بعد
خالد
البغداديّ. لذا
يُعَدُّ هو
الحلقةَ
الحاديةَ
والثلاثين من
السلسلة النقشبنديّة.
صَحِبَ الشيخ
عبدَ الفتاحِ
العقريَّ
(أحدَ خلفاء
البغداديّ
الّذي أقام في
إسطنبول لنشر
الطريقة
بأمرٍ من
شيخه، ومات
بها.) وفي تلك
الفترة التقى
الگُمُوشْخانَويُّ
بالشيخ أحمد
بن سليمان
الأروادي في
إسطنبول. كان
الأرواديُّ
أيضًا من خلفاء
البغداديّ.
أجازَ الگُمُوشْخانَويَّ
بالخلافة
أثناء هذه
الزيارة. ثم
عاد إلى بلده
طرابلس الشام بعد
أن أقام في
مدينة
إسطنبول مدةً
طويلةً.
للشيخ
أحمد ضياء
الدين الگُمُوشْخانَويّ
تصنيفات في
الحديث
والتصوّف والأخلاق.
وردت أسماؤها
في كتب
الباحثين الأتراك.
كلّها مدوّنة
بالعربيّة.
وذلك يبرهن
على أنّه كان
يتقن لغة
الضاد، وإن لم
يكن على درجة
فائقة في
البلاغة. وذلك
عسير جدًّا
على العنصر
التركيّ. إذ
لم ينجح منهم
أحد في
استخدام هذه
اللّغة على
مستوى أدباء
العرب
وأعلامهم بعد
العهد
المملوكيِّ
في مصر. إلاّ
عدد قليل
جدًّا. أشهرهم
الشيخ محمّد
زاهد
الكوثريّ، ثم
الشيخ مصطفى صبري
(آخر شيوخ
الإسلام في
الدولة العثمانيّة)،
ثم الشيخ أبو
السعود
العمادي. مات
الشيخ أحمد
ضياء الدين
الگُمُوشْخانَويّ
عام 1311هـ./1893م. والدولة العثمانيّة
مغلوبة على
أمرها،
معرَّضَة
لأخطارٍ
وشيكة الوقوع.
ولم يكن
النقشبنديّون
يومئذ على شعورٍ
تامٍّ بما
تعاني دولتهم
من أزمات
رهيبة في
الداخل
والخارج. وكان
المجتمع
عامّةً في
ظلامٍ من
الجهل والعمى.
حتّى اندلعت
الحرب
العالميّة
الأولى، فحصدت
مالا يُحصى من
الأرواح.
وما
أنْ وضعت
الحربُ
أوزارها، بدأ
الناس يستفيقون
من سباتهم،
وينهضون من
تحت أنقاض هذه
الدولة
المدمَّرة ليواصلوا
مسيرة الحياة
من جديد. ولكن
البقيّة
الباقية من
النقشبنديّين
مازالوا
ينظرون إلى من
يظهر فيركب
على عاتقهم
ويحتلّ مكان
السابقين من
الشيوخ لِيُعِيدَهُمْ
إلى ذلك
العالم
المُظلم كرةً
أخرى.
فلمّا
تمَّ إعلان
الجمهوريّة التركيّة
عام 1923م.، وانفجرت
ثورة الشيخ سعيد اﻟﭙﺎلوي
الكرديّ عام 1924م. حكمت
السلطة على
عددٍ من مشائخ
الطريقة النقشبنديّة
بالإقامة
الجبرية في
المدن الغربيّة
بعد أن نفّذت
حكمَ الإعدام
في جماعةٍ
منهم عقب
إخماد الثورة
مباشرةً. وكان
من المحكومين
عليهم
بالإقامة
الجبرية في كلّ
من مدينة
إسطنبول، وبورسة،
وإزمير،
أبناء الأسرة
الأرواسيّة
والكُفْرَوِيّة
والحزينيّة وغيرهم.
و من
غرابة الأمر،
أنّ الأسرتين
الأرواسيّة والكُفْرَوِيّة
تعرّضتا
لاستحالةٍ
سريعةٍ جدًّا
في منفاهما
لأسبابٍ
وظروفٍ
اجتماعيةٍ و
ثقافيةٍ، انفكّت
الصلةُ على
أثرها بين
الأسرة
الكُفْرَوِيّة
خاصّة وبين
جماعات
المريدين
المنتسبين
إليها بدافع
هذه
الاستحالة. زِدْ
على ذلك: أنّ
قلّةَ أبناء
هذه الأسرة
عددًا، واخْتِلاَفَهُمْ
عن أتباعهم في
التعايُش
والسلوك بعد
المرحلة
الأخيرة،
يُعَدُّ
أيضًا من
الأسباب
الرئيسة لهذا
الإنحلال. وما
أنْ مات الشيخ
قسيم الكُفْرَويّ
عام 1992م.،
اندرست اسم
هذه الأسرة
واختفت عن
ساحة النقشبنديّين
تمامًا.
أمّا
الأرواسيّون،
فإنّهم
استطاعوا أن
يحتفظوا
بمكانتهم بين
الجماعات
المنتسبة
إليهم لأسباب:
منها،
أنّ عددًا
منهم
استمرّوا في
ممارسة مهنة
الأسلاف إلى
نهاية العقد
الثالث من
القرن العشرين
الميلاديّ.
وعلى رأسهم
الشيخ عبد
الحكيم
الأرواسيّ
الّذي أعاد
للأسرة سُمْعتَهَا
بعد تلك
النكبات
الّتي
أصابتها قبيل الحرب
العالميّة
الأولى. وذلك
بنشاطاته في مدينة
إسطنبول،
خاصّة بعد
إعلان
الجمهوريّة،
وهدوء
الأوساط؛ كما
سنتطرّق إلى
أعماله قريبًا
إنْ شاء الله.
ومن
هذه الأسباب:
أنّ رئيس
الطغمة اليهوديّة
الحاكمة
الّذي وثب على
السلطة فور
الإعلان للجمهورية
المزيّفة؛
وغَصَبَ
الحكمَ بالتواطؤِ
مع »منظمة
الْقَرَائِمَةِ«،
في الداخل؛ و»منظمة
الفرمسونية
العالميّة«
وبدعمٍ من
الحكومة
البريطانيّة
من الخارج؛
استقر أمره
وبدأ يلتقط
شبابًا من
أفذاذ كلّ
فئةٍ،
يُغريهم
بإمكاناتٍ
واسعةٍ،
وأموالٍ طائلةٍ،
ومناصبَ
هامّةٍ طاشت
بها عقولهم واندفعوا
تحت أمره إلى
تحقيق كلّ ما
يهواه. كان
يروِّضُهم
على شاكلته، لِيُكَوِّنَ
منهم قوّةً
يعزّزُ بها
مركزَهُ.
اختار شبابًا
من هذه
العائلات
المحكومة
عليها
بالإقامة
الجبرية. ومنح
الناضجين
منهم فرصة
المشاركة معه
في احتكار
السلطة. وسعى
إلى تربية عدد
من صغارهم وفق
اتجاهاته؛ فأرسل
فريقًا منهم
إلى سويسرا
للدراسة،
وليصنع منهم
عملاء صادقين
مخلصين يخلدّ
بهم ذكره.
فكان على رأس
هؤلاء الفتية
شابٌّ من
الأسرة الأرواسيّة.
اسمه »كَامْرَانْ
إينَانْ«.
وهو ابن الشيخ
صلاح الدين بن
السيد علي بن
صبغة الله
الأرواسيّ
الحيزانيّ،
من مشاهير شيوخ
النقشبنديّة
في شرق
البلاد.
نشأ
كامران إينان
علمانيّا
دهريًّا بحكمِ
البيئةِ
الّتي تربىَّ
فيها،
والثقافةِ
الوضعيةِ
الّتي تلقَّاها
في الغرب. لذا
كان ولا يزال
يُضمر الحقد
على الإسلام
والمسلمين.
ولكنَّه
محنَّكٌ في
فنون
المسايرة، وحاذقٌ في
المُداراة
واللّباقة
إلى حدود
النفاق. يتظاهر
لأتباع آبائه
على عقيدتهم،
ويخاطبهم بأسلوبهم.
ولكن الطغمة اليهوديّة
الحاكمة لولا
تأكّدها من
إخلاصه لها،
لما ضمّتْهُ
إلى فريقها،
ولا كشفتْ له
من أسرار
مخططاتها،
ولا منحته تلك
المناصب
العليا الّتي
لا يزال يشغلها
ويتعاون مع البقيّة
من رجال هذه
المنظمة
السرية
الخطيرة. إذ
أنّ الحكومات اليهوديّة
وكّلت إلى هذا
الرجل وظائفَ
هامةً إبّان احتكارها
لسلطة
الجمهوريّة التركيّة.
فمنحته مهمّة
السفارة في
السنين
الأولى، كما
أكسبت أباه
العضويّةَ في
البرلمان
التركيّ. ثم
ازدادت في
إسباغ نعمها
على هذه
الأسرة أنْ
استخدمت
عددًا من رجالها
الآخرين، كما
وكّلت أخيرًا
إلى كامران إينان
منصب وزارات
عديدة. وهو لا
يزال يتهنّأ بمكانته
المرموقة بين
الجيل الثاني
والثالث من
أفراد هذه
المنظمة اليهوديّة
حتّى الآن.
على الرغم من
أنّ لآبائه
سوابق سياسيّة
خطيرة كما تطرّقنا
إليها بإيجاز
آنفًا. فيكون
استخدامه أمرًا
مخالفًا
للأعراف السياسيّة
على وجه
الإطلاق.
يبرهن على
استثنائيّة
وجوده في
المسرح
السياسي،
عدمُ تمكين
الحكومات التركيّة
لبقيّة أحفاد
الثوار من تلك
المناصب.
أماّ
عبد الحكيم بن
مصطفى
الأرواسيّ، فإنّه
من مشاهير
المتأخّرين
للطائفة النقشبنديّة.
لم نقف على
تاريخ ميلاده.
انخرط في سلك
هذه الطريقة
وأخذ الخلافة
من جدّه السيد
فهيم عام 1889م. وبذلك
يُعَدُّ من الطبقة
الثانية
والثلاثين من
السلسلة النقشبنديّة.
خرج
من موطنه
(قرية آرواس)؛
وهي من ضواحي
مدينة »وَانْ«؛
مهاجرًا إلى
الموصل،
هربًا من هول
القوات الروسيّة
الّتي داهمت
المنطقة
الشرقية عام 1914م. أقام هناك
مدّةَ عامين،
ثم هاجر إلى
مدينة أَضَنَهْ،
فأَسْكِيشَهِرْ،
حتّى وصل إلى
إسطنبول عام 1919م. فأقام
بها، وشهد
التطوّرات
الّتي مرّت
بالدولة العثمانيّة
في أيّام
انهيارها.
ولكنّه ظلّ
يشتغل بنشر
طريقته غير
مبالٍ بما
يجري حوله، أو
ربما تلبيةً
للحاجة
الروحيّة
الّتي كان
الناس في مساس
إليها.
ينبغي
هنا أن لا
ننسى الحالةَ النفسيّةَ
الّتي كانت في
تلك المرحلة
قد سادت ضمير
المجتمع
العثمانيّ بكلّ
فئاته، ذلك
المجتمع
الّذي لم يكد
يصدّق بسقوط »دولته
العملاقة
الّتي كانت في
ذمة أولياء الله«. إنّ
هذا المجتمع
كان يومئذ
يبحث عمن يسليّه
ويكشف غمومه،
ويبشّره بأنّ
الدولة
مازالت في
حماية أضرحة الأولياء.
فوجد
ضالّتَهُ
المنشودةَ في
عبد الحكيم
الأرواسيّ.
إنّ
هذا الرجل - في
الحقيقة - قد
لعب دورًا
هامًّا في
تسلية الناس
بتـزيين
أحلامهم،
وتعظيم
أمجادهم،
واستطاع بهذا
الأسلوب أن
يجدّدَ
عهدَهم
بالطريقة النقشبنديّة
و »عظمائها
الّذين ظلّوا ينشرون
أجنحتهم على
الأمّة التركيّة،
ويحفظونها من
المصائب،
ويقاتلون
أعداءها أمام
الصفّ الأوّل
في كلّ معركةٍ«
لقد
حالفه الحظّ
في هذه
المحاولة أنْ
تَعَرَّفَ
على رجلين
نادرين من
نوعهما في
إسطنبول. وهذا
يُعتَبَرُ
أيضًا من
الأسباب
الهامّة
لنجاحه في نشر
طريقته
واكتساب شهرته
وإحياءِ ما خسرته
أسرته من
السمعة
والكرامة
بتمرّدها على
السلطة فيما
سبق. أحد هذين
الشخصيّتين:أديب
شاعر صنديد
شهير، اسمه
نجيب فاضل، مات
عام 1983م.؛ والثاني
عقيدٌ صيدليّ
متقاعدٌ؛ اسمه
حسين حلمي؛ دسّته
أجهزة
المخابرات في
صفوف أتباع
الأرواسيّ لمهمّةٍ
قام بها حقَّ
قيامٍ منذ
ستين عامًا. مات يوم 25 أكتوبر 2001 في
إسطنبول. تنحصر هذه
المهمّة
أصلاً في نشر
عقائد غريبة تمثّل
شكلاً
مخصوصًا
مختلقًا
وبديلاً عن
الإسلام. وهِيَ:
»الْمُسْلُمَانِيَّةُ«[511] المتعارفة
من قِبَل الغالبيّة
العظمى
للمجتمع
العثمانيّ
منذ ستمائة
عام على الأقلّ.
بل هو الإسلام
الشكليُّ
المجرد عن
الروح
السماويِّ
منذ عهد
العباسيّين؛
وليس هو
الإسلام
الّذي يحدّده
كتابُ الله
وسنةُ رسوله r
بمقوّماته
السماوية
والعالميّة.
لقد
كان عبدُ
الحكيم
الأرواسيّ ذا
حظ عظيم؛ لأنّ
مشاهير شيوخ النقشبنديّة
من العناصر التركيّة
الّذين كانوا
في المنطقة الغربيّة،
حصدتْهم المنيّةُ
في تلك
المرحلة
الزمنيّة؛
فسرعان ما حلّ
الأرواسيّ
محلّهم،
واستفاد من
الفراغ
الحاصل
بموتهم. فذهب
صيته بمحاولات
الرجلين
المذكورين من
بطانته.
فلمّا
أوجستْ
الحكومةُ
خيفةً من
انتعاش
الطريقة النقشبنديّة
بعد الثلاثينات
في المنطقة الغربيّة،
بعد أن انتهتْ
من قمعهم في
المنطقة
الشرقيّة
تطبيقاً
لخطةٍ أعدّتْهَا
عام 1925م.،[512] دبّرتْ
خطةً أخرى
للقضاء على
كبار هذه
الطائفة بتجنيد
عددٍ من
الحشاشين في
مدينة
مَنَامَنْ
قربَ إزمير
عام 1930م. ثم
حصدتهم حصاد
الزرع،
واعتقلتْ مَنْ
لم تتمكّن من
إيجاد ذريعة
لقتله. وكان
الأرواسيُّ -
من حسن حظِّه -
ضمنَ الفريق
الثاني؛ لذا
حُكِمَ عليه
بالإقامة
الجبريّة في
مدينة إزمير.
ثم أُطلق
سراحه عام 1943م. فانتقل
إلى أنقره،
ومات بحيِّ »بَاغْلُومْ«
في العام نفسه.
ومن
مشاهير شيوخ
الطريقة النقشبنديّة
بالمنطقة الغربيّة
في أواخر
الحكم
العثمانيّ:
الشيخ أسعد الأربلي
العراقيّ
الْكرديّ. كان
قد حظي شهرة
واسعة في
مدينة
إسطنبول. نفاه
السلطان عبد
الحميد
الثاني إلى
موطنه الأول
(مدينة أربيل)
بشمالي
العراق؛
لمعارضته
سياستَهُ. بل
بتهمةِ تطاولِهِ
على شخصيّة
السلطان. قيل
أنّ الشيخ
أسعد هذا كان
مُعجِبًا
بنفسه مُستعليًا
مُتهوّرًا
لايعبأ
بكرامة
الناس؛ دخل في
عِرضِ هذا
وذاك حتّى شتم
السلطان عبد
الحمد،
فبلغه، فأمر
بنفيه إلى أربيل
فأقام هناك
عشر سنين
محكومًا عليه
بالإقامة
الجبريّة؛
غير أنّ
أتباعه
يستقبحون هذا
الإسناد ويدافعون
بأنّ حكم
النفي إنّما
صدر بسبب كتاب
ألّفه الشيخ أسعد،
وَرَدَ فيه ما
يثير إساءة
السلطان،
فنفاه.
ولكنّهم لم
يبرّروا
حجّتَّهم
حتّى الآن
باثبات هذا الكتاب
المجهول
الّذي ربما لا
أصل له! وما
قيل أنّ هذا
الكتاب هو »كنـز
العرفان«،
-كما جاء على
لسان الباحث
أكرم إيشن في »موسوعة
إسطنبول«،
مادة النقشبنديّة
- فإنّه لا
يستقيم مع
المنطق
السليم. إذ
أنّ هذا الكتاب
لايحتوي على
شيءٍ مما يكون
قد أغضب السلطان.
بل قد أكّد
فيه المؤلّف
لزومَ إطاعةِ
أولي الأمرِ،
كما يحتوي هذا
الكتاب على
موضوعاتٍ فقهيةٍ
وأخلاقيةٍ
واجتماعية
متفرِّقةٍ؛ كآداب
الوضوء
وفضائل
السواك
والذكر
والدعاء وتحسين
اللحية وذمّ
البخل؛ ولكن الأربلي
كان مواليًا
لجمعية شبّان
الأتراك
الّتي شنّتْ
حربًا ضاريةً
على السلطان
عبد الحميد وسياسته
كما وَرَدَ
التنويهُ
بذلك في »موسوعة
إسطنبول«.[513]
ثم
إنّ الشيخ
أسعد الأربلي
لما أُفرِجَ عنه
عام 1914م. باع
جميعَ أملاكه
في أربل[514]
واشترى
بثمنها قصرًا
في إسطنبول
بحيِّ »أَرَنْكُويْ«،
وهي من
الأحياء
الّتي يسكنها
الأثرياء والطبقة
الأرستوقراطية.
ثمّ صار من
أعضاء »مجلس
مشائخ
الصوفيّة«
وتولىّ
رئاستَهُ، ثم
استقال من
وظيفته عام 1915م.
تحامل
الأربلي على
شخصٍ من رجال
الوعظ في
إسطنبول،
وهاجمه في
رسالته السابعة
والثلاثين
بعد المائة
على أنّه منكر
للصوفية.
كان
أسعد
الأربليّ قد
انخرط في سلك
النقشبنديّين
بالانتساب
إلى شخص اسمه
طه الحريريّ؛
وهو من خلفاء
طه
الشمزينانيِّ
الهكّاريِّ.
يدّعي الأربلي
أنّه مأذونٌ
أيضًا في
الطريقة
القادرية من
الشيخ عبد
الحميد
البريفكانيّ
(خليفة الشيخ
نور الدين
البريفكانيّ).
ورد إقراره
بهذه
التفاصيل في
رسالته
الرابعة
والخمسين بعد
المائة من
جملة رسائله
الّتي نشرت من
قِبَل دار
الأرقم في
إسطنبول عام 1983م. وهي كلّها
مدوّنة
باللّغة التركيّة.
ظهر
في الآونة
الأخيرة رجلٌ
اسمه (عمر
أُونْگَُوتْ) واشتهر
بنشرِ رسائلَ
في مثالب عدد
من رؤساء النقشبنديّة؛
جاء في نهاية
هذه الرسائل أنّه
مأذونٌ من
خليل فوزي في
الطريقة النقشبنديّة،
وأنّ هذا
الأخير كان من
خلفاء الشيخ
أسعد الأربلي؛
غير أنّ
عامّةَ
النقشبنديّين
لا يعترفون به
ولا بشيخه
(خليل فوزي)،
بل يعتبرونه
دعيًّا
دجّالاً
عميلاً
للحكومة العلمانيّة!
يبدو
من عبارات الشيخ
أسعد الأربلي أنّه
كان قد استخلف
شخصًا اسمه (يَكْتَا
أفندي)، يرجع
إليه
أتباعُهُ للاستشارة
والاستفتاء،
وقد زكّاه الأربلي
في عدد من
رسائله إلى
مريديه. ولكن
الّذي اشتهر
بالنيابة عنه
أخيرًا هو
محمود سامي
رمضان أوغلو.
قد أجازه الأربلي
بالخلافة كما
ينصّ على ذلك
خطابه الرابع
والثلاثون
بعد المائة من
جملة رسائله
الّتي جمعها
الدكتور
عرفان جندوز
بالمشاركة مع
ح. كامل يلماز.
قام
خَلِيفَتُهُ
محمود سامي ببذل
جهوده في سبيل
تحسين سمعة
شيخه لدى
الناس الّذين
كانوا
يبغضونه
لمعارضته
سياسة السلطان
عبد الحميد، -
لأنّ القاعدة
الشعبية من الأتراك
مازالوا
يحتفظون
بالمحبة
والإنتماء إلى
سلاطين بني
عثمان على
أنهم رموز
مقدّسة لأمجاد
الأمّة التركيّة
-. فأوصى بعضَ
مريديه المشهورين
بالثروة
والجاه أن
يتزوّجوا من
بنات أسرة آل
عثمان، في
الفترة الّتي
كان رجال الأسرة
المالكة مُبْعَدِينَ
عن البلاد،
وجملةٌ من
نسائهم أصبحن
في حاجة إلى
المساعدة
بسبب ما قد
تعرّضن له من
الفقر والإهمال.
فانتهت هذه
التوصية بعقد
قرانٍ بين رجلٍ
ذي مكانة من مريديه
وبين أميرة من
بنات آل
عثمان. وقُضيت
بذلك على
السمعة
السيئة الّتي
كانت قد شاعت
ضد الشيخ أسعد
الأربلي من
قبل.
مازالت
الطريقة النقشبنديّة
تواصل
مسيرتَها
وانتشارها
على الساحة التركيّة
بكلّ نشاط
وحيوية؛
وبواسطة
طبقاتٍ من
شيوخ هذه الطائفة.
تختلف نسبةُ كلّ
منهم إلى
سلسلة
ساداتهم ما
بين الطبقة
الرابعة
والثامنة بعد
خالد
البغداديّ.
وتستعدّ هذه
الطريقة في أيّامنا
للقفز إلى
الجمهوريّات التركيّة
الّتي حصلت
على
استقلالها
بعد سقوط
الإمبراطورية
السوفيتيّة.
كما تحاول
بأقصى
إمكاناتها
وتعمل لتجنيد
كافّة رجالها
على إبقاء
مفهوم
الإسلام
محصوراً في
ذلك القالب
الّذي صبّه
فيه
الروحانيّون
الأتراك
بخلاف ميّزاته
العلميّة،
ومحتوياته
القرآنية
الأصيلة، و
صورته المحمّديّة
البرّاقة.
سنقوم
بتحليل هذا
الجانب
للطريقة النقشبنديّة
عبر الفصل
الخامس الّذي
نحن على وشكٍ
الدخول في تفاصيله
بعد سرد
معلومات
وافية حول
المميّزات
الشخصيّة
لشيوخ الطرق
الصوفية
ومستوياتهم العلميّة
والثقافيّة إنْ
شاء الله
تعالى.
***
*
الميّزات الشخصيّة
لشيوخ
الطريقة النقشبنديّة
ومستوياتهم العلميّة
والثقافيّة
إنّ
شيوخ الطرائق
الصوفيّة
الأتراك
اليومَ، هم في
الحقيقةِ أخلافُ
دراويشِ
خرسان (Horasan Erenleri) الذين
كانوا
يتردَّدونَ
بين قبائل
التركمان
الرُّحَّل في
العصر الذي
اعتنقوا فيه
الإسلامَ.
وأمّا أؤلئك
الدراويش،
فقد كانوا هم
أيضًا أخلافَ
الرهبان
الهياطلةِ
الذين يزعم بعض
البَحَثَةِ
أنّهم
يلتقونَ في
الأصلِ مع الأتراك.
لقد كانت
المجتمعات
التركمانيةُ
يومئذٍ تحتفل
بهم وتعتقد
فيهم: (أنّهم
واصلون = Erenler). والواصل في
مصطلح الصوفيّةِ
هو الّذي يسلك
طريقًا خاصًّا
من الرياضة
الذهنيةِ
مدّةً ثمَّ
يرتقي حتّى
يتّحد مع
الله. هذا هو
المعتَقَدُ
السائد عند
الصوفيّة
الأتراك على
اختلافِ
مذاهبها.[515]،
تعالى ربُّنا
عن ذلك
عُلُوًّا
كبيرًا.
حظيَ
هؤلاءِ
الدراويشُ
نصيبًا من
المعرفةِ بطرقِ
جلبِ عاطفةِ
الناسِ بحكم
التفاعل معهم
وكسب التجارب
على امتداد
العصور.
لأنّهم طالما
كانوا
يغتبطونَ
المكانةَ
التي يتمتّعُ بها
علماءُ
الإسلامِ في
المجتمع. لقد
كان الدراويش
الّذين
احتلّوا
مكانَ رجال
الدين في
المرحلة التي
دخلتْ قبائلُ
التركمان إلى
حظيرة
الإسلامِ،
كانوا على
هيئةٍ غريبةٍ
في أزيائهم
ومناظرهم
الّتي تتقزّز
منها الطبيعة
السليمة؛
يرتدون
ثيابًا رثّةً
لا يكادُ يتميّزُ
من الرقاعِ،
كما كانوا
يحلقونَ حواجبهم
وشواربهم،
ويشدّون من
شعر رؤوسهم
ضفائرَ يرسلونها،
ويعلّقونَ
حلقاتٍ من
الفضّةِ في
آذانهم، لا
يحترفونَ
صناعةً ولا
يمارسونَ
مهنةً، ولا
يأكلونَ من
كدِّ أنفسهم
إلاَّ ما
يُتَصَدّقُ
عليهم،
ويشذّونَ في
سلوكهم
وتصرّفاتهم
عن عامّةِ
الناسِ.
أمّا
حُظْوَتُهُمْ
من إقبال البسطاءِ
عليهم، وما
كانوا
يتمتّعونَ به
من الإجلالِ
بينهم
يومئذٍ،
إنّما كان من
نتائج العقليّة
السائدةِ
للطبقة
الساذجة في
تلك المرحلةِ.
لأنّ عموم
التركمان
كانوا على
أشدِّ حالٍ من
الجهلِ
والتّخلُّفِ،
بحيثُ لم
ينسبوا صفةَ الوليِّ
إلى أحدٍ
إلاَّ إذا
رأوه مسكينًا
أو غبيًّا في
هيئةٍ
رثَّةٍ،
قَذِرَ
الثيابِ والبدنِ،
بعيدًا عن
النّشاطِ
والعملِ، يجهلُ
القراءَةَ
والكتابةَ،
ولا يتناولُ
كتابًا
أبدًا... كانت
هذه نظرتُهم
في بداية
الأمرِ إلى
مَنْ
يعتقدونَ
فيهِ أنّه من
أولياءِ
اللهِ،
وخاصَّتِهِ
من عبادِهِ، غيرَ
أنَّ هذه العقليّة
تغَيّرَتْ مع
الزّمانِ،
لأنّ أؤلئك
الدراويش ما
لبثوا حتى
انتبهوا إلى
أنّ
لِعُلَماءِ الإسلامِ
مكانةٌ
مرموقةٌ عند
السلطةِ والطبقة
الراقيةِ،
فأخذوا
يقلِّدونَ
العلماءَ في
زيّهم،
ويمارسون
القراءةَ
والكتابةَ طمعًا
فيما ينالُهُ
أهلُ العلمِ
من توقير الناسِ،
وما
يتمتّعونَ به
من
الرّفاهيةِ
واليسرِ
والسعةِ في
المعاشِ. ورغم
هذا
التغيُّرَ
الجذريَّ في
أفكارهم، إنّ العقليّة
الصوفيةَ
المتطرِّفةَ
لم تسمح لهم في
المرحلة
الأولى أن
ينظروا إلى
المناهج الدراسيّةِ
المتعارفةِ
كأداةٍ
للمعرفةِ
والتنوُّرِ.
بل قسموا
العلومَ حسبَ
رأيهم إلى
ضربينِ: علمِ
الظاهر وعلم
الباطنِ. لذا
لم يشتهِ
أحدهم أبدًا
إلى دراسة
العلوم التجربيّةِ
كالحسابِ
والهندسةِ
والفزياءِ والكيمياءِ
والفلك
والتاريخ
والجوغرافيا
وأمثالِها،
ولا حتّى إلى
العلوم الشرعيّة،
كعلمِ
التوحيدِ
والفقهِ
وعلومِ
القرآنِ والحديثِ
وأصولِها،
وما يحتاج
إليه
الطالِبُ
لِفهمِ هذه المعارِفِ
من علوم
الآلةِ،
كالصّرفِ
والنّحوِ
والاشتقاقِ
وفقه اللغةِ
والوضعِ
والمنطقِ...
طالما كَرِهَ
الصوفيّةُ
ممارسةَ هذه
العلومِ،
فاختلقوا
لأنفسهم
علمًا
سَمَّوْهُ عِلْمَ
الباطِنِ (أو
العلمَ
اللَّدُنِّيَّ)،
وزعموا أنّ
علمَ الظاهرِ
لا يُغني عن
الإنسانِ
شيئًا في
طريقِ
الوصولِ إلى
الله! إلاَّ
أنّ هذه الطائفَةَ
- خاصّةً بعد
انتشار
الطريقة النقشبنديّة
بين الأتراك
في المرحلة
الأخيرة من
العهد العثمانيِّ
بجهود خالد
البغداديِّ
عام 1811م.
اهتمّتْ إلى
حدٍّ بالِغٍ
بالعلوم الشرعيّة
تشبُّهًا
بِعلماءِ
الإسلامِ.
ولهذا السببِ التبستْ
على الناسِ
بالعلماءِ،
بحيث لا يكاد
أحدٌ اليومَ
في تركيا
يميّزُ شيوخَ
الطريقةِ
النقشبتديّةِ
من العلماءِ.
بل يُفَضِّلونَهُمْ
على سائر
العلماءِ مع
نسبةِ هذه
الصفةِ إليهم
بما يعتقدونَ
فيهم من
الكرامةِ والبركةِ
وعلم الباطن.
لأنّ »علماءَ
الظاهر« على
حدِّ قولِهم، »محجوبون عن
المعرفة
بالله وعن
طرقِ الوصولِ إليهِ!«
أمّا
شيوخُ هذه
الطريقِةِ
خاصّةً
الذينَ سبقوا
خالِدًا
البغدادِيَّ
وعاشوا في
الحُقْبَةِ
التي ظلَّ هذا
التّيّارُ
على مداها محصورًا
في مناطقِ
تركستان والساحةِ
الهنديةِ،
كانوا أبعدَ
النّاسِ من الأجواءِ
العلميّة،
خاملينَ
مقبّعين على
أنفسهم، لم
يَرِدْ لأحدِهِمْ
أثرٌ في
طبقاتِ
الرجالِ ولا
تَرْجَمَ
لَهُمْ أحدٌ
من الباحثينَ
والمؤرّخين
على امتداد
العصورِ.
لقد جاءت
كلماتُ أديبِ
النقشبنديّينَ،
عبد المجيد بن
محمّد الخانيِّ
مِنْ أقوى
الدلائِلِ
على هذه الحقيقةِ،
إذ يقول في
مُسْتَهَلِّ
كتابِهِ، (الحدائق
الورديّة في
حقائقِ
أجلاّءِ النقشبنديّة):
»
وسمعتُ
أسماءَ
ساداتِ
سلسلةِ
الطريقةِ الجليلةِ،
جعلتُ
أتشوَّفُ
للوقوفِ على
تراجُمِ
أحوالِهم
المقدّسةِ
مدّةً غيرَ
قليلةٍ، وإذ
لم أرها
مُجتَمَعةً
باللغةِ العربيّة
في كتابٍ
واحدٍ؛ لأنّ
أكثرَهم من
بلادِ الفُرسِ
والهندِ
وتلكَ
المعاهد.« ثمّ
يزعم الخاني أنّه
»استحضر
كُتُبًا
مهمّةً
جَمّةً
مدوّنةً بالفارسيةِ
والتركيّة في
ترجمة شيوخه«
ويعدّد
اسماءَ هذه
الكتب التي لم
يحتفل بها أحد
من العلماءِ،
كما يعترف
بهذه الحقيقة
عندما يقول: »إنّه غير
معوّل على
الإقتداءِ
بعبارةِ
المتعرّبين،
لأنّ أكثرَهم
من الفرسِ
المتعرّبين!« كما
يقول: »فقد شذَّ
عنّي من رجال
السلسلةِ
اثنانِ وهما سيدنا
الدويش محمّد
ونجله الشيخ محمّد الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲ، فإنّي لم أقف
لهما على
ترجمةٍ في
مكانٍ، فأرجو
ممّن ألمّ
بترجمتهما أن
يُلحقَها تحت
اسمهما.«
لقد بذل
المؤلّفُ ما
بذل من جهودٍ
بالغةٍ وأفرغ كلّ
طاقتِهِ
وتكلّمَ ملأ
شدقيهِ ليرفع
من شأنِ هذه
الطائفةِ
المجهولةِ،
وليجعلَ
كُلاًّ منهم
تاجًا على
رؤوسِ
العالمين
فيُبَرهِنَ
للناسِ أنّهم
أنوارُ
السماواتِ
والأرضينَ!
مَنْ
أرادَ أنْ
يطّلِعَ على
المميِّزاتِ
الشخصيّة
لشيوخِ
الطريقة النقشبنديّة
السابقينَ
بصورتِها
الحقيقيّةِ،
يكفيه أن يلتمسَ
معلوماتٍ
أثبتها بعضُ
الباحثينَ. ومن
مشاهيرِ
هؤلاءِ
الباحثينَ
الأستاذ
الدكتور فؤاد
كوبرولو.
فإنّه مثلاً
يطرقُ حياةَ
يوسف
الْهَمَدَانِيِّ
الّذي ورد
ذكرُهُ في بعض
المصادرِ
واهتمَّ به بَحَثَةُ
الأعجامِ
أكثرَ من
غيرهِ من
الرروحانيّينَ
لهذه
الطريقةِ. فقد
أثبت الدتور
كوبرولو: »أنّ
يوسف الْهَمَدَانِيَّ رغم ما
تلقّى دروسًا
من العلماءِ
مدّةً في بغداد
وأصبح ذا وقوفٍ
بالِغٍ
وإحاطةٍ
بالعلومِ الشرعيّة
إلاّ أنّه ما
لبث حتّى تركَ
طريقَ العلمِ
بسبب مزاجه الصوفيّةِ«[516] هذا هو
الموقف
المتَعَارَفُ
لشيوخ
الطريقةِ النقشبنديّة
من العلمِ
والمعرفةِ
طوالَ
العصورِ
حتّىَ عهدِ
خالِدِ
البغداديِّ.
أمّا
البغداديُّ
فإنّهُ غدا
مثالاً لِمَنْ
بعدهُ من
شيوخِ هذه
الطريقةِ
بدافعِ نزعتِهِ
إلى الكتابةِ
والقراءَةِ،
وبحكمِ ما سبق
له من دراسةِ
بعضِ العلومِ التقليديّة؛
بذلكَ ازداد
أخلافُهُ
اغتباطًا
بعلماءِ الإسلامِ،
فمارسوا
دراسةَ بعضِ
العلومِ التقليديّة
اسوةً به مع
الإختصارِ
على القراءةِ
دون الكتابةِ.
وكانت
مقرّرات
المدارس
الداخلةِ تحت
هيمنتهم
محدودةً
جدًّا. ومع
ذلك، فإنّ
الدافع الّذي
جعل الطريقةَ النقشبنديّة
تنتشر في
أنحاءِ الشرق
الأوسطِ بعد
عام 1811م. ليس
إلاَّ لأنَّ
شيوخَ هذه
النحلةِ
استخدموا
تكاياهم في
التدريسِ
وظهروا
للناسِ في لباسِ
العلماءِ. فاعتقد
الناسُ أنّهم
من أهل العلمِ
بجانب ما كانوا
يعتقدونَ
أنّهم أصحابَ
الجاهِ عند اللهِ.
تدهور
المستوىَ
العلميُّ بعد
عهد السّلطان محمود
الثاني بشكلٍ
ملحوظٍ
خاصّةً في
المدارس التي
استولى عليها
شيوخ النقشبنديّة
الأكراد، بعد
سيطرتهم على
القطاع
العلميِّ بشرق
البلاد، ثمَّ
تأثّرتْ بهم
العناصر التركيّة
من
الصوفيّةِ،
فأدّى ذلك إلى
تخلّفٍ سريعٍ
في جميعِ
مجالاَتِ
الحياةِ وزاد
من حدّةِ عوامل
الإنهيارِ
للدولةِ العثمانيّة
وسقوطها.
وللمعرفةِ
بحقيقةِ هذه
المشكلةِ وما
قد أسفر عنها
من مشاكلَ
ثانويةٍ
أخرى، يكفي
الإطّلاعُ على
المنهج
المدرسيِّ للنقشبنديّة
ومقارنتِها
بالمنهج
المتّفَقِ
عليهِ عند علماءِ
المسلمينَ
عبر التاريخ.
لقد كانت
النظريةُ
التعليميّةُ
عند علماءِ الإسلامِ
تقومُ على
دعامتين
أساسيّتينِ:
التعليمُ
والتّعلّم.
فما لبثَ أن
تعرّضَ كلاًّ من
هذينِ
الدعامتينِ
للتشويهِ بعد
هيمنةِ هذا
التّيّارِ
الصوفيِّ
الْكُرْدِيِّ
على المدرارس
الكائنة
بالمنطقتين الكرديةِ
والتركيّة.
اقتصر
التعليمُ
عندهم على
قيام
الأستاذِ بقراءةِ
متن الدرسِ
وشرحه بقدرٍ
محدود جدًّا.
أمّا
الكتابةُ
والرسم
والتخطيط،
فإنّها أُسقِطتْ
من المناهج
نهائيًّا، بل
اختفتْ
تلقائِيًّا
لجهل
الأساتذةِ
بالكتابةِ
والنطقِ بالعربيّة
ارتجالاً.
أمّا
التعلُّم،
فإنّه
اضمحلَّ تمامًا؛
لأنّ دورَ
الطالِبِ
اقتصر على
الإستماعِ
المحضِ دونَ
اشتراكه في
المحاضرةِ
بشكلٍ من
الأشكالِ؛ لا
محلَّ
للسؤالِ
والاستفسارِ
عادةً، ولا
للإمتحانِ
والاختبارِ
اطلاقًا في
هذا النّمط
الدراسيِّ
العقيمِ. كما
لا يخضعُ هذه
المدارسُ
لمراقبةِ
أيِّ سلطةٍ
ولا لتفتيشِ
أيِّ مسؤولٍ،
بل شيخ الجماعةِ
مطلَق
العنانِ فيما
يختارُ من
كتابٍ، وموضوعٍ،
وقبولٍ لمن
شاءَ من
الوافدينَ
عليهِ من
الطلبةِ
وطردِ مَنْ
شاءَ منهم.
لقد قسم
علماءُ
الإسلامِ
الفنونَ
قديمًا إلى
آليةٍ وعاليةٍ؛
فالآليةُ
تشمل علومَ
اللغةِ
كالصرفِ والنحوِ
والبلاغةِ
وفروعِها،
ومنها المنطقُ.
وهيَ
بمنـزلةِ
السُّلَّمِ،
يتدرَّ جُ بها
الطالِبُ إلى
تحصيل
العلومِ
العاليةِ
ليتخصَّصَ في
بعضِها. وأمّا
هذا القسمُ،
فإنّهُ يشمل
الحسابَ،
والهندسةَ،
والتاريخَ
والجعرافيا،
والفلكَ
والطّبَّ
والموسيقى
والفزياءَ
والكيمياءَ
وعلمَ الأرضِ
والزراعةَ
والسياسةَ والفلسفةَ
وعلم
الإجتماعِ
وعلومَ
الدينِ. هذه
القاعدة التي
أثبتها
علماءُ
الإسلامِ كانت
معمولةً بها
في العالم
الإسلاميِّ
حتّى بداية
القرن التاسع
عشر الميلادي.
فلمّا تدهورت
الأوضاعُ وانتشر
الجهلُ
واحتلَّ شيوخ النقشبنديّة
مكانَ
العلماءِ
أُلغِيَتْ
جميعُ
العلومِ العقليّة
والتجربيّةِ
من المناهج
الدراسيّةِ
في مدارس هذه
الطائفةِ،
كما
أُلغِيَتِ
المحاضرةُ والخطابُ
بالطريق
المباشرِ؛ بل
اقتصر الأمرُ
على تدريسِ
سلسلةٍ من
كُتُبٍ
قديمةٍ جدًّا
وبصورةٍ
عشوائِيَّةٍ،
يقرأ
الأستاذُ كلّ
يومٍ سطورًا
من كتابٍ
واحدٍ
يختارُهُ من
بينِها إلى أن
ينتهي
الكتابُ، ثمّ
يباشرُ قراءةَ
كتابٍ آخَرَ
من هذه
السلسلةِ
وهكذا يتابَعُ
الدروسُ من
خلالِ كتابٍ
واحدٍ عبرَ
السلسلةِ
كلاًّ على حدةٍ
حتّى تنتهي
الدراسةُ.
وتتراوح
مدّتُها ما
بينَ عَشْرٍ
وخمسَةَ
عَشَرَ
عامًا، يتخرّجُ
الطالِبُ في
نهايتها وهو
شبهُ انسانٍ
أخرس، لا
يتكلّمُ
إلاَّ بعدَ
مراجعةِ
كتابٍ، ولا
يخطُّ بيمينه
أبدًا! فضلاً
عمّا يُعاني
من العيِّ
والعجزِ
البالِغِ في
الحديثِ بالعربيّة،
فلا يكادُ
يجيبُ على
سؤالٍ واحدٍ
حتّى لو خاطَبَهُ
عربيٌّ من
أجهلِ الناسِ!
هذه هي
خلاصةُ
الميّزاتِ
الشخصيّة
والمستوى
العلميِّ
لشيوخ النقشبنديّة
من كلاَ
العُنصرينِ
التركيِّ
والكرديِّ.
أمّا
الكُتُبُ
المقرّرَةُ
للتدريسِ
عندهم، فهي
تلك التي
اختارها
صناديدُهم منذ
قرنينِ، ولم
يتغيّر منها
حتّى كتابٌ
واحدٌ. وهي في
الحقيقةِ
كُتُبٌ
قديمةٌ
وعقيمةٌ يجهلُها
العالَمُ
العربيُّ
تمَامًا. وهذه
أسماؤُها
بالتسلسلِ
حسبَ المنهج
الدراسيِّ المعمولِ
به عند
النقشبنديّينَ
منذ عهدِ خالد
البغداديِّ
حتّى اليوم.
1)
نوُبَهار:
قاموسٌ عربي
كُردي، نظمهُ
الشيخ أحمد
الخاني (1591-1652م.) وهو من
أهالي مدينةِ
آغري
الواقعةِ في
المنطقة
الشرقية
بتركيا.
2) نَهْجُ
الأنام:
رسالةٌ في
العقيدةِ،
منظومةٌ
باللّغةِ
الكرديةِ،
نظمَها
المُلاَّ خليلُ
العمريُّ
الأسعردِيُّ (1754-1843م.)
3) غاية
الإختصار
(التقريب):
كتابٌ صغير
الحجمِ في
الفقه على
المذهب الشافعيِّ،
مؤلِّفُهُ
شمس الدين أبو
عبد الله محمّد
بن القاسم.
4) فتح
القريب
المجيب في شرح
ألفاظ
التقريب: وهو
شرح كتاب
المذكور
آنفًا، ألّفه
أحمد بن الحسين.
5)
التصريف:
كتابٌ في
الاشتقاقِ
وصِيَغِ
الأفعالِ،
مؤلِّفُهُ
مجهولٌ.
6)
الأمثِلَةُ:
جدولٌ مفصّلٌ
في تصريف
صِيَغِ الأفعال،
مؤلِّفُهُ
مجهولٌ.
7)
البِناءُ:
كتابٌ في
أبوابِ
التصريفِ،
مؤلِّفُهُ
مجهولٌ.
8)
المقصود:
كتابٌ في
أبوابِ
التصريفِ
أيضًا، مؤلِّفُهُ
مجهولٌ.
9)
العِزِّيُّ :
كتابٌ في
أبوابِ
التصريفِ
أيضًا، ألّفه
عزّ الدين عبد
الوهّاب بن
ابراهيم
الزنجانيّ
10) العوامل
الجرجانيِّ:
كتابٌ صغير
الحجمِ في النحو
للمبتدئين،
يتناول
العوامل التي
يتغيّر بها
آخر الكلمة،
ألّفه عبد
القاهر بن عبد
الرحمن
الجُرجانيّ
(ت. 1078م.)
11) العوامل
البِركِوِيِّ
: كتابٌ صغير
الحجمِ في النحو
للمبتدئين،
يتناول
العوامل التي
يتغيّر بها
آخر الكلمة،
ألّفه محمّد
البركوي، وهو
تركي الأصلِ.
12) الظروف:
كتابٌ صغير
الحجمِ،
يتناول
الظروفَ في
النحوِ
العربيِّ،
كتبهُ
المُلاَّ
يونس الأرقطيني
باللّغة
الكرديةِ،
يدخل في عداد
الكتب
المتداوَلَةِ
بالمنطقةِ الكرديةِ.
13)
التركيب:
كتابٌ في
النحو
العربي،
يتناول تحليل
ألفاظِ
العوامل
للجرجانيِّ
وهو من مؤَلَّفاتِ
المُلاَّ
يونس
الأرقطيني
أيضًا.
14) سعد
الله الصغير:
وهو كتابٌ
صغير الحجمِ
في النحو
العربي، يشرح
ألفاظَ
العوامل
للجرجانيّ،
مؤلّفه
مجهولٌ.
15) شَرْحُ
المُغنِيِّ:
كتابٌ متوسط
الحجمِ في
مختلف قواعد النحو،
ألّفهُ محمّد
بن ابراهيم بن
محمّد العمري
الميلاني.
شَرَحَ فيه
كتابَ
المُغنِيِّ
لأستاذه أحمد
بن الحسن
الجاربردي.
16) التصريف
الكبير: كتاب
ضخمٌ في
الاشتقاق
والتصريف،
ألّفَهُ سعد
الدين بن
مسعود بن عمر
التافتازاني.
17) حلُّ
المعاقد في
شرح القواعد:
كتابٌ متوسط الحجمِ
في النحو
العربي،
يتناول
الجملةَ، ألّفه
أبو الثناء
أحمد بن محمّد
الزيلوي،
يغلب أنّه
تركي الأصلِ،
شَرَحَ فيه
كتابَ قواعدِ
الإعرابِ
لابن هشام عبد
الله بن يوسف
الأنصاري. يزعم
عمر رضاء
كحالة أنّ هذا
الكتابَ من
مؤلَّفاتِ
سعد الدين بن
مسعود بن عمر
التافتازاني!
18) حلُّ
مشكلات
الإشارات:
كتابٌ في
القواعد الأساسيةِ
للمنطق
والفلسفةِ،
ألّفهُ ناصر
الدين
الطوسي،
شَرَحَ فيه
كتابَ
الإشارات
والتنبيهات
لابن سيناء،
واختصره فخر
الدين الرازي،
لذا يسمّيه
الطلبةُ
(التلخيصَ).
19) حدائق
الدقائق:
كتابٌ ضخم في
النحو
العربي، يسمّيه
الطلبة في
المنطقة
الكردية (سعد
الله كَوْرَا)،
ألّفه سعد
الدين سعد
الله.
20) نتائح
الأفكار في
شرح الإظهار:
كتاب ضخم في النحو
العربي،
ألّفه مصطفى
بن حمزة
الرومي، شَرَحَ
فيه كتابَ
الإظهار
لمحمد البِركِويِ.
21) شَرْحُ
ألفيةِ ابنِ
مالك: كتابٌ
ضخمٌ في النحو
العربي،
ألّفه جلال
الدين عبد
الرحمن السيوطي.
22)
الفوائدُ
الضيائية:
كتاب ضخم في
النحو العربي،
ألّفه نور
الدين عبد
الرحمن
الجامي، شَرَحَ
فيه كافيةَ
ابن الحاجب،
يسمّيه
الطلبة الأكراد
(مُلاَّ جامي).
23)
إيساغوجي:
كتاب صغبر
الحجمِ في
المنطق، ألّفه
أسير الدين
المفضّل بن
عمر الأبهري.
24)
حُسَمْكَاتي:
كتابٌ متوسط
الحجمِ، وهو
شَرْحُ كتابِ
المسمّى
(أيساغوجي)،
مؤلّفه
مجهولٌ.
25) قولُ
أحمد: كتاب في
علم المنطق،
ألّفه أحمد بن
محمّد بن
الخضر.
26) حاشيةُ
عبد الغفور:
كَتَبَهُ عبد
الغفور
اللاّريُّ،
تَنَاوَلَ
فيه بعضَ
المسائِلِ من
كتابِ
الفوائد الضيائيةِ
لأستاذِهِ
نور الدين عبد
الرحمن الجامي
لِحلِّ
عويصاتِها.
27) رسالةُ
الوضع: كتابُ
في علم
الدلالةِ،
ألّفه القاضي
عبد الرحمن بن
أحمد بن عبد
الغفور عضد
الدين الإيجي.
28) رسالة
الإستعارة:
مؤلِّفُهُ
عصام الدين بن
ابراهيم. وقد
يحلّ محلَّ
هذه الرسالةِ
في بعض
المدارسِ
كتابُ استعارة
الليس
السمرقندي.
29) رسالة
المناظرةِ:
لمحمد بن على
الاحسائي. غير
أن
النقشبنديّين
قد اسقطوا هذا
الكتابَ منذ
سنين من
البرامج
الدراسية.
30) شرح الشمسيةِ
في المنطقِ:
ألّفه محمود
بن محمّد
الرازي
تَنَاوَلَ
فيه كتاب
الشمسيةِ
لنجم الدين بن
على القزويني.
31) مختصر
المعاني:
كتابٌ في
البلاغةِ من
تأليفات سعد
الدين بن
مسعود بن عمر
التافتازاني.
32) شرح
العقائد: كتاب
في العقيدة الإسلاميّة،
وهو أيضًا من
تأليفات سعد
الدين بن
مسعود بن عمر
التافتازاني.
33) جمع
الجوامع:
كتابٌ في أصول
الفقهِ،
ألّفهُ تاج
الدين عبد الوهّاب
بن علي
السُّبُكي (ت. 771هـ.)
يبدو
وبكل وضوح من
هذه القائمة،
أن النقشبنديّينَ
قد أسقطوا
جميع العلوم العقليّة
والتجربيّة
من المنهج
الدراسيّ في
مدارسهم،
فضربوا بها عُرْضَ
الْحَائِطِ، بل كرهوا
أن
يَتَنَاوَلَ
أحدٌ من
الطلبةِ في
مدارسهم
كتابًا يضمُّ
مادّةً من هذه
العلوم،
واشمئزّوا
مِنْ كلّ مَنْ
اقْتَرَحَ
عليهم أن
يسمحوا
بتدريسِ شيءٍ
من العقليات
كالحسابِ
والهندسةِ
والتاريخِ
والجعرافيا
والفَلَكِ
والفزياءِ
والكيمياءِ
والزراعةِ
والطبيعةِ
وغيرها من
العلوم
التجربيّة.
كما نقموا
ممّن اطلع على
عجزهم في
الكتابةِ
والنطقِ بالعربيّة
على الرغم من
توغّلهم في
حفظ قواعدها
طوال مدةٍ لا
تقلّ عن عشر
سنين!
إذًا فلا
يخفى أنّ هذه
النحلةَ
طائفةٌ متطرّفةٌ
تخالف كلّ ما
يُرْشِدُ إليهِ
العلمُ
والعقلُ
السليمُ
والكتابُ والسنةُ،
يبرهن على ذلك
استخفافهم
بعلماء الإسلامِ،
وانبهارهم
بالدراويش
المتزمّتين واهل
الشعوذة
الذين
يبالغون في
تعظيمهم بنعوتٍ
غربيةِ وصفات
ليس من
الإسلامِ في
شيءِ؛ كقولهم »قطب
العرفين،
وعوث
الواصلين،
وإمام المتّقين،
وتاج
الكاملين،
ونور
السماوات
والأرضين!«
إلى غير ذلك
من الكفرياتِ
والبدع
والأباطيل، وهذا
مبلغهم من
العلم...
الفصل
الخامس
* أثر
الطريقة النقشبنديّة
على الحياة الاجتماعيّة
والثقافيّة في
المناطق
الّتي
انتشرت فيها.
----------------------------------
* استغلال
السلطة
للنقشبنديّين
ضِدَّ الوهّابيّة........................................................................
* النـزاع
القائم بين
النقشبنديّين
والوهّابيّين
منذ قرنين وأَثَرُهُ
الهدّامُ على
الإسلام
والمسلمين........................................................................................................................................
* العلاقات
بين السلطة
والنقشبنديّين
في العهد
الجمهوريّ................................................
* الفِرَقُ
الرئيسة
للنقشبنديّين
في تركيا اليوم.........................................................................
* أهمُّ
الحركات السياسيّة
الّتي
استخدمتْ
السلطةُ
النقشبنديّين
في مقاومتها ..............
* تلفيقات
النقشبنديّين
في كثير من
أقوالهم ومواقفهم؛
وما جاء في
كلامهم من
ضروب
التعارض
والضعف.....................................................................................................................
* مقتطفات
من آرائهم
الّتي ادّعوا
أنها من الدين
ولا حجّةَ لهم
في إثباتها......................
* مسائل
متفرّقةٌ
اختلفوا فيها
اختلافًا صريحًا،
بحيث جاء مقال
بعضهم
تكذيبًا
لبعضهم الآخر؛
وكذلك أقوال
بعضهم فيهاتضادٌّ
وتناقض
للقائل نفسه......................................
* أمثلة
من معاداة
النقشبنديّين
فيما بينهم، ومناهضتهم
وتباغضهم
وتشنيع بعضهم على
البعض..........................................................................................................................................
* أسلوب
المعارضة عند
النقشبنديّين....................................................................................
* الكلمة
الختامية.......................................................................................................................
*
إجاباتٌ
وتوضيحاتٌ على
التقرير
الصادر من
جامعة أم
القرى بِشأن
هذا الكتاب: ....

الفصل
الخامس
* أثر
الطريقة النقشبنديّة
على الحياة الاجتماعيّة
والثقافيّة
في المناطق
الّتي
انتشرت فيها.
لقد
ظهرت آثار
الحركة النقشبنديّة
على الحياة الاجتماعيّة
والثقافيّة
في جميع أنحاء
تركيا
تقريبًا،
ولكنّها
اكتسبتْ
أبعادًا
وأشكالاً
متنوّعةً
ومعقَّدَةً
في مضمونها،
كنتيجةٍ
أسفرتْ عن
علاقاتٍ
مُخْتَلَقَةٍ
بين مفاهيم
الدين والسياسة
والمصلحة.
لا
نقصد بهذا أنّ
شيوخ الطريقة النقشبنديّة
يتاجرون
بالدين
مباشرةً. بل
الحقيقة عكس
ذلك. وإنّما
يمثّلهم بعض
السماسرة في
هذه الأغراض.
لأنّهم لا
يمتازون
بلباقةٍ
ومهارةٍ
ودهاءٍ
تُمكِّنهم من
احتكار الدين
في سبيل
المصالح؛ ولا
يسمح
لإقدامهم على
ذلك مركزُهُمُ
المقدَّسُ في
نظر
المعتقدين
بهم، حتّى ولو
أثارهم الطّمع
على احتكار
الدين والاتّجار
بالقِيَم
المقدّسة. بل
خمولهم
يواريهم عن
كثير من حقائق
الحياة
وأشكال
التعامل؛ صالحها
وفاسدها. ولكنّ
الأحزابَ السياسيّة
جميعَها، وَجِهَازَ
المخابرات، وعددًا
كبيرًا من
الشركات
العالميّة،
وكثيرًا من
رجال العمل يستغلّون
شهرتهم؛
فتنعكس بذلك
آراء شيوخ الطريقة
على أعمال
تجمّعات
سياسيّة
وتجاريّة. بل
تظهر آثارها
الملفّقة على
نتائج تلك الأعمال
بسلبيّاتها
وخطورتها على
الإسلام
والمسلمين.
تتأكّد
الإشارة هنا
إلى أنّ الروح
الصوفيّ الراسخ
في ضمير
العنصر
التركيّ،
يصدّه دائمًا
عن النظر إلى
حقائق الكون
والحياة والأحداث
والتطوّرات
من المنظور
القرآني الواضح
البرّاق
والمباشر؛
فيأبى إلاّ أن
تكون نظرته
متلبّسةً
بتعليق أو
تفسير أو
تأويل يحمله
على التقليد
ويصرفه عن
إبداء الرأي
النابع من
الفطرة. تلك
الميّزة كانت
ولا تزال
تلازم هذا
العنصر
قديمًا وحديثًا.
فلمّا بدأ التّيّار
النقشبنديّ
يسيطر على
ضمير هذا
العنصر منذ
بداية القرن
الماضي،
ازدادت تلك
النـزعة فيه
تصلُّبًا
وشدّةً،
فانعكست
آثارها على جميع
تصوّراته
وأفعاله،
بحيث لو نظرتَ
إلى أحد منهم
قد خلع ربقةَ النقشبنديّة
من عنقه، حتّى
هو بالذّات تراه
لا يزال
مجبولاً
عليها، لا
يبرح يتصوّر كلّ
شيءٍ بدافع ما
بقيتْ من
تأثيرات هذه
الطريقةِ في
أعماقِ ضميره
والمتغلّبة
الدامغة على كلّ
مجالٍ من
حياته.
وكمثال
حيٍّ على ذلك:
فانّ أعضاء
منظمة النور،
أكثرهم منشقّون
عن الطريقة النقشبنديّة،
ويدافعون عن
حركة النور
بأنّها ليستْ
طريقةً صوفيّةً
كما جاء في
قرارٍ صادرٍ
من اللجنة
الاستشارية
للرقابة على
الكتب الدينيّة
التابعة
لرئاسة الشؤون
الدينيّة
بتاريخ 29/06/1963م. تحت
رقم/326. هذا
نصّه:
»إنّ
حركة النور
ليستْ طريقةً
صوفيّةً، ولا
مذهبًا
اجتهاديًّا.
وإنما هي حركة
متمثّلة في
متابعةِ
رسائلَ كتبها
شخصٌ اسمه
سعيد النورسي
دفاعًا عن
الإيمان من
خلال آيات
قرآنية في
مواجهة التّيّارِ
اللاّدينيِّ
الّذي ظهر
ينتشر في
الآونة الأخيرة«.
على
الرغم من هذه
التصريحات،
فان حركة
النور تيّارٌ
عرفانيٌّ،
شبيهٌ بطريقةٍ
صوفيّةٍ،
فضلاً عن أنّ
أعضاءَ هذه
الحركة - سوى
عدد قليل
جدًّا - لا
يختلفون عن
النقشبنديّين
قيد شعرةٍ في
الاحترام
لمشائخ هذه
الطريقة
والاعتراف بتعاليمها.
وما
هو أشدّ
غرابةً، بل
أشدّ خطورةً
من ذلك، أن
الشيخ سعيد
النورسي
الّذي استطاع
بدهائه أن
يتخلّص من
الطريقة النقشبنديّة
بعد مرحلة
شبابه وتبرّأ
عما قاله قبل
الخمسينات،
فتمكّن بفضل
هذه الصحوة من
القيام بحركةٍ
نضاليةٍ في
مواجهة يهود
سالونيك طوال
حياته؛ لم
ينجُ هو الآخر
من أن يتحوّل
اسمه بعد موته
رمزًا يتاجر
به تلاميذه في
تحقيق أهداف
منظمتهم (حركة
النور)، إلى
حد أنّهم لم
يتورّعوا من
تحريف
كلماته،
والتقوّل على
لسانه،
وإشاعةِ ما
تبرّأ عنه من
رسائله الّتي
أمر
بإتلافها،
حتّى أنزلوه
منـزلةَ رجلٍ
من
الروحانيّين!
لم يفعلوا ذلك
إلاّ لأنّ
حركتهم
امتداد
للطريقة النقشبنديّة
خاصّة فانّ
أعضاء
الطريقة »الْعَجْزمَنْدِيَّةِ«
الّذين
أضافوا إلى
موكب
الصوفيّة
طريقة جديدة
أخرى، وزعموا
أنّهم على
مشرب سعيد
النورسيّ، فإنّهم
أيضًا يقيمون
طقوسًا فيها
الرقص والاهتزاز
والجيشان،
انطلاقاً من
تلك الآثار
الباطنيّة
المتبقّية في
قرارة نفوسهم
والموروثة من
أسلافهم النقشبنديّين.
إنّ
القسطاس
الّذي يحدّد
أبعاد مفهوم
الدين،
ودوره، ومدى
صلاحيته في
مُعْتَقَدِ
الأتراك، هو
التصوّف. ولم
يختلف هذا
القسطاس عند
أكثرهم منذ
اعتناقهم
للإسلام إلى
الوقت الحاضر.
لقد طبّعتهم
الطرائق الصوفيّة
على هذه
النـزعة منذ
القديم؛ فكانت
الطريقة
المولويّة
والقادريّة
والرفاعيّة
والخلوتيّة
والبكتاشيّة
في مقدّمة
الحركات
الصوفيّة
الّتي تأثّر بها
الأتراك. فكان
فهمهم
للإسلام،
وتعاملهم معه
من خلال نُظُمِ
هذه الطّرائق وآدابها
إلى أواخر
العهد
العثمانيّ.
فلمّا قفزتْ
الطريقة النقشبنديّة
من الهند إلى
الديار العثمانيّة
وبدأتْ تنتشر
فيها منذ عام 1811م. سادتْ بعد
ذلك آثارُ هذه
الطريقة على
روح الناس وانعكستْ
إلهاماتُها
على فهمهم
وسلوكهم
وتعاملهم بصورة
واضحة.
إنّ
أهمَّ آثار
الطريقة النقشبنديّة
على عقليّة
المجتمع
وسلوكه،
وأشدَّها
خطرًا على
الإسلام في
تركيا ينحصر
في نزعة غريبة
ابتلى بها
أكثر الناس في
هذا البلد.
وأصبحت
مشكلةً
أخلاقيةً واجتماعيةً
عويصةً
جدًّا، قد
يؤدّي إلى تضليلٍ
شاملٍ، وإلى
إفساد بقيّة
القِيَمِ،
وإثارةِ فتنٍ
تتعاقبها
تطوّراتٌ لا
إمكان لتحديدها
وتقدير
نطاقها
ونتائجها في
هذه الآونة.
ألا وهي نزعةٌ
تتمثّلُ في
اختلاق شخصيّة
موهومة تُنْصَبُ
كأسطورة،
يبدأ الناس
بالطواف حولها
لما يرسخ في
ذهنهم أنّها
محطّ عظمةٍ
وإجلال،
وينتشر ذكرها
في العالمين.
لذا،
فمن حظي بشيءٍ
من ثناء الناس
ولو بِدِعَايةٍ
كاذبةٍ تواطأ
قومٌ على
نشرها
واستغلال تلك
الشهرة التي
صنعوها فيما
بعد، - حتّى
ولو كان لصًّا
أو فاجرًا
سرعان ما
اجتمع الرعاع
والأوغاد حول
تلك الشخصيّة
المختلقة،
على أنّها من
الأولياءِ
المؤيَّدين بالكرامات
وعلم الغيب
والزلفى إلى
الله تعالى،
وذهب صيته
وأصبح قطب
الفلك في
معتقد أهل
البلد بأسرهم !!!
ولهذا
أول ما
تتوسّلُ به
الأحزابُ السياسيّة،
والجمعياتُ
والشركاتُ،
وحتّى
العصاباتُ والمافيا
في تحقيق
أهدافها، هو
الإقدام على خَلْقِ
شخصيّة
تُعَظِّمُهَا
الناس وتبذل
ما في وسعها في
سبيلها.
هذه
المشكلة
أسفرت عن
نتائج خطيرة
كثيفة ومتكرّرة
بطرق غير
مباشرة،
تنوّعت حسب
الظروف والأسباب
بين صراع
وقتال، إلى
جنايات
وثورات
شهدتها ساحة
هذه المنطقة
منذ مائة
وخمسين عامًا.
نقتصر على عدد
منها لتظهر بها
كيف تفاعلت
آثار الطريقة النقشبنديّة
في أشكال من
أزمات
اجتماعية
وأخلاقيّة
أدّتْ في
النهاية إلى
تدهور كبير في
اقتصاد البلد،
وتشوّشٍ رهيب
في المجال
الثقافيِّ
والعلميِّ والإجتماعيِّ.
أوّل
ما نلمس من
هذه الحقيقة
بصورة
مباشرة، هو
التنافس
المتضاعف بين
شيوخٍ
(نَصَبَهُمْ
جهاز
المخابرات التركيّة)
وبين شيوخ الطريقة
النقشبنديّة التقليديّين
على توسيع
نطاق الشهرة
والإكثار من
المريدين
والبطانة
والأنصار. الفئة
الأولى هم
عملاء النظام
والّذِينَ
يثيرونَ هذا
التنافس
تارةً بسبب مصالح
شخصيّة، وتارةً
بإيعاز من
الجهات
الْمُوَجِّهَةِ،
فيفتحون
أبواب
المشاكل على
منافسيهم من
التقليديّينَ،
كما مرّ في
بحث النـزاع
بين الأسرة
الأرواسيّة
والكُفْرَويّةِ.
وما يجري من
التطوّرات
والمنافسة
بين الشيوخ في
هذه المرحلة،
لهو أشدّ
خطورةً منه
على الإسلام
والمسلمين
مما قد جرى في
السابق.
ذلك
ومن عادات
مريديهم: أنّ كلّ
فريق منهم
يقوم
بالدعاية
لشيخه، ولا تدّخر
طائفةٌ منهم
وسعًا في هذه
المحاولة؛
فتتسابق
الأقلام،
وتتفنّن
اللّسُنُ في
اختلاق الكرامات،
وعدّ
الفضائل،
ووصف الشمائل.
كلّ يبذل
جهودَه
ليُقْنِعَ
الناس، حتّى
يعتقدوا أنّ
شيخَه »يفعل
ما يشاء ويحكم
ما يريد؛
ويغفر لمن
يشاء ويعذّبُ
من يشاء، وهو
على كلّ شيء
قدير«! وهذا
مِمَّا يزيد
الطين بلّة.
لقد
بلغ حجم الكتب
الّتي استفرغ
النقشبنديّون
في بطونها من
صِيَغِ
التعظيم والإجلال
والتوقير
لشيوخهم
بدافع
المنافسة - إلى
حدود، يعجز
الإنسان عن
ضبطها
واستيعابها.
فلو لم
يتأكّدوا من
موافقة
شيوخهم على
ذلك، لما أقدم
أحد منهم على
كتابة لفظ
واحد فما فوقه
من هذه
الصِيَغِ الّتي
يقشعرُّ منها
جلد المؤمن
بوحدانية الربّ
سبحانه،
وبخسّة شأن الإنسان
بالنسبة إلى
عظمة الله
العزيز
المتعال.
وعلى
سبيل المثال،
جاء في دُعاءِ
فريقٍ من النقشبنديّين
الأكراد
ألفاظٌ مقتَبَسةٌ
من آيةٍ، يصفون
بها شيخًا من
شيوخهم؛
يردِّدونَها
فيقولون »نور
السماوات
والأرضين« على
سبيل النّعتِ
له، والله
تعالى قد خصها
لنفسه أن توصَف
هي بها على
انفراد بذاته دون
غيره، فقد قال
سبحانه {اللهُ
نُورُ السمَاوَاتِ
وَاْلأَرْضِ.}.[517]
هذه
الغطرسة قد
جعلتهم
يتسابقون
بأساليب فرعونية
تنعكس
نتائجها السلبيّة
على المجتمع،
فتسري في الناس
روح التنافس
على استغلال
الضمائر،
وتسخير بعضهم
البعض لتحقيق
الآمال
والمصالح
الشخصيّة؛
فيتطوّرُ
النـزاع بينهم
ويتصاعد،
وأحيانًا
يتحوّل إلى
فتن يذهب
ضحيتها من
الأموال
والأرواح ما
لا يحصى. كما
حدثت أثناء ثورة الشيخ سعيد اﻟﭙﺎلوي عام 1924م.
ذلك
أنّ الشيخ
سعيدًا كان قد
دعا جميع شيوخ
المنطقة أن
يتعاونوا
معه، وأن يشاركَهُ
كلّ منهم
بتجنيد
مريديه،
وتعزيز جيوش
الثورة بإمكاناته
المالية
والبشرية. فلم
يقم أحدٌ بتلبيته
إلاّ عددًا
قليلاً كانوا
على مقربة من
ساحته. فلم
يسعهم إلاّ أن
يجيبوه مع
الكراهية.
ومن
الأهمّية
بمكان، أنّ
شيوخ الطريقة النقشبنديّة
بالمنطقة
الكرديّة، لم
يرفضوا دعوةَ الشيخ سعيد
اﻟﭙﺎلوي
(النقشبنديّ)
إلا لأنّهم
كانوا
ينافسونه في توسيع
نطاق شهرتهم، وعدد
منهم كانوا
عملاء
للنّظام.
ولهذا لم يكن
أحدهم مخلصًا
للآخر؛ وربما
تمنّى جميعهم أن يسقط
الشيخ سعيد
اﻟﭙﺎلوي مغلوبًا على
أمره أمام
يهود سالونيك
لأنّ كلّ
واحدٍ منهم كان
يراه عقبةً
تُقَلِّصُ من
ساحة نشاطه
ويخسر بها من
شهرته
ومصالحه!
وإلاّ كان
جميعُ شيوخ النقشبنديّة
ضدّ النظام
اليهوديِّ
الحاكم. ولكن
الّذي كان في
قلوبهم من
التباغض
والتنافر،
اعترض سبيلَ
الشيخ سعيد
البالوى فحلّ
دون آماله؛
كما شملتهم
النكبةُ في
الوقت ذاته،
فتمكنتْ منهم
العصابة
الحاكمة من
يهود
سالونيك،
فأخرجوهم من
ديارهم
وأموالهم،
فقُتِلَ منهم
من قُتِلَ،
وأُبْعِدَ
منهم من
أُبْعِدَ
سنين عددًا.
ثم
لم تقتصر
الداهية على
شيوخ النقشبنديّة
وعائلاتهم
فحسب، بل
شملتْ قبائلَ
الأكراد بأسرها؛
فنُصِبتْ
المشانقُ في
مدينة دياربكر
فجرَ يوم 29/يونيو/1925م.
وزحفت الجيوش
على قرى
المنطقةِ
ترتكب المجازر
وتستبيح
الحارم مدة
ستة أشهر من
بداية شهر
يوليو/1925م.
إلى نهاية
السّنّة.
فأسفرتْ هذه
الحركةُ الإجرامية
عن إزهاق ستةٍ
وثلاثين
ألفًا من الأرواح
(تقريبًا) من
سكان المنطقة
بما فيهم الأطفال
والشيوخ
والنساء
والمرضى
العازلين عن
السلاح تمامًا.
بالإضافة إلى
إحراق عشرات
آلافٍ من الكتب!
كانت
المأساة هذه
لاشكّ نتيجةً
رهيبةً ومصيبةً
داميةً
تمخّضت عن فعل
شيوخ النقشبنديّة
وحرصهم على
الدنيا
وصراعهم على
حطامها؛ كما كانت
في الوقت ذاته
نتيجة جهلهم
بطرق التعامل
السليم مع
الناس؛ وعدم
معرفتهم
بأسرار الاستعداد
لمواجهة
العدوِّ؛
وأساليب
التعبئة والقتال؛
فضلاً عن
جهلهم بدقائق
الحيل الحربية
والمناورات.
لأنّهم
كانوا في
الحقيقة
جهلةً بأمور
الدنيا
والآخرة. فلم
تكن
مُدارستُهم
لبعض العلوم عن
فهمٍ وإطّلاعٍ
ورويّةٍ. ذلك
أنّ المدارس الخالديّة
الّتي انتشرت
في المنطقة
الكرديّة منذ
بداية القرن
الماضي، كانت
الدراسةُ
فيها ضعيفةً جدًّا
(باستثناءِ
فروعها
التابعة
لجامعة الزهراء).
كان هؤلاء
الشيوخ يَدْرُسُونَ
ركامًا من كتب
التراث،
معظمها شروح
مطوّلة في
الصرف والنحو.
فكانوا
يباشرون هذه
الدراسة دون
سابق معرفةٍ
بأدنى شيء من
اللّغة العربيّة،
ومن غير
استعداد لها
بدراسة
تحضيرية
مثلاً تحت
إشراف مدرّسٍ
عربيٍّ. كانوا
يحفظون المتون
كما يُحفَظُ
القرآن!
كألفية محمّد
بن عبد الله
بن مالك
الطائي،
ومقدّمة
الأجرومية
لابن آجُرُّومِ
الفاسي، ومتن
قطر الندى
لأبي محمّد
عبد الله جمال
الدين بن يوسف
بن أحمد بن
عبد الله بن
هشام وغيرها؛
ويتخرّجون في هذه
المدارس بعد
مدّة طويلة من
الدراسة لا
تقل عن خمسة
عشر عامًا. ومع
ذلك كانوا ولا
يزال البقيّة
منهم يجهلون
الكتابةَ
والنطقَ بالعربيّة
تمامًا؛ كما
أنّهم لا
يدرسون أدنى
شيء من العلوم
والفنون،
كالفيزياءِ
والكيمياءِ
والحساب
والهندسة
وعلم
الأحياءِ
والفلسفة
والتاريخ
والجغرافية
وفروعها في
مدارسهم!
ولهذا
لم يحظ أحدهم
بشيءٍ من
سعادة
الاشتراك مع
علماء
الإسلام في
أيّ محاضرة
علمية؛ ولا حتّى
ألقى السمعَ
إلى أخبار
ندوة من
الندوات الأكاديمية
الّتي تُقامُ
في جامعات
البلاد بين
الفينة
والأخرى؛ ولا
حضر أحدهم
مهرجانًا من
المهرجانات الثقافيّة
أصلا؛ ولم
يشهد أحدٌ
شيخًا من شيوخ
النقشبنديّة
(خاصّة في
المنطقة
الكرديّة
بتُركيا) أنّه
تناولَ يومًا
من الأيّام
صحيفةً أو
مجلّةً للأنباء،
فاهتمَّ بشيءٍ
ورد فيها من
أخبار ما
يتعرّض له
المسلمون من
الإضطهادِ
والقمعِ
والإبادةِ في
مختلف أنحاء
العالم. بينما
وجدنا منهم من
أفنى عمرَهُ بحماقةٍ
في محاولة
تصحيح
المخارج
للحروف زعمًا
منه أنّ غالب
الناس
يُخطؤون في
النطق بالضاد
والقاف
والطاء! كلّ
ذلك بسبب
الفقر العلميِّ
والثقافيِّ
الّذي يعانون
منه؛ هذا،
بالإضافة إلى
ما قد ابتلوا
به من العزلة
والخمول
واحتقار أهل
العلم. وهم في
الحقيقة
عاجزون عن
الإجابة
بصيغة علمية واضحة
ومُقْنِعَةٍ،
على سؤالٍ قد
يُوَجَّهُ إليهم؛
ولا يجدون
مهربًا من
المواجهة
إلاّ أن
يزيّنوا
للناس سكوتهم
على أنّه
شعارهم. فلا
يقتنع طبعًا
بمثل هذا
الإعتذار
الواهي إلاّ
الّذين
حُشِروا
حولهم من
حثالة الناس وهوامّ
العوامّ.
غير
أن موقفهم هذا
من العلم
وأهله، وإن
كان يُعَدُّ
من العار في
اعتبار
العلماء
والمتفتحين
والمثقَّفين،
ولكن الطبقة
التابعة لهم تعدّه
من علامات المروءة
والفضل
والوقار فيهم.
و هكذا تسري
سلبيّاتهم
إلى المجتمع
وتعمّ
البلايا.
إنّ
السلطة لم
تغفل عن أهميّة
القوة البشريّة
والماليّة
والإمكانات
الدعائيّة
الّتي يملكها
النقشبنديّون
منذ بداية انتشار
هذه الطريقة
إلى اليوم.
لذا جعلتهم
الحكومات
دائمًا نصب
عينها،
وترقّبتها
واستخدمتها
لدى كلّ فرصةٍ
في قضايا
خطيرة جدًا،
سواء في
المرحلة الأخيرة
من العهد
العثمانيّ، وإبّان
العهد
الجمهوريّ،
خاصّة بعد
العقد الثاني
من القرن
الجاري.
فانعكست
نتائج هذا
الواقع الخطير
على حياة
المجتمع
متمثّلةً في
نزعاتٍ وتموّجات
متعاكسة،
وحركات سياسيّة
متشاكسةٍ
انتهت في
الآونة
الأخيرة
بتمايز الفئات
الاجتماعيّة.
وإذا
أسقطنا مالا
يستحقُّ
ذكرُهُ من تلك
القضايا
الّتي لعب
النقشبنديّون
فيها دورهم
بإيعاز من
السلطة السياسيّة،
فانّ خمسًا
منها تَتَّسِمُ
بأهميةٍ
بالغةٍ، وهي:
1) الثورة الوهّابيّة
الّتي انفجرت
في المرحلة
الأخيرة من
العهد العثمانيّ
ودامت أكثر من
قرنٍ؛
2) النـزعة
الماركسيّة
والحركات
اليساريّة
التابعة لها
من بداية
العهد
الجمهوريّ
حتّى سقوط
الإمبراطورية
السوفيتيّة؛
3) الحركة
الإرهابيّة
الأرمنية
الّتي نكست
مجدّدًا من
بداية السبعينات؛
4) الحركة
الانفصاليّة
الكرديّة
الّتي ثارت في
المرحلة
نفسِها ودامت
حتّى الآن؛
5) الصحوة
الإسلاميّة
الّتي انتشرت
بدافع الثورة
الإيرانيّة
منذ عام 1979م.
كان
استغلال
النقشبنديّين
من قِبَلِ
الحكومات التركيّة
في القضايا
المذكورة
بصورة
مُعَقَّدَةٍ،
وبطرق غير
مباشرة. لذا،
لا يتأتىَّ
لكلِّ باحثٍ
أن يطّلع على
دقائق هذا
التعامل
الخطير! وقد
جاء هذا
الاستغلال في كلّ
قضية من
القضايا
المذكورة
بنتيجة
متباينة عن
التجارب
الأخرى.
ولكي
يبدو الأمر في
نسبة معينة من
الوضوح، يناسب
هنا أنْ
نتناول كلّ
قضية منها على
حدة، وندرسَ
ما قد أسفر عن
استغلال
السلطة لتلك
الطائفة من
تأثيرات
وأحداث في كلّ
منها.
***
*
استغلال
السلطة
للنقشبنديّين
ضِدَّ الوهّابيّة.
لقد
كان للطريقة النقشبنديّة
تأثثيرٌ
عميقٌ في نفوس
الأتراك
والأكراد السنّيّين
وهم قوام
المجتمع
العثمانيّ
يومئذٍ؛ وكان
لشيوخ هذه
الطريقة مكانةٌ
مرموقةٌ بين
الطائفتين،
وهما أشدّ ثقةً
بآل عثمان
الأسرة
المالكة،
وأكثر
إنتماءً للدّولة
العثمانيّة.
فكان من نتائج
هذا الواقع أن
مارست الدولة العثمانيّة
سياسة
الإحتكار
للقوّة
الكامنة في
التجمّعات النقشبنديّة
عبر قنواتٍ
خاصّة سلكتها
في تأسيس
العلاقة معها.
فما لبث حتّى
استغلّت
الدولةُ هذه
التجمّعات
وجنّدتها في
تحقيق أغراضٍ
خطيرةٍ
جدًّا، فأثارت
النقشبنديّين
ضدّ الوهّابيّين
الّذين كانوا
قد شقّوا عصى
الطاعة
وانتفضوا ضدّ
السلطة العثمانيّة
في الجزيرة العربيّة.
هذه
المسألةُ في
الحقيقة أمر
خطير ذات وجوه
متعدّدة لم
يطّلع على
حقيقته كثير
من الباحثين
لأسباب ليس
هذا مقام
سردها. ولكنّ
الّذي يجب
الإشارة إليه
حتمًا: أنّ
استخدامَ
السلطاتِ العثمانيّة
هذه الطائفةَ
في مقاومةِ ثورة
الوهّابيّين -
لم يثبت بصورة
موثّقة - أن
كان
استخدامًا
مسلّحًا...
اللهم إلاّ أن
يكون بعض
النقشبنديّين
من الأتراك
المدنيّين،
أو جماعات
منهم قد
تطوّعوا
بالانخراط في صفوف
الجنود
المكلَّفة
بإخماد تلك
الثورة، بإيعازٍ
من بعض شيوخ
هذه الطائفة
(كما ذاع في بعض
الجهات.) فانّ
أمثال هذه
الروايات،
إسنادها
منقطع.
أمّا
كون قيامها
باستخدامهم
في مجال
الدعاية ضد الوهّابيّين،
فانّ ذلك أظهر
من الشمس في رابعة
النهار. ولا
يحتاج أمرؤٌ
أن يُكلِّفَ
نفسَه عناءَ
البحث عن
دليلٍ على ذلك
لكثرتها. ومن
أوائل هذه
البراهين،
كتاب خالد
البغداديّ
الّذي ردّ به
على خطابٍ
تلقّاه من عبد
القادر الحيدريّ،
إذ يعبّر
البغداديّ
فيه عن منتهى
ابتهاجه
بغلبة القوّات
العثمانيّة
على الثوار الوهّابيّين
عام 1233هـ./1818م. كما مر
ذكره[518]
فتعبيره عن
القوّات العثمانيّة
بـ »عساكر
الإسلام« دليل
قاطع على إنّه
مع الجماهير
الغفيرة
التابعة له من
النقشبنديّين
كانوا
مكلّفين
بنشاطات
دعائية كثيفة ضد
الوهّابيّين؛
وأنّ الوهّابيّين
في نظرهم
طائفة باغية
يجب قتالهم
وقمهم وإبادتهم
عن بكرة
أبيهم!
ومن
أواخر هذه
البراهين
وأظهرها
وأشدّها تأثيرًا،
وأكثرها
انتشارًا:
نشاطات
تضليليّة
كثيفة يقوم
بها ضابط
عسكري متقاعد
برتبة عقيدٍ[519]
متخصّصٌ في
العلوم
الصيدلية،
مدعومٌ من
قِبَلِ جهازٍ
معيّنٍ،
ومدسوسٌ في
صفوف
النقشبنديّين
منذ بداية
العهد
الجمهوريّ. اتّصل
هذا الرجل
بالشيخ عبد
الحكيم
الأرواسيّ الّذي
كان قد هاجر
إلى مدينة
إسطنبول عام 1919م. فأصبح من
المقرّبين
إليه، وتمكّن
من الإطّلاع
على أسرار
النقشبنديّين
خلال المدة
الّتي قضاها
في صحبته. ثم حلّ
محلّه بعد
موته عام 1943م.، فاستطاع
بذلك أن يقوم
بتوجيه
جماهير النقشبنديّة
حسب
الاتجاهات
الّتي حدّدها
له الجهاز
المعهود.
فكَتَبَ
رسائلَ جمةً
في هذه الأغراض،
كما جمع
أعدادًا من
كُتُبِ
الخالديّين
ورسائلهم
فطبعها
ونشرها عن
طريق مكتبتين[520]
في إسطنبول؛
يشرف عليهما
أعوانُهُ،
وتُمَوِّلُهَا
شركةٌ
مهيمنةٌ
ضخمةٌ.[521]
غالبها في
مثالب الوهّابيّين
والتشنيع عليهم
وشتمهم
ورميهم
بالكفر
والزندقة.
ومن
الأهمية
بمكان، أنّ
هذا الرجل
استطاع أن ينجو
من سلبيات
التعامل مع
الحكومات التركيّة
ذات الاتجاه
المزدوج عبر
العهد
الجمهوريّ. لأنّ
الحكومات التركيّة
تعاني دائمًا
من اضطراب
شديد وعجز
بالغ في تحديد
سياستها
الداخلية
والخارجية
على السواء.
فهي في صراع
متواصل مع
نفسها، بسبب
اختلاف تكوُّنها
من عناصر لا
يشتركون إلاّ
في اللّغة. »تحسبهم
جميعً
وقلوبهم شتّى«.
تنحصر
مهمّةُ هذا
العسكريِّ
المتشيّخِ
على تأصيل
مقوّمات
العقيدة التقليديّة
للأتراك
العثمانيّين،
وبعث الروح
(التركيّ العظيم
= Megaloturc) في
نفوس الناشئة،
على الرغم من
معارضة
المافيا
المتحكّم في تحديد
سياسة الدولة
وتوجيه
الحكومة.
وربما في ذلك
سرٌّ لا
نعلمه.
هذه
المقوّمات
الّتي هي
بمنـزلة
أركان
الأيمان عند
النقشبنديّين
الأتراك،
تتمثّلُ في
ستة أمورٍ
أساسيةٍ
(بالاختصار)،
وهي:
1) تقديسُ
الدولة العثمانيّة،
وسلاطين بني
عثمان،
والاعتقادُ
بأنّهم جميعًا
أولياء الله
وخاصّتُهُ؛
وعدم الخوض في
نزاعهم على
السلطة، وفي
جناياتهم،
والسفَهِ
الّذي كان يتّصف
به بعضهم..
2) الاعتقاد
بأن أولياء
الله ينصرون
الجيوشَ التركيّة
في كلّ معركة
تخوضها،
ويحضرون مع كلّ
طليعةٍ منـها؛
»كما
نصروهم في
كوريا وقبرص« في
العهد
الجمهوريّ.
ومعنى ذلك أنّ
الجمهوريّةَ التركيّة
امتدادٌ
للإمبراطورية
العثمانيّة،
ورمزٌ
مقدَّسٌ
لتاريخ الأمّة
التركيّة؛
تحمل مسئولية
تمثيل
الأمجاد لهذا
التاريخ إلى
يوم القيامة!
3) الاعتقاد
بأن الوهّابيّين
خاصّة،
والعربَ
جميعًا هم
عصاةٌ جناةٌ،
أهل البغي،
خارجون على
الدولة العثمانيّة
- الدولة
المقدّسة التي
كان للعرب
عامّةً وللوهّابيّين
على وجه
الخصوص دورٌ
كبير في
سقوطها-.
4) الاعتقاد
بأنّ الشيعة
على اختلاف
مذاهبهم ملحدون
خارجون عن
الإسلام
لموقفهم
السلبيِّ من
الدولة العثمانيّة
بعد الحرب
الّتي وقعت
بين السلطان
سليم الأوّل
والشاه
إسماعيل
الصفويِّ، والتي
انتهت
بانتصار
القوات العثمانيّة
على الجيش
الإيراني عام 1514م.
5) الاعتقاد
بأنّ
الصوفيّة
الّذين
أُدرجت أسماؤهم
في القائمة
البيضاء، هم
أولياء الله
وصفوتُهُ من عباده،
تُرجىَ شفاعتُهم،
ويجب التوسّل
بهم،
والتبرّك
بقبورهم. ذلك
لأنّهم
ينوبون عن
الله
بالتصرّف على
الكون (في
اعتقادهم).
والقائمة
البيضاء، هي
"موسوعة مقدّسة"
(في اعتقادهم
أيضًا).
وشهيرةٌ
بينهم؛
أصدرتها مؤسّسةٌ
وقفيةٌ يُشرف
عليها العقيد
المشار إليه
آنفًا،
وتُمَوِّلُها
شركة عالمية
عملاقةٌ
للنقشبنديّين؛
تشترك في
الاسم مع
المؤسّسة
الوقفية
المذكورة،
ويشرف علي هذه
الشركة صهر
العقيد الّذي
مرّ ذكرُهُ.
6) الاعتقاد
بأنّ المذهب
الحنفيَّ
(الّذي تتعصّب
له الغالبيّة
العظمى من
الأتراك
السنّيّين)
أفضل المذاهب الإسلاميّة؛
وأبو حنيفة »هو الإمام
الأعظم«! ذلك
لأنّه غير
عربيّ
الأصلِ،
وأنّه قتيل
العرب
العبّاسيّين.
وعلى كلّ، له
ولمذهبه
الأفضليةُ في
الفقه
التطبيقيِّ؛
أدناه،
أولوية الشخص
الحنفيِّ
بالإمامة على
غيره من تابعي
المذاهب
الثلاثة، ولو
كان هو أميًّا
وغيره من أهل
العلم.
لا
شكّ في أنّ
أعدادًا
كبيرةً من
الناس
معرَّضون
لهذه الدعايات
المتطرّفةِ
ومتأثرون بها.
ولكن يتحتّم
هنا الإعلان
بحقيقة أخرى.
ألا وهي أنّ
صفوةً من شباب
الأتراك، قد استطاعوا
بتوفيقٍ من
الله سبحانه
أنْ يهتدوا
إلى التوحيد
الخالص،
والإيمان
العميق
واليقين
الصادق بالكتاب
والسّنّة؛
وباتّباع
النبيّ r
وبمحبّة
الصحابة
والتابعين
لهم بإحسان
رضي الله عنهم
أجمعين. وذلك
عن فهم صحيح،
و وعيٍ تامٍّ؛
مستعدّين
لتحقيق الهدف
المنشود
بالعمل
الصالح
والسلوك
المثاليِّ
الرفيع. لقد
عاهدوا الله،
لَيَنْصُرَنَّ
دينه الّذي
ارتضى لهم،
ولَيَثْبُتَنَّ
في نضالهم
وجهادهم حتّى
يعودَ لهذه
الأمّةِ
مجدُها إنْ
شاء الله،
آمنين
متوكّلين على
الله سائرين
على جادة الحق
بإقدامٍ جريءٍ
ويقظةٍ
بالغةٍ وحذرٍ
دقيقٍ؛ منقادين
إليه تعالى
بالطاعة
والإحسان
والإخلاص والتقوى؛
وبالاجتناب
عن كلّ ما
حرّمه الله من
سائر
المعاصي،
وكافة أنواع البدع
والخرافات
والتطرّف
والعنف
والحماقات. لا
يخافون لومة
لائم ولا خشية
ظالم، يتقدمون
في مسيرتهم
بخطواتٍ
هادئةٍ وصبرٍ
وتبصّرٍ،
ويترقّبون
يومًا يهزم
الله فيه
الأحزاب!!!
{وَلَيَنْصُرَنَّ
اللهُ مَنْ
يَنْصُرُهُ
إِنَّ اللهَ
لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ}[522]
***
*
النـزاع
القائم بين
النقشبنديّين
والوهّابيّين
منذ قرنين
وأثره
الهدّام
على
الإسلام
والمسلمين.
كانت
السلطة العثمانيّة
في مرحلتها
الأخيرة قد
استخدمتْ
الطليعةَ
الأولى من
الفرقة الخالديّة
في نشر دعايات
كثيفة ضد الوهّابيّين؛
فأسفرتْ هذه
الدعاياتُ عن
نتائجَ غريبةٍ
ربما لم تكن
مما تقصده
السلطة العثمانيّة.
ومنها، أنّ
كلمة »الوهّابيِّ«
اتّسمتْ
بمعانٍ أخرى
فيما بعد، إلى
جانب ما كانت
في البداية صفةً
مجرّدةً
يُرادُ بها
الشخصُ
المعتنقُ
لعقيدة محمّد
بن عبد الوهّاب
النجديِّ
فحسب. بل
أكسبتها النقشبنديّة
أخيرًا معنى
الزنديق
المتطرّف،
والكافر الحربيِّ
وما أشبه!
ثم
تجاوز
المقصود بهذه
الكلمة
حدودَهُ عن الفرقة
الموصوفة بها
في السابق؛
فلم تقتصر التسمية
بها على أتباع
محمّد بن عبد
الوهّاب فحسب.
بل شملت كلّ
مَن دافع عن
التوحيد
الخالص،
وناهض الشرك،
وعمل على
إحباط بدع
القبوريّين.
هكذا تطورت كلمة
»الوهّابيّة«
بالمعاني
الّتي
أَلصقتْ بها
النقشبنديّون
الأتراك. ولكن
أغرب من هذا،
أنّها تحوّلت
في النهاية
إلى شبه مصطلح
يستعملها
حتّى العرب أنفسهم
(غير
الحجازيين)،
وإنْ لم يكن
ذلك على سبيل
التنقيص
والتشنيع.
هذا،
فلمّا انهارت
الدولة العثمانيّة،
كانت ثورة الوهّابيّة
قد انتهت
بالانتصار،
وانقلبت
جحافلهم إلى دولة
مستقلة إذا صح
(؟) ولكن الّذي
لم ينته بعد، هو
النـزاع
الّذي أحدثته
الأدمغة
المغسولة في مستنقعات
السنّية التركيّة
الرجعية
المنبثقة من العقليّة
التقليديّة؛
والمتمثلة في
تقديس الموتى
من
الروحانيين والملوك
والسلاطين.
في
الحقيقة لم
يكن هذا الحدث
في جوهره إلاّ
امتدادًا
للصّراع
التركيّ-العربيِّ
التاريخيِّ
على استغلال
الإسلام في
احتكار
السلطة وتحقيق
المصالح. لذا،
يتفرّع
الصراع
العثمانيّ الوهّابيُّ
(وبالأحرى،
النـزاع
النقشبنديّ
الوهّابيُّ)
يتفرّع أصلاً
من الصراع
التركيّ-العربيِّ،
ويختلف عنه
بميّزةٍ
دينية خاصّة.
وهي أنّ هذا
الخلاف يظهر
في صورة حرب
بين الشرك
والتوحيد. ذلك
أنّ مظاهر
الشرك كانت قد
سادت على أنحاء
المملكة العثمانيّة
جميعها بما
فيها أرض
الحجاز،
الأرض الّتي
نزلت فيها كلمات
الله تعالى
{إِنَّ اللهَ
لاَ يَغْفِرُ أَنْ
يُشْرَكَ
بِهِ
وَيَغْفِرُ
مَا دُوَن ذَلِكَ
لِمَنْ
يَشَاءُ
وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللهِ
فَقَدِ
افْتَرَى
إِثْمًا
عَظيِمًا.}.[523] تلك
المظاهر
البشعة كانت
تثير النفوس
المؤمنة
بالله وبسلطانه
وهيمنته وحده
على الكون؛
وتشحنها بالغيرة
والتمرّد
والخروج على
معاقل الشرك
في جميع أنحاء
البلاد، وليس
في الجزيرة العربيّة
فحسب.
ولكن
الّذين نهضوا
في ديار نجد،
وهم يدعون إلى
التوحيد
الخالص
ونَبْذِ
العبادة لغير الله
المتمثلة في
تقديس القبور
والاستغاثة بالموتى؛
لم يكونوا
يومئذ
متميّزين
بالكفاءة
المطلوبة
لإحياء
الرسالة المحمّديّة
بكلّ جوانبها الإيمانيّة
والعلميّة والعمليّة
والإصلاحيّة
والأخلاقية.
بل كانوا
بدواً،
أجلافًا وجُفَاةً.
لجئوا في
الغالب إلى
العنف والجبر
في كفاح البدع
والشرك
والخرافات.
فلم يتفكروا أنّ
ذلك الركام
الهائل من
أوساخ
العقائد الوثنيّة
الّتي تسرّبت
إلى الدين
الحنيف عبر
عصور الظلام،
لا يمكن
إزالته
بسرعةٍ؛ بل لم
يفطنوا إلى
الحقيقة
المكنونة في
قوله تعالى:
{اُدْعُ إِلىَ
سَبيِلِ
رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ
بِالّتي هِيَ
أَحْسَنُ
إِنَّ
رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ
سَبيِلِهِ
وَهُوَ
أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَديِنَ
* وَإِنْ
عَاقَبْتُمْ
فَعَاقِبُوا
بِمِثْلِ مَا
عُوقِبْتُمْ
بِهِ
وَلَئِنْ
صَبَرْتُمْ
لَهُوَ
خَيْرٌ
للصَابِرِينَ
* وَاصْبِرْ
وَمَا
صَبْرُكَ
إَلاَّ بِاللهَ
وَلاَ
تَحْزَنْ
عَلَيْهِمْ
وَلاَ تَكُنْ
فيِ ضَيْقٍ
مِمَّا
يَمْكُروُنَ *
إِنَّ الله مَعَ
الّذينَ
اتَّقَوْا
وَالّذينَ
هُمْ مُحْسِنُون.َ}[524]
كلّ
ذلك نشأ من
جهلهم بمدى
انتشار عقائد
الشرك ورسوخها
في المجتمع
العثمانيّ،
وأنّ القضاء
عليها أمر
يحتاج إلى
سعىٍ دؤوبٍ وإخلاصٍ
وعلمٍ
وسياسةٍ
ولباقةٍ
وخطّةٍ ودراسةٍ
وصبرٍ ومالٍ
ووقتٍ وعتادٍ
ورجالٍ! فضلاً
عن أنّ
السياسيّين
من قدماء الوهّابيّين
اختلفوا
يومئذ فيما
بينهم،
ودخلوا في
صراع شديد على
السلطة بجانب
قتالهم في
مواجهة قوات الحلف
المصري-العثمانيّ،
أسفرت تلك
الفتن عن إهدار
الدماء،
وتفاقم
الشقاق
واختفاء
الظروف الملائمة
لمهمّة
الدعوة
والإرشاد
والتبليغ إلى
التوحيد الخالص
والاتحاد
والإخاء.
هذا
ومن جانب آخر،
ازداد
النقشبنديّون
حقدًا
وضغينةً
وصولةً على الوهّابيّين،
بحكم الدعم
الّذي كانوا
يتلقونه من
خزانة الدولة العثمانيّة،
والأهميةِ
الّتي
أناطتها بهم.
فانعكس تأثير
محاولاتهم
ودعاياتهم
على المجتمع
بأسره. ثم
استغلّ
يهودسالونيك
هذه الفتنة في
العهد
الجمهوريّ
كوسيلة
للدعاية ضدّ
العرب جميعًا
في صفوف
المجتمع
التركيّ؛ حتّى
انتشرت
الكراهية
تجاه العنصر
العربي،
وتجاه كلّ ما
يمتُّ إليه.
فرسخت هذه
النفرة والضغينة
في نفوس الغالبيّة
العظمى من
الأتراك،
وبخاصة
الّذين ضعفت
صلتهم
بالإسلام تحت
تأثير
الممارسات العلمانيّة
والإلحادية
الّتي
تبنّتها
المؤسّسات
التعليمية
والتوجيهية
عبر العهد
الجمهوريّ في
تركيا. فقد بَعُدَتْ
الشقّة بذلك
بين الأتراك
والعرب إلى
حدود بعيدة،
ثبتت
بالمشاهدة
والعيان
عندما فتحت بعضُ
البلاد العربيّة
أبوابَها
لليد العاملة التركيّة
ما بين أعوام 1975-1985م.
فاتخذت
الحكومة التركيّة
إحتياطات
شديدة، وأخذت
المواثيق
المؤكّدة سرًّا
من المقاولين
ورجال
الأعمال أن
يقيموا
الحواجز بين
العنصرين
التركيّ والعربي
بكلّ ما في
استطاعتهم
تفاديًا
للإختلاط
والزواج؛
وتحذيرًا من تسرُّب
الثقافة العربيّة
إلى المجتمع
التركيّ!
وبجانب هذا، كم أعرب
النقشبنديّون
عن شفاء
غليلهم عندما أعلنت
الحكومة التركيّة
عن حظر سفر الطلاب
إلى البلاد العربيّة
للدراسة.
ثمّ
انفجرت فتنةٌ
عظيمةٌ بدأتْ
تتاجّجُ نيرانُهاَ
على الأراضي
الأفغانيةِ
وتطوّرتْ لِتَعُمَّ
الدنيا
بمساويها
إثْرَ تلك
الهجمات التي
شُنَّتْ
بالطائرات
الانتحاريةِ
في أميركا يوم
11 سبتمبر 2001م. فهي في
حقيقتها
وخلفياَّتِها
ليست إلاَّ
امتداداً
للصراع
التقليديِّ
المتواصل بين
النقشبندييّنَ
والوهّابيّين؛
وإن كانت في
ظاهرها »حرباً
شَنّتْهاَ
أميركا
ثأْراً لما
أصابها من
إهانة
وخسارات«.
ذلك لماَّ
بدأتْ وفودُ
الوهّابيّين
تتوغّلُ في
باكستان
والمنطقة
الأفغانية (فورَ
انسحاب
القوات
السوفيتية من أفغانستان)،
لتتحدّى
الجماعات
الصوفيةَ هناكَ
بذريعةِ »تصحيح
ما فسد من
عقائد
المسلمين!«،
انتفض
القبوريّنون
من منطلقِ
الحمية الجاهليّة،
فما لبثَ
حتّىَ
نَشِبَتْ
الحربُ بينَ
كبير القبوريينَ
(برهان الدين
رباَّني) وبين
أهل التوحيد
من أبناءِ
أفغانستان.
فكان من جملة
أخطاء الوهّابيّين
أن أصرُّوا
على البقاءِ
في تلك
المناطقِ بعد انتهاءِ
مهمّتهم
الجهاديةِ
ضدّ القوات
السوفيتية،
فأصبحوا
طَرَفاً في
النـزاعِ وهم
غيرُ أهل تلك
البلادِ، كما
لم يكونوا
قوّةً سياسيّةً
ذات صلاحيةٍ
للقيادةِ
والهيمةِ. فلم
يكن لوجودهم
هناك من
الحكمة في
شيءٍ مماّ دعا
إلى تطوّراتٍ
خطيرةٍ أسفرت
عن خساراتٍ
جسيمةٍ في
الأموالِ
والأرواح.
فأثبَتَتْ
أخيراً هذه
الحقائقُ
كلُّها أن الوهّابيّين
لم يكونوا ذا
كفائَةٍ
لإرشادِ
الناسِ وإصلاحهم
يوماً من الأيّامِ.
لذلك دخل
الشقاقُ بين
الصفوفِ
كلّما كان للوهّابيّين
دورٌ في
التوجيه، وإن
كانوا مخلصين
في نياّتِهم؛
وغفلوا أنّ
الأتراك شعبٌ
صوفيٌّ يشعر
بحساّسيّةٍ
عند أدنى
إشارةٍ من
التوجيه إلى
توحيد الله؛
فكان لنشاطات
الوهّابيّين
إلى تصحيح
العقيدةِ في
المناطق
الأفغانيةِ تأثيرٌ
كبيرٌ
لاثارةِ غضبِ
الأتراكِ إلى
أن استنفرت
تركيا تطوّعاً
لقتالِ (حكومة
طالبان
الأفغانية)
انتصاراً
للجبهة
الأوزبكيةِ
من منطق العصبيّة
التركيّة ضدّ
العربِ
المتواجدينَ
في أفغانستان.
إنّ
الصراع كانت
قائمة بين
النقشبنديين
والوهّابيّن
إلى الآونة
الأخيرة، وإن
كان الطرفان
يتجاهلان
الأمرَ في هذه
الأيّام. ولا
يكاد يظهر
بصيص الأمل
لسدِّ هذه
الثغرة الرهيبة
حتّى الآن، لو
لا قلوبٌ
مؤمنةٌ بالله
واليوم الآخر
وبالأُخُوَّةِ
الإيمانيّة
من أبناء
الطرفين التركيِّ
والعربيِّ،
وآمالٌ
تبشِّرُ بيومٍ
يهزم الله فيه
الأحزاب! أمّا
أصحابُ هذه
القلوب
الطاهرةِ فهم
صفوة حنفاء،
قد هداهم الله
ورزقهم
الإخلاص
والعزيمة
والثقة بأنّه
تعالى قادر
على أن يهدي
المتطرّفين
من بقيّة
الشعبين إلى
نور الإيمان
والتوحيد،
وسعادة الشعور
بضرورة
الاتحاد
والإخاء وترك
دواعي الفرقة
والمعاداة
والشحناء،
حتّى يحقّق الله
فيهم من أسرار
ما قاله
تعالى:
{وَاعْتَصِمُوا
بِحَبْلِ
اللهِ
جَمِيعًا
وَلاَ تَفَرَّقُوا
وَاذْكُرُوا
نِعَمَةَ
اللهِ عَلَيْكُمْ
إِذْ
كُنْتُمْ
أَعْدَاءً
فَأَلَّفَ بَيْنَ
قُلُوبِكُمْ
فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ
إِخْوَانًا
وَكُنْتُمْ
عَلَى شَفَا
حُفْرَةٍ
مِنَ النارِ
فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا،
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ
اللهُ لَكُمْ
آيَاتِهِ
لَعَلَّكُمْ
تَهْتَدُونَ.}[525]
واختصارًا
لما سبق،
نستطيع أن
نقول: إنّ
العلاقات بين
السلطة العثمانيّة
وبين
النقشبنديّين
كانت تتسم
بالوفاق والتعاون
منذ عهد
السلطان
محمود الثاني
إلى أنْ تحكّم
الاتحاديون
في سياسة
الدولة،
فانقلب الأمر رأسًا
على عقب. وفي
هذا التحوّل
الجذري
أسرارٌ
غريبةٌ،
خافية على
كثير من الناس
حتّى الآن.
سنشرح نُبذةً
منها إنْ شاء
الله تعالى في
المبحث
التالي تحت
عنوان »العلاقات
بين السلطة
والنقشبنديّين
في العهد
الجمهوريّ«. وهي
في الحقيقة
صفحة هامّة من
صفحات تاريخ هذه
الطائفة. سوف
تشهد عليهم
بما اقترفوا
من جنايات عظيمة
على الإسلام
والمسلمين في
مشاركتهم مع النظام
اليهوديِّ
وإنْ كان
معظمها جهلاً
وغفلةً منهم.
كما نشاهدهم
اليوم
يتودّدون إلى
الوهّابيّين.
وبين الطرفين
علاقات
تجارية هائلة.
يتجاهل كلّ
طرفٍ منهما
بما لا يزال
الطرف الآخر
يضمر له من
العداوة
والبغضاء.
فنستغرب
عندما نجد أسواق
مكة المكرّمة
والمدينة
المنوّرة
تزدحم
بالنقشبنديّين
الأتراك، على
امتداد السّنّة؛
يتاجرون
ويربحون
ويمرحون
ويفرحون... بل ويسبّون
الوهّابيّين
باللّغة التركيّة
ويضحكون منهم
في الحين
الّذي
يصافحونهم
ويجالسونهم
في عُقرِ
دارهم!
والمؤمن
الحنيف التركيّ
يعاني مشكلةَ الحصول
على تأشيرة
ليتمكّن بها
من أداء فريضة
الحج، وهو
ينتظر أيّامًا
على باب سفارة
الوهّابيّين
في أنقره
وإسطنبول! كذلك
نستغرب جدًّا
استخدام الوهّابيّين
للآلاف من
الموظفين
النفشبنديين
في بنوكهم
ومؤسساتهم
الموجودة في
أنحاء تركيا،
بينما الشباب
الحنفاء
الأتراك
يعانون من
مشاكل البطالة
على أرض وطنهم
بسبب مقاطعة
المشركين من
أصحاب السلطة
والأثرياء
ورجال العمل
والصوفيّة جموعَ
الحنفاء من
أبناء الوطن
التركيّ. مع
أنّ الرجل
الحنيف يمتاز
بالذمّة
والأمانة؛
وبكفاءة أعلى
في الخدمة من
أمثالهم من
النقشبنديّين
وغيرهم من
سائر طوائف
المشركين.
***
قد
يتساءل
الباحث عما
كان موضوع
الخلاف بين السلطة
العثمانيّة
(حامية
النقشبنديّين)
وبين الوهّابيّين؛
فيتصوّر بأنّ
المشكلةَ،
لعلّها كانت
عظيمةً إلى
حدٍّ اندلعت
بسببها حروب
دامية بين
الطرفين ذهبت
ضحيتها أرواح
وأموال،
وانتهت بالخراب
والدمار
والشقاق
والعداوة؛
بعد أن دامت
طوال قرن، بل
أكثر؛ وأنّ
الفتنة
مازالت مستمرّةً؛
ولكنها
اتّخذت شكلاً
آخر: فاكتسبت
صورةَ حربٍ
بين »القبوريين«
وبين »أعداء
المقدّسات«!
نعم
قد يفكّر بعض
الناس هكذا في
أسباب هذا
النـزاع؛ ولا
يجد ما يشرح
صدره عن واقع الأمر.
وقد يظن بعضهم
أنّ الوهّابيّين،
كان غرضهم
المطالبة
بالحكم
الذاتي، أو
الاستقلال،
أو كانت
ثوراتُهم
ردودَ فعلٍ ضد
ظلمِ ولاةِ
العثمانيّين
يومئذ. كلّ
ذلك بعيد عن
الواقع وعن
القيام مقام
إجابة سليمة عن
هذا الاستفسار.
بل نشأت
تلك الظاهرة وتطوّرت
عن طبيعة
سياسة الدولة العثمانيّة
القائمة على
تأكيد
السيادة في
المناطق
النائية بطرقٍ
خاصّة. فكانت
السلطة
المركزيّة
تتعمّد في بعض
الأحيان إلى
إثارةِ
عناصرَ مجبولةٍ
على روح
التمرُّد في
تلك المناطق
بحججٍ تافهةٍ،
ثم تنقضُّ
عليها بذريعة
إخماد الثورة
وتوفير أسباب
الأمن. فيدبُّ
الذعر في نفوس
سكان
المنطقة،
فتكون السلطة
بذلك قد
أشعرتْهم
بهيبتها
مجدّدًا! وإلاّ
فانّ الحركات
الاستقلاليةَ
في المناطق العربيّة
لم تبدأ إلاّ
بعد حكم
الاتحاديّين،
وممارستهم
التعسّفية
لتتريك العرب.
أمّا
الأسباب
الظاهرة،،
فإنها لم تكن
إلاّ تلك
الحجج التافهة
»لاصطياد
عصفورين
بطلقة واحدة«؛
كما في المثل
التركيّ. وذلك
يُلاحَظُ أنْ
يكون
المقصودُ في
هذه الخطّةِ
تحقيقَ هدفين:
أحدهما إذلال
رقابٍ
تتهيّبها
الناس فتقع في
شرك سياسيٍّ.
وهذا يقلّل من
هيبة »ظلّ
الله في الأرض« (!)
وهو السلطان
العثمانيّ و»بابه العالي« في
إسطنبول؛
والثاني
تحديد مفهوم
التوحيد، وتعديله
بالقسطاس
السياسيِّ
التركيّ العثمانيّ،
وليس
بالقسطاس
القرآنيِّ.
وهذا يقتضي
تحديد علاقات
الناس مع
ربّهم، بأنْ
لا تكون رابطتهم
معه مباشرةً؛
بل »عن طريق
شيخٍ من
أولياء الله؛
لأنّ
الاتصالَ
المباشرَ
يقلّل من هيبة
الله في قلب
العبد« (!)
كانت
هذه حقيقة
الأسرار
الكامنة في
مسألة الوهّابيّة،
وتسليط
النقشبنديّين
عليهم، بعد أن
عجزت السلطة
عن إخماد
ثوراتهم
بالقهر.
وأمّا
نزاع الطرفين
في مسائل
الدين؛ فقد
كان خلافًا
همجيًّا،
جاهليًّا،
غير قائم على
أساس من
الحكمة
القرآنيّة،
والقاعدة
المنطقية
السليمة،
ودون أدنى مراعاة
لآداب
المناظرة
والاحترام
المتبادل. فقد
دافع كلّ طرفٍ
من
النقشبنديّين
والوهّابيّين
عن وجهة نظره
بطريقةٍ
عنجهيةٍ
فظّةٍ. خاصّة
فانّ
النقشبنديّين،
أساليبهم في
الاستدلال
واهية، وصادرة
عن حقد سافر،
وعناد،
ومكابرة. جاءت
ردودهم بلهجات
قاسية،
ومساسٍ
بالكرامةٍ
واقتحامٍ للحرمات،
وقصف من الشتم
والسبّ،
والنقمة
والعتاب. وعلى
سبيل المثال
فقد أفرد أحمد
بن زيني دحلان[526] كتابًا
في مثالب محمّد
بن عبد الوهّاب
وأتباعه،
سمّاه »الدرر
السنية في
الردّ على الوهّابيّة«؛
كما أفرد
بابًا في
كتابه »الفتوحات
الإسلاميّة«
بعنوان »ذكر
فتنة الوهّابيّة...«،
فاستعمل فيه
لهجةً شديدةً
في تقبيحهم.
ومن جملة ما
سجّل في مثالب
محمّد بن عبد
الوهّاب قوله:
»وكان
مؤسِّسُ
مذهبهم
الخبيث محمّد
بن عبد الوهّاب،
وأصله من
المشرق من بني
تميم. وكان من
المعمَّرين؛
فكاد يُعَدُّ من
المُنْظَرين.
لأنّه عاش
قريب مائة سنة
حتّى انتشر
منه ضلالهم،
كانت
ولادتُهُ سنة
ألف ومائة و
إحدى عشرة.
وهلك سنة ألف
ومائتين. وأرّخ
بعضهم بقوله:
(بدا هلاك
الخبيث) 1206.«[527]
وأشدُّ
مَنْ حَمَلَ
على محمّد بن
عبد الوهّاب
وزمرته،
عقيدٌ
نقشبنديٌ
متشيّخٌ في
إسطنبول. شنّ
عليهم حربًا
شعواء
بِرَسَائِلِهِ
ودعاياته
الكثيفة،
وشنّعهم،
ورماهم
بالكفر والزندقة،
وسَبَّهم
بكلماتٍ نخجل
من ذكرها![528]
أمّا
الوهّابيُّون،
فإنّهم لم
يجعلوا
النقشبنديّين
بالتحديد
هدفًا خاصًا
لانتقاداتهم؛
بل قد
تجاهلوهم
تمامًا أو
كادوا. وإنّما
وجّهوا
نقدَهم إلى
الصوفيّة على
وجه العموم.
كما قد دافعوا
عن أنفسهم
بأنّ تسميتهم
من قِبَلِ
المعارضين بالوهّابيّة
تسمية خاطئة.
إذ يقول في
هذا أحد
ملوكهم:
»يسمّوننا
بالوهّابيّين،
ويسمون
مذهبنا بالوهّابيِّ،
باعتبار أنّه
مذهب خاصٌّ،
وهذا خطأ فاحش
نشأ عن
الدعايات
الكاذبة
الّتي كان
يبثها أهل
الأغراض.
نحن
لسنا أصحاب
مذهب جديد،
وعقيدة
جديدة، فعقيدتنا
هي عقيدة
السلف
الصالح، ونحن
نحترم الأئمة
الأربعة، ولا
فرق عندنا بين
مالك والشافعيِّ
و أحمد وأبي
حنيفة،
وكلّهم
محترمون في
نظرنا«.[529]
هذا،
ولإنْ جعلْنا
الشيخ عبد
الرحمن
دمشقية في
عداد الوهّابيّين،
فإنّه قد
تناول النقشبنديّة
بهدوءٍ ولم
يتوسّع فيها.
بل حدد موضوعه
في تحليل
ثلاثة
أقوالٍ،
لثلاثة رجالٍ
من قدمائهم فحسب.[530]
إنّما
اختلف
النقشبنديّون
مع الوهّابيّين،
بل اختلفوا مع
جميع
الموحّدين في
مسائلَ
جانبيةٍ
ثانويةٍ
غريبةٍ لا
علاقة لها بلبّ
الإسلام
وأركانه.
فأثاروا بها
ما لا يحصى من اضطراباتٍ
وفتن، وشنّوا
حروبًا
ضاريةً على مَنْ
خالفهم فيها.
وجعلوا من هذه
المسائل التافهة
ونقاشها
عقبةً كبيرةً
أمام
المسلمين في
مسيرة
الحياة،
وعرقلوهم عن
التقدُّم والنهوض
والازدهار.
فالمصيبة
الكبرى إنما
داهمت
المجتمع بعد
أن سادت
الرهبانيّة
على الحياة
الروحية في
الوطن
الإسلاميِّ بتأثير
تعاليم النقشبنديّة
وطقوسها.
ومن
الجدير
بالإشارة أنّ
هذه الخلافات
وما أسفرت
عنها من
مشاغبات
ومشاحنات،
إنما أثارها
المتأخّرون
من النقشبنديّين
منذ حقبة لا
تتجاوز عن
مائة وخمسين
سنة، دون
قُدَمَائِهِمْ؛
مما يدلّ على
حقائق أخرى لم
ينتبه إليها
كثير من
الناس.
أهمّها، أنّ
قدماء
النقشبنديّين
كانوا أبعد
الناس من ساحة
العلم. فلم
يلتقوا مع
أهله حتّى يقع
بينهم وبين
العلماء خلاف
على مسألة
مَّا، إلاّ قليلاً.
إذ كانوا
دراويش لا
يَعتدُّ بهم
أربابُ العلم.
وهذه الشهرة
الّتي نراها
اليوم تحفُّ بأسمائهم
إنّما هيّجها
المتأخّرون
منهم. وما أن
اهتمّ
مشائخهم
بدراسة بعض العلوم
بدايةً من
خالد
البغداديّ،
تطوّرت المناقشات
والخصومات بين
العلماء
والنقشبنديّين
حتّى أسفرت عن
هذه النتائج
الّتي نحن
بصددها اليوم.
تنحصر
المسائل
الخلافية
الّتي أثارها
النقشبنديّون
في أربعة أمور
رئيسة:
الأوّل
منها، مفهوم
الولاية،
والوليِّ، والاستعانة
بالموتى،
والتبرك
بقبورهم،
والنذر لهم،
وما تتعلّق
بهذه المسألة
من تفاصيلَ شتّى،
شرحناها في
بابها ما تيسر
من أهم
نقاطها.[531]
والثاني،
أقوالٌ
مبتدَعَةٌ
تتعلّق بآباء
الأنبياء
وأمّهاتهم،
وشدّ الرحال
لزيارة النبيِّ
r.
والثالث،
آراء متفرقة
حول مفهومَيِ
البدعةِ
والاجتهادِ.
والرابع،
تأويلات
كلامية حول
مسألة »الاستواء
على العرش«.
ثلاثة
من هذه الأمور
الأربعة، قد
أثارها
النقشبنديّون.
وهي المادّة
الأولى
والثانية
والثالثة.
تجمعها نقطة
مشتركة: وهي
نسبة قدرة
خارقة -
تستحيل على
البشر - إلى من
يدَّعون أنّه
ولىٌّ. ويدخل
الأنبياء
والمرسلون
عليهم السلام
أيضًا في
اعتقادهم هذا.
أمّا المسائل
الأخرى فهي
متفرّعة عن الاعتقاد
ومرتبطة بها.
كالتوسُّلِ،
وطلب الشفاعة
والاستغاثة
بالحيِّ
والميّت من
الروحانيّين
والأنبياء والمرسلين؛
والنذر لهم،
والقسم بهم،
وإقامة البناءِ
على قبورهم،
والتبرُّكِ
بها، والزعم
بصدور
الخوارق من
بعضهم باسم
الكرامة و ما
إلى ذلك...
أمّا
المادة
الرابعة، فهي
بدعة أثارها
عدد من الوهّابيّين
بالتوغّل في
معنى »الاستواء
على العرش«[532] و»الاستواء
إلى السماء«؛[533] فلم
يكتف بعضهم
خاصّة في
مناقشته
الشفهية بما
قاله الإمام
مالك رضي الله
عنه »الاستواء
معلوم،
والكيف
مجهول،
والإيمان به
واجب،
والسؤال عنه
بدعة«[534] فأثار
أسلوبُ الوهّابيّين
الاستعدادَ
في نفوسِ
النقشبنديّين
الّذين طالما
ينتهزون
الفرصة
ليهاجموهم
بأدنى حجّةٍ،
فاتّخذوها
ذريعةً حتّى
رموا جميعهم
بالتجسيم
والزندقة.
هكذا
تطوّر
النـزاع
والخلاف بين
الطرفين ودام
أكثر من قرن،
فارتبك به
الناس الّذين
كانوا في
ظلمات الجهل
والعمى،
وتذبذبت
الآراء،
وتشوّشت
العقول؛
فانحازت
جماعات إلى
النقشبنديّين،
وأخرى إلى الوهّابيّين.
وما زالت
العداوةُ
تستعر في قلوب
كثير من كلا الطرفين
ضدّ الآخر.
ولكنّ
الدائرة في
الحقيقة دارت
أخيراً على
المسلمين.
لأنّهم
أصبحوا في حرج
من جرّاء هذه الحرب
الشعواء بين
الطرفين، فلم
يتمكّنوا من
لمّ شعثهم في
مثار تلك
الفتن وهم
يتكبّدون
ألوانًا من
العذاب. إذ
انهارت دولتهم،
وتكالبت
عليهم
الدنيا،
فقامت على أنقاض
تلك الدولة
العظيمة عدة
دولٍ قزمةٍ،
وثب على كلّ
واحدة منها
طاغيةٌ بدعم
من اليهود
والنصارى،
يستبدّ
بالحكم مع
بطانته ويسوم
رعاياه سوء
العذاب باسم
الديمقراطية
والحرية ولا
يميز في ذلك
بين المسلم
والنقشبنديّ
والوهّابيِّ!
***
* العلاقات
بين السلطة
والنقشبنديّين
في العهد
الجمهوريّ.
لما
سقطتْ
الدولةُ العثمانيّة،
ووثبتْ على
السلطة
الجديدة
عصابةٌ من
يهود سالونيك،
وسمّتها
"جمهورية
تركيا"؛
أيقنت أنّ
أكبر عقبة
تعترضها
وتعرقلها من تحقيق
أهدافها هو
الإسلام
والمسلمون.
ولكنّ أفرادَ
هذه العصابة
كانوا - بحكم
الطبع - يجهلون
حقيقة
الإسلام، كما
كانوا يجهلون
مَنْ هم المسلمون
من بين
الفِرَقِ
الداخلة تحت
شمول النسبة
إلى الإسلام
في واقع
الأمر.
ذلك
أنهم كانوا
يهودًا من
عائلاتٍ ذاتِ
أصولٍ تركيةٍ،
انحدرتْ من
سلالات
تهوّدت في
العهد
الخزريِّ
وانتشرت
قديمًا في
ساحات شاسعة
من شرقي أوربا
وشبه جزيرة
البلقان.
فلمّا دخل
العثمانيّون
تلك المناطق
أيّام
الفتوحات
وضمّوها إلى
مملكتهم، وجد
أولئك اليهود
المشرّدون
بذلك فرصةً
سانحةً
للاندماج في
المجتمع
التركيّ المسلم
بقرينة
الوحدة القوميّة
الّتي كانت
القاسم
المشترك بين
الطرفين. فتدرّجوا
باحتلال
المناصب
الهامة في
أجهزة الدولة
عبر القرون،
متنكّرين
بالإسلام؛
حتّى شاء
القدر أن
يتجمّعوا في
مدينو
سالونيك، وأن يشكّلوا
هناك منظّماتٍ
سرّية
بالمشاركة مع
اليهود
الأصليين من
سلالات
عبرية،
والمهاجرين
من إسبانيا
بسبب اضطهاد
محاكم
التفتيش؛ إلى
أن ظهروا على
مسرح التاريخ
قُبَيل الحرب
العالميّة
الأولى، في صفوف
حزبٍ سياسيٍّ؛
وهو حزب الاِتِّحَاِد
والترقِّي.
فلعبوا
بالدولة
وعملوا على
سقوطها بدعم من
الدول
الأوربية.
لهذه
الأسباب (ولها
تفاصيل، ليس
هذا مقام سردها).
يغلب أن تلك
القلّةَ من
اليهود
الّذين فرضوا
أنفسهم على
المجتمع،
كانوا
متردّدين في
أمر الجماعات
المتباينة،
والمنظمات،
وطبقات الناس
لدى الخطوة الأولى
من انطلاقهم وبعد
نجاحهم في السيطرة
على أجهزة
الدولة
بتمامها.
كانوا يتفقّدون
مِنْ بين هذه
الجماعات
والمنظّماتِ
ما يمكن أن
يستغلوا
أفرادَها
ويستعينوا
بهم حتّى
يشتدّ ساعدهم
في الحكم؛
ويمسُّونَ
الخطرَ في
الوقت ذاته من
أكثرهم خاصّة
من جماهير النقشبنديّين
الّذين كانوا
يمثّلون معشر
المسلمين في
نظر هذه العصابة
اليهوديّة؛
مع أنّ
الحقيقة كانت
خلاف ذلك.
فهذا الّذي جعلهم
في الوهلة
الأولى
يقومون بخطّة
إرهابية
لاكتساح
النقشبنديّين
حتّى يتمكّنوا
بعد ذلك من
القيام
باللّعبة
الكبرى مع اليهود
الأصليّين
الإسبان في
تحقيق
الأهداف
النهائية.
هكذا
بدأ الصدام
بين السلطة والنقشبنديّين
منذ أواخر عهد
السلطان عبد
الحميد
الثاني. حيث
كان الاتّحاديون
اليهود قد
وثبوا على
الحكم في تلك
المرحلة. ولكن
يجب هنا أن
نتذكّر مرةً
أخرى بأنّ هذه
العصابة
الحاكمة
إنّما
استعدّت لشنّ
الحرب على
النقشبنديّين
بسبب
إلتباسهم
عليها،
واعتقادها
الخاطئ في
نسبتهم إلى
الإسلام.
فقامت بتنظيم
ثلاث مؤامرات
ضدّهم: نُفّذتْ
الأولى منها
يوم 13/أبريل/1909م. قُتِلَ
فيها جمهور من
عوامّ
النقشبنديّين
ورجل صحفيٌّ
منهم اسمه
درويش وحدتي؛
وانتهت بخلع
السلطان عبد
الحميد، »على أنّه
يساند القُوَى
الرجعية
ويستغلُّها
في طغيانه واستبداده«.
والمؤامرة
الثانية
نُفّذتْ في
المنطقة
الكرديّة بعد
عامٍ من إعلان
النظام الجمهوريّ،
ما بين مدينتي
أرض الروم و
دياربكر؛ وهي
في ظاهرها
ثورة الشيخ سعيد اﻟﭙﺎلوي الّتي مر
ذكرها. أما في
الحقيقة
فإنّهالم تكن
إلاّ خطّةً
مدروسةً من
قِبَلِ جهاز
المخابرات
التابع
للطغمة
الحاكمة من
يهود سالونيك.
ثبتتْ بدلائل
قاطعةٍ،
أكبرها إثارة
الشيخ سعيد على
حين لم يفكّر
إطلاقًا بأي
عمل ضدّ
النظام.
فأثاره جهاز
المخابرات بوساطة
منظمةٍ سريةٍ
أسّسها
بإيعاز من
الحكومة
بالذات في
المنطقة تحت
إشراف الرائد
قاسم أتاج.
وذلك لسحب
العشائر
الكرديّة من
النقشبنديّين
إلى ساحة
القتال. فإنّ
اختيار جهاز
المخابرات
لتحميل الشيخ
سعيد، قيادةَ
الثورة
مسبقًا، دون
أن يختار لهذا
الدور زعيمًا
من رؤساء
العشائر،
يبرهن بصورة
قاطعة أنّ
المؤامرة لم
تكن مدبَّرة
لمجرد التنكيل
بالأكراد، بل
كان الغرضُ
منها إيقاعَ النقشبنديّين
في الكمين
أوّلاً،
فيكون الأمر
ذريعة للقضاء
على كلّ من
يسوقه القدر
إلى ساحة
الغضب من
الأكراد دون
تمييز بين أن
يكون
نقشبنديًّا
أو لا. والمؤامرة
الثالة هي
"وقعة
مَنَامَنْ"
كما سنشرحها
قريبًا إنْ
شاء الله.
لقد
اتسم موقف
الحكومات التركيّة
في إخماد تلك
الثورات
بأداء واجب لا
مناص منه،
فوقعت محاولاتُها
موقعَ
مُبَرِّرٍ في
الرأي العامّ
المحليِّ
والعالميِّ.
ومعنى ذلك، »أنّ
النقشبنديّين
قد شقُّوا عصا
الطاعة
وخرجوا على
نظامٍ
مؤسَّسٍ« فيما
يبدو؛
والحكومة لم
يسعها إلاّ
أنْ تقوم بتأديبهم،
فاضطرت إلى
استعمال العنف،
وهذا شيء
طبيعيٌّ.
لقد
حققت الحكومة
هدفين كبيرين
أثناء القضاء
على هذه
الثورات.
ويُعتَبَرُ
هذا النجاح تجربةً
عظيمةً
مهّدتْ
البقاءَ
لليهود
الدونما في
الحكم إلى ما
شاء الله.
أحد
تلكما
الهدفين
وأهمّهما هو
التعرُّف على
الطائفة النقشبنديّة
وعلى جميع ما
تتعلّق بهم من
عقائدَ وميّزاتٍ
أخلاقيةٍ
واجتماعيةٍ
وثقافيةٍ؛
ونزعاتٍ
وعلاقاتٍ
واتصالاتٍ
كانت تجري بين
مشائخهم.
تمكّنت
الحكومةُ من
جمع معلومات
رهيبة حول هذه
الطائفة
أثناءَ محاكم
الثورة عام 1925م.؛ كما
تأكّدت من مدى
قوّتهم
البشريّة
والماليّة
ومدى تعاونهم
فيما بينهم.
والهدف
الثاني أنّ
الحكومة
استطاعت أنْ
تروّضَ
النقشبنديّين
على العمالة السياسيّة،
بطمسِ الشهوة السياسيّة
فيهم وإجهاضِها،
وزرْعِ بذور
الشقاق بين
مشائخهم.
لهذا، هناك
تطابُقٌ
كبيٌر بين
آراء كلّ من
الطغمة
الحاكمة وبين
شيوخ
النقشبنديّين
الأتراك في
أمور خطيرة.
ومن أهمّ نقاط
الاتفاق بين
الطرفين في الوقت
الحاضر: هو
موقفهما من
الإسلام بأن
يُجرَّدَ من
الحياة الاجتماعيّة
تمامًا؛ وأن
لا يخرج مفهوم
الدين من
أعماق الضمائر،
ولا من بين
جدران
المساجد
أبدًا. تدل على
ذلك مقولة
للنقشبنديّين
يردّدونها
على سبيل
التحذير من
استغلال الدِّينِ
لأغراضٍ
ومصالحَ
سياسيةٍ - في
ظاهر الأمر -،
ولكنهم في
الحقيقة لا
يريدون بها
إلا أن يسقط الإسلامُ
إلى درك
المسيحية
فيتحوّل إلى
دينٍ يتأوَّلُهُ
كلّ شخصٍ في
تحديد علاقته
مع ربه على
حسب فهمه ورأيه
وذوقه؛ إلى
دينٍ لا ضابطَ
له فيما
يتعلّق بالحياة
الاجتماعيّة
على الإطلاق.
طالما كانت
الزمرة
الحاكمة ولا تزال
تستخدم هذه
المقولة في
تخدير
المشاعر من
جانب، وفي
تهديد
الحنفاءِ
والسلفِيِّينَ
من جانب آخر!
جاءت هذه
المقولة
بصراحة في
موسوعة
للنقشبنديّين.[535] ولكن
الهدف من تلك
المقولة ليس
إلاّ الحيلولة
بين الإسلام
وبين ما جاء
لأجله،
وإلغاء
أحكامه..
لذا
فانّ هذه
الطائفة،
خاصّة بعد أن
تعرّضت للنّكبة
الثالثة - وهي »وقعة
مَنَامَنْ«،
كما سنشرحها إنْ
شاء الله -، لم
تعد تمثّل قوّةً
سياسيّةً
مستقلّةً في
تركيا، على
الرغم من كثرة
أفرادها؛ وهي
أكبر جماعة
بين سائر
الفرق والأحزاب
والمنظمات. بل
استغلّتهم
الأحزابُ السياسيّة
المُسَيَّرَةُ
من قِبَلِ
يهود
سالونيك، الّتي
تتراءى في
ظاهرها
مختلفة
الاتجاه،
ولكنّ
النقشبنديّين
مُبعثَرون
ومتفرّقون في
صفوفها منذ
نصف قرنٍ،
منطبعون
تمامًا على
التبعية
والاستسلام.
يتّصل رؤساء
الأحزاب السياسيّة
التابعة
للنظام
اليهوديِّ
بمشائخهم في
مواسم
الانتخابات،
ويأخذون
تأييدهم؛ بل
يكلّفونهم
بتعليمات لا
يخالفهم فيها
الشيوخ. كما احتلّ
عددٌ من أبناء
شيوخ النقشبنديّة
في هذه السنين
الأخيرة
مناصب هامة في
أجهزة الدولة،
ومنهم أعضاء
في البرلمان.
إن
النقشبنديّين
اليوم
يختلفون كثيرًا
عن أسلافهم في
موقفهم من
السياسة
والسياسيّين.
لم تعد السلطة
تَهَابُهُم،
ولا تعتدّ
بهم. بل ترتاح
لكثرة عددهم
ونشاطهم.
لأنهم كلّما
ازدادوا
عددًا
ونشاطًا،
ازدادت بهم
السلطة قوّةً
وتحكّمًا. ذلك
لأنّ نجاح
الأحزاب السياسيّة
في
الانتخابات
العامّة
متوقّف على
دعمهم. فلا
يمكن لأيِّ
حزب أن يفوز
بأعلى نسبة من
الأصوات في
الانتخابات
العامّة إلاّ
أن يكون قد
أَقْنَعَ
عددًا من شيوخ
هذه الطريقة
وجَذَبَهُمْ
إلى صفوفه.
لذا فانّ الأحزاب
تتنافس في
سبيل
اكتسابهم؛
ولأنّ النجاح
في كسب دعمهم
ضرورة لا مهرب
منها لإرضاء
الطغمة
الحاكمة من
يهود سالونيك
وعملائهم الّذين
يملكون زمام
الحكم في كلّ
مرحلةٍ،
ويحتكرون
السلطة من
خلال أيِّ
حزبٍ يفوز
بالانتخابات
العامّةِ.
فانّ الحزب
السياسيَّ في
تركيا بهذا
الشكل من
الديمقراطية المزيفة
لا يعدو عن
آلةٍ
يستخدمها
يهود سالونيك
في توجيه المجتمع
وترويضه على
أنماطٍ
غريبةٍ من
الشذوذ والزندقة
والإباحية
والانحلال!
ولهذا
السبب، لما
أظهر
النقشبنديّون
الجرأةَ على
تشكيل حزب
سياسيٍّ
بعنوان »حزب
النظام
الوطنيِّ«
بتاريخ 8/فبراير/1970م.، وبدءوا
يتدرّجون إلى
الحكم، دَبَّ الذعرُ
في صفوف يهود
سالونيك. فسرعان
ما انقضّوا
على هذا الحزب
ببطش شديد،
وأنزلوا به ضربتهم
القاصمةَ
وفتكوا
بأوصاله[536] فبدأت
مرحلة جديدة
لإعادة
التجربة
نفسها في حيطة
وحذر بالغ،
فتكرّرت
إعادة تشكيل
هذا الحزب
أربع مرات تحت
شعارات
وأسماء
مختلفة في كلّ
مرةٍ بعد
السقوط
الأوّل، ولكن
باءت
المحاولات
بفشل ذريع في
النهاية،
وألغي حزب
الفضيلة الّذي
كان معقل
النقشبنديّين
يوم 22
/يونيو-حزيران/
2001 . إلاّ
أن كبار هذا
الحزب
مازالوا
يحتفظون بالأمل
كما يظهر من
الحركة الّتي
تدبُّ في
صفوفهم. وقد
أبدوا
استعدادَهم
أخيرًا على
تجربةٍ
جديدةٍ لممارسة
السياسة بعد
أن أقدموا على
تشكيل حزبٍ
جديد سمّوه »حزبَ
السعادة« والعيون
تترقب في
تساؤل عن موقف
النقشبنديّين
في تعاملهم مع
يهود سالونيك
بعد اليوم!
على كلّ،
فانّ
النقشبنديّين
لا يعصون
أمرًا ليهود سالونيك،
- وإنْ كان ذلك
عن كراهيةٍ،
وخوفًا وتقيةً
في بعض
الأحيان -.
يشاركونهم في
طقوسهم الدينيّة
ويحتفلون
معهم عند »قبر
العنيد«[537]
ويقومون
بإجراء ما لا
يتعارض مع
أهداف اليهود
وعقائدهم
وأفكارهم من
تخدير مشاعر
الناس بنشاطاتهم
الصوفيّة،
وإحياء بدع
أوليائهم، وتقديس
قبورهم،
والاستغاثة
بالأموات،
وتعظيم أمجاد
العثمانيّين
في صورة
شعارات دينيّة.
كلّ ذلك يؤدّي
في الحقيقة
إلى تشويش
الانتباه، وصرف
العقول عن فهم
الحقائق
القرآنية،
وصدّ الناس عن
القيام
بمقتضيات
الرسالة المحمّديّة.
***
لما
حصدتْ
السلطةُ اليهوديّة
عام 1925م. ستةً
وثلاثين
ألفًا من
النقشبنديّين
الأكراد في
المنطقة
الشرقيّة
بذريعة »الثورة الإسلاميّة«
الّتي لم تكن
في حقيقتها
إلاّ خطّةً
مدبَّرةً
ومدروسةً
أُلْصِقَتْ
بهذا الشيخ
النقشبنديّ
على حين
غَرَّةٍ منه؛
استعدّتْ
العصابةُ اليهوديّة
لتنفيذ خطّةٍ
ثانية في
المنطقة الغربيّة،
ليتمّ بها
حصاد
النقشبنديّين
الأتراك هذه المرة
عن بكرو أبيهم،
فتتخلّص اليهود
بذلك من
أسطورة الخوف
نهائيًّا.
تَمَّ
تنفيذ هذه
الخطّة
ثانيةً في
مدينة
مَنَامَنْ
يوم 23/ديسمبر/1930م. وهي مدينة
صغيرة على
مقربة من
ولاية إزمير. وذلك
باستخدام
رجلين من
اليهود
الأصليين من سكّان
إزمير (يودا
ويقو)؛ ورجلين
آخرين من الأصل
التركيّ،
كانا حشّاشَيْنَ
من مدمني
المخدّرات.
اسم أحدهما:
لاَزْ
إبراهيم
خواجه؛
والثاني،
درويش محمّد
(كش مهمد، أي محمّد
الحشّاش).
لقد
كانت مهمّةُ
اليهودِيَّيْنِ
- حسب الخطّة -
أن يحضرا
صلاةَ الفجر
في المسجد
المركزي بالمدينة
المذكورة
بزيّ
الصوفيّة
المتنسّكين. و
أن يقوما بإثارة
الحاضرين بعد
انتهاء
الصلاة
مباشرةً، وتنظيم
مظاهرة ضدّ
النظام
الحاكم في
شوارع
المدينة
بشعارات إسلاميّة،
وإلقاء
هتافات آفاقيّة
لتنبيه مشاعر
البُسَطَاءِ
وجذبهم إلى
صفوف
المظاهرين
بإشاعة »أنّ
اثنين وسبعين
ألفًا من جنود
العرب المسلمين،
معزَّزين
بالملائكة قد
أحاطوا
بالمدينة،
وهم على وشك دخولها
وإعلان
الدولة الإسلاميّة
في البلاد!«. ثمّ
عليهما أنْ
ينصرفا
بطريقة
التسلل إلى
مدينة إزمير.
على أن
يسلِّما
الأعلامَ
الخضرَ وكلَّ
رموز الثورة
من الأزياء
واللاَّفتات
والأسلحة إلى
الحشاشَيْنِ
المذكورين
قبل المغادرة.
وسيكون هناك
جنود من قوات
الدرك
مكلَّفين
بحمايتهما، وتوفير
الأمن لِتنصّلهما
وعودتهما تحت
جناح السّرّ إلى
إزمير؛ وكذلك
بإلقاء القبض
على أكبر عدد من
النقشبنديّين
في المنطقة
بما فيهم جميع
المظاهرين.
تمّ
تنفيذ الخطّة
بخسارة بسيطة
نتيجة خطأٍ
وقعت فيه القوّات
الأمنيّة.
فقُتِلَ
أثناء
المظاهرة
رئيسُ قوات
الدرك، الملازم
الثاني مصطفى
فهمي كوبيلاي
مع أحد
اليهودِيَّيْنِ
(والأصح إنّه
يودا). ولكن
أُعْلِنَ أنّ
القتيل رجلٌ
من الأتراك
النقشبنديّين
كتمًا لسرّ
الخطّةِ. أمّا
الثاني
منهما، فإنّه
هرب ونجا. ثمّ
أقامته
الحكومة في
الخارج على
سبيل
المكافأة له.
تذرّعت
الحكومةُ
بهذه »الفتنة«
فأرسلتْ
جيشًا كثيفًا
إلى المنطقة
بقيادة جنرال
مصطفى
موغلالي.
فداهموا
مدينة مَنَامَنْ
وضواحيها
بسرعة البرق،
يدلّ ذلك على أن
الأمر كان
مدبَّرًا.
فقتلوا
كثيرًا من الأبرياءِ
ظلمًا دونما
أدنى سبب، ولا
سمحوا لأحد
منهم حتّى
يدافع عن نفسه
ولو بكلمةٍ
واحدة. ثم
قامت أجهزة
الأمن
باعتقالاتٍ
واسعةٍ في صفوف
مشائخ النقشبنديّة
بالمنطقة الغربيّة،
وعلى رأسهم
عبد الحكيم
الأرواسيّ؛
فنُقِل إلى
مدينة أزمير
كما سبق ذكره.
و أما أسعد الأربلي،
فجيء به من
إسطنبول إلى
مدينة »مَانِسا«
لإجراء
التحقيقات
معه، والبحث
عما إذا كانت له
علاقة بما حدث
في مدينة مَنَامَنْ.
فأصابته
حالةٌ مِنْ هَوْلِ
مَا وَجَدَ
حوله من
الجنود
والاحتياطات
الأمنيّة
الشديدة، و ما
تعرّض له من
الضغوط؛ إذ
كان قد عاش
معزّزًا
وموقّرًا؛
فلم يعهد مثل
هذه المعاملة
المرهبة. ثم
أُحيل إلى
مستشفى مدينة »مانسا«،
فلم يلبث أن
مات فيه مِنْ
رُعْبِ مَا لَقِيَ
من الشدة.
وقيل قُضي
عليه
بتعليماتٍ
سرّيةٍ من
الحكومة!
انتهت
هكذا صفحةٌ
هامّةٌ من
تاريخ النقشبنديّة
وبدأت مرحلة
جديدة في سير
العلاقات
والتعامل بين
الطغمة
الحاكمة من
يهود سالونيك
وبين
النقشبنديّين
بعد هذه
المؤامرة.
ومن
الأهمية
بمكان، أنّ
الخِطَّتين
جاءتا بنتيجة
غريبة لم تكن
في الحسبان
وقدلم تكن تلك
هي المقصودُ
بالذات من
تنفيذهما. بل
كانت العصابة
الحاكمة في
الحقيقة
إنّما تريد
القضاء على
النقشبنديّين
عن بكرة
أبيهم، لأنّها
ترى جميع المسلمين
متجسّدين
فيهم! ولكن
لمّا جمع
القدر بين
الطرفين في
جلسات محاكم
الثورة -
خاصّة بعد
الخطّة
الثانية-،
وجرت بينهما
سلسلة من الحوار،
تأكدّت
الزمرة
الحاكمة من
أنّها خاطئة
في هذه النظرة؛
و ظهرت
بالتالي من
خلال هذه
الحوارات الطارئة
مدى تطابق العقليّة
النقشبنديّة
مع العقليّة اليهوديّة
التركيّة في
تفسير علاقة
الإنسان
بربّه. إذ أنّ
توجّه العبد
إلى الله من غير
واسطة، يراها
الطرفان
خروجًا على
أركان الدِّينِ،
وجرأةً على
الله،
واقتحامًا
بحرمة »وكلاء
الله
المفوَّضين
بالتصرّف عنه
في الكون« (على حسب
عقيدتهما)؛
تعالى الله
عما يصفه
الفاسقون!
كذلك تأكَّدَ كلّ
طرفٍ من
تعصُّبِ
الطرف
الآخَرِ
للعنصر التركيّ
وتفضيله على
سائر العناصر
عن طريق هذه
الحوارات.
فلمّا
ظهر هذا
التطابق بين
عقيدة
الطرفين،
وتبيّنها كلّ
منهما،
انهارت سدود
العداوة
بينهما شيئًا
فشيئًا بعد
ذلك؛ وازداد
التقارب
خاصّة بعد
انتخابات 1950م. الّتي فاز
الحزب
الديمقراطي
فيها بدعمٍ من
النقشبنديّين.
إلاّ أنّ رئيس
الوزراء
عدنان مندريس،
لمّا علم أنّ
المسلمين
أيضًا سوف ينالون
حظًّا كبيرًا
من الحريّة
الّتي متّع
النقشبنديّين
بها، وبدأ
يتوجّس خوفًا
من انتشار
عقيدة
التوحيد، وازدياد
عدد
الموحّدين
الحنفاء في
تركيا، جاء بمشروعٍ
ليوُحّدَ به
صفوف جميع
النقشبنديّين
تحت زعامة شيخ
واحدٍ حتّى
تسهل
مراقبتهم، والتحكّم
في المسلمين
بواسطتهم في
الوقت ذاته.
قيل إنّه
أصدر تعليمات
للمختصين من
أمناء سره
ليجدوا له
رجلاً يكون
على شيءٍ من
الحماقة،
كثير الصمت،
كبير
الهامةِ،
طويل الأنف
أحول... وأن
يقوموا
بالدعاية له
بين صفوف
النقشبنديّين
على أنّه غوث
الزمان وقطب
الفلك حتّى
يَلْتَفَّ
حولَه رعاع
الناس
والبسطاء،
تنفيذًا
لمشروعه. فلم
يلبث أن
تحقّقت
آمالُهُ في
أمد قصير.
فوجدوا له
رجلاً بنفس
المواصفات،
وأقاموا له
مقرًّا على
الطريق الّذي
يربط بين مدينتي
»بدليس«
و»دياربكر«.
فجنّدتْ
الحكومةُ
رهطًا من
رجالٍ
مدرّبين على
الصفة
المطلوبة
للدعاية له،
معظمهم من ضباط
الصف
المتقاعدين.
وما
أن تبعثر
هؤلاءِ
المنتحلون
بين صفوف الناس
وتسلّلوا إلى
المحافل
والمجالس
والمساجد يدعونهم
للانتساب إلى
هذا الشيخ،
انهالت جموع
غفيرة من
مختلف أنحاء
البلاد إلى
هذه المنطقة
المجهولة،
يتهافتون
عليه
وينخرطون في سلكه.
فأثاروا
ضجّةً بوصف
كراماته،
فسُحرتْ عقول
الناس بما
أُقيمت من
حفلاتٍ
وطقوسٍ وحلقاتٍ
هيّجت
الملايين، فتخدّرت
المشاعر، و
صُدَّتْ الوجوه
عن حقيقة
الإسلام
تمامًا.
فاختلط الصوم
والصلاة
والحج
والزكاة
بالختم
خُوَاجَگَانِيَّة،
والحلقات
اليوغيّة،
والرّابطة
الهندوكيّة،
وعدّ الأذكار
بالحصى،
والتركيز على
الصورة
الفوتوغرافية
للشيخ،
والتبرّك
بالقبور،
والاستمداد
من
الروحانيين؛
وتصاعدتْ أصوات
غريبة - شبه
الخوار
والزئير
والعواء - من
حناجر المجذوبين
في التكايا
والمساجد
والبيوت والشوارع
ليلاً
ونهارًا،
أصيب آلافٌ
مؤلّفةٌ من الدراويش
بمرض
الهيستريا،
واختفت
نشاطات الأمر
بالمعروف
والنهي عن
المنكر،
وبطلت أعمال
الدعوة
والإرشاد، و
ماتت روح
الجهاد.
ولكثرة إلتفاف
الناس حول هذا
الشيخ، اشتدّ
الحرج على المسلمين.
فمن رفض منهم
أن يواليه،
تعرّض للسُخرية
من قِبل
جماهير
النقشبنديّين،
ورُمِيَ
بالعداوة »لأولياء
الله«،
وأُطلق عليه
صفة »الْمُنْكِرِ«
و»الوهّابيِّ«!
فلم يعد أحد
يتفكّر في
خاصّية حياة
الرسول r
وشخصيّته
وسيرته. بل
اعتقد الناس أنّه
u
كان على سيرة
شيوخ النقشبنديّة
(؟!) كما اختفت
أيضًا بهذا
الدافع ضجيج
الفِرَق
والأحزاب
المتنازعة؛
فارتاحت
حكومة مندريس
وتمكّنت بفضل
النقشبنديّين
من تحديد الحركة
الإسلاميّة
في تركيا بشكل
ملحوظ.
وأدهى
من ذلك وأمرّ:
أنّ حكومة
مندريس وافقت
على مشروع
القانون رقم 5816، بتاريخ 25/07/1951م.
الّذي ينصّ
على تأليه
الزعيم
التركيّ، كما
اهتمّت بتنظيم
الطقوس الّتي
تُقام في معبد
الدِّينِ
الجديد
بأنقره، ذلك
الدِّين
الّذي اعتنقه
جميع الأتراك
اليهود، وملايين
من الأتراك
المرتدّين عن
الإسلام،
والّذي سُمِّيَ
بـ »دين
الترك
المعاصر«[538]. تحمّل
مندريس هذه
المسئولية
الخطيرة
إرضاءً لشهوة
يهود سالونيك
المتسلِّطين
على الحكم.
(ويزعم
الصحفيّ محمّد
شوكت أيكي: أنّه
أيضًا يهوديّ
الأصْل).فانّ
فِي هذا
الإقدامِ
الخطيرِ - من
رئِيس
الوزراء - حقائق
لم ينتبه
إليها كثير من
الباحثين
حتّى الآن.
أهمّها أنّ اليهود
الأتراك كانوا
يشعرون بحرج
بالغ: أنّهم
يدينون باليهوديّة،
وجمهور عظيم
من بني جلدتهم
يدينون
بالإسلام.
ومعنى ذلك: »أنّ هؤلاء
القوم خاضعون
لِدِيَانَتَيْ
شعبين
أجنبيّين من
الأصل الساميِّ،
وهم من الأصل
الطورانيِّ.
وهذا يحطّ من
كرامتهم القوميّة،
ويقلّص من
استقلالهم
التاريخيِّ
والثقافيِّ«.
ويؤكّد على
هذه الحقيقة
ما كتبته
الباحثة الإنجليزية
جرايس
أليســونGrace
Ellison.
في كتابها Turkey
Today.
وما تفوّه به
أحد شعراء
الأتراك من
الجماعة اليهوديّة
اسمه كمال
الدين كامو[539] وثمّ
دلائل أخرى كثيرة.
أما
الّذي يمس
موضوعنا في
هذا السياق؛
أنّ هذه
الفكرة
الخطيرة لم
تخامرهم إلاّ
بعد إطلاعهم
على أسرار
الطريقة النقشبنديّة
وحقيقة هذه
الطائفة
مؤخّرًا. ذلك
لا يُستبعد أن
يكون كثير
منهم قد اعتـزوا
بأنّ رجالاً
من قدماءِ هذا
الشعب الطورانيِّ
قد استطاعوا
قبل سبعة
قرونٍ أنْ
يحدّدوا
لأمّتهم
اتجاهًا خاصًّا
في تفسير
مفهوم
الإسلام
بشكلٍ يفصل
بينهم وبين
العرب في
الانتماءِ
الدينيِّ
باسم النقشبنديّة
من منطلق
الاشتياق إلى
الاستقلال
الذاتيِّ الّذي
يُضمره
العنصر
التركيّ منذ
القديم، كما
ترمز هذه
الحقيقة في حد
ذاتها إلى الصراع
العربي-التركيّ
على احتكار
الإسلام عبر التاريخ.
ولهذا
يجاهر كثير من
الأتراك
الّذين قد
خلعوا ربقة
الإسلام من
أعناقهم،
يجاهرون بكلّ
صراحةٍ: »إنّه
مادام
أسلافنا قد
نجحوا في هذه
التجربة الّتي
أَكْسَبَتْنَا
المناعة
ضِدَّ
الانصهارِ والتحلُّلِ
في بوتقة
العرب،
فاستطاعوا
بفضلها أن
يحتفظوا
بالشخصيّة التركيّة
المتمايزة
حتّى الآن؛
فما يمنعنا
إذن من أن نُعلِنَ
استقلالَنا
عن دين العرب
تمامًا؟!«
إنّ
هذه
التغيُّرات
السريعة
الّتي ظهرت
على الصعيد
الفكريِّ في
المجتمع
التركيّ
المعاصر عقب
التطوّرات
الطارئة
كنتيجة لعلاقات
السلطة مع
النقشبنديّين،
لا شكّ يبرهن
على تأثير هذه
الطائفة
وعقائدها على
أفكار الزمرة
الحاكمة،
وبوساطتها
على قطاع كبير
من الناشئة
ولو بطريقة
غير مباشرة.
يبدو
أنّ الزمرة اليهوديّة
الحاكمةَ لم
تقتنع بعمالة
مندريس وإخلاصِهِ
لها في إجهاض
الحركة الإسلاميّة
بالقدر الّذي
حمل على
الحركة
الماركسية
والانفصالية
الكرديّة. بل
أحسّت بخطر
عندما وجدت
النقشبنديّين
قد اجتمعوا
تحت زعامة شيخٍ
واحدٍ في شرقي
البلاد.
وبخاصّةٍ
فانّ
النقشبنديّين
الأتراك
أيضًا كانت
نشاطاتهم في
المدن الغربيّة
قد ازدادت في
تلك المرحلة
بتوجيهٍ من
أحد شيوخهم
البارزين
اسمه سليمان
حلمي طوناخان
رئيس الفرقة
المعروفة بـ »السليمانيّة
«Süleymancılar،
كما لوحظ
انتعاشٌ كبيٌر
في حركات
جماعة النور
على مستوى
البلاد. فأوجست
الزمرة
الحاكمة
خوفًا من كلّ
هذه
التطوّرات،
أن تتحوّل في
النهاية إلى
حركةٍ إسلاميّةٍ
صحيحةٍ، أو
حركةٍ نقشبنديّة
موحّدةٍ لا
قبل لهم بها.
فأطاحوا
بحكومة مندريس
يوم 27/مايو/1960م. ثم قتلوه
شنقًا يوم 17/سبتمبر/1961م. واختطفوا
جثمان سعيد
النورسي (زعيم
جماعة النور)،
من مدينة
أورفا بعد
دفنه بقليلٍ.
وذلك عام 1960م. كما نقلوا
مقرَّ شيخ
النقشبنديّين
الأكراد من
المنطقة
الشرقيّة إلى قريةٍ
اسمها
(المنـزل) بالمنطقة
الجنوبيّة
قربَ مدينةِ
آديامان بعد
مدّةٍ قصيرةٍ
لسبب هامٍّ
سوف نتطرَّقُ
إليه إنْ شاء
الله تعالى؛
وقضوا على
مثابات جامعة
الزهراء. ولكن
استمرّ دعم
السلطة اليهوديّة
للشيخ
المذكور
ولأولاده،
كما استمرّت
في الوقت ذاته
مطاردتهم
للمسلمين إلى
اليوم.
***
على
الرغم من وجود
أمارات كثيرة
وواضحة تبرهن
على استمرار
التَّعَاوُنِ
بين الزمرة
الحاكمة وبين
مشائخ النقشبنديّة
ذوي الأصول التركيّة
في هذه
البلاد، قد
يردُّ هذه
الحقيقةَ
بعضُ المعترضين
ممن كلّت
أبصارهم عن
رؤية الواقع،
إمّا بسبب
ظلام الجهل
الّذي قد أحاط
بهم ولا
يكادون
يتخلّصون
منه؛ أو لمصلحة
تجعلهم
يكتمون الحقّ
عنادًا
ومكابرةً.
ويدخل في عداد
أولئك الجهلة
أبناءُ مشائخِ
المنطقةِ
الكرديّةِ
المتبعثرين
اليوم في
إسطنبول
وإزمير وأنقره،
الّذين
يطوفون في
شوارعها
للحصول على
لقمة العيش
ولا يكاد أحد
من أبسط الناس
يعبأ بهم فضلاً
عن رجال
السلطة. وهم
بالاختصار:
أحفادُ كلّ من
الشيخ خالد
الزيباري،
والشيخ أسعد
الخسخيري،
والشيخ خالد
الزيلاني[540]،
والشيخ عبد
الرحمن
التاغي،
وأبناء الشيخ
سيدا الجزري
(هم من سلالات
كردية)؛ وكذلك
أحفاد الشيخ
حامد المارديني،
والشيخ محمّد
الحزين
الفرسافي،
والشيخ عبد
الله الخالدي الْمَخْزومي،
والشيخ عبد
القهّار
الذوقيدي،
والشيخ فتح
الله
الورقانسي (وهم
شخصيّات
عربية ومنهم
مستكردة). وقد
غلب الجهل على
هؤلاء
المساكين إلى
حدٍّ لا يكاد
أحدٌ منهم
يفهم أنّ
الزمرة
الحاكمة قد أصبحت
اليوم في غنى
عنهم؛ ولذلك
قذفتهم في سلّةِ
القمامة.
ولكنها
تتعاون مع عدد
قليل جدًّا ممن
يحتفظ
بمكانته
وشهرته من
الشيوخ
النقشبنديّين
الأتراك
وتستغلُّ
زمرةً من
بينهم، لا
يتجاوز عدد
البارزين
منهم على سبعة
أشخاص فحسب.
وهم بالتحديد:
العقيد المتشيّخ
حسين حلمي
إشيك؛ ورجل يتـزعم
قطاعًا
كبيرًا من
جماعة النور
اسمه فتح الله
جولان؛ ورجل
في المنطقة
الجنوبية قرب
مدينة آديامان
(وهو عربي
مستكرَد)،
احتلّ مكان
أبيه وجدّه
الّذي ذاع
صيته بدعم
جهاز
المخابرات في
عهد مندريس؛
وزعيم
الطائفة
السليمانية؛
ورجل متشيّخٌ
مدسوسٌ (مثل الضابط
الّذي مرّ
ذكره) يقوم
بنشاطاته في
منطقة
ساكاريا،
ورجل من بقايا
الشعب
البُنْطُسيّ
اليوناني من
أهالي مدينة
طربزون. قد
اتخذ من مسجد
إسماعيل آغا
بإسطنبول
مقرًا
ومركزًا. وثَمَّ
شخص أخر، قد
خلّفه شيخ
الداغستانيين.
وهناك عدد أقل
ارتباطًا
برجال
السياسة وهم
خلفاء محمود
سامي رمضان
أوغلو
المعروف بـ »شيخ التجار«
في إسطنبول؛
وخلفاء
إسماعيل حقي
أهرامجي الّذي
كان يبث دعوته
من مدينة
سيواس في
أواسط آناضول.
ربما
يدافع بعض
الناس: »أنّ
هؤلاء الشيوخ
هم أهل الزهد
والنسك، معتكفين
في تكاياهم،
يذكرون الله
قيامًا
وقعودًا وعلى
جنوبهم،
مشغولين عن
الدنيا
وملاهيها، لا
يراهم أحد في
الشوارع
أبدًا... إذن،
فهل يجوز أن يكونوا
متواطئين مع
رجال السياسة
الّذين لا يهمهم
إلاّ
المصلحة، و هل
يجوز أن
يتعاون هذان الجمعان
المختلفان في
العقيدة
والفكر والسلوك
ياترى؛
وبخاصّةٍ ضدّ
أهل التوحيد
الّذين
يلتقون مع
النقشبنديّين
صباح مساء تحت
سقوف المساجد
على أقل تقدير(؟!)«
إنّ
الّذين
يجهلون مدى
حقد
النقشبنديّين
على أهل
التوحيد
الخالص، ربما
يرون في مثل
هذا الدفاع
ضرورةً على
حسب ما يتراءى
لهم من الظاهر.
كما يبرهن هذا
الجهل منهم
على جهلهم
بحقيقةٍ أخرى.
وهي أنّ منطقَ
الإنسان
النقشبنديّ
يسمح له بالتعاون
مع كلّ مَنْ
يصدّقه على
أساطيره
وعقائده إلى
حدود بعيدة،
ولو كان
يهوديًّا أو
نصرانيًّا،
ويضيق صدره عن
كلّ مَنْ
يكذّب
أساطيره
ويرشده إلى
توحيد الله وإن
كان حنيفًا
مسلمًا.
لذا،
يرفض الرجل
النقشبنديّ
على الإطلاق،
أن يتعاون مع
أيّ إنسانٍ لا
يعتقد
بمعتقداته المرسومة
في طريقته؛ و
إذا شاركه في
عمله، لا يُخلص
له أبدًا؛ بل
يضمر له
البغضَ
ويحتقره ويستقذره،
ويتربص فرصة
الإيقاع به
متى سنحت له، وإن
كان ذلك
الإنسان، من
أتقى الناس و
أعلمهم،
وأفضلهم
سلوكًا،
وأحسنهم
خلقًا؛ ولكن
الرجل
النقشبنديّ
لا يقصّر في
التعاون مع
أيّ شخصٍ
يتظاهر له
بالتصديق على
كرامات شيخه
والتعظيم له،
والموافقة
على معتقداته
و ممارساته
لآداب
طريقته، وإن
كان ذلك الشخص
ملحدًا، دهريًّا
أو مشركًا!
ولهذا لم
يتخلّف
النقشبنديّون
- على الأقلّ -
عن التحيُّز
إلى الفئة المتغلّبة،
وعن العمالة
للنطام
الحاكم، واتخاذ
الموقف
المضادِّ من
أهل التوحيد
الحنفاء. بل
قد شاركو
الحكومات العلمانيّة
في مواقف
عديدة وبصورة
فعلية ضدَّ المؤمنين
الحنفاء، وإن
اقتصر ذلك على
إبداء الرأي
غالبًا.
أمّا
الأمارات،
فإنها أكثر من
أنْ تُحصى.
ومن كُبْرَيَاتِهَا:
أنّ أحدًا من
مشائخ
الطريقة النقشبنديّة
لم يَنْبِسْ
ببنت شفةٍ
استنكارًا
لما تقوم به
السلطةُ من
تصرّفاتٍ
ظالمةٍ
بإهانة المسلمين
وغصب حقوقهم،
ولم يُبْدِ
أحدٌ منهم
إدانَتَهُ
لموقفها
المتسامح مع
أجهزة
الأعلام اليهوديّة
التركيّة في
حملاتها على
الإسلام والمسلمين،
وسخريتها
بالمقدّسات الإسلاميّة
من غير
هوادةٍ. كما
لم يُسمَعْ من
أحدِهم إنّه
دافع عن
المسلمين
المضطّهَدين
في أنحاءِ العالمِ
ولو بكلمةٍ
واحدةٍ، ولا
عن الفلسطينيّين
المعرَّضين
للقتلِ
والإبادةِ من
قِبَل الصهاينة.
كذلك
الاستشارات
الّتي يقوم
بها أعداد من
رؤساء
الأحزاب السياسيّة
لدى هؤلاء
الشيوخ
المشهورين،
واجتماعاتهم في
المناسبات،
تدلّ على ما
هنالك من
حوارٍ مستمرٍّ،
وعلاقات
وتعاون بين
الطرفين؛
وإنْ كان لا
يتمكّن أحد من
الإطّلاع على
أسرار هذه العلاقات
غير بطانتهم.
وهى في
حقيقتها
محاولات،
يريد بها كلّ
من الطرفين
أنْ يستغلّ
الآخر من غير
شكٍّ. إلاّ
أنّ مكتسبات
السياسيّين
في استغلال
النقشبنديّين،
يترجّح بكثير على
ما ينال
النقشبنديّون
من مصالح
بوساطة السياسيّين.
ذلك
أنّ نسبة طاقة
الدعم
السياسيِّ
الّتي يمثّلها
النقشبنديّون
في تركيا تفوق
على خمسة وستّين
في المائة.
هذا بغضّ
النظر عن
الأعداد التي تُحرّكُها
هذه الطائفة
بطرقٍ غيرِ
مباشرةٍ،
وتجتذبها إلى
صفوفها في
مواسم
الانتخابات،
لا تقل عن
سبعة في
المائة. وهكذا
تنجلي أمام العيون
بأنّ هذه
القوّة
الهائلة كيف
قد تحولت إلى
آلةٍ خطيرةٍ
بيد الأحزاب السياسيّة
في تحريك عجلة
الديمقراطية
الزائفة في
تركيا، وكذلك
في مقاومة
الحركات السياسيّة
الّتي
تحاربها
الزمرة اليهوديّة
الحاكمة!
***
*
الفِرَقُ
الرئيسة
للنقشبنديّين
في تركيا اليوم.
بهذه
المناسبة
ينبغي
الإشارة هنا
إلى أنّ النقشبنديّين
اليوم في
تركيا،
موزَّعون في
صفوف سبع جماعاتٍ
رئيسةٍ
تابعةٍ
للأشخاص
المذكورين
آنفًا. إلاّ
أنّ هذه
الجماعات،
يختلف بعضُها
عن بعض من حيث
التكوين
الإجتماعيِّ
والمستوى الثقافيِّ
والنشاط
السياسيِّ
اختلافًا
بارزًا.
يمتاز
من بين هذه
الْفِرق،
جماعة الشيخ محمّد
زاهذ كوتكو
برجالها
المثقَّفين؛
وكان في مقدّمتهم
ترغوت أوزال
الّذي استطاع
أن يحتلّ منصب
رياسة
الجمهوريّة؛
وكذلك منهم
نجم الدين
أرباكان (رئيس
الوزراء
الأسبق)،
وعددٌ كبيرٌ
من الأساتذة
موزَّعون
اليوم في
جامعات تركيا.
إنّ
الشيخ محمّد
زاهذ كوتكو
(المعروف بشيخ
الداغستانيّين)،
كان خالديَّ
المشرب، من
أتباع أحمد
ضياء الدين
الگُمُوشْخَانَوِيّ.
احتلّ منصبَ
الخلافةِ
بعده بإجازتين
من خليفتيهِ:
عمر ضياء
الدين ومصطفى
فيضي، وبدأ
يبثّ تعاليمه في
إسطنبول، فاستطاع
أن يؤثِّرَ
على طلاّب
الجامعة منذ
عام 1960م.
فانضمَّ إلى
أتباعه نخبةٌ
من الشباب
المثقَّفين؛
ثم ترابطوا فيما
بينهم حتّى
برز منهم شخصيّات
تدرّجوا
علىالصعيد
السياسيِّ
وشاركوا العلمانيّين
أخيرًا في
تشكيل
حكوماتٍ
وتنصيص
قوانين وتنفيذ
مشروعاتٍ
هامّةٍ.[541]
ومن
هذه
الفِرَقِ؛
طائفةٌ
مفتتنة
بعقيدٍ متشيّخ
مرّ ذكره
بالتفصيل.
تتكوّن هذه
الطّائفة من
طبقةٍ
مثقَّفَةٍ
مكلَّفَةٍ
بالتوجيه،
وأخرى عامّيّةٍ
مكلَّفَةٍ بالتَّقْلِيدِ
والتَّنْفيِذِ.
مهمّةُ هذه
الطّائفةِ
تتعيّن في حرب
السلَفِيّينَ
وأهل التوحيد؛
وترسيخ »العقيدة
السُّنِّيَّةِ
التركيّة التقليديّة«
على أساس
تقديس الملوك
والسلاطين
الأتراك، وتقديس
العنصر
التركيّ والدّولة
التركيّة. لذا،
تُعتَبَرُ
هذه الفرقة من
أهمّ الصفوف
الّتي تستقوي
بها الحكومات العلمانيّة-العنصريّة،
وتستخدمها في
ترسيخ فكرة العصبيّة
التركيّة.
لقد
اتّخذ العقيدُ
المذكورُ
الأسرةَ
الأرواسيّة
رمزًا لدعوته
وتوجيهاته
طمعًا في
احتكار الصفة
الّتي اشتهر
بها الأرواسيّون
بنسبتهم إلى
السلالة
الهاشمية؛
كما استطاع من
جانب آخر أن
يستخدم أبناءَ
هذه الأسرة في
بثّ »الديانة
السنِّيَّةِ
الأرثوذكسية التركيّة«
تظهر
شطارة هذا
الرجل من خلال
بعض محاولاته
على سبيل
الإحتكار.
منها
استجازتُهُ
في العلوم الإسلاميّة
على يد الشيخ
أحمد مكي أفندي
بن الشيخ عبد
الحكيم
الأرواسيّ،
وذلك بالرغم
من عدم كفاءته،
إذ أنّه على
الأصح لم يدرس
هذه العلومَ
الشريفةَ. بل إنّه
رجلٌ عسكريٌّ
متخصّصٌ في
علوم الصيدلة
والكيمياء.
ثمّ قام بطبع
هذه الإجازة
مع عددٍ من
رسائل متفرّقةً
ضمن مجلّد
واحد لا علاقة
بينها وبين
هذه الرقعة.
ومن تلك
الرسائل »فتاوى
علماء الهند
على منع
الخطبة بغير العربيّة«. تَمَّ
نشرها من
قِبَلِ مكتبة
الحقيقة في
إسطنبول عام 1996م.[542]
***
ومن
هذه
الفِرَقِ؛
أيضًا »جماعة
النور«.
وهي أصلاً
منشقّةٌ من
الطريقة النقشبنديّة
ومتفرِّقة في
صفوفٍ
متعاكسةٍ. برز
في الآونة
الأخيرة رجلٌ
من بينهم اِسْمُهُ:
»فَتْحُ
الله جُولاَن«،
فاستعمل
لباقتَهُ مع
بطانته في
تأسيس سلسلة من
المدارس
والمعاهد
الخاصّة في
انحاء تركيا
وخارجها،
امتازت بنظامِهَا
الدقيق،
وبرامِجِها
الدِّرَاسِيَّةِ
المطوَّرة،
وطُلاَّبِهَا
وخرّيجيها
الناجحين
البارزين على
أصعدة مختلفة،
اغتبط بهم
أبناءُ
الأثرياء
والمترفين! ثم
بدأ يستخدمهم
في نشر »الدّيانة
السنِّيَّةِ
الأرثوذكسية التركيّة«.اشتهر
هذا الرجل
أخيرًا إلى
درجةٍ أحسّ
السياسيون في
تركيا بحاجةٍ
إلى دعمه.
وقام بزيارة البابا
إلى روما عام 1997م.
وتَبَادَلَ
العلاقاتِ مع
رجال السياسة،
وحضر الندوات
والمؤتمرات
العالميّة
على سبيل التّحدّي
لمعارضيه!
لهذه
الجمعية
أجهزةٌ
إعلاميّةٌ
ضخمةٌ، تستغلّ
كُتُبُ الشيخ
سعيد
النُّورْسِيّ
في بثّ دعاياتها
عن طريق شبكةٍ
مؤلّفةٍ من
الصحف والإذَاعَاتِ
وَقَنَوَاتِ
الإِنْتَرْنَتْ.
اتّخذت الحكومة
احتياطاتٍ
ضدّ هذا الرجل
عقب انتشار
بطانته في
أجهزة
الدّولة بشكل
ملحوظ، وبدأت
الاستعدادات
الأمنيّة
للقبضِ عليهِ
مخافة أن
ينقضّ على
جهاز الحكم،
وإذا به قد
غادر البلادَ
وأقام في
أميركَا.
***
ومن
هذه
الفِرَقِ؛
السليمانيّون.
وهم طائفة من
النقشبنديّين
من أتباع »الشيخ سُلَيْمَان
حِلْمِي طُونَاخَانْ«
المشهور
بمعارضته
لمعاهد الأئمّة
والخطباء،
اعتقادًا منه
أنّ الحكومات العلمانيّة
تتعمّد
الإضرارَ
بالعقائد التركيّة
التقليديّة
عن طريق هذه
المعاهد.
اهتمّ
بفتح المدارس
القرآنيّة في
أنحاء تركيا،
تمهيدًا لبثّ
طريقته
وعقيدته من
خلال هذه
المدارس.
فانخرط كثير من
الناس في
صفوفه
بتأثيرها.
لقيَ
»سُلَيْمَان
حِلْمِي طُونَاخَانْ« من
حكومة »عَدْنَانْ
مَنْدَرِيس«
ضغطًا شديدًا
لاهتمامه
بتحفيظ
القرآن. وكان مَنْدَرِيس
أيضًا تحت ضغط
»اليهود
الدُّونْمَا«
مرغَمًا على
كفاح كلّ حركةٍ
من شأنها فتح
باب الصحوة
للمسلمين. لذا
كان مَنْدَرِيس
يهتمّ يومئذ
بجمع
النقشبنديّين
حول رجلٍ
أبلهَ في
المنطقة
الشرقية
لتخدير مشاعر
الناس وصدّهم
عن التّيّارات
الإسلاميّة.
أمّا
»سُلَيْمَان
حِلْمِي طُونَاخَانْ«،
فإنّه كان
رجلاً ذكيًّا
جريئًا،
استعمل لباقَتَهُ
في توجيه
الناس إلى حفظ
القرآن
الكريم حتّى
تمكّنَ بذلك
من نفخ عقائده
إلى ضمائرهم!
نشأ
على يده رهط
من الدجاجلة اعتنقوا
عقيدتَهُ وتبعثروا
بين الناس
للدعوة إلى
تعاليمه، وادّعوا
بعد موته »أنّه
أويسيٌّ اتّصل
بروحانيّة
السرهنديّ
واستفاد منه«. كما
ادّعوا أنّه »الِمهديُّ
الْمُنْتًظًرُ!« فتبيّن
أنّ هذا
الإعتقاد لا
يزال يسري بين
مختلف جموع النقشبنديّة،
سواء الخالديّين
منهم وغيرهم.
لأنّ هذه
الفرقة ليست
خالديَّةَ
المشرَبِ.
ويعدّه
أصحابُهُ من
الطبقة الثالثة
والثلاثين من
سلسلتهم.
وردت
قصّةُ حياته
أخيرًا في
رسالةٍ دوّنها
الأستاذ
الدكتور أحمد
آقجندوز، تمّ طبعها
ونشرها على
نفقة مؤسّسة
أوْقَافِ الْبُحُوثِ
العثمانيّة (أوساف)
في إسطنبول
عام 1997م.
***
ومن
هذه
الفِرَقِ؛
جماعةٌ
غالبُها من
سُكّان سواحل
البحر الأسود
(المعروفة
قديمًا باسم: »لاَزِسْتَانْ«)؛
يرأسُهم رجلٌ
متـزمّت من
نفس المنطقة.
أقدم أخيرًا
مع أشخاصٍ من بطانته
على كتابة
تفسيرٍ
للقرآن
الكريم باللّغة
التركيّة
وبأسلوبٍ
صوفيّ تحت
عنوان »روح
الفرقان«
كما مرّ ذكره.
استهدف بذلك
معارضةً
شديدةً من
جانب أهل
التوحيد؛
وكاد أن
يتطوّر الأمر
إلى فتنة بين
هذه الفرقة
وبين المسلمين.
تّمَّ طبع هذا
الكتاب من
قِبَلِ دار
السِّرَاج
(يتولاَها ابن
أمين
السّرّاج!).
أحسّتْ
الحكومة العلمانيّة
في الآونة
الأخيرة بما
اكتسبت هذه
الجماعة من
القوة، فدبّر
جهازُ
المخابرات
مؤامرةً
لاغتيال بعض
البارزين من
هذه الفرقة
تأديبًا لها!
راح ضحيتَها
ملاّ خضر
أفندي صهر شيخ
الجماعة. طعنه
عميل
للمخابرات
بخنجرٍ داخل
مسجد لهم بحيِّ
الفاتح في
إسطنبول، مات
فورًا. كما
وضعوا
تابوتًا
فارغًا أمام
منـزل الشيخ،
وعددًا آخر من
التوابيت عند
باب كلّ من
نائبه وبعض
رجال حاشيته
على سبيل
التهديد:
بأنّهم
معرّضون
للخطر إذا ما
صدر منهم أدنى
حركة ضد
الحكومة
وسياستها.
وثَمَّ
فرقتان
أخريان من
النقشبنديّين
يتعاون
النظام
الحاكم معهما
إلى أبعد
الحدود ويستخدمهما
في أغراضها
وتحقيق ما
يناسب من
أهدافها، خَاصَّةً
فِي شَلِّ
حَرَكَةِ التّيّارات
الإسلاميّة! تمركزتْ
إحداهما في
قريةٍ اسمها »المنـزل«
وهي من ضواحي
مدينة »آديامان«.
لهذه الفرقة منظّمةٌ
سرّيةٌ
أفرادها من
الضّبّات
المتقاعدين.
يقومون ببثّ
دعاياتٍ
كثيفةٍ لشيخ
هذه الجماعة
في كافّة
أنحاء تركيا.
لم يسلم أحد
من التعرّض
لهذه الدّعايات
على الساحة التركيّة
إلاّ قليلاً
من المعزولين
عن الحياة الاجتماعيّة.
يتسلسل شيوخ
هذه الفرقة من
نفس الأسرةِ؛
يُخَلِّفُ
الإبنُ الأكبرُ
أباهُ بعد
موته مباشرةً
ودون أيّ نزاع
على غرار الْمَلَكِيَّةِِ،
لكي لا تَدْخُلَ
الجماعةُ تحتَ
سيطرةِ شيخٍ
خارجَ الأسرة!
تمتدّ
العلاقة بين
هذه الأسرة
وبين
الخزنوييّنَ
في شمالِ
سوريا. والخزنوية
أسرة نقشبنديّة
خطيرة كرديّة
الأصلِ،
اتّخذتْ من
قرية »تل
معروف«
مقرًّا منذ
قرنٍ، وهي على
مقربة من
مدينة »قامشلي«. أسَّسَ
هَذِهِ
التّكِيّةَ
رجلٌ اسمه: أحمد
بن مراد في
نهاية القرن
التاسع عشر. اعتمدت الأسرةُ
الخزنويّة
التقاليد الهندوكيّةَ
في التعبّد، تمسُّكًا
بالعقيدة
الخالديةِ
واتّبَاعًا
بالأسرة
الخانيّةِ. وعملتْ
على إحياءِ
تعاليم »بوذا«
في قميصٍ من
الشغف
بالموتى. امتازتْ
بلباقتها في
استمالة قلوب الناس
بأساليبِ
صوفية الهندِ.
ركّزتْ
الإهتمامَ
على المناسك البوذيّة.
أصرّت على
إقامة حفلة »التَّوَجُّهِ« خاصّةً،
وهي من طقوس
مجوس الهند،
قمّصتها
قدماء النقشبنديّة
الأوّلون
للتّعمية؛
يقلّدهم
الأخلافُ على جهل
منهم. وقد
بلغت التقليديّة
في متأخّري
شيوخ النقشبنديّة
إلى درجة انّ
أحدًا منهم لا
يفكّر لحظة
ليتساءل في نفسه
عمّا إذا كان
لهذه الحفلة
الغريبة أيّ علاقة
بالاسلام!
ساعدتْ
حكومةُ (مندريس)
هذه الأسرةَ
على رغم
وجودها خارج
الأراضي التركيّة!
فنالتْ دعما
ماليًّا من
تركيا (بطرقٍ
خاصّةٍ) طوال
العقد الخامس
من العصر
المنصرم. ثّم
ناب عن شيخ
هذه الأسرةِ (في
تركيا) رجلٌ
من أهل ضواحي
مدينة بتليس (التركيّة)
اسمه عبد
الحكيم البلوانسي،
فطارَ صيتُهُ
في الآفاقِ
بواسطة
منظّمةٍ تمّ
تكوينها على
غرار
المافيا،
وذلك بتعليمات
خاصّةٍ من
رئيس
الوزراءِ (عدنان
مندريس). ولا
تزال هذه
المنظّةُ
تواصل
مهمّتها.
وأمّا
الفرقة
الثانية،
فإنّها أيضًا
جماعةٌ
مشبوهةٌ، أغلب
أفرادها
شبابٌ غوغاءُ
من حثالة الناسِ،
مفتتنون بالعصبيّة
التركيّة،
يكتبونَ
ويطبعونَ ما
يُملي عليهم شيخهم
(عمر أُونْگَُوتْ)
مع جهله
المركّب، من
تأويلاتٍ
وتفسيراتٍ
شاذّةٍ
للآيات الكريمة
والحديث
النبويّ.
وَصدَرَ
أخيرًا
كُتَيْبَاتٌ
لهذا الشيخِ، شنّ
فيها حربًا
شعواءَ على
شيوخ النقشبنديّة،
فَرَمَاهُمْ
بالكفر
والزندقةِ
وهم في ذُعْرٍ
منه
لِعِلْمِهِمْ
بأنَّ
النظامَ
يدعمه بِطُرُقٍ
خاصّةٍ
لأثارة
الإضطرابِ
والشغبِ بين
جماعات
الصوفيّةِ،
تفاديا
لاحتمالات
التقارب
بينها. وهذا
يذكّرنا بقوله
تعالى: سَنُلْقِي
فِي قُلُوبِ الَّذِينَ
كَفَرُواْ الرُّعْبَ
بِمَآ أَشْرَكُواْ
باللهُ مَا لَمْ
يُنَزِّلْ بِهِ
سُلْطَاناً وَمَأْوَاهُمُ
النَّارُ وَبِئْسَ
مَثْوَى الظَّالِمِين
(آل عمران/151).
***
* أهم
الحركات السياسيّة
الّتي
استخدمتْ
السلطةُ
النقشبنديّين
في
مقاومتها.
إنّ
استخدام
السلطة
للنقشبنديّين
لم ينحصر في
الحرب ضدّ الوهّابيّين
فحسب، وإنّما
شمل الحربَ
ضدّ أحزاب،
وحركات سياسية
كثيرة في
العهد
الجمهوريّ،
أهمها أربعة،
مرّ ذكرها
بإيجاز. إنّ
الدخول في
تفاصيل التعاون
بين السلطة
والنقشبنديّين
في كلّ هذه
الحروب، ربما
يتجاوز في بعض
نواحيها حدود
بحثنا. لذا،
نقتصر على
النتائج السلبيّة
لهذا
الاستغلال
الّذي تمخّض
عن أضرارٍ
كبيرةٍ على
الإسلام
والمسلمين.
استغلّتِ
السلطةُ
النقشبنديّين
في مقاومة
الحركة
الماركسية مدةً
أكثرَ من
خمسةٍ
وثلاثين
عامًا بعد
العقد الرابع
من العصر
المنصرم.
فجنّدتهم في
صفوف »جمعية
الكفاح ضدَّ
الشيوعية«.
فأثارت بذلك
فيهم نزعة
الرأسماليّة
البحتة
وروّضتهم على
الانتماء إلى
هذه الفكرة
باسم الحريّة.
فأصبح مفهوم
الحريّة
مشوّهةً
بصبغتِها،
وسادت في هذه
الصورة على
عقولهم. ولم
يكن الناجح في
هذا التعاون
إلاّ اليهودَ
الرأسماليّين.
فازدادوا
بذلك قوةً
حتّى
استغلّوا
النقشبنديّين
في أغراضٍ
أخرى، كما
تحكّموا
فيهم، وقادوا كلّ
جماعةٍ منهم
في وُجْهَةٍ
لا تلتقي فيها
بجماعةٍ أخرى
من
النقشبنديّين؛
فسدّوا عليهم
بذلك طريق
السياسة
المباشرة
بحيث كلّما
قامت فئةٌ من
النقشبنديّين
بتشكيل حزب
سياسيٍّ قضوا
عليه قبل أن
يتسلّم زمام
الحكم؛
وسلّطوا بعضهم
على بعضٍ،
كتجربتهم في
تصعيد ترغوت
أوزال على
منافسيه.
لأنّه كان
نقشبنديًّا
علمانيًّا
متعصّبًا
لتعاليم يهود
سالونيك.
دام
استغلال
السلطة
للطائفة النقشبنديّة
في مقاومة
الماركسيّة
حتّى سقطت
الإمبراطوريّة
السوفيتيّة
وانقشعت غيوم
الذعرِ
فاطمأنّت
الزمرة الحاكمةُ
من مداهمة
الروس لأراضي
آناضول.
فاعتاد النقشبنديّون
عبر هذا
التعاون على
جميع تعاليم
يهود سالونيك
من العلمانيّة،
وممارسة
القواعد
الظالمة
للنظام
الرأسماليِّ،
وطقوس الشرك
بأنواعها؛
كما تأثّرت واستورثت
العداوة لأهل
التوحيد
الحنفاءِ الّذين
يرفضون عبادة
الموتى،
ويتجنّبون
تخليد ذكر
المخلوق و
الاستمداد من
غير الله.
استغلّ
يهود سالونيك
المتغلّبون
على مرافق
الدولة التركيّة
بوساطة
حكومات
مزيّفة،
استغلّوا
فئاتٍ من شباب
عائلاتٍ نقشبنديّة
في القضاءِ
على الحركة الإرهابيّة
الّتي قامت
بها عصابات
أرمنية ضدَّ
الدبلوماسيّين
الأتراك في
الخارج ما بين
1970-1985م.
ثمّ قضوا
أخيرًا على
هؤلاءِ
الشباب
بوساطة منظمةٍ
مهمّتُها
اغتيال
أشخاصٍ
اطّلعوا على
أسرارهم!
إنّ
كثيرًا من أهل
الصحوة الإسلاميّة
مهدَّدون
أيضًا اليوم
باعتداءات
هذه المنظمّةِ
الخطيرة.
ثم
استغلّت
السلطةُ
جماعةً من
أبناء
النقشبنديّين
الأكراد ضدّ
الحركة
الانفصالية
الكرديّة
الّتي قام بها
حزب العمال
الكردستاني،
وذلك بتشكيل
حزبٍ سرِّيٍّ
آخر باسم »حزب
الله«[543] ولكن
السلطة اليهوديّة
قد أصبحت في
عجز عن ضبط
هذه المنظمة.
لأن عنانها قد
انفلتت في
الآونة
الأخيرة من يد
من كان يوجّهها
حسب أوامر
الطغمة اليهوديّة
الحاكمة كما
يبدو. وثَمَّ
أشخاصٌ
بارزون بثقافتهم
ومكانتهم الاجتماعيّة
من أبناء
مشاهير النقشبنديّة،
تطوّعوا ضدّ
المنشقّين
الأكراد
بأقلامهم ودعاياتهم
الإعلامية؛
وعلى رأسهم
أحمد الأرواسيّ.[544]
إنّ أحمد
الأرواسيّ
الّذي شاع بين
مريدي آبائه
أنّ عائلتَه
تنحدر من
سلالة الحسين
بن علي ابن
أبي طالب رضي
الله عنهما،
من الغريب أنّه
يتناسى هذه
النسبةَ، بل
يكتمها
بلباقةٍ عندما
يهاجم القوميّة
الكرديّةَ
ويشدّد
النكيرَ على
من يدّعي أنّ للأكراد
لغة خاصّة
باسم اللّغة
الكرديّة. والّذي
يُستَغْرَبُ
من أحمد الأرواسيّ
في هجومه
الّذي نشره في
كتابٍ خاصٍّ؛[545] أنّه
اتخذ هذا
الموقفَ
الحماسيَّ من
منطلَق الدفاع
عن القوميّة التركيّة
إرضَاءً
لشهوة الزمرة
الحاكمة.
هذا،
وإنّ قادة
الحركة
الانفصاليّة
الكرديّة لما
تأكّدوا من
أنّ السلطة
تستخدم
النقشبنديّين
في الكفاح
المسلح ضدّهم
من جانب، كما
تستخدم رهطًا
من مثقّفيهم من
أمثال أحمد
الأرواسيّ في
تخدير مشاعر
الأكراد
وتعميتهم عن
الصحوة القوميّة
من جانب آخر؛
بدءوا يوجِّهون
ضرباتهم إلى
عائلات نقشبنديّة،
واستعدّوا
لاغتيال
شيخهم »محمّد
راشد أَرُول« الّذي
كان جدُّهُ قد
نُصب على هذه
الطائفة
كمرجعٍ أعلى
بإيعاز من
رئيس الوزراء
الأسبق، عَدْنَانْ
مَنْدَرِيس.
ولكن القوَات
الأمنيَة
قامت بالقبض على
»الإرهابيّ« في
لحظته؛ وكان
جدُّ هذا
الشيخ قد
نُقِلَ إلى ناحيةٍ
بقرب مدينة
أديامان
النائية عن
ساحة النشاطات
السياسيّة
للأكراد،
لنفس الأسباب
قبل انتشار
الحركة
الانفصالية
إلى جميع
أنحاء
المنطقة يومئذ.
إنّ
استغلالَ
السلطةِ
للنقشبنديّين
ضدَّ كلّ هذهِ
الحركاتِ السياسيّة
والإرهابيّة،
في الحقيقة
كان الهدفُ منه،
ترويضَهُمْ
على السيرِ
طبقًا
للقواعد
المرسومة
لهم؛ وعلى الطاعة
العمياء في
الخطوة
الأولى؛ فاستخدمتهم
بصورةٍ
فعليةٍ في خلق
جوٍّ مطلوبٍ
لإذابة
الجموع
المضادَّةِ
للزمرة اليهوديّة
الحاكمة في
بوتقة
العلمنة
والإلحاد
كمرحلةٍ
ثانيةٍ؛
وترسيخ قواعد
الرأسماليّة
ضدّ
المستضعفين، وسدَّ
الانتباهَ
ضدّ الصحوة الإسلاميّة
الّتي بدأت
منذ سنين
تنتشر في
أنحاء العالم
كخطوة ثالثة. فقد
تحقّقت هذه
الأهداف إلى
حدود بعيدة.
فانّ كثيرًا
من الناس
الّذين ما
زالوا
يعتزُّون بالإسلام
ويهتفون
باسمه، فقد
تغيّرتْ
المفاهيمُ
القرآنيةُ في
عقليتهم،
واتخذت صورةً
أخرى غريبةً؛
والتبس عليهم
الحقُّ
بالباطلِ؛
وأصبح
الإسلامُ في
اعتقادهم
عبارةً عن سلسلةٍ
من حكايات
الصالحين،
وحفلات
المولد
النبويِّ،
وزيارة
القبور،
وتعظيم
الموتى، والاستشفاع
بهم. فانّ
خلاصة ما
يُعرَفُ من
مفهوم
الإسلام اليوم
في معتقد
العامّةِ، أنّه
لا يعدو عن
علاقةٍ
شخصيّة للعبد
بمعبوده فحسب؛
دون أي شيءٍ
آخر من
علاقاته
ونشاطاته
وأفعاله مع
بني جنسه في بقيّة
مجالات
الحياة.
ولذا
كثيرًا ما
يثور
المارقون على
المسلمين،
فيقولون لهم
في استغراب
وتساؤل على
سبيل التحقير:
- هل
منعكم أحد من
الصوم
والصلاة
والحجّ والزكاة؛
ثم ماذا
تريدون بعد
هذا القدر من
الحرية؟! نعم
هكذا
يتساءلون
بعُنْجُهيةٍ
وحماقةٍ وغطرسة،
ولا يتفكّرون
أنّهم لو
زحفوا بجيوش
الدنيا على
الرجل المسلم
ليمنعوه من
الصلاة ما
استطاعوا ذلك
رغم أنف كلّ
منهم! لأنّ
المسلم
يستطيع أنْ
يؤدِّيَ
صلاتَهُ
بشكلٍ من
الأشكال ولو
بإجراء
أركانها على قلبه
في أسوأ حالٍ.
ولكنّ
المصيبةَ،
أنّهم لا يكادون
يصطدمون بمثل
هذه الإجابة
الّتي هي أخطر
عليهم من
قنبلة ذريّة!
لأنّ المجتمع
قد تحوّل إلى
قطائع من
النقشبنديّين
المعتادين
على الخضوع
والتذلُّلِ والاستسلام
ليهود
سالونيك.
ولأنّ
الإنسان النقشبنديّ
يعتقد بكلّ
مَنْ
يملك زمامَ
أمرهِ، أنّه
من »أُولِي
الأمْرِ«؛
الّذين قال
تعالى فيهم {
وَأَطِيعُوا
اللهَ
وَأَطِيعُوا
الرسُولَ
وَاُولِي
الأَمْرِ
مِنْكُمْ.}،
ولو كان من
يهود سالونيك!
هذا ما قد حلّ
بالإسلام في
تركيا على يد
اليهود،
بالتعاون مع
النقشبنديّين؛
وإن كان ذلك
عن كراهية
المثقفين
منهم، وعن جهل
شيوخهم،
وحماقة
الملتفّين
حول هؤلاء الشيوخ
من حثالة
الناس.
***
*
تلفيقات
النقشبنديّين
في كثير من
أقوالهم
ومواقفهم.
إنّ
الصوفيّة
عمومًا طائفة
انتقدهم
العلماءُ
قديمًا
وحديثًا؛ وقد
اشتدّ عليهم
كثيرٌ من
المحقّقين
بكلامٍ
لاذعٍ،
ورُمِيَ
غالِبُهُمْ
بالزندقة
والانحلال.
وقالوا إنهم
قومٌ تغمرهم
أمواجٌ من
الوهم
والهواجس
الغريبة،
وتنتابهم
تصوّراتٌ
وخيالاتٌ لا
يجدون لها
تعريفًا
وتوضيحًا؛
فتتساقط من
أفواههم
كلماتٌ
غامضةٌ، و عبارات
معقَّدَةٌ،
يظنُّها
الجاهل أنّها
إلهامات من
الله! »إذ
هو الّذي أوحى
إلى عباده
المرسلين من
آياته
البينات، إذن
فما المانع أن
يفيض بأمثالها
على أوليائه
المكرَّمين
من علومٍ لَدُنِّيَّةٍ
و عرفان
وإشراق
وإلهامات؟!«
لم
تختلف حالة
النقشبنديّين
عن حالة البقيّة
من الصوفيّة
في عباراتهم
ومواقفهم؛ بل
قد أطلقوا
الكلمة على
عواهنها في
مواطن كثيرة؛
فجاءت على
خلافٍ شديدٍ
بأصول المنطق
السليم والاستدلال؛
واهيةً
ملفّقةً. لذا،
من ردَّ
عليهم، أو خالفهم،
أو حتّى إذا
اكتفى
بالنصيحة
لهم؛ هاجموه
بلهجة قاسية،
وربما رموه
بالفسق والتعسّف
والإنكار،
وحتّى بالكفر
والزندقة؛ بل
لجأ بعضهم إلى
استعمال
الشدّة
والعُنْفِ.
وناهيك ما
قالوه في التشنيع
على الوهّابيّة
والسلفية،
وما تعرّض له
أهل التوحيد
من الاضطهاد
على أيديهم في
تركيا
والعراق
وأفغانستان،
بالإضافة إلى
ما قيل عن
ارتكابهم من
جنايات في مناطق
نائية لم تثبت
عليهم!
سنتناول
في هذا الباب
شطرًا من
آرائهم الّتي ادّعوا
فيها ما لا
حجّة لهم في
إثباتها؛
ومسائلَ أخرى
اختلفوا فيها
اختلافًا
فاحشًا. فجاء
مقال بعضهم
تكذيباً
لبعضهم
الآخر؛ كما سنتطرق
إلى أمثلةٍ من
الخصومة
والعداوة
الّتي جرت
بينهم، فلا نظلمهم
إذا سجّلنا ما
تقوم عليهم من
براهيَن قاطعةٍ
على أنّ
الصورة
الحقيقية
لهذه الطائفة
تتوارى بصورة
عابرة تظهر
للناس لطيفةً
نورانيةً مزخرفةً
بالحلم
والتسامح
والزهد
والتقوى والعفّة
والقناعة
والإخلاص!
***
*
مقتطفات من
آرائهم الّتي
ادّعوا أنها
من الدِّينِ
ولا
حجّةَ لهم في
إثباتها.
وعلى
سبيل المثال،
حاول
النقشبنديّون
ليقيموا
الصلةَ بين ما
سمّوه »الرّابطة«
وبين الإسلام.
وادّعى بعضهم
أنها فريضةٌ
من فرائض
الله.[546] و قال
كبيرُ
متأخّريهم
خالد
البغداديُّ »هي أعظم
أسباب الوصول
بعد التمسُّك
التامِّ بالكتاب
العزيز وسنة
الرسول«. ولكنّهم
عجزوا عن
إثبات ما
ادّعوه بأدنى
شيءٍ من كتاب
الله وسنة
رسوله r؛
على الرغم من
محاولاتهم
بشكل مستميت
كما مرّ في
الفصل الثاني
بالتفصيل.
وأغرب
من ذلك أنّهم
جميعًا قد
تهرّبوا من
إطلاق الحكم
على
الرّابطة، هل
أنّها شعيرة
من شعائر الدِّينِ
الإسلاميّ،
أو منسك من
مناسكه، وهل
يجوز التعبّد
بها؟ ويبدو أن
الأمر ضاق بهم
ذرعًا حتّى
لجأ أربعة أشخاصٍ
منهم عام 1994م. إلى فقيه
في إسطنبول،
اسمه خليل
كوننج،
يستفتونه عما
إذا تَدْخُلُ »رابطة
النفشبنديين«
في شمول
العبادة؟
فأجابهم
المفتي: أنّها
لا تُعَدُّ
نوعًا من
العبادة على
الإطلاق.[547]
هذا
مثال هامٌّ من
التناقض
والتضارب
والارتباك
الّذي وقع فيه
النقشبنديّون.
إذ أنّ هؤلاء
الأشخاص،
وسائرَ شيوخ الطائفة
الّذين
يتحاكم إليهم
جموع
المريدين ويراجعونهم
في جميع
مسائلهم، لو
لم
تَنْتَابُهُمْ
الشكوكُ في
أمر
الرّابطة،
وتردّدوا
فيما إذا كانت
هي شكلاً من
أشكال
العبادة؛
لَماَ أحسّوا
بضرورة
الاستفتاءِ
ليتأكّدوا من
حكم الإسلام
في شعيرة من
أهمّ شعائر
طريقتهم، وقد مضى
أكثر من مائة
وخمسين عامًا
على كون الرّابطة
كقاعدةٍ
أساسية
للطريقة النقشبنديّة.
مَثَلُهُمْ
في هذا
الاستفتاء
كمثل رجلٍ يدّعي
أنّه مسلم، ثم
يستفتي
العلماء في
الصلاة
المفروضة
مثلاً هل تدخل
فيما أمر الله
به؟ و أغرب من
ذلك، قيام
أربعة أشخاص
في استفتاء
فقيه لا علاقة
له بالتصوّف
ولا بالطريقة النقشبنديّة.
أمّا إجابة
المفتي على
سبيل
الاحتياط
بقوله »إنها
أصلاً ليست من
العبادة في
شيءٍ«،
ومُرَاوَغَتُهُ
بعد ذلك
بتعليق جاء
فيه (أنّها
مسألة
اجتهادية)،
أشدّ غرابة!
وحسبنا
ذكر حجّتين
دامغتين على
النقشبنديّين
بأنّ جميعَ ما
قد وضعوه
واختلقوه (من
الرّابطة،
والختمِ،
خُوَاجَگَانِيَّة،
وعدِّ ألفاظِ
الوردِ
بالحصى،
وإحصائِها
بكمياتٍ
معينةٍ،
وحبسِ النفَسِ
أثناءَ الوُرْدِ،
والارتداءِ
بوشاحٍ
أثناءَ الذكر
أيضًا،
والجلوسِ في
الحلقةِ
بعكسِ
التورُّك في
الصلاة،
والأركانِ
الأحد عشر...)؛ إنّها
جميعًا لا تعدو
كونها مستحدثات
وافدة دخيلة
على الإسلام
الذي جاء به
رسول الله r.
ولا شكّ في أن
أيًّا من هذه
المستحدثات
الغريبة ليس
من الإسلام في
شيءٍ ولا يمتّ
إليه بأدنى
صلةٍ.
الحجّة
الأولى منهما:
أنّ
المعارضين القُدَماءَ
وَالأشِدَّاءَ
على الصوفية
لوكانوا عثروا
على شيءٍ من
هذه
المستحدثات
في القرون الماضية،
لما مرّوا
علها مرورَ الكرام.
بل إنّهم
لبذلوا أقصى
جهودهم في
الردّ عليها،
وتفنيدها. إنّ
الّذين لم
يتردّدوا في
رمي حسين بن
منصور الحلاج
بالكفر
والزندقة (وهو
شهيد
الصوفيّة)؛ هل
يُعْقَلُ أنْ
كانوا قد عَثَروُا
على كلّ هذه
المختَلَقات
وسكتوا
عنها؟!!!
فهذا
تقي الدين
أحمد بن تيمية
الحرّاني، لم
تسنح له فرصةٌ
إلاّ وقد نال
منهم بأدنى حجّة.
كما حكم على
ابن عربي
بالكفر (وهو
الشيخ الأكبر
عند
الصوفيّة).
فلو كان عثر
على شيءٍ مما
استحدثه
النقشبنديّون
(كالرّابطة
وغيرها من
آدابهم
ومبادئهم
وطقوسهم)؛
لرماهم بالكفر
البواح،
ولأمطرهم
بوابل من اللَّعن
والشتم! بينما
نجد آثارَهُ
خاليةً عن كلّ
ما نتوقع منه.
وهذا من أقوى
البراهين على
أنّ الأمور
المذكورة
حديثةٌ
جدًّا، لم
يعرفها قدماء النقشبنديّة
(ما عدا
الأركان
الأحد عشر
الواردة في
الرشحات
لأوّل مرة)؛
كما تبرهن هذه
الحقيقة على
مدى التعارض
والتلفيق
الّذي وقع فيه
النقشبنديّون
لَمَّا
ادّعوا أنّ
هذه الأمور
منبثقة من
الإسلام، وأنّ
مصدرها
الكتاب
والسّنّة، و
أنّ أكابر النقشبنديّة
قديمًا كانوا
يمارسونها.
أمّا
الحجّة
الثانية
الّتي تقوم
عليهم بأشدَّ
من الأولى؛
وتُكَذِّبُهُمْ
في إسنادهم
تلك البدعَ
إلى الكتاب
والسّنّة؛ هي
سرّية هذه
الأمور.[548] لأنّ
النقشبنديّين
لا يمارسونها
إلاَّ في أماكنَ
خاصّة ومغلّقة
دون غيرهم.
يقومون فيها
بعقد حفلاتٍ
سرّيةٍ لا يحضرها
إلاَّ
بِطَانَتُهُمْ
من المنسوبين
إلى هذه الطريقة.
وقد يتسلّل
معهم إلى هذه
الحلقات بعضُ
المنتحلين.
فمنهم، من
يحضرها
ليلتقطَ معلوماتٍ
حول هذه
الطائفة
ومعتقداتها
بغرض البحث
العلميِّ،
ومنهم
موظّفون من
جهاز المخابرات،
قد كلّفت
السلطة
بعضَهم للدّعاية،
وبعضَهم
لأغراضٍ
أمنيةٍ!
نتساءل
الآن: هل فرض
الله على
طائفة
معيَّنَةٍ من
عباده أمورًا
ليقوموا بأدائها
تحت جناح
السرّ
وحرّمها على
غيرهم؟! وحتّى
فرضُ
الكفايةِ
الّذي يسقط عن
كثير من المسلمين
إذا قام به
بعضهم، لا
مانع من
الاشتراك للبقيّة
بشروطه؛
ويُثابُ عليه
إذا اشترك مع
المؤمنين في
أدائه، كما لا
سرّيةَ فيه.
زد
على ذلك أنّ
هذه الطقوس
والأنماط
الغريبة من
مناسك
البرهميّة
الّتي يتعبّد
بها
النقشبنديّون،
يجهلها جمهور
المسلمين؛
وحتّى أحفاد
الشيوخ
الّذين كانوا
يلقّنونها
الناسَ،
ويرأسون
الحلقات في
الماضي
القريب،
أبناؤهم
وأحفادهم
أيضًا يجهلونها
اليوم تمامًا.
وعلى سبيل المثال:
فانّ أحفادَ كلّ
من الشيخ طه
النهريّ،
والشيخ صبغة
الله الحيزانيّ،
والشيخ محمّد
الحزين
الفرسافي،
والشيخ حامد
المارديني، والشيخ
خالد الجزري،
والشيخ خالد
الزيباري،
وأبناءَ
خلفائهم
(باستثناء
عددٍ قليلٍ
منهم جدًّا)؛
لا يعرفون
شيئًا من هذه
الآداب، ولا
يكادون
يستحضرون في
أذهانهم: ما
هي الرّابطة،
وهل يجب حبس
النفَسِ
أثناء الذكر،
والجلوس بعكس
التورّك في
الصلاة، و ما
معنى »هوش
دردم، ونظر
برقدم، وسفر
در وطن، وخلوت
درأنجمن...إلخ«؛
وهل هذه
أشكالٌ من
العبادة في
الدِّينِ
الإسلاميِّ؟
بالإضافة إلى كلّ
ما سبق، فانه
لا يكاد أحد
منهم يفتكر
اليوم في
اتخاذ مرشدٍ
يلقّنهم
الطريقة النقشبنديّة؛
مع أن آبائهم
وأسـلافهم
كانوا
يعتقدون أنّه »من لا شيخ له
يرشده فمـرشـده
الشيطان«[549] على
الرغم من هذه
الحقيقة أنّ
عددًا من
هؤلاء
الأخلاف،
يصلّون
الخمسَ،
ويصومون
رمضان، ويحجّون
وقد يزكّون؛ ويعتقدون
أنّها فرائض
يحرم تركها.
إنّ
هذا الواقع
حُجَّةٌ
دامغةٌ على
النقشبنديّين،
تدلّ على مدى
وقوعهم في التلفيق
والتعارض
والتضارب في
أقوالهم ومواقفهم
ومزاعمهم
الّتي يدّعون
أنّها مستمدّة
من الكتاب
والسّنّة.
***
* مسائل
متفرّقةٌ
اختلفوا فيها
اختلافًا صريحًا،
بحيث جاء مقال
بعضهم
تكذيبًالبعضهم
الآخر؛ كذلك
أقوال بعضهم
فيها تضادٌّ
وتناقضٌ
للقائل
نفسه بالذّات.
هذه
أمورٌ يفتضح
بها
النقشبنديّون
أمامَ أهل
العلم
والمعرفة
والحذاقة من
الباحثين والدارسين
خاصّة. لأنّ
الجاهلَ لا
يتمتع بمعرفةٍ
تُمَكِّنُهُ
من القيام بالمقارنة
بين أقوالهم
ومواقفهم،
حتّى يتبيّن
له مدى
التطابق أو
الاختلاف
بينها.
ومن
نماذج
الاختلاف
بينهم في
الأقوال على
سبيل المثال:
إنّ
مشائخ النقشبنديّة
يعظّمون ابن
عربي،
ويستدلّون
بأقواله؛ فينقلونها
في كتبهم.
فمنهم مثلاً محمّد
بن عبد الله
الخانيّ،
يقول في
كتابه، البهجة
السنيّة: »قال
سيدي الشيخ
محي الدين بن
عربي (...) كما
نقله العارف
الجيليّ في
أسفاره:
الكرامة
حقٌّ...إلخ«[550] ويقول
حفيده عبد
المجيد بن محمّد
بن محمّد
الخانيّ في
كتابه
الحدائق الورديّة
»قال
سيدنا الشيخ
الأكبر:
فعلماء
الرسوم يأخذون
خلفًا عن سلفٍ
إلى يوم
القيامة،
فيبعد النسب؛
والأولياء يأخذون
عن الله...إلخ.«[551] بينما
نعثر على
كلامٍ لشيخٍ
آخر من هذه
الطائفة؛ وهو
أيضًا خالدي
المشرب اسمه
أحمد بن أحمد
بن خليل
البقاعي في
كتابه »رسالة
في آداب
الطريقة النقشبنديّة«.
يدلّ كلامه
صراحة على أنّه
لا يعبأ بمحي
الدين بن
عربي، وكأنّه
يستهزيء به.
فهذه كلماته بالضبط،
يمدح بها
مشائخ
الطريقة النقشبنديّة
فيقول: »ورفيع
همّتهم يرفع
المريدَ من
حضيض الإمكان إلى
ذروة الوجوب،
ويجعلون
الأحوال
والمواجيد
تابعةً
لأحكام
الشريعةِ،
والأذواقَ
والمعارفَ
خادمةً
للعلوم الدينيّة؛
و لا يستبدلون
الجواهر
النفيسة الشرعيّة
بِجَوْزِ
الوجد وزبيب
الحال مثل
الأطفال، و لا
يغترون بترّهات
الصوفيّة،
ولا يفتتنون
بها، و لا ينـزلون
بها من النصّ
إلى الفصّ؛
ولا من
الفتوحات
المدنية إلى
الفتوحات
المكّية«.[552] يشير
بذلك إلى كتب
ابن عربي، في
الحين الّذي هو
بالذات يتعارض
مع نفسه بهذه
العبارات!
***
ومن
التعارض
الشديد في
معتقدات
النقشبنديّين،
أنهم قد سنّوا
آدابًا
معيّنةً
فاشترطوا الوصولَ
إلى الله
بمراعاة تلك
الآداب والسلوك
على أساسها
برياضاتٍ
شاقّةٍ. ومع
ذلك وقعوا
موقع
المصدّقين
لمحي الدين بن
عربي وأمثاله
الوجوديين »بأنّ كلّ شيء
جزء من الله«
وحتّى »أبو
سعيد الخراز
وغير ذلك من
أسماءِ
المحدثات.«[553]
فما
دام كلّ شيءٍ
في هذا الكون
جزءًا من
الله، ولا
يحتاج الأمر
للوصول إليه
بأيّ محاولة،
لماذا يفرضون
على أنفسهم
تلك الآداب
والرياضات،
ويتكبّدون
الشدائدَ
بالجوع
والسهر
وترديد الأوراد
بأعداد
هائلة،
ويقضون معظم
حياتهم في قيود
(هوش دردم،
ونظر برقدم
وسفر دروطن...)؟
نعم إذا كان كلّ
واحد منهم
جزءًا من
الله، - على
حسب ما يدّعيه
ابن عربي
ويصدّقه
النقشبنديّون
-؛ لماذا يعذّبون
أنفسهم بهذا
القدر من
مجاهداتٍ
ورياضاتٍ
يوغيةٍ
ليتمكّنوا
بها من الوصول
إلى الله؟
أليس ذلك
تكذيبًا لمحي
الدين بن عربي
وتناقضًا
غريبًا
يتخبّط فيه
النقشبنديّون
مع أنفسهم
بالذات؟
كذلك
من تناقضات
النقشبنديّين
في الوقت ذاته
تشبّثهم
بالرسالة
النسَفِيَّةِ
وشرحها
للتفتازانيِّ
في تدريس
العقائد، وهي
رسالة مقبولة مستمدّة
من روح الكتاب
والسّنّة؛ في
الحين الّذي
يعظّمون محي
الدين بن عربي
وحسين بن
منصور الحلاج وأمثالَهما
من الوجوديّين
والحلوليّين؛
فَشَتَّانَ
ما بين عقيدة
عمر النسفي
وعقيدة محي
الدين بن
عربي!
ومن
مناقضاتهم
أيضًا: قال
عبد المـجيد
بن محمّد الخـانيّ
في ترجمـة
يوسف
الهمدانيّ، »أدركتْه
الوفاةُ فدفن
بها (يقصد
مدفنَه، وهي قرية
باميين في
أفغانستان).
ثم بعد حين
نُقِلت
جثّتُهُ
الشريفةُ إلى
مَرْو.«[554] وهي
مدينة في
تركستان.
إن
كانت هذه
العبارات
تدلّ على
حقيقة، فما أقواها
برهانًا على
مخالفة
النقشبنديّين
لأحكام
الجنائز
والموتى في
الفقه الإسلاميِّ،
وتناقضهم مع
أنفسهم، إذ
يدّعون في كلّ
مناسبةٍ
إلتزامَهم
بالشريعة الإسلاميّة
وتمسّكَهُمْ
بالعزيمة دون
الرخصة؛ ولا
يرون مع ذلك
بأسًا من نقل
رفاة ميّتٍ
لهم، على الرغم
من مخالفته
لآراء جمهور
المجتهدين.
إنّ
أسلوبَ عبد
المجيد
الخانيّ في
كلماته المنقولة
آنفًا ينبئ بكلّ
صراحةٍ: أنَّ
نقلَ الجثمان
بعد الدفن،
ونَقْلَ
الرفاةِ،
يجوز في
اعتقاد
النقشبنديّين
من غير
كراهةٍ،
بِغضِّ النظر
عما لو كان
هذا الخبرُ
زعمًا صرفًا
لا أصل له، أو
توافقًا وصدفةً
ليس للواضع
علمٌ بحقيقته.
كذلك ثَمَّ
دلائلُ
قاطعةٌ أخرى
على استباحة
النقشبنديّين
نقلَ الرفاةِ.
منها، قيام
الكُفْرَويّين
بنقلِ رُفاةِ
كبيرهم عبد الباقي
أفندي من
منفاه
إسطنبول، إلى
مدينة بدليس
بعد موته
بمدّةٍ تزيد
على أربعين
عامًا، وذلك
بناءً على
موافقة ابنه
قسيم
الكُفْرَويّ؛
ومنها، قيام
الأسرة
الأرواسيّة
بنقل رفاة
الشيخ شهاب
الدّين
وأقاربة من
مدينة بدليس
إلى قرية
غَيْدَةَ
بنواحي قصبة
حيزان، وذلك
بعد تنفيذ حكم
الإعدام فيهم
بمدّةٍ تزيد
على خمسة
وأربعين عامًا.
ولذا،
نجد مناقضةً
صريحةً قد وقع
فيها النقشبنديّون
في كلّ هذه
الأعمال، وقد
تضاعفت
وتأكّدت
وانحدرت عليهم
بمسئوليات أخلاقية
رهيبة!
***
كذلك
من مناقضاتهم
مع أنفسهم،
أنهم ينسبون أنواع
الكرامات
والعلوم
والمعارف إلى
شيوخهم
وأوليائهم،
مع ذلك لا علم
لهم ولا لجميع
مشائخهم المعاصرين
بما استقى
أسلافهم من
البرهمية
والشامانية
وغيرهما من
معتقدات
شتّى، ولا
حتّى يعلمون
شيئًا حول هذه
الأديان.
ولربما لم
يسمع أحد من
شيوخهم المعاصرين،
خاصّة الّذين
في المنطقة
الكرديّة اسمًا
من أسماء الدّيانات
الهنديّة
الّتي انتقلت
معظم آدابها
إلى طريقتهم!
ومن
هذه الأمثلة:
يقول النقشـبنديّون:
إنّه »من
لا شيخ له
يرشده فمرشده
الشيطان«[555]
ولكنّهم لا
يقصدون بكلمة »المرشد« - في
هذه المقولة - الأساتذةَ
الّذين
يدرّسون
القرآنَ
والفقهَ
والحديثَ؛ أو
الطبَّ
والحسابَ
والهيئةَ والتاريخ
وما إلى ذلك
من علوم عقلية
ونقلية بآدابها
وشروطها. بل
قصدهم من ذلك،
هو إقناعُ كلّ
مَنْ
بَلَغَتْهُ
دعوتُهم أن
يستسلم لهم
مطلقًا، على
أن يسلّم
لأحدهم
عِنانَهُ ثم
يتعلّم منه
آدابَ الطريقة،
ويسير على
نهجهم. ومع
هذا، يرون من
الواجب على كلّ
من يريد
الانخراط في
سلكهم، أن
يتأكّد من أمره
أوّلاً
بالاستخارة
عما إذا كان
دخوله في الطريقة
خيرًا في حقّه
أم لا.[556]
و لا
شكّ أنّ
تخييرهم
لطالب
الطريقة بهذه
الصورة
يتعارض (في
اعتقادهم)
بوجوب اتخاذ
الشيخ على كلّ
فرد من أفراد
الناس بدون
استثناء. فقد
وقعوا بذلك في
تلفيق شديد؛
فضلاً عن
أنّهم قد
حرّفوا معنى
الاستخارة
بعلم الله في
الأمور المشروعة،
و بدّلوه
بالتكهُّن،
مع أنّ
الكَهَانَةَ
محرّم في
الإسلام. وهذا
تلفيق آخر.
لأنّ
الاستخارة،
في الحقيقة هي
طلب وجوه الخير
والّتيسير
والتوفيق من
الله تعالى
بالدعاء
والتضرّع قبل
الإقدام في الأمور
المشروعة.[557] ولا
يخفى أنّ
المشروعيّة
محدّدة
بالمعالم
والقيود
المنصوصة في
كتاب الله
وسنة رسوله r.
و لا خيار
للمسلم في
أداء الفرائض.
بل هو ملزَمٌ
بأدائها عَلى
وُفْقِ ما جاء
في الشريعة
المطهّرة، والعباداتُ
في الإسلامِ
كلّها
توقيفيّةٌ.
وأما قيامه
بنافلة، فلا
داعي له
بالاستخارة في
فعلها أو
تركها. إذ أنّه
يثاب على
فعلها،
ولأنّها
أصلاً مطلوبة
منه على
الاستحباب
وليس على
الوجوب. وفي
الإصرار على
تركها مخالفة
للرسول u.
فهذا أمر في
منتهى
البداهة. لذا
خرجت أمور الصوفيّة
وطقوسهم عن
نطاق
المشروعية.
فهي ليست في
حدّ ذاتها من
الفرائض، ولا
هي من السنن،
ولا من
المباحات. إذ
لا نجد في
نصوص الكتاب
والسّنّة
أدنى إشارة
إلى ما وصفه
النقشبنديّون
من الرّابطة،
والختم خُوَاجَگَانِيَّة،
وعدّ الأذكار
بالحصى، والتركيز
على الصورة
الفتوغرافية
لشيخ الطريقة
والتعبّد
بالمصطلحات الفارسيّة
(هوش دردم، و
نظر برقدم، و
سفر دروطن،
وخلوت درأنجمن...إلخ.).
بل هي أشكالٌ
مختلفةٌ من
التعَبُّدِ،
اختلقها بعض
المتحزلقة من
أهل المكر والحيل،
باستيحاء من
الأديان الوثنيّة.
ثم استحسنها
وتقبّلها من
كان قد نال
محبةَ الناس
وثقتَهم من
جهلة النسّاك
دون رويةٍ حتّى
راجت وانتشرت
بين طائفةٍ
ممن تعلّموا
شيئًا من
مقدمات
العلوم
فاستعانوا به
في الدفاع عنها
بطريقة
التنطّع
والتشدّق، ثم
تطوّر الأمر
هكذا مع
الزمان إلى أن
اشتهر منهم
شيوخ تهافتت
عليهم جماهير
الناس؛
فسُحِرتْ
العيونُ و
انبهرت
العقولُ بعزّهم
وإقبال الناس
عليهم؛ فظنَّ كلُّ
من وجدهم في
تلك الأبّهة
والعظمة أنّه
على حق في كلّ
ما يقوله
ويفعله.
وإلاَّ
فالأمورُ
الّتي
استحدثوها
باسم الدِّينِ،
فانّهم بالذّات
يقاسون حرجًا
شديدًا بسبب
عجزهم عن
إثباتها
وإقامة أدنى
دليل على
الربط بينها
وبين الدِّينِ
الإسلاميِّ
الْحنبف، على
الرغم من
محاولاتهم
ودفاعهم
وهجماتهم بشكل
مستميت. كما
أنّها لا
تُعَدُّ من
شؤون الدّنيا
في الوقت
ذاته. كالسفر
والتجارة
والبناء والزراعة
والفنّ
والدراسة و ما
إليها. وهذا
قد أوقعهم في
تلفيقات،
وأربكهم في
مواجهة
العلماء
وأثارهم على
أهل النصيحة
والإصلاح؛
كما تشهد على
ذلك مقالاتهم
وكتاباتهم و
حتّى أشعارهم
الّتي تفور
بالهجوم والاستنكار
واللّوم
والعتاب على
غيرهم.
***
ومن
تلفيقات
النقشبنديّين:
فقد ورد في
رسالة كتبها
خالد
البغداديّ
إلى أتباعه في
إسطنبول، يحذّرهم
من مخالطة عبد
الوهّاب
السوسيّ -
الّذي مرّ
ذكره في ترجمة
خالد
البغداديّ -
يقول فيها:
»فالآن
أخبركم بأنّي
وجميع رجال
السلسلة تبرّأنا
من عبد الوهّاب.
فهو مطرود عن
الطريقة. فكلّ
من تصادق معه
لأجل
الطريقة،
فليترك
مُصادقَتَهُ
و
مُكاتبَتَهُ.
و إلاَّ فهو بريء
من إمداد هذا
الفقير
وإمداد
السادات الكرام.
ولا أرضى أن
يكاتبني،
وأنْ يستمدَّ
همّتي بعد
وصول هذا
المكتوب إليه«. [558]
يتبرّأ
البغداديّ من كلّ
من يكون على
صلةٍ مع عبد
الوهّاب
السوسيّ بعد
هذا الخطاب؛
كذلك يهدّد
مريديه: بأنّ
جميع رجال
السلسة أيضًا
يتبرّؤن مِمّن
يخالف نهيَه
فيما حذّرهم
عنه. ومعنى
ذلك: إنّه
اتصل بساداته
الّذين هم
ثمانية
وعشرون شخصًا؛
ومنهم من مات
قبله بمئات
السنين. وربما
يصدّقه كثيرٌ
من الناس في
ادّعائه هذا! غير أنّه
لا يكتفي
بالتبرّؤ؛ بل
يهدّد مخاطبَهُ
بأنّه بريء من
إمداده
وإمداد
ساداته؛ أي أنّ
من تمادىَ في
اتصاله بعبد
الوهّاب
السوسيّ؛
حُرِمَ من
إمداد
البغداديّ
وكذلك من
إمداد
الثمانية
والعشرين
شخصًا الّذين
استخلف بعضهم
بعضًا على
منصب الرياسة
للطريقة النقشبنديّة
بدءًا من أبي
بكر الصدّيق
إلى شيخه غلام
علي عبد الله
الدهلويّ؛ وأنّه
لا يرضى من
أحد أن يستمدّ
همّتَه إذا
دامت علاقته
مع خصمه
المذكور!
فقد
يصدّقه أناس
في ادّعائه
هذا أيضًا؛
ولكنّ خالدًا
نفسَه بالذّات،
يقول في
رسالةٍ أخرى
كتبها إلى عبد
الله باشا
حاكم أيالة
عكّا:
» أمّا بعد
فقد بلغني
مرسومكم الحاوي
لشدّة
الاعتقاد
والمبالغة في
الاستمداد لطلب
الذُّرِّيَّةِ
لكم. أمّا
الدعاء، فقد
صدر مني
مرارًا. وأمّا
الهمّة،
فلستُ من
أهلها«.
لا
يخفى على
القارئ ما
يبدو من
التعارض بين
محتوى
الرسالّتين
في قضية »الْهِمَّةِ«. وهي اسم
يُطْلَقُ على
إسعافٍ يقوم
به شيوخ الصوفيّة
في لمح البصر
لمن يطلب منهم
المدد (حسب اعتقادهم)؛
ويقولون في
هذه الفرية:
أنّ الشيخ
يُغيثُ
مريدَهُ متى
استغاثه، ولو كان
بينهما بُعدَ
المشرق
والمغرب!
فقد
وقع
البغداديّ في
تلفيق شديد
عندما قال في
آخر رسالته
معتذرًا: »ولئن
سُلِّمَ، فلا
تُستعمل الْهِمَّةُ
إلاَّ بعد
ظهور أنّ
المطلوبَ
قضاءٌ
معَلَّقٌ،
وإلى الآن ما
تبيّن كون
مطلوبنا
كذلك، لعمى
بصائرنا بسبب
البدع
والشبهات«.[559] يدل
كلام
البغداديّ
على أنّه
يحاول أن
يتخلّص
بلباقةٍ من
سوء ظنّ
المخاطب حتّى
لا يقع موقع
الرجل الكذّاب
عند من يعدُّه
من »كبار
أولياء الله«، ويعظّمه
ويبجّله
معتقدًا فيه أنّه
يعلم الغيب؛
فيتذرّع
بكثرة البدع
والشبهات،
وأنّها هي
الأسباب
الّتي حجبته
عن الإطلاع
على أسرار
الله!
لقد
بلغت
الجُرأةُ في
هذا الرجل على
رب العزّة إلى
حدٍّ، يطرد من
يشاء من رحمة
الله؛ ويهدّد
الناسَ بِأنّه
يحرّمهم من
مدده إذا استهانوا
بما نهاهم
عنه؛ ويدّعي
في الوقت ذاته
أنّ سادته
أيضًا متفقون
معه في
تهديداته! - أولئك
السادة
الّذين لا
علاقةَ لعددٍ
منهم بالطريقة
النقشبنديّة
بوجه من
الوجوه، و لا
بالصوفيّة، و
لا بشخص البغداديّ
بقرينة
خاصّة؛ كأبي
بكر الصديق، وسلمان
الفارسي،
وقاسم بن محمّد
بن أبي بكر،
وجعفر بن محمّد
الباقر،
وغيرهم -
يدّعي
البغداديّ
أنّ رجال السلسلة
جميعًا قد
تبرّؤوا معه
من عبد الوهّاب
السوسيّ -
أولئك الرجال
الّذين لا
برهان للبغداديِّ
أصلاً على
وجود كثير
منهم، فضلاً
عن أنّ البقيّة
قد بَلِيَتْ رُفَاتُهم،
ولا علم لأحدٍ
بأرواحهم أين
حُشِرت،
والعلم عند
الله. كذلك لا
يدري أحد: من
كان منهم
سعيدًا، ومن
كان منهم شقيًّا؛
وأيّهم مات
على الكفر، و
أيّهم مات على
الإيمان. لا
يعلم ذلك إلاّ
الله الواحد
القهار.
بالخلاصة،
فانّ هذا
الرجل يرى
نفسَه قائمًا على
منصب النيابة
عن الله، كما
يظهر من
عباراته. ويرى
أنّه قادر على
أنْ يَهَبَ
لعبد الله
باشا ولدًا،
(ولكنه لا
يريد أن يستعمل
همّتَهُ
إلاَّ بعد
ظهور المطلوب
عما إذا كان
قضاءًا
معلّقًا). أي
أن المطلوبَ
لم يظهر له
بعد، لو كان
يتحقّق بشرط
معيَّنٍ حتّى
يُنَفِّذَ
المشروطَ فور
وجود الشرط.
يظهر
لنا خلال هذا
النسيج
الملبّد من
تلافيفِ
الادّعاءِ
والزندقةِ
والكذِبِ على
اللهِ: أنّ
التعارض
والتلفيق
الّذي وقع فيه
البغداديّ في
إطلاقه
عَبْرَ هذه
العبارات، لا
ينحصر في وجه
معيَّنٍ، بل
يتعدّد
متضاعفًا على
وجوهٍ
مختلفةٍ قد
يُشغِل
الباحثَ إذا
دخل في تفاصيلها.
تدعو
المناسبة أن
نذكر في هذا
المعرض كلمات
قد سجّلها
معصوم
الفاروقيّ في
مسألة »القيّوميّة«
إذ يقول »القيّوم
في هذا
العالم،
خليفة الله
تعالى، ونائبٌ
منابه«.[560]
ولهذا
ليس من الغريب
أن يكون خالد
البغداديّ قد
نَصَبَ نَفْسَهُ
على عرش
النيابة عن رب
العالمين،
ليطردَ من
يشاء من الناس
من رحمة الله،
و ليُمِدَّ من
استغاث به في
لمح البصر ولو
كان هو في
المشرق
والمستغيث في
المغرب؛ كما
ليس من الغريب
أن يسيطر
بأسلوبه
الخاصّ على
ضمير من غلبت
عاطفتُهُ على
عقله، متى
استحسَّ
البغداديُّ
الحرجَ في
إقناعه؛ كما
مرَّ في جوابه
لحاكم عكّا: إنّه
لا ينبغي أنْ
يَسْتَعْمِلَ
هِمَّتَهُ، فَيَهَبَ
له غلامًا
زكيًّا، إلاّ
بعد أنْ يطّلع
على اللّوح
المحفوظ، هل
هناك احتمالٌ
يبشّر بتحقيق
مطلوب حضرة
الباشا أم لا (!)
ومن
تلفيقات
النقشبنديّين
وخلطهم، قولُ
البغداديِّ: »ولا تزيدوا
التكايا عمّا
في عهدي«.[561]
أوصى
خالدٌ
البغداديُّ خُلَفَاءَهُ
بهذه الكلمات
وقد اجتمعوا
عنده لعيادته
وهو على فراش
الموت يترقّب
منيَّتَهُ
يوم أصيب
بالطاعون.
بينما
التكيّةُ هي
مركز الصوفيّة،
ومكان
اجتماعهم،
ومعبدهم
الّذي يقيمون فيه
طقوسَهم،
ويبثّون منه
دعوتَهم. فكلّما
ازداد
انتشارهم بنوا
تكايا أخرى في
المناطق
الّتي تخلو
عنها،
ليقوموا فيها
بنشاطاتهم
سدًّا للحاجة.
وهي في نظامهم
بمنـزلة
المسجد عند
المسلمين.
لذا
يُستغرَبُ جِدًّا
أن يمنع خالدٌ
البغداديّ
خلفاءه من
الإكثار من
بناء التكايا
وهو في آخر
لحظاته من هذه
الدنيا. نعم
يُستَغرَبُ
كلامُهُ هذا،
لِتَعَارُضِهِ
مع المقصود
الذي يسعى
النقشبنديّون
من وراء
تحقيقه سعيًا
حثيثًا. وقد
أعرب عن هذه
الغاية
خليفتُهُ محمّد
بن عبد الله
الخانيّ
بقوله: »لأنّ
هذه الطريقة
هي الملاميّة
المناسبة لما
يكون عليه من
الصحو
الصدّيقي، و
الرجوع إلى
البقاء
الأتمّ الحقيقيِّ،
بدعوة الخلق
وهدايتهم إلى
الحق برياستي
الظاهر
والباطن،
وفتح القلاع
والمواطن«.[562]
إذًا
فما عسى هي
الحكمة من هذه
الوصية الّتي
تدلّ على
التراجع
والانسحاب من
ميدان الدعوة؟!
هل تعني أنّ
البغداديّ
شعر بالندامة
في لحظاته
الأخيرة من
حياته، و ثاب
إليه رشده
فتأكّد من خطر
ما اقترف على
الإسلام وما
شارك في تدمير
أركانه بنشر
طقوس
البرهمية
وتعاليم اليوغية
الّتي جاء بها
من الهند،
ونفخها في عقول
الآلاف من
البسطاء
الّذين كانوا
يعدّون أنفسهم
من المسلمين؛
أم في تلك
الوصية
الغريبة أسرار
أخرى تعجز عن
دركها عقولنا
اليوم! لا شكّ
في أنّها سوف
تُفشى على
رؤوس الأشهاد
يوم التلاق.
***
ومن
التنازع
والتضارب
الّذي وقع بين
أقوال النقشبنديّين
وأفعالهم:
أنهم على
الرغم من اشتراطهم
الخشوعَ
والصمتَ
أثناء الذكر،
فانّ كثيرًا
من مريديهم
ودراويشهم
يَنِطُّونَ
فجأةً من
مقاعدهم، وتَرْجُفُ
أبدانُهم،
وتتصاعد من
حناجرهم
أصواتٌ
غريبةٌ بَشِعَةٌ،
تختلف بين شَخِيرٍ
وزَئِيرٍ وخُوَارٍ
و عُوَاءٍ وصَهِيلٍ
ونَهِيقٍ ونُعاقٍ
وغيرها حتّى
وهم يصلّون.
بينما يسكت عن
هذا اللَّغَطِ
ويتغاضى عنه
شيوخهم، مع
أنهم يشدّدون
على لزوم
الصمت
والهدوء في
جميع
الأحوال، كما يؤكّد
على ذلك ما
جاء في آدابهم
من أنّ الذكر
القلبيَّ
أولى وأفضل من
الذكر
باللسان.
كذلك
جاء في
موسوعةٍ لهم:
أنّ أحمد
الفاروقيّ الّذي
يعظّمونه
بعنوان »الربّانيّ«،
ورد فيه أنّه »كان صامتًا
في غالب
أوقاته مع
جلسائه، و لم
يكن أحد من
المسلمين
يُغْتاب في
مجلسه، و لا
يُذْكَرُ من
عيبٍ فيها
لأحدٍ.
وتلاميذه
كانوا يجلسون
عنده في غايةٍ
من الخشوع
والأدب. وكان
هو في منتهى
الدرجة من
التمكُّن
والهدوء إلى حدٍّ
من التأثير
على تلاميذه،
أنْ جعلهم
يمتازون
بالسكينة؛
على الرغم من
حلمه المتـزايد؛
كما لم يصدر
منه أيضًا شيء
من الوجد والصراخ؛
و لا حتّى
أثرٌ من
تأوُّهٍ
بصوتٍ يُسمع«.[563]
تتميّز
بتلك الحالات
الغريبة
خاصّةً فرقةٌ
منهم في جنوب
شرق تركيا.
لهم مقرٌّ بقرب
مدينة
آديامان. قيل
اعتذر شيخهم
مرارًا عما تصدر
من مريديه من
حالات
الاضطراب
أثناء صلاة
الجماعة
والحفلات
والطقوس. وزعم
أنها حالات تعرض
لهم دونما
اختيار منهم.
ولكن الحقيقة
غير ذلك.
فالواقع، أنّ
هناك جماعة
مدسوسة بينهم
من رجال
المخابرات،
هم مكلّفون
بأعمال
الدعاية لهذا
الشيخ. ومنهم
عدد،
مهمّتُهم
التواجُدُ،
والتباكي،
والتظاهر
بتلك الأصوات
الغريبة
لتهييج
الرعاع
السذّج من
الزائرين،
وإثارة الشوق
فيهم، على أنّ
لهذا الشيخ
تأثيرًا عظيمًا
في قلوب
الناس،
والشيخ
متواطئ في
الحقيقة معهم.
و
أمّا التأكّد
من هذه
الحيلة، فليس
فيه شيء من
الصعوبة على
الباحث
اللّبق
المتفتح. ذلك
أنّ الّذين
يحتفون بهذا
الشيخ خاصّة،
يمتازون عن بقيّة
طبقات الناس
في تركيا
بعقليتهم
البسيطة،
ويعانون من
الفقر
العلميِّ والثقافيِّ
لأنّ غالبهم
من أهل الريف،
ومن الطبقة
المتواضعة المستضعَفَةِ
من سكّان
الأكواخ
بأطراف المدن.
أمّا الرجال
المدسوسون في
صفوفهم،
المكلَّفون
بنشاطاتٍ
دعائيةٍ،
الّذين يقوم
عددٌ منهم
بإثارة
المشاعر،
واجتذابها
بتلك الأصوات
الغريبة،
كلهم مثقّفون.
منهم عدد من
الضباط
المتقاعدين
المتخصّصين
في
استراتيجية
التوجيه
والإثارة
والتكييف
لتسهيل
الاستغلال،
وفيهم أيضًا
عدد من
الموظّفين
المدنيّين
وعدد من المهنيّين.
***
ومن
تلفيقات
النقشبنديّين،
ما وقع بين
أقوالهم و
أفعالهم من
خلاف وتعارض
وتناقض:
وَرَدَ أيضاً
في نفس
الموسوعة الّتي
مرّ ذكرها
آنفًا، أنّ
الشيخ طه
الهكّاريّ
أخطر أصحابَه
بأنّه غير
موافق على عمل
البناء فوق
القبور.
ونهاهم عن
الإقدام على
إقامة أيّ
بناء فوق
مرقده إذا
مات.[564] ومع هذا
نجد الكثيرين
منهم
يتسابقون في
إقامة
الأبنية على
ضرائح شيوخهم.
وعلى سبيل
المثال فقد
بُنيتْ قُبَّةٌ
عِمْلاَقةٌ فَخْمَةٌ
على قبر الشيخ
محمّد
الكُفْرَويّ
بمدينة بدليس،
وذلك تحت
إشراف مهندس
إيطالِيِّ.
والكُفْرَويّ
خليفة الشيخ
طه الهكّاريّ
الّذي نهى عن
البناء على القبور.
كذلك بُنيت
قبةٌ عظيمةٌ
فوق ضريح الشيخ
محمّد الحزين
الحسني
الهاشمي
بقرية
فُرساف، من ضواحي
مدينة سعرد.
وهو قريب
الشيخ طه
الهكاري في
النسب
وقرينه في
المشرب؛ وقبة
على قبر نجله
الشيخ فخر
الدين في قرية
أربنة بالمنطقة
نفسها. وثَمَّ
قبور أخرى
لمشائخ النقشبنديّة
في مناطق
مختلفة من
البلاد،
مبنية ومزخرفة،
يتوافد عليها
جموع من
الزائرين
باستمرار.
ومن
تلفيقات شيوخ النقشبنديّة،
أنهم ينصحون
أتباعهم
دائماً
بمراعاة جانب التواضع
والعفّة
واللّين
والتذلّل،
وهم في عكس
ذلك من
الأبّهة،
والإكثار من
الخدم والحشم؛
مما يدلّ على
حبهم للشهرة
والرياسة؛
ويؤكّد على
ذلك ما جاء في
كتبهم من
المبالغة والغلوِّ
والإفراط في
تعظيم الخلف
للسّلف؛
ولكنّ بشاعة
الحيلة في تلك
العبارات
تظهر بثبوت
تواطؤهم
عليها
وكمثال
على ذلك:
يسترسل محمّد
بن سليمان
البغداديّ في
مدح شيخه
(خالد البغداديّ)،
فيقول: »هو (...)
العالم
العلاّمة،
والعَلَمُ
الفهَّامة،
مالك أزمّة
المنطوق
والمفهوم، ذو
اليد الطولى
في العلوم، من
صـرفٍ ونحوٍ
وفقهٍ ومنطقٍ
ووضع ٍوعروضٍ
ومناظـرةٍ
وبلاغةٍ
وبديعٍ وحكمةٍ
وكلامٍ وأصولٍ
وحسابٍ
وهندسةٍ واصطـرلابٍ
وهيئةٍ وحديثٍ
وتصوّف...«[565]
يبدو
أنّ محمدا بن
سليمان
البغداديَّ
لم يتعرّف بعدُ
على أسماءِ
أهمِّ العلومِ
العقليّة من
طبٍّ
واقتصادٍ
واجتماعٍ
وتاريخٍ وجغرافيةٍ
وفيزياءٍ
وكيمياءٍ
وغيرها من الأساسيات،
ليضمّها إلى
ما ذكر من
العلوم
التمهيدية،
أو لم يفطن
أصلاً إلى أنّ
الأساسيّات
هي من أشرف العلوم؛
فرآها مما
تحطّ من شأن
زعيمه،
فاكتفى بما هو
مقبول في مظنة
أهل عصره، ذلك
مبلغه من
العلم!
يواصل
المؤلف
امتداحه
لشيخه في
مواطن عديدة من
حديقته،
فيقول في مقطع
أخر:
»بشّره
شيخه ببشارات
كشفية قد
تحقّقت
بالعيان، وحلَّ
منه محلّ
إنسان العين
من الإنسان،
مع كثرة تصاغره
بالخدم وكسره
لدواعي النفس
بالرياضات الشاقة
وتكليفها خطط
العدم؛ فلم
تكتمل عليه
السَّنَةُ
حتّى صار
الفردَ
الكاملَ
العلمَ،
والله يؤتي
فضله من يشاء
والله ذو
الفضل
الأعظم، (...)
وشهد له شيخه
عند أصحابه،
وفي مكاتيبه
المرسولة إليه
بخطه المبارك
بالوصول إلى
كمال الولاية وإتمام
السلوك
العادي مع
الرسوخ
والدراية،
والفناء
والبقاء
الأتمّين
المعروفين
عند الأولياء...«[566]
نعم
لقد تظهر
الحيلة أمام
عيوننا بكلّ
وضوح على
أنهما
متواطئان
ومشاركان في
صياغة هذه
العبارات
بالدليل
القاطع من
خلال كلمات محمّد
بن عبد الله
الخانيّ في
مقدّمة كتابه البهجة
السنيّة،
وهذه ألفاظه:
»وأحسن
كتاب أُلّفَ
في بيان
طريقتنا الخالديّة
النقشبنديّة
(...)، كتاب الحديقة
النديّة
الّذي ألّفه
العالم
العلاّمة
والحبر البحر الفهَّامة،
سيدي الشيخ محمّد
بن سليمان
البغداديّ
الخالدي
النقشبنديّ. لأنه
ألّفه في حياة
جناب حضرة
سيدنا
ومولانا قطب
العارفين،
وغوث الواصلين،
أبي البهاء،
ضياء الحق
والحقيقة
والدين،
شيخنا
ومرشدنا
الشيخ خالد
النقشبنديّ
المجدّدي (...)؛
حتّى إنّه مرة
سألني:
ـ ما
تقرأ
للمريدين؟
فقلت:
كتاب الحديقة
النديّة.
فقال:
هل هي فصيحة
العبارة؟
فقلت:
لا يكون في
الدنيا أفصح
منها.
فقال:
كلّها من
عبارتي.
فتحقّق
عندي أنّه
يجمع
العبارات،
والشيخ محمّد
بن سليمان
يرقمها
ويعزوها
لنفسه«.[567]
ومن
تلفيقات
النقشبنديّين،
كلمات لمحمد
بن سليمان
البغداديّ
أيضًا، يقول
فيها: »وبلغنا
أن الإمام
الشافعيَّ
رضي الله عنه،
كان يجالس
الصوفيّة
كثيرًا؛
ويقول يحتاج
الفقيه إلى
معرفة اصطلاح
الصوفيّة،
ليفيدوه من
العلم ما لم
يكن عنده.«[568] بينما
جاء في تلبيس
إبليس لأبي
الفرج عبد الرحمن
بن الجوزي عكس
ما ورد في
العبارات
المنقولة
آنفًا. فيقول
ابن الجوزي: »وبإسناد عن
يونس بن عبد
الأعلى، قال
سمعتُ الشافعيَّ
يقول: »لو
أنّ رجلاً
تصوّفَ أوّلَ
النهار، لا
يأتي الظهر
حتّى يصير
أحمق«[569] وعنه
أيضًا أنّه
قال: »ما لزم
أحد الصوفيّة
أربعين يومًا
فعاد عقله إليه
أبدًأ.«[570] فلابد
وأنّ أحدَهما
صادقٌ والآخرَ
كاذبٌ فيما
نَسَبَ كلّ
واحدٍ منهما
إلى الإمام
الشافعي من
ألفاظٍ نقلناها
آنفًا. ولكنّ
ابنَ الجوزيَّ
الّذي تُوُفِّيَ
عام 597 من
الهجرة، هو
أقدم من محمّد
بن سليمان
البغداديّ
الّذي توفّي
سنة 1234هـ. و
بالتالي هو
أقرب إلى
الصواب في
دعواه
،باعتبار أنّه
عالم
معتَبَرٌ
ومعترَفٌ به
بين سائر
علماء الإسلام
منذ عهده إلى
اليوم. وهناك
تلفيقات أخرى
مرتبطة بهذا، تُضَاعِفُ ما وقع
فيه النقشبنديّون
من التعارضِ
مع أنفسهم،
والارتباكِ
الشديدِ
الّذي انْزَلَقَتْ
به أقدامهم.
ذلك أنّهم
يعظّمون أبا
الفرج،
ويعترفون
بفضله. ولا يُتَوَقَّع
أنْ يرميه
أحدهم بالكذب.
والدليل على
ذلك ترجمته الواردة
في موسوعة
النقشبنديّين.
فقد أطنب الكاتب
في عدّ
فضائله؛ ونقل
عنه أنّه خطَّ
بيمينه
أسفارًا يبلغ
عددها ألفين؛
وأنه أسلم على
يده من اليهود
والنصارى
أكثر من عشرين
ألف شخص.[571]
ولهذا
فان
النقشبنديّين
الّذين
يوافقون محمدًا
بن سليمان
البغداديّ،
كلهم مسئولون
عما قد نَسَبَ
إلى الشافعي
من تلك
الألفاظ المنقولة
في كتابه الحديقة
النديّة؛
وكذلك
مسئولون عن
إثبات الصحة
لهذا الإسناد
حتّى يتميّز
الصادق من
الكاذب؛
وإلاّ وقعوا
معه موقع
المشارك فيما
قال. وأما
الّذين لا
يوافقونه فإنّهم
يكذّبونه
حكمًا، ويكون
موقفهم في
مقام الإعلان
بتكذيب شيخ من
كبار
الروحانيين
في الطريقة الّتي
يشملهم الانتساب
إليها معه،
وبالتالي يكذّبون
أنفسهم في
الوقت ذاته.
وهذا تلفيق
شنيع تَدْهَشُ
منه العقول!
***
ومن
تلفيقاتهم؛
كلمةٌ قالها
أحمد
الفاروقيّ
تحديثًا عن
رأيه وعقيدته
في مسألةِ
وحدةِ الوجودِ.
قال: »ثمّ
وجدتُهُ
تعالى في
الأشياءِ، بل
في نفسي«؛ بعد أن
قال »وجدتُ
اللهَ عين
الأشياءِ«[572]
فإنَّ
كلمةَ »تعالى«
الواردة في
عبارته على
سبيل التنـزيه
لله، تتعارض
مع ما يعتقده
بأنّ الله
عينُ كلّ
شيءٍ. لأنّ
الله سبحانه
إذا كان عينَ كلّ
شيءٍ في
اعتقاد
الفاروقيّ،
فليس »كلّ
شيءٍ«
يستحقُّ التنـزيهَ
من النواقص.
إذ يشتملُ
تعبير »كلّ شيءٍ«
على الشريف
والخسيس؛
وعلى الطاهر
والنجس، وعلى
الكلبِ
والخنـزيرِ اشتمالاً
عامٍّا؛
وبالتالي
تكون
الأقذارُ والنجاسات
والقمامة
وحتّى
الكلابُ
والوحوش
بتمامها من
جملة »كلّ
شيءٍ«.
إذن
فما عسى
الحكمة من
استعمال
الفاروقيّ كلمة
»تعالى«
إذا كان قد
أراد بها أن
ينـزّه الله
عن النواقص
فيميّزه عن
سائر خلقه
بهذه الصيغة
الملفّقة؟!
ومن
التعارض
الّذي يتخبّط
فيه
النقشبنديّون،
مناقشتُهم
حول جواز أكل
اللَّحم.
لقد
وردت في إحدى
رسائل خالد
البغداديّ
عبارةٌ
استفهاميةٌ
على سبيل
الإنكار يردّ
بها على من
يعتقد أو
يتوهّم حرمةَ
أكل اللَّحم.
يقول
البغداديّ
فيها باللّغة الفارسيّة:
»آيا
كدام كتاب
ديده اند كه
پيغمبر خدا r
كوشت نخورده،
و يا أز
خوردنش نهي
فرموده باشند؟!«[573]
ومعناه
بالعربيّة:
»ويحك!
في أي كتاب
شاهدوا أنّ
الرسول r لم
يأكل اللّحم،
أو نهى عن
أكله؟!«
قد
يتراءى
للقارئ في هذا
الاستنكار
الحماسيِّ
أنّ خالدًا
يردّ على متطرّفٍ
يحرّم ما قد
أحلّه الله.
ولكن الحقيقةَ
غامضةٌ في هذا
الحوار. إذ قد
يكون خالدٌ
يستعمل
لباقتَه في
مثل هذه
العبارة
ليُزيلَ الشكُوكَ
حول ما
تتناقله
اللُّسُنُ من
آثار الديانة البوذيّة
في سلوك بعض
الروحانيين
السابقين من
شيوخ النقشبنديّة
مثل كراهية
أكل اللّحم
وغيرها.
ومن
أشد نماذج
الخلاف
والتعارض بين
أقوال
النقشبنديّين
و أفعالهم: أنّهم
في الوقت
الّذي
يتبرءون من
البدع
ويستبشعونها
ويحذّرون
منها حتّى
أحيانًا بدون
مناسبة؛
تراهم
يتعبّدون
بأشكال غريبة
لا تمتُّ إلى
الإسلام بأدنى
صِلَةٍ، كما
سبق شرحها
بالتفصيل. ومع
هذا يأتون
ببدعٍ أخرى
غريبة، بحيث
يختلفون فيها
حتّى مع بعضهم
البعض.
منها
أنّ طائفةً من
هذه النحلة
بمدينة سعرد، إذا
مات شيخٌ من
شيوخهم ضربوا
على الدفوف
أمام
جِنَازَتِهِ
أثناء
التشييع من
المصلّى إلى
المقبرةِ. وآخِرُ
مَنْ أُقيمت
هذه الحفلة
أثناء تشييع
جنازته،
الشيخ محمّد
موسى الكاظم
الحزيني. وهو
من أحفاد
الشيخ محمّد
الحزين
الفُرسافي
الهاشمي[574]
والغريب،
أنّ البقيّة
من شيوخ هذه
الطريقة لا
يوافقونهم
على هذه البدعة.
بل الغالب من
أولئك
يجهلونها
تمامًا، ولا
علم لهم بهذه
العادة،
لخمولِهِمْ
وانعزالِهِمْ
وسوءِ مستواهم
الاجتماعيّ،
وقلّة
اهتمامهم بما
يجري حتّى في
بعض المناطق
من بلادهم. و
لو أنّ شيوخ الأتراك
النقشبنديّين،
بلغهم خبر هذه
البدعة لربما
اتّهموهم
بالكفر
والزندقة.
وهذا أيضًا
يدلّ على الشّقّةِ
البعيدة بين
جماعات
النقشبنديّين،
وعلى مدى
التعارض والتناقض
بين عاداتهم
واتّجاهاتهم
و معتقَداتهم.
إنّ
هذه البدعة
تبرهن في حدِّ
ذاتها على
مخالفةٍ أخرى
يقترفونها
ضمنيًّا. وذلك
لابدّ أنّهم
يعتقدون بفضل
الشيخ على
سائر الناس،
وأنّه أكرمهم
عند الله
رجمًا
بالغيب؛
فيرونه مستحقًّا
للتعظيم بشكل
مخصوص حتّى
بعد موته. وهو
القيام
بإجراء الحفلة
الخاصّة
للتشييع،
والضرب على
الدفوف من المصلّى
إلى المقبرة.
فانّ توقيرَ
جموع المريدين
وتعظيمَهم
لشيوخهم بهذه
الصورة خاصّةً
دون غيره، يدلّ
دلالةً
قطعيةً على
هذا الاعتقاد
الّذي يُنْبئ
عن دعوى بعضهم
أنّه يعلم من هو
أكرم عند
الله، وإنْ لم
يفصح عن هذه
الحقيقة
احترازًا من
ردِّ فعلٍ قد
يصطدم به.
كذلك
ثمة بدعة أخرى
يمارسها
النقشبنديّون
الأكراد في
المنطقة
الشرقية،
بينما يجهلها
النقشبنديّون
الأتراك. إذ
لا يمكن أن
يسكتوا عنها
لو قرع خبرُها
سمعَهم. ألا
وهى أنّ شيوخ النقشبنديّة
في المنطقة
الكرديّة
يستعملون
الدخان داخل المساجد
على غرار
الرافضة
الإيرانيّين؛
وربما بتأثير
الجوار. هذه
العادةُ الْمُنْكَرَةُ
كانت منتشرةً
في القرى دون
المدن حتّى
السنين
الأخيرة. لأنّ
الرقابة كانت
مقتصرة على
المساجد في
المدن. وكان
أهالي القرى يخضعون
لهيمنة شيوخ
هذه الطائفة.
فلم يملك هناك
أحدٌ جرأة
الاعتراض
عليهم بحكم
الظروف. إلاّ
أن البدعة
المذكورة قد
اختفت في معظم
أنحاء المنطقة
بعد سهولة
الرقابة
عليها.
يتضح
من خلال هذه
الأمثلة
الّتي هي قطرة
من بحر، أنّ
التلفيق
والتعارض
والتضارب
الّذي تتمرّغ
فيها الطائفة النقشبنديّة
لا حصر لها في
واقع الأمر.
***
* أمثلة
من معاداةِ
النقشبنديّين
فيما بينهم،
ومُنَاهَضَتِهِمْ
وتَبَاغُضِهِمْ
وتَشْنِيعِ
بَعْضِهِم
البعض...
لقد
وقع النـزاع
والمنافرة
بين كثير من
شيوخ هذه
الطائفة
قديماً
وحديثًا؛
فضلاً عما قد
جرتْ بين متأخّريهم
والمعاصرين
منهم من
مشاحنات
ومشاتمات يعفّ
اللّسان عن
نقلها. وإنّما
طرقنا هذا
الجانب من
سلوكهم
لعلاقته
الملحّةِ بهذه
الدراسة من
باب التكملة،
وليكون عبرة
لأولي
الألباب. فغدتْ
براهينَ
قاطعةً، على
أن الصورةَ
الحقيقيةَ لغالب
مشائخ هذه
النحلة
تتوارى خلفَ
صورةٍ
عابرةٍ،
تظهرُ للناسِ
لطيفةً،
نورانيةً مُشرقةً
على خلاف
الواقع
تمامًا.
كذلك
استفزازاتُهُمْ
وهجماتُهُمْ
على المعترضين
بإطلاق صفة »المُنْكِرِ«
على كلّ مَنْ
ينصحهم أو
يحذِّرُ
المسلمين من
البدع؛ واعتداؤُهُمْ
على
المعارضين
بإحراق
مؤلَّفاتهم،
تدلّ على
الحقد الّذي يُضمرونه
لمن لا يستسلم
لهم.
لقد
مرّتْ في
ترجمة خالد
البغداديّ
نُبْذَةٌ من
قصّته مع
زميله أو
خليفته عبد الوهّاب
السوسيّ
الّذي كان هو
الآخرُ
نقشبنديَّ
المشرَبِ،
مأذونًا من
غلام على عبد
الله
الدهلويّ. ولكن
لا ندري ما
الّذي جعله
ينوب عن خالد
البغداديّ في بثِّ
طريقته حتّى
اندلعتْ
بينهما
معركةٌ ضارية
انتهت
بتدخُّل
السلطان
العثمانيّ، وإصدارِ
الْحُكْمِ على
عبد الوهّاب
السوسيّ
بالإقامة
الجبرية في
المدينة المنورة.
ولكن الّذي
يدل على مدى
حقد النقشبنديّين
على بعضهم
البعض في هذه
الحرب
الشعواء، هو عاقبة
تلك الرسالة الّتي
يزعمها
الخالديّون
أنّ عبد الوهّاب
السوسيّ
كتبها
واتَّهَمَ
فيها خالدًا
بالشعوذة
والكفر
والزندقة.
إذًا
لم تقتصر
مناهضةُ
البغداديّ
للسّوسيِّ
على تلك
الرسائل
الثلاثة
الّتي بعثها
إلى مريديه
بإسطنبول،
والّتي
حذّرهم فيها
من مخالطته.
بل يبدو أنّ
تلك الهجمات
بلغتْ من
الشدة إلى
حدٍّ دفعتْ
الخالديّين
ليسحقوا
بالسوسيِّ
فيجعلوه
هشيمًا تذروه
الرياح. والله
يعلم ماذا
فعلوا به
وبكلّ ما كتبه؛
ولربما
دمّروا قبرَه
بفرصةٍ
ملكوها فور
موته، قبل أن
يدمِّره الوهّابيُّون!
بينما قبرُ
خالد
البغداديّ
مشيَّدةٌ »في سفح
قاسيون«
بدمشق، يزوره
كثير من
النقشبنديّين.
ولكن
الّذي يجب أن
نقوله في
النهاية: هو
أنّنا لم نعثر
حتّى على حرف
واحد من رسالة
عبد الوهّاب
السوسيّ، رغم
ما بذلْنا من
جهود بالغة
طوال مدةٍ
أكثر من خمسة
أعوام نطارد
ورائها بسعيٍ
دؤبٍ من
مكتبةٍ إلى
أخرى في بلدان
الشرق الأوسط،
إلاّ السطور
اليسيرة
الّتي نقلها
ابن عابدين
ضمن رسالته »سل
الحسام
الهنديّ
لنصرة مولانا
خالد النقشبنديّ«[575]
كذلك
عثرنا على
رسالةٍ أسمها »عين
الحقيقة في
رابطة
الطريقة«
لرجلٍ تولّى
الإفتاءَ
بمدينة أدرنه
في أواخر
العهد
العثمانيّ
وهو محمّد
فوزي - على ما
يبدو من
إقراره في
الديباجة-؛
كتبها
باللّغة التركيّة
العثمانيّة،
وتصدّى فيها
للرّد على
شخصٍ لم يذكر
اسمَه، ولا
عنوانَ
كتابِهِ
الّذي أصدره
في الردّ على
الرّابطة سوى
ما نقل منه
المفتي
سطورًا يسيرةً.
لعلّ
ما فعل
النقشبنديّون
بعبد الوهّاب
السوسيّ،
فعلوا بهذا
الرجل أيضًا،
حتّى بقي اسمه
مجهولاً لم
تصل إلينا أخباره،
ولا حتّى
صفحةٌ واحدةٌ
من كتابه، ولا
وقف أحدٌ على
ما قد تعرّض
له من سوءِ
عاقبةٍ!
***
كذلك
الأسرتان
الأرواسيّة
والكُفْرَويّةُ،
نشبت الفتنة
بينهما في
استغلال شهرة
الشيخ طه
الهكّاريّ
منذ أواسط
القرن
الماضي، ودامت
حتّى يومنا
هذا؛ كما
مرّتْ
قصتُهما
بالتفصيل.
ولقد
اشتدّ الحقدُ
والعداوةُ
بينهما إلى
حدود، كان
يرمي كلّ منهما
الآخر بالكفر
والزندقة
والنفاق
والدجل. بينما
كانت جماعات
الأكراد
التابعة
لكلٍّ من الأسرتين،
تعظّمها وتصف
أفرادها
بالعصمة من الذنوب،
وأنّهم
أولياء الله
وصفوة عباده.
فكم سمعنا
بآذاننا من
مريديهم
يقولون »لو
وجدنا كأس
الخمر بيد أحد
من أولاد
مولانا الشيخ،
لاعتقدنا بأن
الله قد أحلّ
ذلك له خاصّة،
أو أحاله إلى
ماء زمزم!«
لمّا
بلغت الخصومةُ
حدَّها بين
الأسرتين
المذكورتين،
تعدّتْ بالتأثير
إلى جماعةِ كلّ
منهما بحكم
الانتماء.
فتسلسلتْ
وسرتْ
العداوةُ بين
طبقات الناس
واستمرّتْ
عبر الأجيال،
فكانت
أحيانًا
تتطوّر إلى
نقاشٍ وقتالٍ
في بعض
المناطق. و
مما يُدهش
الإنسانَ من
هذه الأحداث:
أنّ أتباع
الأسرةِ
الكُفْرَويّةِ
إذا علموا
بدخول شخص من
مريدي الأسرة
الأرواسيّة
إلى مسجد
بمنطقتهم،
وقد صلّى فيه
ومضى؛ ـ إن لم
يكونوا قد
تمكّنوا من
منعه ـ أخرجوا
جميع ما فيه
من البساط
والسجادات،
وغسلوها
تطهيرًا على
أنها تنجّست
بدخوله!
كما
لا نعثر حتّى
على اسمٍ
واحدٍ من كبار
الأسرة
الكُفْرَويّةِ
في الموسوعة
الّتي أعدّها
النقشبنديّون
من جماعة الأرواسيّين،
بإشراف عقيد
متقاعد سبق
ذكره أكثر من
مرة للمناسبة.
لم يَقِفُوا
منهم هذا
الموقفَ السلبيَّ،
ولم يُهملوا
أسماءَ
مشاهِيرِهم
إلاّ على سبيل
النقمة منهم
والازدراء
بهم، على أنّهم
ليسوا من أهل
الصفاء
والعرفان و
الإرشاد إلى
الطريقة النقشبنديّة.
ومن
نماذج
التباغض بين
النقشبنديّين،
أنّ مشائخَ الأسرة
الأرواسيّة
وأتباعَهم من
التاغيّين
الأكراد إذا
علموا أنّ
شخصًا من
مريدي الشيخ محمّد
الحزين
الهاشمي قد
حضر ليشترك في
حلقة الذكر معهم،
رفضوه وأمروه
بالخروج من
الحفلة بحجّة أنّه
غير طاهر،
وأنّ توبته
غير مقبولة
وبيعته غير
صحيحة.
ذلك
أنّ الشيخ محمّد
الحزين كان قد
ألغى عددًا من
آداب النقشبنديّة.
منها، عدّ
ألفاظ الورد
بالحصى. كان
قد أجاز لمريديه
أنْ يعدّوا
أورادهم
بالمسبحة ومن
غير تحديد؛
وكذلك لم يأمر
أحدًا
بالإغتسال
خاصّة عند
أخذِ البيعةِ
منه إذا كان
طاهرًا من الحدث
الأكبر
والأصغر
بخلاف مشائخ
الأكراد؛
فحملهم ذلك
على بغضه
واحتقارهم
لمريديه؛ كما
كان هو الآخر
لا يعترف بهم.
هذا
وقد ظهر منذ
سنين قليلةٍ
رجلٌ بمدينة
ساكاريا اسمه (عمر
أُونْگَُوتْ)،
واشتهر بين
جماعةٍ في تلك
المنطقةِ
بصفةِ شيخٍ
مأذونٍ في
الطريقة النقشبنديّة،
قام بشنِّ
هجومٍ رهيبٍ
على جميع شيوخ
هذه الطائفةِ
المشهورين
اليوم في
تركيا.
التفَّتْ
حولَ هذا
الرجل جماعةٌ
من الشباب العصبيّين
فتمكّن من
الهيمنةِ على
أدمغتهم
وضمائرهم، فأكبّوا
على كتابة كلّ
ما نطق به.
فصدر له عددٌ
كبيٌر من
رسائلَ وكُتيباتٍ
بمساعدتهم؛
كلُّها
مشحونةٌ باتّهاماتٍ
رهيبةٍ
وشتائمَ
بذيئةٍ ينبو
عنها السمع.
وجّهها إلى
عددٍ من شيوخ النقشبنديّة.
منها،
- على وجه
الخصوص -
رسالة أصدرها
تحت عنوان »حقيقة
السليمانيّين«[576] وهم
أتباع »سُلَيْمَان
حِلْمِي طُونَاخَانْ«.
استعمل فيها
لهجةً
شديدةً، اتّهم
الطائفةَ خِلاَلَهَا
على نحوٍ
متواصلٍ بِغَصْبِ
أموالِ النّاسِ
وارتكابِ
سلسلةٍ من
الجرائم
والجنايات
ورماهم
بالكفر
والفسق!
وَرَدَ
على غلاف هذه
الرسالة من اتَهاماته
الْمُوَجَّهّةِ
إلى الطائفة
المذكورة
بالحرف
الواحد: »أنّ
دِينَهُمْ دِينَارُهُمْ،
وَخُلُقَهُمْ
غَصْبُ أموالِ
الناس، وَدَأْبَهُمْ
التكفّفُ والتسوّلُ...«. ومن
كلماته الّتي
شنَّعَ بها على
رئيسِ
الطائفة،
وزوجِ ابنةِ سُلَيْمَان
حِلْمِي، (المحامي
كمال قاجار)،
قوله: »يَظْهَرُ
من ألفاظ
السليمانيّين
أنّهم قد
جعلوا من هذا
الكافر
الأحمر صنمًا
يعبدونه!«[577]
استعمل
(عمر أُونْگَُوتْ)
الأسلوبَ نَفْسَهُ
في حقّ كلّ مِنْ
محمود أفندي
(رئيسِ
النقشبنديّين
من أبناءِ
منطقةِ
لازستان)،
ورئيسِ جماعةِ
النور، ونجم
الدين
أرباكان (رئيسِ
الوزراءِ
الأسبق)،
وجمال الدين
قبلان الّذي
أعلن الحرب
على النظام
اليهوديِّ
الحاكم في
تركيا بعد أن
انتقل إلى آلمانيا
ونادى بقيام »دولة
الخلافة«(!)
أمّا
الدعاوي
الّتي قد
رُفِعت ضدّ (عمر
أُونْگَُوتْ)
من قِبَلِ
جهاتٍ
وأشخاصٍ
مختلفةٍ إلى
المحاكم التركيّة
حتّى الآن،
فقد انتهت
كلُّها
ببرائتِهِ،
على الرغم من
تهوّراته
وشتائمه
وتهديداته.
وهذا يدلّ
بصورةٍ
قطعيةٍ على أنّه
مدعوم من
قِبَلِ جهازٍ
مخصوصٍ لضرب
النقشبنديّين
بعضَهم في
بعضٍ. بل يهدف
الأمر
فوق هذا إلى
التحقُّقِ من
موقف
المسلمين في
الوقت ذاته!
هكذا
استمرّ
التباغض
والتنافر بين
الطرفين، كما وقعت
منازعاتٌ
شديدةٌ بين
عددٍ آخر من
شيوخ هذه
الطائفة على
الرغم من وحدة
كلمتهم في
تعظيم هذه
الطريقة
والدعوة
إليها.
***
*
أسلوب
المعارضة عند
النقشبنديّين.
لقد
وردت في كتب
النقشبنديّين
عباراتٌ هاجموا
بها مَنْ
خالفهم في
أقلِّ شيءٍ
مما أقرُّوه
فضلاً عمن ردّ
عليهم
وناهضهم. إنّ
تلك العبارات
قد بلغت من
الشدّة
أقصاها في بعض
المواطن، وتجاوزت
حدودَ النقد
العلميِّ إلى
ما يتعفّف اللسان
من نقله من
كلمات جارحة
تختلف بين لوم
وعتاب وطعن
وشتم مُقذعٍ
وسبٍّ ماجن.
يبدو
مما قد صرفوه
بألسنتهم
وأقلامهم من
هذا القبيل،
أنّ أحدَهم
إذا أراد أن
ينال من خصمه أطلق
القيود، وقذف
ما في صدره من كلّ
ضغينةٍ على وجه
التعميم،
وأطفأ
غُلَّتَهُ
على حسب
إتقانه من
فنون الطعن
والنكير،
وعدّ
المثالب،
والمساس
بالكرامة ما
يحمرّ له وجه
الجسور!
وعلى
سبيل المثال:
يتخيّل محمّد
بن سليمان
البغداديُّ
معشرًا من
الناس - سماهم
المتفقهةَ في
المذاهب -
فتحامل عليهم
بعد أن استثنى
الفقهاءَ منهم
ليبرّر بذلك
حجّتَه وحتّى
لا يُرْميَ
بعموم
التعدّي على
العلماء،
بينما هو في صدد
الرمي بكلّ من
لا يوافق
الصوفيّة كما
يبدو من سابق
عباراته،
ولربما كان
يلاحظ خصمَه
بالذّات في
ذهنه إذ هو
يرقم هذه
الكلمات،
فيقول:
»فانّ
المتفقهة
قاصرون،
ومرادهم أنْ
يُعرَفوا بين
الناس بالعلم
والفقه لأجل
أغراضٍ شيطانيّةٍ
يريدون
إنفاذها،
وشهواتٍ
نفسانيّةٍ
يحاولون
إيجادها؛
فيضطرّ بهم
الأمر إلى التفتيش
عن عيوب
الناس، فكيف
يؤوّلون
شيئًا مقصودهم
التفتيش عليه.
ومتى ظفروا
بوجهٍ فاسدٍ
في حال
إنسانٍ، فكأنّما
ظفروا بملك
الدنيا...«[578]
ثم ينهال
على هؤلاء
الخصوم
الخياليّين
بالدعاء
فيقول: »خذلهم
الله وأذلّهم
إن لم يكن لهم
نصيب من الهداية
والتوفيق.« [579]
اعتاد
النقشبنديّون
إطلاقَ كلمة »المُنْكِرِ«
على كلّ من
رأوا فيه
شيئًا من
مخالفتهم،
فَتَكَرَّرَ
وتضاعف
استعمالهم
لهذه الكلمة
وما صَاحَبَهَا
من عباراتٍ
لاذعةٍ حتّى
اجتمعتْ،
فتكوّن منها
رُكامٌ ضخمٌ
بحيث يناسب أن
يعبَّر عنه
بأدب الشتم والتهكُّم
في أسلوب
المعارضة عند
النقشبنديّين؛
وهذه أمثلةٌ
منها:
قال
صاحب الحديقة
النديّة
الآنف ذكره في
صدد الدفاع
عن: خالد
البغداديّ :
»فأنكر
عليه بعضُ من
لا خلاق لهم،
لِمَا أنَّ سُوقَهم
ببضائعه
الغزيرة كسد،
فمنهم من أنكر
أصلَ الطريقة
وقال لا شيء
يوصل إلى الله
تعالى غير ما
لدينا من
ظواهر الفقه
وما نحن عليه
من السلفية...«[580]
وقال
أيضًا »فسبحان
من جعل
المحاسن
مساويًا،
والمساوي محاسنًا
في أعين
المنكرين أهل
الغرور.«[581]
وقال
ناقلاً عن عبد
الغني
النابلسي من
بحثٍ يتعلّق
بالجذبة،
فقال »وهي
حالةٌ شريفةٌ
وإن أنكرها
كثير من
المتفقهة
القاصرين في
الزمان
لبعدها عنهم
من قسوة
قلوبهم...«[582]
وقال
أيضًا »إن
شيخَنا (...) كيف
قطع منازل
السلوك، ووصل
إلى حدّ
الإرشاد
والتسليك إلى
ملك الملوك
برحلته
الهندية
الكاملة
بثلاث سنين،
مع أنّ كثيرًا
من الأولياء
لم يقطعها
بستين. فنقول
ذلك فضل الله
يؤتيه من
يشاء، ولا حَجْرَ
على الفضل
الإلهي
الخارج عن
حيطة عقول
العقلاء؛
فليت شعري ما
يقول هذا
المنكر في
وصول من وصل
إلى الكمال
بأقلّ من يوم.«[583]
إنّ
قائل هذه
الكلمات (محمّد
بن سليمان
البغداديّ) هو
من كبار خلفاء
خالد البغداديّ،
إنّه يتعجّب
كيف اكتملت
رحلةُ شيخه
إلى اللهِ في
ظرف ثلاث سنين
بعد وصولِهِ
إلى الهند.
لأنّ هذه
المدة في نظره
قصيرة جدًّا
غير كافية »لقطع
منازل
السلوكِ«.
ولذلك يدّعي »أنّ كثيرًا
من الأولياء
لم يقطعها في
ستين عامًا«
يتصوّرُ
هذا الصّوفي
الجاهل أولاً
وبإيمانٍ
عميقٍ: أنّ
شيخهُ »قطع
منازل السلوك
في مدّة ثلاث
سنينَ«، ولا
شكَّ في أنّه
يقصد بذلك »وُصُلَهُ
إلى اللهِ«؛ فيبرهن
كلامُهُ هذا
بوضوحٍ على أنّه
حلوليٌّ،
ولكنّه عَادَ
يواري غرضه في
طيّ كلماتِه
بقوله: »ووصل
إلى حدّ
الإرشاد
والتسليك«،
حتّى لا
يُرْمَى
بِالْحُلُولِيَّةِ
مباشرةً،
بينما قياسه
سرعةَ شيخه
بالمقارنة
بينه وبين
كثير من
الأولياءِ: »أنهم لا
يقطعونها في
ستين عامًا«،
قد فضّحهُ ولم
يترك له أثرًا
خافيا من
حيلته فيما
تبنّاهُ من
إسرارِ
حُلُولِيَّتِهِ.
ثانيًا: اتّخذ
القياسَ
الزّمنيّ
بعدد (السنينَ)
في سرعة
الإنتقالِ
عبر »منازل
السلوكِ«،
بينما هذا
القياسُ
وتعبير: »منازل
السلوك«
من الأمور
الغريبة على
الإسلام في
الحين الّذي
يخالف العقلَ
والمنطق
الإنسانيَّ،
ولا يُعتد به
في ميزان
العلم.
أمّا
وإذَا كَانَ
القصدُ
المسافةَ بين
العراق
والهند: فَيُحبَّذ
لو بعث الله
هذا الرجلَ من
قبره فوقف برهةً
على إمكانات
هذا العصر، ثم
وجد الناس على
اختلاف
أجناسهم
ودياناتهم
بما فيهم من
الكفار
والمشركين
والزنادقة
والمنافقين
والفجرة
والمجرمين،
كيف يقطعون
اليوم أضعافَ
مسافاتِ ما
بين العراق
والهند، بل
وكيف ينفذون
من أقطار
السماوات
والأرض في
ساعات
معدودات؛ لانْبهر
وطاش عقلُهُ،
ولتصبّب
جبينُهُ
عرقًا مما
سجّل في
حديقته من تلك
الألفاظ
الّتي لم يَعُدْ
لها أيُّ حكمٍ
وقيمةٍ في هذه
الأيّام! ولربما
أعاد النظر في
تحامله على
ذلك المُنْكِرِ
الخياليِّ
الّذي نسب
إليه إنكارَ
وصول بعض
الأولياء إلى
درجة الكمال
عند الله
بأقلّ من يوم،
ولاَسْتَبَانَتْ
له حقيقة شيخه
الّذي نفخ هو
بالذّات هذه
الأفكارَ في
عقله وأملى
عليه كتابَ الحديقة
النديّة كما
جاء في كتاب البهجة
السنيّة
لمحمد بن عبد
الله الخانيّ.
قال
الخانيّ في
كتابه
المذكور:
»لما
كان كتابُ
الحديقة
المذكور موضوعًا
لإثبات وجود
تعلُّم علم
الباطن، وإثبات
فضيلة
الطريقة النقشبنديّة،
ولدفع شبه
المنكرين من
أهل الحسد على
حضرة شيخنا (...)
كان في أخذ
الآداب منها
صعوبة على
المبتدئ
والآن ولله
الحمد تقرر
الطريق
وانخذل أهل
الحسد
والعناد
والتعويق.«[584]
قال
حفيده عبد
المجيد
الخانيّ وهو
يشرح قصة المعارضين
لخالد
البغداديّ
وقد أفرد لها
بحثًا تحت
عنوان »فساد
الحساد«، قال فيه
»فلم
يقابل (أي
خالد
البغداديّ)
صنيعَهم
الشنيعَ إلاّ
بالدعاء لهم
وحسن الصنيع؛
فلم تَخْبُ
نارُهم، وما
زاد إلاّ شرّهم
وشرارهم.«
»كلّ
العداوة قد
ترجى إزالتها
* إلاّ عداوة
من عاداك من
حسد«.
ثم
قال:
»فألّف
بعض
المعروفين
(يقصد معروف
البرزنجيّ) من
المنكرين
الّذي تولّى
البهتان
كبرًا وغرورًا،
رسالةً ملئت
منكرًا من
القول
وزورًا...إلخ.« [585]
وجاءت
في موضع آخر
كلماتٌ له من
نفس البحث
يقصد بها عبد
الوهّاب
السوسيّ
وجماعتَه،
وكأنّ شرارات
الغضب تطير من
قلمه؛ فقال:
»ولفّقوا
من قول الزور
والبهتان
رسالةً بتكفيره
لما زعموا من أنّه
يدّعي رؤية
الجانِّ،
وأرسلوها إلى
دمشق مع أحد
هوامّ
الأكراد
العوامّ يقال
له إسماعيل الزلزلومي.
فلمّا وصل
إليها توسّل
بعض خدم الشيخ
بكلّ وسيلة
جميلة،
واستحضرها
لحضرته
الجليلة ليظهر
عليها. فطار
خبرها إلى
والي الشام،
فأمر بتشهيره
في البلدة
وتعزيره،
فمرّوا به وهو
كذلك من تحت
قصر الشيخ (...)،
فحانت منه إلى
الطريق نظرةٌ،
فأمر بتحويله
إلى رحابه،
وتطهيره
وتخويله حلةً
من ثيابه،
وأدناه منه،
فقبّل
الرجُلُ
رِجْلَهُ،
فعفاه.«[586]
لقد
سرى تأثير أدب
الشتم
والتشنيع من
كبار النقشبنديّين
إلى أدنى
بسطائهم؛ إذ
قد ترى مَنْ
نصب نفسَه على
كرسيِّ
المشيخة من
أوغادهم وأراذلهم؛
تراه يتجرّأ
على تحرير
الرسائل ويبعثها
إلى من اغترّ
به وبنفس
الأسلوب،
تقليدًا
بخالد البغداديّ،
وحتّى بتكرار
بعض ألفاظه
الّتي اعتاد
على
استعمالها!
منهم
رجل اسمه
سليمان زُهْدِي،
ينهال على شخصٍ
من أتباعه
ويهدّده
برسالةٍ
نقلناها فيما
يلي
بالمناسبة
كمثال على
شخصيّة
الكاتب بما تحوي
بين تضاعيفها
من ألوان الجهل
بالآداب
والقواعد؛
ونترك الحكم
للقارئ على ما
جاء في
عباراته
الواهية من
عيوب لغوية وإنشائية
وقصور بلاغية
وسقطات
أخلاقية وما يعتريها
من مظاهر
الخروج على
الإسلام بوجه
عام.
وهذا
نص ما سجّله
الرجل
بحذافيره دون
أدنى تصرُّفٍ
فيه:
»يا
أخينا قد أقمت
في المكة المكرمة
وحضرت حلقة
السادات
الكرام
والختم الخُوَاجَگَانْ
والتوجّهات
عندنا ولكن ما
حصل منك
الدوام وكثرة
اشتغال الذكر
مثل سائر
الاخوان وقلة
المبالات منك
في آداب
الطريقة
العلية وصار
ذلك سببا لتركك
حلقة السادات
عندنا ووصولك
الى المنكرين
والمطرودين
عن طريقتنا
والمتشيّخين
المرتسّمين
في مكة
المكرمة ثم
اعطى المتشيّخ
المطرود
الاجازة ثم
وصلت على بلاد
جاوى وكنت
تريد التشيّخ
مثله وتؤذي
على اهل الحق
والاستقامة
وهذا الفعل
منك لا يرضي
الله ولا
رسوله ولا
سادات الطريقة
العلية وكنت
ضالا ومضلا
على الناس كما
كان المتشيّخين
المطرودين
هنا لولا
وصولك اولا
عندنا فما
بينت لك هذه
النصيحة.
والامام
الّذي اخذ
طريقة التشيخ من
عند
المتشيخين
ولا انصح له
فانه بعيد عنا
لا نعرفه ولا
يعرفنا لان
الباطل لا
يسعد والحسود
لا يسود
والواجب عليك
التوبة
النصوحة عما فعلت
والرجوع عما
جرى والدخول
الى طريقة التربية
والوصول الى
رضاء الله
تعالى بيد المرشد
المأمور بيد
صحيحة مثل
الشيخ عمر
والشخ عبد
الحليم
والشيخ عبد الوهّاب
هناك ان لم
تصل الى مكة
المكرمة وان
لم تفعل ما
امرت لك من
طرف السادات
فانتظر
العقوبات الدنيوية
والاخروية
لانّ تعالى
غيور يحارب من
خالف على اوليائه
وينتقم على من
غير طريق
وصوله اليه ايّ
ظلم اكبر من
هذا الظلم
فسيعلم
الّذين ظلموا
اي منقلب
ينقلبون...إلخ.«[587]
وقال
الحسين
الدوسريّ في
مستهلّ كتابه »الرحمة
الهابطة«
ما نصّه:
»لقد
طرق سمعي بعض
مقالات
منقولة عن
المزوّرين
وجهالات
منسوبة إلى
بعض
المشهورين وإنكار
أمور، عليها
مدار العلماء
العاملين والمتقدمين
منهم والمتأخّرين؛
فوضعت رسالة
مثبتة لما
أنكروه و مبتّتة
لما زوروّه،
احتسابا لوجه
الله الأكرم،
وانتصارًا لاسم
الله الأعظم،
ونصحًا لأمة محمّد
r،
كي لا يقعوا
في ورطة
الإنكار، وكي
لا يبقى الأخ
المنكر على
الإصرار،
فيؤل به إلى
دخول النار.«[588]
وجاء
في تفسيرٍ
أصدرته جماعة
من النقشبنديّين
في الآونة
الأخيرة
بإسطنبول،
قالوا فيه:
»يُستَغرَبُ
ممّن يحكم على
الرّابطة
بالتحريم؛
فهل استنبط هذا
الحكم من
معناها
اللغويِّ أم
الإصطلاحيِّ،
أم وجده في
أحد الكتب
المنـزَلَةِ
من عند الله؟!!«
»ولهـذا
يجب على المرء
أن يخاف الله
فلا
يَمْنَعَنَّ
الناسَ من فعل
المعروف
بتحريم ما
أحلّه الله
وتحليل ما
حرّمه، ولا
يَصِفَنَّ
أحدًا من أهل
القبلة
بالكفر حتّى
لا يُصبِحَ هو
بذاته كافرًا!!«[589]
وما
أكثر من نحو
هذه الألفاظ
والعبارات في
مواطن كثيرة
من كلامهم؛
الّذي لم
يقصدوا في
الحقيقة إلاّ
لينالوا به من
عرضِ أهل التنـزيه
لجناب الحق
سبحانه،
والحطِّ من
كرامة
الموحّدين،
وإيذائهم
وإيلامهم. فاكتفينا
بهذا القدر
اليسير على
سبيل المثال
+
الكلمة
الختاميّة.
لقد
انتهينا هكذا
من دراسةٍ
هامّةٍ،
أخذتْ من
وقتنا
الكثيرَ،
وأفنتْ من
عمرنا أكثر من
ثُلُثِهِ،
وكلّفَتْنا
ما لا يُستهان
به. ولابد من
أن نعترفَ هنا
بأنّ الهموم
كثيراً ما
أقضّتْ
مضجعَنَا إذ
نسلك طرقاً
شائكةً في
البحث
والتعمُّق
أثناء
متابعتنا
لهذه الدراسة!
في
الحقيقة لم
يكن القصدُ من
الإقدام على
هذا العمل
الخطير إلاّ
إظهارَ ما قد
غاب عن جمهور
رجال العلم
خاصّة من أسرار
الطريقة النقشبنديّة
وآدابها
وأهدافها
ومستوحاها
وطقوسها وشخصيّات
رجالها
وتأثيراتها
على الحياة الاجتماعيّة
في المناطق
الّتي انتشرت
فيها.
ولعلّ
الأهمَّ من
ذلك، أنّ
المجتمع
العربيَّ
الّذي تربطه
الصلةُ
التاريخيةُ
القويةُ بالشعب
التركيّ،
وجدناه بمنأى عن
الإطلاع على
أمورٍ كثيرة
تلعب الدورَ
منذ قرونٍ في
توجيه هذا
الشعب
وترويضه على
غير ما يعتاده
ويتلمّسه بقيّة
المسلمين من
مفهوم الدين.
فرأينا من
الخدمة العلميّة
أن نتناول من
تلك القضايا
ما يدخل في
نطاق معرفتنا
واختصاصنا،
وأن نسلّط الضوء
عليها لتمهيد
المجال إلى
مناقشتها في ديوان
العلم وميزان
العقل
والدِّينِ.
ألا وهي
النـزعة
الصوفيّة
المتمثّلة في
الطريقة النقشبنديّة
المتفاقمة في
صفوف
الملايين من
أبناء هذه المنطقة،
والراسخة في
أعماق ضمائر الشيوخ
والشباب
والنساء
والرجال منهم.
وإذا كان هذا
الميلُ
الشائع في
العنصر
التركيّ يدلّ
على حقيقةٍ، فهي
ليست إلاّ
علامات
انقباضٍ
وتشنّجٍ ينتابه
بسبب الضياع
الذاتي
وخسارة
الهوية.
لقد
ثبت من خلال
البحوث
والدراسات العلميّة
أنّ الأزمات
الّتي
يعانيها
المجتمع
التركيّ - على
اختلافها - في
الوقت
الراهن، تعود
الأسبابُ
المتنوّعةُ
لكلّ أزمةٍ
منها في النهاية
إلى مشكلة
الهويّة. ذلك،
أن الإعتزاز
البالغ
بالأمجاد إلى
حدود التطرّف
وجنون
العظمة؛
وتقديسَ
رجالٍ دخلت
أسماؤُهم في
قائمة »أولياء
الله« ضمن
مجلّداتٍ
ضخمةٍ في
المكتبات التركيّة
- بما فيهم
جميع سلاطين
بني عثمان،
حتّى السلطان محمّد
الثالث الّذي
قَتَلَ تسعة
عشر أخًا له
في فجر يوم
الثامن
والعشرين من
شهر يناير
(كانون
الثاني) عام 1595م.؛ وكذلك
الإنهماكَ في
الإستغاثة
بأمواتٍ قد
أصبحوا
عظامًا
نخرةً، بل قد
اندرست وبادت
رفاتهم ولا يدري
أحد هل ماتوا
على الكفر أم
على الإيمان؛
يبرهن على أنّ
هذا الشعبَ لم
يعد يملك
شيئًا يُثبِتُ
به هويتَه سوى
اللجوء إلى العصبيّة
القوميّة
الّتي تعتمد
في جذورها على
أساطير
الآباءِ وتقديس
السلاطين
وأقاصيص
الصوفيّة
والإستئناس
بالقبور
والأموات.
إنّ
هذا البحث الّذي
يتناول
الطريقة النقشبنديّة
بتفاصيلها
وبأسلوبٍ
تحليليٍّ
ومنهجيٍّ، لم
يقتصر على
حدود أبعادها الدينيّة
والرّوحيّة،
بل يتجاوز إلى
حدودها الاجتماعيّة
وعواقبها
الأخلاقيّة،
ويفتح بذلك
نافذةً على
الباحثين،
لِيُطلُّوا منها
على الشعب
التركيّ
الصوفيّ،
ويطَّلعوا على
أحواله
وأزماته
بنظرٍ علميٍّ
وموضوعيٍّ من
خلال الوثائق
والأدلّةِ.
لأنّ إصلاحَ
أيّ فسادٍ، لا
يمكن أنْ يحظى
بنجاح إلاّ
بعد الإطّلاع
على حقيقة
أسبابه.
ولابدّ
من الإشارة
هنا إلى أنّ
تكثيف النقد
على الشعب
التركيّ بسبب
انتشار
الطريقة النقشبنديّة
بين طبقاتها،
لا يعني أنّ
الشعب بعمومه
قد اعتنق هذا
المذهب
الصوفيّ
بعينه؛ بل
هناك طرقٌ
صوفيةٌ أخرى، فضلاً
عن ذلك أنّ
أقلّيّةً من
الموحّدين
الحنفاء،
وجماعاتٍ
متباينةً من
المشركين
والملاحدة من
أبناء الشعب
التركيّ لا
صلة لهم
بالتصوّف على
الإطلاق. إلاّ
أنّ الروح
الباطني الصوفيّ
قد بلغ من
الرسوخ في
ضمير أغلبية
الأتراك إلى
حدٍّ نجد حتّى
العلمانيّين
منهم قد بنوا
صرحًا
عملاقًا على
قبر زعيمهم
بهواجس روحيّة
كما يبدو من
احتفالاتهم
الّتي يقومون
باجرائها في
جوٍّ دينيٍّ
خاصٍّ،
ويُجبرون بقيّة
الفئات على
مشاركتهم في
تلك
الإحتفالات!
ولهذا ليس من
الزور أن
يُقالَ أنَّ
غالبَ الأتراك
حتّى
العلمانيّين
منهم، قومٌ لا
يقتنعون
بأيِّ دين
إلاّ أن يكون
مشوبًا بتصوُّراتٍ
موهومةٍ
وحكاياتٍ
خرافيّةٍ
وتفسيراتٍ
أسطوريّةٍ لا
حدود لها.
وهذا
قد جعل من
الشعب
التركيّ
قومًا
تَبَعِيًّا
يترنّح أمام
عواصف
الأحداث
عَبْرَ
تاريخه،
يُقَلِّدُ كلّ
قومٍ يراه على
الحقِّ،
ويأخذ من
حثالة كلّ
دينٍ، إلى أن
جمعها ومزجها
أخيرًا
بمفاهيم
إسلاميةٍ
واعتقد أنّ ما
قد صنعه هو
الإسلام! بل
هو الإسلام
المبتورُ
الّذي تعرّض
لسلسلة من
الإستحالات،
والموروثُ من
العرب بعد
الربْعِ
الأول من العهد
العبّاسيِّ،
والمتقمِّصُ
اليوم في قالب
النقشبنديّة.
إنّ
الشعب
التركيّ
مسئول
بالدرجة
الأولى عن الفساد
الّذي قد غرق
فيه اليوم إلى
قمّة رأسهِ؛
مسئولٌ عن
إصلاح كلّ ما
يخالف نصوصَ
الكتاب
والسنّة من
معتقداته بسبب
هذا المرض
الّذي قد
تحكّم فيه
وتطوّر إلى
أمراض إجتماعيّة
وأخلاقيّة
أخرى.
والمسلمون
جميعًا
مسئولون
أيضًا بالدرجة
الثانية من
إنقاذ هذا
الشعب عما قد
وقع فيه.
وتتأكّد هذه
المسئوليةُ
المتوجِّهة
إلى أهل الوعي
والخبرة من كلّ
شعبٍ في
العالم عندما
نشاهد
التطرُّفَ
الْمُنْبثقَ
من الروح
الصوفيّ
يتفاقم يومًا
بعد يومٍ في
صفوف هذا
المجتمع
ويُهَدِّدُ
السلمَ والأمنَ
في المنطقةِ؛
كما تترتّبُ
على كلّ شخصٍ
ذي حميةٍ
إنسانيةٍ، يُحِبُّ
الحرّيّةَ
ويتمنَّى
يومًا يسود
فيه الأمن
والطمأنينة
والهدوء في
جميع أرجاء
المعمورة -
إذا ما وقع
نظرُهُ على
مضمون هذا
العمل الهامّ
- تترتّبُ
عليه مشاركة
المخلصين من
أهل الإصلاح
والإرشاد في
محاولة
القضاء على
هذا السرطان
الّذي مزّق روحَ
الشعب
التركيّ
بمخالبه
وأوشك أن يجعل
منه أُلْعُوبَةً
في يد عصابةٍ
خطيرةٍ يختلّ
بها توازن
القوى على
مستوى منطقة
الشرق الأوسط لأمدٍ
غيرِ بعيد!!!
ونؤكّد
بكلّ جدٍّ
واهتمامٍ أنّ
هذا البحث
وثيقة
تاريخية في حدِّ
ذاته؛ يتبنّى
إظهارَ ما قد
خَفِيَ أو
أُخفِيَ عن
العامّةِ من
واقع منظّمةٍ
خطيرةٍ كانت لها
أغراضها في
مرحلة زمنية
معيّنةٍ،
تقمّصت عبرها
في لباسِ
طريقةٍ
صوفيةٍ اسمها الخالديّة،
وفعلتْ ما
فعلتْ تحت
ستار النقشبنديّة،
ثم تحوّلت إلى
طريقةٍ
صوفيةٍ
تمامًا بعد أن
حقّقت شيئًا
كثيرًا من
أهدافها. ولا
نريد أن نستقصي
فيما لا
يتحمّله
الزمان
والظروف والأوضاع
أكثر من هذا
القدر؛ فانّ
القلم الصادق
لن يغفل عن
تسجيل ما قد
جرى في هذا
العالم من صغير
وكبير. {
وَكُلُّ
صَغِيرٍ
وَكَبيِرٍ
مُسْتَطَرٌ }[590]{كَلاَّ
سّوْفَ
تَعْلَموُنَ
* ثُمَّ
كَلاَّ
سّوْفَ
تَعْلَموُن.َ}[591]
ولعلّ
ما قد سجّله
الدكتور أسعد
السمحراني في
ثنايا كتابٍ
له من كلماتٍ
يسيرةٍ جدًّا
تهمس إلى ذوي
العقول
المتفتّحةِ
شيئًا من
أسرار مدينة
السليمانيّة
العراقيّة
الّتي طالما
تحتضن جماعاتٍ
مشبوهةً كما
احتضنتْ ذلك
الشبحَ الخظيرَ
المتقمِّصَ
في لباس
الطريقة النقشبنديّة
الخالديّة
إبان مرحلةٍ
حساسةٍ من
القرن
الماضي..
يقول
السمحرانيُّ:
»بعد
إعدام الباب
اُتُّهِمَ
حسين
المازندراني
(البهاء) مع
مجموعةٍ من
أتباع الباب
بمحاولة
اغتيال ملك
إيران ناصر
الدين شاه
انتقامًا
للباب،
فاعتُقِل ثم
نُفِيَ
وشقيقه يحيى
وبعضُ
أتباعهم إلى
بغداد سنة 1268هـ.- 1852م.، حيث
مكث فيها
قرابة 12
عامًا قضى
بعضها في
السليمانية
يبشر بدعوته.«[592]
وهذا
دليل قاطع على
أنّ
النقشبنديّين
الّذين وقفوا
دائمًا في وجه
المؤمنين
الموحدّين
الحنفاء
وقوفَ
العدوِّ
اللّدود؛
سكتوا - على الأقل
- عن نشاطاتِ
حركةٍ من أخطر
الحركات الهادفة
إلى هدم
الإسلام من
أساسه في
مدينتهم السليمانية
بالذّات. وهي
منبَثَقُ
دعوتهم،
ومركزُهم،
وقبلتُهم
المقدّسةُ
بعد مدينة
بُخَارَى؛
كانوا ولا
يزالون هم
الأكثريةَ
والأقوىَ
فيها من بقيّة
الجموع
والجماعات!
إنّ
الّذي قد جرى
بالأمس من خير
وشر يجري اليوم
أيضًا وسيجري
غدًا
لامحالة،
وإنْ اختلفت الصُّوَرُ
وتباينت
الأشكال
وتنوّعت
الأساليب.
فالحرب سجال
بين الحقّ
والباطل...تلك
سنة الله »قُلْ
كلّ يَعْمَلُ
عَلىَ
شَاكِلَتِهِ
فَرَبُّكُمْ
أَعْلَمُ
بِمَنْ هُوَ
أَهْدىَ
سَبيِلاً«[593]
ولكنّ
الّذي يجب أنْ
يُؤْخَذَ
بنظر
الإعتبار، هو
أنّ التطرُّف
والحقد
والعنف
والإضطهاد
مهما بلغ من
القسوة
حدّها؛ وأنّ
التزوير
والتدليس
والتدجيل
والغش والمكر
والإستغلال
مهما لعب
الدور في
إرباك
البسطاء،
وغسل الأدمغةِ،
وتجنيد
الخونة تحت
ستار التصوّف
والتقشّف أو
العلمنة
والإلحاد؛
لصرف الوجوه
عن الحق،
وتشويه
الحقيقة،
وتقديم
الذئاب في
جلود الضأن،
ونسج نظريات
المؤامرة
لإخماد حرارة
الإيمان
الّذي يملأ
قلوب أهل
التوحيد
الحنفاء؛
فانّ الصدق
والإخلاص
والمثل
العليا سوف تسلك
طريقها
دائمًا إلى
قلوبٍ
مؤْمنةٍ
واعيةٍ وعقولٍ
نيّرةٍ
متفتّحةٍ،
لتبقى
الحقيقةُ
المطلقةُ
وحدها دائبةً
غالبةً
شامخةً إلى
أبد الآبدين
ولو كره
المتزمّتون
وأبناء
الحماقة
جميعًا، فانّ
الحق يعلو ولا
يُعلى عليه. »بَلْ
نَقْذِفُ
بِالْحَقِّ
عَلىَ
الْبَاطِلِ
فَيَدْمَغُهُ
فَإِذَا هُوَ
زَاهِقٌ،
وَلَكُمُ
الْوَيْلُ
مِمَّا
تَصِفوُنَ«[594]
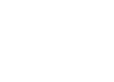
كلماتٌ
توضيحيّة
في سياق
الإجابة على
التقرير
الصادر من
جامعة أمّ
القُرَى
بقلم فضيلة
الأستاذ
الشيخ لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه
رئيس قسم
العقيدة الإسلاميّة
للجامعة المذكورة
بمكّة
الْمُكَرَّمة
حَوْلَ
كِتَابِنَا
»الطَّرِيقَة
النقشبنديّة
بَيْنَ
ماَضِيهاَ
وَحاَضِرِهَا«.
***
المحتويات.
* توطئة
* نصُّ التقرير
الصادر بشأن كتابي:
الطَّرِيقَة النقشبنديّة
بَيْنَ
ماَضِيهاَ
وَحاَضِرِهَا.
*
الإجابةُ على
النقدِ
الواردِ في
القسم الأول
من التقرير
الّذي يستهلّ
بقوله: »
أوّلاً:
الجوانبُ
الإيجابيّةُ
في الكتاب«.
*
الإجابةُ
على النقدِ
الواردِ في
القسم الثاني
من التقرير
الّذي يستهلّ
بقوله: »
ثانياً:
الجوانبُ
السلبيّة«.
* نبذة من
قصّة حياتي
وذكرياتي.
*
وَصْفُ
طائفةٍ بِـ»الوهّابيّة« في
ثنايا كتابي
وبواعثُ اسْتِعْمَالِهَا...
* مسائِلُ
متفرّقة:
***
توطئة
----------------
بسم
الله الرحمن
الرحيم
الحمد
لله ربّ
العالمين
والصلاة
والسلام على
سيّدنا محمّد
وعلى آلِهِ
وصحبِهِ
أجمعين
أمّا
بعد،
فهذه
توضيحاتٌ
تفصيليّةٌ
كَتَبْتُهاَ
لتقومَ مقامَ
الإجابةِ على
تحقيقاتٍ
أجْرَاهَا
وأثْبَتَهاَ
العالمُ
الفاضلُ
العلاَّمَةُ
الشيخ لطفُ
الله بن عبد
العظيم خوجه،
أستاذُ
العقيدةِ
بجامعةِ
أُمِّ القُرىَ
بمكّةِ
المُكَرَّمَة،
أثناءَ
مراجَعَتِهِ
لكتابِي
الموسـومِ »الطريقة النقشبنديّة
بين ماضيها
وحاضرهاَ«.
وأماّ هذا
الكتاب،
فإنّه مِنْ
أهمّ البحوثِ
والدراسات العلميّة
الّتي
أنجزْتُهَا
والحمد لله
منذ
تَنَاوَلْتُ
القلمَ
بَاحِثاً في
مجالاتٍ
شتَّى.
ولماَّ
وفّقني ربِّي
لإتمامِ هذا
الكتابِ عام 1420 من
الهجرة
النبوية u،
اسْتَنْسَخْتُهُ
في
طَبْعَتَيْنِ
عَدَداً غيرَ
كثيرٍ،
وقدّمتُ منه
نُسَخاً إلى
العلماءِ في
بلدِنا
(تركيا)،
لِيَرَوْا
فيه
رَأْيَهُمْ،
فَأَقُومَ
بتصحيحهِ وتنقيحهِ
وتهذيبه على
ضوءِ ما
أتلقّىَ منهم
من توصياتٍ
وإرشاداتٍ
وملاحظاتٍ.
بيد أنّ أحداً
منهم لم
يُبْدِ رأياً
صريحًا فيهِ
من سلبٍ أو أيجابٍ
سوى عدد قليل
منهم أجابوني
شفهياًّ: أنّه
لا مانعَ من
طبعِ هذا
الكتابِ،
وفيه نفعٌ للناسِ.
ولكنَّ
الطّبيعةَ
الحثيثةَ
التي
جُبِلْتُ عليها
مَنَعَتْنِي
من الاجتزاءِ
بهذا القدرِ
من
الاستشارةِ
لما كنتُ على
بيّنةٍ من قلّةِ
عدد العلماءِ
وعَجْزِ
كثيرٍ مِمّنْ
يتّسمونَ
بصفةِ العلمِ
في بلدِناَ عن
فهم النصوص
المدوّنةِ بالعربيّة،
أَحْبَبْتُ
أن أَعْرِضَ
هذا الكتابَ
على أهل
الخبرةِ
والمعرفةِ
بالحرمين
الشريفينِ،
وبدأتُ
أترقَّبُ
الفرصةَ
لتحقيقِ هذا
المطلَبِ،
حتّى قدّرَ
الله لي أنْ
زارني طالِبانِ
من أهل البلدِ
الأمينِ في
داري
بإسطنبولَ،
وهما: سعود بن
سعد العُتَيْبِي،
ومحمّد بن
سالم
الجُهَني،
وذلك بواسطةِ
صديقي الحميم
الشيخ مصطفى
الهلالي
وَبِصُحْبَتِهِ.
فَاسْتَقْبَلْتُهُمْ
بترحابٍ وأَحْسَنْتُ
مثواهم ما
أمكنني
التزاماً بحقّ
الأُخُوَّةِ
في الاسلامِ.
ولمّا
تَعَرَّفتُ
على
الطَّالِبَيْنِ
الْعَرَبِيَّيْنِ
وعلمتُ أنهما
يدرسانِ
بجامعةِ أمّ
القرى بمكة
المكرّمة، وأنّهما
يبحثانِ عن
مصادرَ
علميّةٍ
ليستعينا بها
على إعداد
شهادةِ
الدكتوراه،
قَدَّمتُ لهما
نسخةً من هذا
الكتابِ على
سبيل المساعدةِ
في مهمّتهما،
كما أودعتهُ
في ذمَّةِ
الأخ سعود بن
سعد
العُتَيْبِي
خاصّةً،
لِيَعْرِضَهُ
على العلماءِ
فيروا فيه
رأيهم، ليتمّ
طبعه ونشره
بعد ذلك إنْ
شاء الله
تعالى... إلى أن
بَلَغَنيِ
بعد فترةٍ من
الزمنِ -
تقريرٌ من
الفاضل
المكرّم
الشيخ لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه،
أستاذِ
العقيدةِ
بجامعةِ
أُمِّ
القُرىَ بمكّةِ
المُكَرَّمَة،
وذلك تحت
عـنوان »نظرة حول
كتاب:الطريقة النقشبنديّة
بين ماضيها
وحاضرها«
وقبل
أن أتناوَلَ
مضمونَ هذا
التقريرِ
القيّمِ،
وأقومَ
بتحليله
والإجابة على
ما ورد فيه من
النقد والنصح
والإرشاد،
أريد أن
أُقدّمَ
بالِغَ
شُكْري
وامتناني
أوّلاً للأخ
سعود بن سعد
العُتَيْبِي
على
الْتِزَامِهِ
بالذِّمّةِ
والأمانةِ
فيما
ولَّيتُهُ
ووكّلتُهُ،
ثمّ أتقدّم
بالشكر
الجزيلِ إلى
الأستاذ
العلاّمةِ
الشيخ لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه،
على مساعيه
الطيّبةِ لما
تكرّم ببذلِ جهودٍ
بالغةٍ
بإجراءِ
النظرِ في هذا
الكتابِ الضخمِ
دونَ مَلَلٍ،
وما أثبتَ فيه
من تحقيقاتٍ
هامّةٍ، مماّ
يَدُلُّ على
مدى صبرِهِ
وعنايتهِ ودقّةِ
دراستهِ
للكتابِ
وسعةِ
إطّلاعِهِ على
تفاصيلهِ...
ولا يفوتني
بهذه
المناسبة
أنْ أُعْلِنَ
عن منتهى فخري
واعتزازي
بمثل هذا
العالم
الفذِّ،
وأُكْبِرَ ما
يمتازُ به من
الباع
الطويلِ في
العلوم
والمعارف،
تشهد على ذلك
عباراتُهُ
الرصينةُ
وأُسْلُوبُهُ
الجليُّ
الخالص
المتين،
بجانب ما
يتّصف به من
العدلِ
والإنصافِ...
فجزاه الله
تعالى خير
الجزاءِ،
ونفَّع به
أمّة
الإسلامِ،
وأَكْثَرَ من
أمثالِهِ
زُخْراً
لأمّتنا آمين.
***
الإجابةُ
التفصيليّةُ
على التقرير
المذكور
لَقَدْ
اشْتَمَلتْ
مُلاَحَظَاتُ
الشيخ لطف
الله عَلَى
كِتَابِنَا
المشار إليه
في ثلاثة
أقسامٍ.
أوّلاً:
الجوانب
الإيجابيّة
في الكتاب،
ثانياً:
الجوانب السلبيّة.
ثالثًا:
مسائِل
متفرّقة:
وهذا
نصّ التقرير
بسم
الله الرحمن
الرحيم
نظرة حول
كتاب »الطريقة
النقشبنديّة
بين ماضيها
وحاضرها«
أولاً:
الجوانب
الإيجابيّة
في الكتاب:
1-
هذا الكتاب
وثيقة مهمّة
في بيان حقيقة
النقشبنديّة
من الداخل،
حيث أن مؤلّفه
من أسرة نقشبنديّة
بحسب ما أفاد
به في أول
الكتاب ص3
حيث قال:»
ولدت ونشأت في
أسرة ذات شهرة
واسعة
النطاق، تتمتع
بالزعامة
لقطاع كبير من
هذه الطائفة
الصوفية«.
وانتسابه
لهذه الطائفة
ولزعامتها،
مكّنه من
معرفة خفايا
لا يطّلع
عليها من هم
خارجها، كما
أفاد في
الموضع نفسه
من الكتاب.
فكان هذا الحال
سبباً في رفع
قيمة الكتاب،
حيث شهد شاهد من
أهلها.
2-
ويرفع قيمته
كذلك عنايته
البالغة به،
حيث أمضى فيه
بحسب ما ذكر
في خاتمته ثلث
سني عمره (23)
عاماً (ص4، 367). وتصديق
ما ذكر ظاهر
في ثنايا
الكتاب،
ومعلوماته،
وما أورده من
أخبار، وما
عدّده من كتب
لهذه الطائفة([595])،
وما عرضه من
تاريخها، وشخصيّاتها،
ومعرفته لكلّ
ذلك بإسهاب
ودقّة.. فمثل
هذا الكمّ من
المعلومات لا
يتيسّر جمعها
في مدّة وجيزة
بل تحتاج إلى
سنوات من
الجهد
الحثيث،
والعمل
الدائم.
3-
ومما يرفع
قيمة الكتاب:
أن مؤلّفه
تكلّف تأليفه برغبةٍ،
وَتَوَجُّهِ
نَفْسٍ، فقد
استحوذ
الموضوع عقله
ووقته، حتى
صار شغله،
وهمّه،
وديدنه، وأيّ
مؤلّف يكتب
بهذا الدافع
فلابد أن
يمتاز ويبرز.
4-
كما يرفع
قيمته: أن
مؤلّفه كتبه
بنفس ناقدة، فاحصة،
تزن الأقوال
والأفعال
بالميزان الشرعيّ،
فتقبل منه ما
وافق ، وترفض
ما خالف، ولم
يتردّد في
أيّة حال، في
تخطئة أيّ
قول، أو فكرة
علم مخالفتها
(41، 70).
5-
ويؤكد قيمته:
أن مؤلّفه جمع
كلّ النواحي
المتعلّقة
بهذه الطريقة:
*
فقد بيّن
أثرها
الدّينيّ، في
الشعوب التركيّة
خاصة
والكرديّة . (288).
*
وبيّن أثرها
السياسيّ في
الدولة العثمانيّة،
والتركيّة من
بعد، (253) (255) (299) (306).
*
وبيّن
أحوالها الاجتماعيّة،
وتأثيراتها،
حتّى في داخل
البيت
النقشبنديّ.
فهي
وثيقة عن
الطائفة النقشبنديّة
في سائر
مجالاتها: الدينيّة،
والاجتماعيّة،
والسياسيّة،
والتاريخيّة.
وقد أصاب
ووفّق في
كتابة هذا المؤلَّف
القيّم
وإخراجه إلى
الوجود، حيث
يعدّ من اليوم
مرجعاً
متكاملاً عن
هذه الفرقة الكبيرة
من الفرق
الصوفيّة.
ونوصي ونرجو
أن تخرج
مؤلّفات أخرى
مماثلة، عن
الفرق الأخرى الكبيرة،
مثل:
الجيلانيّة،
الرفاعيّة،
الشاذليّة،
التيجانيّة،
البريليويّة...الخ،
على يد أحد من
أبنائها
العارفين
بالأسرار
القاصدين
الإصلاح
المبتغين وجه
الله.
6-
لقد أصاب
المؤلّف في
نقد أفكار هذه
الطائفة،
أصاب فيما نسبه
إليها من
أفكار صوفية،
مثل:
* قولهم
بالحلول،
والاتّحاد
ووحدة الوجود.
(102)(121).
* قولهم
بالفناء في :
الشيخ،
والرسول،
والله تعالى .(105)(130).
* في
إرجاع طريقهم
في الذكر
والعبادة إلى
الديانات
الهندية، (54) (102) (103) (104) (107)
* في
دعوى مشايخ
الطريقة
عليهم
بالغيب،
وتصريفهم
للأمور. (94) (145) (151).
* في
دعوى المشايخ
استمداد
المريدين من
همتّهم،
وروحانيتهم. (58).
* كذلك
في توجيه
المريدين إلى
استحضار صورة
الشيخ دائماً.
(58) (64)(66)(83).
فكلّ
هذه الأفكار
وغيرها، من
صميم الفكر
الصوفيّ، وما النقشبنديّة
إلا حلقة في
هذا الفكر،
تحمل كلّ
آرائه
واعتقاداته،
وقد أثبت هذه
الاعتقادات
من كتاباتهم
وأقوالهم.
7- من
الحقائق
الخطيرة التي
أبرزها
المؤلّف في هذا
الكتاب:
بيان
أن الأتراك
إنما أسّسوا
هذه الطريقة
قبل سبعة
قرون، في
بُخَارَى
لتكون نسخة
أخرى للإسلام
ليتميّزوا بها
عن العرب
والفرس في
عبادة الله
تعالى (ص24)(32)(354). وهذا
أمر شديد
الخطر
والوبال،
ويحتاج إلى توثيق
أكبر، وأدلة
واضحة، وهي
وإن كانت
شهادة شاهد من
أهلها، إلا أن
البرهان
مطلوب، حتى يقطع
الشكّ
باليقين.
لأنّ
الأمر إذا صار
كذلك، فعلى
المسلمين الناصحين:
عرباً، وتركاً.
أن يشرعوا في
هذا الصنم
الجاهلي تحطيماً
لأنّه يضر
بالإسلام
والمسلمين؛
أعني صنم
التعصّب
للجنس.
8-
بيّن المؤلّف
حقيقة نشاط النقشبنديّة
في الدولة التركيّة،
ومالهم من
سيطرة
إعلاميّة
ضخمة، وحضور
سياسيّ ظاهر
في الأحزاب.
حزب النظام
الوطني حزب
السلام الوطني
حزب الرفاه
حزب السعادة
وإلى تاريخ
كتابته لم يكن
قد ظهر الحزب
التالي: حزب
العدالة
والتنمية،
وهو الحزب
الحاكم اليوم.
(86)(318)(330).
وهذا
يعطي صورة
ربما كانت
غائبة عن
طبيعة العمل
السياسيّ
للأحزاب الإسلاميّة
في تركيّا،
وقد أبرز
المؤلّف
كثيراً من
جوانبها، أو
طرفاً .خاصة السلبيّة.
9-
شهد على أرباب
الطريقة النقشبنديّة،
وأسرته من
أشهرها، وقد
كان منها،
أنّهم يكتمون
أسراراً،
وشهادته لها
قيمة كبيرة،
لأنّها من
موقع العارف
المطلع . (3)(112)(117)(278).
ثانياً:
الجوانب السلبيّة:
تعليقاً
على ما ذكره
المؤلف من ثناء
على أهل
الكلام. (18)(128)(153) (343)(318) فنقول:
*
لا
يقلّ خطر أهل
الكلام على
الإسلام من
خطر التصوف؛
حيث هؤلاء قد
رسّخوا في
تراث الأمّة:
المنهج
العقليّ وردّ
النصّ
الشرعيّ الصحيح
الصريح: إذا
عارض المفهوم
العقليَ. والعقل
الصحيح لا
يخالف النقل
الصريح، ولكن
هكذا توهّموا. وكان
من أثر ذلك
تعطيل نصوص
كثيرة بِدَعْوَى
معارضة
العقل، وهذا
ظاهر في كلام
الرازيّ،
وأهل الكلام
عموماً، كما
هو عند
المعتزلة. وهذا
يشبه تعطيل المتصوّفة
للنصوص
بالذوق
والكشف
والمنام.
والمؤلّف قد تحمّل
مشكوراً
مأجوراً،
بيان خطأ المتصوّفة،
وضلال الفكر
الصوفيّ:
نصرةً للحق
وإعلاء لكلمة
الله تعالى،
فدلّ على حبه
للأتباع،
والتقيّد
بالسنة، ولو
وقف على ما
للكلام من أثر
سيّء في فكر
الأمّة لردّه
ونقضه كما فعل
مع الفكر الصوفيّ
في ردّه على
طائفة كبيرة
منه هي: النقشبنديّة.
لكنّه معذور،
إذ يظهر أن
جلّ عمره
انصرف في فهم
التصوف
والردّ عليه،
فلم يتيسّر له
النظر في
حقيقة علم
الكلام
بالقدر نفسه.
* لا
خلاف في ضلال
الفكر
والاعتقاد
النقشبنديّ،
غير أن
المنتسبين
إليه يغلب
عليهم الجهل، وقلّة
العلم. وطريقة
دعوتهم
واستصلاحهم
يحتاج إلى
رؤية وكلمة
طيّبة،
وموعظة حسنة،
ومجادلة
بالّتي هي
أحسن، كما قال
تعالى: »ادْعُ
إِلَى
سَبِيلِ
رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ
بِالّتي هِيَ
أَحْسَنُ«.
والملاحظ أن
المؤلّف قد
بالغ في
التقبيح والتشنيع
على
المنتسبين،
وهذا ربما
منعهم من الانتفاع
من كلامه
القيّم في النقد،
لأنّه حينئذ
تأخذهم
العزّة
بالإثم، فيتعصبون
جاهليّة. (120، 142).
والواضح إنّه
مدرك لأهميّة
الأسلوب
اللّين الحسن
في الدعوة
والاستصلاح،
بدليل إنّه
أنكر على الوهّابيّة
( أتباع الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب)
شدّة أسلوبهم
في دعوة
المنحرفين عن
التوحيد (299-311)
حتى إنّه ذكّر
بالآية
الآنفة، لكنه
يبدوا أنّه
أخذته الغيرة
على الحق،
فنسي في خضم
ردوده أن
يتمثّل
الأسلوب
الأمثل، وهذا
متصّور أن يقع
من أيّ إنسان،
مهما بلغ من
العلم، فإنّ
بعض الباطل،
وبعض أهله
يتخذون
أساليب من الاحتيال
والخداع ما
يزعج الخاطر
ويؤلم النفس حتى
إنّ المرء
ليردّ عليهم
بالقسوة
والشدّة دون
أن يشعر، ومع
ذلك فالحال
الأكمل الصبر
كما قال تعالى
: »وَاصْبِرْ
عَلَى مَا يَقُولُونَ
وَاهْجُرْهُمْ
هَجْراً جَمِيلا«
* للمؤلف
نظرة سلبية
تجاه من
يُسمّيهم بالوهّابيّة
(229، 311، 312،313)،
وكذلك شيخ
الإسلام ابن
تيمية ( 340)، حيث
يصف أتباع
الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
بالعنف
والجبر وبعدم
الكفاءة في
إرشاد الناس
وإصلاحهم،
وابن تيمية
بأنه يمطر
المخالفين
بالشتم
واللّعن
ويرمي بالكفر
البواح. وهذا يحتاج
منه إلى إعادة
نظر !!. فإنّ
دعوة الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
كان فيها خير كثير،
لو لم يكن إلا
أنّها أعادت
الأمّة إلى صفاء
التوحيد، وما
كان منها من
خطأ فأمر
متوقع، كون
حامليه بشر لا
ملائكة. ثم
إنّ الحكم عليها
بعمومها
حكماً سلبياً
جور وظلم، فلو
كانت كذلك لما
كتب الله لها
الانتشار
والقبول، فالعنف
وقلّة الحكمة
في الإرشاد
موجود في كلّ
طائفة، لكنّ
وجودها لا
يسوغ وصم
الطائفة كلّها
بتلك الأوصاف.
وأمّا ابن
تيمية فلم يكن
يوماً ممن
يرمي الناس
بالكفر
البواح، ولا
كان ديدنه
وخُلقه
اللّعن
والشتم، بل
الإنصاف والعدل
والأدب،
وكتبه شاهدة،
لكنّه لم يكن
يحابي في الحق
أحداً. ولو أن
المؤلّف وقف
على كتبه
بنفسه وأدمن
قراءتها مدّة
لبان له ذلك.
ثم إنّ
المؤلّف من
المحبين لدين
الحنيفيّة
والحنفاء (314)
والداعين
لتصحيح
التوحيد،
وكتابه هذا
شاهد، وغيرته
على التوحيد
ظاهرة، وهو في
هذا يتّفق مع
دعوة الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب.
وابن تيمية،
فهو يتّفق
معهم في
الأصول إذن،
وهذا كاف في
تآلفه معهم.
وأمّا ما
يظنّه ويراه
منهم مخالفاً
للهدي
النبويّ في
الإصلاح فيمكنه
علاجه فيهم
باللّين
والموعظة
الحسنة
والرفق، وهو
لذلك أهل.
***
ثالثاً:
مسائل متفرقة:
أولاً:
تعليق حول سبب
ظهور التصوف
في الأمّة:
الذي
يظهر أنّ ظهور
التصوف في الأمّة
سببه احتكاك
المسلمين
بأصحاب
الثقافات القديمة
وكان التصوف
معروفاً
لديهم بالإضافة
إلى وجود دعاة
لها بين
المسلمين
وسواء حدث خلاف
بين المسلمين
في العصر
الأول أو لم
يحصل لم يكن
ذلك ليؤثّر في
ظهور التصوف
لتلك الأسباب
وأصل خطأ من
يربط ظهور
التصوف بما
حدث من خلافات
في عهد
الصحابة أنّه
يعتمد تفسير
التصوف
بالزهد وهذا
خطأ حتّى أئمة
التصوف
يردّونه.
ثانياً:
اقترح على »
الشيخ فريد«
أن يقارن بين
أقوال الجنيد
والدسوقيّ
والجيليّ
ويقارن بينها
وبين أقوال النقشبنديّة
هل بينها
توافق. انظر ص80
ثالثاً:
في معنى قولهم
» قدّس الله
سرّه« أي
طهّر الله
سرّه وبهذا
الوجه لا مانع
منه ولا يلزم
لجواز
استعماله أن
يكون السلف
استعملوه غير أنّه
لا يبعد أن
يكون أصل
استعماله لدى المتصوّفة
من باب الغلو.
انظر ص98.
رابعاً:
تعليق بعد قول
المؤلّف ص117 »نجد
أنفسنا ... في
مفهوم التصوف«
هي كذلك في بدايتها
لكنّها بعد أن
توطدّت دخلها
أناس لا همّ
لهم إلا
الشهوة
والشهرة
والتعظيم دون
أن يكونوا في
منظمات سرّية
قصدها هدم
الإسلام إذ قد
ترسخ قدمها
وصارت جزءاً
من الإسلام
تلبيساً
وتدليساً.
خامساً:
في معنى مصطلح
ثيوصوفية ص119.
المراد
بالثيوصوفية:
الحكمة الإلهيّة
[ثيو: الإلهيّة
] [ صوفية: حكمة]
سادساً:
في الفرق بين
فناء
المتقدمين
والمتأخّرين
ص129.
الحقيقة إنّه
لا فرق بين
فناء
الأقدمين
والمتأخّرين
فلا يصح القول
بالتطور هنا.
سابعاً:
عقيدة الحلاج
وهل لوحدة
الوجود صور أخرى
ص131.
يذكر
الباحثون أن
الحلاج كان
حلولياًّ لا
وحدوياً. ما
ذكره المؤلّف
عن وحدة الوجود،
هو صورة من
صور وحدة
الوجود
يمثلها
التلمساني،
وثمة صور أخرى
يمثلها ابن
عربي وابن سبعين.
ثامناً:
في ص133
ذكر المؤلّف
عن البوذيين
عبادتهم
للشجر ... الخ.
ولكنّ
المشهور عن البوذيّة
أنّهم يعبدون
بوذا فحسب.
تاسعاً:
الحديث عن من
يعتذر عن بعض
عبارات
الصوفية الشنيعة
ص138.
دعوى
من زعم أنها
عبارات قيلت
في حال الغلبة
دعوى فارغة
وباطلة، بل هي
نتاج نظرية
كاملة في الحلول
ظهرت حال غياب
العقل،
فاللّسان لا
يتحدّث إلا
بما يجول في
الصدر.
عاشراً:
في الفرق بين
عقيدة وحدة
الشهود ووحدة
الوجود ص140.
حقيقة وحدة
الشهود تختلف
عن حقيقة وحدة
الوجود، لكن
من غير
المستبعد أن
يتدرع بها
الحلولية متى
خافوا على
أنفسهم.
الحادي
عشر: في أنواع
التوسل ص165.
التوسل
الشرعي يكون
بثلاثة أمور:
أ-
بأسماء الله
الحسنى ب-
العمل الصالح ج-
بدعاء الرجل
الصالح الحي.
الثاني
عشر: في تحليل
سبب تعذيب النقشبنديّة
لأنفسهم ص343.
سبب ذلك أنّهم
يقولون أن تلك
الحقائق لا
تنكشف إلا
بالرياضات
حتى يزول عن
الروح قيود
الجسد على أنّ
ابن عربي له
مذهب آخر لا
يشترط فيه إلا
الرياضة
الذهنية
لحصول هذا
الانكشاف.
الثالث
عشر: في ثناء
المؤلف على
الرسالة
النسفية
وشرحها
للتفتازاني ص343.
فيجب أن يعلم
أنّها ليست
على المنهج
الصحيح بل
فيها مخالفات
لمذهب السلف
الصالح.
الرابع
عشر: في نقل
الصوفيّة
لبعض جثث
موتاهم ص344.
نقل الرفات
مسألة خلافية
يسوغ فيها
الاجتهاد.
الخامس
عشر: في ثناء محمّد
بن سليمان
البغدادي على
شيخه ص363. يبدو أن
الكلام في
الوصول إلى
مرتبة
الولاية لا
الوصول إلى
دولة الهند
فلهذا لا معنى
لأن يستشهد
بسرعة الوصول
في هذا العصر.
السادس
عشر: الأولى
حذف العبارة
التي في ص310
وهي قولك »إذا
صح« في سياق »...
واعتقد.
جحافلهم إلى
دولة مستقلة
إذا صح«
وعبارة »سفارة
الوهّابيّين«
ص314.
السابع
عشر: ذكر
الشيخ مزيد
حفظه الله أن
الخلاف بين
النقشبنديين
والوهّابيّين
وجميع
الموحدين كان
في مسائل
جانبية
ثانوية غريبة
لا علاقة لها
بلب الإسلام
وأركانه .. وجعلوا
هذه المسائل
التافهة ... ص316.
ثم
ذكر هذه المسائل
التي خاصم
فيها
النقشبنديون
الوهّابيّين
ومنها
الاستعانة
بالموتى
والنذر لهم
والتأويلات
الكلامية
لصفات الله
كصفة
الاستواء على
العرش فهل هذه
مسائل جانبية
ثانوية غريبة لا
علاقة لها بلب
الإسلام
وأركانه
وأيضاً تافهة!
هذا ليس بصحيح
وهو يتناقض مع
ما ذكره الشيخ
من أنّ بعض
نقاط الخلاف
بين الوهّابيّين
والنقشبنديين
يجمعها
اعتقاد النقشبنديّة
نسبة مشيئة
قدرة خارقة
تستحيل على
البشر إلى من
يدعون أنّه
ولي مما ساهم
في الاستعانة
بغير الله
والذبح لهم
وعبادتهم من
دون الله
واعتقاد أنهم
يصرفون الكون
فإذا كانت هذه
مسائل كما
وصفها
بالتافهة ولا
علاقة لها بلب
الإسلام،
وإيمانه
فماذا بقى إذن
من الإسلام
وأركانه وقد
أطاح المؤلّف
دون أن يقصد
بالركين
الركين الأولّ
فيه وهو شهادة
لا إله إلا
الله شهادة
التوحيد.
أسأل
الله تعالى أن
يوفّق الكاتب
الشيخ فريد صلاح
الهاشمي لكل
خير ويبارك في
جهده ويتقبل
منه العمل
والقول، وصلى
الله على نبينا
محمّد وعلى
آله وصحبه
وسلم.
لطف الله
بن عبد العظيم
خوجه
أستاذ
العقيدة
بجامعة أم
القرى بمكة
المكرمة
10/10/1425هـ
***
الإجابةُ
على
الانتقادات الواردِة
في التقرير
أوّلاً:
الجوانبُ
الإيجابيّةُ
في الكتاب:
بالنسبة
لتحليلات
الأستاذ حول
القسمِ
الأوّلِ، فأشكره
بهذه
المناسبةِ
مرّةً أخرىَ
على ماوصفَ من
ميّزاتِ هذا
الكتابِ
انطلاقاً من
الواقع،
وشهدَ على أنّه
»وثيقةٌ
مهمّةٌ في
بيانِ حقيقة النقشبنديّة«، وذكر
أكثر من مرةٍ
عبرَ
التقريرِ ما
يرفعُ من
قيمتهِ، فقال:
»فهي وثيقةٌ
عن الطائفةِ
النقشينديةِ
في سائرِ
مجالاتِها الدينيّة
والاجتماعيّة
والسياسيّة
والتاريخيةِ،
وقد أصاب
ووفّق في
كتابة هذا المؤلّف
القيّم
وإخراجه إلى
الوجود، حيثُ
يُعدُّ مِنَ
اليومِ
مرجعاً
متكاملاً عن
هذه الفرقةِ
الكبيرةِ من
الفِرَقِ
الصوفيةِ«.
فهذه
نعمةٌ عظيمةٌ
أنْ يشهدَ لى
عالمٌ من
علماءِ
أمّتنا: أنّي
ألّفتُ هذا
الكتابَ
بنفسٍ ناقدةٍ
فاحصةٍ تزنُ
الأقوالَ
والأفعالَ
بالميزان
الشرعيِّ،
فتقبل منها ما
وافق، وترفض
ما خالف؛ وأنِّي
لم أتردّدْ في
أية حالٍ في
تخطئةِ أَيِّ
قولٍ أو
فكرَةٍ علمتُ
مخالفتَها
للكتابِ والسّنّةِ...
نعم، هذه
نعمةٌ جليلةٌ
أحمد الله
عليها؛ غير
أنّ الفاضلَ
صاحب التقرير
أوردَ نقداً في
المادّةِ
السابعةِ من
القسم الأول
ما نصّه:
» من
الحقائق
الخطيرة التي
أبرزها
المؤلف في هذا
الكتاب: بيان
أن الأتراك
إنما
أَسَّسُوا هذه
الطَّرِيقَةَ
قبل سبعة
قرون، في بُخَارَى
لتكونَ نسخةً
أخرى
للإسلام،
ليتميّزوا
بها عن العرب
والفرس في
عبادة الله
تعالى (ص24)(32)(354). وهذا
أمر شديد
الخطر
والوبال،
ويحتاج إلى توثيقٍ
أكبرَ،
وأدلَّةٍ
واضحةٍ، وهي
وإنْ كانتْ
شهادةُ شاهدٍ
من أهلها،
إلاَّ أنَّ
البرهانَ
مطلوبٌ، حتى
يقطع الشّكّ
باليقين«.
قُلْتُ
وبالله
الاستعانةُ - :
إنّ العبارات
التي اقْتَبَسَهَا
الفاضلُ
الشيخ من
الصفحات
المذكورة
آنفاً،
وَنَقَلَهَا
من كتابي على
سبيل النقد،
فقد أصابَ في
نقلِها
بأمانةٍ، وهي
من جملةِ ما
قُلْتُهُ
وكتبْتُهُ
بِقَلَمي،
فهنيئاً لهذا
العالم
الْمُنْصِفِ
الّذي وَقَفَ
على أدنى
مسألةٍ
خلافيّةٍ من
مضمون هذا
الكتابِ
حتّىَ لا
يُظلَمَ أحدٌ
من الخصومِ
رغم ما
يُعرَفُ من
هذه الطائفةِ
من خلطٍ وَبِدَعٍ
وزندقةٍ
وتحريفٍ
للدّين
الحنيفِ. ولن
يُعجزَني
توثيقُ هذه
الحقيقةِ
بأدِلَّةٍ من
نفسِ الكتابِ
وغيره
لكثرتِها،
وليس عن حظِّ
نفسٍ والعياذ
باللهِ تعالى.
وأماَّ
في هذا الصدد،
فيجب التركيز
على توضيحِ
أربعةِ أمورٍ
هامّةٍ
لتقريب
المسألة إلى العقول
وفتح المجال
لِفهمها. إذ
لا يسهل إقامةُ
الأدلّةِ على
القضيّة
المذكورةِ
بدونِها.
أولاً:
اعْتِقاَدُ
النقشبنديّينَ
وأَشْكاَلُ
تعبُّدِهم (وهي
بجوانبها
الأصوليةِ
والتاريخيةِ
خافيةٌ على
علماء
أُمّتِنا!)،
فإنَّ فيها
خلطٌ واختلافٌ
واضطرابٌ
وغموضٌ إلى
حدودٍ لا
يُمكنُ ضبطها،
ولا عندهم
أصولٌ
توقيفيةٌ
يُجْمِعونَ
على أساسِهِ
في التفاصيلِ
فتمنعهم مِنْ
ابتداعِ ما لا
مساغَ له (في
مُعتَقَدِهِمْ)
بله ضوابط
الإسلام؛
وذلك حتَّى في
صلاة
الرّابطة
التي هي مِنْ
أهمِّ
طقوسِهم. لذا
فمنهم مثلاً
مَنْ يُغْمِضُ
عينيهِ أثناء
الرّابطة،
ومنهم مَنْ
يُغَطّي
وَجْهَهُ
بِوِشاَحٍ
زيادةً على ذلك،
يُرخيهِ على
رأسِه
فَيُسْدِلُهُ
إلى سُرّتِهِ.
ومنهم مَنْ
يُحَدِّقُ
النظرَ في الصورة
الفوتوغرافيةِ
لشيخ
الجماعةِ كما
تفعله فئتانِ
من هذه
الطائِفةِ
وهم
السليمانيّةُ[596]
والمنـزليّةُ[597].
ومنهم مَنْ
يعدّها أمرًا
تعبّديًا
أفضل من كلّ
ما وردَ في
الكتابِ
والسنّةِ من
النُّسُكِ والنوافل...
[598] وقد
يتواطأ عددٌ
قليلٌ من
خاصَّتِهِمْ.
على مبدأٍ لا
عِلْمَ لأكثرهم
بذلكَ فيظلُّ
أساسُهُ
خافياً
عليهم، ولكن
تظهر
تأثيراَتُهُ
مع الزّمانِ
ثمّ تشيعُ
وتتنتشرُ،
فتتشرّبُها
نفوسُهم
بالتقليد الأعمى.
وكمثالٍ
على ذلك: فقد
وردتْ في
كتابٍ
للنقشبنديّينَ،
اسمُهُ »مناقب
الأولياء«،
ألَّفَهُ حسن
لطفي شوشود
باللّغة التركيّة[599]
في ترجمة
قدماء هذه
الطائفةِ
الذين أسّسوا
الطريقةَ النقشبنديّة،
وردتْ في
الصفحة
الثالثة
والسّتّين
بعد المائةِ
من هذا
الكتابِ - ما
أمكنني
تعريبُهُ - كلماتٌ
يقول فيها: »إنَّ
الولايةَ
مرتبةُ مَنْ
بَلَغَ
حالَةَ الفناءِ،
وهي أعلى مِنْ
مرتبةِ
النُّبُوَّةِ،
فقد أحرز بعضُ
الأنبياءِ
مرتبةَ
الولايةِ،
غير أنّ النُّبُوَّةَ
التَّعْرِيفِيَّةَ
أو التَّبْلِيغِيَّةَ
قد تحقّقَتْ
في كلّ وليٍّ«.
انتهى
كلامُهُ. نعم
هذه ترجمةٌ
مطابقةٌ للنصِّ
التركي
الواردِ في
الكتاب
المذكور
للنقشبنديّينَ.
وأماّ
خلاصة
المقصودِ
لهذه
المقولةِ
الجريئةِ، فهي:
أنَّ
الولايةّ
أعمُّ من
النُّبُوَّةِ،
وأنَّ
الولِيَّ
أفْضَلُ من
النَّبِيِّ!
لأنّ الوليَّ
نبيٌّ مطلفًا
بعكس
النبيِّ،
فإنّ الأنبياءَ
منهم من أحرزَ
مقامَ
الولايةِ ومنهم
من كانَ دونَ
ذلكَ على حدِّ
قولِهِ.
تُرىَ
وما عسى
الغرضُ من هذا
الإدّعاء
الخطيرِ، وما
الذي دَفَعَ
الْمُدَّعِي
حتّى تورّطَ
إلى هذا
الدركَ من
السخافةِ مما
لا شكّ في أنّه
خروجٌ على
الإسلامِ من
أساسه؟! وهل
يقدَّرُ مدى
هذا الخطرِ
على الإسلامِ
والمسلمينَ
إذا كان عددٌ
من أئمّةِ
الطائفةِ
يتواطؤونَ
على هذا
الاعتقادِ
ويبثونه في
عقول آلافٍ من
الرعاعِ
وسفلة
الناسِ؟!
فأماَّ
الجوابُ
الشافي على
هذا السؤالِ
مما لا شكّ
فيه: أنّ
قُدماءَ هذه
الطائفةِ (من
العنصر
التركي
خاصةً)، كانوا
يتواطأونَ
على أنّ الألياءَ
مِنْ قومِهمْ
أفْضْلُ من
سائرِ الأنبياءِ
مِنْ غيرِ
قومِهمْ بما
فيهم محمّد
عليهم
الصلاةُ
والسلام. ولم
يكنُ
تَبَنِّيهِمْ
لهذا
الْمُعتَقَدِ
الخطيرِ في
الحقيقةِ
إلاَّ لأنّهم
كانوا يأسفونَ
على
اتِّباَعِ
قومهم نيباًّ
ليسَ من بني جِلْدَتِهِمْ!
فاخْتَلَقوا
هذا
المُعْتَقَدَ
لِيَشْفو به
غَلِيلَهُمْ،
»لأنَّ
ولياًّ من
الأتراك
أفضلُ من
نبيٍّ عربيٍّ«
عندهم، مع
اعترافهم
بنبوّة محمّد
النبي
العربيِّ r، وإسرارِ
ما دونَ ذلك،
تقيّةً
ودَفْعاً لمخاطرَ
قد تَنْجُمُ
عنه إذا
فشَتْ، وحتّى
لا يفتضحوا،
وَلأَلاَّ
يَحْتَجَّ
عليهم أحدٌ فيرمِيَهُمْ
بِالْحَسَدِ
وَمُنَافَسَةِ
الْعَرَبِ
فِي الدِّين
وما يترتّب
على ذلك من كفرٍ
وإلحاد! فبقي
أصلُ هذا
الاعتقادِ
خافياً على
عامّةِ النقشبنديّينَ،
بحيث لا يكادُ
يُوجَدُ أحدٌ
منهم اليومَ
يعتقد أنّ
ولياًّ من
أولياءهم
يفوقُ محمّداً
في الفضلِ عند
اللهِ إلاَّ
عددٌ قليلٌ من
كبارِ
شيوخِهِمْ
يكتمونه
وَقَدْ اسْتَيْقَنَتْهُ
نُفُوسُهُمْ،
ويُقِرُّنَ
ذلكَ كلّما خلوا
إلى شياطينهم!
بذلك بقيتْ
الكراهيّةُ
للعربِ
راسخةً في
صدورِ غالب
الأتراكِ من
جراّءِ ما
تَبَنَّتْهُ
شرذمةٌ مِنْ
هذه الطائفةِ
وما بثّتْ من
تشنيع العربِ
وتشويه
سمعتهم في
المجتمع
التركي. ومن
أعظم
الدلائلِ على
هذه الحقيقةِ
ما ذكر الشيخ
عثمان المدني
من مثالب النقشبنديّة
فيما يبثونّ
من الكراهية
للعربِ
ضِمْنَ كِتَابِهِ:
»تبصرة
السالكين
وهتك
الماكرين من
علماء السوءِ
والمشائخ
المبتدعين«،
مع أنّه
بالذّات كانَ
مرجعاً لهذه
الطائفةِ. ومن
البرهان
القاطع أيضاً
على أنّهم
يتواطأون على
الزندقةِ:
اِتْلاَفُهُمْ
لنُسَخِ هذا الكتابِ
وأمثالهِ
التي تفضحهم.
فإنّي على رغم
ما بذلتُ من
الجهدِ
للحصول على
نسخةٍ واحدةٍ من
هذا الكتابِ،
لم أتمكّن
منها إلاَّ ما
أطلعني شخصٌ
على سطورٍ
قليلةٍ منها
في لحظات سريعةٍ
ما وسعني فيها
ضبطها! هذه
الكراهيةُ
بلغتْ في
نفوسهم حتى
جعلتْهم
يحترزون من
الاقتداءِ
بعربيٍّ في
صلاتهم
خاصّةً سكانُ
ثلاث مدن في
تركيا[600]:
أَرْضُ
الرّوم،
وبايبورت، وگُموشخانه،
قد تأصّلت
فيهم كراهيةُ
العرب؛ وقد
يُعيد
(النقشبنديونَ
منهم) الصلاةَ
إن كانوا قد
اقتدوا
بعربيٍّ
تقيّةً.
سَمعتُ عن بعض
الناسِ غَيرَ
مرةٍ: أنَّ
محمود أُسطىَ
عثمان أغلو
(وهو شيخُ
جماعةٍ
كثيفةٍ من
النّقشبنديّينَ
الأتراك في
إسطنبول)،
حَذَّرَ
مُريديِهِ من الإقْتداءِ
بأئِمَّةِ
الحَرَمَينِ،
»لأنّهم
وهّابيُّونَ«.
ولربما
حّذَّرَ شيخٌ
أخرُ مريديه
من الاقتداءِ
بهم »لأنّهم
عرب!«.
وأرجو أن لا
يكون لهذا
الخبر وجه من
حقيقة. إلاَّ
أنّ كثرة
الدّلائلِ تؤكّد
على أنّ
الإسلامَ
الحقيقيّ في
نظرهم هو الذي
رسمه لهم
(الساداتُ النقشبنديّة!)،
وليس الإسلام
الذي جاءَ بهِ
محمّد
العربيُّ (ص)!
وتمييزًا
بينهما:
يسمّونَ إسلامهم
بتعبير
(مُسْلُمَانْلِكْ
Muslumanlik).
وقد تناول
العلاَّمَةُ
الأستاذ أحمد
ياشار أوجاك،
هذه التسميةَ
الشَّاذَةَ
للإسلاَمِ
الْمُتَعَارَفِ
فيِ
تُرْكِيَا،
ودرسها بأسلوب
علميٍّ
وَمَوْضُوعِيٍّ
متين. وهي شبيهةٌ
بتسميةِ
الرافضة
للإسلامِ:
(مُسَلْمانيِ).
فالمسلم عند
الأتراك هو
(مُسُلْمَانْ)،
وذلكَ بتأثير النقشبنديّة،
كما هو
(مُسَلْمانْ)
عند الرافضةِ.
وَرَدَتْ
كلماتٌ
وَجِيزَةٌ في
قائمةٍ مُلْحَقَةٍ
بكتابٍ اسمه »السعادة
الأبدية«،
للعقيد
المتشيّخ
حسين حلمي
إيشك، يحاول
من خلالها
إحياءَ ذكرى
عظيمٍ من
عُظَمَاءِ
الأتراك
الجاهليّين،
وذلك دون أدنى
مناسبةٍ، لأنّ
الْكتاب
المذكور يخلو
من هذا الإسم!
نَقَلتُ هذه
الكلمات إلى العربيّة
ملتزما جانب
الذمّةِ،
وهذه ترجمتها:
»أُوغُوزْ
خاَنْ، رحمة
الله تعالى
عليه: كان قومُ
التَّرْكِ
مُتَجَزِّأً
في الماضي إلى
قسمينِ: تُركِ
الشَّرقِ
وتُركِ
الْغَرْبِ؛ يتكوّن
تُركُ
الشَّرقِ من
خمسِ
قَباَئِلَ، وتُركُ
الْغَرْبِ من
خمسَةَ
عَشْرَةَ
قبيلةً. فكانت
قبيلةُ
أُيغُورْ من تُركِ
الشَّرقِ،
وقبيلتا
أُوغُوزْ
وكِيرْجِيزْ
من وتُركِ
الْغَرْبِ.
كانت هذه
القبائلُ
منتشرةً على
الساحة
الهنديةِ
والإيرانية
والعراقية
قبلَ خمسةِ
آلافِ سنةٍ.
وأماَّ الأتراك
من قبيلةِ
أُوغُوزْ،
فكانوا قد
وصلوا إلى أراضي
الشامِ تحت
قيادةِ
أُوغُوزْ
خاَنْ، قبل الهجرةِ
بألفٍ
وثلاثمائة
سنةٍ...«.[601]
وهنا
يتبادر إلى
الذهن عدّةُ
أسلةٍ:
أوّلاً:
ما سببُ
إدراجِ هذه
العبارات في
قائمةٍ
ملحقةٍ
بكتابٍ
ألّفَهُ شيخٌ
نقشبنديٌّ، في
المواعظِ
والمسائل الدينيّة،
وسماَّهُ »السَّعاَدَةَ
الأَبَدَيَّةَ«
ولا يوجد إسم
(أُوغُوزْ
خاَنْ) في هذا
الكتاب أبداً،
فلماذا
تعرّضَ لذكر
هذا الرجل من
غير مناسبةٍ؟
أهكذا
يُرْشَدُ
الناسُ إلى
السَّعاَدَةَ
الأَبَدَيَّةَ
يا تُرىَ؟!
ثانياً:
كيف أباح (هذا
الشيخُ
الصوفِيُّ
المتنسِّكُ)
لنفسِهِ أن
يطلبَ
الرحمةَ من اللهِ
لرجلٍ عاشَ
قبل الهجرةِ
بألفٍ
وثلاثمائةِ
سنةٍ (كما
أفاد هو
بالذاَّت)،
ولا يعلمُ أحدٌ
إلاّ الله، هل
مات (أُوغُوزْ
خاَنْ) على الكفرِ
أم على
الإيمانِ،
ولم يترحّم
عليه هذا الشيخُ
إلاَّ لأنّهُ
كان من أكابر
التُّركِ؟! وبهذه
المناسبة لابدّ
من الإفصاحِ
بأنّه لا يجوز
أن نسكتَ على
ما تُؤْمنُ به
كبارُ هذهِ الطائفةِ
النقشبنديّة
(دونَ
عوامّهم!) من
أنواعِ
الزندقةِ،
وما يتواطؤونَ
عليهِ، ومنها
إيمانهم
بنُبوَّة هذا الرجُلِ
الجاهلِيِّ
استخفافاً
بمحمّدٍ u
ودينه الّذي
ارتضاه الله
لعباده فقال
تعالى إِنَّ
الدِّينَ
عِنْدَ الله الإسْلام[602]
وقال تعالى: وَمَنْ
يَبْتَغِ
غَيْرَ الإسْلامِ
دِينًا
فَلَنْ
يُقْبَلَ
مِنْهُ وَهُوَ
فِي الآخِرَةِ
مِنْ
الْخَاسِرِينَ[603]،
إنَّ هؤلاءِ
وإنْ
يُقِرُّنَ
بالاسلامِ بل ويعتزّونَ
به، ولكنّ
الاسلامَ
الّذي يقصدونه
إنّما هي
النسخة التي
رسمها لهم
(خُوَاجَگَانْ)
أي قدماءُ النقشبنديّة
الّذين
بَنَوْا هذا
الدّين في
بخارى وسمرقند
على أحد عشر
ركناً
أخذُوهاَ من البوذيّة
قبل سبعةِ
قرون. عِلْماً
بأنّي
اقتبستُ العباراتِ
المذكورةَ
آنفاً من
الطبعةِ
التاسعةِ
والسبعينَ من
الكتاب
الموسوم: »السَّعاَدَةَ
الأَبَدَيَّةَ«
(ص/1157)،
مما يدلُّ على
مدي انتشارِ
دعوةِ هذه
الطائفةِ على
الساحةِ التركيّة.
وبلَغَنَا في
الماضي
القريب،
أنّهم قد أسقطوا
هذه العبارات
من كتابهم
المذكور في
طبعاتها
الأخيرةِ بعد
استنكاراتٍ
شديدةِ
تصاعدت من
تجمُّعات
المؤمنين
الحُنفاء.
هذه
التفاصيل كلُّها
إنْ دلّت على
حقيقةٍ
فإنّما تدلُّ
على أنّ
النقشبنديّينَ
(الأتراك
خاصّةً دون
غيرهم!)،
إنّما يرونَ
هذا الدِّين
الّذي أحدثوه
قبل سبعةِ
قرونٍ، يرونه
نُسْخَةً
أخرىَ للإسلامِ
تُميِّزُهم
عن العربِ، بل
عن سائر الناسِ
في عبادة
اللهِ تعالى؛
فيستغني
العالم العاقل
بهذه الدلائل
عن أيّ حجّةٍ
أخرى، ولا
يُعقَلُ حتّى
بعد هذا القدر
من البراهين
(وما اكثرها!)،
أن نبحث عن
وثيقةٍ
ثانيةٍ فيها: »أنَّ
الطريقةَ النقشبنديّة
نسخةٌ أخرى
للإسلامِ
الّذي
اعتنقهُ
الأتراك دونَ
سائر الناسِ
في عبادة
اللهِ تعالى«.
وإنَّ هذا
لشيءٌ عُجاب!
وَمِمَّا
يُبَرْهِنَ
عَلَى هَذِهِ
الْحَقِيقَةِ
أَنَّ
الإِنْسَانَ
التُّرْكِيَّ
مَهْمَا
بَلَغَتْ
مَحَبَّتُهُ
لِلإسْلاَمِ
وَاسْتَقْوَتْ
صِلَتُهُ
وَتَأَكَّدَ
اعْتِزَازُهُ
بِهِ،
فَإِنَّهُ
مِنَ
الْمُسْتَحِيلِ
أنْ يَقْبَلَ
الإِنْدِمَاجَ
فِي جُمْهُورِ
الأُمَّةِ،
وَيَقْنَعَ
بِأَنَّهُ
جُزْءٌ لاَ
يَتَجَزَّأُ مِنْهَا!
بَلْ يَأْبَى
إِلاَّ أَنْ
تَكُونَ لِمَيِّزَاتِهِ
القوميّة
عُكُوسٌ
عَلَى
دِينِهِ فِي كلّ
عِبَادَاتِهِ،
حَتَّى فِي
صَلاَتِهِ
وَدُعَائِهِ
وَحَجِّهِ...
هَذَا،
وَلَيْسَ
مِنَ الْخَفِيِّ
أَنَّ
الشَّخْصَ
التُّركِيَّ فِي
صَلاَتِهِ
أشْبَهُ مَا
يَكُونُ
بِالْجُنْدِيِّ
الَّذِي
يَقِفُ
مَاثِلاً
أَمَامَ
آمِرِهِ،
يَنْتَصِبُ
انْتِصَابًا
شَدِيدًا،
وَيُبَالِغُ
فِي
رُكُوعِهِ
وَسُجُودِهِ
وَقُعُودِهِ
وَهُوَ
مَشْغُولٌ
بِاسْتِعْرَاضِهَا
غَيْرَ
مُبَالٍ
بِمَعَانِي مَا
يَتْلُوهُ
مِنْ آيَاتٍ
قُرْآنِيَّةٍ،
وَمَا يَأتِي
بِهِ مِنْ تَكْبِيرَاتٍ
وَتَسْبِيحَاتٍ
عَبْرَ صَلاَتِهِ.
وَهَذَا
كُلُّهُ
لَيْسَ إلاَّ
لأَنَّهُ
يُرِيدُ أَنْ
يَتَمَايَزَ
فِي دِيَانَتِهِ
وَعِبَادَتِهِ
عَنِ »الإِنْسَانِ
الْعَرَبِيِّ
السَاذِجِ
البَسِيطِ
الرَّخْوِ..«
عَلَى حَدِّ ظَنِّهِ
(وَهَذَ
الظَّنُّ
مُنْتَشِرٌ
بَيْنَ
الأَتْرَكِ،
وَمَا
يَتَّبِعُ
أَكْثَرُهُمْ
إِلاَّ
ظَنّاً إَنَّ
الظَّنَّ لاَ
يُغْنِي مِنَ
الْحَقِّ
شَيْئاً
إِنَّ اللهَ
عَلَيمٌ
بِمَا
يَفْعَلُون).
والأمر
الثاني من
الأمور
الأربعةِ
المذكورةِ
بالايجاز: أنّ
الأتراكَ بعامّتهم
ليسوا
مُجْتَمَعَ
عِلْمٍ
ومعرفةٍ، وإنّما
كانوا بدواً
وجنوداً في
ماضيهم؛ لذا، لا
تزالُ الروح
العسكريّةُ
راسخةً في
نفوسهم حتّى
اليوم، وهذا
الذي منعتهم
عن ممارسة الكتابةِ
طوالَ عصورٍ
مما جعل كلّ
ما يتعلّق
بتاريخهم
ودياناتهم
ومعتقداتهم محصورةً
في القصصِ والروايات
التي لا يمكن
توثيقها
اليومَ بدلائلَ
مسطورةٍ في
الكتب،
وإنّما تثبت
بعض الحقائق
منها بطرقٍ
غير مباشرةٍ،
كما إذا
اندسَّ أحدٌ
في صفوفِ
الخاصّةِ
لبعضِ
منظّماتهم التي
مازالت تتسم
بتجمّعاتٍ
سرِّيَةٍ
فيأتي بخبرهم.
والأمر
الثالثُ من
هذه الأمور
الأربعةِ: أنّ
أهمّ أسباب
الكراهيّةِ
للعربِ في
نفوسِ غالب
الأتراك،
إنّما نشأ
بدافع
الطريقة النقشبنديّة،
وهذا يرتبط
بما سبق من
أسبابٍ
ذكرناها آنفاً،
وأماّ أشدّها
خطورةً، فهي
نظرة فئةٍ من
هذه
الطائِفةِ
إلى طريقتهم
أنَها
الإسلام الذي
يختلفُ عماَّ
يعتنقه
العربُ.
وأماَّ
الأمر الرابع
من هذه الأمور
الأربعةِ
وأهمِّها
شأْناً: هو
أنّ الطريقة النقشبنديّة
وإنْ كانت
أكثر الطرق
الصوفيةِ
انتشاراً في المجتمع
التركيِّ
وأشدِّها
تأثيراً في
نفوسِ هذا
القومِ منذ
القديمِ،
إلاَّ أنَّ
جمهوراً من
هذا الشعبِ قد
صانهم الله
تعالى من هذه
الزندقةِ
الخطيرةِ، لا
يُحَزِّبونَ
الإسلامَ
شكلاً منه
للتُّركِ و
شكلاً
للعربِ، بل
يرونَ أمّةَ
الإسلامِ
مُجْمِعَةً
على الكتابِ
والسنّةِ
وعلى هدىً من
الله، كما
ينبغي
اسنثناءُ جماهير
النقشبنديّينَ
الأكراد
والعرب أيضاً من
أصحابِ هذه
الفكرةِ، وإن
هُمْ
يتّحدونَ مع
النقشبنديّينَ
الأتراك في
أصولِ
طريقتهم
ورسومها وطقوسها
والكراهية »للوهّابيّين« فحسب
دون غيرهم من
سائر العرب.
بهذه
التفاصيلِ
الواضحةِ
الجليّةِ، قد
قامتْ دلائلُ
عدّةٌ على أنّ
طائفةً من النقشبنديّينَ
يرونَ هذه
الطريقةَ
الصوفيّةَ نُسْخةً
للإسلامِ
الخاصِّ
بقومهم، تُمَيِّزُهم
عن إسلام
العربِ. وثَمّة
دلائلُ أخرى تؤكّد
أيضاً على هذه
الحقيقة. ومن
أقواها
الرُّؤيا
التي سبق ذكرُها
على لسان
مؤسّس هذه
الطريقة: محمد
بهاء الدين
البخاري،[604]
والطامّةُ
الكبرى، أنّ
هذه الفكرة
الخطيرة قد
انتشرت
فتجاوزت
محيطَ
النقشبنديّينَ! وَأَكْتَفِي
بِهَذَا
الاقتباسِ
اليسير من
القسم الأوّلِ
للتقرير،
تفادياً
للإملالِ.
***
ثانياً:
الجوانبُ السلبيّة:
قال
الفاضل الشيخ
في المادّة
الأولى من
نقده: »تَعْلِيقاً
عَلَى مَا
ذَكَرَهُ
الْمُؤَلِّفُ
مِنْ ثَنَاءٍ
عَلَى أَهْلِ
الْكَلاَمِ....إلخ.«.
في
الحقيقةِ لم
يكن قصدي فيما
قلتُهُ
الثناءَ
الْمَحْضَ وَبِخَاصَّةٍ
على أهل
الكلامِ،
وإنّما وَجَدْتُ
في كُتُبِ بعض
الكلاميّينَ
ما يردُّ بِدَعَ
الصوفيةِ
ويُكَذِّبهم،
هذا مِنْ وَجْهٍ؛
ومن وجهٍ
آخرَ، أردتُ
أنْ أُبرهنَ
على حماقة
النقشبنديّينَ
ومدى غبائِهم
أنّهم يَدرُسوُنَ
ويُدَرِّسونَ
هذه الكُتُبَ
في مدارسهم مع
أنّ ما وَرَدَ
في هذه
الْكُتُبِ من
تعقيباتٍ جَدَلِيَّةٍ
تُكَذِّبُهم
وتُدْحِضُ
حِجَجَهم
الواهيةَ،
وهذا أشدُّ
عليهم من
ادحاضهم بما
ورد في كتب
السلفييّنَ
أهلِ التوحيد
الْحُنَفَاءِ،
كشرح
الطحاويةِ،
والعقيدة الواسطيةِ
وكتاب
التوحيد
وأمثالها.
لأنّ في هذا
الأسلوبِ من المُحاجَّةِ
إثارةٌ لما في
باطنهم من
الحقد والضغينة
على أهل
التوحيد
الخالصِ،
فيتّخذونه
ذريعةً
للدفاعِ عن
باطلهم
ولِشِفاءِ غليلهم.
وأمّا
إدحاضهم في
الدفاعِ عن
التوحيد بالإشارةِ
إلى ما هم فيه
من الاضطراب
والتناقض بِمُدَارَسَتِهِمْ
كُتُبَ
الكلامييّنَ
وهي تكذِّبهم،
أسلمُ وأشدّ
وقعًا في
نفوسهم، وَكَفَى
الله الْمُؤْمِنِينَ
الْقِتَالَ!
ومن
شواهد
إخلاصيِ في
هذه المقولةِ:
ديباجتيِ
لرسالةٍ
جَمَعْتُهَا
من عباراتِ
شَارِحَيْنِِ
لنظم (بدأ
الأمالي)،
قلتُ فيها:
» أما
بعد، فإنّه
اتّفق لي
البحثُ
والنظرُ في
شرحينِ لطيفينِ
على قصيدةِ
بدأِ الأمالي
مفيدينِ في
بعضِ جوانبهما
الأدبية
واللّغويّةِ
(للأديب الشيخ
أبي الحسن
سراج الدين
علي بن عثمان
الأوشي نسبة
إلى أوش، وهي
قرية من قرى
فرغانة)،
أحدهما
للعلاّمة
عليّ بن سلطان
بن محمّد
القاري (وهو
المسمّى: ضوءُ
المعالي)،
وثانيهما
لمحمد بن
سليمان
الحلبيِّ
الريحاويِ
(وهو المسمّى:
نُخْبةُ
الّلآلي)؛
فأحببتُ أن
ألتقطَ من
كليهما
عباراتٍ لا
يستغني عنها
الطالب مماّ
توافق
الكتابَ
والسّنّةَ،
فأجْمَعَهَا
وأمزُجَها
وأُضيفَ
إليها من
تلقاءِ نفسي
مُلاَحظاتٍ
ومن كتب
العلماءِ
السّلفيّينَ
كلّما
ناسَبَ، فأُرَكِّبَها
في قالِبِ
جديدٍ لعلّه
يحلّ محلَّ
الشرحينِ،
فيتضاعف بذلك
النّفعُ
للباحثِ
ويزداد منه
حظّه دونَ أن
يتورَّطَ فيما
وقع الناظمُ
والشارحان
فيه من
الزّللِ،
فبَدّأْتُ
هذه الرسالةَ
بِديباجةِ
عليّ القاري.
هذا، وقد تصرَّفتُ
في نقلِ بعضِ
عبارات
الشَّارِحَيْنِ
عَبْرَ
التركيبِ، مع
نقد ما فيها
من مخالفاتٍ
لنصوصِ
الكتابِ
والسنّةِ،
ليس ذلِكَ تحريفاً
لكلماتهما أو
أسلوبهما، بل
تحسيناً لهذا
القالب
الجديد، إذ لا
يمكن
تحريفهما في الحقيقةِ
لكثرةِ
نُسَخِهمَا.
فقد ضاقت الأرضُ
في عصرِنا هذا
على
المحرّفينَ
والمنتحلينَ
والحمد لله
الذي أحبط
أعمالهم
بعونه لأهل
العلمِ
والبحثِ في
ضبط التراثِ.
ولا يفوتني أن
اعترفَ بفضلِ
علماءِ
السلفِ
وتابعيهم من
السلفيّينَ
المعاصرينَ
في تأليف
العقيدة الإسلاميّة
على وفق
الكتابِ
والسنّةِ.
وأما اهتمامي
بهذا النظمِ
وَشَرْحَيْهِ،
وأمثالها من
كتب الكلاميينَ
ليس لأنيِّ
مُعجِبٌ بهم
وبأسلوبهم، بل
في هذه
الطريقةِ من
التأليفِ
مخاطرُ على غير
المتمكّنينَ
من الحقائق العلميّة.
فَأُحَذِّرُ
المبتديئين
من ذلك! أما
مطالعتي
ودراستي لكتب
الفلاسفةِ
والصوفيةِ
والمعتزلةِ
والرّافضةِ
والكلاميينَ،
فإنه لم يكن
ذلكَ إلاَّ
بغرض البحثِ
حولَ
منطلقاتهم
وأهدافهم،
والإشارةِ
إلى مواطن
الفساد
والخطر فيها!
وفي هذا معذرةٌ
لأهل البحثِ
كما لا يخفى.
وسَمَيْتُ
هذه الرسالةَ:
بِـ (شَمسِ
المعالي في
دراسة الشرحينِ
على منظومةِ
بدأِ
الأماليِ)،
والله تعالى الموفّقُ
والمثيبُ على
هذا العمل
وتعميمِ نفعِهِ
على الأهالي«
وفي
هذا إجابةٌ
أيضاً على ما
جاءِ في تقرير
الشيخ حفظه
الله تعالى حيث
يقول:
»لكنه
معذور، إذ
يظهر أن جلّ
عمره انصرف في
فهم التصوّف
والردّ عليه،
فلم يتيسّر له
النظر في
حقيقة علم
الكلام
بالقدر نفسه.«!
في
الحقيقةِ ليس
الأمر كذلك.
ومِمَّا لا
شكّ فيهِ أنّي
قد صرفتُ جلّ
أوقاتي (طوال
أربعين عاماً)
في البحثِ حول
الفِرَقِ
والمذاهِبِ،
والأديانِ،
والمللِ
والنّحلِ،
والفلسفاتِ والإيديولوجياَّتِ؛
فتمكّنتُ
بعون الله وكرمه
تعالى من
الاطّلاعِ
على كنه
غالِبِها،
وعلى
أساليبها،
ومقاصدها،
ومواطن اتّفاقها
وافتراقها،
وأسرار
ضلالاتها،
ومخالفاتها
للكتاب
والسنّةِ...
ومع
هذا، فلا
إِشْكالَ
فيما إذا
دَعَتْ الْحاجَةُ
الملحّةُ
لاسقاطِ
كلماتٍ من
كتابِنا (الطريقة
النقشبنديّة)
إذا كان
يتوهّمُ
القاريءُ
بسبَبِها
أنّي أثنيتُ على
أهل الكلامِ
بالقصدِ
المحضِ وليس
بغرضِ إبطالِ
حجج
النقشبنديّينَ.
قال
الفاضل الشيخ
في المادّة
الثانية من
نقده: لا خلاف
في ضلال الفكر
والاعتقاد
النقشبنديّ،
غير أن
المنتسبين
إليه يغلب
عليهم الجهل،
وقلّة العلم.
وطريقة
دعوتهم
واستصلاحهم
يحتاج إلى
رؤية وكلمة طيّبة،
وموعظة حسنة،
ومجادلة
بالّتي هي أحسن...إلخ.
لا
يخفى على
الشيخ حفظه
الله تعالى ما
ورد في ثنايا
كتابي من
الحثِّ على
هذا الجانب
الهامِ في
مهمّةِ
الإرشادِ
والإصلاح،
كما أشارَ هوَ
بِالذّات إلى
ما صرفتُهُ من
النكير على الّذينَ
لم يسلكوا في
دعوتهم جانب
اللّينِ
والعطفِ
والحُنُوِّ
مع الجهلةِ من
عباد الله.
وقد
اسْتَشْهَدَ
الشيخُ بعينِ
ما أوردتُهُ
من الكتاب
العزيز، وهو
قوله تعالى: اُدْعُ
إِلَى
سَبِيلِ
رَبِّكَ
بِالْحِكْمَةِ
وَالْمَوْعِظَةِ
الْحَسَنَةِ
وَجَادِلْهُمْ
بِالَّتِي
هِيَ
أَحْسَنُ
إِنَّ رَبَّكَ
هُوَ أَعْلَمُ
بِمَنْ ضَلَّ
عَنْ
سَبِيلِهِ
وَهُوَ أَعْلَمُ
بِالْمُهْتَدِينَ
[605]
أمّا
قول الشيخ
حفظه الله
تعالى: »والملاحظ
أن المؤلّف قد
بالغ في
التقبيح والتشنيع
على
المنتسبين،
وهذا ربما
منعهم من الانتفاع
من كلامه
القيّم في
النقد، لأنه
حينئذ تأخذهم
العزّة
بالإثم، فيتعصبون
جاهلية... إلى
أنْ قال:
والواضح إنّه
مدرك لأهميّة
الأسلوب
اللَّيِّنِ
الحسن في الدعوة
والاستصلاح...إلخ«
في
الحقيقة
تحتاج هذه
الكلمات إلى
تعقيبٍ يوافي
ما تكبّدتُهُ
في دعوة هذه
الطائفةِ من
السهر
والعناءِ
والمشقةِ
أكثر من
ثلاثينَ سنةً
بله ما
تعرّضتُ له من
استحقارٍ
وشتمٍ ولعنٍ
وتشريدٍ
ومخاطر أقضَّت
مضجعي
فجعلتني
أتقلّبُ في
أمواجٍ من الهموم
والقلقِ ما لا
يمكن حتّى
تلخيصُه في
مثلِ هذا
المقامِ. ولكن
أستحسن ذكر
شيءٍ منه في
منتهى
الإيجاز لعلّ
يقدّم عكوساً
من الحقائقِ
عن هذا
المجتمع ليكون
عبرة لأولي
الألباب.
***
نبذة
من قصّة حياتي
وذكرياتي
كنتُ
من أهمِّ الشخصيّات
البارزينَ
بين شيوخ النقشبنديّة
في تركيا
ومرجعاً
روحياًّ لهذه
الطائفةِ. إذ وُلِدتُ
ونشأتُ في
أسرةٍ ذاتِ
مكانةٍ مرموقةٍ
تتهافت عليها
جمهورٌ من
الناسِ لما
لها من صفاتٍ
تُمَيِّزُهاَ
عن بقيّة شيوخ
الطائِفةِ.
أوّلاً:
أنّها أسرةٌ
مشهورةٌ من
البيت الهاشميِّ،
تنتهي إلى
الحسن بن عليّ
رض الله عنهما
(إذا صحّ،
والله أعلم).
ثانياً:
لم تتغيّر
الطابع
العربيُّ في
هذه الأسرةِ
رغم سياسة
التتريك
بإعطائِها
لقب آيدن Aydın إجباراً.
لذا تميّزَتْ
بهذه الصفةِ (العربيّة)
قداسةً في نظر
الذين يجعلون
من هذا الطابع
صلةً بين
العربِ
والاسلامِ أو
بين البيت
الهاشميِّ
والاسلامِ!
فَيُفَضِّلُونَ
العربَ على بقيّة
المسلمين من
عناصرَ
عَجَمِيَّةٍ.
(أصحابُ هذا
الظنّ
الخاطيءِ
كانوا قلّةً
من الأكرادِ والعربِ
بجنوبِ
تركيا، وما
كاد أحدٌ اليومَ
يَعْبَأُ
بهذه الفكرة).
ثالثاً:
كانَ بيتُناَ
مَوْئِلاً
لآلافِ الزائرينَ
والوافدين من
أطرافِ
البلادِ حتى
عام 1960م.
منهم مَنْ
يأتي
للدراسةِ في
مَداَرِسِناَ
(التي كانت
كُلِّيَةً من
كلّياتِ
الجامعة الزهراءِ)[606]
ليتعلّمَ
فيها اللغةَ العربيّة
ويتلقّى
العلومَ الإسلاميّة
من عقيدةٍ
وفقهٍ
وتفسيرٍ
وحديثٍ...
ومنهم مَنْ
يأتي فاراًّ
من عدوّهِ
يستغيث ويطلب
الحمايةَ،
ومنهم مَنْ
يأتي
للتظلُّمِ
يطلب القضاءَ
بينه وبين
خصمِهِ وهو
يرفض
اللّجوءَ إلى
المحاكِمِ،
لتبرّيهِ عن
القوانين
الوضعيةِ،
ومنهم مَنْ
يأتي
ليتبرّكَ
بأعتابِنا يطلبُ
التمائِمَ
والدعاءَ
والشفاءَ
والشفاعةَ
يوم القيامةِ
وربما
المغفرةَ
لميّتِهِ! فكانتْ
الوفودُ من
أصحابِ هذه العقليّة
يزورونَ
قُبَّةَ
جدّيِ الشيخ محمّد
الحزين وهي
قبّةٌ عظيمةٌ
فوقَ هضبةٍ
بقريةٍ اسمها
(فُرْساَفُ)،
على مقربةٍ من
مدينةِ (أَسْعِرْدَ)
من جهة الشمال،
سكاّنُها
عربٌ. وللأسف
الشديد لا تزالُ
هذه القبةُ
مزاراً
للناسِ حتّى
الآنَ، بالاضافةِ
إلى قُبَبٍ
أُخرىَ
بمدينة
أَسْعِرْدَ
فيها أضرحةٌ
لأَعْماَمِي،
منهم الشيح محمّد
موسى الكاظم
الذي مرّ ذكره
في كتابي (ص/356،
الطبعة
الثانية)، وقد
رثاه الشيخ
زكي أوران وهو
شخص من مريديه
بهذه الكلمات
الخطيرة:
زُرْ
ذاَ المقامَ فَفِيهِ
شَـيْخٌ كاَمِلٌ
مَنْ فِي الْـكُرُوبِ
لَناَ عَلَيْهِ
مُعَوَّلُ
نَجْلُ
الْحَزِينِ
الشَّيْخُ محمّد[607]
كاَظِمٌ مِنْ
فَضْلِهِ فِي
الناَّسِ لَيْسَ
يُجْهَلُ
وَتَأَدَّبَنْ
بِحُضُـورِهِ
وَتَوَسَّـلَنْ
بِهِ فاَلتَّوَسُّـلُ
عِنْـدَ رَبِّهِ
يُقْبَـلُ
ياَ
رَبَّناَ غَمِّـدْهُ
مِنْكَ بِرَحْمَةٍ
وَاجْـعَلْ لَهُ
الْجَناَّتِ
فِيـهاَ يَرْفَلُ[608]
نشأتُ
في منطقةٍ
مليئةٍ
بأمورٍ
متناقضةٍ وشؤونٍ
غريبةٍ
ولغاتٍ
مختلفةٍ
وطباقاتٍ
متباينةٍ
وسلالاتٍ
عريقةٍ؛ فيها
العلمُ
والمعرفةُ
والتدريسُ
ومجالس
الذكرِ
والسماعِ، وفيها
والبِدَعُ
والخرافاتُ
والأباطيلُ
والتوحيدُ
والشركُ
والإسلامُ والجاهليّة
في آنٍ
واحِدٍ،
تشتبكُ في
حينٍ
وتتشابكُ في حينٍ
آخرَ، مع ذلك
قلّ مَنْ
يستغربُ هذا
الخلطَ
والعبثَ، ولا
يفكّر في
إيقافِ هذا
السيلِ الجارِفِ
الذي يحملُ
الغثَّ
والسمينَ،
غيرَ أنَّ
البيئةَ التي
قضيتُ فيها
أيّامَ
طفولتي
وشبابي كانت ساحةً
نيِّرَةً في
وسطِ هذا
الظلامِ،
تحتضنُ
جموعاً من
الطّلبةِ
والعلماءِ
يتزعّمها كبارُ
أسرتي وعلى
رأسها
المغفور له
والدي الشيخ
صلاح بن عبد
الله بن محمّد
الحزين
الهاشمي. ولا
يفوتني أن
أقرَّ هنا
بشهادة الحق
لهذا الرجل العالم
الفقيه
الصالح
التقيِّ إنّه
كان
مُوَحِّداً
في إيمانِهِ
لا يشوبُهُ
قطميرٌ من
الاشراكِ.
ولهذا ظلَّ
مُستَهدَفاً
لضغينة شيوخ
الطائفةِ حتى
أتاه اليقين.
حفظتُ
الكتابَ
العزيزَ
عليه، ودرستُ
اللُّغَةَ العربيّة
والآدابَ
والعلومَ الإسلاميّة
على نُخبةٍ من
العلماءِ
جُلُّهم من
العربِ، بجانبِ
مادرستُ من
العلوم
الحديثةِ في
المدارس
الرسميةِ،
فحظيتُ
نصيباً
وافِراً من المعرفةِ
والثقافةِ
حتّى أصبحتُ
محسوداً بينَ
أصحابي
وأمثالي من
الخرِّيجِينَ
مماَّ كانوا
يعانونَ
العجزَ في
استخدامِ
اللغة العربيّة
نطقاً
وكتابةً. وهذا
العيبُ لا
يزالُ شائعاً حتىّ
الآنَ في جميع
مَنْ
تَصِفُهُمُ
الناسُ بسمة
العلمِ عرباً
وكرداً
وتركاً في
بلادِناَ.
ولماّ
كانتْ من
العادةِ
الشائعةِ بين
العائلات
المشهورةِ في
الزعامةِ
لجماعات
الصوفيةِ:
أنَّ كلاًّ
منها تقومُ
باعدادِ
شخصيّة من
أبنائِهاَ
ليتولّى رئاسةَ
الأسرةِ
والجماعةِ
الملتفّةِ
حولَها حفظاً
على مركزِها
ومكانتِها
ومصالِحِهاَ،
رشَّحَتْنِي
الأسرةُ (إذ
أتمرّغُ في
أوحال الشرك
الصوفيِّ)،
رشَّحَتْنِي
للقيامِ بهذه
المهمّةِ
بشرطِ أن
أُقِيمَ في
اسطنبول، فأتولَّى
توجيهَ
المنتسبينَ
إلى العائلة
الحزينيّةِ
في تلكَ
المدينة
وجوارِهاَ
سعياً
لتأكيدِ ثقتِهم
بأُسْرَتِنَا
وتوطيدِ
صلتهم بها،
ضدّ محاولة
بعض الشيوخ
الّذين
يعملون على
استمالةِ
الناسِ من
مريدي غيرِهم.
إذ هناك
منافسةٌ وصراعٌ
عنيفٌ بين
شيوخ الطرائق
الصوفيةِ
قديماً وحديثاً،
ذلك طلباً
للجاهِ
والشهرةِ
والمصالحِ بتوسيع
النطاقِ
والإكثارِ من
المؤيّدين
والأنصارِ.
سافرتُ
إلى اسطنبول
يومَ الثالث
عشر من شهر أبريل/نيسان
عام 1968م. بعد أن
حضرَ جمعٌ
غفيرٌ من
المريدينَ
محطّةَ
القطارِ
بمدينةِ
تطوان
الواقعةِ
بشرقي تركيا
لتوديعي. وما
أنْ أقلع
القطارُ،
حَتَّى زارني
كبيرُ الموظفينَ
بِهِ
فَمَثُلَ بين
يَدَيَّ
باحترامٍ قائلاً:
يا مولانا! قد
أعددتُ
لسماحتكم
حُجْرَةً
خاصَّةً
تقضونَ فيها
مدّةَ
السَفَرِ إلى
اسطنبول...
فانتقلتُ مع
زوجَتي إلى
الحجرة المخصّصةِ
لنا؛ وهكذا،
إلى أنْ
اسْتَقْبَلَتْناَ
جماعةٌ
كثيفةٌ من
المريدينَ في
محطّةِ
الوصولِ
بإسطنبول، ثم
أصبحتْ داري
في هذه
المدينةِ منذ
بدأِ إقامتنا
مَقْصِداً
للزّائرينَ،
وكنتُ يومئذٍ
بالغاً من
العُمُرِ
ثلاثةً وعشرينَ
عاماً. ورغم
هذه المكانة
الوراثيّةِ
في مثل هذا
السنّ
المبكّرِ
كانتْ
تنتابُنِي تساؤلاتٌ
وهواجسُ
أحاسِبُ بها
نفسي: - ما لنا
وهذه الأُبَّهَة
والحَشَم
والتمايُز!
وما أرى ذلكَ
إلاّ لأنّ
النّاسَ
يعتقدونَ
فِينَا (نحن
زمرةِ شيوخِ
الطّرائقِ
الصوفيةِ) من
الكرامة والبركةِ
ما لا
يعتقدونَ في
غيرِناَ. نعم
كان الأمرُ
كذلك،
فكُناَّ في
اعتقادِهم:
زمرةً من المصطفين
الأخيار،
والمجتبينَ
الأبرار، لا يشقى
جليسُناَ ولا
يُرَدُّ لنا
دُعاءٌ... ولم ينته
الأمرُ عند
هذا الحدِّ،
بل كُناَّ
أيضاً في
اعتقادِهم:
مُفَوَّضينَ
من طرف اللهِ،
نتصرّفُ في
مُلكِهِ كيفَ
نشاءُ،
ونعلمُ الغيبَ،
وتنطوي لنا
الأرضُ، نقطع
المسافات
البعيدةَ في
لَحَظاَتٍ،
ويتوقّف لنا
الزمانُ
فنُصلّي في
الكعبة
المشرفةِ وفي
مسجد الحيِّ
في آنٍ واحدٍ...
إلى غيرِ ذلكَ
من خزعبلاتٍ
لا صحةَ لها
ديناً وعقلاً.
كنتُ
يومئذٍ
مجرّدَ »شيخِ
المهدِ« في
مصطَلَحِ
صوفيةِ
التُّركِ.
ومعنى »شيخِ
المهدِ«: أنّ كلّ
مولودٍ لشيخ
الطريقةِ
شيخٌ أيضاً من
يومِ
وَلَدَتْهُ
أُمُّهُ! ثمّ
إذا نشأَ
وَدَرَسَ
وسَلَكَ
فَنَجَحَ بعد
سُلوكِهِ (وهو
شكلٌ من
التربية
الرياضيةِ
عند الصوفية النقشبنديّة
خاصّةً)،
يُجيزُهُ
مُرْشِدُهُ
بإِجازةٍ (بمعنى
شهادة
التخرُّج)،
يأذنُ له بها
القيامَ ببثِّ
تعاليمِ
الطريقةِ وقبولِ
الناسِ
للانخراطِ في
سلكِها.
فيكونُ بذلكَ
(خَليِفَةً)،
يُحرِزُ
مَنْصِبَ شيخ
الطريقةِ
بالمعنى
الحقيقيِّ،
فيتصرَّفُ
إذن في قبول
المريدينَ
وردِّهم
وتوجيههم
وطردهم »أوتدريجهم
إلى حضرات
القدسِ«! على حدّ
قولِهِمْ
الذي
يُسِرّونه
غاية الإسرار.
(وهو مقام
الحلول
والاتّحاد). كَبُرَتْ
كَلِمَةً
تَخْرُجُ
مِنْ أَفْوَاهِهِمْ
إِنْ
يَقُولُونَ
إِلا كَذِبًا.
أيقنتُ
يومئذٍ أنّي
بحاجةٍ إلى
مثلِ هذه الإجازةِ
لأُبَرِّرَ
بها مكاني
بينَ أمثالي
من الشيوخِ
عند ما يقتضي
ذلكَ
فأُصْبِحَ
مُعتَرَفاً
بِهِ في
عالَمِ
الصوفيّةِ،
لأنّ الظروفَ
والأحداثَ قد
تستوجِبُ
ذلكَ في
عُرفِهم!
تقدّمْتُ
بطلبِ
الاستجازةِ
إلى أحدِ
أساطينِ هذه
الطائِفَةِ
بعد أن
تأمّلتُ
مدّةً لأَختارَ
الأمثلَ
منهم،
فاستقرَّ
رأيي على الشيخ
سليمان بن عبد
الله الخالدي
المخزومي (1868-1976) وذلك
لأسبابٍ: منها
إنّه عربيٌّ،
ومنها إنّه
عالمٌ أديبٌ
شاعرٌ مشارك
في اختصاصاتٍ
مختلفةٍ، له
تآليف في
الفقه
والتصوّفِ[609]،
ومنها إنّه
أكبرُ سِناًّ
من جميع شيوخ النقشبنديّة،
إذ كانَ عمره
يومئذٍ يُربي
على المائةِ،
ومنها إنّه
ممّن درسَ
عليهِ والدي،
ومنها إنّه
كانَ خليفةَ
عَمٍّ لأبي في
الطريقةِ.
فطلبتُ منه أن
يجيزني
لأقومَ ببثِّ
الطريقة النقشبنديّة
نيابةً عنهُ
في إسطنبول.
إلاَّ أنّ هذا
الأسلوبَ
كانَ مخالفاً
لعرف النقشبنديّة؛
لأنيِّ قمتُ
بهذا الطلبِ
من مسافةٍ
بعيدةٍ، (من
مدينة
إسطنبول)، وهو
يقيمُ يومئذٍ
في مدينة
أَسْعِرْد Siirt،
وأماَّ خطابُ
المريدِ إلى
شيخِهِ عن
طريق
المراسلة
الكتابيةِ
يُعَدُّ من
الإساءةِ
بأدب
الطائفةِ
إلاّ إذا
تعذّرَ أو شقّ
ذلك عليه،
خاصّةً وأنّ
مفهومَ الاحترامِ
عند
النقشبنديّينَ
يختلفُ كلّ
الاختلافِ
عماَّ يفهمه
الناسُ
ويعتادونه. إنّ
المريدَ أو
الطالِبَ
لهذه الصفةِ
يجب عليه أن
يكونَ مُستعداًّ
للفداءِ بكلّ
شيءٍ يملكه،
وأن لا يمتنعَ
عن القيامِ
بأيِّ أمرٍ
يُرضيِ به
شَيْخَهُ ولو
كان
مُحَرَّماً!
فلا بدّ أن
يمتثل له عن
طيبةِ خاطرٍ.
ومن جملة ما
يجب على
المريدِ أو
على طالِبِ
هذه الصفةِ
أنْ يتقدّمَ
بنفسِهِ إلى
شيخِهِ وليس
بإرسال كتابٍ.
بيد أنّه أغضى
عن ذلك فضلاً،
بل زاد
تواضُعاً
فأجازني في
أمدٍ قصيرٍ،
قلّما رُزقَ
طالِبٌ مثله.
وما
أنْ أصبحتُ »خليفةً
على سجّادةِ
الارشار«
فَوْرَ
وفاتِهِ،
حَتَّى
شَمَّرتُ عن
ساعد الجدِّ
فبدأتُ
بإقامة حلقات
الذكر؛ ولم
يكن ذلك إلاّ
تحمُّساً
منّي لاثارة
الشوق في قلوب
المنتسبين
إلى أسرتنا
وتوطيدِ
ثقتِهم
وتَمَسُّكِهمْ
بها ردعاً
لمحاولة ما
يُسَمَّى بـ »صيد
المريدين«.
ذلك أنَّ
شيوخَ الطرق
الصوفيةِ
طالما يطمعونَ
في توسيع
نطاقِ
نفوذِهم،
فيتوغّلُ
بعضهم أحياناً
في منطقةِ
شيخٍ آخر،
يدعو مريديه
للانتسابِ
إليهِ، وقد
تتمخضُ عن
ذلكَ تتطوّراتٌ
سياسيةٌ
واجتماعيةٌ.
دامتْ
حلقاتُنا
وجَلَساتُنا
هكذا بين أعوام
1969-1974م.،
لانُهمِلُ
مبدءاً من
مباديءِ هذه
الطريقةِ
وفقاً
لأركانِها
الأحدَ
عشَرَ، نجتمع
في عشيةِ
أياَّم
الخميسِ بعد
صلاة المغرب،
فنُقيمُ
حلقةَ »خَتْمِ
خُوَاجَگَانْ«
بعد صلاةِ
العشاءِ مع
الاصرارِ على
رابطةِ
المرشِدِ،
وهي شكلٌ من
أشكالِ
التعبُّدِ في
الدين
النقشبنديِّ!
تَأْخُذُنِي
الْحَيْرَةُ
الآنَ، أنَّ
هذه الأمورَ
في الحقيقةِ
لم تكن من
الْمُتَعاَرَفِ
داخلَ الأسرة
التي نشأتُ
فيها؛ فإنَّ
والدي
وأعمامي
المأذونين في
هذه الطريقة،
على رغم ماكان
معروفاً من
أنّهم شيوخ
الطريقة النقشبنديّة
(ولا أشكَّ في
الوقتِ
ذاتِهِ أنهم
كانوا قبورييّنَ
ماعدا
والدي!)، ما
كانَ أحدٌ
منهم يقيمُ
هذه الطقوسَ
ولا كانت هي
معروفةً بين
أتباعنا.
فيبدو لي أنَّ
كبارَ
أسرتِنا
كانوا قد انتبهوا
إلى مخاطرها،
لأنِّي أذكر
بعضَ كلامهم
الذي يوهِمُ
شُكوُكَهُمْ
في الآونة الأخيرةِ
حولَ هذه
الطريقةِ »أنّها
تياَّرٌ
غريبٌ على
الاسلامِ،
ابتلى به
المسلمونَ من
غيرِ
رويَّةٍ...«.
ذلكَ،
لأنَّهم
كانوا من أهل
المعرفةِ
والتدريسِ
والتخصُّصِ
في شتَّى
العلوم الإسلاميّة
من عقيدةٍ
وفقهٍ
وتفسيرٍ وحديثٍ
وغير ذلك من
شُعَب
الفنونِ.
فكانوا
متمكّنينَ من
أصولِها
وفروعِها
ومنقولها
ومعقولها
ودقائقِ
تفاصيلها،
بالإضافة إلى
أنّهم كانوا
يمتازونَ
بالذوق
العربيِّ
الخالصِ، فأبتْ
نفوسُهُم
وضمائِرُهُم
أنْ يرضخوا
لِتَعاليمِ
هذا
التّيّارِ
الصوفيِّ
الدخيلِ الذي
يتعارَضُ مع
الإسلامِ
بتمامِهِ،
إلاَّ أنّهم
ربما كانوا
يحسبونَ
حسابهم
لأسبابٍ
وظُروفٍ (ولا
أقولُ: يخافون
على أنفسهم أو
ينافقون)،
فيكتفونَ
بالسكوتِ
أحياناً
وباتخاذِ
أساليبَ لَبِقَةٍ
وتوجيهاتٍ
حاذقةٍ
أحياناً،
بخلافِ بقيّة
الشيوخِ ذوي
الأصول العربيّة
في المنطقةِ
الذين انصهروا
في بوتقة
الكرد
والتركِ، ولا
يكاد أحد منهم
ينطق ويكتب بالعربيّة
اليومَ، وعلى
رأسِها
الأسرة
الأرواسيّة،
وهي من امتداد
السلالة
الحسينية،
اسْتَغَلّتْهاَ
جماعةٌ
طورانيةٌ من
النقشبنديّينَ،
فَجَعَلَتْ
منها صَنَماً
يعبدها
اليومَ ملايينُ
من الناسِ في
تركيا. أما
هذه الجماعةُ
فهي
مُنّظَّمَةٌ
خطيرةٌ أسَّسَها
رجلٌ
عسكرِيٌّ (وهو
العقيد حسين
حلمي إيشك،
مات قبل
عامين،
يَنوبُ عنه
الآنَ الدكتور
أنور أورين Dr. Enver Oren). ومن
خُلَفاءِ هذه
الأسرةِ
عائِلةُ
الملاَّ عبد
الحكيم
البلوانسي.
هذه الأسرة
أيضاً حُسَيْنِيَّةٌ
(عربية
الأصلِ،
كُردية
النشأةِ)،
استغلَّها نفسُ
الرجل
وَبِطَانَتُهُ،
فجعلوا منها
صنماً ثانياً.
لهذه الأسرةِ
قاعدةٌ بقرب
مدينة (آدِياَماَنْ).
يقوم آلآفٌ من
المبشّرينَ
للدعوةِ
إليها في
أنحاءِ
تركيا، وهي
أقوى مراكز النقشبنديّة
وأشدّها
تمسُّكاً
بالتعاليم البوذيّة:
(هوُشْ
دَردَمْ،
ونَظَرْ بَرْ
قَدَمْ، وَسَفَرْ
دَرْ
وَطَنْ...والرّابطة
والختم
خُوَاجَگَانِيَّة...
إلخ).
ولا
شكَّ في أنَّ
أميركا تهتمّ
بهذه المراكز
لتجنيدها ضمن
(مشروعِ الشرق
الأوسط). وهذا
الذي أشرتُ إليهِ
في كتابي ضمن
الكلمة
الختاميةِ (ص/369)،
قبل سنين، إذ
لم يكن هذا
المشروع
يومئذٍ شيئاً
مذكورا، ولكن
بفراسة الرجل
المؤمن
المُوَحِّدِ
والحمد للهِ،
وأماَّ
بِنِعْمَةِ
رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
وإذا
عُدنا إلى
قصّتي: في
الحقيقةِ
أنّي كُنتُ
صوفياًّ
قبورِياًّ،
كما يقول
الأستاذ عبد المُنعم
الجداوي في
اعترافاته.
قضيتُ أياَّمَ
طفولتي
وفترةً من
أياّمِ شبابي
في ظلمةٍ
حالكةٍ من
الاشراكِ
باللهِ وأنا
أشدُّ الناسِ
قياماً بما
فرض الله على
عباده من
الصلاةِ
والصومِ
والحجِّ
والزكاةِ
والتبتُّلِ
والإكثارِ من
النوافلِ،
بإزاءِ ما
كنتُ ألتزمُ
بهِ من
الرّابطة
والختم
خُوَاجَگَانِيَّة
وزيارة
الأضرحةِ
وتعظيم
القبورِ
والاستمدادِ
من أرواح »الأولياءِ«،
وغيرِ ذلكَ من
مَوْبِقاتِ
الإيمانِ وقد
قال تعالى: » إنّه
مَنْ
يُشْرِكْ بِاللهِ
فَقَدْ
حَرَّمَ اللهُ
عَلَيْهِ
الْجَنَّةَ
وَمَأْوَاهُ
النَّارُ
وَمَا
لِلظَّالِمِينَ
مِنْ
أَنصَارٍ«[610].
إلاَّ أنّ هذه
الحالةَ من
صفة
المشهورين من
شيوخ النقشبنديّة،
يَجْمَعُونَ
بينَ تعاليم
الإسلامِ
وتعاليمِ
بوذا في
عبادةِ اللهِ
على مرِّ
حياتهم والعياذ
بالله!
وبينا
أنا على هذه
الصفةِ من
العبثِ
والخلطِ دونما
انتباهٍ إلى
ما في ذلكَ من
اضطرابٍ وتناقُضٍ
وتضارُبٍ
وتعارُضٍ،
فضلاً عماَّ
أَبْذُلُ من
الجهد
للهيمنة على
نفوس المريدين
لأستدرجَهم
إلى أعماقِ
هذا العالَمِ
المظلم،
زارَني ذاتَ
عشيَّةٍ شخصٌ
من البارزينَ
من أتباعي،
اسمه موسى
أباريِ، فلم
تكن الساعةُ
من الأوقات
التي
أستقبِلُ
فيها الزائرينَ
والضُّيوفَ.
قلتُ في نفسيِ
لعلّه جائني
بأمرٍ عاجلٍ
يستفتيني
فيهِ؛ فلماَّ
استقرَّ جالِساً
بعدَ أنْ
أذِنْتُ لهُ
بالجلوسِ،
أخبَرَنِي: أنّه
فوجِيءَ
بتهمةٍ
يقصُدُ بها
المتَّهِمُ،
أنِّي
وأتباعي
نرتكبُ
الشركَ
باللهِ كلّما
نَعْمِدُ إلى
الرّابطة!
فلماَّ
سمعتُ هذه
الكلماتِ،
نَبَضَتْ
خَلَجاتُ
الغضبِ في
ضميري، إلاَّ
أنّي أحجمتُ
عماَّ بدأَ
يجيشُ بينَ جوانحي
من الثورةِ
على هذا
الاتّهام
الجريءِ. - تُرىَ
من يكون هذا
الذي يرمينا
بالشركِ ونحن عباد
الله
الصالحون،
يتضرّعُ
الناسُ إليه تعالى
بجاهِناَ،
وَيُقْسِموُنَ
بِهاَماَتِناَ
قبلَ أن
يحلفوا
بالله، ولا
يتقرّبُ إلينا
أحدٌ إلاَّ
غايتُهُ
التقرُّبُ
إلى الله؟!...
هكذا تصوّرتُ
لَحَظاتٍ
وأنا في صمتٍ
وجمودٍ.
فلم
يلبثْ حتَّى
نابَتْني
أَناَةٌ
وأدركني انتباهٌ
كأنِّي
أستفيقُ من
غشيةٍ أو
أستيقظُ من
سُباتٍ عميق.
فَالْتَفَتُّ
إلى مريدي، فَلاَطَفْتُهُ
ونصحْتُهُ
بالصبر وضبط
النفس حتّى
أتدبّرَ
المسألةَ
فأُخْبِرَهُ
بما يجب القيامُ
به إنْ كانَ
يقتضي ذلك...
وإلاَّ
فالتجاهُل
لمثلِ هذه
الهفوات
أفضلُ، دفعاً
للفتنة وحفظًا
للمروؤَةِ...
ثمّ
صَرَفْتُهُ
بِرِفْقٍ،
وبدأتُ
بالبحثِ عن
حقيقة
الرّابطة بعد
تلكَ
اللّحظةِ،
وهذا الحدثُ
يُعْتَبَرُ
نقطةَ تَحَوُّلٍ
جذريٍّ في
حياتي.
هذا،
فإنّماَ كانت
هدايتي بمحضِ
فضلِ الله تبارك
وتعالى، ولم تكنْ
بدعوةٍ من
أحدٍ ولا
بإشارةِ
مرشدٍ، وَ»الْحَمْدُ
للهِ الَّذِي
هَدَانَا
لِهَذَا
وَمَا كُنَّا
لِنَهْتَدِيَ
لَوْلا أَنْ
هَدَانَا
الله...«.
لذا، تمتاز
هذه الهدايةُ
عن هداية الأتْباعِ
والذيولِ
والأذنابِ
بطريق التقليد
المحضِ.
فإنّهم قد
يتخلّصونَ من
أصنامٍ عديدةٍ،
ولكنّهم بعد
ذلك يتشبثونَ
بشبه صنمٍ واحدٍ،
إذ يرونه
المصدرَ
الحقيقيَّ
الوحيدَ لهدايتهم،
فيخلعونَ
عليهِ نعوتاً
لا يتّصفُ بها
غيرُهُ من
المكانة
والعظمةِ
والعلمِ والذكاءِ
والدهاءِ! كلّ
ذلكَ
تملُّقاً
ورياءاً
واستغلالاً
للضمائِرِ،
أو جهلاً
وتقليداً...
والرسولُ r يقول: مَنْ
يَهْدِهِ
اللهُ فَلاَ
مُضِلَّ لَهُ،
وَمَنْ
يُضْلِلْ
فَلاَ
هاَدِيَ لَهُ.[611]
ولي
مع فئةٍ من
هؤلاءِ
الذيولِ
قصّةٌ شيّقةٌ سأُوافيكُمُوهاَ فيما
بعد إنْ شاء
الله تعالى.
فالله سبحانه
الذي هداني
وثبَّتَني عليها
بكرمِهِ.
فالفرقُ إذن
بينَ هدايتي
وبينَ ما
رُزِقَ منها
غيري على يدِ
أحدٍ من
عبادِهِ
الصالحينَ
ظاهرٌ حينَ
يتشبثونَ به
ويتّخذونه
شبه صنمٍ وهو
بريءٌ منهم،
بله على ما
يُنْكِرونَ
على عبدة
الأصنامِ،
ويعدّونَ
أنفسهم من
خلاصة
السلفيّين.
فهذا مبلغهم
من العلم بالتوحيد!
ولماَّ
أيقظني ربِّي
من نوم
الغفلةِ بهذه
المفاجأة
الغريبةِ،
بَدَأَتْ
الشكوكُ
تَدُبُّ في
روعي،
وتجعلني
أتَساَءَلُ
في نفسي عماَّ
إذا كانتْ هذه
الرّابطة
التي
نتعبَّدُ بها
من صُنعِ
الشيطانِ،
ولكنَّنِي
أتّهمها أحياناً
بسوءِ
الظَّنِّ في
مَشاَئِخِناَ،
فأقول: »وهم
أولياءُ
اللهِ
وخاصَّتُهُ
من عباده الّذين
رفضوا زينةَ
الحياةِ
الدنيا طمعاً
فيما عند
اللهِ من
نعيمٍ وجنانٍ
سوفَ
يخلدّونَ فيها«. حسبَ
اعتقادي
يومئذٍ. ولم
يكن الأمرُ
كذلكَ في
الحقيقةِ من
وجهينِ.
أولاً: أنّ
أولياءَ
الصوفيةِ لم
يعبدوا اللهَ
طمعاً فيما عنده
من نعيمٍ
وجنانٍ، بل
بغرض
الاتّحادِ
معه والحلولِ
فيه، تعالى
رَبُّنا
عماَّ يقوله الفاسفون.
ثانياً: أنّ
هؤلاءِ لم
يكونوا أصلاً من
أولياءِ
اللهِ بل
كانوا أولياء
الشيطانِ بلا
ريبٍ... وهذا
يدلُّ على
أنَّ الضلالة
متى تأصّلتْ
في الإنسانِ
وأصبحتْ
مرضاً مُزْمِناً
في أعماق
وجدانِهِ،
جَعَلَتْهُ
غبياًّ لا
يكاد يميّزُ
الحقَّ من
الباطلِ
بحيثُ لا ينفعه
عِلْمُهُ.
وللأسف كنا
على هذه
الحالة التي
يُرثى عليها...
وعلى ما كان
مِنْ خالصِ
اعتقادي بهم،
كنتُ أقول:
وكيفَ
بهؤلاءِ
الأفاضل أن
يقعوا في حبال
الشيطانِ وهم
أشدُّ الناسِ
يقظةً لا
تعتريهم
غفلةٌ حتّى في
نومهم. هكذا
كناَّ نعتقد
فيهم،
(وخاصّةً منهم
محمّد بهاء
الدين
البخاري
المعروف بين
النقشبنديّينَ
بِشاَهِ
نقشبند،
وأحمد
القاروقي
السرهندي
الذي
تُعَظِّمُهُ
الطائفةُ
بصفة الإمام
الرّباَّني،
وخالد
البغدادي
المشهور بصفة
ذي الجناحين بين
ملايينِ
الناسِ،
وكذلك جدّي
الشيخ محمّد
الحزين
وأمثالهم)
الذين يزور
آلاف الناسِ
أضرحتَهم،
ويستمدّونها
الشفاعةَ
والمغفرةَ والشفاءَ؛
فكيف بهم أن
يكونَ
الشيطانُ قد
غرّهم؟! ولقد
كنتُ غافلاً
يومئذٍ تمامَ
الغفلةِ
عماَّ قال
تعالى: وَمَا
أَرْسَلْنَا
مِنْ
قَبْلِكَ
مِنْ رَسُولٍ
وَلا نَبِيٍّ
إِلا إِذَا
تَمَنَّى أَلْقَى
الشَّيْطَانُ
فِي
أُمْنِيَّتِهِ،
فَيَنْسَخُ
اللهُ مَا
يُلْقِي
الشَّيْطَانُ،
ثُمَّ
يُحْكِمُ
اللهُ آيَاتِهِ
وَاللهُ عَلِيمٌ
حَكِيمٌ.[612]
فلمَّا ننظر
إلى ما ورد عن
هؤلاءِ من
أقوالٍ في
أشعارهم
ومكاتيبهم
وتوجيهاتهم،
نجد كثيراً
مماَّ ألقى
الشيطانُ في أمنيتهم
فتأصّلتْ
وتحكّمت
فيهم، وهي
شاهدةٌ عليهم
إلى يوم
القيامةِ![613]
شغلتنيْ
الرّابطة منذ
اللّحظة التي
أخبرني فيها
الشيخ موسى
أباري بأنَّ
شخصاً
يُلصِقُ بِناَ
تُهمَةَ
الشِّركِ
بِسَبَبِهاَ؛
فأصبحتْ
عُقْدَةً
تُحْرِجُنيِ
وتجرحُ
وجداني
وتُجبِرُني
على التحقُّقِ
مِنْهاَ
حتَّى
أطمئنَّ عما
إذا هي حقٌ أم
باطلٌ. وما
أنْ صرفتُ
الشخ موسى بعد
أن شكرتُهُ
على إخلاصِهِ
لنا وصلتِهِ
القويَّةِ
بطريقتِنا،
تناولتُ
كِتابَ
(تنويرِ
القلوبِ) لمؤلِفِهِ
محمّد أمين
الكرديّ
الأربلي (ت. 1332هـ.)،
فتصفّحتُ
القسمَ
الثالثَ منهُ
وهو يشتمل على
مسائل
التصوّف. حتّى
إذا عثرتُ على
موضوعٍ
عنوانُهُ: »ومبنى
هذه الطريقةِ
العليّة على
العمل بإحدى
عشرة كلمة
فارسية (ص/506) «.
فأخذتني الدّهشةُ
في الوهلة
الآولى أنَّ
رجلاً مِن »علماء
الاسلام«!
ينصح الناسَ
بأنْ يذكروا
الله على
طريقةٍ
مبناها
مصطلحاتٌ
فارسيةٌ؟ هذا،
ويجب
التّركيز هنا
على أنِّي لا
أقول بنفي ذكر
الله بِلغاتٍ
مختلفةٍ. بل
يجوز (بقدر ما
يجوز!) أن يذكر
العبدُ
رَبَّهُ
بلغتِهِ، ولكن
ما بالُ مَنْ
ألَّفَ
كتاباً ضخماً
باللّغة العربيّة
في العقيدة الإسلاميّة
والفقهِ،
فضلاً عماَّ
يُنْسَبُ
إليهِ من العلم
والبركة
والكرامة
وبأنّه »شيخ
شيوخ العصر،
وقدوة جهابذة كلّ
مصر، ونورٌ
أضاءَ من عين
المنّة الإلهيّة
على هذا
القطر، وغيثٌ
رباَّنِيٌّ
عامٌّ أينع به
نبات كلّ قفر...«[614]
إلى غير ذلكَ
من مبالغات
وإفراطٍ
وإسراف... ما
باله يقدِّ مُ
للمسلينَ
طريقةً
شاذّةً من
الذّكرِ
غريبةً على الإسلامِ،
مصطلحاتها
فارسيّةٌ،
ومستوحاها
دياناتٌ
هنديّةٌ،
وتوجيهاتها
كفريّةٌ؟!
إنّ
هذا
التساؤُلَ
قادني حتى
ألقيتُ
النطرَ على
سطورٍ وردتْ
فيها نبذةٌ
مِنَ
الرّابطة وطريقةِ
إجرائِهاَ في
الصفحة
الحادية عشرة
والثانية
عشرة بعد
الخمسِمائَةِ
من هذا
الكتاب؛ يشرحُها
المؤلِّفُ
ويُعّدِّدُ
شروطَها وهو
يُرشِدُ
المريدَ إلى
ذكر الله
فيقول: »التاسع،
رابطةُ
المرشِدِ. وهي
مقابلةُ قلب المريدِ
بقلبِ
شيخِهِ،
وحفظُ
صورتِهِ في
الخيالِ ولو
في غيبتِهِ،
وملاحظةُ
أنَّ قلبَ
الشيخِ
كالميزابِ
ينـزل الفيضُ
من بحرِهِ
المُحيطِ إلى
قلب المريدِ
المرابِطِ،
واسْتِمدادُ
الْبَرَكَةِ
منه لأنّه
الواسِطَةُ
إلى
التوصُّلِ...«
زادتْني
هذه السطورُ
دهشةً عندما
قرأتُ بعدها
مباشرةً من
كلماتِ
المؤلِّفِ أنّه
يقول فيها: »ولا
يخفى ما في
ذلكَ من
الآياتِ
والأحاديثِ«،
فيستدلّ
بقوله تعالى: يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهَ وَابْتَغُوا
إِلَيْهِ
الْوَسِيلَةَ
وَجَاهِدُوا
فِي
سَبِيلِهِ
لَعَلَّكُمْ
تُفْلِحُونَ[615]
وقوله تعالى: يَاأَيُّهَا
الَّذِينَ
آمَنُوا
اتَّقُوا
اللهَ وَكُونُوا
مَعَ
الصَّادِقِينَ.[616]
إنّ
مثل هذا
الاستدلالِ
الفاسد،
زادني أضعافاً
مما ينتابني
من الدهشةِ
كما زاد من
عدد الأسباب
التي دفعني كلّ
منها بحافزٍ
خاصٍّ إلى
مجال البحثِ
حول الرّابطة النقشبنديّة.
ومن الغرابةِ
بمكان، إنّي
كنتُ شيخاً
مُجازاً على
سجادةِ النقشبنديّة
وأنا غافلٌ
يومئذٍ عن
حقيقةِ هذه
الطريقةِ ومبناها
ومستوحاها
ونسيجها
المتضافرِ من
الإسلامِ
والبوذيةِ!
فلماَّ
نبّهني ربِّي
بباعِثِ هذه
التُّهمةِ
وَكَتَبَ
لنفسي
الهدايةَ في
أمدٍ غيرِ مديد،
بدأتُ
أتحرّىَ طريق
الخلاصِ
أوّلاً من آلاَفِ
الْمُلْتَفِّينَ
حوليِ
والمفتتنين
بهذه
الطريقةِ،
دونَ أن يشعروا
بما حدثَ لي
من التغيُّرِ
في آرائي
وضميريِ؛ ليس
ذلكَ خوفاً من
أيِّ عداءٍ
تتعرَّضُ لهُ
حياتي
وماليِ،
كلاَّ!... ولكن
أيقنتُ أنّي لن
أنجحَ في
دعوتي لهم إلى
الحقِ
بمجرّدِ تخطيئي
للطريقةِ النقشبنديّة
واستدلاَليِ
بالكتابِ
والسنةِ،
خاصَّةً في
تلك المرحلة
التي لم أعلم
أحداً
يُوَحِّدُ
الله في هذا
البلد! إذاً،
فكانَ لا بدَّ
أولاً من
تمهيد
السبيلِ لهذه
الدعوةِ ولم
يكن ذلكً من
السهلِ
طبعاً، لأنّ
مثل هذا
النهوضِ
يحتاج إلى
تفكيرٍ
وتنظيمٍ
ومالٍ ورجالٍ
ووقت...
فإيقنتُ
أنّ الاستعدادَ
لهذه المهمّة
الخطيرةِ لا
يمكن إلاّ خارج
البلاد.
فسافرتُ إلى
ليبيا بذريعة
البحوث العلميّة،
فانخرطتُ في
سلك الموظفين
باحدى
الشركاتِ التركيّة
للمقاولةِ.
فكانَ هذا
البلدُ أرضاً
صالحةً، إذ
أنَّ
سُكاّنَهاَ
لم يكونوا من
أهل البدعِ والخرافاتِ،
كما لم يكن
للطرق
الصوفيةِ
أثرٌ
يُذْكَرُ على الأغلبيّة
منهم. بل
وجدتُ
الليبييّنَ
على وجه
العمومِ مجتمعاً
فاضِلاً
خَلوقاً
كريماً،
ولقيتُ منهم
حفاوةً
أفسحتْ لي
المجالَ في
البحثِ حول الصوفية
عامّةً والنقشبنديّة
خاصّةً. في
الحقيقةِ
مكتباتهم
كانت خاليةً من
المصادر التي
أحتاج إليها،
إذ كانت جلّ
هذه المصادر
في مكتباتِ إسطنبول،
ولم يكن من
السهل إدخالُ
مثل هذه الكتبِ
إلى ليبيا.
فلم أظن أنّي
أتمكّنُ
يومئذٍ من
إقناعِ
الموظفين في
أمن بوّابات
الدخول، بإنّي
رجل باحثٌ،
فأذكرَ لهم كلّ
هذه القصّةِ
الطويلةِ حتى
أكسب ثقتهم.
ولا عَمَدْتُ
إلى تجربةٍ في
ذلكَ. تجنّباً
أيَّ إزعاجٍ
أو تشكيك. لذا
تكبّدتُ
عناءً شديداً
في نقلِ
المعلومات
الخاصّةِ
بالصوفيةِ
والطريقة النقشبنديّة
إلى ليبيا.
فكنتُ كلّما
عُدْتُ إلى
بلدي، طفتُ
المكتبات
الشهيرةَ
وعلى رأسها
مكتبة السليمانيّة،
وقمتُ
بكتابةِ
ملاحظاتِ
ضخمة في كرّاساتٍ
ولكن بإيجاز،
مع ذكر أرقام
الصحف للمصادر،
وتاريخ
الأحداثِ
والتطورات
الخاصةِ بالطرق
الصوفيةِ
ورجالاتها،
وأحفظ البقيّة
من تفاصيلها
عن ظهر قلبٍ،
إلى أنْ
تراكمتْ هذه
الكرّاسات
عندي،
فتكوّنتْ
منها مكتبةٌ
متكاملةٌ
بناحيةٍ من
حجرتي
الواقعةِ في
عمارةٍ بموقع الظهرةِ
في طرابلس.
ولم يكن أحدٌ
من اخوتنا الليبييّنَ
يعلم يومئذٍ
أن رجلاً من
الأتراكَ يقيم
في بلدهم،
يملك مكتبةً
ضخمةً
اسْتَنْسَخَ كلّ
ما فيها
بقلِمِهِ،
وتُمَثِّلُ
هذه المكتبةُ
منهلاً
غزيراً في
مجال
التصوُّفِ
خاصّةً فيما
يفضحهم! وكم
كانَ
المثقّفونَ
والعلماءُ
والطَلَبَةُ
والباحثونَ
اللّيبيّونَ
بحاجةٍ
ماسَّةٍ إلى
هذه المكتبةِ
القيّمةِ.
هذا،
وكم
يُؤْلِمُنيِ
يومَ
استغنيتُ عن
هذه المكتبةِ
فجمعتُها في
حاويةٍ
فأنشبتُ فيها النارَ
حتىَّ عادتْ
رُكاماً من
رمادٍ هامد. ذلكَ
أنّ المجتمع
الليبيَّ
أيضاً جزءٌ من
أمتِنا التي
قد خسرت ثروة
العلمَ، فلا
يكاد
المسلمونَ يُقَدِّرونه
اليومَ حقَّ
قدرِهِ إلى أن
يشاءَ الله
فيبعثَ لهم من
يُقِظُهم عن
هذه النومة
الخطيرةِ.
فكانَ ذلك
منّي أنْ لم
أتوقّع من أحدٍ
هناكَ يهتم
بهذه
المكتبةِ
فأحرقتُها!
غيرَ
أنّه لا بأسَ
من ذلك، لأنّ
هذا الكتابَ
الذي عكفتُ
على المصادرِ
وطاردتُ
الوثائِقَ
لتأليفِهِ ما
بينَ أعوام 1974-1997م.
هو في الحقيقة
عُصارةُ هذه
المكتبهِ.
فبنيتُ
أساسَه في
ليبيا عام 1976م.
فورَ إقامتي
في هذا البلد
الطيّبِ؛ ثمّ
قمتُ بترتيبِ
فصولِهِ
وأبوابِهِ
عام 1982م.
وكلّما
دَعَتْ
الحاجةُ إلى وثيقةٍ
أو كتابٍ أو
حوارٍ مع
كبارِ هذه
الطريقةِ، ما
ألوتُ جهداً
في شدّ
الرحالِ إليه
؛ كلّ ذلك
ليصدر
الكتابُ
جامعاً
شاملاً
لكُلِّ أطرافِ
الموضوعِ.
وعلى الرغم من
أنّيِ لم
ألتمسْ
مساعدةَ أحدٍ
من إخوتي
الليبييّنَ
لإكمالِ هذا
الكتابِ،
ولكنّي
أشكرهم
جميعاً، ولا يفوتني
أن أذكر ما
ليقيتُ منهم
من الحفاوةِ
والكرمِ وحسن
القرى ولين
الجانب،
وإنّيِ لأعترفُ
بأنّ المدّةَ
التي قضيتُها
على أرضِ ليبيا
الحبيبةِ -وهي
في الحقيقةِ
لم تكنْ مدّةً
قصيرةً- كانتْ
أحلى أياّمي،
إذ كانت
أياَّمَ شبابي،
وكانت فترةً
سعيدةً
مُثْمِرَةً
نِلتُ خلاَلَها
رِزْقاً
حلاَلاً
واسعاً
أغناني عن الحاجةِ
إلى غيري حتّى
أكملتُ هذا
البحثَ القيّمَ
فَتَرَكْتُهُ
زخراً
للباحثينَ
وعبرةً لأُلي
الألبابِ
ومصباحاً لمن
يريدُ أن يطّلِعَ
في ضوئِهِ على
خطورة
الصوفيةِ
والتصوّفِ
وما
تَعَرَّضَ له
الإسلامُ
والمسلمونَ على
مرّ العصورِ
من جرّاءِ هذا
السرطانِ
الماكرِ وما
خلّفَهُ هذا
الوحشُ
الدسّاسُ
المتلبّسُ في
ثوب الزهدِ
والتقوى من
الخرابِ
والدمار في
صرح الإيمان
والتوحيد.
هذا،
وإنّيِ
لأشكرُ كذلكَ
الْمُتَّهِمَ
الذي لم
تأخذهُ لومةُ
لائمٍ ولا
خشيةُ ظالِمٍ
إذ خاطَرَ
بِنَفسِهِ
فأعلنَّ للمرّة
الأولى على
الساحة التركيّة:
أنَّ صلاةَ
الرّابطة في
الطريقة النقشبنديّة
إشراكٌ
باللهِ، وذلك
عام 1974م.؛
ثمّ بلغني أنّه
قد اتّهمني
واتباعي بهذا
الذنب العظيم
حتّى ألهمني
ربّي على أثره
الرشدَ فقمتُ
بهذا البحثِ
الذي أخذ من
عمري ثلاثةً
وعشرينَ
عاماً. وللعلمِ
لم يكن إبداءُ
هذه الجرأةِ
من السهلِ، إذ
استفتاني
قريبُ
الْمُتَهِمِ
بالذّات، »لَينتقمنَّ
منه بشكلٍ
يكونُ عبرةً
لمن بعده!«
فأبيتُ أن
أُرَخّصَ له
ذلك. فإنّي
أشكر هذا الرجلَ
الصالحَ
الجريءَ الذي
أطلعه الله
على خطرٍ هلك
فيه آلافٌ بل
ملايينُ من
الناسِ، فأعلن
عنه وهو لا
يبالي بما قد
يصيبُهُ من
نقمةٍ ونكال.
ثمَّ علِمتُ أنّه
رجلٌ خايّاطٌ
اسمُهُ (شفيق
أركويونجوŞefik Erkoyuncu )
بحيّ الفاتخ
في إسطنبول،
وهذا الشخص،
لم يكن قد درس
شيئاً مما
نسميهِ علماً!
وما أشدّ حزني
وأسفي إذ
سمعتُ بعدَ
فترةٍ قصيرةٍ
من عودتي إلى
إسطنبول أنّه
قد ذهب إلى
الرفيق
الأعلى، فلم
ألقاه في هذه الحياة
الدنيا بعد أن
اتّهمني
بالشركِ! فتغمّده
الله تعالى
برحمتهِ،
وحشرهُ مع
النبيّينَ
والصّدّيقينَ
والشهداءِ
والصالحينَ
وحسُنَ
أولئكَ
رفيقاً.
أللّهمّ اغفر
لنا وله، وأكرِمْ
مثواهُ،
ولقِّهِ
الأمنَ
والرّاحَةَ
والزُّلفى،
والكرامةَ
والبشرى،
إنّكَ سميعٌ
مجيب.
وأماَّ
وصفُ طائفةٍ
بِـ»الوهّابيّة« في
ثنايا كتابي
وبواعث
استعمالها: فقد
ناسب المقامُ
هنا أن
أتطرّقَ إلى
هذه التسميةِ
إجابةً على ما
وَرَدَ من
النقدِ في
تقرير الفاضل
الشخ لطف الله
بن عبد
العظيم، حفظه
الله تعالى.
قال
الشيخ: »للمؤلف
نظرة سلبية
تجاه من
يُسميهم بالوهّابيّة
(229، 311، 312،313)،
وكذلك شيخ
الإسلام ابن
تيمية ( 340)، حيث
يصف أتباع
الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
بالعنف
والجبر وبعدم
الكفاءة في
إرشاد الناس
وإصلاحهم،
وابن تيمية
بأنه يمطر
المخالفين
بالشتم
واللّعن
ويرمي بالكفر
البواح«.
لقد
أشارَ فضيلةُ
الشيخ إلى
صفحات من
كتابي[617]
وردت فيها وصف
طائفة بـ »الوهّابيّة«.
وإذا كانت هذه
الألفاظُ
تحتاج منِّي
إلى إعادةِ
النَّطرِ
فِيهَا فأقول:
أماّ
صفةُ »الوهّابيّة«،
فقد قصدتُ
منها طائِفةً
متطرِّفةً
ممّن يدَّعونَ
الانتسابَ
إلى الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
رحمه الله
تعالى وهو
بريءٌ منهم
لتصرُّفاتهم
التي أضرَّتْ
كثيراً
بوحدةِ أهل
التوحيدِ كما
سأذكر منها
أمثلةً
للعبرةِ. هذا،
ولا يُعْقَلُ
أن أكونَ قد
قصدْتُ بهذا
الوصفِ جميعَ السَّلَفِييّنَ
من أبناءِ
أُمَّتِناَ
القاطنينَ بجزيرة
العربِ؛ فإنّ
ذلك من الشططِ
لا محالةَ مماَّ
لا يكادُ
يصدّقُهُ
مَنْ يطّلع
على كتابي
بكلّيَّتِهِ
الجامعةِ.
ومماَّ
يُكَذِّبُ
مَنْ يزعم
أنَّ في
إطلاقِ هذه
الصفةِ تعميمٌ:
كلماتي
الواردةِ في
الصفحة/316 مِنْ
كتابي وهذا
نصُّها:
»أمّا
الوهّابيُّون،
فإنّهم لم
يجعلوا
النقشبنديّين
بالتحديد
هدفًا خاصًا
لانتقاداتهم؛
بل قد
تجاهلوهم
تمامًا أو كادوا.
وإنّما
وجّهوا
نقدَهم إلى
الصوفيّة على
وجه العموم.
كما قد دافعوا
عن أنفسهم
بأنّ تسميتهم
من قِبَلِ
المعارضين بالوهّابيّة
تسمية خاطئة.
إذ يقول في
هذا أحد
ملوكهم:
»يسمّوننا
بالوهّابيّين،
ويسمّون
مذهبنا بالوهّابيِّ،
باعتبار أنّه
مذهب خاصٌّ،
وهذا خطأ فاحش
نشأ عن الدِّعَايَاتِ
الكاذبة
الّتي كان يبثّها
أهل الأغراض.
نحن
لسنا أصحاب
مذهب جديد،
وعقيدة
جديدة، فعقيدتنا
هي عقيدة
السلف
الصالح، ونحن
نحترم الأئمّة
الأربعة، ولا
فرق عندنا بين
مالك
والشافعيِّ و
أحمد وأبي
حنيفة، وكلّهم
محترمون في
نظرنا«.[618]
هذا،
ولإنْ جعلْنا
الشيخ عبد
الرحمن
دمشقية في
عداد الوهّابيّين،
فإنّه قد
تناول النقشبنديّة
بهدوءٍ ولم
يتوسّع فيها.
بل حَدَّدَ مَوْضُوعَهُ
في تحليل
ثلاثةِ
أقوالٍ،
لثلاثة رجالٍ
من قدمائهم فحسب«.
إنَّ
من يطّلع على
هذا الأسلوب
بكمالِ الوعيِ
لا يفوته أن
يتنبَّهَ إلى
أمرينِ:
أحدهما:
كون الوهّابيّين
قلّة وإن كان
زمامُ الحكم
بيدهم،
وتدلُّ على ذلكَ
الجملةُ
الأخيرةُ
لهذا النصِّ
وهي تتمثل في
تساؤُلٍ عما
إذا كانَ
الشيخ عبد
الرحمن دمشقيّة
يدخل في عداد الوهّابيّين؟!
والأمر
الثاني: هو
الانتصارُ
الواضحُ
مِنِّي
للجبهة الوهّابيّة
في وجه
النقشبندييّن
بنقلِ كلمات
المغفور له
الملك عبد
العزيز. إذ
أنّ الوهّابيّين
على وجه
العموم (مهما
كانوا)، هم
أهل التوحيد والإيمانِ
الخالِصِ
بخلافِ
النقشبندييّنَ،
وأماّ هؤلاءِ،
فإنَّ غالبهم
زنادقةٌ
مشركونَ
باللهِ خارجونَ
عن الملّةِ!
وهذه
وثيقة أخرى من
كتابي
تُصَرِّحُ
أنّي لم استعمل
صفةَ »الوهّابيّة« من منطلق
العداءِ
السافر،
والاستخفافِ
بهم، بل على
سبيل النقد
والعتابِ.
قلتُ
في الصفحة (361): فلم يكن
لوجودهم هناك
(أي في أفغانستان)
من الحكمة في
شيءٍ مماّ دعا
إلى تطوّراتٍ
خطيرةٍ أسفرت
عن خساراتٍ
جسيمةٍ في
الأموالِ
والأرواح،
بله ما جرّتْ
من تبعاتٍ على
الأمّةِ زادت
من أزماتها في
هذه المرحلة
العصيبةٍ.
فأثبَتَتْ
أخيراً هذه
الحقائقُ
كلُّها أن الوهّابيّين
لم يكونوا
أصحابَ كفائَةٍ
لإرشادِ
الناسِ
وإصلاحهم
يوماً من الأيّامِ.
لذلك دخل
الشقاقُ بين
الصفوفِ
كلّما كان للوهّابيّين
دورٌ في
التوجيه، وإن
كانوا مخلصين
في نياّتِهم...
فهذه
المبرّرات
كلّها تفيد
أنَّ إطلاقِي
صفةَ »الوهّابيّة«،
لم يكن القصدُ
منه التعميمَ
ولا العداءَ،
كما لا أُوافق
على هذه
النسبةِ
للشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
رحمه الله
تعالى.
هنا،
وبهذه
المناسبةِ
يتبادرُ إلى
الذهنِ سؤالانِ:
أوّلهما:
- مَنْ هم الوهّابيُّون؟
وثانيهما:
- ما هي
ميّزاتهم
التي
جعلَتْهم هدفاً
بهذه الصفةِ
في كتابِنا
خاصّةً؟
أماَّ
الإجابةُ على
السؤال الأوّلِ:
فإنّ الوهّابيّين
الّذينَ
يتظاهرونَ
بالانتسابِ
إلى الشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
رحمه الله
تعالى،
ويُكْثِرونَ
من ذكرِهِ ودعوتِهِ
ومآثِرِهِ
دونَ أن
يُحَقِّقُوا
شيئاً
يصدِّقُهم
فيما
يزعمونَ، بل
سُلُوكُهُمْ
وتصرُّفاتهم
وسِيَاسَاتُهُمْ
وَأَسَالِيبُهُمْ
في التعاملِ
يُكَذِّبُهُم
في كلّ ذلِكَ...
وإليكَ ما
يُبَرهِنَ
على هذه
الحقيقةِ من
واقعِ
علاقاتهم
بالقدر الذي
أشهدَني ربّيِ
عليهِ:
1) وَكّلَ
الوهّابيُّون
رَجُلَيْنِ
للقيامِ بأمر
الدّعوةِ في
تركيا، فلم
يُسْمَعْ
أنَّ شخصاً من
القبورييّنَ اهتدى
على يد أحدٍ
منهما؛ رغم
الدعم الذي
يتلقّيانِ من
خزانة الوهّابيّين
منذ عشرات
السنين. وهذا
يبرهن على مدى
عقلية الوهّابيّين
في المعرفة
بالرجالِ
ومستوى
مهارتهم في
كفاح الشركِ
ومتابعة أمر
الدعوةِ...
2) رَجُلٌ وهّابيٌّ
اسمه عبد الله
السبت، (على
ما سمعتُ)
يقوم بتوزيع
كمياَّتٍ ضخمةٍ
من الكتُبِ
تبرُّعاً منه
لنشر الدعوةِ
إلى التوحيد
وتثقيف
المسلمين؛ لم
نسمع أنّه
قدّمَ ولو
نسخةً من هذه
الكتب إلى
شبابِنا الحنفاءَ
الَّذين
يدرسونَ
ويكافحونَ
ضدَّ كفريات
الصوفيةِ في
الوقت ذاته.
في الحقيقةِ
لا يحتاج
تلامذتُنا
إلى الكتب
الشائعةِ في
العلوم الإسلاميّة
من توحيدٍ
وفقهٍ
وتفسيرٍ
وحديث، لأنّ
هذه الكُتُبَ
متوفّرةٌ في
بلدنا،
وإنّما
يحتاجونَ إلى
توفير ظروفٍ
مكانيّةٍ وما
ينهض بهم من البرامج
ويُرْقيِ
مستواهم في
المعرفة
باللّغة العربيّة
نطقاً
وكتابةً.
لأنهم
مازالوا في
أسرِ البرامج التقليديّة
الّتي تقوم على
حفظ متون
الصرف
والنحوِ،
بجانب ما في
هذه البرامج
والمقرّراتِ
من خطورةِ ما
تضمَّ من مخلّفات
القبورييّنَ
والكلاميين!
لأنّها موكّلةٌ
بحماية
وتوجيه
جماعاتٍ من
الصوفيةِ ومؤسّساتهم.
فلا يستطيع
أحد أنْ
يُغَيِّرَ شيئاً
منها.
وعلى
سبيل المثال:
فإنّي
أُدَرِّسُ رهطاً
من طلبة
الجامعاتِ
اللّغَةَ الغربيّة
والعلومَ الإسلاميّة
منذ عام 1987م.
إلاَّا أنّنا
نواجه
مضايقات شديدةً
من المؤسّسات
والجمعيّاتِ،
فإنّها إمّا
ترفضنا، أو تعرقل
أعمالنا.
وأخيرًا
لجأنَا إلى
جمعيةٍ بإسطنبول
إسمها (وَقْفُ
الإنْسانِ)؛
ثقةً منّا
بأحد مسؤولي
هذه
المؤسّسةِ، الدكتور
شرف الدين
كالاي. وهو
مِنْ خرِّيجي
جامعةِ أمّ
القُرىَ.
فلماَّ تقدّمنا
إليه بطلب السماح
لنا
بالتدريسِ، في
قاعة هذه
الجمعية، سألني
عن المصادر
التي أستفيد
منها في إعداد
برنامج
المحاضرات.
وما أن
أجبتُهُ
بتسميةِ شرح
العقيدة
الطحاويةِ،
حَتَّى
اشمئزَّ في
لحظتِهِ
وعَبَسَ
وبَسَرَ، فاشترطَ
عليَّ أن
أُدرِّسَ
كتابَ
(البداية في أصول
الدين)
لمؤلّفه نور
الدين
الصابونيّ، علمتُ
لأنّ
مؤلِّفَهُ
تُركِيٌّ
وكلامِيٌّ!!! والدكتور
شرف الدين
كالاي هذا،
رجلٌ دَرَسَ في
مكّة
المكرّمة
وأتمّ تعليمه
في جامعة أمّ
القُرىَ، وهو
فاضِلٌ
مُوَحِّدٌ
(عَلَى مَا
أَظُنُّ)، وما
بالكَ بِمَن
يُوَجِّهُ »العلماءَ«
والمدرّسينَ
في هذا البلد
من شيوخ النقشبنديّة
وبطانتهم مثل »أمين
السراج«،
و»محمود
أوسطى عثمان
أوعلو«،
و»جُبَّلي
أحمد« و»عمر
أُونْگَُوتْ«
وأمثالهم
المتطرّفين
القبورييّن؟!
هذا، ولم يلبث
حتّى أخطرني
مدير
المؤسّسةِ بإيقاف
التدريس بعد
شهورٍ قليلةٍ!
والدكتور شرف
الدين كالاي
يَشَاهِدَ
الأَمْرَ فِي
عَجْزٍ
وَسُبَاتِ.
3) رجلٌ من
القبورييّنَ
من جماعة
محمود أُسطى عثمان
أوغلو (اسمه
أحمد وانلي
أوغلو)،
اتَّصَلَ
بقنصل الوهّابيّين
في إسطنبول
عام 1984م.
وتلقىَ منه
دعماً
مالياًّ شهدْتُ
ذلك بأمِّ
عيني!
4) ما
وجدتُ وهّابياًّ
في تركيا
إلاَّ وكانَت
له علاقاتٌ
وُدِّيَّةٌ
مع كبار
القبورييّنَ
مثل نجم الدين
أرباكان،
ومحمد زاهد
كوتكو، وأمين
السرّاج، وكوركوت
أوزال (أخو
ترغوت أوزال)،
ومحمد شوكت أيكي
(الصحفي)
وأمثالهم... كلّ
أعمال الوهّابيّين
وشركاتهم في
تركيا
تتولاّها
وتُسَيِّرُها
جماعاتٌ من
القبورييّنَ
النقشبندييّنَ،
ولا يكاد
يوجَدُ
مؤمِنٌ من
الحُنفاءِ
الأتراك في
هذه الشركاتِ.
5) ما
لقيتُ وهّابياًّ
في تركيا
فَعَرَفَ
أنّيِ من أهل
التوحيد
الخالِصِ مُتَميّزًا
بالعفّةِ
والذّمّةِ
والأمانَةِ
وطيبِ
العُشرةِ،
وَافِرَ
الْحَظِّ من
الثقافة الإسلاميّة
والعربيّة،
إلاَّ
وجدتُهُ
متردِّداً
مُرْتَبِكًا
في أمري،
مُحْتَاطاً
في معاملتي،
مُتَخَوِّفاً،
يعتذر
لِيُفَارِقَنِي
في أقرب
فرصةٍ. (نعم،
في هذا البلد
الذي أثبتتْ إحصائيّةٌ
سرّيّةٌ أنَّ
عددَ من
يُتْقِنُ اللّغةَ
العربيّة
نطقاً
وكتابةً من
جملة
سُكَّانِهِ،
لا يتجاوز عن
سبعةَ عشر
شخصاً! وهذا
ما يبرهن على
الحاجة
الملحّةِ إلى
من يتقن
اللغتين العربيّة
والتركيّة
بالنسبة
للعربِ وللوهّابيّين
منهم خاصّةً).
لذا أتحدىَّ
من يأتي بشخصٍ
وهّابيٍّ
يعترفُ أنّه
تعرَّفَ
عليَّ في وقتٍ
ماّ
ولاَزَمَني
بِاطْمِئْنَانٍ
وَبِصَدْرٍ
رَحْبٍ، رغم
شِدَّةِ
حَاجَتِهِ
إلَى مِثْلَي
فِي كَمَالِ
الْوَفَاءِ
بِالْعَهْدِ،
وَحُسْن
الأَدَاءِ فِي
الْقِيَامِ
بِمُتَابَعَةِ
الأَمُورِ واسْتِنْتَاجِهَا
بِنَجَاح،
وَرَغْمَ
كثرة عدد الوهّابيّين
الّذين
لَقِيتُهُمْ
في إسطنبول
وَأَكْرَمْتُهُمْ
وَخَدَمْتُهُمْ
منذ عشرات
السنين!!! فَالْوهّابيُّ
إِذَنْ
بِجَامِعِ
مَعْنَى
الْكَلِمَةِ:
إنْسَانٌ
عَلَى
تَمَامِ
الْجَهْلِ
بِحَقَائِقِ
الْكَونِ
والْحَيَاةِ
والإسْلاَمٍ
والتَّعَامُلِ
السَّلِيمِ،
مُتَزَمِّتٌ
لاَ يَعْرِفُ
كُوعَهُ مِنْ
بُوعِهِ!
6)
ولماَّ كانَ
في الْقَدَرِ
أن يُحْمَلَ
كتابي (الطريقة النقشبنديّة
بين ماضيها
وحاضرهاَ) إلى
البلد
الأمين، لِيَقْضِيَ
اللهُ أَمْرًا
كَانَ
مَفْعُولاً
لِيَهْلِكَ
مَنْ هَلَكَ
عَنْ
بَيِّنَةٍ
وَيَحْيَا مَنْ
حَيَّ عَنْ
بَيِّنَةٍ،
تناولَهُ
عالمٌ من
علماءِ
الإسلامِ،
فتكلّف
مشكوراً
عناءَ
دراسته،
فَقَيَّمَهُ،
فأجرىَ فيه
نظرَتَهُ
اللّطيفةَ،
وأبرزَ آراءَهُ
الحكيمةَ في
مضمونِهِ،
حتَّى أظهر
اللهُ تبارك
وتعالى بذلكَ
حقيقةَ الوهّابيّين
مرةً أخرى،
كما فضّح
النقشبنديينَ
القبوريينَ
به. والحمد
لله الذي منّ
على عبده هذا
الْمُسْتَضْعَفِ
وأقرَّ عينهُ
بإخراج هذا
الكتابِ من
ظلمات
الكتمانِ إلى
أنوار العيانِ.
ولا أظنُّ أنّ
هذا
العاَلِمَ
الجليلَ الذي
قدَّمَ خدمةً
عظيمةً
بإعادة النظر
في هذا
الكتابِ
ونبّهَناَ
بتوصياته
الحكيمةِ وأظهر
هذا الكتابَ
بعد أن كانَ
مكتوماً
وصاحِبُهُ
مُضْطَهَداً
مظلوماً، لا
أظنُّهُ مِنْ
أبناءِ
الجزيرةِ العربيّة،
لأنّي أستوحي
ذلك من
خصوصيات اسمه
الكريمِ (لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه)،
إذ ليس من
عادة عرب الجزيرة
تسميتهم بمثل
هذا الاسم،
كما لا
أظنُّهُ مِنَ الوهّابيّين،
بل إنّه من
الْمُحِبِّينَ
للشيح محمّد
بن عبد الوهّاب
وابن تيميّةَ
وأحمد بن حنبل
وعلماء
أمّتنا الصالحينَ
رضي الله عنهم
أجمعين. وقد
يتكشّفُ لي
بمبادرة هذا
الشيخ الفاضل
إلى دراسة
كتابي: أنَّ
الشيوخ الوهّابيّين
ربما
استنكفوا عن
الاهتمامِ
بهذا الكتابِ
وأظهروا
مكابرتهم
مرّةً أخرى
وهي من طبعهم،
فَلَم
يُصْدِرُوا
هذا
التَّقْرِيرَ
بِاسم جَامَعَةِ
أمّ الْقُرىَ
حَتَّى لاَ
يعترفوا بِالْكِتَابِ
رَسْمِيًا،
وَذَلِكَ اسخفافًا
بهذه الخدمةِ
العظيمةِ، فَفَاتَتْهُمْ
فضيلةُ
التوبةِ من
هذا الذنب
العظيمِ، بل
صَدَرَ
التقريرُ بِتَوقِعِ
الفاضل الشيخ (لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه)،
فأطلعني
ربِّي أخيراً
وبعد كلّ هذه
البراهينِ
على حقيقة الوهّابيّين،
والحمد لله
ربّ
العالمينَ!
أماَّ
علاقةُ هذه
النحلةِ
بالشيخ محمّد
بن عبد الوهّاب
وابنِ تيمية
وأحمد بن حنبل
رضي الله عنهم
أجمعين، فلا
تتعدّى عن
زعمٍ لا أساسَ
له من الصحّةِ
إذ أن كلاًّ
من هؤلاءِ
العلماءِ
الفحول قد
أفنىَ عمرَهُ
ونَذَرَ
حياتَهُ في
إرشاد الأمّةِ
إلى الحقِّ
والصوابِ،
والقيام
بدعوة الناسِ
إلى التوحيد
الخالصِ،
ونبذِ البدعِ
والأباطيلِ
والكفريات...
وقد تعرّضوا
لأشكالٍ من الاضطهادِ
والظّلمِ
والقهرِ
والفريةِ؛
فلم تمنعهم
ذلكَ من الصبر
والمقاومةِ
والدفاعِ
وإظهار الجرأةِ
إلى أن نصرهم
الله وجعلهم
من المحبوبين الذينَ
يقتدي بهم
الصالحون من
أبناءِ هذه الأمّةِ
المحمّديّة
الكريمة.
ولهذا لا
أظنُّ أنّ
أحداً من
أبناءِ
أمّتِنا
المتمتّعينَ
بالفراسةِ
يغترّ بالوهّابيّين،
خاصّةً إذا
نَجَحَ هذا
العمل
الهامُّ وتمّ طبعه
ونشره إنْ شاء
الله تعالى وَمَا
ذَلِكَ عَلَى
اللهِ بِعَزِيزٍ!
تتمثّلُ
هذه
التوصياَّتُ
الهامّةُ في
تنبيهٍ عظيمٍ
أوّلاً إلى
جميع الوهّابيّين
والسّلفييّنَ
بجزيرةِ
العربِ، ثمّ
إلى أصحاب
الحميّةِ
والإيمانِ
والاخلاصِ في
كافّةِ
انحاءِ العالم
الإسلاميّ،
وهو: أن
يتحمّلوا
المسؤوليّةَ
في أمرينِ
خطيرينِ:
أوّلهما:
أنّ هذا
الكتابَ
كلّفني ما
لايُطاق مدّة
ثلاثةٍ
وعشرينَ
عاماً ذُقْتُ
فيها مِنْ كلّ
مُرٍّ،
فتعرّضتُ
لأنواعِ
المؤامراتِ:
مِنْ محاولاتِ
اغتيالٍ، ودسِّ
سمومٍ في
طعامي،
ودعاياتٍ
سيِّئَةِ استهدفَتْ
كرامتي
وعِرضيِ وغير
ذلك ما يضيق
المقامُ عن
الاسهاب فيه.
لقد
تَلَبَّسَ
الكثيرُ من الوهّابيّين
بذنبٍ عظيمٍ
حين تعمّدوا
الخزلاَنَ
بموقفهمْ
المتجاهلِ من
مؤلِّفِ هذا
الكتابِ
كلّما التقيتُ
بأحدهم أو
بجماعةٍ من وفودِهم،
ثمّ من
الْكِتَابِ
نفسِهِ إلى
أنْ قيّضَ
الله له مَنْ
تَناَوَلَهُ
بعين الاهتمامِ،
ألا وهو
العالِمُ
المِفضالُ،
الشيخ لطف الله
بن عبد العظيم
حفظه الله
تعالى وجزاه
خيراً كثيراً.
والأمر
الثاني: أنَّ
آلاَفاً من
الكُتُبِ والوثائِقِ
باللّهجة العثمانيّة
وباللّهجة التركيّة
المُعاصرةِ
والمُدّوَّنَةِ
في مختلفِ مسائل
التصوّفِ
والكلامِ
وتراجم
الصوفيةِ، متوفِّرَةٌ
في تركا
ومتداولةٌ في
أيدي الناسِ؛ وَمُعْظَمُ
نُسَخِهَا
موجودةٌ في
خزانتي؛ بينما
البلادُ العربيّة
خاليةٌ منها،
ولا يمكن
الحصولُ على
نسخةٍ واحدةٍ
من هذه الكُتُبِ
الخطيرةِ في
قطرٍ عربيٍّ،
خاصّةً في الجزيرة
العربيّة
ومنطقة
الحجاز. وما
أشدّ حاجة
العلماءِ
والباحثينَ
والمثقّفينَ
العربِ إلى
هذه الكتب والوثائِق.
ولا بدّ من
خبيرٍ أو
جماعةٍ
متخصِّصينَ
من الخُبراءِ
(باللّغتين التركيّة
والعربيّة) أن
يقوموا
بتصنيفِ وترجمةِ
هذه الكتبِ
والوثائِق
حتَّى تظهر
للعيانِ
وتتبلور ما في
بطونِها من
الخطورةِ على
أُمَّتِناَ،
وما كادَ
ينبثِقُ منها
من تشويهٍ
لحقيقةِ
الإسلامِ
ونتائجَ
هدَّامةٍ
وفتنٍ ستتفاقم
في ربوعِ
الآُمّةِ
فتزيد من
الشقاقِ بين
صفوفِها في
أمدٍ غيرِ
بعيد، فتشتدّ
بسببها المصائبُ
التي
تعرَّضَتْ
لها الأمّةُ
في هذه
المرحلةِ
الحساَّسة.
وقد
قمتُ بجمعِ
وترتيبِ ما
يزيد على
أربعِ مجلّداتٍ
ضخمةٍ من
المعلوماتِ
في مسائل
التصوّفِ
والصوفيّةِ
بجميعِ
أطرافِها السياسيّة
والاجتماعيّة
والتاريخيّةِ
والعقديّةِ
والروحيّةِ
والأخلاقيّةِ،
وذلك باللّغة التركيّة.
إنّ هذه
الْمُحَصِّلَةَ
العظيمَةَ من
عصارةِ مآتٍ
من الكُتُبِ،
والعملَ
الجبَّارَ أيضاً
يحتاجُ إلى
التعريب، بل
يحتاجُ إلى
الحفظِ في
مكانٍ أمينٍ
قبل أن تعبث
به أيدي
العسفِ
والغدرِ
بالإبادةِ
والإتلاف!!! وهذه المهمّة
ليست من السهل
طبعاً حيثُ
يحتاج إلى
مكانٍ خاصٍّ
تتوفّر فيه
أجهزةٌ من الحاسب
الآلي
والمشاَّطِ
وآلات
التصوير
والطباعةِ
ومكتبةٍ
مجهّزةٍ
بالموسوعات
والمعاجم...
فإنِّي أقترح
أولاً على الوهّابيّين
والسلفييّنَ
بأنّهم
مسؤولونَ
بالدرجة الأولى
عن تحقيق هذا
الهدفِ
العظيم،
بنقلِ هذه المصادر
إلى البلد
الأمين
وبصورةٍ
عاجلةٍ! وما
على الرسول إلاَّ
البلاغ.
وأمّا
المسائل
المتفرّقة
التي وردت في
نهاية
التقرير، وهي
سبعة عشرة
مسألة؛ فقد
رأيتُ إرجاءَها
إلى حينٍ،
لحاجة النظر
فيها بروّيةٍ
من جديد. بل
الأنسب أنْ
تُعالَجَ في
جلسةٍ أو
جلساتٍ
خاصّةٍ
أحضُرُها مع نخبةٍ
من علماء
الأمّة، ولا
أظنُّ أنّي
أختلف معهم في
نتائجها إنْ
درسناها في
جوٍّ هاديءٍ.
ولربما وجدوا
في مواضع من
الكتاب شيئًا
من الركاكةِ
أو الغموضِ
فأسفر عن بعض
المشاكل
فحالت دونَ
ظهورِ ما
قصدتُ منها
على حقيقته،
والعصمة لله.
أيها
القارئ
الكريم، إنّه
بعد ما تيسّر
لي تقديم هذا
القدرِ من
الإجابةِ على
تقرير جامعة أمّ
القرى، لا
يفوتني أن
أقول مرّة
أخرى، وقد
قلتُ مراراً،
كما ضبطها بعض
الباحثين
والصحفيّين: »كأنّي
خُلِقْتُ
لأُحَارِبَ
التّطرُّفَ
والعنفَ
والباطلَ بكلّ
أشكاله. ولهذا
عاداني كلّ من
عرفني من
أبناءِ الحماقةِ،
وكره لقائي
دجاجلةُ
السّياسةِ
والإعلام،
وسماسرةُ
الدِّين،
حتّى مراسلوا
الصحافة العربيّة
في إسطنبول
وعلى رأسِهم
رَجُلٌ
تونسيٌّ حيَّالٌ
مَكَّارٌ
خَبيِثٌ!
ولكنّي ما
هَادَنْتُ
عدوًّا
للحقّ، ولا
ابتسمتُ
لمنافقٍ
يرائي، بل
فضحتُ أعداءَ
السّلامِ،
واستحقرتُ كلّ
صنمٍ
وأسطورةٍ،
وأبيتُ إلاّ
أن أكونَ
مقرًّا لما
يُقِرُّهُ
العقلُ
السّليمُ
والعلمُ والتّجربة
والكتابُ
العزيز
والسّنّة
المطهّرةُ... «
ثمّ
أقول: »إنّي
قَدّمتُ هذا
البحثَ بين
يدي علماءِ
أمّتِنا
ليرواْ فيها
رأْيَهُمْ؛
وقد تكبّدتُ في
هذه المسيرةِ
ما لا يسهل شَرْحُهُ!
ومتى وجدوا
فيها شيئاً
يُخِلُّ بالموضوعيّةِ
والمنهجيّةِ
في الأسلوبِ،
ويتعارضُ مع
المبادئِ العلميّة
ويخالفُ
الكتابَ
والسُّنَّةَ،
فأنا مستعدٌّ
لإجراءِ
التّعديلِ
اللاّزمِ
عليهِ بكلّ
ودٍّ،
وأشكرهم على
ذلك. وأمّا من
غَرَّتْهُ نفسُهُ
فحالَ دونَ
إخراجِ هذا
العمل - الذي
تحتاج إليه
الأمّةُ في
مثلِ هذه
المرحلةِ
الحسّاسةِ
ليساعد أبناءها
على فهم ما
تُحَاكُ
للعبثِ
بالدّين
الحنيف من خلالِ
منظّمَةٍ
صوفيةٍ
خطيرةٍ
متقمّصةٍ بلباسِ
الزّهدِ
والتّقوىَ -، أو
حالَ دونَ
وصوله إلى
أبناءِ
الأمّةِ بعد تمام
طبعه، نعم،
مَنْ قَصَدَ
هذا عن حظِّ
نفسٍ، فإنّي
أحيلُ
أمْرَهُ إلى
الله العزيزِ
الجبار،
والملكِ
القهّار، أن
يعامله بما
يستحقّه!!!«
كان هذا
موجزًا
للخطوط
العريضةِ
فيما أبلاني
به ربّي
البلاءَ
الحسنَ منذ
عام 1972م. وأنت
أيّها
القارئُ
الكريم، آخر
مَنْ وصَلَهُ
كتابي هذا في
حينٍ قد ضاقت
الأرضُ بما
رحبتْ على
مؤلّفِ هذا الكتابِ
إذ يحيط به حصارٌ
شديدٌ شَارَكَ
في
إِحْكَامِهِ
عديدٌ من فئات
البغي والظلم والعلوّ
والضلالٍ،
بما فيهم
الوهّابيّونَ
الّذين
يتقمّصونَ
بوشاحِ
السلفّيّةِ
كذبًا وزورًا.
ولا أظنُّ أنّ
كلمةً من هذه
العبارات
تتوارى بأدنى
شيءٍ من غموض،
كما لستُ أقصد
بها مصلحةً،
ولا كتبتُها
رياءً ولا
طلبًا لسمعةٍ.
بل تبنّيتُ
هدفينِ في
كلِّ جهودي:
محاربةَ
الشّركِ ومكافحةَ
العُجْمَةِ
في الدّين.
وعسى أن يحقّق
الله فيك آمالي
وأحلامي
فيسهِّلَ
أمري بشيءٍ من
دَعْمِكََ
ومساعدتِكَ، حتّى
أرى هذه الأعمال
مطبوعةً
للمرّة
الثالثة يتداولها
القرّاءُ.
والحمد لله
الّذي وفّق
عبدَهُ
مؤلّفَ
الكتابِ
لإتمامِ هذا
العمل
الهامِّ،
ومكّنه من
جمعِ
مُعْظَمِ
الوثائق
المتعلّقة
بالفرقة
النقشبنديّة،
سِوَى عددٍ
يسيرٍ منها
والكمالُ لله
سبحانه. وأحمده
جلّ سلطانه
على ما أكرمني
بنصره في
مواجهة
صناديد هذه
النحلة بعد أن
وصلتهم
طبعتانِ من
هذا الكتابِ،
وقد أوشكت
طَبْعَتُهُ
الثّالثةُ،
فلم ينبس
أحدهم ببنت
شفةٍ حتّى هذه
اللّحظةِ،
فغلبوا
هنالِكَ
وانقلبوا
صاغرين. وله
الحمد سبحانه
على ما أغناني
عن مؤازرة أيّ
شخصٍ وأيِّ
فئةٍ من
النّاسِ على كَثْرَتِهَا
وَتَظَاهُرِ
بَعْضِهَا بـ»السلفيّةِ
وأنصار
التوحيدِ!« فافتضحتْ بذلك،
الفرقةُ
الوهّابيّةُ
رموزُ الفتنةِ
والهزيمةِ وَخوارجُ
هذا العصر. فَقُطِعَ
دَابِرُ الْقَوْمِ
الَّذِينَ ظَلَمُواْ
وَالْحَمْدُ
لله رَبِّ الْعَالَمِينَ
فريد
صلاح الهاشمي
Feriduddin AYDIN
الاربعاء,
09 جمادى
الآخرة, 1427 هـ.
05 تمّوز-
يوليو 2006م.
أسماء
الأعلام
- أ -
الآلوسي،
أبو الثناء
شهاب الدين
محمود بن عبد
الله ( 1217-1270هـ./1802-1885/
م.) 170، 297.
الآلوسي،
أبو البركات
خير الدين
نعمان بن محمود
( 1252-1317هـ./1836-1899م.)
297
الإسطنبولي،
محمّد أسعد
أفندي.
(1789-1848م.) 62-90.
أبان بن
عبد الحميد بن
لاحق بن عفير
الرقاشي (149-193
هـ./766-809 م.) 23.
إبراهيم
النبي عليه
السلام.
107، 247.
إبراهيم
البياريّ. 271
إبراهيم
بن أبي المجد
بن قريش بن
محمّد الحسيني
الدسوقي (633-676
هـ./1235-1277 م.) 92، 440،
إبراهيم
الشاشي. 238
إبراهيم
الفصيح (1820-1882م.) 104، 151،
إبن
آجرّوم، محمّد
بن محمّد بن
داود
الصنهاجي
الفاسي، (627-723
هـ./1273-1323 م.) 352.
إبن
الأثير، عزّ
الدين أبو
الحسن علي بن
أبي الكرم
الشيبانيّ (555-630
هـ./1160-1233 م.) 15، 212.
إبن
تيميّة، أبو
العباس تقي
الدين أحمد بن
عبد الحليم
الدمشقي
الحنبلي
الحرّاني، (661-728
هـ./1263-1228 م.) 203، 394، 439، 467.
إبن
الجوزي،
أبوالفرج عبد
الرحمن بن علي
بن محمّد (510-597
هـ./1116-1201 م.) 9، 409.
إبن
حجر، شهاب
الدين أبو
العباس أحمد
بن محمّد
الهيتني (909-973
هـ./1503-1566 م.) .177
إبن
حجر، أبو
الفضل أحمد بن
علي بن محمّد
العسقلانيّ (773-852
هـ./1372-1449 م.) 205.
إبن
خلّكان، أبو
العبّاس شمس
الدين أحمد بن
محمّد بن أبي
بكر. (608-681
هـ./1211-1282 م.) 22، 205.
إبن
سعد، محمّد بن
سعد بن منيع
الزهري. (168-230
هـ./784-845 م.) 205.
إبن
عباس، عبد
الله بن عبد
المطلب
الهاشميّ القرشيّ
الصحابيّ (ت
688م.) 84، 85، 143، 204.
إبن
عابدين،
محمّد أمين بن
عمر بن عبد
العزيز. (1198-1252 هـ./1784-1836 م.) 28، 75، 308،415.
ابن
عربي، محي
الدين بن
محمّد بن علي
بن محمّد بن
أحمد الطاءيّ
الحاتمي
المرسيّ. (560-638
هـ./1160-1240 م.) 150، 152، 153، 155،
156، 158، 161، 162، 394، 396، 397، 440،
441.
ابن
العماد عبد
الحي بن أحمد
بن محمّد بن
عماد العكري
الدّمشقي
الحنبلي. (1032-1089
هـ./16231679 م.) 205، 212، 215.
إبن
كثير، أبو الفداء
إسماعيل بن
عمر القرشي. (700-774
هـ./1301-1373 م.) 15، 85، 118، 162، 163،
208.
ابن
المبارك، عبد
الله المروزيّ.
(118-181 هـ./736-797 م.) 22،
462.
إبن
مسعود/ راجع ع:
عبد الله ابن
مسعود.
82، 84، 86، 205.
ابن
المثنّى، أبي
عبيدة معمّر. (110-209
هـ./728-824 م.) 23،
ابن
المقفّع، عبد
الله. (109-145
هـ./727-762 م.) 23.
إبن
وكيع. 80، 462.
أبو بكر
البغدادي.
314.
أبو بكر
بن عبد الرحمن
بن الحرث بن
هشام، أحد الفقهاء
السبعة.
205.
أبو بكر
الصّدّيق
(الخليفة
الراشد). (ت.
13 هـ./634 م.) 25، 70، 191، (191-210)،
402، 403.
أبو
جعفر محمّد بن
جرير الطبري/
راجع: الطبري.
أبو
الحسن علي بن
أبي جعفر
الخرقاني. (ت.
425 هـ./1034 م.) 174، 175، 191، 196، 211،،
212.
أبو
الحسن
النّدوي،
فاضل هندي
معاصر. 55،
56، 150، 245، 248، 249، 251، 253، 254،
257، 267، 274.
أبو
حنيفة، نعمان
بن ثابت
الكوفي
الإمام. (80-150
هـ./699-767 م.) 357.
أبو
السعود،
محمّد بن
محمّد بن
مصطفى العمادي،
شيخ الإسلام
في عهد سليمان
القانوني. (898-982
هـ./1493-1574 م.) 87، 327.
أبو
سعيد، أحمد بن
عيسى الصوفي
الخرّاز. (ت.
286 هـ./899 م.) 155، 397.
أبو
سعيد عثما
الجليلي
الموصلي. 279،
280، 296.
أبو
عبيدة معمّر
بن المثنّى. (110-209
هـ./728-824 م.) 23.
أبو
محمّد جمال
الدين عبد
الله بن يوسف
بن أحمد بن
عبد الله بن
هشام
الأنصاري. (708-761
هـ./1309-1360 م.) 205، 342، 352.
أبو منه،
بطرس، باحث
عربي معاصر/
راجع: مقدّمة
المؤلّف.
4.
أبو نوّاس
الحسن بن هناء
بن عبد الأوّل
بن صباح. (145-196
هـ./762-812 م.) 23.
أبو الْعَتَاهِيَة
إسماعيل بن
قاسم بن سويد
بن كيسان. (130-211
هـ./748-826 م.) 23.
أبو علي
السنديّ. 207.
أبو علي
الفارمديّ (ت.
478 هـ./1085 م.) 101، 191، 196، 212، 213.
أبو
الفرج، عبد
الرحمن ابن
الجوزي/ راجع:
ابن الجوزي.
9، 209، 409.
أبو
الفضل، بن عبد
الله
القُنوي. 157.
أبو
الفيض
المنوفي/
راجع: محمود
أبو الفيض
المنوفي.
21، 22، 136.
أبو
القاسم، جار
الله محمود بن
عمر الزمخشري/
راجع:
الزمخشري.
80، 90.
أبو
نعيم أحمد بن
عبد الله بن
أحمد بن إسحاق
الإصفهاني. (336-430
هـ./948-1038 م.) 205، 207، 209.
أبو
يزيد السطامي/
راجع
البسطامي.
أبو يعقوب
يوسف
الهمداني/
راحع:
الهمداني.
الأحرار/
راجع: عبيد
الله الأحرار.
أحمد
آقجندوز،
باحث تركي
معاصر.
385.
أحمد
الأربلي
الخطيب. 314.
أحمد
الآرواسي. 389،
390.
أحمد
الأغربوزي. 314.
أحمد
البدوي/ راجع:
أحمد
البُخَاريّ. 34.
أحمد
البرزنحي. 314.
أحمد
البقاعي. 43،
57، 127، 147، 176، 397.
أحمد بن
حنبل. (164-241
هـ./78/0-855 م.) 203، 212، 472، 473.
أحمد بن
زيني دحلان. (1231-1304
هـ./1816-1886 م.) 375.
أحمد بن
سعيد
المجدّدي.
104.
أحمد بن
سليمان
الأروادي. (مات
في حدود 1275 هـ./1885 م.)
104، 314، 320.
أحمد
بن عبد الرحيم
بن وجيه الدين
/ راحع: شاه ولي
الله الدهلوي.
أحمد
الخزنوي: 386.
أحمد
شاه الدراني.
270.
أحمد
شاه عزيز
الدين عَلَمْگِير. (ت
1759م.) 262، 268.
أحمد
ضياء الدّين
الْگُمُوشْخَانَوِيّ.
(1227-1311 هـ./1812-1893
م.) 43، 67، 94، 95، 104، 106، 120،
127، 136، 181، 320، 327، 382.
أحمد
فاروق ميان.
43
أحمد
الفاروقي
السرهندي
المعروف
بالإمام
الرباني/
راجع:
السرهندي.
أحمد
القسطموني. 314.
أحمد
مكّي أفندي بن
عبد الحكيم
الأرواسي.
383.
أحمد
ولي الله/
راجع : شاه ولي
الله الدهلوي.
أحمد
ياشار أوجاك
(أستاذ في
جامعة حاجت
تبه في أنفره). 14،
216، 447.
أدهم
جبه جي أوغلو.
باحث معاضر
تركي. 149.
الأربلي،
محمّد أمين
الكردي/ راجع:
الكردي.
أريج
فروم. 57.
أسعد
الأربلي.
(ت. 1848-1931م.) 105، (332-335)، 375.
أسعد
الصاحب. (1271-1347
هـ./1855-1928 م.). 9، 282، (295-316)، 401
أسعد
الخسخيري. 379.
أسعد
السمحراني
(باحث عربي
معاصر). 429.
إسماعيل
الأناراني.
314.
إسماعيل
البرزنجي.
314.
إسماعيل
البصري.
314.
إسماعيل
حقّي أهرامجي.
380.
إسماعيل
الزلزلوي. 314.
إسماعيل
الشيرواني. 76،
(310-314).
أشرف
الكابلي/
راجع:
الكابلي.
أفلطون
(الفيلسوف
اليوناني ق.م.
148.
أكبر
شاه، جلال
الدين محمود
بن همايون بن
ظهير الدين بن
بابر شاه. (1542-1605
م.) (243-258).
أكرم
إيشن. 33، 332.
أكمل
الدين
البابرتي. (710-786
هـ./1310-1384 م.) 90.
إلياس
أيوب (باحث
صيدلي عربي
معاصر). (57-68).
الإمام
الربّانيّ/
راجع:
السرهندي.
الإمام
الزهبي/ راحع:
الزهبي.
الإمام
الشافعي/
راجع:
الشافعي.
الإمام
الهروي/ راجع
الهروي.
الأﻣﮑﻨﮕﻲ،
محمّد
الخواﺟﮕﻲ. (918-1008
هـ./1512-1599 م.). (192-196)، (237-244)
أمين
القدسي.
157.
أنس بن
مالك. (612-712م.)
78.
الأنصاري،
أبو يحيى
زكريا بن
محمّد بن أحمد
السنيكي.
(826-926 هـ./1423-1520 م.) 9.
الأنصاري
القادري،
بهاء الدين. 55،
254.
أنور
الجندي (باحث
كاتب عربي
معاص). 18.
أورنكزيب
علمكير بن
شهاب الدين
محمّد شاه جهان.
(1618-1707م.) 262، 268.
أويس بن
عامر بن جزء
بن مالك
القرنيّ
التابعيّ
الزاهد. (ت.
37هـ/657م.) 174، 209.
-
ب -
باتانجالي
Patanjaliالراهب
الهندي. 117.
بارمينيديس
(الفيلسوف
اليوناني ت.
حوالى
(540-450ق.م.) 148.
الباقلاني،
محمّدد أبو
بكر بن
الطيّب. (338-403 هـ./9501013 م.) 115، 144.
الباقي
بالله
الكابولي/
راجع: محمّد
الباقي بالله
الكابولي.
البخاريّ،
محمّد بهاء
الدين/ راجع:
شاه نقشبند.
البدخشي،
محمّد زاهد. (ت. 936 هـ./1529 م.) 192، 241، 242.
بدرخان
باشا، آخر
أمير كردستان. (1802-1868م.) 285.
بدر
الدين بابا. 34.
البدواني/
راجع: نور
محمّد
البدواني.
البرزنجي،
معروف
النودهي. (1166-1254 هـ./1752-1838 م.) 57، (277-314)،
422.
ب. ريال. 57، 58.
البزدويّ،
عليّ بن محمّد
بن الحسين. (400-482 هـ./1010-1089 م.) 19.
البسطامي،
أبو يزيد
طيفور بن عيسى
بن آدم بن سروشان. (188-261 هـ./803-874 م) 174، 175، 191،
196، 201، (207-211)
بشر
الحافي، أبو
نصر بشر بن
الحارث بن عليّ
بن عبد الرحمن
المروزيّ الحافي. (150-227 هـ./767-841 م) 22.
البغداديّ،
أبو البهاء
خالد ضياء
الدين ذو الجناحين
(1193-1242 هـ./1776-1876 م.) (270-320)
البغداديّ،
محمّد بن
سليمان
البغداديّ/
راجع: محمّد
بن سليمان.
البلاذري،
أحمد بن يحيى
بن جابر بن
داود. (ت. 279-
هـ./892 م.) 15، 231.
بلوتينوس
(الفيلسوف
اليوناني. (205-270 م.) 148.
بهادر
شاه، آخر
الملوك
التيموريّين. (1221-1278 هـ.) 268.
بوذا
الراهب،
سيدهارتا
غوتاما (مؤسّس
الديانة
البوذية،
حوالى (563-483 ق.م.) 53، 119، 120، 265، 386،
441، 460.
البيضاوي،
أبو سعيد ناصر
الدين عبد الله
بن عمر. (ت. 685 هـ./1286 م.) 182، 183.
البيهقيّ،
علي بن الحسين
الواعظ
الكاشفي. (1462-1533م.)، 55، 56، 70، 101، 113،
236، 239، 240، 435.
-
ت -
تاج
الدين بن
زكريّا بن
سلطان
الهنديّ. (ت. 1050 هـ./1640 م.) 71، 157، 451.
تاج
الدين عبد
الوهّاب بن
علي السبكي. (727-771 هـ./1327-1370 م.) 212، 344.
ترغوت
أوزال، رئيس
الجمهورية
التركية السابق.
(ت. 1993م.) 382، 388، 471
الترمزي
الحكيم،
محمّد بن علي
بن الحسين. (كان حيًا في 318
هـ./930 م.) 216.
التسْتَرِيّ،
أبو محمّد سهل
بن عبد الله
بن يونس بن
عيسى. (200-283
هـ./815-896 م.) 22.
التفتازانيّ،
مسعود بن عمر
بن عبد الله. (712-791 هـ./1312-1389 م.) (341-343).
التلمساني،
سليمان بن علي
بن عبد الله.(ت. 690 هـ.) 128، 148، 155، 440.
تيمورلنك.
(1336-1405م.) 225، 238، 258.
-
ث -
الثوريّ،
أبو عبد الله
سفيان بن سعيد
بن مسروق
الكوفي. (97-161 هـ./716-778 م.) 22، 85.
-
ج -
ج.
توندريو. 57، 58، 68.
الجامي،
ملاّ عبد
الرحمن نور
الدين.
(819-898 هـ./1414-1492 م.) 33،
233، 239، 342، 343.
جان
جانان/ راجع: شمس
الدين حبيب
الله ميرزا
مظهر.
الجرجاني/
راجع: السيد
شريف
الجرجاني.
اﻟﭽﺮخِيّ / راجع:
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ.
جعفر
الخلديّ. (252-348 هـ./866-959 م.) 197، 198.
جعفر
الصادق بن
محمّد الباقر
بن علي زين
العابدين بن
الحسين السبط.
(80-148 هـ./699-765 م.) 175،
191، 196، 206، 207، 209.
الجليليّ،
أبو سعيد
عثمان بن
سليمان بن
محمّد أمين بن
حسين بن
إسماعيل بن
عبد الجليل
الحيائي
الموصلي. (1187-1245 هـ./1773-1829 م.) 279، 280، 296،
301.
الجليليّ،
سليمان باشا. 279، 284، 295، 296.
الجنبوري،
علي بن قوّام. 55.
جنيد
البغداديّ،
أبو القاسم بن
محمّد بن الجنيد
القواريري
الخزّار. (ت. 298 هـ./910 م.) 92، 440.
-
ح -
الحاج
حمدي
الدّاغستانيّ.
309.
حاجي
خليفة، مصطفى
بن عبد الله. (1017-1067 هـ./16091657 م.) 236.
الحافيّ/
راجع: بشر بن
الحارث.
حالت
أفندي (من
كبار رجال
الدولة
العثمانيّة في
عهد محمود
الثاني. 1760-1823م.) 284.
حامد
المارديني. 321، 326، 379، 395.
الحسن
بن علي بن أبي
طالب. (3-50
هـ./624-670 م.)
حسن
القوزاني. 314.
حسن
حلمي
القسطموني. 95.
حسن
حلمي بن علي. 95.
الحسين
بن علي بن أبي
طالب. (ت.61
هـ./680 م.) 224، 331، 389.
حسين بن
علي بن هود. (ت. 699هـ.) 128.
حسين بن
علي، نظام
الملك/ راجع:
نظام الملك.
حسين
حسام الدين عبديزاده
أفندي. 32.
حسين
حلمي إيشيك
(عقيد متقاعد
مدسوس في صفوف
النقشبنديين.
مات يوم 25
أكتوبر 2001
في إسطنبول). 65، 331، 355، 380، 383، 447، 459.
حسين
الدوسري. (91-93)، 314، 424.
حسين
علي نوري بن
عباس بن بزرك
المازندراني،
زعيم
البهائية. (1233-1309 هـ./1817-1892 م.) 429.
حكيم
آتا. 27.
الحلاّج،
حسين بن منصور. (ت.309 هـ./922 م.) 18، 128، (148-154)،
293.
حميد
آلغار: راجع:
مقدّمة
المؤلّف. 4.
حمد
الله
الداجويّ. 165، 170، 176، 181.
حيدر
بابا. 32.
-
خ -
خالد
البغداديّ/
راحع:
البغداديّ.
خالد
الجزري. 314، 326، 395.
خالد الزيباري. 379، 395.
خالد
الزيلاني. 379.
خارجة
بن زيد بن
ثابت
الأنصاري،
أحد الفقهاء السبعة.
(ت. 99 هـ./717م.) 205.
الخازن،
علاء الدين
علي بن محمّد
بن إبراهيم الشحي.
(678-741 هـ./1279-1340 م.) 84،
85.
الخانيّ،
عبد المجيد بن
محمّد بن
محمّد (1263-1319 هـ./1847-1901 م.). مبعثر
في كثير من
صفحات الكتاب.
الخانيّ،
محمّد بن عبد
الله (1213-1279
هـ./1798-1862 م.). 29، 41، 65، 103، 111،
121، 177، 215، 277، (314-319)، 404، 408،
421.
خرشيد
باشا. (ت. 1822م.).
284.
الخرقاني/
راجع: أبو
الحسن علي بن
أبي جعفر.
الخضر/
راجع: أسطورة
الخضر في
قائمة
المفاهيم.
الخلدي/
راجع: جعفر
الخلدي.
خليل
آتا. 232
خليل
فوزي. 333.
خليل
كوننج، فقيه
عربي الأصل،
تركي الوطن. 393.
خواجه
أشرف الكابلي.
70.
خواجهء
عزيزان/ راجع:
الرامتني.
خير
الدين زركلي/
راجع زركلي.
-
د -
داماد
فريد باشا. (1853-1922م.) 324.
داود
باشا، والي
بغداد. (1774-1851م.) 284، 285.
درويش
أحمد
الطربزوني.
درويش
محمّد (كش
مهمد)،
الحشّاش الذي
استخدمته
الحكومةُ
عميلاً
لتنفيذ خطّةٍ
في مدينة منامن
التابعة
لولاية
إزمير.نُفِذَ
فيه حكم الإعدام
مع زميله لاز
إبراهيم
خواجه سنة (1930م.) 374.
درويش
محمّد
السمرقندي/
راجع:
السمرقندي. 192، 242.
الدهلوي،
شاه ولي الله/
راجع شاه ولي
الله.
الدهلويّ،
غلام علي عبد
الله. (1158-1240
هـ./1745-1824 م.) 43، 53، 158، 192، (267-275)،
402
الدوسري/
راجع: حسين
الدوسري.
الدمشقيه،
عبد الرحمن :
راجع: مقدّمة
المؤلّف. 4.
ديفيد
دين كومينس David Dean Commins. 98.
-
ذ -
الذهبيّ
محمّد بن أحمد
بن عثمان بن
قايماز التركمانيّ
الحافظ. (673-748 هـ./1274-1348 م.) 207، 208، 209.
-
ر -
رابعة
العدوية. 138.
رادلوف،
فريديريك
ولهلم. Friedrich Wilhelm Radlof (1837-1918م.) 15.
الرازي،
فخر الدين
محمّد بن عمر
بن الحسين
الّتيميّ
البكريّ. (543-606 هـ./1149-1210 م.) 19، 80، 81،
342، 438.
رحمي
سرين. 43، 48،
56، 106، 108، 113، 120، 399.
رشاد أونْـﮕﻮران،
باحث تركي
معاصر. 32.
الرقّاشي،
أبّان بن عبد
الحميد بن
لاحق بن عفير (
هـ.؟/ م.؟) أديب
شاعر عاصر الرشيد
العباسيّ. 23.
ركن
الدين محمود
البُخَاريّ. 32.
الرِّيوَگَرِي/
راجع: عارف
الرِّيوَگَرِي.
-
ز -
زركلي،
خير الدين. (1310-1396 هـ./1893-1976
م.) 22، 138، 174، 189، 207، 215، 234،
239، 244، 246، 248.
زاهد
الكوثري/
راجع: محمّد
زاهد بن الحسن
بن علي الكوثري
اﻟﭽﺮكسي.
الزمخشري،
أبو القاسم
جار الله
محمود بن عمر. (467-538 هـ./1075-1144 م.) 80، 90.
زنون،
الفيلسوف
اليواني. (335-263ق.م.) 148.
-
س -
السرخسي،
شمس الأئمة،
محمّد بن أحكد
بن أبي بكر. (ت. 490 هـ./1097 م.) 19.
السرهندي،
أحمد
الفاروقي
العروف
بالإمام الرباني
(971-1034 هـ./1563-1625 م.) 43،
70، 102، 158، 159، 180، 182، 192، (237-285)،
462.
سعيد
باشا، والي
بغداد. 278، 290، 294، 295.
سعيد
اﻟﭙﺎلوي. (ت. 1925م.) 323، 328، 331، 350، 351،
370.
سعيد بن
المسيّب، أحد
الفقاء
السبعة. (ت. 94 هـ./712 م.) 205.
سعيد
سيدا الجزري. (1889-1968م.) (96-99)، 379.
سعيد
الكردي
النورسي. (1873-1960م.) 347-378-379-384.
سفيان
الثوري/ راجع:
الثوري.
السقَطيّ،
أبو الحسن
سَرِيّ ابن
المغلِّس. (ت. 251 هـ./865 م.) 22.
سلجوق
أرايدين،
باحث تركي
معاضر. 147، 159.
السلطان
بايزيد
الأول، يلدرم
بن مراد،
السلطان
العثماني. (1347-1402م.) 238.
السلطان
بايزيد
الثاني، صوفي
بايزيد الولي
بن محمّد
الفاتح. (1448-1512م.) 32، 33، 34، 95، 96.
السلطان
تيبو، قائد
عسكري هندي. (1749-1799م.) 368.
السلطان
سليمان
القانوني بن
سليم الأوّل. (1494-1566م.) 32.
السلطان
عبد الحميد
الثاني بن عبد
المجيد. (1842-1918م.) 150، 322، 327، 332، 334،
370.
السلطان
مراد الثالث
بن سليم
الثاني. (1546-1595م.) 101.
السلطان
محمّد الفاتح
بن مراد
الثاني.
(1432-1481م.)
(32-34)
السلطان
محمو الثاني
بن عبد الحميد
الأوّل. (1784-1839م.) 37، 168، 284، 338، 362.
السلطان
وحيد الدين بن
عبد المجيد. (1861-1926م.) 324.
سلمان
الفارسي. (ت. 656م.) (191-205)، 403.
سليمان
بن يسار، أحد
الفقاء
السبعة. (34-107 هـ./654-725 م.) 205.
سليمان
زهدي. 93، 103،
127، 423، 424.
سليمان
حلمي
طوناخان،
تُنسَبُ إليه
الفرقة السليمانية
وهم طائفة من
النقشبنديّين. (1888-1959م.) 75، 379، 384، 385، 417،
444.
السماسي/
راجع: محمّد
بابا السماسي. 192، 196، 223.
السمرقندي،
درويش محمّد. (ت. 936 هـ./1529 م.) 192، 196، 242.
السهروردي،
شهاب الدين
أبو الحفص عمر
بن محمّد بن
عبد الله ابن
عمويه. (539-632 هـ./1145-1234 م.) 90.
سهل بن
عبد الله بن
يونس بن عيسى
التستري. (200-283 هـ./815-896 م.) 22.
سميح
عاطف الزين،
باحث عربي
معاصر. 9، 18، 125، 163، 216، 293.
السني،
أبو بكر أحمد
بن محمّد بن
إسحاق. (ت. 364 هـ./975 م.) 112.
السويدي/
راجع محمّد
أمين بن علي. 278، 279، 295، 296.
السيد
شريف
الجرجاني. (740-816 هـ./1339-1413 م.)
السيد
علي بن صبغة
الله
الحيزاني
الأرواسي، نُفِذَ
فيه حكم
الإعدام سنة 1913م. 329.
السيد
فهيم
الأرواسي. (1825-1895م.) 330.
سيف
الدين
الفاروقي/
راجع:
الفاروقي.
السيوطي،
جلال الدين
عبد الرحمن بن
أبي بكر. (849-911 هـ./1445-1505 م.) 87، 88، 90،
153، 342.
-
ش -
الشاذلي،
أبو الحسن علي
بن عبد الله
بن عبد الجبار
بن يوسف بن
هرمز المغربي. (591-656 هـ./1195-1258 م.) 96، 436.
الشافعي،
محمّد بن
إدريس. (150-204 هـ./767-819 م.) 187، 214، 340، 409، 410.
شاه
رؤوف أحمد. 267.
شاه
عالم محمّد
أكبر الثاني. (ت. 1172-1221م.) 268.
شاه
عباس الصفوي/
راجع: الصفوي.
شاه
نقشبند/ محمّد
بهاء الدين
البخاري. (718-791 هـ./1318-1389 م.) 32، 174، 179،
192، 217، 226، 228، 462، 463.
شاه ولي
الله
الدهلوي،
أحمد بن عبد
الرحيم.
(1114-1176 هـ./1704-1766 م.) 45، 46، 244، 270،
299، 300، 301.
شريف
أحمد بن علي. 56، 102، 181.
الشريف
الجرجاني/
راجع: السيد
شريف
الجرجاني.
شريف
ماردين: راجع:
مقدّمة
المؤلّف. 4.
الشعراني/
راجع عبد
الوهّاب
الشعراني.
شمس
الأئمة/ راجع
السرخسي.
شمس
الدين حبيب
الله ميرزا
مظهر جان
جانان. (1111-1195 هـ./1699-1781 م.) 53، 192، 264،
265، 266.
شمس
الدين سامي. (1850-1904م.) 207.
شهاب
الدين
الشيرواني. 235.
شهاب
الدين بن صبغة
الله
الأرواسي.
نُفِذَ فيه
حكم الإعدام
سنة 1913م. 323،
325، 398.
شهاب
الدين محمود
بن عبد الله
الآلوسي/ راجع
الآلوسي.
الشطّاري،
عبد الله. 55، 254.
الشطّاري،
محمّد. 55، 254.
الشيباني،
ابن الأثير عزّ
الدين أبو الحسن
على بن أبي
الكرم. (555-630 هـ./1160-1233 م.) 15، 212.
الشيخ
شادي. 180.
الشيرازي،آية
الله ناصر
مكارم. من
علماء الشيعة
المعاصرين. 88.
-
ص -
صادق الحلوائي. 243.
صالح
باشا. 284.
صالح
السِّيبْكِي. 326.
صبغة
الله
الحيزاني
الآرواسي. (ت.1870م.) 323، 324، 325، 329، 395.
صتُوك
بُوغْراخان. (959م.) 12.
صدر
الدين
البخاري. 216.
صدر
الدين
القنوي،
محمّد بن
إسحاق. (ت. 672 هـ./1273 م.) 152.
الصفوي،
شاه عباس
الكبير، شاه
إيران. (1571-1629م.) 258، 357.
صلاح
الدين بن
السيد علي بن
صبغة الله
الحيزاني
الأرواسي. 329.
-
ط -
طاهر
العقري. 314.
عبد
الرحمن
الكردي
العقري. 314.
طه
الحريري. 105، 333.
النهري
الهكّاري/
راجع:
الهكّاري.
الطبري،
أبو جعفر
محمّد بن جرير. (224-310 هـ./839-923 م.) 15، 79، 80.
الطبقجلي،
محمّد أمين بن
محمّد صالح. (1173-1232 هـ./1760-1816 م.) 295.
الطويلي،
عمر بن عثمان. 314.
-
ع -
عابد
شلبي. 34.
عارف
الرِّيوَگَرِي. (ت. 606هـ./1209م.) 191، 196، 218.
العامري،
مُرَارَةُ بن
الربيع. 79.
عباس
الصفوي/ راجع:
الصفوي.
عباس
العزّاوي. (ت. 1971م.) 97، 102، 104، 193، 277،
283، 285، 294، 295، 296، 308، 309، 394.
عبد
الباقي بن
محمّد
الكفروي. 326، 398.
عبد
الجميل.
216.
عبد
الحكيم
الأرواسي. (1865-1943م.) 95، 96، 328، 330، 331،
355، 375، 383، 389.
عبد
الحميد
البريفكاني. 333.
عبد
الحي بن أحمد
بن محمّد بن
العماد
العكري الحنبلي. 212.
عبد
الخالق الْغُجْدُوَانِيّ. (ت. 575 هـ./1179 م.) 113، 127، 174،
191، 196، 210، 215، 217، 218، 231.
عبد
الرحمن
الدمشقيه،
باحث عربي
معاصر/ راجع: مقدمة
المؤلّف.
عبد
الرحمن خان. 243.
عبد
الرحمن عبد الخالق،
باحث عربي
معاصر. 155، 156، 397.
عبد
الرحمن
الوكيل، باحث
عربي معاصر. 9، 155، 156.
عبد
الرحيم
البرزنجي. 270.
عبد
العزيز بن شاه
ولي الله
الدهلوي. (1159-1239 هـ./1746-1824 م.) 244.
عبد
الغفور
الكردي
الكركوكي. 314.
عبد
الغفور
المشاهدي. 314.
عبد
الغني النابلسي. (1050-1143 هـ./1641-1731 م.) 153، 420.
عبد
القادر
البرزنجي. 314.
عبد
القادر بن
حبيب الله
السندي، باحث
مستعرب معاصر. 9، 207، 208.
عبد
القادر بن
شيبة الحمد،
باحث عربي
معاصر. 124.
عبد
القادر بن
عبيد الله بن
طه النهري. (1850-1925م.) 322، 323، 324.
عبد القادر
الديملاني. 314.
عبد
القادر
الجزائري. (1807-1883م.) 319.
عبد
القادر
الجيلي أو
الجيلاني. (470-561 هـ./1077-1166 م.) 214.
عبد
القادر
الحيدري. 282، 355.
عبد القهّار
الذوقيدي. 380.
عبد
الكريم
البرزنجي. 270.
عبد
الكريم
البياري
المدرّس. 282، 310، 312، 402، 411.
عبد
الكريم
الجيلي. (1365-1428م.) 128، 148.
عبد
الهادي بن
محمّد
الكفروي. 326.
عبد
الوهّاب
الشعراني. (898-973 هـ./1493-1565 م.) 153.
عبد
الوهّاب
السوسي. 76، (302-309)، (401-435).
عبد الله
الأرزنجاني. 324.
عبد
الله الإلهي
(ملاّ إلهي). (ت. 1487م.). 32.
عبد
الله باشا
(حاكم عكّا). 402، 403.
عبد
الله بن أسعد
اليافعي
اليمني
المكّي. (700-768 هـ./1301-1367 م.). 209.
عبد
الله ابن
المبارك
المروزي. (118-181 هـ./736797 م.). 22، 462.
عبد
الله ابن
مسعود. (653م.). 82، 84، 86، 205.
عبد
الله ابن
المقفع. (109-145 هـ./727-762 م.). 23.
عبد
الله الجلي،
من خلفاء خالد
البغدادي. 314.
عبد
الله الخالدي
المخزومي،
والد الشيخ
سليمان
الخالدي
الأسعردي
الشهير
بتصانيفه. 380.
عبد
الله
الخرباني. 270.
عبد
الله
الشطّاري. 55، 254.
عبد
الله الفردي. 314.
عبد
الله المكّي،
من خلفاء خالد
البغدادي. 103.
عبد
الله الهروي،
من خلفاء خالد
البغدادي. 314.
عبد
الفتّاح
الكردي
العقري. (ت. 1860م.). 307.
عبدالمجيد
بن محمّد بن
محمّد الخاني/
راجع: الخاني.
عبيد
الله ناصر
الدين
الأحرار. (ت. 895 هـ./1490 م.). 23، 35، (70-74)،
(101-246).
عبيد
الله بن عبد
الله بن عتبة
بن مسعود
الهزلي، أحد
الفقهاء
السبعة. 205.
عبيد
الله بن طه
النهري. (ت. 1888م.). 205، 323، 324.
عبيد
الله الحيدري. 295، 314.
عثمان
بن عفّان. (ت. 35 هـ./656 م.). 21.
عثمان
الطويلي/
راجع:
الطويلي.
عدنان
مَنْدَرِيس
(رئيس وزراء
تركيا الأسبق (1899-1961م.). (376-390).
عرفان
جندوز. 96، 100، 104، 106، 333.
عروة بن
الزبير بن
العوّام
الأسدي، أحد
الفقهاء
السبعة (22-93 هـ./643-712 م.). 205.
عصمت
غريب الله. 103.
علاء
الدين
العطّار. (ت. 802 هـ./1400 م.). 192، 233، 234،
235.
علي
أفندي
أُرْﮔُﱯ. 283.
علي
باشا تبه
دلنلي. 284.
علي بن
أبي طالب. (23ق. هـ. 40هـ./600-661 م.). 21،
203، 224، 231، 266، 321، 324.
علي بن
حسين الواعظ
الكاشف
البيهقي. (1462-1533م.). 55، 56، 70، 101، 215، 236،
238، 435.
علي بن
قوام
الجنبوري. 55.
علي
الرامتني،
خواجهء
عزيزان. (ت. 721 أو 728 هـ.). 192، 196،
221، 222.
علي
شربجي، محقق
عربي معاصر. 52.
علي بن
سلطان الهروي
القاري. (ت. 1014 هـ./1606 م.).149، 157، 177،.
علي
قدري. 106، 108،
113، 120، 399.
علي
القدسي. 157.
علي
محمّد البلخي. 103.
علي
نائلي. 104.
عمر أُونْگَُوتْ،
متشيّخ
نقشبنديّ
معاصر. 333، 384،
387، 417، 418، 471.
عمر بن
الخطّاب. (40 ق. هـ. 23 هـ./584-644 م.). 174.
عمر بن
الفارض. (576-632 هـ./1181-1235 م.). 138، 149.
عمر
دميرجان،
باحث تركي
معاصر. 41.
عمر
فاروق أفندي،
نحل الشيخ
سعيد شيدا
الجزري. 98.
عمر
فريد كام. (1864-1944م.). 149.
عيسى
عليه السلام. 84، 108، 133، 247.
-
غ -
الغزالي
حجة الإسلام
محمّد بن
محمّد. (450-505 هـ./1058-1111 م.). 90، 101، 212،
313، 352.
غلام
علي عبد الله
الدهلوي/
راجع:
الدهلوي.
-
ف -
الفاروقي،
محمّد
المعصوم. (1007-1079 هـ./1599-1668 م.). 196، 261، 262، 276.
الفاروقي
سيف الدين. (1049-1098 هـ./16301696 م.) 192، 197، 262،
263، 264.
فؤاد
كوبرولو. (1890-1966م.). 41، 214، 337.
فتح
الله
الورقانسي. 380.
فخر
الدين بن
محمّد الحزين
الفرسافي
الحسني الهاشمي. (ت. 1914م.). 407.
فخر
الدين الرازي/
راجع الرازي.
فريد
الدين
العطّار. (ت. 627 هـ./1230م.). 128، 148، 156.
فريديريك
ويلهلم
رادلوف/ راجع:
رادلوف.
الفضيل
ابن عياض بن
مسعود
التميميّ
اليربوعيّ. (105-187 هـ./723-803 م.)
الفيروزآبادي،
أبو طاهر مجد
الدين محمّد
بن يعقوب بن
محمّد بن
إبراهيم
الشيرازي. (729-817 هـ./1329-1414 م.). 86.
-
ق -
القازاني،
محمّد مراد بن
عبد الله،
معرِّب
الرشحات ومكتوبات
الربّاني. (ت. 1352- هـ./1933 م.). (246-250).
قاسم
آتاج، عميل
يهود سالونيك
الذي دسّته الحكومة
التركية في
صفوف الثوّار
النقشبنديّين
عام 1925م. 370.
قاسم بن
محمّد بن أبي
بكر
الصّدّيق،
أحد الفقهاء
السبعة. (31-106 هـ./653-721 م.). 95، 205، 206،
403.
قاسم
النوري، محقق
عربي معاصر. 52.
قاضي
عياض بن موسى
اليحصبي
السبتي
المالكي. (496-544 هـ./1103-1149 م.). 151.
القرّاب/
راجع: الهروي.
القرطبي،
محمّد بن أحمد
بن أبي بكر بن
فرح الأنصاري
الخزرجي. (ت. 671 هـ./1273 م.). 82.
قسيم
السنندجي. 271.
قسيم
الكفروي/
راجع:
الكفروي.
القشيري،
مسلم بن
حجّاج. (206-261 هـ./810-875 م.). 115.
القشيري،
أبو القاسم
عبد الكريم بن
هوازن بن عبد
الملك بن
طاحة. (376-465
هـ./986-1073 م.). 116، 141، 246، 211،
212، 213.
القنوي/
راجع: صدر
الدين القنوي.
-
ك -
كامران
إينان Kamran Inan، سيايسيّ
معاصر وعضو في
البرلمان
التركي. 339.
كامل
يلماز، باحث
معاصر تركي. 333.
كحّاله،
عمر رضاء،
باحث عربي
معاصر. اسمه
مبعثر في
الحواشي
السفلية.
الكرخيّ،
أبو محفوظ
معروف بن
فيروز. (ت. 200 هـ./815 م.). 22.
الكردي،
محمّد أمين
الأربلي. (ت. 1332 هـ./1913 م.). 43، 47، 49،
56، 108، 109، 114، 118، 121، 123، 127،
129، 139، 148، 193، 196، 199، 279، 295،
296، 463.
الكستلي،
مصطفى بن
محمّد. (ت. 901 هـ./1460 م.). 173.
كعب بن
مالك. 79، 86.
الكفروي،
الشيخ قسيم. (1920-1992م.). 31، 53، 197، 240، 265،
307، 328، 373، 398.
كلال بن
حمزة/ راجع/
الأمير كلال.
كمال
قاجار، من
شيوخ
النقشبنديّين
المعاصرين في
تركيا، ورئيس
الفرقة
السليمانية. 417.
كوبيلاي،
مصطفى فهمي،
ملازم ثاني؛
قُتِلَ في
وقعة منامن (1906-1930م.). 374.
الكوثري/
راحع: محمّد
زاهد بن الحسن
بن علي
الكوثري اﻟﭽﺮكسي.
-
ل -
لاز
إبراهيم
خواجه،
(الحشّاش الذي
استخدمته الحكومة
عميلاً
لتنفيذ خطّةٍ
في مدينة منامن
التابعة
لولاية إزمير.
نُفِذَ فيه
حكم الإعدام
مع زميله كش
مهمد، إي
محمّد
الحشّاش وذلك عام
1930م. 374.
لطف
الله الأسكوبي. 34.
لطف
الله بن عبد
العظيم خوجه. 6، 431، 432، 433، 443، 472، 473،
476،
-
م -
الماتريدي،
الإمام أبو
منصور محمّد
بن محمّد
الماتريديّ. (ت.333 هـ./944 م.). 144
مالك بن
أنس، إمام دار
الهجرة. (93-179 هـ./712795 م.). 215.
المحلّي،
جلال الدين بن
محمّد بن
أحمد. (791-864
هـ./1389-1459 م.). 87.
محمّدد
أبو بكر بن
الطيّب
الباقلاني/
راجع: الباقلاني.
محمّد
امين بن علي
السويدي. (1200-1246 هـ./1785-1831 م.). 278، 279، 295،
296.
محمّد
أمين بن محمّد
صالح
الطبقجلي. 295.
محمّد
أسعد أفندي/
راجع:
الإسطنبولي.
محمّد
إسماعيل
الشهيد. 299.
محمّد بابا
سماسي. (755هـ.-1354م.). 192، 196، 223.
محمّد
البغدادي
الإمام. 314.
محمّد
بن إسماعيل
البخاري،
إمام
المحدّثين. (194-256 هـ./810-870 م.). 115.
محمّد
بن جرير
الطبري/ راجع:
الطبري.
محمّد
أمين الكردي
الأربلي/
راجع: الكردي.
محمّد
الباقي بالله
الكابلي. (971-1012 هـ./1563-1603 م.). 53، 196.
محمّد
بهاء الدين
البُخَاريّ/
راجع: شاه
نقشبند.
محمّد
بهاء الدين بن
عبد الغني بن
حسن بن إبراهيم
البيطار. (1265-1328هـ./1849-1910 م.). 156.
محمّد
بن سليمان بن
مراد بن عبد
الرحمن العبيدي
البغدادي، من
خلفاء خالد
البغدادي. (ت.1234 هـ./1819 م.). 29، 302.
محمّد
بن عبد الله
الخاني/ راجع:
الخاني.
محمّد
بن عبد الله
بن عبد الملك
الطائي، ناظم الألفية
الشهيرة في
النحو.(600-672 هـ./1204-1274 م.). 342، 352.
محمّد
بن عبد
الوهّاب بن
سليمان
التميمي النجدي.(1115-1206 هـ./1703-1792 م.). 358، 365، 438،
439، 467، 469، 470، 472، 473.
محمّد
الجديد
البغدادي. 314.
محمّد
الحزين
الفرسافي
الحسني
الهاشمي.(1816-1892م.). 325، 326، 379، 395، 407،
412، 416، 455، 458، 462، 463.
محمّد
الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲ/
راجع: الأﻣﮑﻨﮕﻲ.
محمّد
رائف.
محمّد
رشيد باشا
(الفريق)
محمّد
زاهد البدخشي/
راجع:
البدخشي.
محمّد
زاهد بن الحسن
بن علي
الكوثري
الجركسي.( 1296-1371هـ./ 1879-1952م.). 95، 105، 156،
157، 197، 337.
محمّد
زاهد كوتكو. (ت. 1980م.). 105، 189، 471.
محمّد
سعيد بن أحمد
الفاروقي
السمرقندي. 181، 262.
محمّد
شريف العباسي. 101.
محمّد
الشطّاري. 55، 254.
محمّد
شيرين بن صبغة
الله
الحيزاني.
نُفِذَ فيه
حكم الإعدام
سنة 1913م. 325.
محمّد
صالح بن أحمد
الغرسي. 9، 299، 300، 301.
محمّد
صدّيق خان بن
الحسن
القنوجي
البخاري. (1248-1307 هـ./1832-1889 م.). 97، 297، 298،
299.
محمّد
عاشق. 314.
محمّد
عبده. (1266-1323
هـ./1850-1905 م.). 320.
محمّد
علي باشا،
حاكم مصر. (1769-1849م.). 285.
محمّد
الغريب. 325.
محمّد
الفراقي
الكردي. 314.
محمّد
فوزي (المفتي
الأسبق
لمدينة
أدرنة). 415.
محمّد
الكردي. 271.
محمّد
الكفروي. 407.
محمّد
الناصح. 314.
محمّد
نامق باشا
(المشير). 316.
محمّد
المجذوب
العمادي. 314.
محمّد
مطيع الحافظ،
باحث عربي
معاصر. 57، 62، 270، 271، 278، 313، 404.
محمّد
المعصوم
الفاروقي/
راجع:
الفتروقي. 262.
محمّد
الفاتح. ( 1432-1481م.). (32-34).
محمّد
المحلّي/
راجع:
المحلّي.
محمود
أسطى عثمان
أوغلو، شيخ
طائفةٍ من
النقشبنديّين
في إسطنبول. 56، 103، 106، 165، 181، 425، 447،
472.
محمود
الإنجيرفغنوي. (ت.715 هـ./1315 م.). 192، 196، 220.
محمود
سبكتكين،
ثالث ملوك
الغزنويّين
وأشعرهم. (970-1030م.). 211.
محمود
سامي رمضان
أوغلو، شيخ
نقشبندي تركي. 334،380.
محمود شاكر،
فاضل عربي
معاصر . 198، 247.
محمود
شلبي. 32.
محمود
الصاحب، شقيق
خالد
البغدادي. (315-319).
محي
الدين بن
عربي/ راجع:
ابن عربي.
مراد بن
علي الأزبكي
المنـزوي،
خليفو معصوم الفاروقي. (1054-1132 هـ./1644-1719 م.). 34.
مُرَارَةُ
بن ربيع
العامري/
راجع: العامري.
مرزا
رحيم الله بيك
محمّد درويش
العظيم آبادي.
273، 275.
المرسي،
عبد الحق بن
إبراهيم بن
سبعين. (614-669 هـ./1217-1271 م.). 128، 441.
مروان
إبراهيم
القيسي، باحث
عربي معاصر. 9، 133، 156، 253.
مسلم بن
حجاج القشيري/
راجع:
القشيري.
مصطفى
أبو يوسف
الحمامي. (ت. 1368 هـ./1949 م.). 181.
مصطفى
بن محمّد
الكستلي/
راجع:
الكستلي.
مصطفى
صبري، آخر من
احتل منصب
المشيخة
الإسلامية في
الدولة
العثمانيّة. (1277-1373 هـ./1860-1954 م.). 157، 328.
مصطفى
فهمي كوبيلاي/
راجع:
كوبيلاي.
مصطفى
فوزي. (1871-1924م.).
67. 92، 94، 95.
مصطفى اﻟْﮕُﻠْﻌَﻨْﺒَﺮِيّ. 314.
مصطفى
موغلالي. 375.
مصلح
الدين الطويل. 34.
المطرزي،
ناصر الدين
عبد السيّد. (ت. 610 هـ./1213 م.). 238.
معروف
التكريتي. 314.
معاوية
بن أبي سفيان. (610-680م.). 21، 22،
82.
المقتدر
بالله جعفر بن
أحمد
المعتضد،
الخليفة
الثامن عشر من
سلالة العباس
بن عبد
المطلب. (295-310 هـ./908-923 م.). 18.
ملاّ
أحمد الجزري. 138.
ملاّ
جامي/ راحغ
الجامي.
ملاّ
خالد الكردي. 314.
ملاّ
خضر أفندي. 386.
ملاّ
عباس الكوكي. 314.
ملاّ
محمّد شريف. 96.
ملاّ
هداية الله
الأربلي. 314.
ملاّ
رسول. 310، 311.
موسى
الجبوري. 314.
موسى
صفوتي باشا. 316، 317.
موسى
كاظم الحزيني
الهاشمي. (ت. 1997م.). 412.
مؤمن
الشبلنجي. (كان حيًّا
في 1290 هـ./1873 م.). 207.
منير
بعلبكي، فاضل
وباحث عربي
معاصر. 57.
ميرزا
مظهر/ راجع
شمس الدين
حبيب الله.
المير
عبد الأوّل. 240.
الأمير
كلال بن حمزة. (ت. 772 هـ./1370 م.). 225.
المنوفي،
السيد محمود
أبو الفيض. 21، 22، 136.
ميمون
بن ديصان
القدّاح. 232.
-
ن -
ناصر
الدين عبيد
الله الأحرار/
راجع:
الأحرار.
ناصر
الدين عبد
السيد
المطرزي/
راجع:
المطرزي.
النابلسي/
راجع: عبد
الغني
النابلسي.
النبهاني،
يوسف بن
إسماعيل. (1265-1350 هـ./1849-1932 م.). 78، 177، 181،
189، 190، 215.
نحم
الدين
أرباكان،
سياسيّ تركيّ
معاصر. 382، 417، 471.
نجم
الدين دادروك. 230.
نجيب
فاضل، شاعر
تركي. (1905-1983م.).
95، 331.
نزار
أباظة، باحث
عربي معاصر. 57، 62، 404.
الندويّ،
/ راجع: أبو
الحسن الندويّ.
النسائي،
أبو عبد
الرحمن
المحدّث. (215-303 هـ./830-915 م.). 112، 462.
النسفي،
أبو البركات
عبد الله بن
أحمد بن محمود. (ت. 710 هـ./1310 م.). 83.
النسفيّ،
أبو حفص عمر
بن محمّد. (461-537 هـ./1069-1142 م.). 19، 144، 173،
398.
نظام
التهانيسري. 249.
نظام
الملك، حسن بن
علي. (1018-1092م.).
213.
نعمان
بن محمود
الآلوسي/
راجع:
الآلوسي. 297.
نعمة
الله بن عمر. 43، 56، 147، 399.
النهري،
طه الهكّاري/
راحع:
الهكّاري.
نوح
عليه السلام. 107، 247
نور
الدين
البريفكاني. 302، 333.
نور
محمّد
البدواني (ت. 1135 هـ./1772 م.) 192، 197، 263،
264، 265.
النوويّ،
محي الدين أبو
زكريا يحيى بن
شرف الدين. (631-677 هـ./12331278 م.). 52، 112، 115.
-
هـ -
الهرويِّ،
إسماعيل بن
إبراهيم بن
محمّد بن عبد
الرحمن القرّاب. (330-414 هـ./942-1023 م.). 19.
الهكّاري،
طه النهري
الشمزيناني اﻟْﮕَﻴﻶنيّ. (ت. 1853م.). 105، 151، (320-395)، (406-415).
الهلال
بن أمية
الواقفي/
راجع:
الوتقفي. 79، 225.
الهمداني،
أبو يعقوب
يوسف. (440-535
هـ./1048-1140 م.). (191-216)، 338، 398.
-
و -
الواقفي،
/راجع: الهلال
بن أميّة.
ولهلم، فريديريك
رادلوف/ راجع:
رادلوف.
-
ي -
ياسين بن
إبراهيم
السنهوتي. 177.
اليافعي/
راجع: عبد
الله بن أسعد
اليافعي. 209.
ياقوت
بن عبد الله
الرومي
الحموي. (574-626 هـ./1178-1229 م.). 212.
يحيى
المزوري. (ت. 1252 هـ./1836 م.). 295.
يزيد بن
أسلم. 80.
يعقوب
اﻟﭽﺮخِيّ (ت. 851 هـ./1447 م.) 192، 196، (335-341)
يعلى بن
شدّاد.
67.
يقو،
(يهوديٌّ من
سكان مدينة
إزمير،
استخدمته
الحكومة
عميلاً
لتنفيذ خطّةٍ
في مدينة مَنَامَنْ
التابعة
لولاية
إزمير-تركيا). 234.
يودا،
(يهوديٌّ من
سكان مدينة
إزمير،
استخدمته
الحكومة
عميلاً
لتنفيذ خطّةٍ
في مدينة مَنَامَنْ
التابعة
لولاية
إزمير-تركيا). 234.
يوسف بن
إسماعيل
النبهاني/راجع:
النّبهاني.
يونس بن
عبد الأعلى. 409.
يونس
أمراه
التركماني. 148.
***
المصطلحات
والمفاهيم
والتعبيرات
الخاصّة
والملل
والنخل
- أ -
*
الأتراك: وردت
هذه الكلمة
مبعثرة في
ثنايا الكتاب
أكثر من سبعين
مرةً .
* إثبات
النّظر في
الأمام: 119، 120.
* إدّعاء
النقشبنديّين:
أن معتقدهم هو
معتقد أهل
السنّة. 113، 193، 210.
* إدّعاء
النقشبنديّين:
أنهم لم
يزيدوا ولم ينقصوا. 193، 210.
*
الإسترخاء: 127.
*
استحضار صورة
الشيخ في
الذهن : 61، 76، 93، 436.
*
الاستمداد من
روحانية
الشيخ: 111، 112، 176، 200، 207، 229، 376،
388، 402، 460.
* إشتقاق
كلمة
التّصوّفِ : 9، 10، 133، 134، 199، 204.
*
الاعتكاف : 137.
* إغلاق
الباب: 67، 69.
* القاب
الطريقة النقشبنديّة
: 29، 30.
*
إلَهيّات Ilâhiyat: تسمية
ماكرة أطلقها
حكّام النظام
العلماني على
كليات العلوم
الإسلامية في
جامعات تركيا. 99.
*
الأويسية: 131، 135، 174، 204، 207، 209، 255.
-
ب -
*
البرهميّة:
وردت بكثرة في
تضاعيف
الكتاب. 14، 21، 42، 46، 53، 57، 60، 61،
67، 70، 89، 216، 223، 251، 254، 256،
269، 274، 276، 278، 287، 395، 399، 405.
* البوذيّة
: وردت بكثرة
في تضاعيف
الكتاب. 14، 16، 46، 53، 60، 61، 70، 115،
116، 119، 121، 124، 125، 132، 134، 139،
150، 223، 254، 265، 269، 411، 441، 448،460،
463، 464.
*
البكتاشيّة : 21، 168، 348.
*
البنجريّة : 21.
*
البيرميةّ : 21.
* البيعة
: 43.
-
ت -
*
التركيز
الفزيولوجي Consantration physiologic: 129.
* ترانس (Trence): 59.
* التصوف Theosophy: 132.
*
التَّكِيَّة : 50.
* تغميض
العينين: 51.
-
ج -
*
الجراحيّة : 21، 294.
*
الجوكية: 53، 57، 127، 137، 139، 278، 279،
290، 293.
-
ح -
* حبس
النَفَسِ : 9، 30، (53-68)، 254، 269، 276، 279،
393، 395.
*
الحروفيّة : 21.
* حفظ
النَّفَسِ : 114، 117.
*
الحقيقة
المحمّديّة : 133، 269.
-
خ -
*
خُوَاجَهْ :
كلمة فارسية
بمعنى الشيخ
والعالم،
جمعها : خُوَاجَگَانِ:
مبعثرة في
ثنايا الكتاب
*
الخوارج : 21.
*
الخلوتيّة : 21.
* الخلوة: 116، 122، 124، 136، 137، 145.
*
الخفيفيّة : 21.
-
ذ -
* الذكر : 51
-
ر -
* رابطة: 61.
*
الروشنيّة : 21.
* رؤيا
شاه نقشبند: 27، 450.
*
الرياضة
البوذية : 124.
-
ز -
* زُهّاد
: 21، 115.
* زنادقة
العجم: 24، 116.
-
س -
*
السَّيْرُ
والسُّلُوك: 136.
-
ش -
* الشامانيّة: 14، 16، 21، 53، 399.
* الشيعة
: 21، 25، 33، 88، 198، 251،
258، 259، 266، 357.
-
ص -
* »صاحب« : 281،
-
ط -
* طالبان:
إسمٌ أُطلِقَ
على الحكومةِ
الأفغانيةِ
الَّتي
شكّلَتْهَا
جماعةٌ من
طلبةِ الجامعات
الإسلاميّة
ذوات الطابع
القديم والمتخلّف
في باكستان،
وذلك بِدَعْمٍ
من
الوهّابيّينَ. 24.
* طابع
الطريقة النقشبنديّة: 198، 320.
-
ع -
* العارف
بالله : 44، 144، 145.
* العشقَ
الإلهيَّ : 138.
* عُكْلٌ
(اسم فبيلة من
العرب): 78.
* عقيد
متشيّخ: 356، 365، 380، 383، 447.
-
غ -
* الغفلة
: (115-117).
*
الغيبوبة Transcendental
absance: 129.
-
ف -
* الفناء
في الله : 116، 120، 121، 126، 129، 138، 146،
147، 159.
* الفناء
والبقاء : 145.
-
ق-
»قدّس
الله سرّه«: 113، 151، 440.
-
ك -
*
اﻟﮕُﻠْـشَنِيَّةُ
:
-
ل -
*
اللّطائف
الخمس: 9، 38، 54، 105، 107، 108ـ 369.
* لوطوس Lotus : 127.
-
م -
*
مَانْترَا (Mantra : om, mani, padme, hum): 187.
*
المانويّة: 14، 21، 53.
*
مديتيشن (Meditation): 57، 59.
*
المزدكيّة: 14، 21، 53.
*
مصطلحات
فارسيّة
للصوفيّة:111، 217، 218، 463.
*
مصطلحات
عربيّة
للصوفيّة: 41.
*
مفاهيم دخيلة
:
53، 73، 121، 132، 135،
142، 194، 195، 260، 269، 316، 394.
*
مفاهيم
باطنيّة : 17، 110، 135، 140، 206، 316، 348.
* مقولة »قدّس
الله سرّه«: 113، 151، 440.
*
مُلاَّ
(وَمَلاَّ،
وَمَلاَ):
كلمةُ
فارسيّةٌ
مبعثرة في
ثنايا
الكتاب؛ تأتي
بمعنى الشيخِ
والعالمِ. يَكْثُرُ
اسْتِعْمَالُهَا
في إيران وأفغانستان
وباكستان،
وكذلك في
تركيا على سبيل
الوصف لرجال
الدِّينِ.
يأتي جمعُ هذه
الكلمةِ
بصيغةِ (مَلاَلِي)
على لسان
العرب.
* الملاميَّة
: 32، 77، 404.
*
المعرفة
بالله: 44، 124، 125، 131، 135، 141، 142،
145، 234، 237.
* »من لا
شيخ له.... إلخ« : 43، 395،
399.
* »ميان«: 281.
-
ن -
*
النَّفَسُ
الموزون : 58.
* نقشبند: 8.
*
نيرفانا Nirvana : 59.
-
هـ -
* الهَيَاطِلَةُ: 15، 335.
* الهمّة
والبركة: 402، 485.
-
و -
* وحدة
الشهود: 158.
* وحدة
الوجود: 148
* »وكن
عنده كالميّت
عند مغسل«: 49.
* الواصل
إلى الله: 44.
-
ي -
* اليوغا
: 57.
***
أسماء
الأماكن
والمعالم
التاريخية
والجغرافية
- أ -
* أربل: 333.
*
أفغانستان: 24، 172، 235، 243، 361، 362، 392،
398، 409، 469.
* آماسيا
: 32.
-
ب -
* بخارى: 15، 25، 115، 180، (215-242)، 429، 444،
448.
* بخيرة
آرال: 15،
*
البشتون: 25.
-
ت -
*
تركستان: 31، 221، 237، 275، 398.
-
ج -
* جامعة
مرمرا: 99.
* جَيْحون
: 15.
-
خ -
* خراسان: 18، 24، 32، 207، 213، 279، 280.
* خُوَارِزمْ
:15، 180، 225، 233.
-
س -
* سمرقند: 34، 172، 238، 241، 243.
* سَيْحون
: 15.
-
ط -
* طاشكند: 238.
* طربزون: 103، 380.
-
غ -
* غار
حراء : 137.
-
ف -
* فرغانة: 15، 451.
-
ك -
*
الكداهية : 32.
-
م -
* ماوراء
النهر : 18، 19، 24، 221، 224.
* مسجد
إسماعيل آغا: 103، 380.
* مكتبة
السليمانيّة:
مكتبة قديمة
ضخمة في إسطنبول،
مشهورة
بمخطوطاتها.
يزيد عدد
الكتب الموجودة
فيها عن
أربعمائة ألف
مجلّد، كثير
منها أثرية. 98، 102، 104، 222، 278، 279، 284،
394، 465.
***
المراجع العربية
- أ -
أبجدية
التصوّف
الإسلاميّ،
محمّد زكي
إبراهيم 1995م.
الطبعة
الخامسة.
إثبات
المسالك في
رابطة
السالك،
مصطفى فوزي.
إثبات
النبوّة،
أحمد
الفاروقي
السرهنديّ.
الأجرميّة،
ابن آجرّوم،
محمّد بن
محمّد بن داود
الصنهاجي
الفاسيّ.
الأذكار
المنتخبة من
كلام سيّد
الأبرار (الأذكار
النووية ) محي
الدين أبو
زكريا يحيى بن
شرف الدين
النوويّ.
إرشاد
العقل السليم
إلى مزايا
الكتاب الكريم،
أبو السعود
العماديّ.
إرغام
المريد،
محمّد زاهد
الكوثري.
اصطلاحات
الصوفية،
خالد
البغداديّ،
مكتبة السليمانية
خزانة لالا
إسماعيل رقم: 699/5
إسطنبول.
أصول
التصوف
الإسلاميّ،
حسن شرقاوي،
دار المعرفة.
الجامعة.
إسكندرية 1991م.
الأعلام،
خير الدين
زيركلي.
ألفية
ابن مالك،
محمّد بن عبد
الله بن مالك
الطائي.
الانتباه
في سلاسل
الأولياء،
أحمد بن عبد
الحليم شاه
ولي الله
الدهلويّ.
أنوار
التنـزيل
وأسرار
التأويل، أبو
سعيد ناصر
الدين عبد
الله بن عمر
البيضاويّ.
الأنوار
القدسية في
مناقب النقشبنديّة،
ياسين بن
إبراهيم
السنهوتي.
إيضاح
الطريقة، عبد
الله
الدهلويّ،
مكتبة
السليمانية
خزانة حسني
باشا رقم: 7421
إسطنبول
-
ب -
البصائر
لمنكري
التوسّل
بالمقابر،
حمد الله
الداجويّ.
بغية
الواجد، أسعد
بن محمود
الصاحب.
البهائية
والقاديانية،
أسعد
السمحرانيّ.
البهجة
السنيّة في
آداب الطريقة النقشبنديّة،
محمّد بن عبد
الله الخانيّ.
-
ت -
التاج
المكلّل من
جواهر مآثر
الطراز الآخر
والأوّل،
محمّد صدّيق
خان بن الحسن
القنوجيّ البخاريّ.
التاريخ
الإسلاميّ،
محمود شاكر.
تبرئة
الغبيّ عن طعن
ابن عربي،
جلال الدين عبد
الرحمن
السّيوطيّ.
تبصرة
الفاصلين عن
أصول
الواصلين،
سليمان زهدي.
تحرير
الخطاب في
الردّ على
خالد
الكذّاب، معروف
النودهي
البرزنجيّ.
تحفة
العشّاق،
إبراهيم
الفصيح.
تذكرة
الرجال، عبد
الكريم
البياري.
تذكرة
الحفّاظ،
الحافظ
الذهبيّ
محمّد بن أحمد
بن عثمان بن
قايماز
التركمانيّ.
تفسير
القرآن
العظيم، أبو
الفداء
إسماعيل بن كثير.
تفسير
نمونة
(بالفارسية)،
لجنة بإشراف
آية الله ناصر
مكارم شيرازي.
تكملة
النفحات
الأقدسية في
شرح الصلوات
العظيمة
الإدريسية،
محمّد بهاء
الدين بن عيد
الغني بن حسن
بن إبراهيم
البيطار.
تلبيس
إبليس، أبو
الفرج عبد
الرحمن بن علي
بن محمّد ابن
الجوزيّ.
التصوّف
الإسلاميّ
مدرسةً
ونظريةً،
محمّد جلال
شرف، دار
العلوم
العربية
بيروت 1990م.
التصوّف
الإسلاميّ
منهجًا
وسلوكًا، عبد
الرحمن
عميرة، مكتبة
الكليات
الأزهرية
القاهرة.
التصوّف
العربيّ،
محمّد ياسر
شرف، دار الهلال
القاهرة 1982م.
التصوّف
في ميزان
البحث
والتحقيق، عبد
القادر حبيب
الله السنديّ.
مكتبة ابن القيم،
المدينة
المنوّرة 1990م.
تصوّفك
ظفرلري، شيخ
صوفوت.
إسطنبول 1343
هـ.
تنوير
القلوب في
معاملة علاّم
الغيوب، محمّد
أمين الكرديّ
الأربليّ.
تنوير
المقباس في
تفسير ابن
عبّاس، أبو
طاهر مجد
الدين محمّد
بن يعقوب بن محمّد
بن إبراهيم
الشيرازي
الفيروزآبادي
تهذيب
التهذيب، أبو
الفضل أحمد بن
علي بن محمّدد
ابن حجر
العسقلانيّ.
-
ج -
جامع
الأصول، أحمد
ضياء الدين الگُمُوشْخَانَوِيّ.
جامع
البيان في
تفسير
القرآن، أبو
جعفر بن جرير
الطبريّ.
جامع
كرامات
الأولياء،
يوسف بن
إسماعيل النبهاني.
-
ح -
الحجج
البيّنات في
ثبوت
الاستغاثة
بالأموات،
علي محمّد
البلخيّ.
الحدائق
الوردية في
حقائق أجلاّء النقشبنديّة،
عبد المجيد بن
محمّد بن
محمّد
الخانيّ.
الحديقة
النّدية في
الطريقة النقشبنديّة،
محمّد بن
سليمان
البغداديّ.
حلّية
الأبرار
وشعار الأخيار
في تلخيص
الدّعوة
والأذكار
(الأذكار
النووية) ) محي
الدين أبو
زكريا يحيى بن
شرف الدين النوويّ.
حلّية
الأولياء،
أبو نعيم أحمد
بن عبد الله بن
أحمد بن إسحاق
الإصفهاني.
-
د -
الدرر
السّنية في
الردّ على
الوهّابية،
أحمد بن زيني
دحلان.
دفع
الظلوم عن
الوقوع في عرض
هذا المظلوم،
محمّد أمين بن
علي السّويدي.
دين
الله الخالص،
محمّد صدّيق
خان بن الحسن
القنوجي
البخاريّ،
دار الكتب العلميّة
بيروت 1995م.
دين
الله الغالب
على كلّ منكرٍ
مبتدعٍ كاذب، أبو
سعيد عثمان بن
سليمان بن
محمّد أمين بن
حسين بن
إسماعيل بن
عبد الجليل
الحيائي
الموصليّ
-
ر -
رجال
الفكر
والدعوة في
الإسلام، أبو
الحسن
الندويّ.
الرحمة
الهابطة في
ذكر اسم الذات
والرّابطة،
حسين
الدّوسريّ.
الردّ
المتين على
منتقص العارف
بالله محي الدين،
عبد الغني بن
إسماعيل بن
عبد الغني
النابلسي.
الردّ
على القائلين
بوحدة
الوجود، ملاّ
علي بن سلطان
القاريّ.
الرسالة
الأسعدية،
أسعد
الأربليّ.
الرسالة
التاجية، تاج
الدين بن
زكريا
الهنديّ.
الرسالة
الخالديّة،
خالد
البغداديّ.
الرسالة
الشطّارية،
بهاء الدين
الأنصاريّ
القادريّ.
رسالة
في آداب
الطريقة النقشبنديّة،
أحمد خليل
البقاعيّ.
رسالة
في تحقيق
الرّابطة،
خالد
البغداديّ.
الرسالة
القدسية،
عصمت غريب
الله.
الرسالة
القشيرية،
أبو القاسم
عبد الكريم بن
هوازن بن عبد
الملك بن طلحة
القشيريّ.
الرسالة
المدنية،
نعمة الله بن
عمر.
الرسالة
المشغولية،
أحمد سعيد
المجدّديّ.
الرسالة
البهائية علي
قدري (ترجمة:
رحمي سرين). إسطنبول-1994م.
-
ز -
الزمرد
العنقاء،
مجمعوة
مكوَّنَةٌ من
رسائلَ
مختلفةٍ.
-
س -
السطرايات
(تعاليم
باتانجالي
الراهب)
السعادة
الأبدية فيما
حاء به النقشبنديّة،
عبد المجيد بن
محمّد بن
محمّد
الخانيّ.
سلّ
الحسام
الهندي في
نصرة مولانا
خالد النقشبندي،
محمّد أمين بن
عمر بن عبد
العزيز إبن
عابدين.
سلسلة
العارفين
وتذكرة
الصدّيقين،
محمّد زاهد
البدخشي.
-
ش -
شذرات
الذّهب في
أخبار من ذهب،
ابن العماد
عبد الحي بن
أحمد بن محمّد
بن عماد العكري
الدّمشقي
الحنبلي.
شرح
السلسلة
المرادية،
درويش أحمد
الطرابزونيّ.
شرح العقائد
النسفية، سعد
الدين مسعود
بن عمر التفتازانيّ.
شرح
العقيدة
الطحاوية،
أبو جعفر أحمد
بن محمّد بن
سلامة
الأزديّ.
شرح
منظومة
الأمالي،
محمّد بن
سليمان الحلبيّ.
الشفاء،
قاضي عياض بن
موسى اليحصبي
السبتي المالكيّ.
شواهد
الحقّ، يوسف
بن إسماعيل
النبهانيّ.
-
ص -
صحيفة
الصفا لأهل
الوفاء،
سليمان زهدي.
الصراط
المستقيم،
محمّد
إسماعيل
الشهيد الدهلويّ.
صفات
الصفوة، أبو
الفرج عبد
الرحمن بن علي
بن محمّد ابن
الجوزيّ.
الصوفية
في إلهامهم،
حسن كامل
الطنطاوي، القاهرة
1992م.
الصوفية
في نظر
الإسلام،
سميح عاطف
الزّين دار
الكتاب
اللبناني
الطبعة
الثالثة
بيروت 1985م.
الصوفية
عقيدة
وأهدافًا،
ليلى بنت عبد
الله.دار
الوطن للنشر
الرياض.
الصوفية
والتصوّف،
عدنان حقي،
مركز البحوث الإسلامية
رقم: 297،7 مال.س. 20682-1
إسطنبول.
-
ض -
الضابطة
في الرّابطة،
سعيد سيدا
الجزريّ.
-
ط -
طبقات
ابن سعد،
محمّد بن سعد
بن منيع
الزهريّ.
طبقات
الشافعية،
تاج الدين بن
عبد الوهّاب بن
علي السبكيّ.
الطرق
الصوفية بين
الساسة
والسياسة في
مصر المعاصرة،
زكريا سليمان
البيّومي،
مركز البحوث
الإسلامية
رقم: 297،75
بيت.
طواسين،
حسين بن منصور
الحلاّج.
-
ع -
العقائد
النسفية، أبو
حفص عمر بن
محمّد
النسفيّ.
العقل
الصوفيّ في
الإسلام، علي
شلق، دار المدى.بيروت
1985م.
العلم
الشامخ، صالح
المقبليّ.
علماء
دمشق
وأعيانُها،
محمّد مطيع
الحافظ نزار
أباظة.
علماء
الإسلام
والوهّابيّون،
مجموعة مكوّنة
من خمسِ
رسائلَ، قام
بنشرها عقيد مدسوس
في صفوف
النقشبنديين.
مكتبة إيشق،
إسطنبول 1972م
عمل
اليوم
والليلة، أبو
عبد الرحمن
النسائي.
عمل
اليوم
والليلة، أبو
بكر أحمد بن
محمّد بن إسحاق
السنيّ.
عين
الحقيقة في
رابطة
الطريقة،
محمّد فوزي، مفتي
ولا ية أدرنة
في أواخر
العهد
العثمانيّ.
-
غ -
غوث العباد،
ببيان
الرشاد،
مصطفى أبو
يوسف الحماميّ.
-
ف -
الفتح
الربّاني،
عبد القادر
الجيلانيّ،
مكتبة
السليمانية
خزانة طاهر
آغا رقم: 14
إسطنبول.
الفتوحات
الإسلامية،
أحمد زيني
دحلان.مطبعة
المدني
القاهرة 1968م.
الفتوحات
المكّية، ابن
عربي، محي
الدين بن محمّد
بن علي بن
محمّد بن أحمد
الطاءيّ.
فصوص
الحِكَم،
للمؤلّف
السابق.
الفكر
الصوفيّ في
ضوء الكتاب
والسّنّة،
الطبعة
الثالثة، عبد
الرحمن عبد
الخالق. مكتبة
ابن القيم،
الكويت.
فلسفة
التصوّف،
قدرات
وطاقات، هاني
يحيى نصر،
منشورا مجلّة
الثقافة. دمشق
1990م.
-
ق -
قاموس
الأعلام، شمس
الدين سامي.
قضايا
الصوفيّة في
ضوء الكتاب
والسّنّة، محمّد
أسيد
الجليند،
مكتبة
الزهراء
القاهرة 1990م.
قطر
النّدى وبل
الصدى، أبو
محمّد عبد
الله جمال
الدين بن يوسف
بن أحمد بن
عبد الله بن
هشام.
القول
الجميل في
بيان سواء
السّبيل،
أحمد بن عبد
الحليم شاه
ولي الله
الدهلويّ.
القول
الصواب في ردّ
ما سُمّي
بتحرير
الخطاب، /
راجع دفع
الظلوم......
-
ك -
الكبريت
الأحمر في
بيان علوم
الشيخ
الأكبر، عبد
الوهّاب
الشعرانيّ.
كتاب
الأربعين في
شيوخ
الصوفية، أبو
سعيد أحمد بن
محمّد بن احمد
الماليني،
مركز البحوث الإسلامية
رقم: 297،72
مال.ك. 51558
إسطنبول.
الكرامة
الصوفية
والأسطورة
والحُلُم،
على زيغور،
مركز البحوث
الإسلامية
رقم: 297،7
زيك. ك.
إسطنبول.
الكشاف
عن حقائق
غوامض
التنـزيل
وعيون الأقاويل
في وجوه
التأويل، أبو
القاسم جار
الله محمود بن
عمر
الزمخشريّ.
كشف
الظنون، حاجي خليفة
مصطفى بن عبد
الله.
كنتُ
قبوريًّا
(اعترافات)،
عبد المنعم
الجدّاوي.
الطبعة
الرابعة.
الرياض 1981م.
كنـز
العرفان،
أسعد
الأربليّ.
-
ل -
اللّباب
في تهذيب
الأنساب، ابن
الأثير عزّ الدين
أبو الحسن علي
ابن أبي الكرم
الشيبانيّ.
-
م -
مجامع
الحقائق في
أصول الحنفية،
عبد الوهّاب.
المجد
التالد،
إبراهيم
الفصيح.
مجلة
المجمع
العلمي
الكردي
(مولانا خالد)
عباس
العزاّويّ.
مختصر
شرح بن علاّن.
مدارك
التنـزيل
وحقائق
التأويل، أبو
البركات عبد
الله بن احمد
بن محمود
النسفيّ.
مدخلٌ
إلى التصوّف
الإسلاميّ،
أبو الوفاء الغنيمي
التفتازانيّ.
دار الثقافة
القاهرة 1991م.
المذاهب
الصوفية
ومدارسها،
عبد الكريم
عبد الغني
قاسم، مكتبة
مدبولي
القاهرة 1989م.
مرآة
الجنان وعبرة
اليقظان، عبد
الله بن أسعد
اليافعيّ
اليمنيّ
المكّيّ.
المسموعات،
محمّد زاهد
البدخشيّ.
معالم
الطريق إلى
الله، محمود
أبو الفيض
المنوفيّ.
معجم
البلدان،
ياقوت بن عبد
الله الرومي
الحمويّ
معجم
المؤلفين،
عمر رضاء
كحّالة .
مفاتيح
الغيب
(التفسير
الكبير)، فخر
الدين محمّد
بن عمر بن
الحسين
التيّميّ
البكريّ الرازيّ.
مقاصد
الطالبين،
محمّد رائف.
المقامات
المظهرية،
غلام علي عبد
الله الدهلويّ.
المقدّمة
في التصوّف،
أبو عبد
الرحمن محمّد بن
أحمد بن
الحسين
السلميّ،
(تحقيق يوسف
زيدان) مكتبة
الكليات
الأزهرية
القاهرة 1987م.
مكاتيب
شريفة، عبد
الله
الدهلويّ.
مكتوبات
السرهنديّ.
مناقبُ
عبدِ الخالقِ الْغُجْدُوَانِيِّ،
فضل الله بن
روزبهان
الإصفهانيّ،
مكتبة
السليمانية
خزانة يحيى
توفيق رقم: 54
إسطنبول.
منتخبات
من مكتوبات
السرهنديّ.
المنحة
الوهبية في
ردّ
الوهّابية،
داود بن سليمان
البغداديّ.
منشورات
المجمع
العلمي
الكرمانيّ.
منهج
البحث عن
اليقين بين
السلف
والصوفية، عبد
المقصود عبد
الغني، مكتبة
الزهراء القاهرة
1993م.
المؤامرة
على الإسلام،
أنور الجندي.
الطبعة الثالثة،
دار الإعتصام
القاهرة 1978م.
المواهب
السرمدية في
مناقب
السادات النقشبنديّة،
محمّد أمين
الكرديّ
الأربليّ.
موسوعة
بهجة
المعرفة،
نشرتها
الشركة العامّة
للنشر
والتوزيع
والإعلان في
ليبيا.
موسوعة
المورد، منير
بعلبكي.
الموفي
بمعرفة
الصوفي، كمال
الدين أبو
الفضل جعفر بن
تغلب
المصريّ،
تحقيق: محمّد
عيسى صالحة.
مكتبة دار
العربية.
الكويت 1988م.
موقف
ابن عابدين من
الصوفية
والتصوّف،
فريد صلاح
الهاشمي.
ميزان
الاعتدال في
نقد الرجال،
الإمام الذهبيّ
محمّد بن أحمد
بن عثمان بن
قايماز
التركمانيّ.
المصباح،
ناصر الدين
عبد السيد
النمطرزيّ.
-
ن -
نظرية
الاتّصال عند
الصوفية في
ضوء الإسلام سارة
بنت عبد
المحسن بن عبد
الله آل سعود.
جدّة 1991م.
النقشبنديّة،
عبد الرحمن
الدمشقية. دار
طيبة، الرياض 1984م.
نهجة
السالكين
وبهجة
المسلكين،
سليمان زهدي.
نور
الأبصار،
مؤمن
الشبانجيّ.
-
هـ -
هذه هي
الصّوفية،
عبد الرحمن
الوكيل.
الطبعة الرابعة،
دار الكتب العلميّة
بيروت 1984م.
-
و -
وفيات
الأعيان
وأنباء أبناء
الزمان، ابن
خلّكان أبو
العباس شمس
الدين أحمد بن
محمّد بن أبي
بكر
-
ي -
اليوغا،
ج. توندريو ب.
رئال، ترجمة:
إلياس أيوب.
مكتبة
المعارف، بيروت
1988م.
***
المراجع
الأجنبية
A. Faruk Meyan, Şah-ı
Nakşibend. İstanbul-1970
A Group of Naqshabandis,
Râbıta ve Tevessül İstanbul-1994
A Group of Naqshabandis,
Ruhul Fukkan İstanbul-1991
Ahmet Yaşar Ocak,
Menâkıbnâmeler. Ankara-1992
Ahmet Yaşar Ocak, Türk
Sufîliğine Bakışlar İstanbul-1996.
Ahmet Yaşar Ocak, Osmanlı
Toplumunda Zındıklar ve Mülhidler İstanbul-1998.
Ahmet Yaşar Ocak, Bektaşî
Menâkıbnâmelerinde İslâm Öncesi İnanç Motifleri, İstanbul-1983.
Ahmet Yaşar Ocak, Babaîler
İsyanı, İstanbul-1996
Ahmed Faruqî Serhindî,
Mektûbât (Translation: Abdulkadir Akçiçek) İstanbul-1979
Ali Kadri, Tarikat-ı
Nakşibendiyye Prensipleri, İstanbul-1994.
David Dean Commins, Change
in late Ottoman Syria. New York-1960.
Erich From, Budhism and
Psychoanalysis. New York-1960.
Ancyclopedia of Meydan
Larousse, İstanbul
Ancyclopedia of «Dünden
Bugane İstanbul», İtem: Otman Babab Velâyetnamesi.
Ferîduddin Aydın,
Tarikatta Rabıta ve Nakşibendîlik. İstanbul-1996.
Fuad Köprülü, Türk
Edebiyatında Mutasavvıflar. Ankara-1993.
H. A. Rose, Rites and
Ceremonies of Hindus and Muslims. Undated.
Hasan Küçük, Osmanlı
Devletini Tarih Sahnesine Çıkaran Kuvvetlerden biri, tasavvuf ve Tarikatlar.
İstanbul-1976.
Hasan Lütfi Şuşud,
Menâkıb-ı Evliya, İstanbul-1958.
Hüseyin Hilmi Işık,
Vehhabiye Nasihat. İstanbul-1970
İslâm Alimleri
Ansiklopedisi (Ancyclopedia of The Muslim Doctors)
İrfan Gündüz, Tasavvufî
Bir terim Olarak Râbıta. No printed.
İrfan Gündüz, Ahmed Zıyâüddîn
Gümüşhânevî, Hayatı ve Eserleri. İstanbul-1984
James Dexter, Meditation.
(Translation: Gönül Üzmez) İstanbul-1996.
Kasım Kufralı,
Nakşibendîliğin Kuruluşu ve Yayılışı. İstanbul-1949.
Mahir İz, Tasavvuf.
İstanbul-1981.
Martin Lings, Whats
Suffism? Britain-1975.
Mehmed Esad Erbilli,
Mektûbât, İstanbul-1983.
Mehmed Zahid Kotku,
Tasavvufî Ahlâk. İstanbul-1982.
Mohammad Yahya Tamizi,
Sufi Muvement in eastern İndia. Delhi-1992.
Muhammed İhsan Oğuz,
Mektuplar. TDV. İSAM. 297.7
Nikki R. Keddie, Scholars,
Saint and Sufiis Muslim Religius İnstitutions Since 1500 USA-1978.
Ömer Demircan, Dünden
Bugüne Türkiyede Yabancıdil. İstanbul-1988
Ömer Öngüt, Hakiki
Mutasavvıflar,Hakiki Vahdet-i Vücutçular. İstanbul-1996.
Ömer Öngüt, Refah Dinine
Mensup Mahmut Efendinin Mollalarına Cevaptır. İstanbul-1996.
Ömer Öngüt,
Süleymancıların İçyüzü. İstanbul-1996.
Reşat Öngören, VI. Asırda
Anadoluda Tasavvuf (Doktora Tezi) İSAM. İst.
R. A. Nicholson., Studies
in İslamic Mysticisme. Britain-1980.
R. S. Bhatnagar,
Dimensions Of Classical Sufi Thought. Delhi-1984.
S. Ahmet Arvasî,
Doğuanadolu Gerçeği. Ankara-1992.
Selçuk Eraydın, Tasavvuf
ve Tarikatlar. İstanbul-1994.
Sir James Bolevard,
Meditation. (Translation: Şebnem Gürpınar) İstanbul-1993.
Vahdet-i
Vücûd Risâlesi, Ömer Ferid Kam. İstanbul.
محتويات
الكتاب
الفصل
الأوّل
* النقشبنديّة؛
ظهورُها،
وتطوّرُها،
ومناطقُ
انتشارِها.
* أهم
الأسباب
الّتي عملتْ على
ظهور الطريقة النقشبنديّة.
|
الموضوع |
رقم الصفحة |
|
مقدّمة
المؤلّف:....................................................................................................... |
3 |
|
السبب
الأول لظهور
الطريقة النقشبنديّة
:....................................................... |
10 |
|
السبب
الثاني:....................................................................................................... |
14 |
|
السبب
الثالث:.................................................................................................... |
17 |
|
السبب
الرابع:..................................................................................................... |
19 |
|
السبب
الخامس:.................................................................................................. |
21 |
|
السبب
السادس:................................................................................................ |
24 |
|
التغيُّرات
الّتي طرأت
على هذه
الطريقة التركيّة:............................................. |
27 |
|
المناطق
الّتي
انتشرت فيها
الطريقة النقشبنديّة
ودواعي انتشارها:................ |
31 |
الفصل
الثاني
* آدابُ
الطريقةِ النقشبنديّة،
ومَصَادِرُهَا،
وميّزاتُها.
|
الموضوع |
رقم الصفحة |
|
آدابُ
الذِّكْرِ
عندهم :........................................................................................... |
50 |
|
البيعةُ
وآدابُ
المشيخةِ،
وآدابُ
المريدِ مع
شيخِهِ، والغايةُ
منها:............................. |
43 |
|
الذّكرُ
بلسان القلب:............................................................................................ |
51 |
|
الرابطة
:................................................................................................................. |
61 |
|
شروطُ
الرابطة
وصورة
أدائها :........................................................................... |
65 |
|
أوّلُ مَنْ
أحدث
الرابطة :...................................................................................... |
70 |
|
الغايةُ
من الرابطة :................................................................................................ |
73 |
|
عقوبةُ
المخلّ
بآداب
الرابطة: ............................................................................... |
74 |
|
أسلوبُهم
وطريقةُ
استدلالهم
في إثبات
الرابطة،
ومقالاتهم
في الدّفاع
عنها،وما
قيل في ردّها |
76 |
|
مِنْ أَهَمِّ
مَا كُتب في
مسألة الرابطة
:..................................................................... |
90 |
|
مِنْ
آدابهم: الذّكرُ
على أساسِ
اللّطائفِ
الخمس :............................................... |
107 |
|
الحلقةُ
السِّرِّيَّةُ
الّتي
تُسمّىَ عندهم »خَتْمِ خُوَاجَگَانْ «:..................................... |
109 |
|
المصطلحاتُ
الفارسيّةُ
في الطريقةِ النقشبنديّة
وأسرارُها :.................................. |
111 |
مبادئُ
الطريقة النقشبنديّة
بالفارسيّة،
وهي أحد عشر
مبدءًا
|
1.
هُوشْ
دَرْدَمْ :..................................................................................................... |
114 |
|
2.
نَظَرْ بَرْ
قَدَمْ :
................................................................................................... |
118 |
|
3.
سَفَرْ
دَرْوَطَنْ :.................................................................................................. |
121 |
|
4.
خْلَوْت
دَرْ
أَنْجُمَنْ :......................................................................................... |
122 |
|
5.
يَادْ
كَرْدْ :......................................................................................................... |
123 |
|
6.
بَازْ
كَشْتْ :..................................................................................................... |
126 |
|
7.
نِكَاهْ
دَاشْتْ:
................................................................................................... |
126 |
|
8.
يَادْ
دَاْشْت :..................................................................................................... |
127 |
|
9.
وُقُوفِ
زَمَانِي :................................................................................................. |
129 |
|
10.
وُقُوفِ
عَدَدِي :............................................................................................ |
129 |
|
11.
وُقُوفِ
قَلْبِي: ................................................................................................ |
129 |
الفصل
الثالث
* مفاهيم،
ومصطلحات،
ومعتقدات
أخرى عند هذه
الطائفة.
|
التصوّف
:.............................................................................................................. |
132 |
|
السَّيْرُ
وَالسُّلُوكُ
:................................................................................................. |
136 |
|
العشق
الإلهيّ :...................................................................................................... |
138 |
|
المعرفة
بالله :.......................................................................................................... |
141 |
|
الفناء
والبقاء :...................................................................................................... |
145 |
|
وحدة
الوجود :..................................................................................................... |
148 |
|
وحدة
الشهود :..................................................................................................... |
158 |
|
الولاية،
والوليّ،
وتصرّف
الميّت :......................................................................... |
162 |
|
المكاشفة
والإلهام،
وعلم الغيب :.......................................................................... |
171 |
|
الأُوَيْسِيَّةُ
:.................................................................................................................. |
174 |
|
الكرامة،
والمناقب:................................................................................................... |
176 |
|
مفهوم
التوسّل في
معتقد النقشبنديّة
وما ركّبوا
عليه من أمور :
............................. |
186 |
الفصل
الرابع
* حقيقة ما
تُسمّيهِ النقشبنديّة
»سلسلة
خُوَاجَگَانْ«،
وأسماءُ
الّذين هم بمنـزلة
حلقاتها
المقدّسة
في اعتقادهم.
* مزعمة »سلسلة
السادات«.
* الروحانيّون
في هذه
الطريقة
المعروفون بـ »رجال السلسلة«.
* شخصيّاتهم،
ومستوياتهم العلميّة
والاجتماعيّة،
وترجمة
أحوالهم
بالتفصيل.
|
1.
أبو بكر
الصدّيق رضي
الله عنه :.................................................................... |
201 |
|
2.
سلمان
الفارسي رضي
الله عنه :..................................................................... |
203 |
|
3.
قاسم بن
محمّد بن أبي
بكر الصدّيق
رضي الله
عنهم :.................................. |
205 |
|
4.
جعفر الصادق
بن محمّد
الباقر رضي
الله عنهما :......................................... |
206 |
|
5.
أبو يزيد
البسطاميّ :...................................................................................... |
207 |
|
6.
أبو الحسن
الخرقانيّ :..................................................................................... |
211 |
|
7.
أبو علي
الفارمديّ :...................................................................................... |
212 |
|
8.
أبو يعقوب
يوسف
الهمدانيّ :........................................................................ |
213 |
|
9.
عبد الخالق الْغُجْدُوَانِيّ
:................................................................................ |
215 |
|
10.
عارف الرِّيوَگَرِي
:..................................................................................... |
218 |
|
11.
محمود الإنْجِيرْفَغْنَوِيّ
:................................................................................ |
220 |
|
12.
علي الرَّامِتَنيّ
:............................................................................................. |
221 |
|
13.
محمّد بَابَا
السمَّاسيّ :................................................................................... |
222 |
|
14.
أمير كُلاَلْ
بن حمزة :................................................................................... |
224 |
|
15.
محمّد بهاء
الدين
البُخَاريّ
المعروف بـ »شاه
نقشبند« :........................ |
226 |
|
16.
محمّد علاء
الدين
العطّار :........................................................................... |
233 |
|
17.
يعقوب اﻟﭽﺮخِيّ
:........................................................................................ |
235 |
|
18.
ناصر الدين
عبيد الله
الأحرار :................................................................... |
237 |
|
19.
محمّد زاهد
الْبَدَخْشِيّ
:................................................................................. |
241 |
|
20.
درويش محمّد
السمرقنديّ :....................................................................... |
241 |
|
21.
محمّد الْخُوَاﺟَﮕِﻲ
الأﻣْﮑَﻨَﮕِﻲ
:.................................................................... |
242 |
|
22.
محمّد باقي
بالله
الكابُليّ :............................................................................ |
243 |
|
23.
أحمد
الفاروقيّ
السرهنديّ
المعروف بـ »الإمام
الربّانيّ« :................... |
245 |
|
24.
محمّد معصوم
الفاروقيّ :............................................................................ |
261 |
|
25.
محمّد سيف
الدين
الفاروقيّ :.................................................................... |
262 |
|
26.
نور محمّد الْبَدَوَانِيّ
:................................................................................... |
263 |
|
27.
شمس الدين
حبيب الله مِيْرْزَا
مَظْهَر جَانِ
جَانَانْ :.................................... |
265 |
|
28.
غلام علي عبد
الله الدَّهْلَوِيّ
:................................................................... |
267 |
|
29.
خالد
البغداديّ
المعروف بين
النقشبنديّين
بـ »ذي
الجناحين« :......... |
270 |
|
* خالد
البغداديّ
ومعارضوه :............................................................................ |
289 |
|
* خلفاء
البغداديّ
وأسلوب
تعامله معهم :...................................................... |
310 |
|
* الميّزات
الشخصيّة
لشيوخ
الطريقة النقشبنديّة
ومستوياتهم العلميّة
والثقافيّة :............................................................................................................................ |
335 |
الفصل
الخامس
* أثر
الطريقة النقشبنديّة
على الحياة الاجتماعيّة
والثقافيّة في
المناطق
الّتي انتشرت
فيها.
|
استغلال
السلطة
للنقشبنديّين
ضِدَّ
الوهّابية :.................................................... |
354 |
|
النـزاع
القائم بين
النقشبنديّين
والوهّابيّين
منذ قرنين وأَثَرُهُ
الهدّامُ على
الإسلام والمسلمين
:............................................................................................................. |
358 |
|
العلاقات
بين السلطة
والنقشبنديّين
في العهد
الجمهوريّ :.............................. |
368 |
|
الفِرَقُ
الرئيسة
للنقشبنديّين
في تركيا اليوم
:.................................................... |
382 |
|
أهمُّ
الحركات السياسيّة
الّتي
استخدمتْ
السلطةُ
النقشبنديّين
في مقاومتها... |
387 |
|
تلفيقات
النقشبنديّين
في كثير من
أقوالهم ومواقفهم؛
وما جاء في
كلامهم من
ضروب التعارض
والضعف :............................................................................................. |
391 |
|
مقتطفات من
آرائهم
الّتي
ادّعوا أنها
من الدِّينِ
ولا حجّةَ
لهم في
إثباتها......... |
392 |
|
مسائل
متفرّقةٌ
اختلفوا
فيها
اختلافًا
صريحًا،
بحيث جاء
مقال بعضهم
تكذيبًا
لبعضهم
الآخر؛ وكذلك
أقوال بعضهم فيها
تضادٌّ
وتناقض
للقائل نفسه :................. |
396 |
|
أمثلة من
معاداة
النقشبنديّين
فيما بينهم، ومناهضتهم
وتباغضهم
وتشنيع
بعضهم على البعض
:............................................................................................................... |
413 |
|
أسلوب
المعارضة
عند
النقشبنديّين
:................................................................ |
418 |
|
الكلمة
الختامي:................................................................................................... |
426 |
|
كلماتٌ
توضيحيّة في
سياق
الإجابة على
التقرير
الصادر من
جامعة أمّ
القُرَى بِشأن هذا
الكتاب:................................................................................................................ |
431 |
![]()